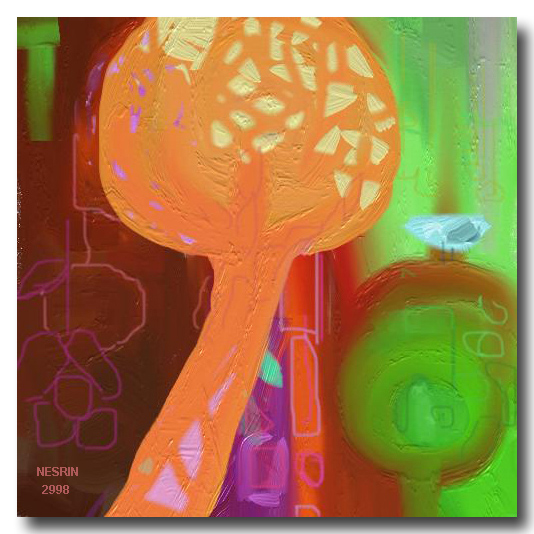|
|
جوليان بارنز
رياض قاسم حسن العلي


الحوار المتمدن-العدد: 8538 - 2025 / 11 / 26 - 16:13
المحور:
الادب والفن
حينما نشر جوليان بارنز روايته الأولى "مترولاند" (Metroland) عام 1980، لم يكن يدرك أنه بصدد إطلاق أحد الأصوات السردية الأكثر خصوصية في الأدب البريطاني المعاصر. استقبلت الرواية استقبالًا متناقضًا بين حفاوة النقاد وانزعاج العائلة، فقد أخبرته والدته بأنها منزعجة جدًا مما تضمّنته الرواية من إشارات جنسية صريحة، وهي التي كانت قد حذرته في طفولته من “توحش خياله”. هذه المفارقة بين الأم التي توبّخ ابنها على جرأة الخيال، والناقد الذي يحتفي بعمق التجربة، تمثل لحظة رمزية في سيرة بارنز الأدبية: لحظة انتقاله من الفضاء العائلي المحافظ إلى فضاء الكتابة بوصفها فعل تحرّر وتجاوز.
الناقد والشاعر الإنجليزي" فيليب لاركن " كتب له رسالة أثنى فيها على الرواية قائلًا إنه قد "استمتع بها كثيرًا"، وكان هذا الإطراء ذا قيمة رمزية خاصة، إذ جاء من أحد الأصوات الشعرية التي مثّلت الواقعية الإنجليزية المتقشفة والنزعة التأملية في الحياة اليومية. وإذا كانت الأم قد رأت في الرواية تعديًا على الحياء، فإن لاركن رأى فيها احتفاءً بالتحوّل الإنساني وبالانفلات من الضجر الطبقي والروحي الذي خنق أجيالًا من البريطانيين.
استوحى بارنز روايته "مترولاند" من رحلاته اليومية عبر مترو لندن أثناء دراسته الثانوية، فحوّل المكان إلى استعارة للنضج والتحوّل، فهو يرصد عبر شخصية البطل "كريستوفر لويد " تحوّل الوعي من المراهقة المثالية إلى الواقعية البورجوازية، ومن أحلام باريس الثورية إلى حياة الضواحي المتكررة الرتيبة. من هنا يمكن قراءة الرواية كـ تأمل ساخر في خيانة الذات الأولى: الذات التي حلمت بالحرية وانتهت بالامتثال. هذا التوتر بين الحلم والامتثال سيبقى السمة الأساسية في مشروع بارنز الروائي اللاحق كله، من "ضجيج الزمن" إلى "إحساس بالنهاية".
نالت الرواية جائزة سومرست موم، وهي جائزة تُمنح للكتّاب الشباب الذين يجسّدون روح المغامرة الأدبية. ومع ذلك، اختار بارنز نشرها تحت اسم مستعار مأخوذ من اسم زوجته – في دلالة مزدوجة على الحذر والتمويه، وكأن الكاتب في بداياته كان يخشى أن يُحاكم أدبيًا أو أخلاقيًا على ما كتبه، قبل أن يتصالح لاحقًا مع هويته السردية ويعلنها بلا أقنعة.
وفي عام 1997 تحولت الرواية إلى فيلم سينمائي كتب له السيناريو أدريان هودجز وأخرجه فيليب سافيل، وقام ببطولته كل من كريستيان بيل وإميلي واتسون. ورغم أن الفيلم لم يحقق شهرة جماهيرية واسعة، إلا أنه لاقى تقديرًا نقديًا متزنًا.
كتب الناقد" ديفيد روني" في مجلة Variety أن: "مخطط الفلاش باك في فترة باريس ودروس كريس وتوني المبكرة من ستينيات القرن العشرين منظمة ومباشرة للغاية، والملاحظات حول الإخلاص والالتزام والحل الوسط ليست جديدة. لكن الحوار الذكي الذي أجراه كاتب السيناريو ونهج المخرج المتواضع يجعل هذه التجربة أكثر إرضاء مما قد يوحي به نطاقها الضيق".
يمكن النظر إلى هذا التوصيف النقدي باعتباره مفتاحًا لفهم عالم بارنز السردي: العمق في البساطة، والفلسفة في التفاصيل اليومية. فهو كاتب يبحث عن الأسئلة البسيطة التي تفضح التعقيد الوجودي — عن معنى الحب، والالتزام، والوفاء، والتسوية، وكل ما يجعل الإنسان يعيش حياة “معقولة” لكنها خالية من الإشراق الأول.
بعد سنتين فقط، نشر بارنز روايته الثانية "قبل أن تقابلني" (Before She Met Me) سنة 1982، والتي مثلت خطوة أكثر جرأة من الناحية النفسية والفكرية. تدور الرواية حول مؤرخ غيور يغرق في هوس مرضي بماضي زوجته، حتى يتحول فضوله إلى جنون انتقامي. وإذا كانت "مترولاند" تبحث عن هوية مفقودة بين الحلم والواقع، فإن "قبل أن تقابلني" تغوص في الذاكرة بوصفها مرضًا، وفي الماضي بوصفه عدوًا لا يمكن هزيمته.
في هاتين الروايتين المبكرتين تتضح ملامح ما سيصبح لاحقًا أسلوب بارنز الفلسفي-الروائي: سردٌ بارد في ظاهره، لكنه يغلي في العمق بأسئلة الوجود والزمن والهوية. فهو يكتب عن التحولات البطيئة في الداخل الإنساني، حيث تتآكل القناعات، وتذبل الرغبات، ويتحوّل الماضي إلى مرآة لا ترحم.
--------------------
وُلد جوليان باتريك بارنز (Julian Patrick Barnes) في مدينة ليستر الإنجليزية عام 1946، في بيتٍ يمكن وصفه بأنه بيت اللغة والأدب بامتياز. فقد نشأ وسط عائلة أكاديمية كرّست حياتها للتعليم والثقافة؛ إذ كان والداه مدرّسين للّغة الفرنسية، وهو ما ترك أثرًا بالغ العمق في تكوينه الثقافي المبكر، ووجّه اهتمامه نحو التراث الأدبي الفرنسي الذي سيصبح لاحقًا أحد أهم منابع رؤيته الجمالية والفكرية ، يقول بارنز : " كانت أمي الشخصية المسيطرة في البيت، فهي المرأة الوحيدة فيه، كما أنها كانت الابنة الوحيدة في عائلتها. أما نحن الرجال، فلم يكن أحد منا — كيف أعبّر عن ذلك؟ — من ذلك النوع الذكوري المتسلّط أو المهيمن بلا هوادة، لذا يمكن القول إنها لم تجد من يقف في وجهها كثيرًا ".
أما شقيقه الأكبر، جوناثان بارنز، فقد اختار بدوره درب الفلسفة، وأصبح أحد أبرز المتخصصين في الفلسفة اليونانية القديمة، مما جعل من بيت آل بارنز مختبرًا مصغّرًا للتأمل والنقاش والجدل المعرفي.
تلقّى بارنز تعليمه في مدرسة "سيتي أوف لندن" العريقة، قبل أن يلتحق بكلية ماجدالين في جامعة أوكسفورد، حيث درس الأدب وتخرّج عام 1968 حاصلاً على درجة البكالوريوس في الآداب مع مرتبة الشرف. وبين عامي 1966 و1967، عمل مدرسًا في فرنسا، وهناك بدأ احتكاكه الحقيقي بالثقافة الفرنسية في عمقها الحيّ لا الأكاديمي فقط، متأثرًا بفلاسفة التنوير والرواية الواقعية ورمزية فلوبير وبروست وكامو. ومن هنا انبثقت حساسيته السردية المميزة التي تمزج بين الصرامة العقلية الفرنسية والسخرية البريطانية الباردة. ولهذا ليس غريبًا أن يكون أحد الكتّاب الإنجليز القلائل الذين يحظون بشعبية استثنائية في فرنسا، حيث تُرجم معظم أعماله مبكرًا ونال عنها جوائز فرنسية مرموقة.
بعد تخرجه، بدأ بارنز حياته المهنية بالعمل في معجم أوكسفورد للّغة الإنجليزية لمدة ثلاث سنوات، وهو عملٌ ترك بصمته العميقة على وعيه اللغوي، إذ تمرّس هناك بدقّة المفردة واشتغالها التاريخي في النصوص. ثم انتقل إلى الصحافة الأدبية، فعمل محررًا وناقدًا في أبرز المؤسسات الثقافية البريطانية في ملحق التايمز الأدبي، حيث كتب مراجعات نقدية بأسلوب ساخر ومكثّف.
و عمل كذلك محررًا في مجلة نيو ريفيو ومساعدًا محررًا أدبيًا وناقدًا تلفزيونيًا في مجلة نيو ستيتسمان (1977-1981).
ثم نائب رئيس التحرير الأدبي في صحيفة صنداي تايمز (1980-1982).
هذه المرحلة الصحفية كانت مخبرًا لتكوين صوته السردي والفكري؛ فبارنز تعلّم من الصحافة مهارة التقطيع، وإيقاع الجملة، والاقتصاد في اللغة، كما تمرّن على النظر إلى الواقع بعيون ناقدة وساخرة في آنٍ واحد. وربما من هنا ولدت نزعته الدائمة إلى تفكيك الخطابات الجاهزة، سواء كانت سياسية أو ثقافية أو دينية.
استمر بارنز في كتابة المقالات المتنوعة في الصحف البريطانية، أبرزها عموده الأسبوعي الشهير في صحيفة الغارديان بعنوان "المتحذلق في المطبخ" (The Pedant in the Kitchen)، وهو سلسلة من المقالات التي تمزج بين الطرافة والذكاء والتأمل في تفاصيل الحياة اليومية. حتى في هذه الكتابات الخفيفة ظاهريًا، كان يُظهر بارنز ذلك الحس الميتافيزيقي الدفين الذي يميّز مجمل أعماله الروائية: بحثه الدائم عن النظام في الفوضى، وعن الجمال في التفاصيل العابرة.
أما على الصعيد الشخصي، فقد كانت حياته تتميّز بقدرٍ كبير من التحفّظ والخصوصية. نادرًا ما يجري المقابلات، وإن فعل، فإنه يعطي منها مقتطفات مقتصدة من حياته الخاصة، محافظًا على مسافة بين الكاتب والعالم الخارجي، كما لو كان يؤمن بأن الكاتب لا يُعرّف بحياته بل بأعماله.
كان ارتباطه بزوجته بات كافانا (Pat Kavanagh) – وهي وكيلة أدبية بارزة – علاقة إنسانية ومهنية في آنٍ واحد. فقد كانت وكيلته الأدبية، وصديقته الأقرب، وشريكته في كل مراحل تطوره الأدبي، منذ بداياته الأولى وحتى وفاتها عام 2008. وبعد رحيلها، عبّر بارنز عن حزنه بطريقة نادرة في روايته "مستويات الحياة" (Levels of Life) الصادرة عام 2013، حيث تحوّل النص إلى تأمل عميق في الفقد والحب والموت. وكان قد صرّح عند فوزه بـ جائزة البوكر أنه يهدي كل نجاحاته إليها، اعترافًا بأنها كانت المرآة الصافية التي رأى من خلالها نفسه ككاتب وإنسان.
إن تتبّع مسيرة بارنز يكشف عن كاتب مهووس بالدقة والصدق الفكري في المعنى الجمالي ،أي الإخلاص للحقيقة المعقّدة للحياة. فهو من ذلك النوع من الكتّاب الذين لا يفصلون بين الحياة والمعرفة، بين التجربة والكتابة، بين اليومي والفلسفي. وربما يمكن القول إن جوليان بارنز يمثل نموذج “المثقف السردي” في الأدب الإنجليزي المعاصر، الذي يكتب الرواية بوصفها وسيلة للتفكير، لا للهروب من التفكير.
● الوكيل الأدبي
وللحديث عن وظيفة الوكيل الأدبي، يتبدّى أمامنا الفارق الحضاري والمؤسسي الهائل بين ما ترسّخ في تقاليد النشر الغربية، وبين ما يسود في العالم العربي من فوضى مهنية وتشتّت قانوني. فبينما ينظر الغرب إلى الوكيل الأدبي باعتباره الضمانة القانونية والأخلاقية لحقوق الكاتب، ووسيطًا محترفًا ينظّم العلاقة بين الإبداع وسوق الكتاب، ما يزال العالم العربي يفتقر إلى هذا المفهوم، حيث تُدار علاقة الكاتب بالناشر غالبًا بروح عشوائية أو شخصية، لا بضوابط مهنية واضحة، فيغدو الكاتب الطرف الأضعف في معادلة الإنتاج الثقافي.
ولتقريب الصورة، نستشهد بتجربة الكاتب العراقي محمد حياوي الذي قدّم وصفًا بالغ الدقة لهذه الفجوة في أحد تصريحاته قائلاً:
"أذهلتني تجربة متواضعة مررت بها مؤخراً عندما تعاقدت معي إحدى دور النشر الهولندية على ترجمة ونشر وتوزيع روايتي الأخيرة. أقول أذهلتني لجهة دقّة الإجراءات المعتمدة ودقّة العقد الذي روجعت مواده على يد أحد مستشاري اتحاد الكتّاب الهولنديين القانونيين، قبل أن يطالبني الناشر بتحديد وكيلي الأدبي. ونظراً لجهلي بمثل تلك التفصيلات، لجأت إلى الاتحاد نفسه كوني عضواً فيه، فتدخّل بصفته الاعتبارية كوكيل أدبي لي بعد أن تنازل عن حقّه العام من نسبة المبيعات، لكنني خرجت في المحصلة النهائية من هذه التجربة بخيبة أمل كبيرة وشعور بالإحباط مما يجري في عالمنا العربي من فوضى على صعيد صناعة النشر وتوزيع الكتاب وطبيعة العلاقة بين الكاتب والناشر".
تُظهر هذه الشهادة بجلاء أن الوكيل الأدبي في المنظومة الغربية فاعل ثقافي ذو كفاءة قانونية ومهنية، يدافع عن حقوق الكاتب ويصون استقلاليته، ويُعدّ صلة وصل حقيقية بين المبدع ومؤسسات النشر، وبين النص وسياقه التسويقي والحقوقي. فالمسألة هناك قائمة على ثقافة مهنية دقيقة، تجعل من كل خطوة في عملية النشر جزءًا من منظومة متكاملة تُراعي حقوق الملكية، والشفافية في التوزيع، وتوازن المصالح بين الأطراف.
أما في العالم العربي، فإن غياب هذا الدور جعل العلاقة بين الكاتب والناشر محكومة بالانطباع والمزاج والولاء الشخصي أكثر مما هي محكومة بالقانون. وفي حالات كثيرة، يتحول الكاتب إلى كائن تابع للناشر، يُساوم على نصه أو يُجبر على دفع تكاليف الطباعة والتوزيع، في غياب شبه تام للبنى القانونية التي تكفل حماية الإنتاج الثقافي.
إن ما يقوله حياوي هو تشخيص لبنية ثقافية مأزومة، تكشف كيف أن الكتابة العربية ما تزال خارج الصناعة بالمعنى الاحترافي للكلمة، وأن الكاتب العربي ما يزال — رغم كل الجوائز والمهرجانات والاحتفاءات — يفتقد إلى البنية المؤسسية التي تحميه كصاحب حقّ فكري ومادي.
من هنا تتضح أهمية وجود الوكيل الأدبي في تجربة كاتب مثل جوليان بارنز، إذ أن زوجته بات كافانا كانت الضامن المهني لمسيرته الأدبية، واليد الخبيرة التي تعرف كيف تتعامل مع دور النشر والجوائز والترجمات والحقوق الدولية. لقد مكّنته من أن يتفرغ تمامًا للكتابة، مطمئنًا إلى أن ما يكتبه سيجد طريقه إلى القارئ في أفضل صورة ممكنة، دون أن يُستنزف في دهاليز العقود والتفاهمات المالية.
وهنا يكمن جوهر الفارق: في الغرب، الكاتب هو مركز صناعة متكاملة تحيط به شبكة من الحماية والدعم، بينما في العالم العربي، الكاتب هو الحلقة الأضعف في سلسلة مرتجلة من التقديرات الشخصية والعلاقات العابرة. الفارق إذن في وجود منظومة تحوّل الكتابة إلى مهنة لا مغامرة، وإلى حرفة تحترم الزمن والجهد والعقل، لا إلى حالة من الهواية المزمنة التي تُغلفها الشعارات الثقافية دون بنية تحميها.
● ببغاء فلوبير
لكن الرواية التي جعلت اسم جوليان بارنز يتصدر المشهد الأدبي البريطاني والعالمي بحق، هي روايته الشهيرة "ببغاء فلوبير" (Flaubert’s Parrot) الصادرة عام 1984، والتي تُعدّ نقطة التحوّل الحقيقية في مسيرته الإبداعية، إذ أخرجته من دائرة الروائي الواعد إلى مصاف الروائي المثقف الفيلسوف الذي يكتب من تخوم المعرفة لا من حدود الحكاية. لقد كانت هذه الرواية هي الأولى من أعماله التي تُترجم إلى لغات عديدة، كما وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر في العام نفسه، ونالت جائزة ميديسيس الفرنسية، وهو ما يعكس التقدير النقدي الكبير الذي لاقته خارج إنكلترا، خصوصًا في فرنسا التي رأت فيها نوعًا من "ردّ الاعتبار" لواحد من أعلامها الكبار، غوستاف فلوبير، ولكن من خلال عينٍ إنكليزية ساخرة ومتأملة في آن.
تبدو "ببغاء فلوبير" للوهلة الأولى عملاً عن فلوبير نفسه، عن سيرته وكتاباته ووساوسه ومثاليته الأدبية، لكنها في العمق رواية عن الرواية ذاتها، عن طبيعة السرد، عن الحقيقة والوهم في الفن، وعن العلاقة الملتبسة بين الكاتب والعالم، بين المتخيّل والواقعي. يقول الناقد المصري مهاب نصر في قراءته للرواية:
"تبدو الرواية كما لو كانت إعادة كتابة لسيرة الروائي الفرنسي غوستاف فلوبير، ولكنها بطريقة ما تعد رواية عن "الرواية"، ليس عن الفن الروائي فقط، انما عن إمكانات القص والسرد في الحياة والفن على السواء. أهما منفصلان حقاً؟"
هذا السؤال الأخير — "أهما منفصلان حقًا؟" — يمكن اعتباره المفتاح الفلسفي للرواية بأكملها. فبارنز في هذه التجربة يهدم الحدود بين النقد والسرد، بين البحث الأكاديمي والتخييل الروائي. شخصيته الرئيسة، الطبيب الأرمل "جيفري براكيت"، ليست سوى قناعٍ سردي لذات الباحث القلقة عن المعنى: يبحث عن الببغاء الذي كان رفيق فلوبير في أثناء كتابته مدام بوفاري، لكنه في الحقيقة يبحث عن جوهر الكتابة نفسها، عن الببغاء بوصفه رمزًا للذاكرة، ولعبثية المحاكاة، ولعجز الإنسان عن الوصول إلى "الأصل".
ما يفعله بارنز هنا هو نوع من التأمل الميتاسردي في فكرة الأدب، إذ تتقاطع الفصول بين البحث في حياة فلوبير، والتأمل في النصوص، والسخرية من المؤرخين والنقاد الذين يتوهمون أن الحقيقة يمكن أن تُلتقط من الوثائق. الرواية تعبر عن هوسنا جميعًا بالعثور على المعنى المفقود في نص الحياة.
وقد صرّح بارنز في إحدى مقابلاته أنه تعرّف إلى فلوبير وهو في الخامسة عشرة من عمره، حين قرأ "مدام بوفاري" لأول مرة، فاندهش من قدرة اللغة على أن تُضيء الخيانة والملل واليأس بهذا القدر من الجمال. ومنذ تلك اللحظة، كما يقول، "أدركت أن الأدب ليس مجرد حكاية تُروى، لكنه وعيٌ يُفكّر بنفسه". لقد قرأ بعدها كل ما كتبه فلوبير، حتى رسائله الخاصة، وأصبح بالنسبة له نموذج الكاتب المهووس بالدقة والجمال والصدق الفني المطلق — وهي السمات التي سعى بارنز نفسه إلى تجسيدها في كل ما كتب لاحقًا.
ومع ذلك، يظل سؤال الناقد في محله: لماذا لم تفز الرواية بجائزة المان بوكر؟ ولماذا ظل بعض النقاد الإنجليز ينظرون إليها ببرود؟
ربما لأن الرواية، رغم جمالها، تحدّت التقاليد البريطانية المحافظة في السرد. فهي تتأمل في معنى أن نحكي أصلًا، وتكشف كيف أن الحقيقة الأدبية ليست أكثر من تركيب لغوي متقن. كانت الرواية — بكل جرأتها الشكلية والفكرية — أقرب إلى المشروع الفرنسي في "تفكيك النص"، حيث تتماهى الكتابة مع النقد الذاتي للكتابة. ولهذا، فبينما رحّب بها الفرنسيون وعدّوها تحية بارعة لفلوبير، استقبلها بعض النقاد الإنجليز بقدر من التحفّظ، معتبرين أنها أقرب إلى لعبة فكرية منها إلى رواية “حية” بالمعنى الواقعي.
لكن تلك اللعبة الفكرية نفسها هي ما جعل من "ببغاء فلوبير" عملًا مفصليًا في الأدب الإنجليزي الحديث، إذ دشّنت ما يمكن تسميته بـ المرحلة الميتاسردية في تجربة بارنز، تلك التي جعلته يكتب من داخل الرواية عن الرواية، ومن داخل اللغة عن اللغة، مستبدلًا السرد الخطي بالحفر المعرفي في بنية الذاكرة والتاريخ والفن.
-----------------
يرى جوليان بارنز أن الكتاب الجيد يشبه الحيوان في تكوينه العضوي؛ له رأس وجسد وذيل، وعلى الكاتب أن ينسّق ما بينها ليولد عملًا نابضًا بالحياة، متماسك البنية، جميل التكوين. هذه النظرة المجازية تعكس فلسفته في السرد: أن الجمال يتحقق في طريقة ربط أجزاء الفكرة وتوزيع أنفاسها داخل الكائن النصيّ الحيّ.
تقول "فانيسا جينيري" في تحليلها لأعمال بارنز إن "السمة المميزة في مجمل نتاجه هي تنوّع الموضوعات والتقنيات، وهو تنوّع يربك بعض القرّاء والنقّاد، لكنه في الوقت نفسه يسحر آخرين. فبينما يمكن تحديد بعض الثيمات الأساسية مثل الهوس، والحب، والعلاقة بين الحقيقة والخيال، واستحالة استعادة الماضي، فإنّ ما يميز بارنز هو أنه في كل رواية يحاول اقتحام مجال جديد من التجربة الإنسانية، مستكشفًا أنماطًا سردية مختلفة، ومختبرًا حدود الحكاية ذاتها".
وفي إحدى عباراته التي تكشف عن عمق وعيه الجمالي، يقول بارنز: "إن السعادة تكمن في الخيال، لا في الفعل، والمتعة توجد أولاً في الترقّب، ثم لاحقًا في الذاكرة. ذلك هو المزاج الفلّوبيري."
بهذا المعنى، يبدو بارنز امتدادًا لتقليد سردي يرى في الأدب وسيلة لتكثيف التجربة لا استنساخها، وفي الخيال أداةً لفهم ما لا يُفهم في الواقع.
وفي عام 2011، بعد مسيرة طويلة من الحضور النقدي والنجاح الأدبي، التفتت إليه جائزة "المان بوكر" أخيرًا عن روايته البديعة "الإحساس بالنهاية" (The Sense of an Ending)، وهي الرواية التي رسّخت مكانته بين كبار الروائيين الإنجليز المعاصرين.
وجائزة المان بوكر التي تأسست عام 1969 برعاية شركة "بوكر" — أكبر الشركات البريطانية المعنية بالنشر والنقد الأدبي — كانت قد تجاهلت بارنز ثلاث مرات حين وصل إلى قائمتها القصيرة دون أن يفوز. لكنه في المرة الرابعة كسر الصمت، قائلاً في حوار مع صحيفة لندن إيفنغ ستاندرد: "لقد كانت لي تجربة طويلة مع عدم الفوز بهذه الجائزة؛ أُدرِجت في القائمة القصيرة ثلاث مرات من قبل، وأعتقد أنني قد استنفدت كل الاحتمالات المتعلقة بهذا الأمر، وآن أوان التغيير أخيرًا."
●ترجمات بارنز الى العربية
تُرجمت إلى العربية ثلاث من أبرز أعمال جوليان بارنز، جاءت متفاوتة في جودتها، وكاشفة في الوقت نفسه عن طبيعة التلقي العربي لأعمال هذا الكاتب الماكر في لغته والمراوغ في تقنياته السردية:
1. رواية "الإحساس بالنهاية" (The Sense of an Ending) صدرت ضمن سلسلة إبداعات عالمية عن المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب في الكويت عام 2012، بترجمة الدكتور خالد مسعود شقير ومراجعة الدكتور حسين علي الديحاني.
غير أن هذه الترجمة مثّلت واحدة من أكثر الترجمات إثارة للجدل، إذ لجأ المترجم إلى حذف مقاطع كاملة من النص الأصلي تحت ذرائع أخلاقية تتعلق “بحماية القارئ” من ما اعتبره محتوى غير مناسب. هذه الرقابة الذاتية، التي تنطلق من مبدأ “لا أُريكم إلا ما أرى”، أفرغت النص من حيويته الفكرية وجماله الدلالي، فضلاً عن الركاكة اللغوية والافتقار إلى الحسّ الأدبي الذي تتطلبه ترجمة نصّ بارنز المعقّد. لذلك يمكن القول إن هذه النسخة قدّمت نصاً مشوّهاً ومبتوراً أكثر مما قدّمت ترجمة أدبية أمينة.
2. رواية "ضجيج العصر" (The Noise of Time) صدرت عن مجموعة كلمات الإماراتية عام 2019 بترجمة عهود المخيني، وهي ترجمة يمكن عدّها من المحاولات العربية الجادّة لفهم بارنز ونقله بلغته الدقيقة والمتأملة. تقول المترجمة في حوار لها مع الترا صوت: "دعني أطري على جوليان بارنز القارئ الحذق. إنه روائي ذكي، لا في السرد فقط، بل في الربط أيضًا. يجيد التنقّل بخفة بين القارات والأماكن والشخوص والمشاعر بطريقة تجعلك تقف متوجسًا إلى جانب شوستاكوفيتش في حواره التاريخي مع ستالين، ثم تنتقل إلى لحظات فرحه الخجول برفقة لينين. لن تشعر بالانقطاع ولا بغربة الشخوص الميتة."
هذه القراءة تكشف عمق فهم المترجمة لبنية الرواية السيرية التي قدّم فيها بارنز حياة الملحّن شوستاكوفيتش كصراع دائم بين الفن والطغيان، وهو ما انعكس بوضوح في ترجمتها الرصينة والأسلوب السلس الذي حافظ على نبرة بارنز المرهفة.
3. رواية "ببغاء فلوبير" (Flaubert’s Parrot) صدرت كذلك عن دار كلمات في العام نفسه (2019) بترجمة بندر محمد الحربي، وقد حظيت هذه النسخة باستقبال نقدي وجماهيري واسع في معارض الكتب العربية. تميّزت الترجمة بالدقة والقدرة على نقل روح السخرية الذكية التي تطبع أسلوب بارنز، وهي من الترجمات القليلة التي نجحت في الحفاظ على التناوب بين الفكاهة والمأساة، بين الهوس بالكاتب الفرنسي غوستاف فلوبير وبين تساؤلات بارنز الدائمة حول معنى الفن والكتابة والذاكرة.
يمكن القول، في المحصلة، إن ترجمة أعمال بارنز إلى العربية ما زالت محدودة، لكنها تشكّل خريطة مصغّرة لطبيعة الترجمة الأدبية العربية اليوم: تتأرجح بين الرقابة والتأويل، بين الخوف من النصّ والرغبة في امتلاكه.
●بارنز والسينما
تُعد العلاقة بين الأعمال الروائية والسينما والتلفزيون في الثقافة الغربية من الظواهر الراسخة، إذ تُظهر كيف أن الأدب يتحول أحيانًا إلى نص بصري ودرامي يمتد إلى الجمهور السينمائي. ذلك لأن كثيرًا من الروايات الغربية، بما فيها أعمال جوليان بارنز، تضم عناصر التشويق والإثارة والحبكة المحكمة التي تجعلها قابلة للتكييف بصريًا، مع الحفاظ على روح النص وأبعاده النفسية والفكرية.
لكن تحويل الرواية إلى فيلم أو مسلسل لا يتم إلا بتعاون وثيق بين المخرج والروائي، إذ يحتاج المخرج إلى فهم معمّق للخبايا الأدبية، وإلى جلسات مطوّلة مع الكاتب لتوضيح ما قد يلتبس عليه في النص، وفي بعض الحالات يشارك الروائي نفسه في كتابة السيناريو، أو يكتب النص بنفسه. هذه العملية تكشف عن التفاعل الإبداعي بين الأدب والسينما، حيث تتحول الرواية إلى كائن حيّ جديد يتنفس على الشاشة، دون أن تفقد صلته بالأصل الأدبي.
من أبرز أعمال بارنز التي تحولت إلى أعمال سينمائية أو درامية:
1. فيلم Love, etc وهو إنتاج فرنسي من إخراج ماريون فيرنو الذي كتب السيناريو أيضًا، وعُرض سنة 1996 مأخوذ عن رواية Talking It Over البطولة ضمت شاراوت جينسبورغ وإيفان عتال من أصول جزائرية، وتشارلز بيرلينغ ،وهذا الفيلم يُعد مثالًا على التكييف الذي يحافظ على روح الرواية في النقل بين الثقافات واللغات.
2. فيلم Metroland سبق ذكره، مأخوذ عن أولى روايات بارنز، يحكي قصة التحولات النفسية والاجتماعية لشاب في لندن.
الإنتاج أظهر العلاقة الوثيقة بين السرد الذاتي والتكييف البصري، مع مراعاة التفاصيل النفسية الدقيقة للشخصيات.
3. الدراما التلفزيونية Arthur & George
وهو مسلسل من ثلاثة حلقات أخرجه ستيورام أورم، وكتب السيناريو إيد وايتمور.
البطولة: آرشر علي وتشارلز إدواردز، وأدى دور كونان دويل الممثل مارتن كلونيس.
الرواية تحولت أيضًا إلى مسرحية عام 2010 على مسرح برمنغهام ريبيرتوري، كتب النص المسرحي ديفيد إدغار، وهو مثال على مرونة النص الروائي في الانتقال بين الوسائط الإبداعية.
صدرت الرواية عام 2005، وتستند إلى أحداث حقيقية تتناول علاقة غريبة ومعقدة بين السير آرثر كونان دويل (مؤلف شخصية شارلوك هولمز) وبين جورج إدالجي، وهو محامٍ من أصول هندية اتُّهم ظلمًا بجريمة لم يرتكبها.
تتناول الرواية قضايا العدالة والهوية والتمييز الطبقي والعِرقي في إنجلترا مطلع القرن العشرين، بأسلوب بارنز المميز في المزج بين السرد التاريخي والتحليل النفسي.
4. فيلم الإحساس بالنهاية (The Sense of an Ending) إخراج: ريتيش باترا، سيناريو: نيك باين، بطولة: جيم برودبنت وشارلوت رامبلينج، وعُرض عام 2017 حيث تلقى أداء جيم برودبنت إشادة نقدية كبيرة، لكنه لم يحقق النجاح التجاري المتوقع على شباك التذاكر، مما يعكس صعوبة نقل رواية تقوم على التأمل الذاتي والذاكرة والندم إلى شكل بصري محكوم بمطالب السوق السينمائي.
● أعمال لا يمكن تقديمها سينمائيًا
توضح هذه الأمثلة أن أعمال بارنز، رغم خصوصيتها الفكرية والذهنية، يمكن أن تتكيف بصريًا، لكن نجاح هذا التكييف يتوقف على فهم النص وروحه الدقيقة، وعلى قدرة المخرج والسيناريست على الحفاظ على التوتر الدرامي والتأمل الفكري دون المساس بالعمق الأدبي.
فرواية "ببغاء فلوبير" تمثل مثالًا صارخًا على الصعوبة التي يواجهها أي مخرج أو سيناريست عند محاولة تحويل نص بارنز إلى عمل بصري. السبب الأساسي يكمن في الميتاسرد وتعقيد البنية الزمنية والفلسفية للرواية. فالرواية تتنقل بين ذكريات شخصية الراوي، وتأملاته النقدية في نصوص فلوبير، وبين مقاطع من السير الذاتية والتأويلات التاريخية، مع تقطيع متعمد للزمن والحكاية، ما يجعل أي نقل حرفي إلى السينما أو التلفزيون أمرًا معقدًا للغاية.
إضافة لذلك، تحتوي الرواية على طبقات متعددة من التأمل في طبيعة الكتابة والفن والأدب نفسه؛ وهي استكشاف لمفاهيم مثل الهوس، والذاكرة، والوهم، والعلاقة بين الحياة والفن. أي محاولة للتركيز على الحبكة الخارجية وحدها من دون التعمق في هذه الطبقات المعرفية ستفقد النص روحه، كما يوضح نقد بعض التكييفات الأدبية إلى السينما التي لم تنجح في التقاط هذا العمق.
كما أن الرواية تعتمد بشكل كبير على اللغة نفسها كعنصر فني محوري: الجمل الدقيقة، السخرية الذكية، والتناوب بين الأسلوب النقدي والفكاهي، كلها عناصر يصعب نقلها بالصورة أو الصوت، لأنها جزء من تجربة القراءة التي تجعل القارئ شريكًا في بناء المعنى. لذلك، حتى أفضل التكييفات السينمائية لا تستطيع إلا أن تقدم نسخة مُختزلة أو مترجمة بصريًا لهذه التجربة الفكرية الغنية، مما يبرز الفجوة بين النص الأدبي المكتوب والتجربة البصرية المتاحة للجمهور.
من هنا يمكن فهم لماذا لم تُحول بعض روايات بارنز، مثل "ببغاء فلوبير"، إلى أعمال سينمائية أو تلفزيونية ناجحة، بينما كانت رواياته ذات الحبكات المباشرة والزمن الخطي النسبي، مثل "ميترولاند"أو "الإحساس بالنهاية" ، أكثر قابلية للتحويل، على الرغم من التحديات الفلسفية والتأملية التي تحتويها. إن هذا التباين يوضح بشكل جلي خصوصية نصوص بارنز الأدبية، وحرصه على الكتابة التي تتحدى القوالب التقليدية للسرد، وتجعل من تجربة القراءة نشاطًا ذهنيًا وتفكيريًا متكاملًا، يصعب اختزاله في صورة أو مشهد درامي تقليدي.
● اقتراحات القراءة
مقالة (Julian Barnes British author and critic) منشورة في موقع britannica
مقالة (Julian Barnes: ‘Do you expect Europe to cut us a good deal? It’s so childish’) لليزا الادريس منشورة في الغارديان بتاريخ 2019/10/26
مقالة سيرية للكاتب في صحيفة الغارديان منشورة بتاريخ 2018/3/2
مقالة تعريفية للكاتب منشورة في موقع FAMOUS AUTHORS
مقالة تعريفية للكاتب منشورة في موقع Waterstones
مقابلة اجراها الصحفي شوشا غوبي مع الكاتب نشرته مجلة باريس ريفيو سنة 2000
مقابلة مع الكاتب اجرته راشيل ويتريد منشورة في موقع interviewmagazin بتاريخ 2020/4/16
مقابلة مع الكاتب اجراها معه جون فريمان ونشرت مترجمة في موقع تكوين بتاريخ 2020/2/6 بترجمة عبد الوهاب السليمان
مقالة (جوليان بارنز.. أستاذ الرواية والعالم يعيش على نثره) منشورة في صحيفة المدى بتاريخ 2016/04/2 مترجمة عن صحيفة الاوبزرفر
مقالة ("الإحساس بالنهاية".. إبحار روائي في حياة الكاتب الإنجليزي جوليان بارنز) لسماح ابراهيم منشورة في الاهرام بتاريخ 2015/11/15
مقالة (جوليان بارنز يرصد تفاصيل حياة رتيبة بأسلوب مخادع في الشعور بالنهاية)منشورة في صحيفة الاتحاد بتاريخ 2011/10/29
مقالة (إبقاء العين مفتوحة لجوليان بارنز… لوحات فنية تساوي ألف كلمة ” صاحب ببغاء فلوبير والفائز بـ البوكر…) منشورة في صحيفة رأي اليوم بتاريخ 2016/12/21
مقالة (الإحساس بالنهاية لجوليان بارنز أو: هل نملك تاريخاً شخصياً؟)لمحمد عبد النبي منشورة في موقع الكتابة.
#رياض_قاسم_حسن_العلي (هاشتاغ)



ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

|
حفظ
 |
بحث |
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
| إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الإشراقية: فلسفة النور بين العقل والذوق وميراث الحكمة الشرقي
...
-
المثقفون الجدد
-
العقل بين الازدهار والانكسار: مسار المعرفة في الحضارة الإسلا
...
-
الإنسان على حافة الهاوية: بين ذئابية هوبز وألوهية فويرباخ –
...
-
تجربة ابن سينا مع كتاب -ما بعد الطبيعة- لأرسطو
-
الفلسفة وقيمة السؤال: نحو فهم جديد لمعنى التفكير الفلسفي
-
انطباع ضد الموضوعية: دفاع عن الذات القارئة
-
السرد، القارئ، والأنطولوجيا الإنسانية
-
باروخ سبينوزا: الفيلسوف الذي عاش منفياً من معابد البشر
-
عودة إلى سبينوزا مرة أخرى ورؤيته في علم الأخلاق
-
الفردية والإيديولوجيا: قراءة فلسفية ونفسية في فكر كارل يونغ
-
أفول أوروبا: بين النقد الجذري لأونفراي والسخرية الاستراتيجية
...
-
القنفذ والشعر: دريدا وبلاغة المأزق
-
حين تتحول الكلمات إلى أصنام: رؤية فلسفية للغة والفكر
-
التسعينات: نوستالجيا الخراب هوامش غير مكتملة
-
رافاييل: الجمال والانسجام
-
وهم الاختيار في الديمقراطية المعاصرة
-
الإنسان المعاصر بين الواقع والواجهة
-
حين يستحم النص: لعبة ما بعد الحداثة في -حمّام النساء- لندى س
...
-
الموضوعية والذاتية: إشكالية الفكر بين الحياد والانحياز
المزيد.....
-
عقدان من تدريس الأمازيغية.. ماذا يحول دون تعميم تدريس لغة ال
...
-
-أوبن إيه آي- تطلق نسخة مخصصة للترجمة من -شات جي بي تي-
-
العمدة الشاعر الإنسان
-
إيران في مرآة السينما: كيف تُصوّر الأفلام مجتمعا تحت الحصار؟
...
-
ذاكرة تعود من جبهات القتال.. السودان يسترد مئات القطع الأثري
...
-
متهم بالاعتداء الجنسي على الأطفال... المخرج تيموثي بوسفيلد ي
...
-
بالفيديو.. راموس يتدرب مع توبوريا بطل فنون القتال المختلطة
-
من كان آخر سلاطين الدولة العثمانية؟
-
الممثل الشهير كييفر ساذرلاند في قبضة شرطة لوس أنجلوس
-
عبلين تستضيف مختارات الشاعر الكبير سميح القاسم “تقدّموا” وأم
...
المزيد.....
-
دراسة تفكيك العوالم الدرامية في ثلاثية نواف يونس
/ السيد حافظ
-
مراجعات (الحياة الساكنة المحتضرة في أعمال لورانس داريل: تساؤ
...
/ عبدالرؤوف بطيخ
-
ليلة الخميس. مسرحية. السيد حافظ
/ السيد حافظ
-
زعموا أن
/ كمال التاغوتي
-
خرائط العراقيين الغريبة
/ ملهم الملائكة
-
مقال (حياة غويا وعصره ) بقلم آلان وودز.مجلةدفاعاعن الماركسية
...
/ عبدالرؤوف بطيخ
-
يوميات رجل لا ينكسر رواية شعرية مكثفة. السيد حافظ- الجزء ال
...
/ السيد حافظ
-
ركن هادئ للبنفسج
/ د. خالد زغريت
-
حــوار السيد حافظ مع الذكاء الاصطناعي. الجزء الثاني
/ السيد حافظ
-
رواية "سفر الأمهات الثلاث"
/ رانية مرجية
المزيد.....
|
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

 |
بحث
|
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
|
إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة