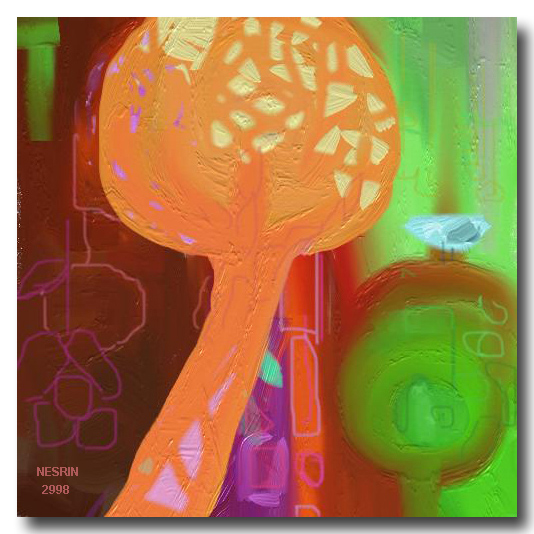|
|
(القلق شعرية بين الرمز والتلقي والسيمياء - قراءة في قصيدة شلال عنوز قرأتُكِ قلقاً)
سعد محمد مهدي غلام


الحوار المتمدن-العدد: 8501 - 2025 / 10 / 20 - 00:17
المحور:
الادب والفن
[ النص ]
("قَرأتُكِ قَلقاً"
حينَما قَرَأتُكِ
قَلَقاً
هَمَسَ البَوح
في أُذُن الوَقت
وَهوَ يَتصفّح
قَراطيس
فَم الوَجد
سَرقَتني الكلمات
تَوَسّدتُ
مخدّة المَجانين
تَوالى على ساحلي
شَهيق
أسراب الرَغبات
فاستبقتُ
صراخ ظِلّي
إليك
وانهمرتُ سَيلاً
نازفاً
مِن حُمّى
الانصِهار
هل هي
صِدفةٌ
أن يَلتقي بَحران
عِندَ مَرسى
مَنزوع
من رقابة
العَسَس؟
وهل يُولد الحُبّ
من رَحم خَريف
على سَفح
زمن
آيلٍ للغُروب؟)
1- مقدّمة تأطيرية
تنطلق هذه الدراسة من فرضية أنّ قصيدة :قَرأتُكِ قَلقاً، لشلال عنوز" لا تقرأُ بوصفها قصيدة عاطفية عابرة، بل بوصفها تجربة كتابية تختبر الحدود القصوى للغة عندما يُراد أن تَقول :القلق ،لا كموضوع، بل ككينونة شعرية متكاملة بين حدّي النص / القصيدة والمخاطب والتلقّي كلاهما. وقد اخترنا تقاطع ثلاث مناظر نقدية لتفكيك هذه الكينونة:
أ. السيميائية التي تُظهر كيف تَنتج العلامة دلالتها من داخل البنية الصورية والزمنية والجسدية.
ب. الرمزية التي تُتابع التحوّلات الوجودية والصوفية والإيروسية التي تُطلقها الصور.
ج. جماليات التلقّي التي تُبرز كيف يُنجز القارئ بنية المعنى عبر ملء الفراغات ومواجهة التوترات في حميمية تسابق الآفاق لبلوغ فهم المعاني .
بهذا نكون أمام مشروع قراءة: ثلاثية البُعد تسعى إلى الإجابة عن سؤال مركزي:
كيف يُصبح القلق - في شعرية عنوز - فعلاً لغوياً، ورمزاً وجودياً، وآلية تلقٍّ متجدّدة في آنٍ واحد؟
2-القراءة السيميائية الأولية:
أ. العتبة العنوانية
بنية زمانية فعلية مكتملة في زمنٍ ماضٍ يحملها العنوان تأكيدًا على رسوخ سابق لمحصلة فعل القراءة محملًا بطاقة إشارية كثيفة الدلالة ، ما يوحي بانقضاء تجربة شعورية تامة إذ يَدخِل فعل القراءة بعلاقة عاطفية مباشرة مع القلق كعاطفة فاعلة منفعلة مما يكسب النص مكنة التحوّل إلى فعالية تأويلية متبادلة وفعل معرفي وجودي يحقق للغة وظيفتها الايحائية الياكبسونية ، لكنها مفتوحة دلاليًا: «قرأتُكِ» تعني هنا استبطان الآخر واستظهاره… وكشفًا عن معاناة القارئ من جرّاء بركسيس القراءة. «قلقًا» ليست صفة الموصوف بل هي الصورة التي يتجلى بها الآخر المستظهر استبطانًا داخل الذات وارتكاساته في الذاكرة المحفوظة وما تتركه على حاضر وجدان الشاعر. تتقاطع «القراءة» مع «القلق» في تمثيل حالة من الوعي الوجودي المشوَّش ليس بفعل الريبة بل جراء تناسل المتناقضات بين سيرورة اليقين وصيرورته، حيث يصبح الحبيب نصًّا يتلوه العاشق لا بعينه، بل بتوتره الدائم وحيرته إزاء تصادم الخلاص بالإخلاص وديمومة انطباعات الماضي الحسية على فعاليات مواكبة الشاعر لمطالعة المقروء وجودًا نصيًا يتجسد في الكينونة الشاخصة للمقروءة قلقًا.
ب. المشهد الشعري وتحولات العلامة
أولًا/ همس البوح - قراطيس فم الوجد
- «همس البوح في أذن الوقت» تشكيل سيميائي لفعلٍ حميم يُمارَس مع الزمن، حيث يُنسَب للبوح سلطة الزمن وهيمنته الظاهراتية، وهذا متوقع عندما يتجسد شاخص الكائن نصًا مقلقًا.
- «قراطيس فم الوجد»: استعارة مركبة تُشبه الحبيب - أو التجربة - بورقة يُقرأ منها الانفعال، في بنية تجعل الوجد جسدًا له فم وأوراق. هذه الصورة تعبّر عن تشظي الحضور داخل الغياب وتشيؤ الإحساس والتراسل مع الوجود.
ثانيًا/
سَرقَتني الكلمات - مخدة المجانين
- دال «السرقة» يوحي بغياب السيطرة والانجراف خلف انفعالات اللغة المخادعة وغوايتها الطاغية .
- «مخدة المجانين» ليست استعارة بسيطة، بل رمز يعيد إنتاج العشق كنوع من الجنون الفوكوي، مستمدّ من خطاب الصوفية والعاشقين الذين يفقدون توازنهم أمام النص/الآخر.
ثالثًا/
التوتر والذوبان
- «شهيق - صراخ - انهمرت - حمى - الانصهار» كلها علامات جسدية تمثل حالات ومواقع في المقام العاطفي تنتاب طارق المسلك مأخوذًا بها صاغر الإرادة.
3- المشهد الرمزي:
التماهي والانصهار
- «توالى على ساحلي شهيق أسراب الرغبات»: يُجسَّد «الساحل» هنا الجسد/الذات المتلقية بالجذب… و«أسراب الرغبات» كائنات طائرة تنقضّ على المدى الداخلي.
- «فاستبقت صراخ ظلي إليك»: الظل ليس تابعًا مرئيًا، بل صورة باطنية للذات العاشقة، والاستباق كسرٌ للمنطق الزمني.
- «وانهمرتُ سيلًا نازفًا من حمى الانصهار»: الجسد يتحوّل إلى مادة: ماء، دم، حرارة… تفكك الهوية داخل طقس العشق.
4 -الأسئلة الختامية:
شفرات الميتا-عشق
- «هل هي صدفة أن يلتقي بحران عند مرسى منزوع من رقابة العسس؟»: ترميز للعاشقين في موضع لقاء حرّ، منزوع من رقابة الرقيب، تمرّدًا وجوديًا.
- «وهل يولد الحب من رحم خريف؟» سؤال مفتوح على ميتافيزيقا الزمن: الحب يولد في الذبول والغياب، احتجاجًا على الغياب لا احتفالًا باللقاء.
خلاصة سيميائية
قصيدة «قرأتُكِ قلقًا» نص رؤيوي مفعم بالمجازات الحارقة… الذات لا تقرأ الآخر بعين العارف، بل تتفتّت في حضوره… لتدور في حومة وغى الحيرة… درويشًا ملاماتيًا في حلقة الذكر حول شمس الآخر الحارقة. اللغة هنا ليست أداة، بل معراج إلى التهلكة الوجدانية… وهي الطريق الوحيد لمعرفة الوجود والتعرف على الآخر وبوابة كشف الذات.
5 -القلق كرمز
أ. العنوان:
فتحة دلالية مشحونة
مع انفتاح العتبة الأولى على فعل ماضٍ مكتمل يوحي بانقضاء تجربة شعورية، ظلّ مفتوحًا على أفقٍ دلالي يتجدّد في كلّ قراءة. فالفعل «قرأتُكِ» ليس فعل معرفة، بل استبطان للآخر واستظهاره، كأنّ المحبوب نزع الحجاب وتحوّل إلى نصٍّ يُتلى ويُفكَّك. العنوان، وفق مفهوم «الوظيفة الإيحائية للغة» عند ياكوبسون، يكثّف الدلالة في لحظة انفتاح يغذّي سائر النص (إسماعيل 1).
ب. مشهدية القراءة كفعل وجودي
يُشخَّص في العنوان مجازُ التشخيص: المقروءة امرأةٌ حيّةٌ بالقلق، والقارئ لا يقرأ كلمات، بل يقرأ هيئة كيانية من القلق كماهية وجود، فتندثر الحدود بين الذات/القارئ والموضوع/المقروءة. القلق هنا ليس حالة نفسية، بل كيانٌ مُجسَّد يُقرأ، وهو الجوهر المقروء في القراءة الصوفية عند ابن عربي: «الكون كتاب الله، والإنسان حروفه» (3).
ج. القلق:
هوية انطولوجية
يشير القلق إلى أليات دفاعية يطلقها الشعور تجاه الآخر، وقد أطلق هارولد بلوم عليه «قلق التأثير» المحفّز للإبداع ومرافق خوف الشاعر من تأثيرات الآخر. في قصيدة عنوز يتحوّل القلق إلى ابتلاء المحب من وجود المحبوب وإمكان فقدانه، فيتجلى توقًا وشغفًا وجوديّين لا خلاص منهما. وبهذا يصبح القلق هوية انطولوجية للشاعر والصوفي والمحبّ على حدّ سواء.
د. المشهد الشعري وتحوّلات العلامة
- «همس البوح في أذن الوقت» تُجسّد البوح ككائن يخاطب الزمن مباشرة، فيعلن العاطفة طرفًا في سرّ عشقي.
- «قراطيس فم الوجد» استعارة مركبة تشي بتشظي الحضور وتحويل الشعور إلى نصّ ماديّ.
- «سرقتني الكلمات» تُفيد ضياع السيطرة أمام غواية اللغة، فتصير الكلمات سلطة تمارس فعلها على الشاعر (الغذامي 7).
هـ. الساحل كفضاء للهوية المُتفتّتة
يتكرر مشهد الساحل المائيّ/الهامشي، فيُصبح حدًّا متآكلًا لا يفصل بين الداخلي والخارجي بل يُذيبهما. «شهيق أسراب الرغبات» ليس فعل تنفّس، بل اجتياحٌ طائر يُذكّر برمز الماء عند أدونيس: «انبعاث وانحلال معًا».
و. المشهد الرمزي: تماهٍ وانصهار
- «الساحل» رمز للذات المتلقية اندفاع الموج العاطفي.
- «أسراب الرغبات» تزرع ندوبًا تتحوّل براعم، في مفارقة صوفية بين الجرح والولادة (ابن عربي 13).
- «صراخ الظل» يكشف قرين الذات الوجودي، والاستباق كسرٌ زمني يُعلن شدّة الانجذاب.
- «انهمرتُ سيلًا نازفًا من حمى الانصهار» تُصوّر ذوبان الجسد في ماء ودم وحرارة، إعادة صياغة للهوية عبر العشق (باشلار 15).
ز. الأسئلة الختامية: شفرات ميتا-عشق
- «هل هي صدفة أن يلتقي بحران عند مرسى منزوع من رقابة العسس؟»
- ليس سؤال صدفة، بل كشفٌ للمستتر: اللقاء خارج سلطة الرقيب تمرّد وجودي.
- «وهل يولد الحب من رحم خريف؟»
-الخريف رحم رمزي للموت/الولادة معًا، في احتجاج على الغياب أكثر من احتفال بالحياة (أدونيس 17).
ح. الخلاصة الرمزية
«قرأتُكِ قلقًا» نصّ رؤيوي يُجسّد العشق قدرًا وجوديًا لا مهرب منه. تتقاطع الحواس بالفكر والجسد بالروح واللغة بالصمت. الذات لا تعكس الآخر، بل تتفتّت في حضوره وتدور حلقة الحيرة بحثًا عن ذاتها في الآخر وعن الآخر في ذاتها، فيكون الانصهار مصيرًا لا يُردّ. القلق إذن جوهر العشق والقراءة معًا: هو الوجود في ذاته، و«الشعر فضاء للولادة المستمرة للمعنى» (إسماعيل 27).
6 - القلق كفضاء تلقٍّي
أ. تحديد منهجي: لماذا جماليات التلقي؟
يفترض هانس روبرت إيزر أنّ النص لا يتحقّق إلا بفعل قراءة يملأ فيها المتلقّي «الفراغات/الثقوب» التي يُحدثها الشاعر، فيُنشئ «بنية موضوعية افتراضية» تتبدّل مع كل تجربة تلقّية. القصيدة إذن ليست كائنًا مغلقًا، بل «مربّع إنتاج» يتجدّد عبر تفاعل القارئ مع دلالاته المفتوحة، فيردم الفجوات بأدوات التنقيب ومخزونه المعرفي.
ب. عنوان القصيدة كدليل تلقٍّ أوّلي
- «قرأتُكِ» يُفعّل المجاز التشخيصي، يستدعي خبرة القارئ بتراث «الكتابة كامرأة» و«المرأة ككتاب» (ابن عربي).
- «قلقًا» تقدّم صفةً غير مرئية كاسم مفعول به، فتخلق فراغًا سيميائيًا: ما معنى أن تقرأ «حالة» لا «كيانًا»؟ يُدفع القارئ إلى تفعيل «أفق المخزون» المتعلّق بالقلق كرمز للوجود الحديث.
ج. البنية السردية الصغرى وتفاعل القارئ
أولًا/
. التقطيع المضبوط بالفراغات البيضاء
كل مقطع يُنهى بتعليق سطر أو كلمتين؛ تلك «الكسرة البصرية» تُحدث إيقاع «ترقّب/انقطاع» يُجبر القارئ على إعادة صياغة المعنى داخليًا. إنها تقنية «تحوير» تُنتج «مسافة جمالية» تمكّنه من رؤية ذاته وهو يُنتج الدلالة (إيزر 1975: 213).
ثانيًا/
التحوّلات الضميرية
يتنقّل المتكلّم بين «أنا» (مضمر) و«ظلي» و«سيلٍ» ثم يعود إلى «أنا» سائلًا. هذه التحوّلات تُشكّل «نقاط تلاقٍ متعددة» تتيح للقارئ الإبحار بين هويات متموّجة، فيُنتج معنى جديدًا في كل قراءة؛ فعل التلقّي يشبه «الإبحار دون مرسى محدّد» (Spielraum).
7- المشهد الرمزي: «مرسى منزوع من رقابة العسس»
- «العسس» يستدعي مخزونًا ثقافيًا (الدولة/الأب/القانون) فيحدث فراغًا معنويًا: ماذا يحدث حين تُرفع الرقابة؟ يدخل القارئ في «تفاوض افتراضي» بين رغبته في التمرّد وخوفه من الفوضى.
- لقاء «بحرين» يُفعّل «قاعدة السمة المكانية» (باختين) التي تُفكك الحدود بين الذات والآخر؛ النص لا يعطي إجابة، فيبقى الفراغ مفتوحًا ليُملأ بخبرات القرّاء.
8- السؤال الخواتيمي: «وهل يولد الحب من رحم خريف؟»
- «رحم خريف» فراغ مركزي يختبر إمكان ولادة الحياة من الموت؛ يُفعّل القارئ «أفق توقّع» متناقضًا: خبرته اليومية تقول إن الخريف نهاية، بينما يدعوه السؤال لتصوّر عكس ذلك.
- هذا التناقض يولّد «الديناميكية التوترية» التي تُبقي التلقّي مفتوحًا؛ كل قارئ يُعيد صياغة إجابته فيحدث «تحوّلًا في أفق التوقّع» (Horizontwandel).
9- التلقّي المُوسَّع والرقمي
في الوسائط الرقمية يتضاعف «الانكشاف»؛ يستطيع القارئ التوقف، إعادة التغريد، التعليق، حتى تعديل النص. تُنتج هذه الممارسات ما يُسمّيه إيزر «النص الممتدّ» (extended text) الذي يتجاوز الصفحة المطبوعة، فتصبح القصيدة عملاً متناسلاً مع كل تفاعل.
10- خلاصة التلقي:
القلق كمحرّك للتجربة الجمالية
- لم يُقدَّم للقارئ إجابات جاهزة، بل زُرعت فراغات يملؤها باستمرار؛ القلق إذن ليس موضوعًا، بل آلية تلقي تُبقي الذات في «تفتح دائم» (perpetual openness).
- بذلك تتحقق «أيديولوجيا التلقي» عند إيزر: القارئ لا يستهلك النص، بل «يُنتجه» من جديد في كل مرة ويُعيد إنتاج نفسه معه.
11- مقاربة ياوس/إيزر الختامية
إذا كان النص يبني أفقًا غنائيًا متوقعًا في بدايته، فإنه يُخترق فجأة بالسؤالين المفتوحين، فيُلقى بالقارئ في فضاء تأويلي وجودي. بهذا الخرق تكتسب القصيدة قيمتها الجمالية؛ إذ تُخلّف «فراغات نصية» لا تُملأ إلا بتدخل القارئ الذي يصبح شريكًا في إنتاج الدلالة.
12 - خلاصة تركيبية
كيف تُنجز شعرية القلق في «قرأتُكِ قَلقاً» تكاملًا بين السيمياء، الرمز، والتلقي؟
أ. سيميائيًا:
العلامة هنا ليست دلالة على شيء غائب، بل «فعل حي» يُنتج جسدًا وزمنًا ومادة. القارئ يُلاحظ:
- اشتغال الفعل الماضي «قرأتُكِ» كمحدد زمني مغلق يفتح ذاكرة مستقبلية للتوتر.
- تحولات الدلالات الجسدية (همس/شهيق/سيل/حمى) إلى سلسلة من «الإشارات الذائبة» التي تُفكك الثبات الدلالي للكلمات.
ب. رمزيًا:
القلق يتجاوز الحالة النفسية ليصبح:
- «كتابًا مفتوحًا» يُقرأ وجوديًا على النحو الصوفي.
- «مرسى» و«رحم خريفي» يُفجّران ثنائية الموت/الولادة، فيُصبح القلق فضاء للانبعاث عبر الانحلال.
ج. تلقيّيًا:
النص لا يُعطي إجابة، بل يُورّط القارئ في:
- ملء الفراغات البصرية والزمنية (الكسور، التحولات الضميرية).
- التفاوض مع الرقابة الرمزية (العسس) ومع الخوف من «الخريف» كرمز للنهاية.
- إعادة إنتاج ذاته عبر كل قراءة جديدة، فتتحقق «شعرية القلق» بوصفها حالة تفتح دائمة لا تُحسم.
إجمالًا، تُقدّم القصيدة نموذجًا نادرًا يتقاطع فيه:
- التحليل البنيوي (كيف تُنتج العلامة معناها)،
- التحليل الرمزي (كيف يتجلى القلق كينونة وجودية)،
- التحليل التلقّي (كيف يُصبح القارئ شريكًا في إتمام الدلالة).
وهكذا يبقى «القلق» - في شعرية شلال عنوز - ليس موضوعًا شعريًا يُروى، بل آلية كتابية تُعيد تشكيل الذات واللغة والعالم في آنٍ معًا.
13 - المراجع
(بترتيب أبجدي لأسماء المؤلفين)
1-ابن عربي، محيي الدين. الفتوحات المكية. بيروت: دار صادر، 1999. (المراجع 3، 13، 24)
2- أدونيس (علي أحمد سعيد إسبر). الصوفية والسريالية. بيروت: دار العودة، 1992. (المراجع 9، 12، 19، 23)
٣ أدونيس. زمن الشعر. بيروت: دار العودة، د.ت. (المرجع 17)
٤ إيزر، وولفغانغ. فعل القراءة: نظرية جمالية التجاوب. ترجمة عبد الرحمن أيوب. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة «عالم المعرفة»، د.ت. (المرجع 26)
٥ باشلار، غاستون. جماليات المكان. ترجمة غالب هلسا. بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، 1984. (المراجع 8، 10، 11، 15، 20)
٦ الغذامي، عبد الله. الخطيئة والتكفير: من البنيوية إلى التشريحية. بيروت: المركز الثقافي العربي، 1985. (المراجع 7، 14، 21)
٧ فضل، صلاح. بلاغة الخطاب وعلم النص. القاهرة: دار الشروق، 1992. (المراجع 2، 5، 16، 18، 22)
٨ إسماعيل، عزّ الدين. الأسس الجمالية في النقد الأدبي. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1992. (المراجع 1، 4، 6، 27)
٩ ياوس، هانس روبرت. جماليات التلقي. ترجمة منذر عياشي. دمشق: وزارة الثقافة، د.ت. (المرجع 25)
١٠ حيّ ابن سكران/مجموعة شعرية صدرت عن دار الشؤون الثقافية في وزارة الثقافة- بغداد ط1 2025
#سعد_محمد_مهدي_غلام (هاشتاغ)



ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
الكاتب-ة لايسمح
بالتعليق على هذا
الموضوع
|
نسخة قابلة للطباعة
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

|
حفظ
 |
بحث |
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
| إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
(رَغبةٌ تُراوِغُ شكلَها)
-
(ماءُ الْآهِ)
-
(الجِهةُ البَاهِتةُ مِنَ الكَوْكب)
-
(في البدءِ كانتِ المدينةُ نارًا)
-
( الأَمَلُ: شَجرَةٌ )
-
(فِرَاقُ غَمَامَةِ الفَجْرِ)
-
(الجسد والمكان والزمن في رؤيا آلهة الطوفان: قراءة ثقافية تكا
...
-
(من الشكل إلى الدلالة: التأويل البصري والبنية التناصية في قص
...
-
( كَأَنَّنِي فِي مَجَازِ الكَوْنِ: أُغْنِيَةٌ)
-
(موجوعَةٌ قَدَمي، وكُلِّي أنا وَجَعُ)
-
(مِرْآةٌ فِي الرِّيحِ)
-
( غَيَّاب )
-
(نظرية القراءة وجمالية التلقي لقصيدة -أنثى الرمّان في رؤيا آ
...
-
(فقط شَهْوَة)
-
(حين تنقر الزنابق شبابيك الخريف يشتعل الرُّضاب حتى وإن كان ف
...
-
(أَحْلَامُ صَعْلُوكٍ)
-
(حُلْمُ النُّهوض)
-
4//الدِكّاكُ أَرائِكَ المَنامْ والسَّماءُ تَقطُرُ ياقوتا
-
3//الدِكّاكُ أَرائِكَ المَنامْ والسَّماءُ تَقطُرُ ياقوتا
-
(المدينة التي تأكل خيالها)
المزيد.....
-
عائشة بنور: النقد عاجز عن مواكبة طوفان الروايات
-
لماذا تتصدر الروايات القديمة قوائم القراءة من جديد؟
-
بعد استحواذ -نتفليكس- على -وارنر- … ما هو مستقبل السينما؟
-
من هي أم سيتي البريطانية التي وهبت حياتها لحبيبها الفرعون؟
-
المطرب الموصلي عامر يونس يفتح سيرته الفنية في حوار مع «المدى
...
-
انتخاب الفلسطينية نجوى نجار عضوا بالأكاديمية الأوروبية للسين
...
-
الإخوان المسلمون في سوريا.. الجذور الفكرية والخلافات العقائد
...
-
هل مات الخيال: كيف تحولت الرواية إلى سيرة ذاتية؟
-
فيلم -غرينلاند 2: الهجرة-.. السؤال المؤلم عن معنى الوطن
-
الزهرة رميج للجزيرة نت: العلم هو -كوة النور- التي تهزم الاست
...
المزيد.....
-
دراسة تفكيك العوالم الدرامية في ثلاثية نواف يونس
/ السيد حافظ
-
مراجعات (الحياة الساكنة المحتضرة في أعمال لورانس داريل: تساؤ
...
/ عبدالرؤوف بطيخ
-
ليلة الخميس. مسرحية. السيد حافظ
/ السيد حافظ
-
زعموا أن
/ كمال التاغوتي
-
خرائط العراقيين الغريبة
/ ملهم الملائكة
-
مقال (حياة غويا وعصره ) بقلم آلان وودز.مجلةدفاعاعن الماركسية
...
/ عبدالرؤوف بطيخ
-
يوميات رجل لا ينكسر رواية شعرية مكثفة. السيد حافظ- الجزء ال
...
/ السيد حافظ
-
ركن هادئ للبنفسج
/ د. خالد زغريت
-
حــوار السيد حافظ مع الذكاء الاصطناعي. الجزء الثاني
/ السيد حافظ
-
رواية "سفر الأمهات الثلاث"
/ رانية مرجية
المزيد.....
|
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

 |
بحث
|
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
|
إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة