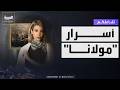|
|
المثقف والمسلّمات: حدود التفكير الحُر(21)
داود السلمان



الحوار المتمدن-العدد: 8431 - 2025 / 8 / 11 - 12:26
المحور:
قضايا ثقافية
المسلّمات ليست عدوة التفكير بالضرورة، لكنها تتحوّل إلى خطر حين تصبح جدارًا يحول دون السؤال. ولهذا، فإن دور المثقف لا يكون في تحطيمها دائمًا، بل في إخراجها من دائرة "اللامفكر فيه" إلى ساحة التأمل، والتاريخ، والنقاش. أن يُظهر أنها نتاج زمن، وظرف، وسياق، لا أنها مُنزّلة أو مطلقة. حينها فقط، يمكن للمجتمع أن يتعامل معها بشكل ناضج: إما أن يُعيد الاعتراف بها بوعي جديد، أو أن يتحرر منها بثقة لا بتخوين. لكن حدود التفكير الحر لا تُفرض فقط من الخارج، بل أحيانًا من الداخل. فكثير من المثقفين يحملون مسلّماتهم الخاصة، التي يرونها فوق النقد. قد تكون أيديولوجية، أو سياسية، أو حتى جمالية. وحين يرفض المثقف أن يُخضع قناعاته للمراجعة، يصبح هو نفسه جزءًا من المشكلة. إذ لا فرق بين من يُحصّن المسلّمات باسم الدين أو الوطن، وبين من يُحصّنها باسم العقل أو الحداثة. الحصانة، أيًّا كان نوعها، هي عدو التفكير.
مع ذلك، تبقى المسألة مرتبطة بالشجاعة، لا بالعداء. أن يكون المثقف شجاعًا بما يكفي لأن يقول: "لست متأكدًا"، أو "ربما هذا الذي نعتقده ليس كما نظن". هذه هي نقطة الانطلاق نحو وعي جديد. فالتفكير الحر لا يعني كسر كل القواعد، بل التفكير فيها من جديد، ومساءلتها، وفتح احتمال أن يكون ما نعتقده يقينًا، قابلًا للخطأ أو المراجعة.
ومع ذلك، المثقف، حين يفعل ذلك، لا يكون عدوًا لمجتمعه، بل صديقه الأصعب، الذي لا يجامل، ولا يهادن، لكنه أيضًا لا يحتقر، ولا يعادي. هو فقط يضيء طريقًا آخر، لمن أراد أن يسلكه.
ولعل أخطر ما تواجهه المسلّمات في علاقتها بالمثقف، ليس فقط العنف الظاهر أو المقاومة العلنية، بل التواطؤ الصامت. ذلك النوع من الرقابة الذاتية التي يمارسها المثقف على نفسه، دون أن تُفرض عليه من سلطة أو جمهور. حيث يتحول الخوف من رد الفعل، أو من النبذ، أو حتى من الفهم الخاطئ، إلى حاجز غير مرئي، يمنعه من الاقتراب من "المناطق المحظورة"، حتى وإن كان يراها جديرة بالتساؤل.
هنا يصبح المثقف شريكًا في ترسيخ المسلّمات، لا من خلال الدفاع عنها، بل من خلال تجاهلها أو السكوت عنها. وهذا النمط من الصمت، صمت الخوف أو المجاملة أو الحفاظ على المكانة، هو الذي يُفرّغ الثقافة من وظيفتها الأخلاقية. فحين تتحوّل الثقافة إلى ساحة لتزيين المعتقدات السائدة، بدلًا من تفكيكها وتحليلها، فإنها تصبح مجرد امتداد للسلطة، لا أداة لتحرير العقل.
لكن، هل يُطلب من المثقف أن يكون دائمًا في صدام؟ أن يتحوّل إلى متمرّد أبدي؟. بل ليس بالضرورة. الصراع من أجل التفكير الحر لا يعني الوقوف في مواجهة كل شيء دائمًا، بل الحفاظ على مسافة نقدية تتيح له فهم السياق، وتحديد اللحظة التي يصبح فيها الصمت خيانة، أو الكلام ضرورة. فالمثقف ليس خطيبًا ولا محاربًا، بل "نقّاد المعنى"، كما يقول بول ريكور. هو الذي يرى ما لا يُقال، ويقول ما لا يُرى، ويراهن على التنوير حتى وهو يعرف أنه بطيء ومؤلم.
وبحسب هذا السياق، فإن التفكير الحر، في جوهره، ليس انفلاتًا من كل قيد، بل مقاومة مستمرة لِما يُفرض كيقين. لا توجد حرية مطلقة في الفكر، لكن توجد دائمًا مسافة يمكن توسيعها، حدود يمكن دفعها إلى الوراء، ومناطق مسكوت عنها يمكن أن يُلقى عليها ضوء الأسئلة. وهذه مهمة لا ينجزها الفرد وحده، بل تحتاج إلى ثقافة عامة تحترم السؤال، وتؤمن بأن الشك ليس تهديدًا، بل شرطًا أساسيًا للنضج.
وببساطة، إن المجتمعات التي تُجرّم السؤال، أو تحاصر التفكير خارج المألوف، تُنتج مثقفين خائفين، مزيّفين، مُدلّجين، يقفون على المنصة ليعيدوا على الناس ما يعرفونه مسبقًا. أما المجتمعات التي تفسح للمثقّف حرية ارتكاب الخطأ، حرية قول غير المتوقع، حرية إعادة صياغة المُسلّم، فهي المجتمعات التي تصنع التقدّم الحقيقي.
وهكذا، فإن العلاقة بين المثقف والمسلّمات ليست معركة صفرية، بل هي اختبار دائم للوعي. اختبار يُبيّن إن كانت الثقافة وظيفة تزويقية، أم ممارسة للتحرر. والمثقف الحر ليس من يقاتل كل المسلّمات بلا تمييز، بل من يعرف متى يصمت ومتى ينطق، متى يعارض ومتى يعيد بناء الفكرة، متى يقف على حدود الحرية… ومتى يتجاوزها.
وأما القيمة الأخلاقية العميقة للمثقف فتكمن في هذا التوازن الدقيق: أن يكون شجاعًا دون أن يكون شعبويًا، نقديًا دون أن يكون عدميًا، حرًا دون أن يكون فوضويًا. أن يظل يقظًا، لا فقط للمسلمات الخارجية، بل للمسلمات التي تنمو داخل أفكاره هو نفسه، وهذا شرط مهم يجب تطبيقه.
وبطبيعة الحال، لن يكون المثقف قادرًا على نسف كل المسلّمات دفعة واحدة، ولا هو معنيّ بذلك أساسًا، لأن المسلّمات ليست مجرد أفكار عابرة، بل طبقات متراكمة من التجربة البشرية، من العادات، والمعتقدات، والسلطات الرمزية المتجذرة في اللاوعي الجمعي. لكن المثقف، في أدق أدواره، يُربك الثبات. يزعزع ما يبدو راسخًا، لا لهدمه بالضرورة، بل لتفكيكه، لإعادة النظر فيه، ولإزاحة الغبار ع عما اعتدنا تسليمه دون مساءلة. وهذا التفكيك لا يُقصد به إثارة الجدل أو إشعال المواجهة فقط، بل هو ممارسة ضرورية لإبقاء الوعي حيًا، والفكر متيقظًا. إذ كلما استسلمنا للمسلّمات بوصفها حقائق مطلقة، فقدنا القدرة على التعلم، على التغير، على تحسين شروط حياتنا وعلاقتنا بالعالم.
في المقابل، لا ينبغي أن يقع المثقف في فخّ "العدمية الثقافية"، أي أن يتحوّل إلى كائن ساخر من كل شيء، نابذٍ لكل قناعة، متعالٍ على كل وعي جمعي، فقط لأنه يريد أن يبدو مختلفًا أو متفوقًا. هذا النوع من السخرية الباردة لا يبني وعيًا، بل يُشيع الإحباط، ويُفرغ النقد من معناه. فليس المطلوب من المثقف أن يُبغض مجتمعه أو يحتقر ثقافته، بل أن يحبها بما يكفي ليقلق من ركودها، ويقلقها كي تتنفس.
والنتيجة، التفكير الحر ليس ترفًا، بل ضرورة وجودية. وهو لا يتحقق في فراغ، بل داخل مجتمع، داخل لغة، داخل تراث، داخل لحظة سياسية واجتماعية مركبة. لذلك، فإن مسؤولية المثقف لا تكمن فقط في امتلاك الحرية، بل في إعادة إنتاجها للآخرين: في كتاباته، في خطابه، في حضوره، في الطريقة التي يخلق بها مساحة للآخرين كي يسألوا، ويفكروا، ويشكّوا، دون أن يخافوا.
وبالتالي، حين يصل المثقف إلى تلك النقطة - أن يُحرّض على التفكير، لا أن يفرضه - يكون قد أدى مهمته الأخلاقية والإنسانية. لأن أعمق أشكال التأثير لا تأتي من الإجابة، بل من السؤال الذي لا يُنسى. والمجتمعات لا تنضج حين تملك كل الأجوبة، بل حين تجرؤ على طرح الأسئلة الصعبة، وتقبل العيش في ظل التوتر الذي يصنعه التفكير الحر.
ختامًا، فإن العلاقة بين المثقف والمسلّمات هي مرآة لدرجة وعي المجتمع نفسه. والمثقف الذي يكتفي بإعادة إنتاج ما يُنتظر منه، هو جزء من الأزمة لا من الحل. أما المثقف الذي يضيء المناطق المعتمة، ويجعل من التساؤل فعلًا يوميًا، فهو من يفتح الطريق، لا فقط للأفكار الجديدة، بل لأشكال جديدة من الحياة. لذلك، فإن حدود التفكير الحر ليست تلك التي تُرسم له من الخارج، بل تلك التي يرفض المثقف أن يتجاوزها من الداخل. وعندما يجرؤ على تجاوزها، بصدق ومسؤولية ووعي، يكون قد بدأ فعلًا في أداء الدور الذي لا يقدر عليه سواه.
في النهاية، ليس ثمة مثقفٌ حرٌّ تمامًا، ولا تفكيرٌ بلا قيود.
لكن المهم: أن لا تكون تلك القيود غير مرئية.
أن لا تُزرع فينا دون وعي.
وأن نظل نسأل: من قال إن هذا لا يُسأل عنه.
مصادر ومراجع هذا المقال المعتمدة:
1. محمد شحرور – الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة، دار النشر: الأهالي للطباعة والنشر – دمشق، سنة الطبع: 1990 (الطبعة الأولى)
2. محمد شحرور – الكتاب والقرآن: رؤية جديدة، دار النشر: دار الساقي – بيروت، سنة الطبع: 2011 (رؤية جديدة).
3. علي حرب – نقد النص، دار النشر: المركز الثقافي العربي
سنة الطبع: 1993.
4. علي حرب – نقد الحقيقة، دار النشر: المركز الثقافي العربي
سنة الطبع: 1993.
5. علي حرب – المصالح والمصائر: صناعة الحياة المشتركة، دار النشر: الدار العربية للعلوم ناشرون، سنة الطبع: 2010.
#داود_السلمان (هاشتاغ)



ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

|
حفظ
 |
بحث |
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
| إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
المثقف المقولب: نهاية الابتكار أم بدايته؟(20)
-
صناعة الاتجاهات: كيف توجه أفكار المثقفين(19)
-
المثقف في مواجهة القالب الاجتماعي(18
-
التفكير النمطي: خطر على أصالة المثقف(17)
-
ذاكرة بلا قيود… مَن قتل الإيرانيين؟
-
هل المثقف المقلوب ناقد ام منقذ؟(16)
-
قولبة الثقافة: تأثير على حرية المثقف(15)
-
المثقفون والامتثال: فقدان صوت المستقبل(14)
-
الأفكار الملقنة هل تصنع الابداع؟(13)
-
صراع المثقف مع القيود: بحثًا عن الهوية(12)
-
كيف تُصنع القوالب فكرا موحدا؟(11)
-
المثقف والتبعية الفكرية: خيانة الوعي وتمتثل الخطاب(10)
-
تماثل الأفكار: هل يفقد المثقفون صمتهم؟(9)
-
التفكير المقيّد: مأساة الفكر المقولب(8)
-
زمن بلا باب - سياحة في (باب الدروازة) للروائي علي لفتة سعيد
-
المثقف في دائرة الضغط: كيف تفرض الأفكار(7)
-
الهوية الممزقة في (رياح خائنة) للروائية فوز حمزة
-
قوالب الفكر: هل تختلف أصوات المثقفين(6)
-
المثقف المقولب: ضحية العصر أم صانع قيوده؟(5)
-
صناعة المثقف: عندما تتحدد الأفكار قبل أن تُقال(4)
المزيد.....
-
وداعًا لفوضى الأزياء القديمة.. تجربة تسوّق فخمة لقطع -الفينت
...
-
تحليل: الصين وفيديو روبوتات -الكونغ فو- بالتلفزيون الرسمي..
...
-
حريق هائل يمتد على مساحة 15 ألف فدان يعبر حدود أوكلاهوما إلى
...
-
مباشر: إيران تعتزم إجراء مناورة بحرية مع روسيا وترامب يلوح
...
-
سفير أمريكي سابق: ترمب يلعب خارج أرضه ويخسر أمام بوتين وشي
-
عاجل | هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: حالة تأهب على الحدود ا
...
-
عبلة كامل تنهي غياب سنوات بظهور استثنائي في أول أيام رمضان 2
...
-
كيم يتوعد خصومه: لا تطمعوا في حماية الرب عندما نستخدم هذا ال
...
-
-لن يتغير نظام إيران بمجرد تدخل جوي-.. شاهد ما قاله نائب أمر
...
-
عمرو سعد يعلن تخصيص 10 ملايين جنيه من صناع مسلسل -إفراج- للأ
...
المزيد.....
-
قواعد الأمة ووسائل الهمة
/ أحمد حيدر
-
علم العلم- الفصل الرابع نظرية المعرفة
/ منذر خدام
-
قصة الإنسان العراقي.. محاولة لفهم الشخصية العراقية في ضوء مف
...
/ محمد اسماعيل السراي
-
الثقافة العربية الصفراء
/ د. خالد زغريت
-
الأنساق الثقافية للأسطورة في القصة النسوية
/ د. خالد زغريت
-
الثقافة العربية الصفراء
/ د. خالد زغريت
-
الفاكهة الرجيمة في شعر أدونيس
/ د. خالد زغريت
-
المفاعلة الجزمية لتحرير العقل العربي المعاق / اسم المبادرتين
...
/ أمين أحمد ثابت
-
في مدى نظريات علم الجمال دراسات تطبيقية في الأدب العربي
/ د. خالد زغريت
-
الحفر على أمواج العاصي
/ د. خالد زغريت
المزيد.....
|
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

 |
بحث
|
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
|
إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة