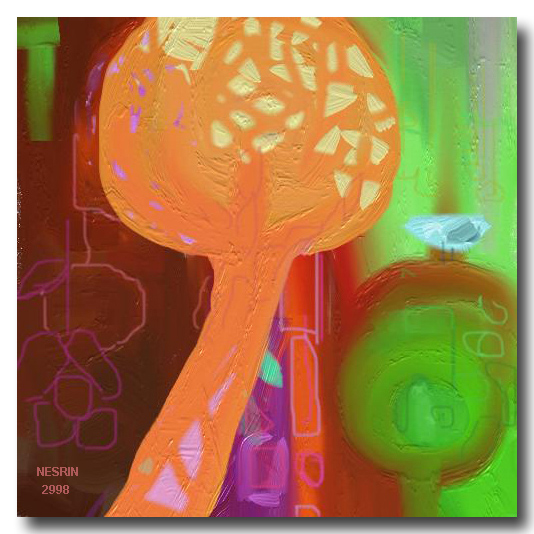محمد حجازي البرديني


الحوار المتمدن-العدد: 8498 - 2025 / 10 / 17 - 01:21
المحور:
الادب والفن
المقدمة.
تبحث هذا الدراسة في تمثيلات العبور؛ من هجرةٍ ولجوءٍ وسفر، في الرواية العربية المعاصرة، بوصفها مداخل لصوغ هويةٍ متحوّلة، تتجاوز حدود المكان والانتماء. تنطلق الدراسة من فرضية أنّ الهوية في الرواية الحديثة لم تعد جوهرًا ثابتًا بل صيرورة سردية تتشكّل عبر الانتقال بين الأمكنة والثقافات.
ولتحقيق ذلك، يوظّف الباحث مقاربات نقدية متعددة: النقد الثقافي، والسيميائيات، ونظرية ما بعد الاستعمار، والتحليل النفسي الأدبي، والنقد السردي البنيوي.
ويُطبَّق هذا المنهج التحليلي على عدد من الروايات العربية المعاصرة، أبرزها: موسم الهجرة إلى الشمال (الطيب صالح، 1966)، ساق البامبو (سعود السنعوسي، 2012)، باب الشمس (إلياس خوري، 1998)، فرانكشتاين في بغداد (أحمد سعداوي، 2013)، ورجال في الشمس (غسان كنفاني، 1963)، وذاكرة الجسد (أحلام مستغانمي1993).
الكلمات المفتاحية: الهوية العابرة، الرواية العربية، العبور، الهجرة، اللجوء، السفر، السرد، الاغتراب.
الفصل الأول: الإطار النظري والمفاهيمي.
1. مفهوم الهوية في النقد الثقافي.
تعتمد الدراسات الثقافية على تصورٍ دينامي للهوية؛ إذ يراها ستيوارت هول (Hall, 1996) بنيةً متحركةً تتشكّل في عملية مستمرة من إعادة التمثيل. فالهوية ليست حقيقة مطلقة بل "مشروع سردي" تُبنى معناه عبر الخطاب.
ويقول هول: «الهوية ليست من نحن، بل كيف نتحدث عن أنفسنا» (Hall, 1996, p. 4).
إنّ العبور في هذا السياق ليس انتقالًا جغرافيًا فقط، بل هو فعل سردي يُعيد ترتيب علاقة الذات بالآخر، والذاكرة بالزمن.
ومن هذا المنظور، يغدو المنفى – كما يصفه إدوارد سعيد (Said, 1993) – حالة وعيٍ مزدوجة يعيشها الفرد بين وطنٍ مفقود ووطنٍ مُتخيَّل. فالمنفي يعيش «في المسافة بين هنا وهناك» (Said, 1993, p. 173).
2. الهوية العابرة في النظرية ما بعد الكولونيالية.
يرى هومي بابا (Bhabha, 1994) أنّ الهجنة الثقافية تمثل «الفضاء الثالث» الذي تتولد فيه المعاني الجديدة عبر الصراع والتفاوض. فالشخصية المهاجرة في الرواية الحديثة تُجسّد هذا الفضاء الثالث، حيث تتقاطع الثقافات وتُعاد صياغة الذات.
ويقول بابا: «الهوية الحديثة لا تُكتشف، بل تُبتكر» (Bhabha, 1994, p. 112).
في حين يذهب بول ريكور (Ricoeur, 2000) إلى أنّ الذاكرة والهوية لا تنفصلان، إذ يتأسس السرد بوصفه وسيلةً لإعادة بناء الذات الممزقة.
3. من هوية الجذر إلى هوية العبور.
في السرد العربي التقليدي، ارتبطت الهوية بمفهوم الانتماء المكاني (الأرض، القبيلة، العائلة)، غير أنّ الرواية الحديثة تجاوزت هذا المفهوم. فقد أصبحت الهوية حركةً دائمة لا تعرف الاستقرار، كما يشير عبد الله إبراهيم (1995) في كتابه المكان في السرد العربي، مؤكدًا أن "المكان في الرواية العربية لم يعد إطارًا للحدث بل بنيةً لإنتاج المعنى" (ص. 214).
الفصل الثاني: الهجرة والاغتراب كفضاء سردي.
1. موسم الهجرة إلى الشمال (الطيب صالح).
تمثّل رواية الطيب صالح (1966) نقطة تحوّل في تمثيل الهوية المهاجرة. فشخصية مصطفى سعيد تمثل المثقف العربي العابر بين ثقافتين: عربية وغربية.
يقول مصطفى سعيد:
«جئتكم غازيًا، فهل صدقتم أني جئتكم مسالمًا؟» (صالح، 1966، ص. 74).
بهذا الخطاب، يعكس سعيد أزمة الهوية الكولونيالية كما وصفها فرانتز فانون في بشرة سوداء، أقنعة بيضاء، حيث يتحوّل الاستعمار إلى اغترابٍ داخلي (Fanon, 1952).
يستبطن النص صراعًا بين «الذات المستعمَرة» و«الذات المستعمِرة»، ليكشف عن التوتر بين التماهي والمقاومة.
يحلّل إدوارد سعيد (1993) هذه الظاهرة باعتبارها ردّ فعل ثقافيًّا على المركزية الأوروبية، حيث تصبح الكتابة نفسها شكلاً من المقاومة (p. 237).
2. ساق البامبو (سعود السنعوسي).
في رواية سعود السنعوسي (2012)، يتجسّد مفهوم الهوية العابرة في شخصية عيسى راشد الطاروف، الذي يقف بين ثقافتين: الكويتية والفلبينية.
يقول عيسى:
«في مانيلا كنت كويتيًا، وفي الكويت كنت فلبينيًا، لم أكن أنتمي لأيٍّ منهما» (السنعوسي، 2012، ص. 119).
إنّ هذا الوعي المنكسر يعبّر عن ما يسميه بابا (1994) بـ«الهوية الهجينة» (hybrid identity). فالذات لا تنتمي إلى مركزٍ محدد، بل تتحرك بين هوامش متعددة.
يصبح "العبور" هنا أداة سردية لإظهار التمييز الطبقي والعِرقي في المجتمع الخليجي، وكاشفًا عن أزمة الهوية ما بعد الكولونيالية.
3. باب الشمس (إلياس خوري).
رواية إلياس خوري (1998) توظّف اللجوء الفلسطيني كأقصى حالات العبور الوجودي. فالشخصيات تتحرك بين المنفى والمخيم والقرية، بحثًا عن "باب الشمس" بوصفه رمزًا للخلاص.
يقول الراوي:
«لا نكتب لكي نحفظ الذاكرة، بل لكي لا نموت منها» (خوري، 1998، ص. 45).
يتجلّى هنا مفهوم "الكتابة كنجاة"، إذ تصبح الرواية وسيلة لمقاومة محو الهوية. وفقًا لـ بول ريكور (2000)، فإن السرد يمكّن الإنسان من إعادة بناء ذاته عبر "الذاكرة المؤسطرة" (p. 189).
الفصل الثالث: السفر والمنفى كتمثيل للهوية.
1. رجال في الشمس (غسان كنفاني).
في رواية كنفاني (1963)، يتحوّل السفر إلى رمزٍ للعبور القسري.
عندما يصرخ الراوي في النهاية:
«لماذا لم تدقّوا جدران الخزان؟» (كنفاني، 1963، ص. 88)،
يتحوّل السؤال إلى احتجاجٍ على الصمت العربي أمام المنفى.
يحلّل سعيد (1993) هذه الرواية باعتبارها نقدًا للاغتراب الجمعي، حيث يُختزل الإنسان العربي في كائنٍ عالقٍ بين الرفض والخضوع (p. 243).
إنّ الرحلة نحو "الخلاص" تنتهي بالموت، في إشارة إلى فشل مشروع الهوية القومية في مواجهة النكبة.
2. فرانكشتاين في بغداد (أحمد سعداوي).
تُعيد رواية سعداوي (2013) إنتاج مفهوم الهوية من خلال العبور بين الحياة والموت. فالشخصية الرئيسية (الشمّاع) تصنع جسدًا من أشلاء ضحايا التفجيرات، ليصبح كائنًا هجينًا يُدعى «شسمه».
يقول السارد:
«لم أكن أعرف لمن أنتمي، لكلّهم أم لأحدهم فقط؟» (سعداوي، 2013، ص. 102).
إنّ هذا الجسد المكوّن من أجزاءٍ متناقضة يرمز إلى الهوية العراقية الممزقة بعد الاحتلال. وهو ما ينسجم مع مفهوم الهوية المركّبة عند كاثرين مالابو (Malabou, 2011) بوصفها "هوية تصنع ذاتها عبر الجرح والدمار".
3. ذاكرة الجسد (أحلام مستغانمي).
تقدّم مستغانمي (1993) نموذجًا مغايرًا للعبور: العبور الأنثوي الداخلي. فالسفر في هذه الرواية ليس جغرافيًا، بل عاطفيًّا ووجوديًّا.
تقول البطلة:
«أنا امرأة من هذا الجنوب الذي لا يكفّ عن السفر في نفسه» (مستغانمي، 1993، ص. 201).
يتحوّل السفر إلى رمزٍ لتحرّر الذات الأنثوية من قيود الذاكرة الذكورية، في محاكاةٍ لما تسميه جوليا كريستيفا (Kristeva, 1988) بـ«العبور الداخلي للذات الأنثوية» (p. 72).
الفصل الرابع: تحليل نقدي مقارن.
- في روايات صالح والسنعوسي، يُقدَّم العبور كصراعٍ بين ثقافتين: واحدة مركزية (غربية/أبوية)، وأخرى مهمّشة (عربية/أنثوية).
- في روايتي خوري وكنفاني، يتحوّل العبور إلى مأساة جماعية تمثل مأزق الأمة في مواجهة التهجير والاحتلال.
- في رواية سعداوي، يصبح العبور جرحًا وجوديًا، وفي مستغانمي يتحوّل إلى فعل تحرر رمزي.
- تتقاطع جميع هذه النصوص في تحويل العبور من تجربة مادية إلى بنية سردية تنتج المعنى والهوية.
الفصل الخامس: النتائج.
- إنّ الهوية في الرواية العربية المعاصرة هوية عابرة متحركة، لا تعرف الثبات، تتشكل في فضاءٍ من التعدد والاختلاف.
- العبور (الهجرة، اللجوء، السفر) يعمل كـ«محرك سردي» يعيد ترتيب العلاقة بين الذات والمكان.
- المنفى ليس نهاية الهوية بل بدايتها الجديدة، إذ تكتب الذات نفسها من خلال الفقد.
- تقنيات السرد الحديثة (تعدّد الأصوات، التقطيع الزمني، الميتاسرد) تسهم في بناء هويةٍ سردية مفتوحة.
- تعكس هذه الروايات تحوّل الأدب العربي من أدب الانتماء إلى أدب الترحال، ومن هوية الأرض إلى هوية اللغة.
الخاتمة.
لقد أظهرت هذه الدراسة أنّ الرواية العربية المعاصرة لم تعد تحكي عن الوطن، بل من المنفى. إنها تكتب من قلب الاغتراب، لتعيد بناء الذات المشتتة.
فالعبور، بما يحمله من دلالات الهجرة والسفر واللجوء، يتحوّل إلى لغة سردية تعيد كتابة الهوية، وتجعلها كيانًا دائم الحركة بين الذاكرة والمستقبل.
وبهذا تغدو الرواية العربية فضاءً جماليًا للإنسان العربي المتحوّل، الذي وجد في الكتابة وطنًا مؤقتًا، وفي السرد خريطة عبوره الأخيرة.
المصادر والمراجع (وفق نظام APA – ط7):
Bhabha, H. K. (1994). The Location of Culture. London: Routledge.
Fanon, F. (1952). Peau noire, masques blancs. Paris: Seuil.
Hall, S. (1996). Questions of Cultural Identity. London: Sage Publications.
Kristeva, J. (1988). Étrangers à nous-mêmes. Paris: Fayard.
Malabou, C. (2011). Changing Difference: The Feminine and the Question of Philosophy. Cambridge: Polity Press.
Ricoeur, P. (2000). La mémoire, l’histoire, l’oubli. Paris: Seuil.
Said, E. W. (1993). Culture and Imperialism. New York: Vintage Books.
إبراهيم، عبد الله. (1995). المكان في السرد العربي. بيروت: المركز الثقافي العربي.
السنعوسي، سعود. (2012). ساق البامبو. الكويت: الدار العربية للعلوم.
خوري، إلياس. (1998). باب الشمس. بيروت: دار الآداب.
خوري، إلياس. (2016). أولاد الغيتو – اسمي آدم. بيروت: دار الآداب.
سعداوي، أحمد. (2013). فرانكشتاين في بغداد. بيروت: دار الجمل.
صالح، الطيب. (1966). موسم الهجرة إلى الشمال. بيروت: دار العودة.
كنفاني، غسان. (1963). رجال في الشمس. بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية.
مستغانمي، أحلام. (1993). ذاكرة الجسد. بيروت: دار الآداب.
المصطلحات:
- مرحلة الكولونيالية (الاستعمار)؛ هي حقبة سيطرت فيها قوة أجنبية على بلد أو منطقة، غالباً لغرض الاستغلال الاقتصادي. تضمنت هذه المرحلة مراحل متتالية مثل الاستكشاف والمصادرة والاستيلاء والاستغلال والتبرير. أما ما بعد الكولونيالية فهي نظرية نقدية ظهرت بعد نهاية الاستعمار لتحليل آثار الخطاب الاستعماري وإعادة قراءة التاريخ من وجهة نظر الشعوب المستعمَرة.
- مرحلة ما بعد الكولونيالية.
هي نظرية نقدية تسعى لتحليل الخطاب الاستعماري من منظور الشعوب المستعمَرة وإعادة قراءة التاريخ من وجهة نظرهم.
ومن أبرز مفكري هذه النظرية إدوارد سعيد وهومي بهابها وغاياتري سبيفاك، كما أن أعمال فرانز فانون سبقت ظهور النظرية وشكلت أساسًا لها.
استكملت هذه الدراسة بتاريخ الأحد 7 / 9 / 2025 م.
962776537021
#محمد_حجازي_البرديني (هاشتاغ)



ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

 |
بحث
|
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
|
إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة