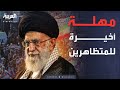|
|
كراسات شيوعية (المغرب العربي: الشعوب هى من تواجه الإمبريالية وقادتها) [ Manual no: 48]فرنسا.
عبدالرؤوف بطيخ


الحوار المتمدن-العدد: 8451 - 2025 / 8 / 31 - 21:13
المحور:
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
في 30 يوليو/تموز 2024، وبمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتوليه السلطة، تلقى ملك المغرب، محمد السادس، هدية من إيمانويل ماكرون:
"الاعتراف الرسمي بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية. هذه المستعمرة الإسبانية السابقة يطالب بها كل من المغرب والانفصاليين الصحراويين في جبهة البوليساريو، بدعم من الجزائر"وأنهت هذه الهدية حالة البرود التي سادت بين فرنسا والمغرب، منذ الفضيحة التي كشفت قيام المملكة بالتنصت، باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس" على العديد من الشخصيات، بما في ذلك رئيس الجمهورية الفرنسية.
في حين حسّن هذا الاعتراف العلاقات مع المغرب، إلا أنه أثار أيضًا أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين فرنسا والجزائر. في البلدان الثلاثة، استُغلت التوترات لصرف الانتباه عن السخط الاجتماعي وتعزيز الشعور الوطني.
اتهامات بالتجسس، وسجن الكاتب بوعلام صنصال، وقضية المؤثرين، وجريمة قتل مولوز، وطرد الجزائريين بموجب قانون مكافحة الإرهاب، والتهديدات بالتنديد باتفاقيات 4 ديسمبر 1968، واختطاف المؤثر أمير د.ز، وطرد الموظفين القنصليين، هذه الحلقات، التي تستحق سلسلة مكتب الأساطير، أثارت جدلاً تم استغلاله لقضايا السياسة الداخلية الفرنسية.أشعل وزير الداخلية برونو ريتيللو، الذي كان يخوض حملةً لقيادة حزب الجمهوريين، ومع طموحاتٍ رئاسيةٍ مُعلنة، فتيلَ الخلافاتِ سعيًا لإثباتِ وجوده داخل حزبه وفي مواجهةِ منافسيه من اليمين المتطرف. وتباهى بأن كلَّ جدلٍ كان في صالحه وزادَ شعبيته.وطالبت مارين لوبان، التي كانت حريصة على عدم تجاوزها على يمينها، بـ"تجميد التأشيرات والتحويلات المالية الخاصة" ووعدت، إذا وصلت إلى السلطة "بمعاملة الجزائر كما فعل ترامب مع كولومبيا".
في أوائل أبريل/نيسان، عندما تم إرسال جان نويل بارو إلى الجزائر لتخفيف الأزمة، تعرض لانتقادات شديدة من اليمين المتطرف، الذي اتهمه بـ"الخضوع للديكتاتورية الجزائرية"هذا التصعيد المُقزز جزء من الحملة المُعادية للهجرة التي تشنها هذه الحكومة، كما فعلت الحكومات السابقة. يا للأسف، إن كانت هذه الحسابات السياسية تتعارض مع مصالح أصحاب العمل الفرنسيين المقيمين في الجزائر، الذين أذهلتهم هذه الحملة الهستيرية. يا للأسف، جميع العمال الجزائريين، أو من أصل جزائري، العالقين بين قوتين، والذين سئموا من الوصم والتصوير على أنهم مُتميزون ومُقصرون.هذا الخلاف الدبلوماسي يهدف إلى صرف الانتباه عن السخط الاجتماعي، ولا يؤثر على العمال، سواءً في فرنسا أو الجزائر. على العمال الواعين أن يعارضوا هذه الحملة البغيضة! عمال من جميع الأصول، أصحاب عمل واحد، نضال واحد!تكشف هذه الأزمة عن مدى ثقل الماضي الاستعماري. فرغم أن شعوب المغرب العربي نالت استقلالها منذ أكثر من ستة عقود، إلا أن قبضة الإمبريالية، وبالأخص الإمبريالية الفرنسية، على هذه المنطقة لم تنتهِ قط. وسرعان ما خاب أمل الشعوب التي كانت تفخر بإسقاطها للقمع الاستعماري. فبينما كانت تأمل في حياة حرة كريمة، رأت قادتها، مضطهديها الجدد، يقفون أمامها. وبينما قدمت الدول الثلاث المستقلة حديثًا - المغرب وتونس عام ١٩٥٦، والجزائر عام ١٩٦٢ - وجوهًا مختلفة، استخدم كل نظام من الأنظمة الناتجة عن الاستقلال نفس الأساليب لقمع الاحتجاجات التي كان من المؤكد التعبير عنها. وفي نهاية المطاف، كانت كل دولة من هذه الدول الجديدة، بطريقتها الخاصة، المدافعة عن النظام البرجوازي والضامنة للنظام الإمبريالي.
• المغرب العربي
يضم المغرب خمس دول معترف بها هي: ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، ويجب أن نضيف إليها الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة، والتي لم يتم إنهاء الاستعمار فيها بعد في الواقع.
يعيش 110 ملايين نسمة في هذه المنطقة التي يحدها البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي والصحراء الكبرى الشاسعة. سنناقش بشكل رئيسي دول المغرب الأوسط الثلاث:
(تونس والجزائر والمغرب والصحراء الغربية) التي يرتبط مصيرها بسابقاتها، وتشترك شعوبها في تاريخ مشترك طويل. استعمرتها فرنسا وإسبانيا، وخاضت معارك ضارية لنيل الاستقلال، معارك أثرت على بعضها البعض دائمًا. اللغة العربية الرسمية هي لغتهم المشتركة، ويتشاركون لغة التواصل نفسها، العربية المغاربية الشعبية، بالإضافة إلى اللغة البربرية، التي تُعبّر عنها لهجات متعددة. يتشاركون الثقافة نفسها والتطلعات نفسها؛ كان ينبغي أن يكون لهم مصير مشترك، لكن هذا لم يكن الحال.في الواقع، عانى الشعبان المغربي والجزائري منذ الاستقلال من تنافسات بين قادتهما. وقد كانت هذه التنافسات متأصلة، حتى قبل الاستقلال، في خطط القادة الوطنيين، الذين كان كلٌّ منهم يسعى إلى بناء دولته الخاصة. وقد غذّت الإمبريالية الفرنسية، التي لم تكن ترغب في مواجهة كلٍّ موحدٍ وواسع، هذه التوترات شبه الدائمة بين أكبر دولتين في المغرب العربي، المغرب والجزائر.يكفي القول إن نضال شعوب المغرب العربي ضد الظلم هو تاريخنا، كعمال، على ضفتي المتوسط. أولًا، لأن الاستعمار الفرنسي ترك بصمةً لا تُمحى هناك، وثانيًا، لأن فرنسا لعبت دورًا محوريًا في تأسيس هذه الدول المستقلة، وأخيرًا، لأن جزءًا كبيرًا من الطبقة العاملة الفرنسية، التي يبلغ تعدادها نحو عشرة ملايين نسمة، بمن فيهم أحفاد المهاجرين، قد جاء من المغرب العربي على مدى أجيال.
• الجدل الدائر حول الماضي الاستعماري
في الأشهر الأخيرة، كان استعمار الجزائر محور جدلٍ واسع. على سبيل المثال، لتأكيده أن "فرنسا أنشأت مئات من أورادور-سور-غلان في الجزائر" عُلق عمل الصحفي جان ميشيل أباتي، رغم أنه ليس معروفًا بمواقفه الراديكالية، من محطة (RTL) ووُجهت إليه تهمة السخرية، وأُمر بالاعتذار. ووصف جوردان بارديلا تعليقاته بأنها "تزويرٌ بغيضٌ للتاريخ" لا يُستغرب هذا، كونه صادرًا عن اليمين المتطرف، إذ لطالما ضمّ بين صفوفه ورثة الجزائر الفرنسية، الذين لم يتقبلوا يومًا استقلال هذا البلد. هذه الكراهية، التي تركها جيل جان ماري لوبان المندثر، انتقلت إلى أحفادهم، واليوم يتعزز هؤلاء الرجعيون الحنونون بحشد اليمين المنبثق من الديغولية، التي عارضوها مع ذلك بشأن القضية الجزائرية. ها هم يُعيدون إحياء أسطورة فوائد الجزائر الفرنسية، مُثيرين الكراهية تجاه هذا البلد، الذي أصبح كبش فداء. لقد مهد ساركوزي الطريق. بقانونه لعام ٢٠٠٥، حاول فرض تعاليم الدور "الإيجابي" للاستعمار. لم يُقرّ قانونه، لكن خرافة "التوبة" المزعومة التي ستطالب بها الجزائر انتشرت. لا يُحصى عدد المرات التي أكد فيها: "ليس لدينا ما نخجل منه في تاريخ فرنسا" مهد الطريق لريتيليو، ودارمانين، وسيوتي، الرئيس السابق لحزب "الجمهورية إلى اليسار" الذي ساند لوبان، والذي وصف تصريحات أباتي بأنها "إهانة لفرنسا" و"عار".
لكن العار الحقيقي الوحيد هو إعدام 800 من سكان البليدة عام 1830، ومذبحة
قرويي زعاتشة، بعد عشرين عامًا، الذين عُرضت جماجمهم في متحف الإنسان بباريس! أما العار فهو حصار 500 فرد من قبيلة بني صبيح، حتى الموت، في كهف ضخم بعين مران، بين تلمسان ومستغانم. أما العار فهو عمليات التهريب، مثل تلك التي أدت عام 1845 إلى اختناق ألف فرد من قبيلة لجأوا إلى كهوف سلسلة جبال الظهرة.
• من الغزو الاستعماري إلى الاستقلال
الغزو الاستعماري
في وقت مبكر من عام ١٨٣٠، شهدت الجزائر وصول القوات الفرنسية والممولين والمستوطنين الذين قدموا لتكوين ثروات البلاد ونهبها. استغرق الجيش الفرنسي أربعين عامًا للتغلب على المقاومة الشرسة للسكان.
في عام ١٨٤٨، ضُم شمال الجزائر، حيث قُتِلَت النخب المحلية، وقُسِّم إلى ثلاث مقاطعات، وحُوِّل إلى مستعمرة استيطانية.
في عام ١٨٨١، استولت فرنسا على تونس، ثم استولت عليها عام ١٩١٢ كجزء من المغرب، بينما احتلت إسبانيا الجزء المتبقي. وبينما استخدمت فرنسا حصار الديون للسيطرة على اقتصادات هذه الدول، لجأت أيضًا إلى قوة السلاح. وطبقت كل ما اكتسبته من خبرة في الجزائر، في مجال القمع الاستعماري. وهكذا.........
في عام ١٩١٠، قمعت القوات الفرنسية انتفاضة شعبية في المغرب قمعًا وحشيًا. وبعد فتوحات قصيرة، وإن لم تكن أقل عنفًا، فرضت فرنسا حمايتها على تونس والمغرب، مدّعيةً أنهما غير قادرتين على حكم نفسيهما دون "مساعدة". واختارت إدارتهما بالاعتماد على السلطات المحلية، باي تونس وسلطان الرباط.
عشية الاستقلال، قُدِّمَ استمرار الهيمنة الاستعمارية للشعب الفرنسي باعتباره أمرًا جوهريًا لعظمة البلاد وأمرًا بديهيًا. بالنسبة لمليون أوروبي عاشوا في الجزائر لأجيال عديدة، كانت الجزائر "فرنسا"، وبدا هذا أمرًا لا رجعة فيه.
• صعود الحركات القومية
بالتأكيد،واجهت فرنسا في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي ثورات في المغرب
العربي هزت الإمبراطورية الاستعمارية، لكنها نجحت في كل مرة في استعادة النظام. وهكذا، في عام ١٩٢٥، في جبال الريف شمال المغرب، استخدمت فرنسا كامل قوتها العسكرية لسحق الانتفاضة الشعبية التي قادها عبد الكريم الخطابي، الذي لم يُلحق هزيمة نكراء بالجيوش الإسبانية فحسب، بل نجح أيضًا في إنشاء جمهورية ريفية يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة وهددت بالانتشار إلى بقية المغرب العربي. في الوقت نفسه، كانت السلطات في فرنسا تراقب عن كثب الحزب الشيوعي الناشئ الذي ولدته الثورة الروسية. حمل الحزب راية الأممية عاليًا وفخرًا، داعيًا الجنود الفرنسيين إلى التآخي مع جنود الريف. في عام ١٩٢٥، استجاب ٩٠٠ ألف عامل فرنسي لدعوته للإضراب ضد هذه الحرب الاستعمارية القذرة التي قادها بيتان.
في كل مكان، عزز القمع واحتقار المستوطنين الشعور بالقمع الوطني. من الرباط إلى تونس، نهضت أجيال جديدة من النشطاء ونظمت صفوفها. منذ عام ١٩٢٤ في باريس، سعى الاتحاد الدولي للمستعمرات، الذي أنشأه الحزب الشيوعي، إلى مخاطبة جميع المظلومين من الاستعمار. اجتمع العمال الجزائريون في حركة "نجمة شمال أفريقيا" للمطالبة بالاستقلال، ولا بد من التأكيد على وحدة دول المغرب العربي الثلاثة. ورغم اعتقالات الشرطة المتكررة لزعيمها" مصالي الحاج" اكتسبت حركة "نجمة شمال أفريقيا" نفوذًا في فرنسا والجزائر.
في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين في المغرب، كان الشباب المغاربة، من الطبقات الثرية التقليدية، هم الذين أخذوا زمام المبادرة، بينما في تونس أسس محام شاب يدعى بورقيبة حزب الدستور الجديد.
ولكن في ثلاثينيات القرن العشرين، عندما اهتز العالم بأزمة غير مسبوقة، جاءت الاحتجاجات الأكثر تصميماً من الطبقة العاملة، والتي بلغت ذروتها في الإضراب العام في مايو/أيار ويونيو/حزيران 1936.
انطلقت من فرنسا، ثم اجتاحت المغرب العربي. بدا أن وصول حكومة الجبهة الشعبية إلى السلطة عام ١٩٣٦ قد مهد الطريق للاستقلال. في تونس، أتاح تصميم ووحدة العمال الفرنسيين والتونسيين تطبيق اتفاقيات ماتينيون على العمال التونسيين. أكد هذا الاتحاد أن الطبقة العاملة، بتجاوزها الانقسامات التي خلقتها الدولة الاستعمارية، يمكن أن تكون قوة قادرة على قيادة ثورة جميع المضطهدين بنفسها. خاصة وأن الرد الوحيد لليسار الحاكم في المغرب والجزائر
كان القمع.فسادت خيبة الأمل والغضب بين العمال، الذين لجأوا بعد ذلك إلى المنظمات القومية. وكرمز، تخلى مصالي الحاج عن الراية الحمراء ليُنشئ علمًا جزائريًا. ولإنقاذ النظام الاجتماعي والاستعماري، اعتمدت البرجوازية الفرنسية على ليون بلوم، وكذلك على الحزب الشيوعي، الذي تخلى نهائيًا عن سياساته الأممية المبكرة.
• لقد تم إنقاذ النظام الاستعماري، لكن وقته كان ينفد.
بعد الحرب العالمية الثانية
قوّضت الحرب العالمية الثانية أسس الإمبراطورية الاستعمارية بشكل حاسم. تشبّثت فرنسا، بقيادة الجنرال ديغول، بها أكثر فأكثر بعد أن خرجت منهكة من هذا الصراع العالمي، الذي كان فيه الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة المنتصرين الأكبر. لم يستطع ديغول منع الثورة المتصاعدة، التي أجّجها الفقر المدقع وتصاعد المطالب القومية. شكّل إنزال الحلفاء في نوفمبر 1942، واللقاء بين الرئيس الأمريكي روزفلت وسلطان المغرب في الدار البيضاء، حافزًا للناشطين المغاربة في تأسيس حزب جديد، حزب الاستقلال.
انطلقت شرارة الثورة في الجزائر، في قسنطينة، في 8 مايو/أيار 1945، أي قبل 80 عامًا بالضبط. في المسيرات التي نُظمت احتفالًا بالتحرير، هتف النشطاء الجزائريون "يسقط الاستعمار" وهاجمت الشرطة المتظاهرين الذين كانوا يلوّحون بالعلم الجزائري الجديد. في سطيف، تحوّل المسير إلى مواجهة امتدت في اليوم التالي، مما أثار بدوره قمعًا عنيفًا خلّف، وفقًا للتقديرات، ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل. وقد منحت هذه المجزرة، التي نُفّذت بتواطؤ من الوزراء الشيوعيين، استراحةً لأنصار الجزائر الفرنسية.
كانت سنوات ما بعد الحرب، والتي جاءت إضافة إلى سنوات الحرب العالمية الثانية، سنوات رهيبة، حيث تم توجيه جميع موارد المستعمرات في المقام الأول نحو فرنسا، وخاصة القمح والشعير، مما ترك السكان في حالة من المجاعة.
• صعود العمال في تونس والمغرب
وفي المغرب وتونس، شهدت سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية ارتفاعاً في
الإضرابات العمالية، على الرغم من معارضة الحزب الشيوعي الفرنسي، الذي كان يخوض في فرنسا "معركة الإنتاج" بجلود العمال.
في المغرب، توافد العمال المناضلون على حزب الاستقلال، حزب الاستقلال الجديد، بقيادة علال الفاسي آنذاك، والذي أنشأ نقابات سرية مناضلة. وعززت إضرابات عام ١٩٥١ المنتصرة هذا التوجه. وسعى السلطان إلى استعادة هذا النجاح عام ١٩٥٢ بالمطالبة، أمام حشد غفير، بـ"التحرر السياسي الكامل للمغرب".
في تونس، كان الزعيم النقابي فرحات حشاد قد غادر بالفعل الاتحاد العام للعمال في تونس ليؤسس الاتحاد العام للعمال التونسيين في عام 1946. وبالانسجام مع الاتحاد العام للعمال في فرنسا، المتحالف مع الحكومة الفرنسية، قدم الاتحاد العام للعمال في تونس الإضراب باعتباره "سلاح الاحتكارات" وحث العمال التونسيين على إعادة بناء البلد الذي اضطهدهم بأي ثمن.
شهد الاتحاد العام التونسي للشغل، بقيادة فرحات حشاد، صعودًا صاروخيًا:
"فبعد عامين من تأسيسه، بلغ عدد أعضائه 100 ألف عضو. كان "فرحات حشاد" قد عارض الاتحاد العام للشغل (CGT) بقيادة فراشون، الذي وضع قوة العمال في خدمة البرجوازية الفرنسية، لكن بدعمه حزب الدستور الجديد، وهو حزب وطني برجوازي، وضع الاتحاد العام التونسي للشغل هذه القوة في خدمة البرجوازية التونسية.كان بورقيبة يأمل في الحصول على استقلال تونس عبر تسوية مع السلطات الفرنسية، التي رفضت ذلك. اشتد القمع. اعتُقل بورقيبة ونُفي، وأصبح "فرحات حشاد" الذي تُرك حرًا، هدفًا لليمين المتطرف الفرنسي، الذي اغتاله عام ١٩٥٢. في الأيام التي تلت هذه الجريمة، انتشرت المظاهرات، وقمعها الجيش الفرنسي بوحشية بالغة.وقد أدى اغتيال الزعيم النقابي التونسي إلى اندلاع مظاهرات وإضرابات في المغرب، والتي اتخذت طابعاً متفجراً في عام 1953، عندما عزلت السلطات الفرنسية السلطان "بن يوسف" ونفتْه إلى مدغشقر.
في الجزائر، كان من المفترض أن يمنح قانون جديد، اعتُمد عام ١٩٤٧، حق الاقتراع العام للجزائريين، ولكنه كان عامًا اسميًا فقط. لم يقتصر الأمر على استبعاد النساء، بل أنشأ هيئتين انتخابيتين، مما أدى إلى أن صوت فرنسي واحد يساوي صوت تسعة جزائريين. شجعت هزيمة الجيش الفرنسي في الهند الصينية جيلًا جديدًا من النشطاء على الانخراط في الكفاح المسلح. وُلدت جبهة التحرير الوطني، التي انبثقت من صفوف حزب مصالي الحاج، لكنها انفصلت عن الزعيم القديم، في ٢٣ أكتوبر ١٩٥٤. وفي الأول من نوفمبر، أعطى قادتها إشارة التمرد بسلسلة من الهجمات في جميع أنحاء الجزائر.
خشي القادة الفرنسيون من تلاقي نضالات شعوب الدول المغاربية الثلاث. كما خشيوا من أن تتجه الثورات في تونس والمغرب نحو التطرف وتفلت من سيطرة القوى الوطنية الأكثر اعتدالاً. وقد أكدت المؤشرات هذا الخوف. وبالفعل، بدأ صراع مسلح بالظهور في المغرب وتونس.
أدركت الحكومة الفرنسية عجزها عن التعامل مع انفجار كان سيمتد إلى أرجاء المغرب العربي، فسارعت إلى إيجاد حل لإخماد الحريق. وكان بورقيبة في تونس والسلطان في المغرب محاورَين مسؤولَين تستطيع التفاوض معهما. أُخرجا من منفاهما، وعند عودتهما إلى بلادهما، استقبلتهما حشودٌ غفيرةٌ من الفرح.
في المغرب، في 2 مارس/آذار 1956، استبدل السلطان المستعاد لقبه بلقب ملك المغرب، تحت اسم محمد الخامس. وبعد أيام قليلة من 20 مارس/آذار 1956، تولى الحبيب بورقيبة، زعيم الحزب الدستوري الجديد، رئاسة حكومة انتقالية في تونس.مع استقلال (تونس والمغرب) أصبح للجيش الفرنسي حرية التصرف في محاولة استعادة النظام الاستعماري في الجزائر. عززت فظائعه صفوف جبهة التحرير الوطني، التي فرضت نفسها قائدةً للنضال، ليس فقط على شعبها، بل أيضًا ضد التنظيمات المنافسة، التي أُمرت بالتجمع، تحت طائلة القتال وإعدام أنصارها. أما هيئة الأركان الفرنسية، التي سعت للانتقام لهزيمتها في ديان بيان فو في الهند الصينية، فرغم حشد جيشها وقوتها النارية وأكثر من مليوني مجند شاب، نال الشعب الجزائري استقلاله في 5 يوليو/تموز 1962، بعد ثماني سنوات من حربٍ ضارية.
• لقد فتحت ثورة الشعوب المغاربية إمكانيات... ضاعت سدى
لقد كلّف طرد القوة الاستعمارية الشعب الجزائري ثمنًا باهظًا: ما لا يقل عن 500 ألف قتيل ومليونين مشردين إلى المخيمات. وازدادت أهمية هذه التضحيات غير المسبوقة لأنهم وجدوا أنفسهم معزولين في خضم النضال. لم تكن هذه العزلة حتمية؛ بل كانت نتيجة سياسات القادة الوطنيين والخيانة المخزية للمنظمات العمالية في فرنسا، التي أثبتت تواطؤها في مذبحة الجزائريين. أولًا، قاد الحزب الاشتراكي الحكومات التي شنت هذه الحرب القذرة. أما الحزب الشيوعي الفرنسي، فقد بالكاد تميز عن الحزب الاشتراكي. فقد صوّت لصالح "كامل السلطات المدنية والعسكرية" في الجزائر، مما سمح بإرسال الوحدة.
بينما كان الحزب الشيوعي الفرنسي يدعو إلى السلام في الجزائر، ترك الجنود المستدعين لمصيرهم، والذين رفضوا عام ١٩٥٦ ركوب القطارات التي كانت تقلهم إلى الحرب. وقد زادت هذه السياسة من تشويه سمعة الحزب الشيوعي الجزائري، المرتبط به، وعززت موقف القوميين في جبهة التحرير الوطني.
في فرنسا، لم يحتجّ الحزب الشيوعي الفرنسي (PCF) أيضًا على فرض حظر تجول على عشرات الآلاف من الجزائريين في فرنسا القارية. ومع ذلك، كانت الغالبية العظمى منهم عمالًا مُستغَلّين، إلى جانب العمال الفرنسيين، في نفس المصانع والمناجم ومواقع البناء والمزارع. لم يكن لدى جبهة التحرير الوطني، ولا الحزب الشيوعي الفرنسي، ولا أي حزب رئيسي، سياسة تضمن نضال هذين الفئتين من الطبقة العاملة معًا من أجل أهداف مشتركة، سواء في فرنسا أو على الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط. هذا الاصطفاف على كلا الجانبين، كلٌّ خلف برجوازيته، لم ينتهِ من عواقبه. ما زلنا ندفع ثمنه بعد ستين عامًا!نتجت عزلة الشعب الجزائري أيضًا عن ضيق خيارات القادة الوطنيين في الدول المغاربية الثلاث لبناء دولتهم الخاصة. فرضوا هذا الخيار على شعوبهم، التي عانت من نفس الاضطهاد الاستعماري، ونفس الحرمان، وتشاركت نفس التطلعات إلى حياة كريمة وحرة. بدفعة واحدة، رفعت الطبقات المظلومة في المغرب رؤوسها، مُدركةً انتمائها إلى الكل الواحد. فتح شعور التضامن والروابط المتعددة التي جمعت بينهم آفاقًا ثورية واسعة. لم يسعَ القادة الوطنيون قط إلى الاعتماد على هذه المشاعر، مع أنه كان من الممكن بتوحيد الطبقات الشعبية في الدول الثلاث تحقيق الاستقلال في ظروف أكثر ملاءمة.
ومع ذلك، كانت هذه هي الفكرة التي دافع عنها في عصره عبد الكريم، بطل ثورة الريف، حين أعلن: "لو وُجدت في الجزائر وتونس، وفي الوقت نفسه في الريف، مقاومة متكافئة، لكُتب التاريخ على نحو مختلف". تنظّم عمال المستعمرات الثلاث ضمن حركة نجم شمال إفريقيا التي أسسها مصالي الحاج، والتي كانت قد وضعت، في بداياتها، تحرير جميع شعوب المغرب العربي هدفًا مشتركًا. وعندما نجح عبد الكريم، الذي فر من منفاه ولجأ إلى القاهرة، في جمع القوميين الجزائريين والمغاربة والتونسيين في المؤتمر الأول للمغرب العربي عام ١٩٤٧، ظلّ يدافع عن فكرة المغرب العربي الموحد والمستقل.
لكن في خمسينيات القرن الماضي، أدار القادة القوميون في الدول الثلاث ظهورهم للمنظور الذي طرحه عبد الكريم. ومع ذلك، لم يكن هناك أي شيء تلقائي في رحيل فرنسا الذي أدى إلى ظهور ثلاث دول متعارضة ومتنافسة!ومع ذلك، في زمن الاستقلال، جسّدت هذه الدول الجديدة في نظر شعوبها نهاية الاحتقار واستعادة الكرامة. بل كان بإمكان الشعوب أن تشعر بالسعادة والفخر لإنهاء الإذلال الاستعماري. ولكن، بينما كانت تطمح بكل إخلاص إلى انتشال بلدانها من التخلف، سرعان ما تبددت آمالها وخيبة أملها.اعتمدت هذه الأنظمة أيديولوجيات مختلفة، لكنها سرعان ما اتخذت طابعًا استبداديًا واحدًا في كل مكان. أما خطابات القادة الوطنيين حول وحدة المغرب، فسرعان ما سيكتشف الناس أنها لم تكن سوى ديماغوجية محض.
كان بن بلة، أول رئيس للجمهورية الجزائرية، قد أعلن بالفعل:
"إن إعادة التضامن مع إخواننا في شمال إفريقيا أمرٌ ضروريٌّ للغاية!". لكن كلاً منهما أراد جهازه الحكومي الخاص، للدفاع عن مصالح برجوازيته ضد جيرانه وشعبه. أراد كلٌّ منهما السيطرة على أراضيه، خلف حدوده، ليحصل على أفضل ما تبقى من فتات الإمبريالية. مع أن التعاون الاقتصادي، بل وحتى وحدة الدول الثلاث، كان سيمنحها وسائل أكبر بكثير لمقاومة الضغوط الإمبريالية، ولا سيما ضغوط القوة الاستعمارية السابقة.وفي أعقاب استقلال الجزائر، أدت هذه التنافسات إلى صراعات أخوية حول ترسيم الحدود.
طالبت الملكية المغربية، باسم "المغرب التاريخي" ما قبل الاستعمار، بأراضٍ تمتد حتى الحدود مع مالي والسنغال، بما في ذلك الصحراء الإسبانية وموريتانيا وجزء من الصحراء الجزائرية. ورفضت جبهة التحرير الوطني، باسم حرمة الحدود الناجمة عن الاستعمار، المطالب المغربية. واعتبرت أن الشعب الجزائري دفع ثمن هذه الأراضي بدمائه. في خريف عام ١٩٦٣، أي بعد عام من استقلال الجزائر، تبددت أحلام الوحدة المغاربية نهائيًا عندما اندلعت معركة عنيفة بين الجيشين المغربي والجزائري للسيطرة على مدينتي تينجوب وحاسي البيضاء، في ثنايا الصحراء. ويُقال إن "حرب الرمال" هذه قد خلّفت أكثر من ألف قتيل. وبعد ثلاث سنوات، طالب بورقيبة التونسي بدوره بمنطقة حدودية تُعرف بـ"العلامة ٢٣٣" لكنه نبذ التصعيد مع جاره الجزائري.لقد عكست هذه الصراعات الحدودية، في المناطق الصحراوية الغنية بالمعادن والهيدروكربونات، الحاجة الملحة إلى الطبقات الحاكمة الجديدة في هذه الدول للاستيلاء على الموارد التي يمكن أن تساعد في تطوير اقتصادها الوطني الناشئ في عالم تهيمن عليه الإمبريالية.
لقد شوّه الاستعمار اقتصادات هذه الدول، الزراعية في المقام الأول، لخدمة احتياجات فرنسا. في هذه الدول الثلاث، أبدى القادة رغبةً في تنمية بلدانهم. ولإطعام سكانها المتزايدين، قُدّمت الإصلاحات الزراعية كحلٍّ، لكنها لم تُفلح في الوفاء بوعودها.لم يستطع الاستقلال السياسي، في حد ذاته، الفرار من براثن الإمبريالية. سمح استغلال الفلاحين والعمال بظهور برجوازية وطنية وبرجوازية صغيرة، وللشركات متعددة الجنسيات بجني أرباحها. بنى الحكام الجدد أجهزة قمعية هائلة، مهمتها الأساسية سحق الثورات التي اندلعت مرارًا وتكرارًا.
• من الاستقلال إلى التسعينيات: التنمية الوطنية مستحيلة! إنشاء ولايات جديدة
في الجزائر
في الجزائر، ادّعى النظام، بتبنيه اسم الجمهورية الديمقراطية الشعبية، الاستجابة للمطالب الشعبية. في عام ١٩٦٠، صاغ أحد قادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين (UGTA)، التابع لحزب جبهة التحرير الوطني، هذه التطلعات على النحو التالي:
"لا يكافح العمال الجزائريون من أجل العلم والسفارات فحسب، بل يكافحون من أجل ضمان الأرض للفلاحين، والعمل وظروف معيشية أفضل للعمال".
حمل القادة الوطنيون لجبهة التحرير الوطني آمال شعب بأكمله في الخلاص من الفقر. ولكن مع الاستقلال، شهد الشعب، الذي لم يكن له رأي قط، صراعًا على السلطة بين قادة جبهة التحرير الوطني. بدعم من الجيش، أسس أحمد بن بلة نظام الحزب الواحد، وقضى على منافسيه، قبل أن يُطاح به انقلاب بومدين العسكري عام ١٩٦٥. كانت البرجوازية الجزائرية أضعف من أن تتمكن من حكم البلاد دون دعم الجيش. وهكذا أصبح هذا الأخير العمود الفقري للنظام. قام الأمن العسكري القوي، الذي بُني خلال حرب الاستقلال، بتطهير جميع قنوات التعبير عن الاحتجاج، مثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
رسّخت اتفاقيات إيفيان، الموقّعة بين فرنسا والجزائر عام ١٩٦٢، توازن القوى ونظّمت العلاقات بين البلدين. وسمحت لفرنسا بالاحتفاظ بقواعد عسكرية، بما في ذلك منشآت للتجارب النووية، في الصحراء. ونجحت البرجوازية الفرنسية في فرض سيطرتها على الهيدروكربونات والموارد المعدنية. وبين عامي ١٩٦٦ و١٩٧٠، كان ٧٥٪ من إنتاج شركة النفط الفرنسية "إلف" يأتي من الصحراء.
منذ البداية، اضطرت الدولة الجزائرية إلى خوض صراع لضمان حد أدنى من السيطرة على اقتصادها. بين عامي 1963 و1968، أممت مليون هكتار من أراضي المستوطنين وشركات التعدين وسبعة وستين مصنعًا فرنسيًا خاصًا. في 20 يوليو 1970، حاولت الدولة الجزائرية إجبار الشركات الفرنسية على زيادة سعر برميل النفط من دولارين إلى 2.80 دولار. رفضت فرنسا رفع الأسعار أو دفع 25 مليار فرنك كضرائب مستحقة عليها للحكومة الجزائرية. رد بومدين بتأميم النفط والغاز والسيطرة على 51٪ من أصول شركات النفط الفرنسية. أسس سوناطراك، الشركة الوطنية المسؤولة عن استغلال النفط والغاز، وأطلق خطة لتصنيع البلاد. ردت الدولة الفرنسية بفرض حظر على صادرات النفط.
رغم انعدام الحرية، اعتبر السكان هذه الإجراءات انتقامًا للتنازلات التي فرضتها الإمبريالية الفرنسية خلال اتفاقيات إيفيان. هذه الإجراءات، التي لم تكن تحمل أي طابع اشتراكي، كانت رد فعل الدولة البرجوازية في بلد فقير، في محاولة لحماية نفسها، إلى حد ما، من الضغوط الإمبريالية.
تسببت أزمة النفط عام ١٩٧٣ في ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز، وجلبت العملة الأجنبية إلى الجزائر. حسّنت هذه الثروات الطائلة إلى حد ما الحياة اليومية للطبقات العاملة، إلا أن معظمها استُخدم في بناء المجمعات الصناعية والصلب والبتروكيماوية. وُصفت هذه المشاريع بأنها "اشتراكية"، لكنها فاقمت اعتماد البلاد الاقتصادي على الإمبريالية.لتصنيع وتشغيل المصانع القائمة، ولاستيراد الآلات وقطع الغيار باهظة الثمن، اضطرت الجزائر إلى الاقتراض من البنوك الفرنسية. علاوة على ذلك، كانت الأموال المخصصة للتصنيع محدودة لتطوير الزراعة، مما أجبر المزارعين على الهجرة.الجزائر، التي كانت تنتج 70% من احتياجاتها الغذائية عام 1969، لم تنتج سوى 31% بعد عشر سنوات. واضطرت إلى الاستدانة لاستيراد أطنان من الحبوب ومنتجات الألبان من أوروبا.
عندما توفي بومدين في 27 ديسمبر/كانون الأول 1979، تدفقت حشود بشرية هائلة إلى الجزائر تخليدًا لذكرى الرجل الذي جسد نهاية الإذلال الاستعماري. كان العقيد بومدين يحكم البلاد بقبضة من حديد، لكن التقدم في قطاعي الصحة والتعليم منحه قاعدة شعبية.من خلال منح اللجوء والمساعدة لمعارضين من جميع أنحاء العالم، من نشطاء المؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب إفريقيا إلى الفهود السود وفلسطينيي منظمة التحرير الفلسطينية، عزز بومدين الموقف الدبلوماسي للدولة الجزائرية. رسّخ صورة نظام ثوري، لكنه في الواقع لم يتسامح مع أي معارضة في بلاده، وفضّل أيضًا ممارسة الشعائر الدينية. كان الإسلام دين الدولة، ويحكم حياة الجزائريين. كان تعزيز دوره سياسة مدروسة من جانبه، بل كان نقطة مشتركة بين الأنظمة الثلاثة. بالنسبة لمحمد الخامس، الذي كان يتمتع بمكانة أمير المؤمنين، كان هذا واضحًا، لكن بورقيبة فعل الشيء نفسه.
• في المغرب
في المغرب، سعى الملك الجديد محمد الخامس إلى ترسيخ سلطته منذ الاستقلال، بمساعدة فرنسا والفصيل الأكثر محافظة في حزب الاستقلال القومي. كان المغرب مستقلاً، لكن اقتصاده ظل زراعياً وتأثر بالاستعمار. كانت تطلعات ملايين الفلاحين الفقراء في الريف، والطبقات العاملة في المدن، والبرجوازية الصغيرة المثقفة والتجارية، وكبار أصحاب الأعمال وملاك الأراضي، متعارضة.استغل محمد الخامس هذه الانقسامات بمهارة. كان مدينًا بمفاتيح مملكته للدولة الفرنسية، لكنه تظاهر بأنه "شهيد الاستقلال".
منحه حزب الاستقلال هذه المكانة لمعارضته الحكم الفرنسي ونفيه لمدة ثلاث سنوات. منحه لقب أمير المؤمنين شرعية بين الشعب، وكونه وريثًا للسلالة المغربية العريقة قبل الاستعمار منحه ثقة الطبقات الثرية.
تناوب محمد الخامس بين المناورات السياسية واستخدام القوة لبناء دولةٍ يُمكنه أن يُسميها ملكًا له. وجلب حزب الاستقلال إلى السلطة، مما أدى إلى تفكك هذا الحزب الذي جمع قوىً ذات مصالح متضاربة.
في الصحراء الإسبانية، سمح محمد الخامس للقوات الفرنسية والإسبانية بسحق مقاتلي جيش التحرير المغربي، الذين كانوا يدعمون القوات الصحراوية في نضالها من أجل الاستقلال. في الريف، هاجمت ثورة شعبية، رفضت إلقاء السلاح حتى نيل الجزائر استقلالها، الجنود الفرنسيين. في أواخر عام ١٩٥٨، أي بعد عامين من الاستقلال، أُرسل ولي العهد، الحسن الثاني لاحقًا، بدعم من القائد أوفقير، على رأس عشرين ألف رجل لقمع هذه الثورة. قصف قرى الريف، مما أسفر عن مقتل وجرح عدة آلاف.
في عام ١٩٦١، وقبل وفاته المفاجئة، نجح محمد الخامس في تهميش حزب الاستقلال والأحزاب المنبثقة عنه، وبنى جيشًا وجهازًا قمعيًا بين يديه، متمتعًا بدعم شعبي. وخلفه ابنه الحسن الثاني. وعلى رأس الجهاز القمعي، اكتسب ثقة البرجوازية الفرنسية، التي رأت فيه حليفًا قويًا، ضامنًا لمصالحها حتى ضد شعبه. وهكذا بدأت الصداقة الفرنسية المغربية الأسطورية، وأصبح الحسن الثاني "صديقنا الملك"أعلن دستور عام ١٩٦٢ أن الملك "شخصٌ مقدسٌ لا تُمسّ حرمته"، وأن النظام ملكيٌّ بحقٍّ إلهي. كان الملك أكبرَ مُلاك الأراضي وأغنى رجلٍ في البلاد، حيث ترأسَ مجموعةً صناعيةً مغربيةً كبرى، أومنيوم، التي استغلّت مناجم الفوسفات، أهمّ موارد البلاد. كانت العلاقات الجيدة مع النظام الملكي أفضلَ سبيلٍ، إن لم يكن الوحيد، لممارسة الأعمال التجارية هناك.
كان شقيق الملك، مولاي عبد الله، وسيطًا إلزاميًا. لُقّب بـ "صاحب السمو" 51%، وهي النسبة التي كان يطلبها من الشركات المغربية والأجنبية التي رعاها. وبينما ازدهرت هذه الشركات في ظل ديكتاتورية الحسن الثاني، ظلت الطبقات العاملة تعاني من الفقر.
في عام ١٩٦٥، في الدار البيضاء، خرج شباب المدارس الثانوية إلى الشوارع، وانضم إليهم سكان الأحياء الفقيرة والعاطلون عن العمل والعمال. وضربت موجة الغضب منطقة فاس أيضًا. وأطلقت الشرطة النار. وأطلق الجنرال أوفقير، قائد الأمن المغربي، جلاد الريف، النار على الحشود من مروحية. وتدفقت الدبابات على المدينة. وعلى مدار ثلاثة أيام، قتل النظام مئات الشباب والفقراء. وأعلن الحسن الثاني حالة الطوارئ التي استمرت خمس سنوات.
دشّن قمع الدار البيضاء ما يُسمى بـ"سنوات الرصاص" التي استمرت طوال ثلاثين عامًا من حكم الحسن الثاني. تولى الجنرال أوفقير منصب وزير الداخلية، وكُلّف بالقضاء على جميع أشكال المعارضة. ضحاياه لا حصر لهم. من بينهم المهدي بن بركة، الزعيم السابق لحركة الاستقلال، الذي انضم إلى المعارضة واغتاله أوفقير عام ١٩٦٥ بمساعدة المخابرات الفرنسية. ويروي شهود عيان مشاهد التعذيب المروعة التي تعرض لها المعارضون السياسيون أو من يُفترض أنهم معارضون. ويُعدّ سجن تازمامارت، في جبال الأطلس المغربي، حيث عانوا
من أسوأ معاملة لسنوات، رمزًا لهذه السنوات.رغم نجاح النظام الملكي في استعادة النظام، إلا أنه ضعف. تلاشى الدعم، بل وحتى الحماس الشعبي، الذي حظي به إبان الاستقلال، وحل محله اشمئزاز من المحسوبية والفساد. وترسخت فكرة التخلص من الملك بين صفوف هيئة الأركان العامة. حاول قادة الجيش، بمن فيهم أوفقير المتعطش للدماء، اغتياله مرتين، عامي ١٩٧١ و١٩٧٢، دون جدوى. قوضت هذه المحاولات الانقلابية هيبة الملك الضعيف. ولاستعادة صورته واستعادة السيطرة على جيشه، اتخذ الحسن الثاني إجراءات.
قمع الملك بشدة الضباط الذين تمردوا وسعوا للحصول على الدعم من اليسار، وذلك برفع الحظر المفروض على الحزب الشيوعي المغربي.
في عام 1975، أعطت وفاة الجنرال فرانكو، الدكتاتور الإسباني، الملك المغربي الفرصة لضم الصحراء الغربية.تحت اسم المسيرة الخضراء، أطلق الحسن الثاني 350 ألف رجل وامرأة لاستعادة هذه المستعمرة الإسبانية التي كانت على وشك الاستقلال. وخلافًا للأسطورة التي روّجتها الحكومة المغربية، لم تكن هذه المسيرة وليدة اندفاع الشعب، الذي تحرك بعفوية، بدافع من حماسة إلهية. بل كانت كل شيء منسقًا من قبل السلطات، على أعلى مستوى. كان على كل مدينة إرسال وحدتها من "المتطوعين"، بإشراف آلاف الضباط من القوات المسلحة والدرك الملكي. مهدت هذه المسيرة الخضراء الطريق للاحتلال العسكري المغربي للصحراء الغربية، ضاربةً عرض الحائط بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.بعد رحيل القوات الإسبانية عام ١٩٧٦، استعاد المغرب شمال الصحراء الغربية ووسطها، بما في ذلك عاصمتها العيون، بينما استولت موريتانيا على جنوبها. ثم أعلنت جبهة البوليساريو، وهي جماعة من الوطنيين الصحراويين، قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية (SADR). واعترفت الجزائر بها على الفور. ثم اندلعت "حرب رمل" جديدة بين جبهة البوليساريو والجيش المغربي.منذ ذلك الحين، لم يعد الضباط المنشغلون بقتال جبهة البوليساريو يشكلون تهديدًا للحسن الثاني. كما أتاحت له الحرب فرصةً لتحقيق توافق بين جميع الأحزاب السياسية في البلاد، من الأحزاب التقليدية إلى الحزب الشيوعي. تخلى القوميون المغاربة عن خطابهم المناهض للملكية، ليتوحدوا حول قضية الصحراء الغربية.شُنّت حربٌ ضاريةٌ على الصحراويين. ورغم هذا القمع، لم يُفلح النظام قط في إجبارهم على الاستسلام، وبعد خمسين عامًا، لا تزال قضية الصحراء الغربية دون حل.
• في تونس
في تونس، حكم الحبيب بورقيبة منذ عام ١٩٥٦ باسم جمهورية زعمت أنها علمانية، حديثة، وديمقراطية، ومنفتحة على الغرب. اكتسب شعبيته بفضل السنوات العشر التي قضاها في المنفى أو السجن، ودعم الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT) وهو اتحاد نقابي قوي. كانت شعبيته مصدر فخر واعتزاز في أعين أثرياء تونس المتلهفين للتمتع بثرواتهم بسلام، وفي أعين الرأسماليين الأجانب الذين اعتبروه ضمانًا لسلامة استثماراتهم.
مثل بومدين في الجزائر والحسن الثاني في المغرب، فرض بورقيبة نفسه بقمعه الشرس لكل معارضة، وكذلك لكل من هدد بالهيمنة عليه في حزبه. في عام ١٩٦١، اغتال رفيقه "صالح بن يوسف" حُظر الحزب الشيوعي التونسي، وكذلك الصحافة اليسارية. طُهّر الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة العمالية الوحيدة، ولعدة مرات. أصبح بورقيبة الحاكم الأوحد للسلطة التنفيذية. أُجريت انتخابات، لكن جميع الأحزاب الأخرى باستثناء حزبه حُظرت. اتخذ نظامه شكل ديكتاتورية شخصية وبوليسية. كانت هذه الواجهة الديمقراطية كافية للقادة الفرنسيين لتأييد أسطورة "تونس الديمقراطية" والإشادة بمزايا الرجل الذي عيّن نفسه رئيسًا مدى الحياة في سبعينيات القرن الماضي.
في عام ١٩٦٤، وتحت ضغط الولايات المتحدة، التي بسطت نفوذها على الدول المستقلة حديثًا، أجرت تونس إصلاحًا زراعيًا يهدف إلى توسيع نطاق محاصيل التصدير. وُصف التخطيط الزراعي بأنه "اشتراكي" ونُفذ من أعلى، بمساعدة الجيش والشرطة، بهدف تركيز ملكية الأراضي لصالح الفلاحين الأثرياء والبرجوازيين. قاوم صغار المزارعين الفقراء، خوفًا من فقدان سبل عيشهم، مقاومة شرسة. فقاموا بتخريب الإنتاج وذبحوا الماشية، بل ولجأوا أحيانًا إلى الإرهاب. في عام ١٩٦٩، وفي مواجهة أعمال شغب فلاحية واسعة النطاق، أوقف بورقيبة هذه التجربة، بموافقة الولايات المتحدة.
في عام ١٩٧٢، سنّ قوانين تمنح تسهيلات واسعة للشركات الأجنبية المنشأة في تونس. استفادت الشركات الفرنسية، وكذلك البرجوازية المحلية والبرجوازية الصغيرة الثرية. لكن ما استحوذ على اهتمام القوى الإمبريالية كان استغلال رواسب الفوسفات، الضرورية لإنتاج الأسمدة.
• التبعية الاقتصادية والمديونية وإفلاس الدولة
في جميع أنحاء المغرب العربي، كما هو الحال في العديد من البلدان الفقيرة الأخرى حول العالم في الوقت نفسه، عجزت الزراعة عن إطعام السكان المتزايدين. في المناطق الريفية، اضطر الشباب العاطل عن العمل إلى الهجرة إلى المدن أو إلى أوروبا. وظهرت مدن عشوائية ضخمة حول الدار البيضاء وتونس والجزائر العاصمة. فاقمت هذه الأزمة الزراعية اعتماد دول المغرب العربي على الإمبريالية. ولإطعام سكانها، اضطرت هذه الدول إلى استيراد الحبوب والسكر والحليب التي تحتاجها من الدول الإمبريالية، ودفعت ثمنها بالعملة الأجنبية. وقد أدى ذلك إلى تفاقم عجزها التجاري. وهكذا، في أواخر سبعينيات القرن الماضي، كان 25% من العجز في تونس ناتجًا عن واردات غذائية، وكانت فرنسا المورد الرئيسي لها.
وفي الجزائر، كان تصدير المحروقات هو المورد الأساسي للبلاد، بينما في المغرب وتونس، كان بيع الفوسفات هو الذي يحتل هذه المكانة، متقدما كثيرا على المحاصيل التصديرية والسياحة.لذا، عندما انهار سعر الفوسفات عام ١٩٧٧، وانخفض سعر برميل النفط أربعة أضعاف عام ١٩٨٤، كانت كارثة. وعلى شفا الإفلاس، لم يكن أمام هذه الدول حلٌّ سوى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، الذي طالب بدوره الأنظمة بفرض سياسات تقشفية صارمة على العمال والطبقات الشعبية. أثار هذا ردود فعل. وعلى مدى عقد من الزمن، كانت منطقة المغرب العربي مسرحًا لثورات قادها الشباب.
من إضرابات العمال في تونس عام 1978 إلى أعمال الشغب في أكتوبر/تشرين الأول 1988 في الجزائر، وأعمال شغب الخبز في المغرب عام 1981، كان الناس يرفعون رؤوسهم.
• 1978-1988: ثورة الشعب ضد قادته
في تونس
في تونس، في 26 يناير 1978، أمر رئيس الأمن، بن علي، الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين الذين استجابوا لدعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للتحرك، مما أسفر عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى. حُكم على حبيب عاشور، زعيم الاتحاد العام التونسي للشغل، على الرغم من ارتباطه بالحكومة، بالسجن لمدة عشر سنوات مع الأشغال الشاقة. ومع ذلك، استمرت الاضطرابات العمالية. في عام 1980، أشعل الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السلع الأساسية حوض تعدين قفصة، الواقع في منطقة محرومة في جنوب البلاد. بعد ستة أشهر من الإضرابات، استولى عمال المناجم الغاضبون والمسلحون على مدينة قفصة المنجمية، وحظوا بتعاطف ودعم الطبقة العاملة. برر بورقيبة القمع باتهام عمال المناجم بتنفيذ أعمال حرب بالاشتراك مع قوات خاصة من الخارج تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد. تبنت الإمبريالية الفرنسية، التي كانت قلقة بشأن إمداداتها من الفوسفات، حملة التشهير هذه؛ وأرسلت مساعدات عسكرية إلى بورقيبة وأرسلت ثلاث سفن حربية للإبحار قبالة سواحل تونس.
وفي يناير/كانون الثاني 1984، أدى مضاعفة أسعار الخبز والسميد إلى إدانة أفقر الفقراء للمجاعة، وخاصة في جنوب البلاد حيث كان الخبز يمثل ثلاثة أرباع الإنفاق الغذائي.في مواجهة أعمال شغب هزت معظم مدن البلاد، تخلت الحكومة عن زيادات الأجور. ولأول مرة منذ الاستقلال، أجبر العمال والطبقات العاملة نظام بورقيبة على التراجع.بعد هذا القمع، قرر بورقيبة الانفتاح السياسي. فسمح لأحزاب كانت محظورة سابقًا، مثل الحزب الشيوعي التونسي. احتاجت الحكومة إلى دعم نقابي لإضفاء بعض الشرعية على هذه الديمقراطية المزعومة. أُطلق سراح قادة الاتحاد العام التونسي للشغل من السجن ليتمكنوا من التوصل إلى اتفاق انتخابي مع حزب بورقيبة، الذي قمعهم سابقًا. قدّموا مرشحين مشتركين تحت مسمى الجبهة الوطنية. وهكذا أيّد الاتحاد العام التونسي للشغل نهج الديمقراطية على طريقة بورقيبة. وتمكّن مرشحون آخرون من إلقاء كلمات وتنظيم تجمعات أثارت اهتمامًا شعبيًا. وخوفًا من نتيجة الانتخابات، زوّر النظام نتائج الانتخابات!.
في عام ١٩٨٧، أُطيح ببورقيبة، الذي حكم البلاد بقبضة من حديد لما يقرب من ثلاثين عامًا، على يد رئيس وزرائه بن علي، الذي زاد من قوة الشرطة. وبحلول فجر عام ٢٠٠٠، تضاعف عدد أفراد الشرطة أربع مرات، وارتفع عدد الأشخاص الخاضعين للمراقبة من ٢٠٠ إلى أكثر من ٣٠٠٠.وفي حين كان العديد من الشباب عاطلين عن العمل، كان الأثرياء يتباهون بثرواتهم، بدءاً من عائلة بن علي، وهي مافيا استولت على أكثر الشركات ربحية في البلاد.
• في الجزائر
في الجزائر، خلف الجيش بومدين بعد وفاته عام ١٩٧٨، واختار الشاذلي بن جديد، الضابط الأعلى رتبةً. بدأ عهده بثورة وانتهى بنفس الطريقة. اندلعت أولى هذه الثورات عام ١٩٨٠ في منطقة القبائل، وهي منطقة اعتبرت نفسها مهمشة، وطُمست لغتها الأمازيغية من الهوية الجزائرية. بعد حملة قمع أسفرت عن مقتل ١٣٠ شخصًا واعتقالات جماعية لناشطين دافعوا عن الثقافة الأمازيغية، اختار النظام الاعتماد على الإسلاميين في مواجهة النشطاء اليساريين ذوي الحضور القوي في الجامعات. سمحت لهم شبكة المساجد الواسعة التي بنتها الدولة أو الأعيان بتوسيع نفوذهم في جميع أنحاء البلاد.
في عام ١٩٧٩، أوصلت الانتفاضة الشعبية في إيران، التي أطاحت بنظام الشاه، آيات الله إلى السلطة. عزز هذا النجاح الذي حققه الأصوليون الإيرانيون موقف الإسلاميين حول العالم. في الجزائر، وتحت ضغطهم، سُنّ قانون جديد للأسرة عام ١٩٨٤، حُكم فيه على النساء بالبقاء قاصرات مدى الحياة.
في عام 1985، أدى انخفاض أسعار الهيدروكربونات إلى انهيار إيرادات البلاد، وتوقف الواردات، وحدوث نقص في المواد الغذائية، وانتشار البطالة الجماعية.
أشعلت هذه الأزمة فتيل الانفجار الاجتماعي في 5 أكتوبر/تشرين الأول 1988. وامتدت الثورة إلى المدن الكبرى. وبعد خمسة وعشرين عامًا من استقلال البلاد، رفض الشعب حزب جبهة التحرير الوطني. فأُعلنت حالة حصار، ونشر الجيش مدرعاته. وبعد أسبوع من القمع الدموي، خيم الحزن على مئات العائلات. بينما بحث آلاف آخرون عن أبنائهم أو أشقائهم الذين اختفوا أو اعتُقلوا أو حتى عُذبوا في سجون جنوب الجزائر.بعد هذا القمع، وفي محاولة لبث روح جديدة في نظام بالٍ، حاول الجيش أيضًا الانفتاح الديمقراطي في عام 1989. تكاثرت الصحف وتم تشريع الأحزاب السياسية المحظورة. وقد أثار هذا الآمال. كانت رياح الحرية تهب في جميع أنحاء البلاد. لكن لم يتمكن أي حزب من منحها تعبيرًا طبقيًا ومنظورًا ثوريًا، وكان أكثر المستفيدين هم الإسلاميون في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، الذين ازدهروا في ظل السلطة. كانوا على وشك الوصول إلى السلطة، بفضل النتيجة الساحقة في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية. في بداية عام 1992، أوقف الجيش، الذي رفض السماح لقوة سياسية لا يسيطر عليها بالوصول إلى السلطة، العملية الانتخابية. بعد ثلاث سنوات من التواجد في الخلفية، عاد إلى الواجهة.أدى تعطيل الانتخابات إلى اندلاع حرب بين الجماعات الإسلامية المسلحة من جهة والجيش من جهة أخرى، ما جعل السكان عالقين بين الطرفين. وعلى كلا الجانبين، مارست العصابات المسلحة أعمالًا إرهابية، وكان المدنيون هم الضحايا الرئيسيين.
لم يكن "العقد الأسود" في التسعينيات، كما سُمّي، حربًا أهلية، بل حربًا على المدنيين، يُقدّر أنها خلّفت ما بين 100 ألف و200 ألف قتيل. مع ذلك، كانت فترة ازدهار للمجموعات الدولية الكبرى والبرجوازية الجزائرية، التي كانت بارعة في إدارة أعمالها. تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من التوترات الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر، لم ينقطع التعاون بين أجهزة الأمن في البلدين.
في عام ١٩٩٨، أنهت هيئة الأركان العامة الاشتباكات بالتوصل إلى اتفاق مع الجماعات الإسلامية. ثم اختار الجنرالات الانسحاب مجددًا والاختباء خلف ستار مدني، ممثلًا بزعيم تاريخي لجبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بوتفليقة. وبذريعة المصالحة، تم العفو عن جرائم العشرية السوداء. واليوم، وبعد خمسة وعشرين عامًا من انتهاء هذه المأساة، لا تزال العائلات تبحث عن المفقودين من تلك الفترة.
• المغرب
في المغرب، فرض صندوق النقد الدولي إجراءات التقشف في ثمانينيات القرن الماضي في بلدٍ يعاني من تفاوت اجتماعي كبير. انتقلت ملايين الهكتارات من الأراضي الاستعمارية، التي تُعدّ من أغنى الأراضي في البلاد، إلى أيدي وجهاء الريف ومسؤولي النظام وبعض الضباط، تاركةً أعدادًا كبيرة من الفلاحين الفقراء في حالة بؤس. أما سياسة مغربة الملكية الأجنبية، فقد أفادت أغنى البرجوازية المغربية، مع الحفاظ على رأس المال الأجنبي الذي احتفظ بحصص كبيرة في الشركات. وبحلول عام ١٩٧٨، كانت ٣٦ عائلة قد استحوذت على ثلثي هذه الممتلكات.في هذه الأثناء، كانت الطبقات العاملة تُعاني من ضغوط إجراءات التقشف التي زادت من تكلفة حرب الصحراء. كانت هذه الحرب تُستنزف 45% من ميزانية الدولة! وكان السكان يزدادون فقرًا بلا هوادة.
في عام ١٩٨١، وخلال فترة جفاف حاد، اندلعت "أعمال شغب الخبز" في المغرب. وفي جميع أنحاء البلاد، استهدفت المظاهرات رموز الثراء. وأطلقت الشرطة النار على الحشود، مما أسفر عن مقتل ما بين ٦٠٠ و١٠٠٠ شخص. وكان طفل واحد من كل ثلاثة وفيات. وسُجن الآلاف وصدرت عليهم أحكام. وفي عام ١٩٨٤، وبأمر من صندوق النقد الدولي، فرض النظام زيادات إضافية على أسعار المواد الغذائية.وفي الدار البيضاء، أثار ارتفاع رسوم التسجيل في شهادة البكالوريا حركة طلابية في المدارس الثانوية امتدت إلى المدن الكبرى، واستقطبت الشباب من الأحياء الفقيرة والأحياء العشوائية، وفي نهاية المطاف السكان بأكملهم، إلى حركة ثورة ضد البطالة والجوع، ولكن أيضا ضد الدكتاتورية.في مواجهة الاحتجاجات، تخلى الحسن الثاني عن زيادات الأسعار المخطط لها، ثم أرسل دباباته لإطلاق المدافع وطائراته المروحية لإطلاق نيران رشاشاته على المتظاهرين. وفي خطاب بغيض، وصف الشباب الذين أجبروه بشجاعة على التراجع بأنهم قطاع طرق وكسالى.
• تقييم ثورات الثمانينيات
في ثمانينيات القرن الماضي، نجحت الطبقات العاملة في المغرب العربي في الحشد ضد حكامها. لكن المأساة تكمن في أنه في غياب أحزاب تمثل مصالحها، حاول العديد من القادة استغلال نضالية العمال لقيادتهم نحو أهداف بعيدة كل البعد عن مصالحهم الطبقية. في تونس، مهد التحالف المشين بين اليسار والنقابات والنظام الطريق للحركة الإسلامية.في البلدان الثلاثة، في مواجهة أنظمة مكروهة، كان الإسلاميون المعارضة الوحيدة القادرة على حشد السخط الشعبي. وقد نجحوا في كسب تأييد في الأحياء، بفضل شبكات المساجد ودورها في جوانب عديدة من الحياة الاجتماعية، كمساعدة الفقراء، الذين كان لهم صوتهم، على عكس الديمقراطيين الذين لم يحاولوا قط مخاطبتهم والاستجابة لتطلعاتهم.وعلى مدى سنوات الثورات الشعبية ضد غلاء المعيشة، والتي شهدت تزايد نفوذ الإسلاميين، استمرت الأنظمة الثلاثة أيضاً في استخدام ورقة القومية لتحويل غضب شعوبها ضد جيرانها.
• الصحراء الغربية والتنافسات الإقليمية والوحدة المغاربية المستحيلة
الصحراء الغربية
في المغرب، واصل الحسن الثاني حربه القذرة في الصحراء الكبرى، ضد 500 ألف صحراوي يعيشون على أرض تبلغ مساحتها نصف مساحة فرنسا. أراد الملك السيطرة على ثروات الإقليم المعدنية ورواسب الفوسفات، التي تُعدّ من بين الأكبر في العالم. كما سعى للسيطرة على ساحل المحيط الأطلسي الشاسع، الذي يضم مياهًا غنية بالأسماك ورواسب نفطية محتملة. وبصفته سيدًا إقطاعيًا، استند في مطالبه إلى روابط الولاء السابقة بين القبائل الصحراوية وسلاطين المغرب.من جانبها، استندت الجزائر إلى حرمة الحدود الاستعمارية، ودعمت الجمهورية الصحراوية، مدّعيةً أنها تتصرف باسم حق الشعوب في تقرير مصيرها. في الواقع، كانت هي الأخرى تطمع في منفذ بحري على ساحل المحيط الأطلسي، مما كان سيعزز موقفها في مواجهة المغرب.
بين عامي ١٩٧٥ و١٩٩٠، شنّ جيش جبهة البوليساريو، بدعم من الجزائر، حرب عصابات طويلة ضد الدولة المغربية، مما منعه من استغلال الصحراء كما يشاء. استفاد الحسن الثاني من دعم الإمبريالية الفرنسية. يتذكر الصحراويون، اللاجئون في مخيمات الجزائر، القصف الفرنسي لعملية لامانتان التي نُفذت عام ١٩٧٧ ضد جبهة البوليساريو.بمساعدة فنيين فرنسيين وخبراء إسرائيليين وأمريكيين، وبدعم مالي سعودي، بنى المغرب جدارًا رمليًا بطول 2720 كيلومترًا. هذا الحاجز محمي بسدود ورادارات، وآلاف الجنود المتمركزين بشكل دائم. يُقال إن عشرة ملايين لغم متناثرة على طول هذا الجدار، الذي قسّم الصحراء فعليًا إلى قسمين؛ 80% من أغنى المناطق في الغرب لا تزال تحت السيطرة المغربية، و20% في الشرق تحت سيطرة جبهة البوليساريو. وهكذا، اقتصرت هجمات البوليساريو على منطقة بعيدة عن أغنى مناطق الصحراء. ومع ذلك، فإن المغرب، الذي كان على شفا الانهيار الاقتصادي، لم يتمكن من هزيمة الانفصاليين.وفي عام ١٩٩١، وبعد خمسة عشر عامًا من القتال الذي أودى بحياة عشرة آلاف رجل، اضطر الحسن الثاني إلى الموافقة على وقف إطلاق النار. وقد قبل مبدأ استفتاء تقرير المصير الذي يُنظم تحت رعاية الأمم المتحدة، لكنه لم يكف عن المناورة لمنعه.
بحلول أوائل القرن الحادي والعشرين، انضم 200 ألف مستوطن مغربي إلى 200 ألف جندي في الإقليم. وشجعت الحكومة استيطانهم من خلال تقديم مساعدات: السكن، والضروريات الأساسية منخفضة التكلفة، والنقل المجاني، ورفع رواتب موظفي الخدمة المدنية. وكان الهدف هو جعل الضم لا رجعة فيه، وتقليل النفوذ العددي للصحراويين.كانت التكلفة على الفقراء المغاربة باهظة. خصصت الدولة خُمس ميزانيتها لإبقاء القوات في الصحراء، بينما كان أكثر من نصف سكان المغرب أميين، و13% منهم تحت خط الفقر! من ناحية أخرى، استفاد رجال الأعمال المغاربة ومصنعو الأسلحة من هذه الأموال التي ابتلعتها الصحراء. قامت شركة وستنجهاوس الأمريكية بتركيب تغطية رادارية بقيمة 250 مليون دولار، وتولت فرنسا مسؤولية تجهيز الجيش وتدريبه.
الصحراء، التي قُدّمت كقضية وطنية مقدسة، أتاحت للملكية تدجين جميع الأحزاب السياسية. خضع الجميع لهذه القضية، وتعرض من لم يمتثل للقمع، مثل أشهر ناشط سُجن في سجون الحسن الثاني، إبراهيم السرفاتي. وُلد لعائلة يهودية مغربية، وترك الحزب الشيوعي ليؤسس جماعة ماوية. أدى انتقاده للملكية وإدانته للحرب الاستعمارية في الصحراء إلى اتهامه بالتآمر على أمن الدولة والحكم عليه بالسجن المؤبد في سجن القنيطرة سيئ السمعة. ورغم الإذلال والتعذيب، رفض التراجع. وبعد الفضيحة التي أثارها نشر كتاب جيل بيرو "صديقنا الملك" اخترعت الحكومة له جنسية برازيلية لطرده.
عندما توفي الحسن الثاني عام ١٩٩٩، ترك لابنه محمد السادس ثروة طائلة: أكبر مجموعة خاصة في المغرب، وأسهمًا في العديد من الشركات الأجنبية، بما في ذلك شركة سيمنز الألمانية. ووفقًا لصحيفة لوموند، كان لدى الحسن الثاني "حوالي عشرين حسابًا مصرفيًا ثريًا، وقصر في بيتز بمنطقة إيل دو فرانس، وأكثر من عشرين قصرًا مخفيًا [...] جاهزة لاستقباله على مدار الساعة".
كان محمد السادس ينوي تجسيد تجديدٍ يقطع مع سنوات الحسن الثاني الرمادية. كان في الثالثة والثلاثين من عمره آنذاك، وأراد أن يبدو عصريًا، منسجمًا مع الشباب، وقريبًا من الشعب، وأطلق على نفسه لقب "ملك الفقراء".
لكنه سار على خطى والده في قضية الصحراء، مُعجّلاً استغلال مواردها. تجلى ذلك في خريف عام ٢٠١٠، عندما تجمع ٢٠ ألف صحراوي في مخيم أكديم إزيك للتنديد بالتهميش الذي يعانون منه. لم يُسمح لأي وسيلة إعلامية بتغطية الحدث، وحاصرت قوات الأمن مخيمهم المكون من ٧٠٠٠ خيمة، بعيدًا عن الأنظار. فجر الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني، اقتحم الجيش الموقع. قُتل أحد عشر جنديًا مغربيًا، و٣٦ صحراويًا، وجُرح المئات.هذه هي أسرار التنمية المتناغمة في الصحراء، التي تُروّج لها الدعاية الملكية. دعايةٌ روّج لها السياسيون الفرنسيون بلا خجل، لا سيما منذ ديسمبر/كانون الأول 2020.
• الصحراء الغربية والتوترات الإقليمية
في العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2020، أي بعد شهر من استئناف القتال بين
جبهة البوليساريو والجيش المغربي، أعلن الرئيس دونالد ترامب، قبل أيام قليلة من انتهاء ولايته الأولى، اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. هذا الاعتراف، الذي كان جزءًا من اتفاقيات أبراهام التي رعاها ترامب، كان يهدف، باسم السلام، إلى تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.
كانت صفقةً على طريقة ترامب:
"الاعتراف بمغربية الصحراء مقابل التطبيع مع إسرائيل" في الواقع، كان هذا التطبيع أمرًا طبيعيًا، نظرًا لعمق العلاقات التاريخية بين إسرائيل والمغرب.
زعزع هذا الإعلان الوضع الراهن وأخلّ بالتوازن في المنطقة، وأجّج التوترات الجزائرية المغربية. وأدى كشف الصحافة عن عمليات تنصت واسعة النطاق على الجزائر من قِبل أجهزة المخابرات المغربية عبر عملية بيغاسوس إلى انهيار العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب. وفي أغسطس/آب 2021، أغلقت الجزائر خط أنابيب الغاز الذي يُغذّي إسبانيا عبر المغرب، مما حرم المغرب من الوصول إلى الغاز الجزائري.دخل المغرب، بدعم من الولايات المتحدة، في مواجهة مع جميع الدول التي لم تعترف بالصحراء جزءًا لا يتجزأ من أراضيه. في عام ٢٠٢٢، رضخت إسبانيا للضغوط المغربية، وفي العام الماضي، وتحديدًا في عام ٢٠٢٤، جاء دور إيمانويل ماكرون، الحريص على حماية مصالح البرجوازية الفرنسية في البلاد.في الواقع، مع احتدام الحرب التجارية وطرد القوات الفرنسية من منطقة الساحل، من الضروري للإمبريالية الفرنسية الحفاظ على مكانتها كشريك تجاري رئيسي للمغرب. ويزداد هذا الأمر أهميةً في ظل خلع منافسيها الأتراك والصينيين، وخاصة الإيطاليين، من عرشها في الجزائر.
في مقابل هذا التكريم، حظي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته الرسمية إلى المغرب أواخر أكتوبر 2024، باستقبال حافل، وفوق كل ذلك، بعقودٍ بقيمة 10 مليارات يورو. وكان من بين الوفد المتضخم وزراء وشخصيات لطالما عززوا علاقاتهم بالمملكة، حيث قُدّمت لهم كل التسهيلات للاستمتاع بعطلة الأحلام. أما بالنسبة لرجال الأعمال الحاضرين في الوفد، فهذه هي الطريقة المعتادة للعمل والتحضير على أفضل وجه ممكن.عدد الإقامات الخاصة لرجال الأعمال، الذين يتصادف أنهم رؤساء شركات إنجي، وسافران، وتوتال إنرجي، وسويز، وفيوليا، لا يُحصى. وتتنافس مجموعة ألستوم على إنتاج وتسليم 168 قطارًا. وأفادت التقارير أن إيرباص أبرمت صفقة بيع ما بين 15 و18 طائرة هليكوبتر للنقل من طراز كاراكال. وتُشير التقارير إلى أن شركة كهرباء فرنسا (EDF) تبني مشروع الطريق السريع الكهربائي شمال الصحراء الغربية، بين الداخلة والدار البيضاء. من جانبها، وقّعت توتال إنرجي عقدًا بقيمة ملياري يورو لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر على الساحل الأطلسي للصحراء.إن هذه الصفقات الوقحة التي تتم دون مراعاة لمصالح الشعب الصحراوي مثيرة للاشمئزاز.
• ثقل التنافسات المغاربية
يدفع الشعبان المغربي والجزائري ثمنًا باهظًا للتوترات التي تؤججها حكومتاهما وتؤججها القوى الإمبريالية. هذه التنافسات ليست خاصة بهما، بل هي تنافسات برجوازيتيهما، المتشبثة بحدودهما والمعتمدة على أجهزة دولتهما لحماية نفسها من منافسيها والدفاع عن ثرواتها وامتيازاتها.ولكن على نطاق المغرب العربي بأكمله، فإن التنافسات والتوترات المتواصلة وحالات الحرب الدورية منعت حتى التعاون الاقتصادي.جرت محاولة هذا التعاون عام ١٩٨٩، عندما كان المغرب العربي يعاني من تضييق الخناق على صندوق النقد الدولي، وكانت حرب الصحراء الغربية قد دمرت المغرب. في ذلك العام، ألقى الحسن الثاني والشاذلي بن جديد سلاحهما ليُعلنا تأسيس اتحاد المغرب العربي. لكن الأمل لم يُكتب له النجاح، وظل هذا الاتحاد مجرد صدفة فارغة.
في عام ١٩٩٣، اتهم المغرب المخابرات الجزائرية بتدبير الهجمات على فندق في مراكش. أُجبر المواطنون الجزائريون أو الفرنسيون الجزائريون الذين لا يحملون تصريح إقامة على مغادرة المملكة. فرض المغرب تأشيرة دخول على الجزائريين، الذين كان يُسمح لهم سابقًا بالدخول بحرية. ردّت الجزائر بإغلاق الحدود البرية بين البلدين.لقد أدى هذا الإغلاق، منذ ثلاثين عامًا، إلى قطع الروابط الإنسانية الوثيقة القائمة على جانبي الحدود.يدفع الشعب ثمن ذلك اقتصاديًا من خلال سباق التسلح الذي تنخرط فيه حكومته. في السنوات الأخيرة، بلغ هذا السباق مستويات غير مسبوقة: فالجزائر هي ثاني أكبر مشترٍ للأسلحة في أفريقيا، حيث ستنفق 24 مليار دولار عليها بحلول عام 2024. وخصص المغرب 13.3 مليار دولار للقوات المسلحة الملكية لعام 2025.
يُقال إن البلدين يستحوذان على أكثر من 60% من مشتريات الأسلحة في أفريقيا، وهو هدرٌ كبير. في حين تعاني شعوب المغرب العربي من أزمة اجتماعية خانقة، وبطالة واسعة النطاق، وتضخم مرتفع للغاية، وتدهور في الخدمات العامة، تُبدّد حصة متزايدة من الثروة على شراء الأسلحة. ويستغل النظامان المغربي والجزائري هذا التصعيد ومناخ العدوانية المصاحب له لإثارة المشاعر القومية وإسكات الاحتجاجات. يدرك قادة المغرب العربي أنهم يقفون على بركانٍ قد ينفجر في أي لحظة.
• الثورات ضد النظام: من الربيع العربي إلى الحراك
تونس 2011 سقوط الدكتاتور
في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدا الوضع تحت سيطرة القادة. في الجزائر، نجح بوتفليقة، الذي تولى رئاسته بقمع انتفاضة واسعة النطاق في منطقة القبائل بعنف، في ترسيخ مكانته، مستفيدًا من تطلعات شعبٍ تطلّع إلى السلام والاستقرار بعد فوضى العشرية السوداء. في المغرب، سعى محمد السادس إلى تجسيد التجديد، متجاوزًا سنوات الحكم الاستبدادي. بقيادة بن علي، اعتُبرت تونس مثالًا للاستقرار؛ ووُصفت بـ"المعجزة التونسية" جعلتها اتفاقيات التجارة الحرة الموقّعة مع الاتحاد الأوروبي ملاذًا آمنًا للشركات الفرنسية البالغ عددها 1200 شركة التي أقامت فروعًا لها هناك.
بالنسبة لشركات فوريسيا، وفاليو، وبي إس إيه، ورينو، وسوسيتيه جنرال، وبي إن بي باريبا، ودانون، كان الأمر بمثابة معجزة حقيقية: فقد كانت لديهم قوة عاملة ماهرة ورخيصة، تحت إشراف شرطة تراقب أحياء الطبقة العاملة باستخدام آلاف المؤشرات. لكن وراء هذه "المعجزة" كانت هناك مناطق مهجورة، وبطالة جماعية، وشعب لم يعد يتقبل الفقر والفساد.
في عام ٢٠٠٨، ثار عمال مناجم قفصة على إدارة المناجم التي مارست ممارسات توظيف تتسم بالمحسوبية والمحاباة. وعلى مدى ستة أشهر، ثار السكان على السلطة التعسفية والبطالة التي طالت ثلث شبابهم، بينما كان عمال المناجم يكدحون لاستخراج الفوسفات. وتصاعد الغضب الاجتماعي.
انفجرت الأزمة أواخر عام ٢٠١٠ في مدينة سيدي بوزيد، عندما أشعل بائع متجول شاب النار في نفسه بعد أن صادرت الشرطة بضاعته. هزّ هذا الفعل اليائس البلاد بأكملها، وكان نقطة انطلاق "الربيع العربي" أشعل تونس، وامتد تأثيره إلى جميع الدول العربية.في تونس، وفي غضون أسابيع قليلة، "سقط جدار الخوف". اختلطت المطالب الاجتماعية بالمطالب السياسية:
"بن علي، ارحل!" "الشعب يريد تغيير النظام" حظي بن علي بدعم ساركوزي ووزيرة خارجيته، ميشيل أليو ماري، التي عرضت عليه "خبرة قوات الأمن الفرنسية". ولاستعادة النظام والحفاظ على مصالحها، اختارت الولايات المتحدة، بالتشاور مع قائد الجيش التونسي، التخلي عن الديكتاتور الذي خدمها ببراعة. وهكذا، اضطر بن علي، ديكتاتور تونس لثلاثة وعشرين عامًا، على عجل، إلى السفر جوًا بلا عودة إلى المملكة العربية السعودية.
في ربيع عام ٢٠١١، كان التونسيون فخورين وسعداء بنجاحهم في الإطاحة بدكتاتور بدا راسخًا. غذّى هذا النصر أملًا كبيرًا بالتغيير. كان بن علي يتصرف كعضو مافيا، إذ صادر ٤٠٠ شركة، وامتلكت عشيرته مئات الحسابات المصرفية، وعشرات اليخوت، وروائع فنية، تُقدّر قيمتها جميعًا بـ ١٣ مليار دولار. وهكذا نجح في كسب الإجماع ضده. صفّق له العاطلون عن العمل، والمحامون، وأصحاب المشاريع الصغيرة، والصحفيون، والعمال، وحتى أصحاب الأعمال - جميع الطبقات الاجتماعية - لرحيله، ولكن لم تكن لديهم جميعًا نفس التوقعات أو نفس المصالح.لم يكن يكفي إزاحة ديكتاتور، بل كان ضروريًا أيضًا إسقاط السلطة الاقتصادية التي كان يخدمها. في الواقع، لم يكن النظام الاجتماعي الظالم، سبب كل هذه المعاناة، قائمًا على رجل واحد، مهما بلغ ثراؤه. رحل بن علي، لكن النظام الرأسمالي، والدولة، والجهاز القمعي للبرجوازية التونسية، أدوات النظام الإمبريالي، لا يزال قائمًا.
أعقب سقوط بن علي فترة من الاضطرابات الاجتماعية، تخللتها مظاهرات وإضرابات عمالية واعتصامات. ناضلت الطبقات المضطهدة من أجل بقائها وانتظرت التغيير.واتسمت الحياة السياسية بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، حزب بن علي. انسحب سياسيون كانوا على خلاف مع النظام، وعاد الباجي قايد السبسي، الوزير السابق في عهد بورقيبة. وعادت الأحزاب المحظورة سابقًا إلى الظهور: الحزب الشيوعي (POCT) والجبهة الشعبية، وهي تجمع لقوى يسارية مختلفة؛ وحزب النهضة الإسلامي، المرتبط بجماعة الإخوان المسلمين.قدّم الجميع، بما في ذلك حركة النهضة، انتخاب المجلس التأسيسي والديمقراطية على أنهما طريق التغيير، وأنكرت رغبتها في بناء خلافة. زعم زعيمها، راشد الغنوشي، أنه إسلامي معتدل، على غرار تركيا أردوغان. قاوم نشطاؤها القمع، وسرعان ما أعادوا تنظيم صفوفهم، واكتسبوا نفوذًا في الأوساط الشعبية التي تجاهلتها الأحزاب الديمقراطية، بل واحتقرتها.
في أكتوبر/تشرين الأول 2011، بفوزه في انتخابات المجلس التأسيسي، أصبح حزب النهضة القوة السياسية الرائدة. وسيلعب هذا الحزب دورًا قياديًا في الحكومة الانتقالية حتى عام 2014. وعلى مدى ما يقرب من ثلاث سنوات، اختلف المعسكر "الحداثي" والمعسكر الإسلامي داخل المجلس التأسيسي حول العديد من مواد التشريعات. ورغم اختلافهما في العديد من القضايا، إلا أنهما دافعا عن المعسكر الاجتماعي نفسه:
"البرجوازية، وملكيتها الخاصة، وحقها في استغلال العمال. ولم يقترحا أي شيء لمعالجة الصعوبات الاجتماعية الرئيسية التي كانت السبب الجذري للثورة".
رحل بن علي، لكن الفساد ظلّ مستشريًا في جميع شرائح المجتمع. اضطرّ العمال إلى محاربة أصحاب العمل أنفسهم بشراسة، وتعرضوا للقمع من قبل الشرطة نفسها. عاشت غالبية التونسيين الفقراء في المدن والأرياف في فقر مدقع.انتشرت الثورة التونسية مُعديةً في جميع أنحاء العالم العربي، مع أننا لن نناقش مصر والشرق الأوسط، أو ليبيا والسودان هنا. أما في المغرب، فقد أدى الغضب إلى اندلاع حركة 20 فبراير، التي نجح الملك في تهدئتها بإصلاح دستوري منح رئيس الوزراء مزيدًا من الصلاحيات دون إحداث أي تغيير جذري. أما في الجزائر، فقد اتخذت الاحتجاجات شكل إضرابات ومظاهرات وأعمال شغب.
وفي واقع الأمر، اهتز المغرب لفترة طويلة.
• حراك الريف المغربي2016-2017
في خريف عام ٢٠١٦، ثار سكان الريف المغربي مجددًا ضد الفقر. في هذه المنطقة الفقيرة، لا تزال ذكرى ثورة عبد الكريم ضد الاستعمار الإسباني والفرنسي حاضرة في الأذهان. في مدينة الحسيمة الساحلية، على بُعد ٣٠٠ كيلومتر من طنجة، أشعلت وفاة محسن فكري، بائع السمك، حريقًا. صادرت الشرطة بضاعته وألقتها في حاوية قمامة. ولاستعادة سمكه، قفز الشاب في الشاحنة ودُهس حتى الموت. انتشرت صور هذا المشهد المروع على مواقع التواصل الاجتماعي، مُثيرةً مشاعر وغضبًا لا حدود لهما.
في الأيام التالية، تظاهر السكان احتجاجًا جماهيريًا ضد عنف الشرطة واحتقارها وتعسفها. وامتد الحراك إلى القرى المجاورة، وتطور إلى حركة جماهيرية ضد الفساد والتهميش في المنطقة. وظهرت صور عبد الكريم وعلم جمهورية الريف في المظاهرات. وحملت اللافتات السؤال الذي طرحه عبد الكريم آنذاك: "هل أنتم حكومة أم عصابة؟"لعدة أشهر، احتشد الشعب في مسيرات أسبوعية، مطالبًا بالإصلاحات، وحدد قائمة بعشرين مطلبًا.دفعت قوة الحركة وطبيعتها السياسية المتزايدة الحكومة المغربية إلى الخوف من عودة الربيع العربي. فنُشرت قوة قوامها 25 ألف شرطي لاحتواء المتظاهرين.
وبأمر من وزارة الشؤون الدينية، انتقد الأئمة الحراك بشدة. وردًا على ذلك، قرر المتظاهرون مقاطعة المساجد. وعندما قاطع ناصر الزفزافي، الشاب العاطل عن العمل والقيادي في الثورة، خطبة إمام للتنديد بالهجمات، أُلقي القبض عليه فورًا وحُكم عليه بالسجن عشرين عامًا.
اندلعت المظاهرات في عدة مدن في أنحاء البلاد، وشارك فيها أكثر من 50 ألف شخص في شوارع الرباط العاصمة. وفي مواجهة حركة هددت بالامتداد، تصاعد القمع. وفي منطقة الريف، قضت أحكام قاسية على المتظاهرين على الحركة. وأتاحت محاكمات المعتقلين فرصة تجدد الاحتجاجات، لكن الحكومة تمكنت في النهاية من إخمادها.لكن جمر الثورة لا يزال موجودًا، فهو لا ينطفئ أبدًا، ويعود للاشتعال دائمًا عندما لا نتوقعه.
• 2019، حراك الجزائر
وهكذا، في الجزائر عام ٢٠١٩، اعتُبر إعلان ترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وهو أبكم ومعاق، إذلالاً إضافياً. بوتفليقة، الذي نجا من موجة "التطهير" خلال الربيع العربي، أشعل فتيل أكبر حراك شعبي منذ استقلال البلاد. وكما في تونس، خرجت جميع فئات المجتمع إلى الشوارع للمطالبة برحيله. كان الشعب الجزائري يطالب بمحاسبة سلطة تأسست بعد الاستقلال عام ١٩٦٢، متهماً أعيان البلاد بنهب ثرواتها"تخلصوا من النظام!"و "دعوهم جميعا ليرحلوا!"، كانت هذه الشعارات تعني للطبقة العاملة أنهم لم يعودوا مسحوقين أو محتقرين، وأنهم أحرار، ولديهم حقوق، ويمكنهم إطعام أسرهم، والحصول على الرعاية الطبية، والحصول على منزل والعيش بكرامة.لم تتوقع الطبقات العاملة شيئًا مما يُسمى أحزاب المعارضة، الإسلامية والديمقراطية، التي قدمت جميعها دعمها المباشر أو غير المباشر لبوتفليقة. رُفضت هذه الأحزاب، ولم يتمكن أي منها من ترسيخ مكانته كقائد للحراك، الذي نجح مع ذلك في الإطاحة ببوتفليقة ومنع إجراء الانتخابات الرئاسية. لكن بينما نجح ملايين الجزائريين، معظمهم من الطبقات العاملة، الذين تظاهروا لأشهر في إسقاط واجهة النظام، لم يكن ذلك كافيًا. فبدون أي قيادة حقيقية خاصة بهم وبدون أهداف سياسية محددة، كان قايد صالح، رئيس أركان الجيش، هو من فرض نفسه في النهاية، مدعيًا الاستجابة لمطالب الحراك بـ"عملية تطهير" مذهلة. ووجد كبار المسؤولين، وكبار الموظفين الحكوميين، وعشرات الوزراء، وحتى رئيسا وزراء سابقان، أنفسهم خلف القضبان.لكن النظام باقٍ. في ديسمبر/كانون الأول 2019، ورغم دعوات المقاطعة، انتُخب عبد المجيد تبون رئيسًا، ليصبح الوجه المدني الجديد لسلطة الجنرالات.
• الأنظمة الاستبدادية أكثر فأكثر
في تونس، رفضت الطبقات الشعبية في نهاية المطاف جميع الأحزاب التي تغنّت بالديمقراطية. في الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠١٩، استغلّ قيس سعيد، أستاذ القانون المتقاعد المغمور الذي لا ينتمي لأي حزب، هذا الرفض. فاز بسهولة، متغلبًا على رجل الأعمال نبيل القروي، الذي كان آنذاك في السجن بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي. في مواجهة هذا الخصم، لم يجد قيس سعيد، الذي قاد حملة لمكافحة الفساد، صعوبة في تجسيد تواضع ونزاهة موظف حكومي بسيط. وقد سجّل هذا القومي المحافظ والمتدين نقاطًا إيجابية لدى الرأي العام عندما هاجم النظام البرلماني.
في مارس/آذار 2022، وبالتشاور مع الجيش، أعلن حل البرلمان وحالة الطوارئ. ثم وضع أسس دستور جديد، مكّنه من إسكات معارضيه من جميع الأطياف. حُكم على زعيم حركة النهضة بالسجن ثلاث سنوات لمجرد إثارة خطر "حرب أهلية" في تونس. في سبتمبر/أيلول 2024، وفي انتخابات مُحددة مسبقًا، أُعيد انتخاب قيس سعيد رئيسًا بنسبة 90.69% من الأصوات، ولكن هذه المرة بنسبة مشاركة بلغت 28.8%، وهي أعلى نسبة امتناع عن التصويت منذ عام 2011.
وفي الشهر نفسه، في الجزائر، وفي ظل مناخ قمعي، وفي مواجهة مرشحين اثنين تم اختيارهما بعناية، أعيد انتخاب عبد المجيد تبون لولاية ثانية، ولكن مرة أخرى مع نسبة إقبال منخفضة للغاية.
بعد أربعة عشر عامًا من الربيع العربي، وبضع سنوات من احتجاجات الحراك المغربي والجزائري، تنخرط أنظمة المغرب العربي في اندفاعة استبدادية متسارعة. تُنتهك الحقوق الديمقراطية، وتُداس الحريات، ويُلاحق المعارضون. كل ذلك ذريعة لتطويع النظام، بهدف خلق مناخ من الخوف والاستنكار. "المؤامرة الداخلية" و"التلاعب الخارجي" تهمتان تستخدمهما الأنظمة على نطاق واسع لاعتقال المعارضين الحقيقيين أو المفترضين. ولهذا السبب، في تونس، حُكم مؤخرًا على نحو أربعين معارضًا بأحكام سجن طويلة.
مئات سجناء الرأي الذين ما زالوا يقبعون في السجون الجزائرية، على سبيل المثال، لمجرد مشاركتهم هاشتاغ #JeNeSuisPasContent (لستُ سعيدًا) لم يحظوا في فرنسا بنفس الدعم الذي حظي به الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال. وبينما ندين سجنه، ندين أيضًا نفاق السياسيين، من أقصى اليمين إلى بعض اليسار، الذين يطالبون بالإفراج عنه ويتظاهرون بأنهم مدافعون عن حرية التعبير.لأنه هنا في فرنسا، أين حرية التعبير عندما يحاول أحد تجار التجزئة إسكات أولئك الذين ينددون بالسياسة الإجرامية لنتنياهو من خلال مساواتهم بمعادي السامية؟وأين الحرية للناشط جورج إبراهيم عبدالله المتهم بلا أدلة والذي يقبع في السجون الفرنسية منذ أكثر من أربعين عاماً؟.
في المغرب العربي، لم نسمع احتجاجات ما يسمى بالديمقراطيين الفرنسيين على مصير مئتي سجين رأي من الريف حُكم عليهم بالسجن عشرين عامًا! ولم يحركوا ساكنًا بعد إدانة الصحفي المغربي سليمان الريسوني، الذي لم يكن ذنبه سوى فضح المحسوبية والفساد المستشري في المغرب والمجتمعات المغاربية.
ماكرون، وريتيللو، ولوبان، وسيوتي من جهة، وآل تبون، ومحمد السادس، وقيس سعيد من جهة أخرى، أخوة توأم، مستعدون لاستخدام نفس الأساليب. هم والنظام الذي يخدمونه لا يستحقون إلا شيئًا واحدًا:
"الإطاحة بهم نهائيًا".
• المغرب العربي: إلدورادو للرأسماليين، واستغلال للعمال
يظل المغرب العربي بمثابة كنزٍ ثمينٍ للشركات الفرنسية، حتى مع مواجهتها منافسةً من جهاتٍ أخرى. يوجد 600 منها في الجزائر، و1000 في المغرب، و1500 في تونس. تُشغّل شركات توتال، وأورانج، وكارفور، وبيجو، ورينو، والعديد من الشركات الصغيرة في قطاعات النسيج والطيران والإلكترونيات، 150 ألف عامل في تونس. يمتلك نظام قيس سعيد الاستبدادي كل مقومات جذبهم. أما بالنسبة للملكية المغربية، فيبدو لهم أنها ضمانةٌ للاستقرار المُلائم لأعمالهم.
هذا الأسبوع، تصدرت مجلة "التحديات" صفحتها الأولى. فوق صورة محمد السادس، نقرأ "معاداة الجزائر - المغرب، مغامرة فرنسا - إلدورادو للأعمال". عنوان يلخص كل شيء.في الواقع، استفادت شركات كولاس ريل وتاليس وإنجي بشكل رئيسي من بناء خط القطار فائق السرعة، الذي تُقدر تكلفته بـ 1.1 مليار يورو. تمكنت ألستوم من بيع اثني عشر قطارًا دون الاستجابة لأي مناقصة، بفضل فضل من محمد السادس، الذي تحول من ملك الفقراء إلى ملك الرأسمالية المغربية. تكشف التحديات أنه يسيطر على جزء كبير من الاقتصاد المغربي؛ أما ثروته الشخصية، التي قُدرت بـ 5.7 مليار دولار عام 2015، فقد زادت بشكل ملحوظ.من جانبه، يُعدّ رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش من أغنى رجال الأعمال في البلاد. فهو رئيس مجموعة "أفريقيا"، الشركة الرائدة في توزيع الوقود. وبصفته رئيسًا للحكومة، وقّع مؤخرًا عقدًا مع ثلاث شركات، من بينها شركته العائلية القابضة، لبناء محطة تحلية مياه كبيرة في الدار البيضاء. ولأنه لا يوجد أفضل من نفسك، فقد منح نفسه دعمًا ماليًا بقيمة مليارات الدراهم.
لقد جعل بناء البنية التحتية الحديثة، مثل ميناء طنجة المتوسط وقطار الدار البيضاء-طنجة فائق السرعة، بمزارعه الصناعية وطاقة الرياح، ومزارعه الضخمة، ومراكزه التجارية الفخمة، وقصوره الفاخرة، المغرب نموذجًا للنجاح والتنمية. لكن وراء الواجهة الساحلية يكمن الفقر، ومعدل أمية يبلغ 30%، ومدارس متداعية، وطرق غير سالكة، وأحياء فقيرة، كما يتضح من زلزال سبتمبر 2023.
تنتشر هذه التفاوتات والفقر في جميع أنحاء المغرب العربي. ولإغراق السوق الأوروبية بالفواكه والخضراوات، استولت قلة من العائلات المغربية والتونسية الثرية على أفضل الأراضي و85% من المياه، بينما تعاني الأرياف من الجفاف.
اليوم، من الرباط إلى تونس إلى الجزائر العاصمة، يتعرض العمال لاعتداءات من أصحاب العمل الذين يستغلون البطالة لفرض ظروف عمل مزرية. على سبيل المثال، في طنجة بالمغرب، الغالبية العظمى من العاملات البالغ عددهن 55 ألف عاملة في 417 مصنعًا للنسيج غير مسجلات. في 8 فبراير/شباط 2021، إثر فيضانات، غرقت 20 عاملة و8 عمال في مصنع تحت الأرض. لم يُستجوب صاحب العمل قط، وتعرضت عائلات الضحايا، التي طالبت بالعدالة، للترهيب من قبل الشرطة. في العام الماضي، في بومرداس بالجزائر، لم يُفتح أي تحقيق عندما احترقت 12 عاملة في مصنع للولاعات حتى الموت إثر انفجار خزان غاز.
يعاني هؤلاء العمال، الذين يستغلهم أصحاب العمل المحليون أو الأجانب، من ظروف عمل ومعيشة متشابهة للغاية في مختلف أنحاء المغرب العربي.
يواجهون نفس الأجور المتدنية، والتضخم، والمراقبة المستمرة، واندماج النقابات في الأنظمة الحاكمة. وقد ثار كلاهما مرارًا وتكرارًا في السنوات الأخيرة، مواجهين القمع بشجاعة ومكافحين ما أسموه "النظام".
ولكن "النظام" الذي يضطهدهم والذي يجب عليهم الإطاحة به ليس فقط جهاز الدولة، والشرطة والجيش الذي يتصلب في كل من هذه البلدان، بتواطؤ من الدولة الفرنسية.إن النظام الذي يستغلهم هو الرأسمالية، التي أخضعت الكوكب بأكمله لسيطرتها، وحولته إلى كيان اقتصادي واحد ووحدت جميع العمال في مصير مشترك.إن الروابط التي تجمع عمال المغرب العربي، على ضفتي المتوسط، ليست مجرد روابط عائلية أو روابط نسجها تاريخ مشترك طويل. فهؤلاء العمال مرتبطون بسلسلة الاستغلال نفسها، ويثرون نفس الطبقة البرجوازية.إلى البرجوازية الفرنسية القديمة، بويج، وبيجو، وأرنو وشركاه، انضم عدد قليل من البرجوازيين المغاربة والجزائريين والتونسيين الذين كانوا الرابحين الكبار من الاستقلال.
• مأزق التنمية الوطنية
بعد مرور ستين عاما على الاستقلال، تعلمت الطبقات المضطهدة في المغرب العربي بمرارة أن نهاية القمع الاستعماري لا تعني نهاية الفقر.
لقد أنشأ القادة الوطنيون دولًا صاغت نفسها وفق الهياكل الموروثة من حقبة إنهاء الاستعمار، وأصبحت ضامنةً للنظام الإمبريالي. محمد السادس، وتبون، وقيس سعيد، جميعهم يعملون كحراس حدود للاتحاد الأوروبي. يُصدّون بوحشية المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى الساعين للوصول إلى أوروبا.
أما فيما يتعلق بدور المساعد للنظام الإمبريالي في منطقة الساحل، والذي احتلته الجزائر منذ فترة طويلة في مواجهة الميليشيات الجهادية إلى حد ما، فقد نسبت الولايات المتحدة وفرنسا هذا الدور للتو إلى المغرب.
لقد قام الزعماء القوميون بتقديس الحدود الموروثة من الاستعمار، ففصلوا الشعوب وأعاقوا حركتها.قُدِّم إنشاء دول منفصلة، لكل منها أنشودتها وأعلامها، لشعوب المغرب العربي على أنه السبيل الوحيد لتحرير نفسها، بينما هو في الواقع يُفرِّقها ويُؤجِّجها في صراعها. واليوم، تُشكِّل الحدود، بجدرانها الرملية وأسلاكها الشائكة، قضبان سجن تُستغل فيه الطبقات المُضطهدة استغلالاً مُضاعفاً.في حين أن أحداً لا يندم على النظام الاستعماري ووحشيته ونهبه وعنصريته وإذلاله، فإنه لا يمكن أن يكون هناك تحرر طالما استمرت الهيمنة الإمبريالية في جميع أنحاء الكوكب.كم عدد الشعوب التي ناضلت بشدة من أجل استقلالها، في أفريقيا أو آسيا أو في أي مكان آخر، واجهت هذه التجربة الصعبة؟
في المغرب العربي، حيث تُفاقم قضية الصحراء الغربية التوترات، ما هو مستقبل الشعب الصحراوي؟ هل سيعتمد على إسبانيا أو المغرب، أم سيُنشئ دولة صغيرة هشة؟ كلا الخيارين لا يُقدم أي منظور حقيقي.
بالطبع، ليس للدول المجاورة القوية، ولا للقوى الإمبريالية الطامعة في ثروات باطنها، أن تقرر مستقبل الصحراء الغربية. بل للشعب الصحراوي وحده أن يقرر مصيره! لكن المستقبل لا يمكن أن يكون في ظل نظام مغاربي أو جزائري يضطهد شعبيهما. المستقبل يكمن في اتحاد أخوي يجمع جميع الطبقات المظلومة في المغرب العربي!.
• الصراع الطبقي ضد مأزق "الديجاجيسم"
شهدت دول المغرب العربي، قبل الاستقلال وبعده، صراعاتٍ مستمرة، اتخذت أحيانًا شكل انفجارات اجتماعية حقيقية، طويلة الأمد وحاسمة. لكنها في كل مكان اصطدمت بنفس العائق. لا شك أن الانتفاضات ستتكرر، من أقاصي المغرب العربي إلى أقاصيه، بل وحتى في بقية العالم العربي. لا يسعنا إلا أن نتشاطر الغضب الذي يُحرك العمال والجماهير الشعبية بين الحين والآخر في تونس والجزائر والمغرب.لكن السؤال الذي يُطرح عليهم، والذي يجب أن نسأله لأنفسنا معهم، هو السؤال المتعلق بالوجهات السياسية.
تبدأ جميع الانتفاضات الشعبية بثورات ناجمة عن انتهاكات وظلم النظام الاقتصادي والسياسي. كان هذا هو الحال بالنسبة لانتحار محمد البوعزيزي في تونس عام ٢٠١٠، ووفاة بائع سمك شاب سحقًا في حاوية قمامة في المغرب عام ٢٠١٦. لكن يجب أن تجد هذه الانفجارات الغاضبة مخرجًا. لقد تصرف العمال والمستغَلّون الذين كانوا في طليعة هذه الحركات دون وعي بقوتهم ومصالحهم كطبقة مميزة. ومع ذلك، هناك عدد لا حصر له من القوى السياسية المستعدة لاستغلال هذه الحركات وتوجيهها، وفي النهاية دفعها إلى طريق مسدود. يتراوح هذا من أشكال مختلفة من الديماغوجيين الإسلاميين إلى الجنرالات، بمن فيهم سياسيون بارعون في استعادة المظاهر الديمقراطية للحفاظ على النظام.إن السياسة التي تكتفي بقول "اغربوا عن وجهكم" للسياسيين الحاليين لا تكفي. فعندما "يغرب" سياسي واحد، يخرج عشرة آخرون من جحورهم ليحلوا محله. يجب أن تُسهم الطاقة المبذولة خلال هذه الحركات حقًا في اتخاذ خطوة نحو الثورة. نحو ثورة تهاجم النظام الرأسمالي نفسه والإمبريالية.
• وهذا هو الدور التاريخي الذي يقع على عاتق الطبقة العاملة.
يدور الصراع الطبقي بين البروليتاريا والبرجوازية على نطاق عالمي. وعلى هذا النطاق فقط يُمكن خوض غمار الرأسمالية، لأنه وحده يُتيح تنظيمًا اقتصاديًا أرقى. وعلى الصعيد الدولي فقط يُمكننا مواجهة التحديات التي تواجه البشرية، في المغرب العربي كما في أي مكان آخر! لذلك، وبعيدًا عن الحدود الفاصلة، من الضروري أن ينجح عمال مختلف البلدان، خلال هذه الحركات، في تعزيز وعيهم الطبقي والاقتراب من برنامج الثورة البروليتارية، برنامج الثورة الاشتراكية العالمية.عاجلاً أم آجلاً، على العمال أن يتبنوا هذا البرنامج، لأن ثورات وحركات أخرى ستحدث لا محالة. ما ينقصنا أكثر هو رجال ونساء ونشطاء وأحزاب، سيدافعون خلال هذه الثورات، في المغرب العربي وهنا في فرنسا وأوروبا، عن هذا البرنامج، وهو الوحيد القادر على إعطاء منظور حقيقي لنضالات الطبقات المستغلة.
________
ملاحظة المترجم:
1.المصدر: دائرة ليون تروتسكي عددرقم( 181)يونيه-حزيران2025.التى يصدرها الاتحادالشيوعى الأممى.فرنسا.
2.رابط الكراس:
https://www.lutte-ouvriere.org/clt/maghreb-les-peuples-face-a-limperialisme-et-a-leurs-propres---dir--igeants.html#lo-sommaire-1.1
3.رابط فيديو عروض تقديمية مقدمة من (دائرة ليون تروتسكي) شعوب المغرب في مواجهة الإمبريالية الفرنسية وقادتها (نقاش):
https://www.lutte-ouvriere.org/portail/multimedia/cercle-leon-trotsky-peuples-maghreb-face-limperialisme-francais-propres---dir--igeants-184190.html
4.الرابط الرئيسى ل دائرة ليون تروتسكى:
https://www.lutte-ouvriere.org/clt/index.html
5.-كفرالدوار10اغسطس-اب2025.
#عبدالرؤوف_بطيخ (هاشتاغ)



ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

|
حفظ
 |
بحث |
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
| إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
إعادة إصدار كتاب (رأس المال) لكارل ماركس.مجلة (الصراع الطبقى
...
-
أوكرانيا: البنوك الفرنسية تستفيد من الحرب.بقلم سيسيل سيريج.ف
...
-
كراسات شيوعية(الحرب التجارية واقتصاد الحرب:تعبيرعن تصاعد الت
...
-
قراءات ماركسية عن: سياسة (ترامب والحرب التجارية والاقتصاد ال
...
-
إفتتاحية جريدة النضال العمالى ( لنستعد للقتال للدفاع عن حقنا
...
-
مقال (الاستجواب الدائم لكورنيليوس كاستورياديس) بقلم: خوان ما
...
-
جبرا نيقولا وتوجه اليسار الراديكالي(التروتسكى) فى فلسطين[2].
...
-
جبرا نيقولا وتوجه اليسار الراديكالي(التروتسكى) فى فلسطين[2].
...
-
جبرا نيقولا وتوجه اليسار الراديكالي(التروتسكى) فى فلسطين. بق
...
-
نص سيريالى بعنوان(رجل القوس من كفرالدوار) عبدالرؤوف بطيخ.مصر
...
-
أعلام شيوعية فلسطينية(جبرا نقولا)استراتيجية تروتسكية لفلسطين
...
-
وثائق شيوعية: رسالةأدولف جوفي إلى ليون تروتسكي .كتبت في 16 ن
...
-
مقال(أندريه نين. لم يتم دفنه) مزيد من المعلومات والبيانات ال
...
-
مقال (بييربرويه) وأسماء مستعارة: بيير سكالي، فرانسوا مانويل،
...
-
مقال(تحية لبيير برويه، المؤرخ والناشط والرفيق)بقلم: لويس جيل
...
-
نص سيريالى بعنوان (مع ذلك ,كان دائمًا هنالك شيئًا ما ) عبدال
...
-
نص سيريالى بعنوان (مداعبات تيريزا أفيلا) عبدالرؤوف بطيخ.مصر.
-
نص(بالتأكيد تغير كل شيء)
-
حملات تضامنية (بيان تضامن للتوقيع:الثقافة هى خط الدفاع الأول
...
-
حملات تضامنية(بيان تضامن للتوقيع:الثقافة هى خط الدفاع الأول
...
المزيد.....
-
تصريح حزب التقدم والاشتراكية حول تطورات القانون المتعلق بالم
...
-
مجلس ترامب: واجهة إمبريالية لشرعنة احتلال غزة؛ النظام المغرب
...
-
انسحاب ترمب من -الصحة العالمية- يدفع ملايين الفقراء بالعالم
...
-
The Sun Sets on the Syrian Kurdish Rebellion
-
The Destruction of UNRWA Is a Warning to Indonesia: The Two-
...
-
ب?وخ? تير?ري ئيسلامي سياسي، پ?لاماري س?ربازي و ک?م??کوژي ل?
...
-
ليبيا: -ماكرو الحشرات-.. معرض يكشف الجمال الخفي ودور الحشرات
...
-
من التعبئة الجماهيرية إلى صناعة الكراهية: كيف أُعيدَ توجيه ا
...
-
سيرة لينين
-
رواية 1984 كتبها اشتراكي
المزيد.....
-
الرأسمالية والاستبداد في فنزويلا مادورو
/ غابرييل هيتلاند
-
فنزويلا، استراتيجية الأمن القومي الأميركية، وأزمة الدولة الم
...
/ مايكل جون-هوبكنز
-
نظريّة و ممارسة التخطيط الماوي : دفاعا عن إشتراكيّة فعّالة و
...
/ شادي الشماوي
-
روزا لوكسمبورغ: حول الحرية والديمقراطية الطبقية
/ إلين آغرسكوف
-
بين قيم اليسار ومنهجية الرأسمالية، مقترحات لتجديد وتوحيد الي
...
/ رزكار عقراوي
-
الاشتراكية بين الأمس واليوم: مشروع حضاري لإعادة إنتاج الإنسا
...
/ رياض الشرايطي
-
التبادل مظهر إقتصادي يربط الإنتاج بالإستهلاك – الفصل التاسع
...
/ شادي الشماوي
-
الإقتصاد في النفقات مبدأ هام في الإقتصاد الإشتراكيّ – الفصل
...
/ شادي الشماوي
-
الاقتصاد الإشتراكي إقتصاد مخطّط – الفصل السادس من كتاب - الإ
...
/ شادي الشماوي
-
في تطوير الإقتصاد الوطنيّ يجب أن نعوّل على الفلاحة كأساس و ا
...
/ شادي الشماوي
المزيد.....
|
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

 |
بحث
|
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
|
إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة