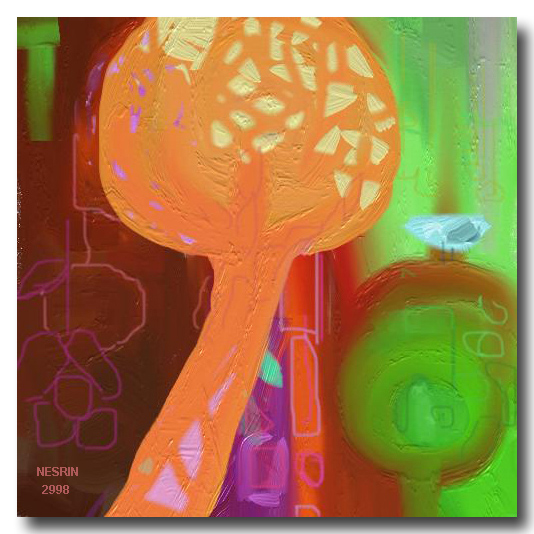|
|
السّرياليّة والسّرياليّة الثوريّة. من الحلم إلى التمرّد: في معنى تحرير اللاوعي والواقع.
رياض الشرايطي


الحوار المتمدن-العدد: 8509 - 2025 / 10 / 28 - 16:15
المحور:
الادب والفن
المقدّمة: حين يصبح الحلم ساحة سياسيّة.
في قلب القرن العشرين، وبينما كان العالم يئنّ تحت وطأة حروب مدمّرة، وسلطة رأسمالية ناشئة، وهياكل اجتماعية تفرض حدودها على الفرد والمجتمع، بزغت السريالية كحركة ثورية، ليس في الفن وحده، بل في الفكر والوعي والخيال. السريالية لم تكن مجرد تيار أدبي أو أسلوبي، بل مشروعا فلسفيا متكاملا لتفكيك الواقع القمعي، وكشف اللاوعي الذي تحتله السلطة، ومقاومة الهيمنة الثقافية والسياسية التي تحاصر الحرية الإنسانية في أطر جامدة. إنها، قبل كل شيء، صوت للإنسان المضطهد، خطاب للخيال المسلوب، وقوة لتجاوز الواقع السائد.
لقد ولدت السريالية من رحم الصدمة: صدمة الحرب العالمية الأولى، وصدمات التحولات الصناعية والاجتماعية، وصدمات العقل المنضبط والمفاهيم الجاهزة التي حاولت تحويل الإنسان إلى وظيفة أو رقم في آلة الإنتاج. في هذا السياق، جاء أندريه بريتون ورفاقه ليعيدوا التفكير في كل شيء: في اللغة، في الرغبة، في الفن، في الحب، في الموت، في الحلم ذاته. لقد فهموا أن الثورة الحقيقية لا تبدأ على الأرض المادية وحدها، بل في المخيّلة واللغة والوعي. فالتحرر من الظلم الاجتماعي والسياسي يبدأ بالتحرر من اللغة المهيمنة، من الفكر الرسمي، ومن القوالب الذهنية التي تكبت الخيال.
السريالية الثورية، إذن، ليست رفضا للعقلانية بقدر ما هي رفض للعقلانية التي تقيد الإنسان وتجعله خاضا للسلطة. إنها دعوة لإطلاق العقل والخيال معا، لخلق لغة جديدة للفكر الحر، ولتجربة إنسانية تعيد بناء الواقع من الداخل. وفي هذا المعنى، تصبح السريالية الثورية مشروعا مستمرا للتحرير الشخصي والجماعي، وللكشف عن الحقيقة الكامنة في اللاوعي، ولإعادة اكتشاف قدرة الإنسان على الإبداع والتغيير.
وليس أدل على ذلك من الممارسات الشعرية والفنية التي أرادها السرياليون: الكتابة الآلية، الحلم اليقظ، التلاعب بالرموز، تصوير الواقع من منظور اللاوعي، واستخدام المصادفات والإيهام والتنافر لخلق معنى جديد لا يخضع للسلطة. ومن هنا، تتلاقى السريالية مع الماركسية في نقدها للهيمنة الطبقية، ومع الفلسفة الوجودية في حرصها على إعادة الإنسان إلى ذاته، ومع علم النفس في كشفها عن قوى اللاوعي الدفينة.
في الوطن العربي، دخلت السريالية في صلب التجارب الأدبية والفنية منذ منتصف القرن العشرين، على يد شعراء مثل أدونيس وأنسي الحاج ومحمود درويش. هؤلاء الشعراء استخدموا أدوات السريالية كوسائل لتحرير اللغة، لتفكيك الرموز التقليدية، لإعادة بناء الوعي الجمعي، ولخلق مساحات للخيال الحرّ الذي يرفض القمع السياسي والاجتماعي. وهكذا، صارت السريالية الثورية العربية امتدادا طبيعيا للحركة العالمية، لكنها اكتسبت بعدا محليا يعكس الصراعات الطبقية والسياسية والثقافية الخاصة بالمجتمع العربي.
بمعنى آخر، السريالية الثورية ليست مجرد مدرسة فنية، ولا مجرد حركة ثقافية، بل مشروع وجودي وفكري شامل يسعى إلى تحرير الإنسان من كل أشكال القيد: المادي، النفسي، الرمزي، الاجتماعي والسياسي. إنها دعوة مستمرة لإعادة اكتشاف الإنسان في حريته الكاملة، وفي خياله الذي لم يُسلب بعد، وفي حبه للحياة كما ينبغي أن تكون: تجربة جمالية وثورية، متحدية للسلطة، وناهضة بالوعي الجمعي، ومفتوحة على المستقبل الذي يصنعه الإنسان بنفسه.
1 — جذور السّرياليّة: من دمار الحرب إلى دمار المعنى.
أ — اللحظة التاريخيّة للانفجار:
ولدت السّرياليّة في رحم القرن العشرين الجريح.
كانت الحرب العالمية الأولى (1914–1918) قد كشفت عن الوجه الحقيقيّ للعقل الغربيّ الذي طالما تباهى بالتقدّم والأنوار.
العقل الذي أنجب نيوتن وديكارت وهايدنبرغ هو نفسه الذي أنجب المدافع والغازات السامة ومعسكرات الإبادة.
لقد تهاوى الإيمان بـ«العقل» كمنقذ، وتحوّل إلى «آلة للسيطرة».
وهكذا وُلدت السّرياليّة كـثورة ضدّ ديكتاتورية العقل.
لقد سبقتها حركة الدادائيّة، التي فجّرت كلّ القيم الفنية والأخلاقية في وجه أوروبا ما بعد الحرب.
لكن السّرياليّة ذهبت أبعد من ذلك: أرادت أن تستثمر الفوضى في بناءٍ جديد، أن تجعل من الجنون منهجا للمعرفة، ومن اللاوعي محرّكا للفعل.
ففي باريس 1924، أعلن أندريه بروتون «البيان السريالي الأول»، الذي كان بمثابة بيان سياسيّ أيضا، إذ دعا فيه إلى ثورة على كلّ القيم البرجوازية، وعلى فكرة الفن النخبويّ المنعزل عن الحياة.
كتب بروتون:
«إنّ أسمى رغباتنا هي أن نجعل الواقع والحلم لا ينفصلان.»
كان ذلك تحدّيا مباشرا للعقلانية الرأسمالية التي تفصل بين الجدّ واللعب، بين العمل والرغبة، بين الإنتاج والخيال.
فالسّرياليّ يرفض هذه الفواصل جميعها، ويريد أن يعيش العالم ككلّ عضويّ يتدفّق فيه الوعي واللاوعي معًا.
ب — التحالف بين فرويد وماركس:
في عمقها، كانت السّرياليّة ابنة لقاء فلسفيّ بين التحليل النفسيّ الفرويديّ والتحليل الماديّ الماركسيّ.
من فرويد أخذت الإيمان بقدرة اللاوعي على إنتاج المعنى واللغة والرمز.
ومن ماركس أخذت الإيمان بقدرة التغيير الاجتماعي على تحرير الإنسان من القهر الماديّ.
وهكذا، ولدت فكرة التحرّر المزدوج: تحرير اللاوعي من القمع النفسيّ، وتحرير الإنسان من القمع الاجتماعيّ.
كان الحلم بالنسبة للسّرياليين ساحة سياسية، مثلما كانت الثورة بالنسبة للماركسيين حلما جماعيا.
ومن هنا ظهرت العلاقة الجدلية بين السّريالية والماركسية: الأولى تبحث عن الحرية في الداخل، والثانية في الخارج، لكنّهما تلتقيان في الهدف نفسه ، الإنسان الكامل، الإنسان الذي لا يخضع لا لسلطة داخلية ولا خارجية.
قال بول إيلوار، أحد أبرز شعراء الحركة:
«الحرية ليست كلمة، بل حالة من الوعي.»
ج — ضدّ البرجوازيّة والأخلاق الكاذبة:
لم يكن السّرياليّ فنانا هائما في الخيال، بل متمرّدا على الواقع الاجتماعيّ والسياسيّ الذي ينتج القبح الأخلاقي.
رأى بروتون وإيلوار وأراغون في الأخلاق البرجوازية «أخلاق الخوف والملكية»، التي تجعل الإنسان عبدا للقواعد والتقاليد والربح.
لذلك، لم تكن السّرياليّة مجرّد أسلوب في الفن، بل مشروعا أخلاقيا مضادا.
أرادت أن تعيد تعريف الخير والشرّ، الجميل والقبيح، العقل والجنون، وفق منطق إنسانيّ حرّ.
في هذا السياق، يمكن القول إنّ السّرياليّة هي أول حركة فنية أعلنت الحرب على «النظام الرمزيّ» نفسه، لا على السلطة المادية فقط.
فهي تدرك أنّ النظام لا يحكمنا فقط بالقوانين، بل بالأحلام أيضًا ، بالأفكار المسبقة، بالصور، بالمخيّلات.
ومن هنا، فإنّ الثورة الحقيقية تبدأ من الخيال، لأنّ من يملك خيالك يملك مستقبلك.
2 — أدوات السّرياليّة: تقنيات تفجير اللغة والعقل.
السّرياليّة ليست تنظيرا فلسفيا فحسب، بل ممارسة فنية دقيقة.
لقد طوّر بروتون ورفاقه ما يمكن تسميته بـتقنيات التحرّر، وهي أدوات تهدف إلى زعزعة النظام الداخلي للغة والوعي.
كلّ تقنية فيها تحمل بذرة العصيان على منطق السيطرة.
أ — الكتابة التلقائية: حين يكتب اللاوعي نفسه:
في «الكتابة التلقائية» لا يخطّ الكاتب ما يفكّر فيه، بل ما يتدفّق منه دون رقابة.
اللّغة هنا تتحرّر من سلطة «العقل الواعي» لتصبح مرآة مباشرة للذات العميقة.
هذه التقنية لم تكن مجرّد أسلوب بل تمرينا في التحرّر النفسيّ؛ لأنّها تهدم جدار الرقابة الذي بناه المجتمع داخل كلّ فرد.
بهذا المعنى، الكتابة التلقائية ليست نشاطا أدبيا فقط، بل ممارسة سياسية ضدّ القمع الداخلي.
كتب بروتون:
«اكتب بسرعة دون موضوع، دون وعيٍ مسبق، لأنّ الصدفة وحدها هي التي تكتب الحقيقة.»
هذه الجملة تختصر فلسفة السريالية: الإيمان بأنّ الصدفة والعفوية واللاوعي قوى تحرّرية، لا فوضى يجب ضبطها.
ب — الحلم: مختبر الثورة الرمزية:
الحلم، في منظور السرياليين، ليس بديلا عن الواقع بل تكثيف له.
هو المسرح الذي تتكثّف فيه الرغبات والمخاوف والتمزّقات التي يفرضها النظام الاجتماعيّ.
ولذلك، فإنّ تحليل الأحلام لم يكن عندهم نشاطا نفسانيا فحسب، بل وسيلة لفهم القمع الرمزيّ الذي نعيشه في اليقظة.
كانوا يرون أنّ في كلّ حلم، مهما بدا عبثيا، بذرة مقاومة، لأنّه يكشف ما يريد الواقع أن يخفيه.
ج — التصادم والصورة الصادمة:
من أدوات السريالية أيضا تقنية «التصادم» (juxtaposition): وضع صورتين أو فكرتين لا رابط منطقيّ بينهما في جملة واحدة أو في مشهد واحد، لإنتاج أثر من الدهشة والتنوير.
بهذا التصادم تفتح ثغرات في اللغة والعقل، يدخل منها النور.
لقد شبّه بروتون هذا الأثر بما يحدث حين «يتلامس حجران كهربائيّان»، فتنبثق شرارة المعنى.
كتب الشاعر لوتريامون (أحد آباء السرياليين الروحيين):
«جميل كصدفة لقاء آلة خياطة ومظلّة على طاولة تشريح.»
(هذه الجملة كانت بمثابة نشيد للسرياليين، لأنها تختصر مبدأ المفاجأة.)
د — الكولاج والمونتاج: تفكيك العالم وإعادة تركيبه:
في الفن التشكيلي والسينما، استخدم السرياليون تقنية الكولاج والمونتاج لتفكيك الواقع المرئي وإعادة تركيبه في صور غير متوقعة.
هكذا تصبح اللوحة أو الفيلم مساحة لتوليد المعنى من خلال الانقطاع لا الاستمرار، من خلال المفارقة لا الانسجام.
وهذه التقنية في جوهرها ثورة على منطق الإنتاج الرأسماليّ الذي يقوم على التكرار والتنميط؛ إذ تجعل من الصورة حدثا مفتوحا على كلّ تأويل.
هـ — الصدمة الجمالية: هزّ المتلقّي ليصحو:
كلّ هذه الأدوات تلتقي في هدف واحد: إحداث الصدمة.
فالصدمة ليست للزينة، بل لإيقاظ الوعي.
هي نوع من «التحريض الجماليّ» الذي يجعل المشاهد أو القارئ يخرج من منطقة الراحة، ليكتشف أنّ ما اعتاد تسميته «واقعا» هو بناء هشّ من الرموز القابلة للتحطيم.
بهذا المعنى، السّرياليّة ليست فنّا للتأمل، بل فنّا للانفجار.
3. التقاء السريالية بالماركسية: نحو وحدة الحلم والتحرر.
إنّ اقتراب السرياليين من الماركسية
كان نتيجة منطقية لتطوّر وعيهم بالفن والإنسان والتاريخ. فمنذ البداية، لم تكن السريالية مشروعا فنيا صرفا، بل موقفا شاملا من الوجود. أراد بروتون ورفاقه أن يعيدوا للإنسان قدرته على الحلم، على أن يعيش بصدقٍ ما يفكر فيه، وأن يخضع الواقع لمقاييس الرغبة لا لمقاييس السوق أو الدين أو الأخلاق البرجوازية.
لكن سرعان ما أدركوا أنّ الحلم وحده، إن لم يجد سندا ماديا في بنية المجتمع، سيبقى حبيس المخيلة. عندها ولد السؤال الحاسم: كيف نحرّر الحلم من قيود الاقتصاد والسياسة؟ كيف يتحقق اللاوعي في التاريخ؟
من هنا بدأ الحوار العميق بين السريالية والماركسية، بين الشعر والثورة، بين الحلم والتحليل المادي للتاريخ. رأى السرياليون في الماركسية وسيلة لتحرير الخارج كما رأوا في السريالية وسيلة لتحرير الداخل، وفي هذا التقاطع تشكّلت فكرة "السريالية الثورية".
كتب أندريه بروتون في بيانه الثاني (1930):
"إننا لا نرى تعارضا بين النشاط الثوري والنشاط السريالي. على العكس، نحن نرى أن السريالية تمهّد الأرضية النفسية التي تسبق الثورة الاجتماعية، وأن الثورة الاجتماعية هي التي تفتح الطريق أمام تحقق السريالية الكامل."
كانت تلك لحظة حاسمة: السريالية لم تعد تبحث عن الجمال، بل عن التحرّر الشامل للإنسان. أرادت أن توحّد بين الثورة الداخلية (في الوعي) والثورة الخارجية (في المجتمع). فكما قال الشاعر بول إيلوار:
"الثورة ليست فقط ما يحدث في الشارع، بل ما يحدث في القلب أيضا."
في الثلاثينات، حاول بروتون أن يربط السريالية بالحركة الشيوعية الفرنسية. شارك السرياليون في الاجتماعات والبيانات السياسية، ودافعوا عن الثورة الإسبانية، ووقفوا إلى جانب المضطهدين في المستعمرات. إلا أنّ العلاقة بين السرياليين والحزب الشيوعي لم تخل من توتر. فالحزب رأى فيهم جماعة برجوازية طوباوية، منشغلة بالأحلام والرموز بدل النضال الطبقي المباشر.
لكن السرياليين، من جانبهم، رفضوا الخضوع لأي وصاية سياسية أو فكرية. قال بروتون بوضوح:
"نحن لا نريد أن نكون شعراء الحزب، بل أن نكون الشعراء ضدّ كل حزب، ما دام الحزب يسجن الحرية باسم الثورة."
هذا التناقض لم يكن سطحيا، بل كشف عن صراعٍ فلسفي حول مفهوم الحرية ذاته:
بالنسبة للماركسية الكلاسيكية، الحرية هي نتاج التحرر من علاقات الإنتاج الرأسمالية.
أما بالنسبة للسريالية، فالحرية تبدأ من تحرير المخيلة والرغبة، أي من كسر الرقابة التي تفرضها السلطة واللغة والعادات.
لقد فهم بروتون وتروتسكي ، رغم اختلاف تجربتيهما ، أن الثورة الاجتماعية إذا لم ترافقها ثورة في المخيلة والرمز، فإنها ستعيد إنتاج القمع بأشكال جديدة. في بيانهم المشترك "نحو فنّ ثوري مستقل" (1938)، كتبا:
"لا يمكن للفن أن يكون خادما لأي سلطة، حتى وإن كانت سلطة الثورة ذاتها. إنّ الفن الثوري هو الذي يحرّر الإنسان من الداخل، كما تحرّره الثورة من الخارج."
بهذه الروح، تحوّلت السريالية إلى جناح رمزي من أجنحة الثورة، وإلى مختبر لتجريب وعي جديد بالعالم، يرى في الحلم والطبيعة والجنون والأيروس واللاوعي أدوات لكسر الاستلاب الذي ينتجه النظام الرأسمالي.
هكذا، أصبح السريالي هو الماركسي الحالم، الذي يعي أن الثورة لا تكتمل إلا حين تتحرّر الرغبة كما يتحرّر العامل.
في هذا السياق، يمكن القول إن السريالية الثورية كانت محاولة فريدة للجمع بين التحليل المادي للتاريخ والتحليل النفسي للذات. فهي ترى أن تحرير الطبقة العاملة من الاستغلال لا ينفصل عن تحرير الإنسان من عقده، من كوابيسه التي تنتجها الثقافة البرجوازية والدين والخوف.
ولهذا كتب بروتون في نصّه "الجنون والحرية":
"لا يمكن أن نحرّر الإنسان من الفقر دون أن نحرّره من الخوف."
4. ضدّ الواقعية الاشتراكية: الفن الثوري لا يملى عليه.
حين فرض الحزب الشيوعي السوفييتي في الثلاثينات ما سمّاه بـ"الواقعية الاشتراكية"، كانت تلك ضربة قوية لفكرة الفن الحرّ. فبدل أن يكون الفن ساحة للتجريب، صار وسيلة للدعاية السياسية. أُريد من الفنان أن يصبح موظفا في جهاز الدولة، يرسم العمال والفلاحين بابتسامات مصطنعة، وينتج نصوصا تمجّد الزعيم والحزب، وتخلو من أي تعقيد نفسي أو خيال رمزي.
كانت الواقعية الاشتراكية، كما وصفها جورج لوكاش، "فنّا يعكس الواقع الموضوعي في تطوره الثوري". لكن السرياليين رأوا في هذا "الانعكاس" نوعا من القمع الجمالي والفكري، لأن الواقع ليس موضوعا خارجيا فقط، بل هو أيضا ما يسكن اللاوعي.
ردّ بروتون على هذه الموجة بقوله الشهير:
"من العبث أن نطلب من الفن أن يكون أداة دعاية، لأن الفن هو دعاية الحياة نفسها، لا برنامجها."
بينما كتب تروتسكي في البيان ذاته مع بروتون:
"الثورة لا تفرض على الفنان أسلوبا. فالإبداع لا يولد بالأوامر، بل بالحرية."
بهذا الموقف، أعلنت السريالية الثورية تمرّدها لا على البرجوازية وحدها، بل أيضا على السلطة الثورية حين تتحول إلى بيروقراطية. كانت تقول: ليست كل ثورة ثورية، فحين تضع الثورة يدها على الفن، تموت الروح.
لقد فهم السرياليون أن أخطر ما يمكن أن يحدث للفن الثوري هو أن يتحوّل إلى فنّ رسمي، لأنّ السلطة ، أي سلطة ، تحوّل الجمال إلى شعارات.
من هنا جاء شعارهم الضمني:
"فلنحرّر الثورة من الدعاية، ولنحرّر الفن من الرقابة."
لقد آمنوا بأن الفن الثوري لا يقاس بموضوعاته بل بطريقته في رؤية العالم.
فلوحة لسلّم أو لظلّ يمكن أن تكون ثورية إذا كسرت منطق التمثيل، وفتحت الوعي على احتمالات جديدة للوجود.
أما القصيدة الثورية، فهي ليست التي تمجّد العمال، بل التي تحدث انفجارا في اللغة، تجعل القارئ يخرج من ذاته كما يخرج العامل من مصنعه.
لقد عرّى السرياليون في نقدهم للواقعية الاشتراكية تناقضا جوهريا في الفكر الثوري الرسمي:
أنّ التحرّر لا يمكن أن يفرض من فوق، وأنّ الانضباط الأيديولوجي لا ينتج سوى فنّ عقيم.
فالثورة، كي تبقى حيّة، تحتاج إلى شاعر مجنون أكثر مما تحتاج إلى وزير ثقافة.
لقد كانت السريالية الثورية تقول ضمنيا:
"التحرّر لا يتحقق عندما نغيّر الحكومة، بل عندما نغيّر طريقة الحلم."
وهذا بالضبط ما جعلها تواجه كلّ سلطة، من الكنيسة إلى الحزب إلى الدولة، وترى أن الفنان الثوري هو الذي يزعزع لا الذي يصفّق، وأن القصيدة لا تكون سلاحا إلا حين تكون غموضا يقاوم التبسيط.
5. السريالية الثورية كجماليات للمقاومة: حين يتحول الحلم إلى سلاح.
منذ ولادتها، كانت السريالية مشروعا للتحرر، لكنها حين امتزجت بالروح الثورية، تحولت إلى جماليات للمقاومة. أي إلى شكل من أشكال الصراع الرمزي ضد كلّ سلطة تحاول تدجين الوعي أو اختزاله في مقولات جاهزة عن "الواقع" و"العقل" و"المنفعة".
لقد أدرك السرياليون أنّ الهيمنة الرأسمالية لا تشتغل فقط على مستوى الاقتصاد والسياسة، بل أيضا على مستوى الرغبة والخيال واللغة. فالبرجوازية ، كما لاحظ ماركس ، لا تكتفي بالسيطرة على وسائل الإنتاج، بل تنتج أيضا الوعي المهيمن. والسريالية، بهذا المعنى، جاءت لتفجّر هذا الوعي من الداخل، لتفتح في جدار النظام ثغرة يدخل منها الحلم كقوّة ثورية مدمّرة.
لقد كانت السريالية الثورية تقول إنّ الحلم فعل سياسي، لأنّ من يحتكر الواقع يحتكر أيضا تعريف الممكن.
كتب بروتون في "البيان الثاني":
"ليس الواقع ما هو أمامنا، بل ما نقدر أن نحلم به."
بهذه العبارة، نسف الفاصل بين الواقعي والخيالي، بين الفنّ والسياسة، بين القصيدة والبيان، ليجعل من الحلم سلاحا ضدّ الواقع المفروض.
في هذا السياق، كانت الكتابة التلقائية، التي اشتهرت بها السريالية، أكثر من مجرد تقنية فنية. كانت تمرينا على الحرية، على قول ما لا يقال، على التحرر من رقابة الأنا العليا، ومن كلّ ما تمّ تلقينه منذ الطفولة من محرمات دينية وأخلاقية واجتماعية.
إنّها فعل مقاومة ضدّ السلطة التي تتسلّل إلى اللغة نفسها. فالكتابة عند بروتون أو أرتو أو ميشيل ليريس هي نوع من العصيان ضدّ اللغة المعلّبة التي تنتجها الصحف والكنائس والمدارس. هي تمرين على استعادة الصوت الأصلي للإنسان قبل أن يفسده النظام.
كتب أنطونان أرتو في نصّه "رسالة إلى مديري المصحات العقلية":
"إنهم يريدون شفائي من الجنون لأعود أداة طيّعة في أيديهم. أما أنا فأريد شفائي من العالم الذي جنّ حقا."
بهذه الصيغة المفارقة، أعاد أرتو تعريف الجنون كفعل وعي حقيقي في وجه الجنون الاجتماعي العام الذي يقدّس المال والسلطة والعقلانية القاتلة.
وهكذا، تحولت الهلوسة إلى موقف سياسي، واللاوعي إلى ساحة مقاومة. فبدل أن يكون الحلم ملاذا للهروب، صار سلاحا للهدم وإعادة التأسيس.
من هذا المنطلق، فالسريالية الثورية ليست دعوة للانسحاب من الواقع، بل دعوة لاختراقه عبر اللاوعي، لتفكيك رموزه من الداخل، كما يفكك الثائر جهاز الدولة من قلبه.
وفي لحظة تاريخية كانت أوروبا فيها تغرق في الفاشية، تحوّلت السريالية إلى ملجأ للإنسان الحرّ، الذي يرفض أن يختزل في الهويّة، أو الوطن، أو الدين، أو العرق. كانت تقول:
"لا وطن للشاعر إلا الحرية، ولا دين له إلا الحلم."
وهنا يكمن عمقها الثوري الحقيقي: فهي لم تسع إلى قلب الأنظمة فقط، بل إلى قلب الإنسان ذاته.
كانت تدرك أن كلّ ثورة سياسية لا تلامس البنية الرمزية للمجتمع ستهزم عاجلا أم آجلا.
إن لم نحرّر الحلم من سلطة الواقع، سنعود لنسجن أنفسنا في واقع جديد.
ومن هذا المنطلق، يمكن القول إن السريالية الثورية قدّمت ما يشبه الطبقة الرمزية للثورة: الثورة في المتخيَّل، في الصورة، في اللغة، في الجسد، في اللاوعي الجمعي.
هي ثورة تتجاوز الشارع والمصنع إلى المخيلة الاجتماعية نفسها، حيث تتجذر السلطة وتعيد إنتاج ذاتها.
لقد ألهمت هذه الروح السريالية العديد من الحركات الفنية والسياسية اللاحقة: من الوضعية الموقفية عند غي ديبور، إلى الموجة الطليعية في السينما والشعر والمسرح. كانت كلّها، بشكل ما، استمرارا لذلك الحلم الأول: أن يكون الفنّ ثورة دائمة.
وفي عبارة أرتو الشهيرة، التي تصلح شعارا للسريالية الثورية كلها:
"حين يتكلم الجسد، تسقط الأنظمة."
6. في السياق العربي والتونسي: السريالية بين التحرر والرقابة.
حين ننتقل إلى العالم العربي، نجد أن السريالية لم تقرأ ، في الغالب ، كحركة تحرر رمزي وفكري، بل كفعل لغويّ و انحراف عن "الالتزام الواقعي".
لقد تعامل النقّاد العرب طويلا مع السريالية كأداة شكلية، بوصفها أسلوبا غامضا أو تجريبا في الصور، دون فهم خلفيتها الفلسفية الثورية.
لكن إذا قرأناها من منظور يساري تحليلي، ندرك أن السريالية في الوطن العربي ليست مجرد تقليد للغرب، بل ضرورة وجودية وسياسية في وجه الأنظمة التي تحكم المخيلة قبل أن تحكم الجسد.
فالوطن العربي، الذي يعيش منذ قرونٍ تحت سلطة مزدوجة ، دينية وبيروقراطية ، لم يكن ينقصه الواقع ليتمرد عليه، بل كان ينقصه الخيال.
كانت السريالية، لو طُبقت بعمقٍ نقدي، يمكن أن تكون أداة لتحرير الفكر من الرقابة الداخلية التي يمارسها المقدّس والسياسي والاجتماعي.
لأن أخطر أنواع الرقابة، كما قال ميشيل فوكو، هي تلك التي تسكننا، لا تلك التي تُفرض علينا.
والسريالية هي في جوهرها مقاومة لهذه الرقابة المتجذرة في اللغة واللاشعور الجمعي.
في تونس مثلا، ظهرت بوادر سريالية مبكرة في بعض التجارب الشعرية والفنية، لكنها بقيت مترددة بين الشكل والجوهر.
يمكن أن نلمحها في بعض نصوص أبي القاسم الشابي، حين يتجاوز الرمزية إلى الحلم الكوني، كما في قوله:
"سأعيش رغم الداء والأعداء
كالنسر فوق القمة الشمّاء"
ذلك التمرّد الحلمي على الواقع، رغم كل القهر، هو في جوهره سرياليّ قبل أن يسمّى كذلك.
ثمّ ظهرت لاحقا تجارب أكثر نضجا، مثل شعر أنسي الحاج وأدونيس وصلاح عبد الصبور و آدم فتحي، الذين حملوا في لغتهم نزوعا إلى كسر النسق الواقعي، وتمجيد الحلم، وتمزيق اللغة التقليدية.
لكن رغم هذا، ظلّ الوعي السريالي في الوطن العربي أسيرا بين مطرقة الدين وسندان الأيديولوجيا.
فلم يستطع أن يتحوّل إلى مشروع تحرري جذري كما كان عند بروتون أو أرتو أو لوركا، لأنّ الثقافة العربية المعاصرة ، كما يشير المفكر المغربي عبد الكبير الخطيبي ، لم تحسم علاقتها مع اللاوعي بعد.
أي أنّنا لم نحرّر بعد اللغة من قدسيتها، ولا الحلم من وصايته، ولا الجسد من رقابته.
إنّ السريالية في السياق العربي يمكن أن تكون مشروعا ثوريا حقيقيا إذا أعيد فهمها يساريا:
باعتبارها سلاحا ضدّ الخطاب الأبوي، وضدّ الرأسمالية النيوليبرالية التي تحوّل الإنسان إلى سلعة، وضدّ الدولة التي تروّض المواطن كما تروّض اللغة.
كتب أدونيس:
"ليس في وسع الشعر أن يغيّر العالم، لكنه يستطيع أن يغيّر الوعي الذي يصنع العالم."
وهذا هو جوهر السريالية الثورية في تونس والوطن العربي اليوم: أن تغيّر وعينا بما نعتبره "طبيعيا"، أن تفكك المقدس والواقع واللغة، لتعيد الإنسان إلى ذاته الحرّة، غير المروّضة، غير المُمَثَّلة.
7. الحلم كأداة مادية للتحرّر من القهر اليومي.
لم يكن الحلم عند السرياليين مجرّد انزلاقٍ إلى اللاوعي أو لعبة لغوية مع المرآة الباطنية، بل كان سلاحا ضدّ الواقعي الكاذب، ضدّ النظام الذي يحتكر تعريف الممكن. الحلم في جوهره ليس نقيض الواقع، بل امتداده الحرّ حين يتحرّر من الاقتصاد السياسي للوعي. فحين يغفو العامل المرهق في مصنعه أو المرأة المنهكة في حقلها، فإنّ ما يطلّ من عينيها المغلقتين ليس الخيال الهارب بل حقيقة مؤجلة، صورة لعالم بلا سيّد ولا عبودية، تتسرّب من الشقوق الصغيرة في جدار النظام القائم.
في التصوّر السريالي الثوري، يصبح الحلم فضاء ماديا ، لا مجازيا ، لأنّه ينتج رغبة، والرغبة هي طاقة عمل اجتماعيّة. فماركس حين قال إنّ "الإنسان يصنع تاريخه ولكن لا كما يشاء"، كان يشير إلى أن الوعي المقهور لا يملك سوى الحلم كسلاحٍ أوّلي ضد الضرورة. أما السريالية فقد ذهبت أبعد: جعلت من الحلم أداة لتفجير الضرورة نفسها.
بريتون رأى في الحلم "ثورة مستمرة داخل الإنسان"، وجاك فيان علّمنا أن "الخيال هو المادة الخام للثورة"، بينما كتب أراغون في "الفلاح الباريسي" أنّ الشوارع نفسها تحلم. هذه ليست استعارات شعرية، بل هي إعلان أن اللاوعي نفسه له طابع طبقي: من يحلمون بالحرية هم الذين حرموا منها في الواقع، ومن يخافون أحلامهم هم الذين يملكون السلطة في اليقظة.
من هذا المنظور، يصبح الحلم مجالا للعمل السياسيّ، ليس لأنّه يقدّم برنامجا، بل لأنّه يزعزع شكل الوعي المفروض. فحين يحلم الشاعر و السارد بعالم لا سلطة فيه ولا حدود، فإنّ الرأسمالية ترتجف لأنّها تفقد احتكارها للخيال.
وهنا تلتقي السريالية الثورية مع الماركسية في أعمق نقطة: كلاهما يريد إلغاء الانقسام بين الضرورة والحرية. الأولى عبر الثورة المادية، والثانية عبر الثورة الرمزية، وكلاهما يؤمن أن الإنسان يجب أن يعيش ما يحلم به، لا أن يكتفي بتفسيره.
ولذلك، فالسريالية لا ترى في الحلم هروبا من العالم، بل تقدّما في اتجاه العالم الممكن، ذاك الذي تحمله الجماهير في أعماقها دون أن تدري، كما تحمل البذرة شجرتها المقبلة.
8. الشعر كتنظيم للغيب، وكعلم للمستحيل.
الشعر في السريالية الثورية علمُ المستحيل، هندسة ما لم يُبنَ بعد. فحين تكتب القصيدة، أنت لا تصف الواقع بل تخترقه، تفتح فيه فجوة يدخل منها الضوء. السريالية الثورية ترى الشعر كأداة مادية لتغيير الوعي الجمعي، لأن اللغة ، حين تتحرّر من السوق ومن النحو ومن السلطة ، تصبح آلة ثورية بامتياز.
إنّ الشعر السريالي لا يطلب من القارئ أن يفهم، بل أن يستيقظ. إنه يدعوه إلى الانفجار الداخلي، إلى إعادة بناء علاقته بالزمن، بالجسد، بالذاكرة. وفي هذه العملية، يصبح الشعر تنظيما للغيب: محاولة لترتيب الفوضى دون قتلها، ولإعطاء معنى للغرابة دون تدجينها. إنه تخطيط للحلم الجماعيّ، كأن القصيدة خارطة أولى لعالم آخر.
من هنا نفهم كيف تحوّل الشعر، في السريالية الثورية، إلى ممارسة سياسية موازية للكفاح المسلّح ، كلاهما يهدف إلى زعزعة البنى القائمة، إلى تحرير الإنسان من "اللغة القديمة" كما من "النظام القديم".
كان أندريه بروتون يقول: "الثورة لن تكون إلا شعرية، أو لن تكون". وهذا القول ليس شعارا جماليا بل برنامجا سياسيا خفيا: فالثورة لا تكتمل إذا لم تغيّر لغتنا ورؤيتنا للواقع. كلّ انتفاضة لا تولد لغتها الخاصة هي انتفاضة ناقصة، لأنّ الوعي الجديد لا يمكن أن يُعبّر بلسان القديم.
وهكذا، تصبح القصيدة في السريالية الثورية مختبرا للحرية: فيها نجرّب المستقبل، نختبر أشكال الحياة الممكنة قبل أن نعيشها. إنّها التجسيد الرمزي لما يسميه إرنست بلوخ "دفء الأمل": ذلك الأمل الماديّ الذي لا يتغذى من التمنّي، بل من الفعل التخييلي الذي يسبق الفعل الثوري.
الشعر هنا لا ينتمي إلى الأدب، بل إلى الاقتصاد الرمزي للثورة: إنه ينتج قيمة جديدة لا تقاس بالنقود ولا بالشهرة، بل بقدر ما يفتح من مساحات الحرية داخل الإنسان. وحين يكتب الشاعر من موقعه الطبقيّ، من داخل المعاناة اليومية، يصبح شعره جزء من الصراع الاجتماعي نفسه ، لا وصفا له.
إنّ السريالية الثورية تعيد للغة وظيفتها الأصلية: لا أن تقول ما هو، بل أن تجعل ما لم يكن ممكنا ممكنا. فالكلمة ليست إشارة، بل شرارة. ومن هنا تنبع خطورتها. ولذلك ظلّت السلطة، بكل أشكالها، تخاف الشعر الحرّ أكثر مما تخاف الرصاص، لأنّ الرصاصة تقتل جسدا، أما القصيدة فتُحيي شعبا.
9. جدلية الفنّ والثورة: من الصدمة الجمالية إلى الوعي الطبقي.
لم تكن السريالية، في جوهرها، مدرسة فنية بقدر ما كانت حركة لتفجير الوعي. لقد فهم بروتون، وإيلوار، وأراغون، وبونفوا وغيرهم أن الفنّ ، إن ظلّ في حدود الجماليات البورجوازية ، سيتحوّل إلى تجميل للقبح الاجتماعي. لذلك جاءت السريالية لتعلن العصيان: أن يكون الفنّ في قلب الثورة، وأن تكون الثورة في قلب الفنّ.
الفنّ، في تصوّرها الثوري، ليس مرآة تعكس الواقع بل مطرقة تحطّمه لتعيد تشكيله. إنّه صدمة للوعي، لحظة يعاد فيها توزيع المعنى، حيث يسحب الواقع من يد السلطة ليُعاد إلى الجماعة التي حرمته.
وهنا تكمن الجدلية الكبرى: الفنّ لا يحرّر ما لم يصطدم بالبنية الاقتصادية والاجتماعية التي تُنتجه.
فكما قال تروتسكي في كتابه الأدب والثورة:
"الثورة لا تحتاج إلى شعر مطيع، بل إلى شعر يخلق لغة جديدة للعالم الجديد."
وهذا بالضبط ما فعلته السريالية: خلقت لغة لا تنتمي إلى القاموس القديم، لا إلى القواعد، ولا إلى الإعلانات التجارية، بل إلى الانفجار الإنساني نفسه.
الفنّ السريالي الثوري يعمل كقنبلة رمزية، لا تنفجر في المتاحف بل في الوعي. إنّها لحظة يلتقي فيها اللاوعي الفردي بالوعي الطبقي، كما لو أن الحلم نفسه قرّر أن ينضمّ إلى الحزب الثوري.
ففي اللوحات السريالية ، كأعمال دالي، أو تانغي، أو إرنست ، نرى الواقع وقد تكسّر وانعكس في مرايا الزمن، بينما في الشعر السريالي نسمع اللغة وهي تحاول الإفلات من سلطة المعجم، كما يحاول الإنسان الإفلات من سلطة النظام.
هذه الجدلية بين الفن والثورة ليست تجميلا للماركسية، بل امتدادها في الحقل الرمزي. فماركس علّمنا أن التاريخ يتحرك عبر التناقضات، والسرياليون طبّقوا ذلك على الجمال نفسه: الجمال لا يولد إلا من الصراع، من الجرح، من اللايقين.
ولذلك لا وجود في السريالية لجمال محايد. الجمال إمّا أن يكون متمرّدا أو أن يكون تابعا. الجمال الذي لا يثور يصبح سلعة، أي شكلا آخر من أشكال القمع.
في هذا السياق، يمكن أن نفهم كيف أن السريالية انحازت منذ بداياتها إلى الثورات العالمية: من الثورة الروسية إلى الإسبانية إلى حركات التحرّر في الجزائر وهايتي.
فالفنّ الثوري لا يمكن أن يكون "نقيا" بمعنى البورجوازية للفنّ، لأنه مشتبك دائما مع الأسئلة الكبرى: من يملك الحلم؟ من يملك اللغة؟ من يملك الجسد؟
هكذا تحوّلت السريالية من مجرّد تيار أدبي إلى موقف وجودي يرى أن مهمة الفنان ليست أن يعبّر عن الواقع، بل أن يعيد بناءه على أسس العدالة والدهشة. فالثورة لا تكتمل إلا حين تصبح الحياة نفسها فنّا حرّا، حين يتحرّر الخيال من الاقتصاد كما يتحرّر العامل من ربّ العمل.
ولعلّ هذا ما قصده أراغون حين كتب:
"لن تكون هناك ثورة حقيقية ما لم يتغيّر الإنسان من الداخل، ما لم يحلم العالم من جديد."
بهذا المعنى، فالسريالية ليست مدرسة بل ساحة صراع بين ما هو قائم وما ينبغي أن يكون، بين الإنسان كما هو، والإنسان كما يتخيّله لنفسه، أي الإنسان الثوري.
10. السريالية في الأدب العربي: من الحلم الفردي إلى الوعي الجماعي.
حين عبرت السريالية البحر الأبيض المتوسط، لم تصل إلينا كاستيراد ثقافي من باريس، بل كصدىٍ للواقع العربي المنقسم بين الاستعمار والقمع الداخلي والفقر الرمزي.
لقد وجد فيها الشعراء العرب لغة جديدة لقول ما لا يقال، وسلاحا رمزيا ضدّ الرقابة، وضدّ الاستبداد الذي صادر الواقع كما صادر الحلم.
في الوطن العربي، لم تأت السريالية كموضة حداثية، بل كحاجة وجودية.
منذ الأربعينات والخمسينات، بدأت إرهاصاتها في مصر ولبنان وسوريا والعراق وتونس والمغرب، عبر تجارب متفرقة ولكنها تنتمي إلى الجذر نفسه: كسر المعنى السائد بحثا عن حرية مطلقة في الرؤية واللغة.
في مصر، ظهر جماعة الفن والحرية سنة 1938 بقيادة الشاعر جورج حنين، الذي رفع شعار "يحيا الفنّ الحرّ!".
كانت هذه الجماعة ، المتأثرة ببريتون ولكنها متجذّرة في واقع القاهرة المستعمَرة ، أول من أعلن أن الفنّ العربي لا يمكن أن يكون ثوريا إلا إذا تمرّد على التقليد وعلى الاستعمار معا.
كتب حنين:
"لا خلاص للخيال دون حرية، ولا حرية دون خيال."
وهذا القول يلخّص الميثاق السريالي العربي: لا يمكن فصل الثورة الجمالية عن الثورة السياسية، لأن كليهما يهدف إلى كسر البنية الذهنية التي تجعل القهر ممكنا.
ثمّ واصل الشعراء العرب في المشرق والمغرب تطوير هذه الرؤية، كلّ وفق سياقه الاجتماعي والسياسي.
في لبنان، أطلق الشاعر أنسي الحاج صرخته في "لن"، حيث حرّر اللغة من البلاغة، وكتب الشعر كطقس للتحرّر الداخلي، بينما قال أدونيس في "أغاني مهيار الدمشقي" إن الشعر هو "ولادة أخرى للعالم".
وفي العراق، رأينا عند السيّاب والبياتي توترا بين الواقعية والرمزية، بين الحلم الثوري والوجع الواقعي، بينما ذهبت نازك الملائكة في مسار أكثر تأمليا يلامس الغيب السريالي بلغة علمية دقيقة.
أمّا في المغرب العربي، فقد كانت السريالية تتغذّى من منابع أخرى: الروح الصوفية، واللغة الشعبية، والوجدان الجماعي المقموع.
في تونس، مثلا، نجد في تجارب شعراء مثل كمال الزغباني ومنصف الوهايبي توتّرا بين الواقعي والحلمي، بين الجسد والسياسة، بين السجن كفضاء مادي والحلم كفضاء للمقاومة.
وفي المغرب، جسّد محمد خير الدين ، الذي سمّى نفسه "بركان اللغة" ، أعمق تمثّل للسريالية الثورية في الوطن العربي، حين جعل من اللغة نفسها ميدانا للانتفاض ضدّ الاستعمارين، الفرنسي والوطني معا. و هو قائل:
"الكتابة عندي زلزال، لا وسيلة للزينة."
السريالية العربية، إذا، لم تكن محاكاة للسريالية الأوروبية، بل كانت تحريرا للحلم من الاستعمار اللغوي والفكري.
لقد جعلت من الشعر أداة لفضح البنية الذهنية التي رسّخها الاستعمار: بنية الخضوع، والخوف، والتقديس الأعمى.
وفي ذلك، التقت مع الماركسية في جوهرها ، أي في تسييس الخيال، وجعل اللاوعي ساحة للصراع الاجتماعي.
فالشاعر العربي، في صيغته السريالية، لم يعد نبيّا أو متأملا صوفيا، بل صار مقاتلا رمزيا، يهاجم اللغة الرسمية كما يهاجم الثائر السلطة السياسية.
والقصيدة لم تعد زينة لغوية، بل بيانا ثوريا مشفّرا، يخاطب اللاوعي الجمعي الذي كمّمته الأنظمة.
لقد أصبحت القصيدة العربية الحديثة ، في روحها السريالية ، ساحة تحرير للحلم الجماعي العربي، بعد أن صادرته الهزائم والأنظمة والتاريخ الرسمي.
ومن هنا نفهم أن السريالية العربية هي امتداد طبيعي للسريالية الثورية، ولكن بلحم عربيّ وذاكرة محلية. فهي ليست تقليدا، بل تمرّدا جديدا، يربط بين الميثولوجيا العربية القديمة (من الحلاج إلى رابعة العدوية إلى المتنبي) وبين الحسّ الثوري الحديث الذي يرى أن الحرية لا تُمنح بل تُنتَزع ، في الواقع كما في الحلم.
وفي النهاية، يمكن القول إن السريالية في الأدب العربي ليست فقط تيارا جماليا، بل هي محاولة لإعادة بناء الذات العربية من رمادها، عبر تخيّل واقع جديد لا يقوم على القهر والخوف، بل على الجمال كقيمة وجودية، والحلم كفعل سياسيّ بامتياز.
11. الحرية والجسد والجنون: نحو تحطيم قيود العقل الأداتي.
في قلب السريالية الثورية يقف الجسد، لا بوصفه موضوعا للرغبة فحسب، بل كأرض محرّرة من النظام الاجتماعي الذي كبّله قرونا طويلة.
فالجسد في الحضارة البورجوازية، كما في الحضارات السلطوية، كان دوما موضوع رقابة وتأديب وقمع.
منذ الكنيسة، مرورا بالمدرسة والمصنع والثكنة، وصولا إلى شاشات الإعلانات، ظلّ الجسد يختزل إلى آلة إنتاج أو إلى سلعة إغراء.
أمّا السريالية، فقد أعلنت تمرّدها على كلّ هذا: الجسد ليس أداة، بل مفتاح للوعي، بوابة للانفلات من منطق السيطرة.
يقول أندريه بروتون في البيان السريالي الأول:
"إنّ أعظم عمل ثوريّ هو أن يترك الجسد ليحلم، أن يسمح له بأن يقول الحقيقة التي تخافها العقول."
بهذا المعنى، فالسريالية الثورية ليست دفاعا عن الجسد في معناه الإيروتيكي، بل في معناه التحرّري الوجودي: الجسد ككائن يفكّر، كذاكرة، كحلم مضغوط في لحم حيّ.
حين يتحرّر الجسد، يتحرّر العقل من سلطته على ذاته.
لأنّ السيطرة على الجسد هي الشكل الأوّل للعبودية، والاعتراف بالجسد كفضاء للحرية هو بداية الثورة الحقيقية.
لقد أدرك السرياليون، متأثرين بفرويد وماركس ونيتشه، أن العقل الأداتي (العقل الذي يريد السيطرة والتنظيم والتصنيف) هو ابن النظام الرأسمالي ذاته، عقل لا يخلق بل يعيد الإنتاج.
لذلك كان لا بد من استدعاء الجنون، ليس كمرض، بل كقوة مضادة للنظام.
فالمجنون في السريالية هو من رفض القواعد، من رأى في الفوضى نظاما أعمق.
إنّه، بتعبير ميشال فوكو في تاريخ الجنون:
"صوت الحقيقة التي نفاها العقل من ذاته، كي يحافظ على توازنه الزائف."
وهكذا صار الجنون في السريالية الثورية منهجا للحرية، طريقا لاستعادة الإنسان من بين أنقاض العقل السلطوي.
فكما أن الماركسية حرّرت العمل من عبودية رأس المال، حرّرت السريالية الحلم من عبودية العقل.
وهما معا يشكّلان وجهين لثورة واحدة: ثورة ضدّ الاستلاب، ضدّ تحويل الإنسان إلى أداة.
يقول بول إيلوار:
"أحلم بعالم لا يعاقب فيه المجنون، بل يستمع إليه كما يستمع إلى شاعر يقول الحقيقة في لغة أخرى."
الحرية، في السريالية الثورية، ليست مجرّد مطلب سياسيّ، بل هي تحوّل أنطولوجيّ ، تحرّر الإنسان من كل ما في داخله وخارجه من قيود.
هي أن تخلق عالمك بدل أن تقاد إلى عالم صمّم لك.
أن تحبّ دون إذن من قانون، وأن تحلم دون ترخيص من سلطة، وأن تكتب دون أن تخاف رقيبا أو ناقدا أو إلها متعسّفا.
وفي هذا السياق، نجد أن السريالية العربية بدورها فتحت هذا الأفق:
ففي قصائد أدونيس وأنسي الحاج والماغوط ونزار قباني ومحمود درويش وكمال الغالي وهو يوسف خديماللّه وغيرهم، يصبح الجسد ساحة صراع بين الحلم والرقابة، بين اللغة والسكوت.
القصيدة نفسها تتحوّل إلى فعل جسديّ، إلى عرق ودم وأنفاس.
لقد كتبت المرأة العربية السريالية ، من مثل نوال السعداوي وسلوى بكر وحنان الشيخ ورفيقة حداد ، أجمل تمارين الحرية حين جعلت جسدها نصّا يواجه المؤسسة الأبوية والدينية والسياسية في آن واحد.
فالسريالية في سياقنا العربي لم تكن فقط تحرّرا من الشكل الأدبي، بل تحرّرا من الذكورة السلطوية التي جعلت من الأنثى كائنا بلا حلم.
من هنا، يمكن القول إنّ السريالية الثورية جسّدت أعظم انقلاب في فهم الحرية:
لم تعد الحرية حقّا يمنح، بل غريزة تستعاد.
لم تعد شعارا سياسيا، بل حالة جسدية وروحية شاملة، تتحقّق حين يلتقي الجسد بالخيال في رفضهما المشترك لكلّ أشكال الاستعباد.
إنها حرية لا تتجزأ: حرية الحلم، وحرية الجسد، وحرية القول، وحرية الرفض.
وهي، بهذا المعنى، ليست نزهة فكرية، بل فعل ثوريّ مستمرّ داخل الإنسان نفسه،
12. الذاكرة، اللغة، والخيال: الحلم كفضاء مقاومة جماعية.
إذا كان الجسد في السريالية الثورية هو أرض الحرية، فإن اللغة والخيال هما فضاؤها الكوني.
السريالية لا ترى اللغة كأداة للتواصل، بل ككائن حيّ، كقوّة خيميائية قادرة على تفجير العالم من الداخل.
في اللغة يعيش اللاوعي الجمعي، وفيها أيضا تعاد كتابة التاريخ لا كما كتب، بل كما ينبغي أن يكون.
لقد كان بروتون يؤمن بأن اللغة حين تتحرّر من قواعدها النحوية، تتحرّر من النظام الاجتماعي نفسه، لأن اللغة ، في بنيتها العميقة ، هي مرآة السلطة.
حين يقول أحدهم "ينبغي" أو "يجب"، فذلك لأن النظام يتكلّم عبره.
لكن حين يقول الشاعر "أحلم"، فهو يكسر ذلك التسلسل السلطوي ويؤسس لمعنى جديد خارج منطق الأمر والطاعة.
السريالية الثورية، إذا، هي ثورة لغوية قبل أن تكون سياسية.
فمن يملك اللغة يملك العالم.
ومن يبدع لغة جديدة يخلق عالما جديدا.
ولذلك كان الشعر السريالي محاولة لإعادة العالم إلى براءته الأولى، إلى حالة الطفولة الكونية قبل أن تصاغ الأشياء في قوالب السلطة.
كما قال بروتون:
"الطفولة هي المرحلة الأكثر سريالية في حياة الإنسان، لأنها الوحيدة التي لم تلوّث بعد بالمنطق."
وفي هذا المعنى، يشكّل الخيال عند السرياليين نوعا من الذاكرة العليا، ذاكرة ليست لما حدث، بل لما يمكن أن يحدث.
الخيال هنا ليس هروبا من الواقع، بل هجوما عليه من زاوية أخرى، اختراق للواقع بوسائل اللاواقع.
كما قال غاستون باشلار:
"الخيال ليس ما نراه في الحلم، بل ما يجعلنا نغيّر الواقع بعد أن نحلم."
هذه الفكرة بالذات، حين وصلت إلى الأدب العربي، وجدت تربة خصبة في ظلّ واقعٍ مأزومٍ بالهزائم والرقابة والاستعمار الثقافي.
فصار الخيال في الشعر العربي المعاصر شكلا من المقاومة:
في قصيدة محمود درويش مثلا، يتحوّل الحلم إلى وطنٍ بديل، وإلى أداة لإحياء ذاكرة جماعية طمست.
وفي شعر صلاح عبد الصبور، يتحوّل الحلم إلى سؤال عن الموت والحياة والمعنى.
وفي كتابات محمد شكري وعبد الرحمن منيف وواسيني الأعرج و فتحية بن فرج و آمنة الرميلي، يصبح الحلم ساحة لتعرية القهر الاجتماعي والسياسي، حيث اللاوعي الشعبي يتكلّم من خلال الكوابيس.
الذاكرة في السريالية ليست نوستالجيا، بل ميدان نضال رمزيّ.
إنها رفض للنسيان المفروض بالقوة، وتأكيد على أنّ ما يمحى في التاريخ يمكن أن يستعاد في الشعر و الرواية.
وهكذا تتحوّل القصيدة و الرواية إلى أرشيف للمقموعين، يحفظ ما لم يكتب في كتب المنتصرين.
اللغة السريالية هي لغة من لا لغة له، لغة المهمّش والمجنون والمنفيّ والعامل والمرأة والطفل، الذين سلبت منهم الكلمة والقدرة على تسمية الأشياء.
ولذلك فإن الخيال، في المنظور السريالي الثوري، ليس هروبا من السياسة بل تجسيدها الأعمق.
فالخيال هو المساحة الوحيدة التي لا تستطيع السلطة احتلالها بالكامل.
يمكن أن تغلق صحيفة، يمكن أن يمنع كتاب، يمكن أن يسجن شاعر و روائي و مسرحي و سينمائي، لكن لا أحد يستطيع أن يمنع إنسانا من أن يحلم.
ولهذا السبب بالذات، يقول إيلوار:
"حين يغلقون فمي، أُواصل الكلام في نومي."
إنّ الحلم هنا فعل مقاومة، واللغة الثائرة سلاح في معركة الذاكرة، والخيال هو آخر أراضي الحرية التي لم تستعمر بعد.
فالسريالية الثورية إذا ليست فقط تيارا فنّيا أو أدبيا، بل مشروعا للتحرّر الإنساني الشامل:
تحرير الجسد من السلطة، واللغة من القاموس، والخيال من الواقع.
وهكذا، تغدو السريالية الثورية مشروعا مزدوجا:
تثوير الواقع عبر الحلم، وتثوير الحلم عبر الواقع.
وفي هذا الالتقاء الأخير بين الاثنين، يولد الإنسان الجديد الذي حلمت به الماركسية، وغنّت له السريالية، ودفع ثمنه الشعراء بأعمارهم وأحلامهم.
13 ـ السريالية بين الحلم والثورة: الحلم كقوة مادية للتغيير.
حين كتب أندريه بريتون في "البيان السريالي الأول" أن الحلم ليس هروبا من الواقع بل نافذة عليه، كان يعيد الاعتبار لقوة اللاوعي بوصفه طاقة ثورية قادرة على إعادة صياغة العالم. الحلم، في هذا المعنى، ليس مجرد تجربة فردية أو هذيان داخلي، بل هو فعل تمرّد على المنطق المألوف، وعلى نظام القيم البرجوازي الذي يقيس الحقيقة بميزان العقل وحده. فالسرياليون آمنوا بأن التحرّر الحقيقي يبدأ من تحطيم القيود التي يفرضها الوعي الاستعبادي على خيال الإنسان.
يقول بريتون: «إن أبسط عمل سريالي هو أن تنزل إلى الشارع وتمسك بيد امرأة لا تعرفها، وتذهب بها حيث يقودكما الحلم». هذه الجملة ليست شاعرية فقط، بل ذات دلالة سياسية ثورية؛ فهي تعلن تمرّد الإنسان على كل أشكال الانضباط الاجتماعي. الحلم هنا فعل اقتحام للعالم لا انسحاب منه، ومحاولة لاكتشاف ما وراء جدار الواقع المزيّف الذي بنته الرأسمالية حول الإنسان.
لقد رأى السرياليون في الحلم ساحة مواجهة بين الإنسان المكبوت والمجتمع القامع. فرويد كشف آلية الحلم، لكن السرياليين ، كما يقول المفكر هربرت ماركوز في الإنسان ذو البعد الواحد ، حاولوا تحويلها إلى أداة لتحرير الإنسان من بعده الواحد، أي من سجن العقل الأداتي والنظام الصناعي. الحلم هو العمل الثوري في أكثر صوره جذرية، لأنه يقوّض النظام الرمزي للعقل البرجوازي الذي يفصل بين الواقعي والمستحيل.
إن السريالية الثورية لا ترى الحلم كاستراحة، بل كاستعداد للانفجار. لذلك، كانت العلاقة بين الحلم والثورة علاقة جدلية: الحلم يزرع في الوعي إمكانية الثورة، والثورة تحقق في الواقع ما كان حلما. ولهذا اعتبر لويس أراغون أن "الخيال هو مستقبل الواقع"، بمعنى أن ما يتصوّر اليوم بلا منطق قد يصبح غدا مشروعا سياسيا جديدا.
وفي هذا الإطار، لم يكن الفن السريالي غاية جمالية، بل وسيلة لإعادة خلق العالم. فلوحات دالي، مثل إصرار الذاكرة، لا تكتفي بتمثيل الزمن الذائب، بل تهدم مفهوم الزمن الرأسمالي القائم على الإنتاجية والانضباط. والقصائد السريالية، مثل نصوص بول إيلوار وأراغون، تفكك اللغة نفسها لتعيد ترتيبها على منطق الحلم، أي على حرية تامة في التوليد والارتباط.
إن السريالية الثورية تعيد تعريف الحلم كأداة للوعي الجمعي، إذ يصبح الحلم، كما يقول الشاعر إيلوار، «الحق في أن نرى العالم كما يجب أن يكون، لا كما هو». وهكذا يتحوّل الحلم إلى فعل مقاومة ضد العقلانية القمعية وضد كل نظام يختزل الإنسان إلى آلة إنتاج.
وفي المجتمعات العربية، اكتسب مفهوم الحلم السريالي بعدا خاصا. فالحلم العربي، بعد النكسة مثلا، صار رمزا للبحث عن الخلاص من الاستبداد والخيبة. نرى ذلك عند أدونيس الذي كتب في هذا هو اسمي:
"أحلم أن أكون حجرا يصرخ / في وجه الطغاة."
الحلم هنا ليس مهربا، بل احتجاجا شعريا او سرديا على الواقع، وفي هذا يتجلّى الأثر السريالي في الرواية و الشعر العربي المعاصر كامتداد للثورة الداخلية على أنقاض الخارج المهزوم.
14 ـ السريالية الثورية اليوم: من الثورة الجمالية إلى الثورة الاجتماعية.
حين ننظر إلى العالم المعاصر، تبدو السريالية وكأنها عادت من جديد، لا في صالات العرض فقط، بل في الشارع، في الميمات، في الفنون الرقمية، في ثورات الشعوب التي تحوّلت إلى كوابيس ثم إلى أحلام من جديد. فالعالم المعولم صار في ذاته لوحة سريالية هائلة: الحقيقة تقلب، الزمن يتفكّك، الصور تسبق الوقائع، والخيال صار مادة إعلامية تباع وتشترى.
لكن هنا تحديدا تستعيد السريالية الثورية ضرورتها. في زمن الخداع البصري والسياسي، لم تعد السريالية مجرّد حركة فنية تاريخية، بل أصبحت استراتيجيا فكرية للكشف عن اللاواقعي داخل الواقعي. فكما كتب الفيلسوف فالتر بنيامين: «الفن لا يحرّر العالم، لكنه يكشف أنه يحتاج إلى التحرّر». السريالية الثورية المعاصرة هي وعي جديد بأن العالم فقد اتزانه العقلي، وأن العقل ذاته أصبح أداة قمع وتبرير للاستغلال.
إن مهمّة السريالية الثورية اليوم هي استعادة الخيال كقوة مادية للتغيير. فحين تحتكر اللغة والإعلام والفكر لصالح السوق، يصبح الحلم آخر مساحات الحرية الممكنة. لكن هذا الحلم يجب أن يربط بالتحليل الماركسي للواقع، حتى لا يتحوّل إلى مجرد زينة ثقافية أو نزوة فنية. ومن هنا تأتي أهمية الربط بين التحليل النفسي الماركسي وبين السريالية، كما حاول هربرت ماركوز وفريدا كاهلو وغيرهما.
ماركوز يرى أن الثورة لا يمكن أن تكون فقط سياسية أو اقتصادية، بل يجب أن تكون أيضا حسّية وجمالية، أي أن تشمل تحرير الغرائز والرغبة من الاستلاب. وهنا تلتقي السريالية الثورية مع الماركسية الإنسانية: كلتاهما تبحث عن إنسان جديد، حرّ في تفكيره وفي جسده وفي لغته.
وفي هذا السياق، يمكن القول إن الفنانين السرياليين الجدد في الوطن العربي ، من الشعراء إلى المصورين إلى صانعي الأفلام التجريبية الى الساردين ، هم ورثة هذا الوعي الجديد. فحين يكتب شاعر مثل أنسي الحاج أو أدونيس أو صلاح فائق نصوصا تقلب فيها الصور والأزمنة، فإنهم لا يعبثون باللغة فحسب، بل يعيدون تأسيس الوعي على قاعدة الحرية المطلقة.
تقول فريدا كاهلو، التي كانت قريبة من فكر السريالية الثورية دون أن تعلن انتماءها الصريح لها:
"لم أرسم أحلامي. رسمت واقعي فقط. لكنه كان أكثر جنونا مما يتخيّلون."
وهذه العبارة تختصر جوهر السريالية الثورية: الواقع ذاته صار جنونا، والفن هو الوسيلة الوحيدة لفهمه عبر تجاوز منطقه.
وفي الوطن العربي، حيث القمع السياسي والاجتماعي والرقابة الدينية، تصبح السريالية الثورية شكلا من أشكال المقاومة الثقافية. فحين يرسم الفنان السوري تمام عزام لوحة حبيبته على جدار مدمر في حلب، فهو يمارس سريالية ثورية بالمعنى الكامل: تحويل الخراب إلى حقل للخيال، والدمار إلى نداء للحياة.
السريالية الثورية اليوم ليست حركة ماضوية بل ضرورة وجودية. إنها، كما يقول أدونيس، «محاولة لإعادة كتابة العالم بلغات الحلم والحرية». وهي في هذا المعنى لا تكتفي بتفكيك الواقع، بل تحاول إعادة تركيبه على صورة الإنسان الذي نريد.
وهكذا يمكن القول إن السريالية الثورية تمثل اليوم ، في زمن الرأسمالية الرقمية والهيمنة الرمزية ، ما كانت تمثله الماركسية في بدايات القرن العشرين: أفقا جديدا للوعي الإنساني، وجسرا بين الثورة على العالم الخارجي والثورة داخل الذات. إنها دعوة إلى "تحرير الواقع من نفسه"، أي إلى جعل الحياة نفسها عملا فنيا بلا قيد، والخيال سلاحا ضد الاستلاب.
15 ـ السريالية كتحرّر من اللغة ومن الخطاب السلطوي.
حين تناول أندريه بريتون اللغة بوصفها أحد أقوى أدوات القمع العقلي والاجتماعي، كان يلمّح، دون أن يقولها صراحة، إلى أن كل سلطة تبدأ من احتكار الخطاب. فالعقل البرجوازي لا يهيمن فقط عبر الاقتصاد والسياسة، بل عبر اللغة أيضا. اللغة، كما يقول ميشال فوكو، هي سجن غير مرئي، تحدّد ما يمكن قوله وما يجب كتمانه. ومن هنا انطلقت السريالية في مشروعها الأكثر جذرية: تفجير اللغة نفسها.
لقد أراد السرياليون أن يجعلوا من الكتابة لحظة ولادة جديدة للمعنى، لا استنساخا للواقع. فحين دعا بريتون إلى الكتابة الآلية (écriture automatique)، لم يكن يبحث عن العبث أو المصادفة، بل عن استعادة الكلمة من يد السلطة ومن يد العقل المهيمن. في الكتابة الآلية، تفتح اللغة على لاوعيها، على ما لم يقل، على ما ظلّ منفيا من الخطاب الجمعي. إنها، بتعبير بول إيلوار، «اللغة حين تنام فيها الرقابة وتتكلم الرغبة».
إن الثورة اللغوية السريالية ليست تمرينا أسلوبيا، بل تمرّدا سياسيا. فالسلطة تفرض لغتها، والمجتمع يفرض منطقه، والتعليم يفرض تراكيبه، والطبقات الحاكمة تفرض مفرداتها. اللغة، في جوهرها، تعيد إنتاج الهرمية الطبقية. لذلك، رأى بريتون أن تحطيم اللغة المألوفة شرط لتحرير الإنسان من الفكر الخاضع. وهنا تلتقي السريالية مع التحليل الماركسي للنظام الرمزي: فماركس نفسه قال إن الأفكار المهيمنة في كل عصر هي أفكار الطبقة المهيمنة.
من هذا المنظور، تتحوّل السريالية إلى مشروع لتفكيك اللغة المهيمنة وإعادة خلق لغة الحرية. إنها محاولة للعودة إلى اللغة الأولى، اللغة التي لم تفسدها المؤسسات، ولم تهذّبها القوانين، ولم تنقّحها المدارس. إنها لغة الطفل، الحالم، العاشق، المجنون، أي لغة الإنسان قبل أن يستعبد بالعقلانية البيروقراطية.
في هذا السياق، يمكننا القول إن السريالية الثورية هي التي تحوّل اللغة من وسيلة للتواصل إلى وسيلة للتحرّر. فكما يكتب لويس أراغون في الفلاح في باريس:
«الكلمات مثل القنابل، بعضها ينفجر في القلب، وبعضها يهدم العالم.»
بهذا المعنى، تصبح اللغة نفسها ميدان صراع طبقي. فالشعر و السرد السريالي الثوري لا يكتب ليرضي الذوق، بل ليخلخل المعنى الموروث ويكسر التوازن الكاذب الذي تبنيه البلاغة الرسمية. إن كل جملة سريالية هي تمرين على الحرية، وكل انزياح لغوي هو ثورة صغيرة ضد الدلالة المستقرة.
وفي الأدب العربي، أدرك الشعراء الطليعيون هذا البعد الثوري للغة. نقرأ عند أدونيس في الكتاب قوله:
«أعيد خلق اللغة كما تعاد خلق الأرض بعد الطوفان.»
وعند أنسي الحاج في الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع:
«اللغة جسدي، أبدّل أعضاءها كما أشاء، لتصرخ كما أريد.»
هذه النصوص ليست تجريبية فنية فحسب، بل سياسية بعمقها. فهي إعلان انفصال عن لغة الخطاب السلطوي، وعن البيان القومي أو الديني أو الحزبي. الشعراء السرياليون العرب حوّلوا اللغة إلى مختبر حرية، وإلى شكل من أشكال المقاومة الجمالية ضد الرقابة والعقل الأبوي.
السريالية الثورية، إذا، تعيد للغة وظيفتها البدائية: لا كأداة لوصف العالم، بل كقوة لتغييره. إنها تمرد ضد كل نظام نحوي يرسم حدود الفكر، وضد كل بلاغة تسعى لتجميل القيد بدل كسره. فحين يقول بول إيلوار:
«الكلمة حرّة مثل الحبّ، ومن لا يحبّ لا يستطيع أن يكتب.»
فهو يلخّص تماما روح السريالية الثورية: أن يكون الشعر فعل عشق للعالم ورغبة في إعادة خلقه.
وفي زمننا الحاضر، حيث اللغة الإعلامية والسياسية باتت مبرمجة ومحايدة و"آمنة"، تصبح الكتابة السريالية أداة لتفجير الوعي الجمعي من الداخل، ولتحرير الإنسان من لغة السوق والعناوين الجاهزة. فهي مقاومة لغوية ضد تدجين الفكر.
وهكذا تتحول السريالية الثورية إلى ماركسية لغوية، تسعى إلى إعادة امتلاك الكلمة من يد البرجوازية الثقافية التي جعلت من الأدب سلعة ومن المعنى استهلاكا. إنها تبحث عن الكلمة التي لا تشترى، الكلمة التي تولد من الألم والحلم والرغبة، لا من القاموس. فالسريالية الثورية هي أن تكتب كما لو أنّ العالم لم يُكتب بعد.
16 ـ نحو إنسان سريالي ثوري: الحلم الجديد والوعي الجديد.
إن مشروع السريالية الثورية، في جوهره الأعمق، ليس فنيا فقط، بل أنثروبولوجي، أي أنه يسعى إلى خلق إنسان جديد. الإنسان الذي تتحدث عنه السريالية ليس الفرد المتحرّر جنسيا أو لغويا وحسب، بل هو كائن جديد يعيد التوازن بين الحلم والعقل، بين الرغبة والفعل، بين الذات والجماعة. إنه الإنسان الذي يتحرّك خارج الحدود التي رسمها له المجتمع الصناعي الرأسمالي.
لقد فشل المشروع البرجوازي الحديث، منذ القرن التاسع عشر، في بناء إنسان حرّ. أنتجت الرأسمالية فردا منضبطا، استهلاكيا، مسيّرا، خائفا من الخيال، مسجونا داخل منظومات عمل وإنتاج ورقابة. هنا جاءت السريالية الثورية لتعلن العصيان: الإنسان ليس آلة إنتاج، بل كائن خياليّ، والشغل لا يجب أن يقتل الحلم، بل أن يحقّقه.
هذا الإنسان السريالي الثوري يشبه ما تنبّأ به هربرت ماركوز حين قال:
«التحرر الحقيقي هو حين يصبح الجمال ضرورة حياتية لا ترفا.»
فالسريالية لا تنادي بالهروب من العالم، بل بإعادة بنائه على أسس جمالية وإنسانية. فالعالم الذي يخلو من الجمال والخيال، كما كتب أراغون، هو "جريمة ضد الوجود".
الإنسان السريالي الثوري هو الذي يرى العالم بعين الطفل لا بعين البيروقراطي. يرفض الحدود، القوانين الجامدة، المعايير الجمالية، وحتى مفهوم "النجاح" بمعناه الرأسمالي. هو كائن حرّ يعيش الشعر في الشارع، والحلم في المصنع، والحرية في اللغة. إنه، بتعبير بريتون، «الإنسان الذي يرى في الحجر وردة، وفي الموت بداية، وفي الجنون شجاعة».
وفي السياق العربي، يمكن القول إن هذا الإنسان السريالي الثوري هو الذي يسعى اليوم إلى التحرر من منظومتين قاهرتين: الاستبداد السياسي، والاستلاب الثقافي. فالثورات العربية، رغم ما اعتراها من انكسارات، كشفت الحاجة إلى خيال جديد يوازي الفعل السياسي. لم يعد يكفي إسقاط الحاكم، بل يجب إسقاط المخيّلة القديمة التي تقبل الطغيان كقدر. وهنا تحديدا يصبح الحلم الثوري السريالي ضرورة تاريخية.
فحين يقول الشاعر العراقي سعدي يوسف:
«أحلم بالمدينة التي لا تغلق أبوابها على الفقراء»
فهو لا يصف utopia رومانسية، بل يعيد كتابة الممكن السياسي بلغة الشعر. وكذلك حين يكتب أدونيس:
«في الحلم أرى وطنا بلا حدود ولا قضاة»
فهو يمارس سريالية ثورية عربية الطابع، تربط بين الحلم والفعل، بين الخيال والنقد الاجتماعي.
الإنسان السريالي الثوري، إذا، هو الإنسان الذي يعيد تعريف الواقعية نفسها. فالواقعية التي تفرضها السلطة هي واقعية الموت والروتين والطاعة، بينما الواقعية الجديدة التي تقترحها السريالية هي واقعية الانفتاح والدهشة والتحوّل الدائم. في هذا السياق، يقول المفكر الفرنسي روجيه غارودي:
«أن تكون واقعيا في عصر كهذا يعني أن تحلم.»
بهذا المعنى، لا تكون السريالية الثورية مجرد مذهب أدبي أو فني، بل هي فلسفة وجودية وموقف من العالم. إنها نداء ضد الاغتراب، ضد السلطة، ضد القياس، ضد موت الخيال. وهي أيضا دفاع عن الإنسان باعتباره آخر منطقة لم يغزوها رأس المال بعد.
فالسريالية الثورية اليوم، في زمن الآلة والذكاء الاصطناعي والسلعنة المطلقة لكل شيء، تعيد إلينا ما نسيناه: أن الحلم فعل سياسي، وأن الخيال طاقة مادية للتغيير، .
كما كتب بريتون في نهاية حياته:
«لن تنتهي السريالية حتى يتحقق الإنسان الكامل، الإنسان الحالم الحرّ.»
وهذا هو مشروعها الأخير والأول معا: بناء إنسان لا يخاف من الحلم، ولا يخاف من الحرية.
17 ـ السريالية الثورية كفلسفة للمقاومة ضد الاغتراب الرأسمالي.
حين تبلورت السريالية في بدايات القرن العشرين، كان العالم يعيش تحت صدمة الحداثة الصناعية: المصانع، الحرب، الاستعمار، المدن الضخمة، اختناق الإنسان في الزمان الحديدي للآلة. كانت الرأسمالية الناشئة قد حوّلت الإنسان إلى وظيفة، والوعي إلى سلعة، والرغبة إلى منتج. في هذا السياق المريض، جاءت السريالية لا كمدرسة فنية فقط، بل كصرخة وجودية ضد الاغتراب، بالمعنى الماركسي العميق للكلمة.
ماركس وصف الاغتراب بأنه فقدان الإنسان لذاته داخل علاقات الإنتاج، حيث تصبح قواه الحيوية ملكا للآخر. أمّا بريتون، فقد وسّع المفهوم إلى المجال النفسي: الإنسان لا يغترب فقط في العمل، بل أيضا في الحلم، في اللغة، في الحب، في الفن، في السياسة. الاغتراب لم يعد ماديا فقط، بل رمزيا. وهنا تحديدا تتقاطع السريالية الثورية مع الماركسية النقدية في مشروع تحرير الإنسان من كل أشكال الاستلاب، المادي والروحي.
إنّ الرأسمالية لا تكتفي بسرقة العمل، بل تسرق المخيلة أيضا. إنها تسوّق الأحلام في شكل إعلانات، وتبيع الرغبات كسلع. وهكذا تحوّل الخيال الإنساني إلى أداة لتكريس النظام نفسه. وهنا بالضبط تبدأ مهمّة السريالية الثورية: أن تستعيد الحلم من السوق، وتعيده إلى الإنسان. أن تحرّر الخيال من وظيفة الإعلان، وتعيد إليه وظيفته الأصلية: الثورة.
كما يقول الفيلسوف هربرت ماركوز:
"الثورة لا يمكن أن تكتمل ما لم تحرّر الحواس والخيال من هيمنة الواقع القائم."
هذه المقولة تلخّص جوهر السريالية الثورية: فهي ترى أن تغيير العالم يبدأ من تغيير طريقة رؤيته. ومن هنا جاءت دعوتها إلى “التحرر من العقل الأداتي”، أي من العقل الذي لا يرى في الأشياء إلا قيمتها النفعية. فالعقل الذي يصنع آلة القتل هو نفسه الذي يبني نظام الاستغلال. لذلك، كان على السريالية أن تفتح الباب أمام "العقل الحالم"، العقل الذي يرى الإمكانات المجهولة في الواقع، لا فقط ما هو قائم.
لقد وجدت السريالية الثورية نفسها، منذ بداياتها، في مواجهة مباشرة مع النظام الرأسمالي للمعنى، الذي يحوّل كل شيء إلى وظيفة: الفن إلى سلعة، الحب إلى عقد، الكلمة إلى شعار إعلاني. فحين يكتب بول إيلوار:
"على صفحات دفتر المدرسة... كتبت كلمة حرية، وقرّرت أن أعيشها."
فهو يعيد الكلمة إلى معناها الأصيل، أي إلى الفعل، إلى الجسد، إلى الواقع. السريالية الثورية ليست إذن أدبا للحلم، بل أدبا للفعل الحالم، للفعل الذي يستمدّ طاقته من اللاوعي الجمعي الذي لم تفسده الأيديولوجيا بعد.
في هذا الإطار، يصبح الفن السريالي الثوري أداة مقاومة ضد ترويض الخيال، وضد “النظام الرمزي للرأسمالية المتأخرة” الذي تحدّث عنه الفيلسوف غي ديبور في كتابه مجتمع الفرجة. فديبور يرى أن الإنسان لم يعد يعيش في العالم، بل في صور العالم، وأنه صار يستهلك التمثيل بدل الحقيقة. والسريالية الثورية، في مواجهة هذه “الفرجة الشاملة”، تدعو إلى تحطيم الشاشة وإعادة الاتصال بالحلم كقوة أصلية.
ولذلك، لم تكن السريالية مجرد خيال، بل برنامج تحرّري شامل. أراد بريتون أن يخلق "مجتمعا بلا رقابة داخلية"، حيث يتحرّر الإنسان من الرقيب الأبوي والديني والسياسي، ويعود إلى وحدته الأولى مع الطبيعة والرغبة واللغة. ولهذا لم يكن غريبا أن تنفتح السريالية الثورية على الماركسية، وعلى الفكر الثوري العالمي، وأن يرى فيها بعض اليساريين، مثل أراغون وبنجامين، أفقا للثورة الشاملة.
يقول بريتون في حوار شهير:
"السريالية ليست حلما بلا وعي، بل وعيا أعمق بالحلم."
إنها، في جوهرها، وعي مضاد للاغتراب، لأن الحلم هو المجال الوحيد الذي لم تستطع الرأسمالية تملّكه بعد. لكن هذا الحلم يجب أن يتحوّل إلى وعي جمعي مقاوم، لا إلى نزعة فردية أو هروب رومانسي.
وفي الوطن العربي، يتخذ هذا الاغتراب شكلا مركبا: اغتراب عن الذات، عن التاريخ، عن اللغة، عن الحرية. فالعربي المعاصر يعيش بين قهرين: قهر النظام الاستبدادي، وقهر النظام النيوليبرالي. هنا تبرز أهمية السريالية الثورية كمنهج تحرري مضاعف: فهي تحرّر الإنسان من قيود السلطة السياسية ومن القيود الذهنية معا.
حين يكتب الشاعر محمود درويش في قصيدته "سرير الغريبة":
"نامي لأحلم أني حرّ، أني لا أحلم."
فهو يختصر مأساة الإنسان العربي بين الحلم المقموع والرغبة في الحلم.
السريالية الثورية، إذا، هي المشروع الذي يعيد للإنسان العربي حقّه في الخيال بوصفه شكلا من أشكال المقاومة. فمن لا يملك الحلم لا يمكنه أن يملك الثورة.
18 ـ السريالية الثورية والمستقبل: الحلم كأفق للإنسان الجديد.
في عالم اليوم، حيث تتداخل التكنولوجيا بالسلطة، والإعلام بالرأسمال، والذكاء الاصطناعي بالتحكّم في الوعي، تبدو السريالية الثورية أكثر راهنية من أي وقت مضى. لقد صار الواقع نفسه سرياليًا:
حروب تبثّ مباشرة على الشاشات، شعوب تقتل على الهواء، حقائق تخلق بالذكاء الاصطناعي، وأحلام تباع عبر الخوارزميات. في هذا العالم، يصبح السؤال الجوهري: هل ما زال يمكننا الحلم؟
السريالية الثورية تجيب: نعم، ولكن بشروط جديدة. فالحلم لم يعد مجالا للهروب، بل أفقا للمقاومة ضد الواقع الافتراضي الذي يبتلع الوعي. إننا نعيش اليوم، كما يقول الفيلسوف السلوفيني سلافوي جيجك، في "عصر ما بعد الواقع"، حيث صار الخيال يصنع من فوق، وتتحكم به الشركات الكبرى. وهنا تبرز السريالية الثورية كحركة مضادة: خيال من الأسفل، من الإنسان، من الجسد، من الشارع، من الحلم الفردي الجماعي الذي لا يمكن برمجته.
إن المستقبل السريالي الثوري هو المستقبل الذي يربط بين التكنولوجيا والتحرر لا السيطرة، بين الخيال والإنتاج لا الاستهلاك. فكما أراد ماركس أن يتحرّر العامل من آلة المصنع، تريد السريالية الثورية أن يتحرّر الحالم من آلة الصورة. فالعصر الرقمي، كما يرى باومان، جعل الإنسان سائلا، متحوّلا، بلا جذور. والسريالية الثورية، من داخل هذا الانسياب، تحاول أن تخلق نقطة مقاومة شاعرية: أن تعيد للخيال دوره كأداة بناء لا كمنتج خاضع للعرض والطلب.
وهنا يمكن القول إن السريالية الثورية تمهّد لولادة إنسان ما بعد الرأسمالية، الإنسان الذي سيعيد التوازن بين الفن والحياة، بين العمل والرغبة، بين العلم والشعر. إنها تبشّر بـ"اشتراكية الجمال"، حيث تتحرّر القيم الجمالية من السوق، ويصبح الإبداع نمط حياة لا مهنة. فالمجتمع السريالي الثوري هو المجتمع الذي لا يحتاج فيه الإنسان إلى الهروب من الواقع، لأنه جعل من واقعه حلما متحققا.
في هذا المعنى، يلتقي فكر بريتون مع رؤية الفيلسوف الماركسي إرنست بلوخ في كتابه مبدأ الأمل، حين يقول:
"الإنسان هو الكائن الذي لم ينجز بعد."
السريالية الثورية، إذا، ليست ماض فنيا، بل مستقبل فلسفي. إنها الوعي الذي يذكّرنا بأن الإنسان لم يكتمل، وأن عليه أن يواصل الحلم كي يظلّ إنسانا.
وفي الوطن العربي، يحمل هذا الأفق معنى مضاعفا. فالأجيال الجديدة، التي ولدت بعد الانتفاضات والثورات، لم تعد تؤمن بالسياسة التقليدية ولا بالأيديولوجيات الجامدة، بل تبحث عن لغة جديدة للثورة، لغة شعرية، تخييلية، متعدّدة، تتجاوز الأحزاب والرايات. هذه هي الروح السريالية الثورية العربية المعاصرة: أن تكون الثورة حلما لغويا وجماليا في مواجهة سلطة اللغة والرمز.
نرى هذه الروح في فنون الشارع، في جداريات فلسطين وتونس والعراق ولبنان، في الشعر الرقمي، في الأغاني التي تخلط بين الغضب والحلم، في السينما التجريبية التي تفضح اللاعقل في الواقع العربي. إنها كلها تجليات لما يمكن تسميته بـ"السريالية الواقعية الجديدة"، التي تحوّل الواقع نفسه إلى مادة للحلم.
وهكذا تصل السريالية الثورية إلى ذروتها: حين تصبح اليوتوبيا اليومية، أي ممارسة مستمرة للحلم داخل الواقع. لا كمدينة فاضلة بعيدة، بل كعادة إنسانية يومية: أن نحلم ونحن نعيش، أن نخلق ونحن نكافح، أن نكتب ونحن نقاوم.
في نهاية المطاف، السريالية الثورية ليست مدرسة ولا مرحلة ولا موضة، بل وعي مستمر بضرورة الحلم كمحرك للتاريخ.
بهذه العبارة تختتم رحلة السريالية الثورية: من اللاوعي إلى الثورة، من الكلمة إلى الفعل، من الفن إلى الحياة.
فالحلم، في زمن الاغتراب الشامل، فعل مقاومة تاريخي ، مقاومة ضد النسيان، ضد الترويض، ضد موت الإنسان في ذاته.
19 ـ السريالية الثورية في مواجهة الرقابة والهيمنة الثقافية.
إذا كان للسلطة في أي مجتمع أن تبسط سيطرتها على الأفراد، فإن إحدى أقوى أدواتها هي التحكم في الثقافة والفكر والخيال. فالرقابة ليست مجرد منع نشر الكتب أو قمع الصحافة، بل هي أيضا سيطرة على الخيال وعلى اللغة وعلى الرموز. في هذا السياق، تصبح السريالية الثورية أكثر من مجرد حركة فنية؛ إنها مقاومة ضد كل أشكال الهيمنة الثقافية، سواء كانت سياسية، دينية، أو حتى اقتصادية.
أندريه بريتون والجيل السريالي المبكر لم يتوقف عند الفن فقط، بل اتخذ من الكتابة والشعر واللوحة ساحات تمرد ضد السلطة الرمزية. فكتابة النصوص السريالية، خاصة تلك الآلية أو التصادفية، كانت وسيلة لكشف التناقض بين العالم المعلن عنه والعالم الكامن في اللاوعي. كانت كل جملة غير متوقعة، كل صورة غير مبرّرة، صوتا ثوريا ضد المنطق الاستعبادي للوعي السائد.
وقد توسعت هذه الفكرة لتشمل السريالية العربية الحديثة. في الوطن العربي، حيث تتقاطع الرقابة السياسية والدينية مع ضغط الأعراف الاجتماعية، تصبح السريالية خط مقاومة ثقافي مزدوج: مقاومة ضد النظام الظالم، وضد لغة السلطة الرسمية التي تقمع الخيال. نرى ذلك عند شعراء مثل أدونيس، أنسي الحاج، محمود درويش، سعدي يوسف، حيث تحوّل الشعر إلى أرض مقاومة حقيقية. فالقصيدة تصبح فضاء لإعادة تركيب الواقع، لتفكيك الرموز المهيمنة، ولخلق لغة جديدة للحرية.
إن السريالية الثورية تواجه الهيمنة الثقافية الرأسمالية أيضا. فالسلطة الاقتصادية تتحكم في الفن وتحوّله إلى سلعة استهلاكية، تبيع الصور والأحلام كما تباع السلع في السوق. هنا، تصبح السريالية الثورية أداة لاستعادة الحلم من السوق، وتحويل الفن إلى فعل حقيقي للتغيير لا مجرد منتج للبيع. كما كتب هربرت ماركوز في الإنسان ذو البعد الواحد:
"الفن الذي يخضع للآلة الاقتصادية يقتل الإنسان. الفن الثوري هو المقاومة الحقيقية ضد هذه الموت الآلي."
الوعي السريالي الثوري، إذا، هو وعي مزدوج: وعي بالقمع الخارجي ووعي بالاستلاب الداخلي. كل تجربة فنية، كل نص شعري، كل لوحة، كل رواية ، هي ميدان صراع، حيث تقلب القواعد المألوفة، وتحرّر اللغة من قيودها التقليدية، ويصبح الحلم قوة حقيقية ضد الرقابة والهيمنة.
في الوطن العربي المعاصر، نجد هذه المقاومة السريالية في الشارع كما في الشاشة، في الجداريات كما في الأفلام التجريبية. فالفنان السريالي الثوري لا يكتفي بكشف القمع، بل يبني لغة بديلة، لغة تسمح بتجربة الحرية في الوقت ذاته، لغة تهدم الأشكال الرسمية لتعيد خلق الواقع على صورة الإنسان الحر.
20 ـ السريالية الثورية كأفق مستقبلي: الحلم والعمل كقوة للتغيير الاجتماعي.
النقطة الأخيرة في هذه الرحلة الفكرية العميقة هي استشراف مستقبل السريالية الثورية: كيف يمكن للحلم أن يصبح أداة عملية للتحول الاجتماعي؟ هنا تتجلى العلاقة الجدلية بين الحلم والفعل. فالخطر الحقيقي ليس في فقدان الحرية السياسية فحسب، بل في فقدان القدرة على الحلم. والحلم، وفق بريتون وفريدا كاهلو وأدونيس، هو قوة مادية لتغيير الواقع.
إن السريالية الثورية اليوم ليست ماض فنيا، بل مشروع مستقبلي. فهي تؤكد أن الإنسان، في عالم تتسارع فيه التكنولوجيا وتسيطر فيه خوارزميات الذكاء الاصطناعي، يجب أن يظل خالقا للحلم لا مجرد متلق للواقع. إنها دعوة لإعادة بناء الوعي الاجتماعي على أساس خيالي، بحيث يكون الخيال هو القاعدة التي تعيد تشكيل المؤسسات، والمدن، والتعليم، والعلاقات الاجتماعية.
تخيل إنسانا يعيش في مجتمع سريالي ثوري: يرى الواقع كما هو، لكنه يحلّق في إمكانياته، يتفاعل مع الحلم كفعل يومي، ويحوّل الرغبة إلى مشروع اجتماعي. هذا الإنسان لا يقبل الواقع كما هو، بل يحوّله من الداخل، بالخيال واللغة والفن. إنه يشبه ما وصفه لويس أراغون:
"الخيال هو مستقبل الواقع، والواقع هو نتيجة الخيال."
وفي السياق العربي، تصبح هذه الفكرة ثورية على مستوى المجتمع ككل. فبعد عقود من القمع، بعد أن أصبح الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي ضاغطا، يظهر الحلم السريالي كأفق جديد: أفق يمكن من خلاله إعادة إنتاج الحياة اليومية كفعل مقاومة. فالفن السريالي، والشعر، و السرد ، والموسيقى، والأفلام، والجداريات، وحتى وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تصبح ساحات لإعادة تشكيل الوعي الجمعي، ومختبرا لتجريب أفكار جديدة للمجتمع.
السريالية الثورية، إذن، هي جسر بين الخيال الفردي والفعل الاجتماعي، بين التحليل النقدي للواقع ورغبة الإنسان في تغييره. وهي تعيد التأكيد على أن كل ثورة حقيقية تبدأ بالحلم، وأن الحلم الذي لا يتحول إلى وعي جماعي يبقى ناقصا. وهكذا، يصبح كل شاعر، وفنان، ومفكر، ومواطن واع، عاملا في الثورة اليومية، حيث يصبح الحلم ممارسة فعلية، والعمل نتيجة للحلم.
السريالية الثورية، في هذا المعنى، ليست مجرد حركة تاريخية، بل مشروع دائم للتغيير، مشروع يربط بين الماضي والحاضر والمستقبل، بين الحلم والفعل، بين الفرد والجماعة، بين الفن والحياة. إنها تذكير بأن الحرية الحقيقية تبدأ في اللاوعي، وأن الإنسان الذي يفقد القدرة على الحلم، يفقد أيضا القدرة على الثورة.
وهكذا تختتم رحلتنا في عالم السريالية الثورية: من الكشف النفسي إلى الثورة الاجتماعية، من اللغة إلى الفعل، من الحلم إلى بناء الإنسان الجديد. إنها دعوة مستمرة لكل من يرفض أن يكون الواقع مجرد وصف، ولكل من يرى أن الحياة نفسها يجب أن تُعاش كأكبر تجربة إبداعية ثورية ممكنة.
خاتمة :
إذا كانت السريالية الثورية قد بدأت كتيار فني وفلسفي في قلب أوروبا بين الحربين العالميتين، فإنها اليوم، بعد أكثر من قرن، تثبت أنها ليست مجرد تجربة تاريخية عابرة، بل رؤية عميقة مستمرة لتحرير الإنسان والفكر والخيال واللغة. فهي رحلة من الداخل إلى الخارج، من الذات إلى المجتمع، من اللغة إلى العمل، ومن الحلم إلى الثورة. لقد أرادت السريالية الثورية منذ البداية أن تجعل من الفن واللغة أداة لتحرير الإنسان من كل أشكال الهيمنة، من السلطة المهيمنة على الجسم، على الفكر، على الرغبة، وعلى الخيال.
السريالية الثورية تمثل أيضا تجربة تاريخية وفلسفية للنقد الاجتماعي العميق. فهي تفضح أوجه الاستلاب في المجتمعات الرأسمالية والصناعية، وتكشف كيف أن الإنسان يسلب ليس فقط من أرضه ووقته وعمله، بل من حلمه، من قدرته على الإبداع، من لغته الخاصة، ومن حريته الداخلية. في هذا السياق، يصبح كل نص شعري، وكل لوحة فنية، وكل تجربة سردية، ميدان صراع ضد الاستلاب والاغتراب والهيمنة الثقافية.
وفي السياق العربي، أثبتت السريالية الثورية قدرتها على تحويل الواقع إلى مادة للخيال، والخيال إلى أداة للتحرر، واللغة إلى قوة مقاومة سياسية وثقافية. الشعراء والفنانون السرياليون العرب لم يكتفوا بتقليد التجربة الأوروبية، بل أضافوا إليها أبعادا محلية، جعلت من الفن السريالي مساحة لمواجهة الاستبداد، لمقاومة الرقابة، لإعادة بناء الوعي الجمعي، ولخلق لغة جديدة للحرية والجمال والمقاومة.
أبعد من ذلك، تحمل السريالية الثورية اليوم أفقا مستقبليا حقيقيا. فهي لا تعني الهروب من الواقع، بل إعادة بنائه من خلال الحلم والعمل معا، ومن خلال إدراك أن الخيال ليس رفاهية بل أداة سياسية واجتماعية. في عصر التكنولوجيا المهيمنة، والذكاء الاصطناعي، ووسائل الإعلام الشاملة، تصبح السريالية الثورية أكثر أهمية من أي وقت مضى، لأنها تحرر الإنسان من الهيمنة الرمزية، وتعيد للخيال دوره كقوة للتغيير، وتعيد للغة كفعل مقاومة حقيقي.
السريالية الثورية إذا، مشروع مستمر، ليس له نهاية، لأنه مرتبط بالإنسان نفسه. إنها تذكير دائم بأن الحرية الحقيقية تبدأ بالخيال، وأن الثورة تبدأ من الداخل قبل أن تتحقق في الخارج، وأن الحلم ليس مجرد رفاهية بل قوة إنتاجية للتغيير الاجتماعي والفكري والجمالي والسياسي. فهي تؤكد أن الإنسان الذي يفقد القدرة على الحلم يفقد أيضا القدرة على الثورة، وأن الإنسان الذي يملك القدرة على الحلم هو القادر على إعادة بناء العالم.
إن خاتمة هذا المشروع هي أن السريالية الثورية ليست مجرد حركة فنية أو فلسفية، بل أسلوب حياة ووعي دائم وحلم مستمر وفعل متواصل. إنها تدعونا جميعا، كأفراد ومجتمعات، أن نعيش في عالم تتحرر فيه اللغة من القيود، ويتحرر الفكر من الهيمنة، ويتحرر الخيال من الاستلاب، ويتحرر الإنسان من كل أشكال القيد، حتى نصبح نحن أيضا جزء من الثورة المستمرة للحياة نفسها، حيث يصبح الحلم والفعل واللغة والفن قوة واحدة لصنع إنسان جديد، ولإقامة مجتمع جديد، ولخلق عالم جديد، يكون فيه الإبداع والحرية والمقاومة عناصر أساسية للوجود، وليس مجرد رفاهية فنية.
#رياض_الشرايطي (هاشتاغ)



ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

|
حفظ
 |
بحث |
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
| إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
النضال البيئي بين العفوية والتنظّم في تونس: الواقع والآفاق.
-
بين تاريخ الوصاية وإغراءات «الإعمار»: ما يقترَح اليوم ليس مج
...
-
مشروع قانون المالية لسنة 2026: بين الوهم الاجتماعي وتكريس ال
...
-
الديني و الماركسي في خندق المقاومة وحدود الالتقاء: من طهران
...
-
اتفاق شرم الشيخ: عودة الانتداب بثوب أمريكي – قراءة في مشروع
...
-
غزة والمقاومة: غنيمة التّاريخ وبوصلة الأحرار
-
من -الشعب يريد- إلى -النهضة تقرر- إلى -الرئيس يقرر
-
الأفقية والقاعدية: تفكيك مفاهيمي وتحليل تطبيقي.
-
البناء القاعدي والتسيير الذاتي: بين النظرية، التجارب، والتحو
...
-
السلاح ، المخدرات و الادوية ، اسلحة للثراء و اخضاع الشعوب.
-
تحليل مقتضب للنرجسية الفردية و السّلطة والشعبوية.
-
الاعتراف بالدولة الفلسطينية: خطوة ناقصة في معركة طويلة ضد ال
...
-
الأدب العربي والترجمة: ساحة المقاومة والوعي.
-
الأدب والتكنولوجيا: بين انفتاح النص وقلق المستقبل.
-
نقد الإبداع وإبداع النقد.
-
بقايا الطلائع القديمة: الثورة بين الخطاب والممارسة والخيبة.
-
اللّجوء بين إنسانية العالم وابتزاز السياسة: في أزمة النظام ا
...
-
قراءة نقدية تفكيكية لرواية -أنا أخطئ كثيرا- للاديبة اللبناني
...
-
11 سبتمبر 2001 ، انطلاق اللّعبة الامبريالية الكبرى.
-
الحرب كحقل تجارب للذكاء الاصطناعي: كيف أصبحت غزة مختبرا للمر
...
المزيد.....
-
معطف بلاستيكي وحذاء مفتوح الأصابع.. إطلالات غريبة للمشاهير ع
...
-
صوت هند رجب يصل إلى الأوسكار.. تجربة سينمائية عربية تتجاوز ا
...
-
غوتيريش: إصلاح مجلس الأمن بات ضرورة ملحة لتعزيز التمثيل والف
...
-
-الفارسي-.. رواية بتفاصيل مذهلة كتبها عميل -سي آي إيه- عن صر
...
-
-الفارسي-.. رواية بتفاصيل مذهلة كتبها عميل -سي آي إيه- عن صر
...
-
ريشة خلف الحصار.. طفلة توثق مأساة غزة من زاوية خيمة النزوح
-
-القصة أكبر مني-.. سلمان رشدي يتحدث عن فيلم يوثق محاولة اغتي
...
-
شارع النبي دانيال بالإسكندرية.. قبلة المثقفين التي نسيها الم
...
-
لؤلؤة الأندلس تعود للنور: الليزر يفك طلاسم -مدينة الزاهرة- ا
...
-
اختلاف الروايات بشأن مقتل أمريكي برصاص ضباط أمن في مينيسوتا
...
المزيد.....
-
دراسة تفكيك العوالم الدرامية في ثلاثية نواف يونس
/ السيد حافظ
-
مراجعات (الحياة الساكنة المحتضرة في أعمال لورانس داريل: تساؤ
...
/ عبدالرؤوف بطيخ
-
ليلة الخميس. مسرحية. السيد حافظ
/ السيد حافظ
-
زعموا أن
/ كمال التاغوتي
-
خرائط العراقيين الغريبة
/ ملهم الملائكة
-
مقال (حياة غويا وعصره ) بقلم آلان وودز.مجلةدفاعاعن الماركسية
...
/ عبدالرؤوف بطيخ
-
يوميات رجل لا ينكسر رواية شعرية مكثفة. السيد حافظ- الجزء ال
...
/ السيد حافظ
-
ركن هادئ للبنفسج
/ د. خالد زغريت
-
حــوار السيد حافظ مع الذكاء الاصطناعي. الجزء الثاني
/ السيد حافظ
-
رواية "سفر الأمهات الثلاث"
/ رانية مرجية
المزيد.....
|
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

 |
بحث
|
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
|
إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة