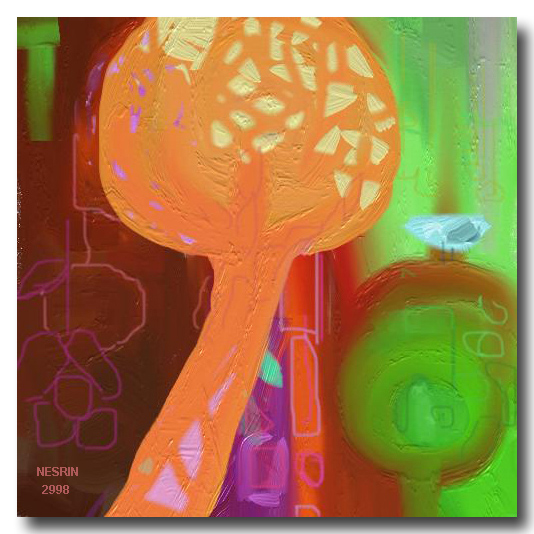|
|
(سيميولوجيا الأهواء وتجلياتها في قصيدة -أنثى الرمّان وآلهة الطوفان- للشاعرة د. بشرى البستاني)
سعد محمد مهدي غلام


الحوار المتمدن-العدد: 8476 - 2025 / 9 / 25 - 18:16
المحور:
الادب والفن
الملخص:
تُقدِّم هذه الدراسة قراءة سيميولوجية متعمقة لقصيدة "أنثى الرمّان وآلهة الطوفان" للشاعرة والأكاديمية د. بشرى البستاني، لا بوصفها نصًّا عاطفيًّا، بل كبنية دلالية متكاملة تُعيد تشكيل الهوية الأنثوية ضمن شبكة رمزية معقدة. من خلال منهج تحليلي تفكيكي جندري، نُظهر كيف تتحول الأهواء كالوجع، الرغبة، الخوف، الصمت، والانكسار من انفعالات ذاتية إلى علامات سيميائية فاعلة تُنتج المعنى، وتُعيد تعريف اللغة، والجسد، والوجود. وتستند الدراسة إلى مرجعيات نظرية غربية (شيفري، باشلار، ريكور، كريستيفا، هيدجر، فوكو...) ومراجع عربية (الغذامي، أبو ديب، سعدون)، لتؤكد أن القصيدة ليست تعبيرًا عن الذات، بل مشروعًا تأسيسيًّا لإعادة بناء العالم من منظور أنثوي عراقي عميق الجذور. وهكذا، لا تُقرأ الأهواء هنا كمشاعر، بل كقوى تأويلية تُعيد تشكيل الكون من جديد.
الكلمات المفتاحية:
الهوية الأنثوية، السيميولوجيا العاطفية، شعر التفعيلة، زهرة الرمان، دجلة، الجسد الأنثوي، الأهواء، الخطاب الشعري، بشرى البستاني.
المقدمة:
الأهواء كعلامات لا كعواطف (نحو سيميولوجيا للانفعال الشعري)
في قصيدة "أنثى الرمّان وآلهة الطوفان"، لا تُقدَّم المشاعر الإنسانية كالوجع، الرغبة، الخوف، النشوة، الصمت، الانتشاء، الهلاك، الخيانة، التوق، الطمأنينة كحالات نفسية عابرة أو انفعالات ذاتية ربما تعكس واقعًا نفسيًا عليلًا، بل بصفتها علامات سيميولوجية مُنتجة للمعنى، تُشكّل بنية نصية متكاملة، وتُعيد تعريف الذات الأنثوية، والكون، واللغة، والوجود. إن تشكلات الأهواء هنا لا تعبر فقط عن تجليات عوامل المرأة الأنثى في فضاء الواقع، بل تُصبح أجنحة تُحلق بها نحو نور الحقيقة المخفية، نحو ما وراء الدلالة، نحو الكينونة التي لا تُقال، بل تُعاش.
إن هذه القصيدة ليست مجرد نص شعري، بل حدث لغوي وجودي، يضعنا أمام مشكلة مركزية: كيف تتحول العواطف من حالات داخلية إلى أنظمة دلالية؟ وكيف يصير الألم هوية، والصمت استراتيجية، والرغبة طقسًا، والكسرة فعلًا تأسيسيًا؟
يقول جان ماري شيفري في كتابه لماذا الخيال؟: "الانفعال ليس حالة داخلية تُعبَّر عنها، بل نظام دلالي يُبنى داخل النص، ويُنتج علاقاته الخاصة مع الرموز، البنية، والقارئ." (1)
وهذا بالضبط ما تفعله الشاعرة بشرى البستاني: هي لا تبوح، بل تُنشئ. لا تشكو، بل تُكوّن. لا تعبر، بل تُعيد تشكيل العالم من جديد عبر شبكة من العلامات العاطفية التي تتحول إلى بنى لغوية، رمزية، وجودية.
وفي هذا السياق، يمكننا القول مع غاستون باشلار إن: "الشعر لا يُعبّر عن الانفعال، بل يُصوغه. إنه لا يُفرّغ الوجد، بل يُركّب المعنى من خلاله." (2)
لكن عند بشرى البستاني، لا يقف الأمر عند "تركيب المعنى"، بل يتعداه إلى خلق عالم جديد، حيث
١ الرمان ليس ثمرة، بل كينونة.
٢ دجلة ليس نهرًا، بل آلهة طوفان.
٣ الصمت ليس غيابًا، بل حضور معرفي.
٤ الكسرة ليست خطأ لغويًا، بل اختيار دلالي عميق.
وهذا ما يجعل قصيدتها قريبة من مشروع جوليا كريستيفا، حين تتحدث عن "الكتابة الأنثوية" باعتبارها: "فضاءً رمزيًا يُعيد تشكيل اللغة من الداخل، ويُفكك الثنائية التقليدية بين الذكر والأنثى، والمعنى واللا معنى." (4)
لكن الشاعرة العراقية لا تقف عند التفكيك، بل تذهب إلى ما بعد ذلك: إلى البناء من جديد، إلى إعادة تدوير الأبجدية، إلى إعادة تعريف الخطيئة والميلاد، إلى جعل زهرة الرمان مركز الكون.
وهنا، نرى كيف تتلاقى التجربة الشعرية مع ما يطرحه رولان بارت في "نظام العلامات" حين يقول: "النص الشعري الحديث لا يُشير إلى العالم، بل يُنتجه. إنه لا يُقلّد الواقع، بل يُعيد تشكيله من خلال اللغة." (5)
ومن هنا، فإن قراءتنا لهذه القصيدة لا يمكن أن تكون تلقائية أو عاطفية، بل يجب أن تكون قراءة سيميولوجية دقيقة، تتعامل مع كل شكل من الأشكال التالية: الكلمة، الصوت، الإيقاع، الصورة البلاغية، البنية النحوية، كعلامة ضمن شبكة دلالية متشابكة.
وقد أكد بول ريكور في "الرمزية للشر" أن: "الفعل الشعري لا يبدأ بالتعبير، بل بالتأويل. الشاعر لا يقول ما يشعر به، بل يُفسّر شعوره ليُنتجه كشيء جديد." (3)
وهذا هو بالضبط ما يحدث في "أنثى الرمّان": الشاعرة لا تعبر عن الوجع، بل تُفسره كهوية. لا تعبر عن الرغبة، بل تُعيد تعريفها كقوة كونية. لا تعبر عن الخوف، بل تُفككه كبنية داخلية للخطاب العاطفي.
وهكذا، فإن الأهواء في هذا النص لا تُقرأ كمشاعر، بل كأنظمة تأويلية فاعلة، تُعيد تشكيل العلاقة بين:
- الذات والآخر.
ب- الأنثى والذكر.
ج- الجسد والروح.
د- اللغة والوجود.
ولذلك، فإن مهمتنا في هذا المبحث هي تفكيك خمسة أهواء مركزية، ليس كحالات نفسية، بل كبنى سيميولوجية متكاملة:
1. الوجع بوصفه هوية بلاغة الوجع المؤسس.
2. الرغبة كقوة رمزية/كونية تتجاوز الجسد إلى الكون.
3. الخوف كقناعٍ للحب والنجاة المعكوسة : هندسة داخلية للعلاقة.
4. الصمت والانكسار بوصفهما استراتيجيتين أنثويتين للمعرفة والحماية.
5. الخطيئة والميلاد / تقاطع المقدس والمدنّس في الجسد الأنثوي.
قراءة هذه الأهواء لا تتم إلا من خلال ما يسميه مارتن هيدجر بـ"التفكير الأصيل"، حين يقول: "الشعر ليس تزيينًا للواقع، بل طريقة وجودية في العالم. وهو وسيلة الكشف عن الحقيقة." (6)
وهذا ما نجده في القصيدة: الشعر ليس تزيينًا، بل كشفٌ وجودي، انفراجٌ روحي، خلاصٌ لا يأتي من الآخر، بل من الذات.
"لا احتاج من يواسيني / مادامت المعجزة ملءَ دمي"
وهكذا، ندخل إلى قلب المشروع الشعري لبشرى البستاني: أن تُعيد تشكيل العالم من منظور أنثوي، لا كهامش، بل كمركز.
المحور الأول:
الوجع بوصفه هوية (بلاغة الوجع المؤسس)
"يقتلع شجر الحلم، يُشعل حدائق الحكمة"
"كسرتنا الكسرة في مخاض التشكيل"
"زهرة الرمان ملاذي، فنائي، حشري"
في هذه المقاطع الثلاثة، لا يظهر الوجع كمفعول عليه، ولا كحالة طارئة تمرّ على الذات، بل يُعاد تأطيره كـ فعل داخلي جوهري، كجزء من تكوين الهوية الأنثوية. فالوجع هنا ليس شيئًا يُقصى أو يُشفى، بل يُمنح وظيفة إبداعية مركزية: فهو ما يربط بين التجربة الجمالية (الرمان/الحكمة) وبين التهشيم (الاقتلاع/الكسر)، وهو ما يجعل المعنى واللغة والجمال يولدان من رحم الدمار.
هذا الوجع ليس انفعالاً عابراً، بل بنية تكوينية، تنتمي إلى ما يمكن أن نسميه بلاغة الوجع المؤسس ؛ أي تلك البلاغة التي لا تعبر عن الألم، بل تُنتجه كمكوّن أساسي في بناء الذات.
يقول غاستون باشلار في، "جماليات المكان": "الألم في الشعر ليس انفعالًا بل مادة بناء يُعاد تشكيله ليُنتج جمالًا من نوع جديد: جمال الجرح، جمال السقوط، جمال التمزق. إن الشاعر لا يتألم ليكتب، بل يكتب ليُعيد تشكيل ألمه كشيء جمالي." (2)
وهذا هو بالضبط ما يحدث في قصيدة "أنثى الرمّان": الشاعرة لا تحكي عن وجعها، بل تبني من خلاله عالمًا شعريًا متكاملًا، حيث يصبح الاقتلاع مصدرًا للحلم، وحيث تتحول الحدائق المشتعلة إلى محراب للحكمة.
"يقتلع شجر الحلم، يُشعل حدائق الحكمة"
جملتان متوازيتان في البنية، لكنهما متعاكستان في الدلالة:
الاقتلاع = تدمير.
الإشتعال = تجديد.
لكن في النسق الشعري، لا يكون الإشتعال مدمرًا، بل تطهيريًا، كما في الأديان الوثنية القديمة، حيث النار لا تُهلك، بل تُنقّي.
وهنا، نجد تشابهًا واضحًا مع ما يذهب إليه فريدريك نيتشه في ماقاله زارا Thus Spoke Zarathustra: "ما لا يقتلك يجعلك أقوى." ولكن عند بشرى البستاني، لا يكفي أن تنجو من الألم، بل يجب أن تُعيد تشكيل ذاتك من خلاله.
إن هذا التحوّل من "الوجع كمعاناة" إلى "الوجع كهوية" هو ما يجعل القصيدة نصًا وجوديًا، وليس مجرد شكاية عاطفية.
يؤكد بول ريكور في "الرمزية للشر" أن: "الألم لا يُفهم إلا عندما يُدمج في سيرة الذات، فيصير جزءًا من هويتها، لا طارئًا عليها. حينها، لا يُسأل لماذا أتألم؟ ، بل كيف أُبنى من خلال ألمي؟ ." (3)
وهذا هو بالضبط ما تقوم به الشاعرة:
هي لا تسأل "لماذا أتألم؟"،
بل تجيب: "لأنني أُخلق من جديد".
"كسرتنا الكسرة في مخاض التشكيل"
جملة قصيرة، لكنها حاملة لطبقة دلالية عميقة. فالكسرة هنا ليست خطأ لغويًا أو ضعفًا في التركيب، بل هي فعل دلالي عميق، يشير إلى أن الانكسار هو شرط التشكل.
الكسرة، كحرف لغوي، تمثل الضعف الظاهري، لكنها في هذا السياق، تُصبح رمزًا للقوة الخفية. فهي لا تكسر الكلمة فقط، بل تفتحها على معانٍ جديدة، وتُسقط سلطة الفتحة التي كانت تُعبّر عن اليقين والعلو.
وهنا، يمكننا الاستعانة بما يطرحه كمال أبو ديب في دراساته "حول اللغة والجسد" حين يقول: "في الكتابة الأنثوية الحديثة، لا تكون اللغة أداة تعبير، بل موقع صراع. والكسرة تصبح فعل مقاومة ضد هيمنة الصوت الذكوري في البنية اللغوية." (11)
وفي هذا السياق، فإن "الكسرة" في القصيدة ليست مجرد اختيار لغوي، بل فعل تفكيكي، يُعيد توزيع السلطة داخل النص، ويجعل من الهشاشة مصدرًا للحركة.
"زهرة الرمان ملاذي، فنائي، حشري"
هذه الجملة الثلاثية هي ذروة التحوّل: الرمان لم يعد ثمرة، بل كيانًا وجوديًا يحمل ثلاث وظائف:
- ملاذ: مكان للحماية.
- فناء: حالة للاندثار.
- حشر: يوم القيامة، يوم الجمع.
وهنا، نرى كيف يتحول الرمان إلى رمز كوني، يجمع بين الحياة والموت، بين الجمال والدم، بين الحب والخطيئة.
يقول سعيد سعدون في "الكتابة الأنثوية في الأدب العربي المعاصر": "الجسد الأنثوي في الشعر الحديث لا يُقدّم كمكان للرغبة، بل كفضاء رمزي متكامل، يحمل تاريخ الأسطورة، وذاكرة الجسد، ومشروع الخلاص." (14)
والرمان هنا هو هذا الجسد: ليس جسدًا بيولوجيًا، بل جسدًا رمزيًا، يحمل في بذوره كل ما فقدته الإنسانية، وكل ما يمكن أن تُعيد اكتشافه.
ومن هنا، فإن الوجع في القصيدة لا يُبكى عليه، ولا يُندب، بل يُحتفى به كشرط للخلق.
إنه وجد مؤسس، مثل مخاض الولادة، مثل اقتلاع الشجرة قبل زرعها من جديد، مثل إشعال النار قبل ظهور النور.
المحور الثاني:
الرغبة كقوة رمزية-كونية (تتجاوز الجسد إلى الكون)
"جاء دورك كي تعتنق عقيدة زهر الرمان"
"خالصة من عناد الدم ومكابرة الوجد"
"فاتحة ذراعيها لأفقٍ يصل الأرضَ بسماءٍ عاشرة"
في بنية هذه القصيدة، لا تُقدَّم الرغبة بوصفها توقًا جسديًا محضًا، ولا شهوة حسية تقليدية، بل كطاقة رمزية كونية تنبع من الداخل الأنثوي، وتُعاد توزيعها على الكون، واللغة، والأبجدية، والطوفان، والنار. فالرغبة هنا ليست طلبًا، بل مشروعًا وجوديًا، لا يطلب الآخر، بل يُعيد تشكيل العالم حول الذات.
الشاعرة لا تقول:
"أريدك"،
بل تقول: "اعتِنْ بعقيدة زهر الرمان".
وهذا التحوّل من "الطلب" إلى "العقيدة" هو ما يجعل الرغبة في هذا النص ظاهرة فلسفية وروحية، لا مجرد انفعال عابر.
تقول جوليا كريستيفا في" ثورة الشعرية": "الرغبة الأنثوية لا تطلب الآخر، بل تُعيد تشكيل الكون من حوله لتُصبح مركزًا لا هامشًا. وهي لا تبحث عن اكتمالها فيه، بل تُقرره منه." (4)
وهذا بالضبط ما يحدث في القصيدة: الأنثى لا تنتظر الآخر ليكملها، بل تُنادي العالم إلى مرجعيتها الحسية-المعرفية. فالرمان لم يعد ثمرة، بل معتقدًا متجددًا، وهو ليس غذاءً للجسد، بل غذاءً للروح، وصلاة يومية، وعهدًا وجوديًا.
"جاء دورك كي تعتنق عقيدة زهر الرمان"
جملة تشبه إعلانًا دينيًا، أو وصية ميتافيزيقية. فهي لا تدعو إلى الحب، بل إلى الاعتناق الروحي لرمز أنثوي مركزي. وهنا، نرى كيف تنتقل الرغبة من المستوى البيولوجي إلى المستوى الطقوسي.
وفي قولها:
"لا وصية تهديها إليه غير الدخول في زهرة رمان"
نجد كيف تتحوّل الرغبة إلى شفرة شعرية تشترط التماهي الكلي مع المعنى الأنثوي حتى تتحقق المعرفة والنجاة.
هذه الرغبة ليست رغبة تقليدية، بل هي:
أ- رغبة هيدجرية: تُنتج الوجود.
ب- رغبة صوفية: تُبقي النار مشتعلة لا للخراب، بل للانبعاث.
يقول مارتن هيدجر في "الكينونة والزمان": "الرغبة ليست نقصًا، بل طريقة الوجود في العالم، طريقة إعادة تشكيل الذات والعالم معًا. إن الشاعر لا يرغب لأن شيئًا ينقصه، بل لأنه يريد أن يُظهر ما كان خفيًا." (6)
وهذا هو بالضبط ما تقوم به الشاعرة: هي لا تشعر بنقص، بل تُعلن عن وجودها الكامل، وتدعو الآخر إلى الدخول في كينونتها، لا كمتلقٍ، بل كمشارك في الخلق.
"فاتحة ذراعيها لأفقٍ يصل الأرضَ بسماءٍ عاشرة"
الرقم "عشرة" ليس اختيارًا عرضيًا، بل هو إشارة إلى تجاوز النظام السماوي التقليدي (السبع سماوات)، إلى عالم موازٍ، إلى فضاء رمزي لا يخضع لله ierarchies الدينية أو الجندرية القائمة.
وهنا، نجد تشابهًا مع ما يطرحه ميخائيل باختين في نظريته عن -الفضاء المطلق-: "المرأة في الخطاب الشعري الحديث لا تفتح ذراعيها نحو السماء، بل تخلق سماء جديدة. وهي لا تتبع الفضاءات الموجودة، بل تُعيد تعريف الأفق." (15)
فالأنثى في القصيدة لا ترفع يديها دعاءً، بل تفتح أفقًا جديدًا، وتشكل نظامًا كونيًا بديلًا، حيث تكون هي مركز الجاذبية.
وهكذا، فإن الرغبة في هذا النص:
- لا تُستجدى.
- لا تُستجَد.
- لا تُبادل.
بل هي شرط وجودي، مثل الهواء، مثل الضوء، مثل اللغة.
يذهب عبد الله الغذامي في "الثقافة والرمز" إلى أن: "الكتابة الأنثوية في السياق العربي الحديث لا تتحدث عن الحب، بل عن الخلق. والرغبة عندها ليست شهوة، بل فعل تأسيسي لإعادة تعريف العلاقات الإنسانية من جذورها." (12)
وهذا ما نجده في القصيدة: الرغبة لا تُطلب، ولا تُمنح، بل تُعلن عنها كحقيقة واقعة، مثل الطوفان، مثل النار، مثل دجلة.
"خالصة من عناد الدم ومكابرة الوجد"
الدم والوجد رمزان تقليديان للعاطفة يتم استبعادهما هنا. 《فالرغبة》 لا تنبع من "عناد الدم" (الغرائز)،
ولا من《 "مكابرة الوجد"》 (العواطف المبالغ فيها)،
بل من مكان أعمق:
من 《العقل الرمزي》،
من《 الرؤية الكونية》،
من《 الهوية》:
التي تعي نفسها كمركز للوجود.
المحور الثالث:
الخوف كقناعٍ للحب والنجاة المعكوسة (هندسة داخلية للخطاب العاطفي)
"وكانت التهلكة معه هلاكاً طافحاً بالهلاك / رملاً متحركاً يأخذها لهاوية غاربة / وموتاً بلا موت"
> "التهلكة نجاةٌ معي إن دخلتِها فتحَتِ الحصونُ أبوابها / لكن/ كانت مذعوراً بلبلابٌ يلف عنقه"
في هذه المقاطع، لا يظهر الخوف في صورته البدائية كرهبة أو تقيّة أو ضعف أمام المجهول، بل يُعاد إنتاجه بوصفه هندسة داخلية للخطاب العاطفي، تكشف بنية العلاقة بين الأنا والآخر، وبين الأنثى والرجل، وبين الذات والمطلق. فالخوف هنا ليس انفعالًا سلبيًا، بل حركة بنيوية تُعيد توزيع السلطة داخل النص.
الشاعرة تصف "التهلكة" ليس كنهاية، بل كحالة متكررة، "طافحة بالهلاك"، وكأن الدمار نفسه أصبح نظامًا وجوديًا. و"الرمْل المتحرّك" لا يبتلع، بل يحمل نحو "هاوية غاربة"، أي هاوية لا تُرى، ولا تُدرك، بل تُعاش. و"الموت بلا موت" هو تعبير عن حالة توقف جوهرية: ليست الحياة، ولا الموت، بل سكون مؤلم في الفاصل بينهما.
وهذا ما يجعل القصيدة قريبة من مشروع جاك لاكان، حين يقول في ،"مقالات في التحليل النفسي"،: "الخوف في الخطاب الشعري غالبًا ما يكون قناعًا يخفي رغبة أعمق: رغبة في التماهي، في التسليم، في الانهيار المُنتج. فالذي يخشى من الآخر، في الحقيقة، يخشى من اكتماله دونه." (7)
وفي هذا السياق، فإن "التهلكة" ليست عقوبة، بل فرصة نجاة: "التهلكة نجاةٌ معي إن دخلتِها فتحَتِ الحصونُ أبوابها"
جملة تنقض الثنائية التقليدية
بين "التهلكة" و"النجاة"،
وتفكك البنية الأخلاقية التي تجعل من الخلاص شرطًا للبقاء. هنا، النجاة لا تأتي من الهروب من التهلكة، بل من الدخول الكامل فيها. وهذا يشبه ما يطرحه فريدريك نيتشه حول "الإرادة إلى القوة"، حيث لا يمكن الوصول إلى العظمة إلا عبر التدمير الذاتي.
لكن المفارقة الكبرى تأتي في السطر التالي:
"لكن/ كانت مذعوراً بلبلابٌ يلف عنقه"
الرجل، الذي كان يُفترض فيه أنه مصدر القوة، يصبح هو المذعور. واللبلاب، الذي يُعدّ رمزًا للحياة، يتحول إلى خنقة حول عنقه.
هذه الصورة الرمزية العميقة تكشف أن الخوف ليس خوف المرأة من الرجل، بل خوف الرجل من حرية المرأة، من استقلالها الوجودي، من قدرتها على الخلاص من خلال التهلكة.
يذهب إدوارد سعيد في "الثقافة والإمبريالية" إلى أن: "الخوف من الأنثى في الخطاب الاستعماري ليس خوفًا من جسدها، بل من قدرتها على تفكيك النظام وإعادة تشكيل العالم. فالمرأة الحرة تعني نهاية الهيمنة الذكورية، وبالتالي نهاية النظام نفسه." (8)
وهذا هو بالضبط ما يحدث في النص: الرجل لا يخشى من موت المرأة، بل يخشى من حياتها المستقلة، من خلاصها الذي لا يحتاج إليه، من نجاتها التي تتحقق عبر الدخول في زهرة الرمان :
أي في عالمها الخاص.
"كانت مذعوراً بلبلابٌ يلف عنقه"
اللبلاب هنا ليس مجرد نبات، بل رمز للارتباط القاتل، للارتهان العاطفي، للهيمنة الناعمة التي تُمارس باسم الحب.
وقد أشار عبد الله الغذامي في، "الذاكرة الثقافية"، إلى أن: "في الخطاب الشعري العربي الحديث، يتحول الحب أحيانًا إلى شبكة من العلاقات المقلوبة: حيث يدّعي الرجل الحماية، وهو في الحقيقة محبوس. ويبدو أنه يملك، وهو في الحقيقة أسير." (13)
وهكذا، فإن الخوف في هذا النص ليس انفعالًا، بل علامة على عجز الذكورة أمام مطلق الأنثى. إنه قناع للحب الناقص، وعلامة على فقدان القدرة على احتضان الرغبة الكبرى التي تُجسدها المرأة/زهرة الرمان.
فالرجل لا يستطيع أن "يدخل في زهرة رمان"، لأنه لا يفهم أن الخلاص لا يأتي من القوة، بل من التواضع أمام الكينونة الأنثوية.
المحور الرابع:
الصمت والانكسار (استراتيجيتان أنثويتان للمعرفة والحماية)
"تقول / وهو في الطفولة ... تصمت، / كي تظل محفوفة بملائكة العرش"
"لم تقل له: إنه لم يكن وطنًا لأمنه... ولذلك لم تصدق"
في بنية قصيدة "أنثى الرمّان وآلهة "، لا يُمثّل الصمت غيابًا، ولا عجزًا لغويًا أو نفسيًا، بل حضورًا عميقًا يتجاوز الفعل اللفظي، ويؤسّس لبُعد سيميائي مغاير. فالأنثى هنا لا تصمت لأنها عاجزة عن الكلام، بل لأنها تملك المعرفة الكاملة، وتمنحها فقط لمن يُتقن الإصغاء بباطنه.
الصمت، في هذا السياق، هو طقسٌ معرفي روحي، يحمي الذات من اختراق دنيوي للمقدّس، ويُعيد تعريف السلطة الأنثوية كـ صمت فاعل، لا خضوع سلبي.
يقول ميشيل فوكو في، "تأويل الذات": "الصمت في النصوص الحديثة ليس غيابًا، بل حضور استراتيجي؛ حضور يُعيد تعريف السلطة من خلال ما لا يُقال. إن القول لا أتكلم قد يكون أقوى من أي خطاب." (9)
وهذا هو بالضبط ما تقوم به الشاعرة: هي لا ترفض الحديث، بل تختار التكتم كوسيلة للحفاظ على حرمة التجربة، وكطريقة لضبط التوازن بين الحقيقة والخذلان.
"تصمت، / كي تظل محفوفة بملائكة العرش"
الصمت هنا ليس انعزالاً، بل حالة اتصال أعلى، اتصال بالسماء، بالروح، بالسرّ الذي لا يُشارك.
وقد أشار كمال أبو ديب في "الشعر الحديث: البنية والدلالة" إلى أن: "في الكتابة الأنثوية العربية المعاصرة، يصبح الصمت فعل مقاومة ضد هيمنة الخطاب الذكوري الذي يفرض نفسه بالصوت العالي. والأنثى لا تنطق إلا عندما تدرك أن صوتها لن يُحوّل إلى شعار أو أداة توظيف." (11)
وفي موقع آخر:
"لم تقل له: إنه لم يكن وطنًا لأمنه... ولذلك لم تصدق"
الصمت هنا يصبح شكلاً من المقاومة المعرفية، طريقة لرفض الاعتراف بالسلطة الزائفة، ولضبط العلاقة مع الآخر من دون أن تفقد السيطرة على ذاتها.
المرأة لا تكذب، ولا تصرخ، ولا تندفع في الحوار، بل تلتزم الصمت، ليس استسلامًا، بل حكمة وجودية.
أما الانكسار : الذي يتجلى في مفردات مثل "الكسرة"، "الكسر"، "لا ضمّة تؤوينا" ؛ فهو ليس ضعفًا لغويًا أو شعوريًا، بل هو الجزء الجارّ من البنية:
أ- الكسرة تجرّ الألم.
ب- تُحيل المعنى إلى الداخل.
ج- وتُسقط السلطة التي كانت تستند إلى الفتح والعلو.
"تصطرع بين فتح الكاف وكسرها / والكسرُ أقوى / فقد جرّ الأملَ والألمَ وما حولهما"
هذه الثلاثية الشعرية تمثل لحظة تحوّل جوهرية في بنية اللغة والهوية معًا. فالصراع ليس بين كلمتين، بل بين نظامين:
١ نظام الفتح: اليقين، الهيمنة، العلو.
٢ نظام الكسر: التساؤل، التواضع، الغوص.
والكسرة، رغم ظاهرها الضعيف، تنتصر: "والكسرُ أقوى" لأنها لا تُخفي، بل تُظهر، وتُعمق، وتُحدث.
تذهب جوليا كريستيفا في "ثورة الشعرية" إلى أن: "الانكسار في الكتابة الأنثوية ليس ضعفًا، بل قوة، لأنه يُعيد تشكيل اللغة من داخلها عبر الكسر، التمزق، التشتت. والكتابة لا تبدأ حيث تنتهي اللغة، بل حيث تنهار." (4)
وهنا، تتحول الكسرة إلى حرف سيميولوجي فاعل، يرمز إلى الجرح، والإرغام، والانكسار المُبدع. إنها ليست علامة على الخلل، بل على الحركة الداخلية، على الدفع نحو التشكل.
وقد أشار سعيد سعدون في "الكتابة الأنثوية" إلى أن: "الأنثى في النص الشعري المعاصر لا تُبنى من خلال التماسك، بل من خلال الشقوق. وهي لا تُعلن عن نفسها من خلال الوحدة، بل من خلال التصدع. فالانكسار عندها ليس نهاية، بل بداية." (14)
وهكذا، فإن الصمت والانكسار، في هذا النص، هما وجهان لاستراتيجية أنثوية عليا:
- لا تقف على باب الرجاء.
- ولا تطلب الاعتراف.
بل تبني المعنى من الداخل، من الكسور، ومن ما لا يُقال.
إنها استراتيجية القوة من خلال الضعف، مثل تقليد "الكنتسوغي" الياباني، الذي لا يُخفي الكسر، بل يُضيء عليه بالذهب، ليجعل من العيب جمالًا، ومن الشقّ تحفة.
المحور الخامس:
الخطيئة والميلاد (تقاطع المقدس والمدنّس في الجسد الأنثوي)
"قالت له ذات عذاب: / سأذهب إلى الجنة بدونك..."
"لا وصية تهديها إليه غير الدخول في زهرة رمان."
"أنا مريمُ السرّ / ولهم الخطيئة"
في هذه المقاطع الثلاثة، لا يُقدَّم الجسد الأنثوي بوصفه وعاءً للرغبة فحسب، بل يُبنى بوصفه نقطة التقاء بين المتضادات: الخطيئة والميلاد، الطوفان والخلاص، العتمة والنور، الإثم والمعجزة. فالجسد هنا لم يعد مكانًا للخطيئة، كما في الخطاب اللاهوتي التقليدي، بل حارسًا للحقيقة، وممرًا نحو التجلّي.
الشاعرة تعلن بصوتٍ لا يحتمل التأويل:
"سأذهب إلى الجنة بدونك..."
جملة تنقض الثنائية القائمة بين "الأنثى/الخطيئة" و"الذكر/النجاة"، وتُعيد توزيع المقدس:
- الأنثى هي الحاملة للمعجزة.
- الآخرون، خطؤهم ليس في الجسد، بل في الجهل بنوره.
وهذا ما يجعل قصيدتها قريبة من مشروع جورج باتاي، حين يقول في" الإيروسية": "الجسد الأنثوي في الشعر الحديث لا يُقدّم كخطيئة، وإنما كفضاء للمقدس، حيث يتقاطع الإثم مع النور، والدم مع القيامة. فالأنثى ليست مصدر الشر، بل مصدر الحياة التي لا يمكن فهمها إلا من خلال الموت." (10)
وفي قولها:
"أنا مريمُ السرّ / ولهم الخطيئة"
تُعلن الشاعرة عن انقلاب رمزي كامل على التاريخ الثقافي والديني. فـ"مريم" لم تعد مجرد أم للمسيح، بل حاملة السرّ الكوني، صاحبة المعرفة الأولية، مركز الخلق.
وقد أشار عبد الله الغذامي في "الثقافة والرمز" إلى أن: "في الكتابة الأنثوية العربية المعاصرة، تُعاد توظيف شخصيات دينية نسائية (مريم، حواء، ليلى) ليس كضحايا، بل كقائدات لمشروع معرفي جديد. والأنثى لم تعد رمزًا للسقوط، بل للصعود." (12)
وزهرة الرمان، في هذا السياق، تتحوّل إلى محراب، لا مجرد استعارة حسية. إنها فضاء طقوسي يُعاد فيه تعريف العلاقة بين الجسد، الروح، المقدس، والمدنّس.
"لا وصية تهديها إليه غير الدخول في زهرة رمان."
الدخول في زهرة الرمان ليس فعلًا جنسيًا، بل طقسًا معرفيًا، شرطًا للنجاة، وسيلة الوصول إلى المعنى.
وهنا، نرى كيف تتلاقى التجربة الشعرية مع ما يطرحه مارتن هيدجر حول "الوجود الأصيل"، حين يقول: "الإنسان لا يصل إلى الحقيقة من خلال الفهم العقلي، بل من خلال الانغماس الوجودي في الكينونة. الدخول في الشيء هو الطريقة الوحيدة لفهمه." (6)
فالدخول في زهرة الرمان هو انغماس وجودي، ليس في الجسد، بل في المعنى الذي يحمله الجسد.
وهكذا، تتقاطع الخطيئة مع الميلاد، كما تتقاطع زهرة الرمان في نكهة دمها:
الخطيئة هنا = وعي سابق للنظام.
الميلاد = لغة تعيد تشكيل العالم وفق إيقاع الأنثى.
يقول سعيد سعدون في "الكتابة الأنثوية": "الأنثى في النص الشعري المعاصر لا تُولد من دون خطيئة، لأن الخطيئة هي شرط المعرفة. وهي لا تُخلص من الخطيئة، بل تُخلص من خلالها." (14)
والقصيدة تصل إلى الذروة في قوله:
"لا احتاج من يواسيني / مادامت المعجزة ملءَ دمي / وفي دمه وعلى شفتيه بلابل تحتضر"
الخلاص ليس بالآخر، بل من خلال الذات / ذات تعرف أنها مذنبة بالنور، وتُولد من الخطأ إلى الفهم، ومن العتمة إلى شعرية المعرفة.
الدم هنا ليس دم عقاب، بل دم خلق. والبلابل على الشفاه ليست حيوانات، بل رموز للروح التي تصارع الموت.
الخاتمة:
الأهواء بوصفها نظامًا تأويليًا وفاعلية شعرية أنثوية
في "أنثى الرمّان وآلهة الطوفان"، لا تُقدَّم الأهواء بوصفها مشاعر سطحية أو انفعالات لحظية، بل بوصفها قوى سيميولوجية تُعيد تشكيل اللغة، وتفكك السلطة، وتؤسّس لذات أنثوية كونية تمتلك اللغة، والخلق، والرؤية.
لقد رأينا عبر المحاور الخمسة أن:
أ- الوجع لا يُبكى عليه، بل يُبنى به. إنه بلاغة الوجع المؤسس، الذي يُنتج الجمال من رحم الدمار.
ب- الرغبة لا تُستجدى، بل تُستعاد كطقس للمعرفة. وهي لا تطلب، بل تُنادي العالم إلى مرجعيتها الحسية-المعرفية.
ج- الخوف لا يُدان، بل يُفكك كعلامة على عجز الآخر عن احتواء الكينونة. فالرجل يخشى خلاص المرأة، لا موتها.
د- الصمت والانكسار لا ينتميان إلى اللاكلام، بل إلى بلاغة مزدوجة من الحماية والفهم، وهما استراتيجيتان أنثويتان عليا تبنيان المعنى من الداخل.
ه- الخطيئة والميلاد لا يتعارضان، بل يشكلان قطبي الكينونة التي تعي أنها "مريم السرّ"، لا موضوع الفقد.
الشاعرة، وهي بروفيسورة في النقد الحديث، لا تكتفي بإعادة كتابة الأنثى، بل تُعيد تدوير الأبجدية، والانفعال، والطوفان، والرمز، والأسطورة ضمن شبكة شعرية سيميائية متقنة، تُصبح فيها الأهواء تجربة جمالية، تأويلية، ومعرفية في آنٍ.
هذه القصيدة لا تُقرأ، بل تُحلّ كما تُحلّ الشفرات، وتُطاف بها كما يُطاف بالرموز الكبرى، وفي قلبها: زهرة الرمان / الكلمة الأولى/ الميلاد الأخير/ المجاز الذي لا ينضب.
قائمة المراجع:
1. شيفري، جان ماري، لماذا الخيال؟، ترجمة: عبد الله الغذامي، بيروت: المركز الثقافي العربي، 2005، ص 145.
2. باشلار، غاستون، جماليات المكان، ترجمة: جورج طعمة، بيروت: دار التنوير، 1990، ص 88.
3. ريكور، بول، الرمزية للشر، ترجمة: طه عبد الرحمن، بيروت: المركز الثقافي العربي، 1996، ص 212.
4. كريستيفا، جوليا، ثورة الشعرية، ترجمة: محمد برادة، بيروت: دار التنوير، 1985، ص 95 و203.
5. بارت، رولان، نظام العلامات، ترجمة: محمد الجراح، بيروت: منشورات عويدات، 1981، ص 77.
6. هيدجر، مارتن، الكينونة والزمان، ترجمة: توفيق الطويل، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1987، ص 145.
7. لاكان، جاك، مقالات في التحليل النفسي، ترجمة: نبيل صبري، القاهرة: دار الشروق، 2003، ص 188.
8. سعيد، إدوارد، الثقافة والإمبريالية، ترجمة: كمال أبو ديب، بيروت: دار الآداب، 1998، ص 188.
9. فوكو، ميشيل، تأويل الذات، ترجمة: يوسف زيدان، القاهرة: دار الشروق، 2005، ص 112.
10. باتاي، جورج، الإيروسية، ترجمة: عبد الله الغذامي، بيروت: دار الساقي، 2000، ص 66.
11. أبو ديب، كمال، الشعر الحديث: البنية والدلالة، دمشق: دار الفكر، 1995.
12. الغذامي، عبد الله، الثقافة والرمز، بيروت: دار الثقافة، 2003.
13. الغذامي، عبد الله، الذاكرة الثقافية، بيروت: دار التنوير، 2001.
14. سعدون، سعيد، الكتابة الأنثوية في الأدب العربي المعاصر، بيروت: دار الثقافة، 2005.
15. باختين، ميخائيل، الشعرية الرومانسية، ترجمة: نبيل الصغير، بيروت: المركز الثقافي العربي، 1992.
#سعد_محمد_مهدي_غلام (هاشتاغ)



ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
الكاتب-ة لايسمح
بالتعليق على هذا
الموضوع
|
نسخة قابلة للطباعة
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

|
حفظ
 |
بحث |
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
| إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
(هَلْ مُمْكِنٌ؟)
-
(قبسات من وجهها في الليل المتحرك:تواقيع شوارِد سماء رصاصية)
-
(مجازُ الانطفاءِ العظيم)
-
(وقفة تفكيكية/ثقافية لقصيدة -أنثى الرمّان في رؤيا آلهة الطوف
...
-
(وطنٌ نُنشِّقُهُ كمِسْكِ الجِراحِ)
-
(وَجْدٌ عَلى جَناحِ نُورس)
-
(صَليلُ الذَّاكِرةِ:جَدَلُ الأَجْفانِ الحافيةِ)
-
( مع جُذورُ الحَيْرةِ في مَرافئِ الرَّماد ،حارَتْ إِليَّ وأَ
...
-
(رُهابُ الزَّهرةِ: تَراسيمُ الكادابول)
-
(بَناتُ الأَفْكارِ – رَقيم)
-
(شِباكٌ في العَتْمَة:الشَّيْخُ وَالبَحْرُ)
-
(تاجُ بَلقيسَ وَفَسْقيَّةُ المَرْجان)
-
(على تخوم الشَّمال ومَراتِع الخُزامى:نَزْوة)
-
(مَرْثِيةُ آيْلان – كُورانُ الرَّمادِ)
-
الأنوثة المبدعة بين الزمن والرمز: قراءة سيميائية في قصيدتي -
...
-
(قِيَام نَوافِل) (تَهَيُّؤات)
-
( فقط اِبْتَعدِي ...!)
-
(وَجهٌ يَنحَني عَلى غَيمٍ يَشربُ الضَّوء:رَصيفُ رَحيقِ شَفتي
...
-
(ظلالُ الطوفان: رِهانٌ)
-
(حين يُفتي القاضي مرتين: زوال الحياد القضائي ومخالفة النظام
...
المزيد.....
-
الخوف بوصفه نظامًا في رواية 1984 للكاتب جورج أورويل
-
الدكتور ياس البياتي في كتابه -خطوط الزمن-: سيرة إنسان ووطن
-
رفع الحجز عن معاش الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بقرار رسمي عاجل
...
-
هل هجرت القراءة؟ نصائح مفيدة لإحياء شغفك بالكتب
-
القضية الخامسة خلال سنة تقريبًا.. تفاصيل تحقيق نيابة أمن الد
...
-
فيلم -عملاق-.. سيرة الملاكم اليمني نسيم حميد خارج القوالب ال
...
-
احتفاء كبير بنجيب محفوظ في افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب
...
-
هل ينجح مهرجان المنداري ببناء جسر للسلام في جنوب السودان؟
-
مخرجة فيلم -صوت هند رجب-: العمل كان طريقة لـ-عدم الشعور بالع
...
-
-أغالب مجرى النهر- لسعيد خطيبي: الخوف قبل العاصفة
المزيد.....
-
دراسة تفكيك العوالم الدرامية في ثلاثية نواف يونس
/ السيد حافظ
-
مراجعات (الحياة الساكنة المحتضرة في أعمال لورانس داريل: تساؤ
...
/ عبدالرؤوف بطيخ
-
ليلة الخميس. مسرحية. السيد حافظ
/ السيد حافظ
-
زعموا أن
/ كمال التاغوتي
-
خرائط العراقيين الغريبة
/ ملهم الملائكة
-
مقال (حياة غويا وعصره ) بقلم آلان وودز.مجلةدفاعاعن الماركسية
...
/ عبدالرؤوف بطيخ
-
يوميات رجل لا ينكسر رواية شعرية مكثفة. السيد حافظ- الجزء ال
...
/ السيد حافظ
-
ركن هادئ للبنفسج
/ د. خالد زغريت
-
حــوار السيد حافظ مع الذكاء الاصطناعي. الجزء الثاني
/ السيد حافظ
-
رواية "سفر الأمهات الثلاث"
/ رانية مرجية
المزيد.....
|
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

 |
بحث
|
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
|
إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة