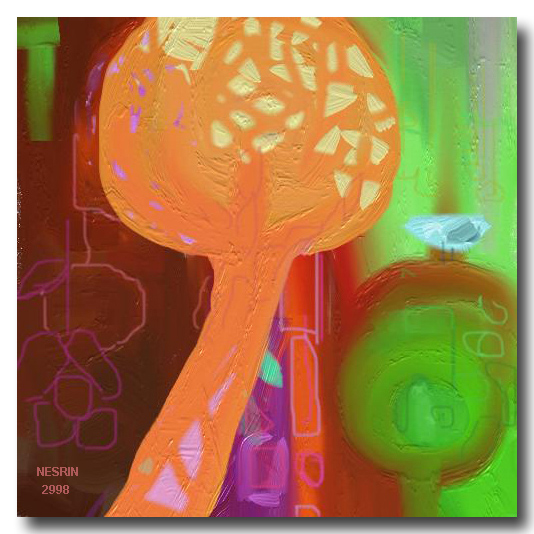|
|
نقد الإبداع وإبداع النقد.
رياض الشرايطي


الحوار المتمدن-العدد: 8469 - 2025 / 9 / 18 - 15:33
المحور:
قضايا ثقافية
☆ حين يتحوّل السؤال إلى ثورة لغوية وفكرية :
حين يتحوّل السؤال إلى ثورة لغوية وفكرية
منذ فجر التاريخ، حين كان الإنسان يرسم بيد مرتعشة حيوانا بريا على جدار كهفه، لم يكن يعبث بالزخرفة، بل كان يبتكر لغة. كان يحاول أن يخلّد أثره، أن يقول: "لقد كنت هنا." لقد كان الإبداع، منذ لحظته الأولى، فعل مقاومة ضد الزوال. كان مواجهة مع العدم، مواجهة مع الطبيعة التي كانت تتربص به، مواجهة مع الزمن الذي يهدده بالمحو. الشعر الأول، الحكاية الأولى، الأغنية الأولى، كلها لم تكن من باب الرفاهية جمالية، بل كانت حاجة وجودية، كالماء والخبز والنار.
لكن، منذ تلك اللحظة أيضا، وُلد النقد. لم يكن النقد كتابا منفصلا، بل كان سؤالا ينخر في وعي الجماعة: لماذا رسم هذا الحيوان بالذات؟ لماذا اختار هذه الألوان؟ هل هذا الطقس المقدس يعكس خوفا أم أملا؟ النقد، منذ البداية، لم يكن قمعا للإبداع بل كان دهشة ثانية: إذا كان الإبداع هو الدهشة الأولى أمام العالم، فالنقد هو الدهشة الثانية أمام النص. الإبداع يقول: "هذا ما أراه." والنقد يردّ: "لكن ماذا يعني ما تراه؟ ماذا تخفي؟ ضد من تقف؟"
هذه الثنائية بين الإبداع والنقد ليست علاقة عداء محض ولا علاقة تبعية صرفة، بل علاقة جدلية تاريخية. في كل عصر نجد هذا التوتر: المبدع يريد أن ينفلت من كل قيد، والناقد يعيده إلى أسئلة العقل والمجتمع والتاريخ. المبدع يشبه البركان المنفجر، والناقد يشبه الجيولوجي الذي يحاول أن يرسم خريطة للحمم. المبدع يحلم، والناقد يسائل. ومن هذا الاحتكاك، يولد الشرر.
لقد اتهم الشعراء عبر العصور النقاد بأنهم "قضاة بلا قلب"، وأنهم يقتلون النصوص بالتحليل البارد. فردّ النقاد بأن الشعراء "أطفال متوحشون"، يكتبون دون وعي، وأن مهمتهم هي أن يضعوا النظام في الفوضى. لكن الحقيقة أعمق من هذا التراشق: فلا يمكن للإبداع أن يعيش بلا نقد يوقظه، ولا يمكن للنقد أن يوجد بلا إبداع يغذّيه. النقد هو روح ثانية للنصوص، والإبداع هو الجسد الذي يمنح النقد مادة الحياة.
من هنا تأتي أهمية المعادلة: نقد الإبداع وإبداع النقد. ليست مجرد عبارة بل إعلان ثوري عن وحدة متوترة: أن نقرأ النصوص لنفككها، لكن أيضا أن نكتب النقد نفسه كنصّ جديد. أن يتحوّل النقد من سلطة إلى تحرير، وأن يتحوّل الإبداع من نزوة فردية إلى حدث جماعي يُعاد إنتاجه باستمرار عبر النقد. إنها علاقة تواطؤ وصراع في آن واحد: يفضح أحدهما الآخر، لكنه في الوقت ذاته لا يعيش بدونه.
1. نقد الإبداع: بين الفهم والتقويض .
النقد ليس تعليقا على النصوص كما يفعل الشراح، بل هو حفر وكشف. عندما نقرأ قصيدة أو رواية أو لوحة، لا يكفينا أن نصف جمالياتها، بل علينا أن نغوص في أعماقها. النقد هنا يشبه عملية تنقيب أثرية: النص كمدينة مطمورة، والناقد كمن يزيح الرمال ليكشف عن بناياتها المخفية، عن طرقها، عن أصداء أصوات من سكنوها.
بول ريكور قال: "النص أكثر حكمة من مؤلفه." هذه الجملة تختصر معنى نقد الإبداع: النصوص دائما أكبر من نوايا مبدعيها. المبدع قد يكتب بدافع ذاتي أو لحظة وجدانية، لكن النص يذهب أبعد: يدخل في التاريخ، يتحوّل إلى وثيقة عن عصره، يكشف تناقضات مجتمعه، يبوح بما لم يكن واعيا في عقل صاحبه. النقد هو الذي يستخرج هذه الحكمة الكامنة.
لكن النقد الثوري لا يكتفي بالفهم، بل يذهب نحو التقويض. فكل نص، مهما كان جميلا، يحمل داخله تناقضات: قد يمجّد الحرية بلغة عبودية، أو يتغنّى بالثورة بلسان برجوازي، أو يحتفي بالجمال وهو يعيد إنتاج أيديولوجيا السلطة. النقد هنا ليس متفرجا بل مقاتلا: يكشف هذه المفارقات، يفضح ما يخفيه النص تحت زخارفه. رولان بارت حين أعلن "موت المؤلف" كان يفتح الباب أمام هذا النقد الثوري: لم يعد النص رهينة نية صاحبه، بل صار ملكا للقراء، قابلا للتأويلات اللامتناهية.
بهذا المعنى، النقد هو فعل تحرير. إنه يحرّر النصوص من سلطة مبدعيها، من سلطات القراءات الرسمية، من أسر المناهج الجامدة. وهو أيضا فعل سياسي: لا يسأل فقط "كيف كُتب النص؟" بل يسأل: "مع من يقف؟ ضد من يكتب؟ هل هو أفيون ينوّم أم شرارة توقظ؟" هنا يلتقي النقد مع الماركسية التي ترى الأدب جزء من الصراع الطبقي. كما قال لوكاتش: "الأدب العظيم يكشف التناقضات الاجتماعية في صميمها." والنقد هو الذي يعرّي هذه التناقضات، يوضح كيف يُستخدم الأدب لتكريس سلطة أو لتقويضها.
إن نقد الإبداع بهذا المعنى هو صراع مزدوج: مع النصوص نفسها لكشف أعماقها، ومع النظام الاجتماعي الذي تنتجه النصوص وتُنتج فيه. إنه نقد لا يهادن: لا يتعامل مع الأدب كزينة، بل كجبهة قتال. ولهذا، فهو نقد ثوري بالضرورة.
غرامشي قال: "المثقف هو من يجعل اللاوعي الجمعي وعيا." وهذا بالضبط ما يفعله الناقد حين يمارس نقد الإبداع: يلتقط ما هو مبعثر في النصوص، ما هو غامض ومضمر، ويحوّله إلى وعي جماعي قادر على المقاومة. إنه لا يفسر الأدب فقط، بل يحوّله إلى سلاح.
2. إبداع النقد: حين يتحوّل الناقد إلى شاعر آخر .
لكن النقد إذا بقي أسير التحليل الجاف فإنه يفقد روحه. النقد لكي يكتمل، عليه أن يتحوّل بدوره إلى إبداع. أي أن يصبح نصا جديدا، له لغته الخاصة، إيقاعه، جماليته. النقد العظيم لا يشرح الأدب فقط، بل يُكتب كأدب.
لقد أدرك الجاحظ هذا مبكرا. فكتبه ليست نصوصا نقدية صامتة، بل عوالم ممتلئة بالصور، بالجدل، بالقصص، بالسخرية، بالحكمة. نقرأ البيان والتبيين فنجد أننا أمام نصّ يتدفّق بالحياة، لا يقل إبداعا عن الشعر الذي يناقشه. بورخيس بدوره كتب نقدا يلامس الخيال: مقالاته النقدية أقرب إلى قصص متخيلة، حتى ليصعب أن نعرف أين يبدأ النقد وأين ينتهي الأدب. أمّا أدونيس، فقد جعل النقد امتدادا للشعر: مقالاته تُقرأ كقصائد فكرية، يتقاطع فيها المفهوم بالأسطورة.
النقد هنا يتحوّل إلى شعر من نوع آخر: ليس شعر الصور بل شعر الأفكار، ليس شعر الإيقاع بل شعر الحفر في المعنى. الناقد يصبح شاعرا للأسئلة، شاعرا للقراءات الممكنة. وهكذا يتحقق ما قاله تزفيتان تودوروف: "النقد العظيم هو الذي يصبح بدوره أدبًا."
إبداع النقد يعني أن الناقد يخلق لغة جديدة. لا يكتب بلغة خشبية أكاديمية، بل بلغة حيّة، متوترة، مفتوحة على المجاز. النقد حينها لا يظلّ طفيليًا على النصوص، بل يتحوّل إلى نصّ مستقل، قادر على إثارة الدهشة بذاته. إنه كتابة ثانية: لا تقل جمالا عن الأولى، بل قد تتفوّق عليها أحيانا لأنها تجمع بين الفكرة والجمال.
كما قال أدونيس: "النقد هو الوجه الآخر للشعر، وجهه الذي يرى العالم." والشعر من دون هذا الوجه الآخر قد يظل منغلقا في ذاته، أما النقد الإبداعي فيفتح له عيونا أخرى.
هكذا يصبح إبداع النقد ثورة ثانية: إذا كان الإبداع هو الثورة الأولى ضد الصمت، فإن إبداع النقد هو الثورة الثانية ضد المعنى المغلق. الأولى تخلق النص، والثانية تعيد خلقه. وبذلك، لا يعود النقد سلطة على الإبداع، بل شريكا له في ولادة لا تنتهي.
3. التوتر الخلّاق: صراع أم جدلية؟.
إن العلاقة بين النقد والإبداع ليست علاقة خصومة بسيطة يمكن حسمها بانتصار طرف على آخر، بل هي علاقة جدلية يتغذى فيها كل طرف من الآخر. فلو عاش الإبداع في عزلة كاملة عن النقد، لتحوّل إلى صرخة عابرة لا ذاكرة لها. ولو عاش النقد بلا إبداع، لتحوّل إلى آلة بيروقراطية تلوك نفسها في فراغ.
لقد وعى هيغل هذا حين تحدث عن "الجدل" بوصفه محرّك التاريخ: الأطروحة تولّد نقيضها، ومن صدامهما تنبثق تركيبة جديدة. هكذا أيضا، النص الإبداعي يولّد نقده، والنقد يولّد بدوره نصوصا جديدة. فالقصيدة التي تُكتب اليوم ستُقرأ بعد عقود بمنظار آخر، وربما تُفجّر معاني لم يكن الشاعر يحلم بها. النقد هنا ليس نهاية، بل بداية جديدة.
لكن هذا التوتر لا يخلو من العنف. فكم من شاعر كُسرت روحه لأن ناقدا متغطرسا سخر من تجربته. وكم من ناقد أُتهم بالقتل الرمزي لأنه هزّ صورة شاعر كان يظن نفسه فوق النقد. ومع ذلك، فإن هذا العنف ليس عيبا بل علامة حياة: فالصراع يعني أن النصوص حيّة، وأن القراءات مشتعلة.
يقول أنطونيو غرامشي: "الأزمة هي عندما يموت القديم ولا يستطيع الجديد أن يولد." وإذا طبقنا هذه الفكرة على العلاقة بين النقد والإبداع، نجد أن غياب النقد يعني موت النصوص في قوقعتها، وغياب الإبداع يعني جفاف النقد وتحوله إلى مجرد خطب جوفاء. إن الحياة لا تُخلق إلا في الفراغ بين الطرفين، في الصدام الذي يولّد شرارة.
خذ مثلا تجربة الشعر العربي الحديث: حين خرج رواد قصيدة التفعيلة (بدر شاكر السياب، نازك الملائكة) على الوزن التقليدي، لم يكن لتمرّ ثورتهم لولا النقد الذي رافقها، سواء كان مؤيدا أو معارضا. النقد هو الذي صاغ وعي الجيل الجديد بمشروعية هذا الانقلاب، وهو الذي أدخلها في مدار التاريخ. بعبارة أخرى: الثورة الإبداعية بلا نقد تبقى تمرّدا شخصيا، أما مع النقد فتتحول إلى تيار جماعي.
4. السلطة والمعارضة: النقد كسلاح والإبداع كصرخة .
إذا كانت الجدلية بين الإبداع والنقد تفسّر صراعهما الداخلي، فإن السياق السياسي والاجتماعي يفسّر صراعهما الخارجي مع السلطة. فالإبداع غالبا ما يكون صرخة في وجه القمع، والنقد الحقيقي هو السلاح الذي يحوّل تلك الصرخة إلى خطاب تحريضي واعٍ.
لكن السلطة ، أيّ سلطة تدرك خطورة هذا التحالف. لذلك تسعى دائما إلى تدجين النقد وتحويله إلى بروباغندا، كما تسعى إلى تدجين الإبداع بتحويله إلى ترف جمالي منزوع المخالب. إن ما تخشاه الأنظمة ليس القصيدة في حد ذاتها، بل النقد الذي يجعل منها رمحا يوجّه نحو قلبها.
حين كتب محمود درويش: "على هذه الأرض ما يستحق الحياة"، لم يكن الشعر وحده هو ما جعل الجملة خالدة، بل النقد الذي أعاد قراءتها في سياق المقاومة، فحوّلها إلى شعار سياسي وشعوري في آن. وكذلك حين صرخ نيتشه: "لقد مات الله"، لم يكن وقع العبارة في ذاتها، بل النقد الذي حملها عبر القرون كقنبلة فكرية فجّرت أركان الفلسفة الغربية.
النقد هنا يصبح أداة مقاومة، والإبداع يصبح صوت المقاومة. الاثنان يلتقيان في مواجهة العدو المشترك: سلطة الهيمنة، سواء كانت سلطة سياسية أو ثقافية أو أيديولوجية. وفي هذا المعنى، يمكن القول إن النقد الثوري هو الذي يعيد للإبداع بعده التحرري، والإبداع الثوري هو الذي يزوّد النقد بذخيرة رمزية لا تنفد.
لكن ماذا يحدث حين يتواطأ النقد مع السلطة؟ حين يصبح الناقد موظفا لدى النظام أو المؤسسة؟ هنا يتحول النقد إلى أداة قمع مضاعف: قمع النص، وقمع القارئ. يصبح النقد أداة إخصاء للإبداع بدل أن يكون أداة تحرير. وهنا تنشأ الحاجة إلى إبداع نقد جديد، يثور حتى على النقد نفسه، ويفضح تحوّله إلى أيديولوجيا سائدة.
لقد أدرك إدوارد سعيد هذا حين كتب "الاستشراق": لم يكن يقدّم مجرد قراءة للنصوص الغربية عن الشرق، بل كان يمارس إبداعا نقديا يكشف كيف تحوّل النقد نفسه إلى أداة استعمارية. هنا النقد لا يفسّر النصوص فحسب، بل يفضح السلطة التي أنتجتها، ويفتح طريقا لوعي مضاد.
5. الإبداع كفعل تحرّر: بين الخيال والواقع المادي .
الإبداع ليس زخرفة فوقية. إنه في جوهره فعل تحرّر، اقتلاع للإنسان من قهر اليومي، من جمود الرتابة، من أصفاد القوانين الجائرة. كل قصيدة حقيقية، كل لوحة، كل قطعة موسيقية، تحمل في طياتها بذرة انفجار.
يقول هربرت ماركوز، في كتابه "الإنسان ذو البعد الواحد": "الفن الحقيقي يَعِدُ بما لم يتحقق بعد، ويُظهر العالم كما يمكن أن يكون، لا كما هو." هذا القول يكشف وظيفة الإبداع التحررية: إنه ليس مجرد تسجيل للواقع، بل حلم يتجاوز الواقع ويكشف إمكانياته الكامنة. القصيدة ليست مرآة، بل نافذة، نافذة تُفتح على عالم آخر لم يولد بعد.
انظر إلى تاريخ الثورات: دائما كان الشعر والفن يسبقانها. قبل أن تندلع الثورة الفرنسية، كان فولتير وروسو قد زلزلوا الأرض تحت أقدام الملكية. قبل أن تنفجر الثورة الروسية، كان ماياكوفسكي يرسم قصائد كأنها قنابل. في فلسطين، لا يمكن أن تفصل بين بندقية الفدائي وصوت درويش و توفيق زياد و معين بسيسو و غيرهم كثيرون . الإبداع هنا ليس زخرفا، بل هو محرّض.
الإبداع التحرري أيضا لا يكتفي بمخاطبة النخبة. هو يخاطب الشعب، يهبط إلى الشارع، إلى الورشات، إلى الحقول. حين غنّى الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم و اولاد المناجم و البحث الموسيقى ... الخ ، لم يغنّوا للنقاد في الصالونات، بل للعمال والفقراء. وحين غنّى فيكتور خارا في تشيلي، كان صوته يهتف للثوار الذين سيُقتلون معه لاحقا. هنا الإبداع يتجاوز كونه فنّا ليصبح "أغنية الشعب"، "صرخة المضطهدين".
لكن الإبداع التحرري ليس رومانسية فارغة. هو أيضا مرتبط بالواقع المادي. لا يمكن للقصيدة أن تحرّض إذا لم تلمس الجرح الملموس: البطالة، القمع، الاستعمار، الاستغلال الطبقي. الإبداع الحقيقي يعرف أن الجمال لا ينفصل عن السياسة، وأن الحلم لا ينفصل عن الخبز. يقول برتولت بريخت: "الفن ليس مرآة تعكس الواقع، بل مطرقة تشكّله."
وهكذا يصبح الإبداع فعلا مزدوجا: يحرر المخيلة من سجونها، ويحرر الواقع من قيوده. إنه يخلق مسافة من الحلم، لكنه في الوقت نفسه يعيدنا إلى الأرض بأسئلة أكثر حدة. إنه الجسر بين الممكن والمستحيل، بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون.
6. النقد كإبداع ثوري: من التحليل إلى الفعل .
النقد، في صورته الثورية، ليس تعليقا أكاديميا على النصوص. إنه كتابة ثانية، نصّ يولد من نصّ، لكنه لا يقل عنه جمالا ولا خطورة. النقد الثوري هو الذي يواجه النصوص بجرأة، لا يخاف من تقديسها ولا من إسقاطها، بل يتعامل معها كجسد حيّ يجب أن يُفتح، يُشقّ، يُعرّى.
يقول تيري إيجلتون: "النقد ليس تفسيرا للنصوص بقدر ما هو تفسير للعالم عبر النصوص." هذه العبارة تختصر معنى النقد الإبداعي: هو الذي يستخدم النصوص كمدخل لفهم المجتمع، التاريخ، السلطة. حين نقرأ قصيدة عن الحب، النقد الثوري يسأل: أي حب؟ في أي سياق طبقي؟ ضد أي قيود اجتماعية أو سياسية؟
النقد الإبداعي أيضا يخلق لغة خاصة به. ليس محايدا، بل منحازا. ليس وصفا باردا، بل مشاركة في الصراع. عندما كتب إدوارد سعيد "الثقافة والإمبريالية"، لم يكن يكتفي بتحليل الروايات الأوروبية، بل كان يفضح كيف شكّلت هذه الروايات الوعي الاستعماري. النقد هنا يصبح مقاومة فكرية، لا تقل خطورة عن المقاومة المسلحة.
إبداع النقد أيضا يكمن في جرأته على إعادة كتابة النصوص. النقد العادي يشرح، أما النقد الثوري فيعيد الكتابة. يفتح الباب لتأويلات جديدة. يحوّل النصوص إلى أسلحة في معارك لم يتخيلها مؤلفوها. ما معنى أن نقرأ اليوم شكسبير في ضوء الاستعمار؟ أو أن نقرأ المتنبي في ضوء الصراع الطبقي؟ هذا هو إبداع النقد: أن يمنح النصوص حياة ثانية، أن يخرجها من القبر الأكاديمي ويزجّ بها في ساحة النضال.
كما أن النقد الإبداعي يرفض أن يكون وصيا. إنه لا يقول: هذه هي الحقيقة الوحيدة. بل يفتح أفقا للحوار. النقد الثوري أشبه بمسرح بريخت: لا يقدم اليقين، بل يصدم القارئ بأسئلة جديدة. إنه يزعج أكثر مما يريح، يفتح جراحاً بدل أن يغلقها.
في النهاية، يصبح النقد الثوري نفسه شكلا من أشكال الأدب. إنه كتابة مشبعة بالشعر، بالصور، بالاستعارات. هكذا كان نيتشه حين كتب "هكذا تكلّم زرادشت": لم يكن كتابا فلسفيا فقط، بل نصا أدبيا أيضا. هكذا كان بورخيس حين كتب مقالاته: لم نعد نعرف هل نقرأ نقدا أم قصيدة. وهكذا ينبغي أن يكون النقد الثوري: إبداعا موازيا، شعرا بلغة أخرى.
7. جدلية الحرية والقيود: الإبداع كتحرّر والنقد كإزالة للأغلال.
الإبداع، في أعمق معانيه، ليس لعبة جمالية بل فعل تحرّر. فالقصيدة، اللوحة، الأغنية، جميعها محاولات للخروج من السجن، سواء كان سجنا سياسيا أو اجتماعيا أو لغويا. لكن كل تحرّر يصطدم بالقيود: اللغة نفسها قيد، التقاليد قيد، المؤسسة قيد. هنا يأتي النقد ليعمل على فضح هذه القيود وتفكيكها.
يقول الفيلسوف جاك دريدا: "النص لا يقول أبدا ما يبدو أنه يقوله، بل يخفي أكثر مما يظهر." هذا القول يضعنا أمام حقيقة أنّ كل إبداع، مهما بدا حرا، يحمل في داخله قيوده الخاصة. الشعر العربي الكلاسيكي، مثلا، كان إبداعا عظيما لكنه ظلّ حبيس الوزن والقافية، وحين خرج السياب ونازك الملائكة على تلك القيود، كان النقد الثوري هو الذي صاغ شرعية التمرد.
هنا نفهم أن الحرية لا تُمنح للإبداع، بل تُنتزع عبر النقد. النقد يكشف أن القيود ليست طبيعية، بل تاريخية. يكشف أن ما نظنه قدرا أزليا هو في الواقع صناعة بشرية قابلة للتفكيك. النقد إذن ليس قيدا إضافيا، بل معول يفتح طريق الحرية.
لكن الحرية ليست مجرد تحرّر شكلي. أن تكتب قصيدة بلا وزن لا يعني أنك تحرّرت إذا بقيت أسيرا لأيديولوجيا سائدة. أن ترسم لوحة تجريدية لا يعني أنك ثوري إذا كانت معروضة في قاعات نخبوية بعيدة عن الشعب. النقد هنا يذكّر الإبداع بأن الحرية الحقيقية ليست في الشكل فقط، بل في المضمون، في الانحياز.
ماركس لخص المسألة حين قال: "الحرية هي وعي الضرورة." أي أن الحرية لا تعني غياب القيود، بل تعني فهم القيود وتغييرها. الإبداع يفجر اللغة، والنقد يفكك سلطتها. الإبداع يصرخ، والنقد يفسر الصرخة ويحوّلها إلى وعي جمعي. ومن هنا تصبح الجدلية بين الحرية والقيود ليست مأساة، بل شرطاً للإبداع نفسه.
خذ مثلا تجربة محمود درويش. قصائده كانت انفجارا جماليا، لكنها أيضا كانت مشتبكة مع شرطها التاريخي: الاحتلال، النفي، الهوية. النقد الذي رافق تجربته لم يقتل شعره، بل وسّعه، جعله صوتا جماعيا يتجاوز الشاعر الفرد. لولا هذا النقد الثوري، لظلّ درويش مجرد شاعر شخصي، لا أيقونة وطنية.
إذن، الحرية والقيود ليستا ضدّين مطلقين، بل هما لحظتا جدلية. الإبداع يحاول التحليق، النقد يكشف أن السماء مليئة بالأسلاك الشائكة. الإبداع يحلم، النقد يذكّر أن الحلم لا يكفي إذا لم يتحوّل إلى فعل. ومن هذا الصراع يولد ما هو جديد.
8. النصوص كساحات صراع: من يملك المعنى؟.
النصوص ليست محايدة. إنها ساحات صراع، ميادين تتواجه فيها الطبقات، الأيديولوجيات، الرؤى. كل نص هو معركة على المعنى: من يملك الحق في أن يقول ما هو "الجمال"؟ من يملك الحق في أن يحدد "الحقيقة"؟
الإبداع ينتج النصوص، لكن النقد هو الذي يحدد مصيرها. رواية تُقرأ كتسلية برجوازية قد تتحول عبر النقد إلى وثيقة فضح للاستعمار. قصيدة مهملة قد تصبح بعد قرن بيانا ثوريا. النصوص لا تعيش بذاتها، بل بقرّائها. وهنا يكمن الصراع: أي نقد يقرأ؟ أي سلطة تحدد القراءة المشروعة؟
أنظمة الاستبداد تعرف هذا جيدا. لذلك تحاول السيطرة على النقد أكثر مما تحاول السيطرة على الإبداع. فهي تسمح بكتابة الروايات والشعر، لكنها تفرض مناهج نقدية تجعلها آمنة. تجعل النقد "أكاديميا"، منزوع المخالب، يقتل النصوص بدل أن يحررها. هنا تصبح وظيفة النقد الثوري فضح هذه اللعبة، إعادة النصوص إلى معركتها الأصلية.
يقول أنطونيو غرامشي: "كل إنسان مثقف، لكن ليس لكل إنسان وظيفة المثقف." النقد الثوري يفهم هذه الحقيقة: القارئ العادي الذي يفسر قصيدة في ضوء تجربته قد يكون أكثر ثورية من الناقد الأكاديمي الذي يضعها في قوالب جافة. لذلك، النقد الثوري لا يقدس "النقاد المحترفين"، بل يفتح المجال أمام تعددية القراءات الشعبية.
النصوص كساحات صراع تعني أيضا أن كل قراءة هي موقف سياسي. لا توجد قراءة بريئة. أن تقرأ المتنبي كبطل فردي يعني أن تتبنى أيديولوجيا الفردانية. أن تقرأه كصوت جماعي ضد سلطة زمانه يعني أن تنحاز للشعب. أن تقرأ "هاملت" كدراما شخصية يعني أن تتجاهل بنيتها الطبقية. أن تقرأها كأزمة ملكية فاسدة في طور الانهيار يعني أن تنحاز لوعي تاريخي.
وهنا يظهر معنى إبداع النقد: أن يكون النقد نفسه معركة. لا يكتفي بتفسير النصوص، بل يشتبك معها كأنها ساحات حرب. فكل كلمة، كل استعارة، كل صورة شعرية، هي خندق، هي سلاح، هي إمّا أن تكون في صفّ السلطة أو في صفّ المقاومة.
7. النقد كفعل تحرّر من التمركز السلطوي.
النقد في معناه الثوري الأقصى ليس تلك الممارسة الجامدة التي تقيس النصوص بمسطرة قديمة، بل هو تمرّد ضد التمركز السلطوي الذي يجعل من النقد سلطة خادمة للأنظمة أو المؤسسات. فالنقد إذا تماهى مع السلطة، يتحول إلى أداة قمع، يكرّس الأذواق الرسمية ويمنع انبثاق المختلف والجديد. أما النقد الإبداعي الحقيقي، فهو تحطيم لسلطة المعايير الجامدة، وهو تحرير للنص من السجن الأكاديمي، وهو في النهاية تحرير للوعي.
هنا، يتقاطع النقد مع السياسة في أعمق معانيها. مثلما أنّ الثورة ليست إصلاحا تجميليا، بل قلبا للطاولة على العلاقات السائدة، كذلك النقد الحقيقي ليس مجرّد تعديل على نصوص الإبداع، بل هو قلب للمنطق الذي يحدد ما هو "مقبول" وما هو "مرفوض"، ما هو "جميل" وما هو "قبيح". لذلك قال فالتر بنيامين: "كل وثيقة حضارة هي في الوقت نفسه وثيقة بربرية." فالنقد الثوري يفتّش دائما عن تلك البربرية المستترة خلف النصوص الجميلة، وعن العنف المطمور تحت البلاغة.
وفي السياق العربي، لطالما تحوّل النقد أحيانا إلى سلطة مؤسساتية تابعة، لكنه في لحظات أخرى انفجر كصوت مضاد. نذكر على سبيل المثال بعض كتابات طه حسين في بداياته حين هزّ صورة "المقدّس" الأدبي، أو مواقف عبد الله العروي الذي جعل من النقد التاريخي فعلا تحرريا ضد الاستبداد. النقد هنا ليس قراءة عابرة، بل تحطيم لـ"أيقونات" مفروضة، وتحرير للخيال من القوالب الموروثة.
إنّ نقد الإبداع يصبح ثوريا عندما يكشف حدود "السلطة الرمزية" التي تحدث عنها بيير بورديو، أي حين يفضح كيف تتحول اللغة إلى أداة سيطرة. فالنقد حينئذ لا يصف النصوص فحسب، بل يكشف علاقاتها بالعالم، يكشف كيف يمكن لشعرٍ ما أن يكون تغطية على الخراب، أو كيف يمكن لرواية أن تكون فضحا للهيمنة الطبقية. النقد هنا ليس تابعا للإبداع، بل هو شريك له في معركة التحرر.
8.إبداع النقد كتجاوز للوظيفة وتأسيس لكتابة ثانية.
إذا كان النقد فعل تحرير، فهو لا يكتمل إلا عندما يتحول إلى كتابة ثانية، أي عندما يكتسب هو الآخر جمالياته ولغته وطاقته الخاصة. إبداع النقد يعني أن يصبح النقد نفسه نصا يوازي النصوص الإبداعية، نصا يُقرأ من أجل ذاته لا فقط من أجل ما يقوله عن الآخر. في هذه اللحظة يتجاوز النقد وظيفته "الخدمية" التقليدية، ليصير إبداعا قائما بذاته.
لقد أدرك ذلك الجاحظ منذ قرون، حين جعل من نقده للبلاغة والشعر عملا إبداعيا في حد ذاته. كما نرى ذلك عند بورخيس الذي كتب مقالات نقدية غاية في التكثيف والخيال، حتى بدت كقصص قصيرة متنكرة في هيئة نقد. وفي زمننا الحديث، تحوّل النقد عند إدوارد سعيد إلى خطاب مقاومة، ليس فقط ضد نصوص أدبية بل ضد بنية كاملة من "الاستشراق" الذي شكّل نظرة الغرب إلى الشرق. هنا النقد لم يكن وصفا، بل كان إبداعا يُنتج خطابا ثوريا هزّ أسس الأكاديميا الغربية.
إبداع النقد يعني أن تتحوّل لغة الناقد إلى مختبر للحرية، وأن تنفلت من سلطة الجامعات ودور النشر المهيمنة. يصبح الناقد شاعرا من نوع آخر، لا يكتب قصائد، بل يكتب تأويلات تُضيء النصوص من زوايا لم تخطر على بال أصحابها أنفسهم. وهنا نستحضر قول نيتشه: "ليس هناك حقائق، بل تأويلات." فإذا كان العالم كله شبكة من التأويلات، فإن إبداع النقد يكمن في القدرة على إنتاج تأويلات جديدة، ثرية، ثورية، قادرة على توسيع أفق القارئ وتفجير مخيلته.
في هذا المعنى، النقد ليس تابعا للإبداع، بل هو صنو له. وإذا كان الإبداع ثورة لغوية، فإن النقد إبداع معرفي وجمالي يوازيه. كلاهما يقفان ضد الركود، ضد اللغة الخشبية، ضد ثقافة السوق التي تريد تحويل كل شيء إلى سلعة صامتة. وكما يقول محمود درويش: "القصيدة موقف." يمكننا أن نضيف: والنقد أيضا موقف، لا يقل شعرية ولا ثورية.
9.العلاقة الجدلية بين النقد والإبداع , حوار لا ينقطع.
لا يمكن أن نتصور الإبداع في عزلة عن النقد، ولا النقد بمعزل عن الإبداع. إنهما يدخلان في علاقة جدلية تشبه الصراع الحيّ بين النهر والضفتين: فالنهر لا يتشكل إلا بالضفاف التي تحدد مساره، لكنه في الوقت نفسه يقوّضها ويعيد رسمها مع كل فيضان. هكذا أيضًا يعمل النقد والإبداع: النقد يرسم للنص أفقا من الفهم والتأويل، لكنه في الوقت نفسه يهدد بإعادة صياغته، فيما يحاول الإبداع دائما أن يتملص من سلطة الناقد، أن يتجاوز توقعاته وأن يبتكر مسارات جديدة.
إنّ هذه الجدلية ليست "نزاعا" بالمعنى السلبي، بل هي وقود لحيوية الثقافة. فكل نص إبداعي يولد ومعه بالضرورة قارئ/ناقد محتمل، وكل نص نقدي يتغذى من إبداع سبق وجوده. ولعل ما يجعل العلاقة أكثر ثراء هو أنّ الناقد الجاد ليس مستهلكا للإبداع فحسب، بل هو منتج لمعنى جديد، تماما كما أنّ المبدع ليس مجرد مولّد للنصوص، بل هو أيضا ناقد ضمني للعالم وللتقاليد الأدبية التي سبقته.
يقول تزفيتان تودوروف: "كل نص هو جواب على نصوص أخرى." يمكننا أن نضيف: وكل نقد هو بدوره نص يفتح الحوار مع نصوص أخرى. فالثقافة إذن ليست خطا مستقيما، بل نسيجا من الحوارات المتداخلة، حيث يصبح الناقد مبدعا في التأويل، والمبدع ناقدا في خلقه للعالم.
من هنا، فإنّ العلاقة بين النقد والإبداع ليست ثنائية جامدة (إبداع/نقد)، بل حركة جدلية دائمة: الإبداع يفتح ثغرات، النقد يتسلل إليها ويضيئها، ثم يخلق فراغات جديدة يدفع الإبداع إلى ملئها. وكأنهما في لعبة لا تنتهي من المطاردة والتحرر.
في السياق الثوري، يصبح لهذه الجدلية بعد آخر: فالإبداع الثوري لا يعيش إلا إذا رافقه نقد ثوري يحرره من التشييء، والعكس صحيح. فالإبداع الذي لا يخضع لنقد ثوري يتحول إلى زخرفة، والنقد الذي لا يرتبط بإبداع حيّ يتحول إلى خطاب جافّ. وهنا نستحضر روزا لوكسمبورغ التي قالت: "الحرية هي دوما حرية المختلف." هذه المقولة يمكن أن تُطبّق على العلاقة بين النقد والإبداع: الحرية الحقيقية للنصوص أن تظل مفتوحة على تأويلات مختلفة، والحرية الحقيقية للنقد أن يظل قادرا على مواجهة النصوص دون خوف.
إنّ هذه الجدلية، بقدر ما هي متوترة، هي شرط للحياة الثقافية. إنها الضمانة الوحيدة لكيلا يتحول الأدب إلى متحف، ولكيلا يتحول النقد إلى محكمة. بل يظل كلاهما فضاءً للصراع، للحوار، ولإنتاج المعنى.
10.النقد والإبداع كرافدين للمعركة الاجتماعية والإنسانية.
إذا كانت الجدلية السابقة تبرز البعد المعرفي والجمالي، فإنّ النقطة الأعمق تكمن في أنّ النقد والإبداع ليسا معزولين عن المجتمع، بل هما رافدان أساسيان في المعركة الكبرى للإنسان ضد القهر والاستلاب. إنّ النصوص الكبرى لم تولد لتزيين المكتبات، بل لتكون صرخات في وجه الظلم، والنقد الحقيقي لم يُكتب لملء المجلات الأكاديمية، بل لتعرية الزيف وكشف المستور.
لننظر مثلا إلى تجربة محمود درويش: إبداعه الشعري كان فعل مقاومة، لكن نقد هذا الشعر ، من إدوارد سعيد وصولا إلى نقاد عرب آخرين ، جعل من هذا الإبداع أرضية لصياغة خطاب ثقافي مقاوم يتجاوز فلسطين إلى الإنسانية جمعاء. هنا نرى كيف يتكامل النقد والإبداع: الإبداع يطلق الشرارة، والنقد يحوّلها إلى نار تنتشر في الحقول الفكرية.
يقول أنطونيو غرامشي: "كل إنسان هو مثقف، لكن ليس لكل إنسان وظيفة المثقف في المجتمع." الإبداع والنقد هما لحظتان من هذه "الوظيفة": المبدع يفتح فضاء جديدا للوعي، والناقد يوسّعه ويحوّله إلى قوة اجتماعية قادرة على تغيير البنى. فالنقد هنا لا يقف على الضفة متفرجا، بل يدخل المعركة، يفضح الأيديولوجيات المهيمنة، ويكشف كيف يمكن للخطاب الثقافي أن يكون أداة للسيطرة أو أداة للتحرر.
كما أن الإبداع أداة لقول ما لا يمكن قوله بلغة السياسة المباشرة. حين يكتب برتولد بريخت مسرحياته، كان يدرك أنّ الفن وحده قادر على فضح عبثية العالم الرأسمالي بطرق أعمق من البيانات السياسية. لكن هذا الإبداع لم يكن ليستمر ويؤثر لولا النقد الذي رافقه، النقد الذي صاغ المفاهيم (مثل "المسرح الملحمي") وجعل منها أدوات نظرية وجمالية في خدمة الصراع الطبقي.
إذن، النقد والإبداع ليسا مجالين منفصلين، بل هما جناحان لمعركة واحدة: معركة تحرير الوعي من الاستلاب. ومن هذا المنطلق، يمكن القول مع فرانتز فانون: "كل جيل يجد نفسه مضطرا لاكتشاف مهمته، إما أن يتمها أو يخونها." مهمة جيلنا في هذا السياق ليست فقط إنتاج نصوص جديدة، بل أيضا إنتاج نقد جديد يواكبها ويحوّلها إلى قوة اجتماعية.
في النهاية، حين نتحدث عن "نقد الإبداع وإبداع النقد"، فإننا نتحدث عن حركة مزدوجة لا يمكن فصلها: الإبداع هو الشرارة الأولى، والنقد هو الريح التي تنفخ فيها لتصبح نارا متقدة. ومن دون هذا التكامل، سنبقى أسرى ثقافة جامدة، تزيينية، عاجزة عن التغيير. أما حين يتحدان، فإنهما يتحولان إلى قوة هدم وبناء، إلى معول يهدم جدران القهر، وإلى معمار يؤسس لحرية جديدة.
11.الإبداع والنقد كفعل مقاومة ضد الهيمنة الثقافية .
النصوص الإبداعية ليست مجرد مواد أدبية، بل ساحات صراع مع الهيمنة الثقافية التي تريد فرض أيديولوجيا واحدة، وذوقا واحدا، ونظرة واحدة للعالم. الإبداع حين يثور على هذه الهيمنة يفتح الباب لتعدد الأصوات، لتعدد القراءات، ولتعدد المعاني. والنقد حين يرافق هذا الإبداع لا يكتفي بالمراقبة، بل يتحوّل إلى فعل مقاومة معرفية وجمالية، يكشف الزيف ويعيد بناء النصوص كأدوات للتحرر.
يقول بيير بورديو: "الثقافة ليست مرآة للواقع، بل ساحة معركة على الرأسمال الرمزي." النقد الثوري يفهم هذا، ويحول النصوص الإبداعية إلى أدوات في المعركة نفسها، حيث تصبح كل صورة شعرية، كل قصة، وكل لوحة مساحة للاشتباك مع السلطة الرمزية. وفي الوطن العربي، نجد أن أدب المقاومة الفلسطينية، من شعر محمود درويش إلى روايات غسان كنفاني، لم يكن فقط فنا، بل كان سلاحا ثقافيا، ونقد النصوص التي تناولتها الدراسات الأكاديمية الغربية أصبح بدوره فعل مقاومة، يكشف الاستلاب ويحيل النصوص إلى أدوات قوة جماعية.
كما أن النقد الإبداعي، في هذا السياق، لا يقف عند حدود النصوص، بل يمتد ليصل إلى المجتمع نفسه. فالناقد يصبح وسيطا بين النصوص والقارئ، بين الإبداع والوعي الشعبي، بين الشعر والفعل الاجتماعي. إنه يفسّر الرموز، يكشف المكنون، ويحوّل الجمال إلى فعل سياسي، تمامًا كما فعل جون ستيوارت ميل حين اعتبر حرية التعبير شرطا للنهضة الفكرية والاجتماعية: "حرية التعبير هي أساس كل تقدم."
النقد والإبداع هنا لا يقتصران على التسلية أو الإبهار، بل يتحوّلان إلى قوة مقاومة حقيقية، إلى فعل اجتماعي، وإلى أداة لتفجير الجدران التي تبنيها السلطة ضد حرية الفكر والإبداع.
12.المستقبل المفتوح ، النقد والإبداع كرافدان للحرية .
النقد والإبداع ليسا فقط إرثا للماضي أو للحاضر، بل هما أدوات لفتح المستقبل. فكما أن الإبداع يولد من حاجة الإنسان للتعبير عن ذاته والتمرد على الواقع، فإن النقد يولد من حاجة الإنسان لفهم هذا الواقع، لتفسيره، ولتحديه. وفي عالم يزداد تعقيدًا وسلطوية، يصبح التزاوج بين النقد والإبداع شرطا للبقاء الفكري والثقافي، شرطا لإنتاج وعي حر، وشرطا لاستمرار المعركة ضد الاستلاب الثقافي والسياسي.
يقول فريدريك نيتشه: "الفن هو الطريقة التي يبتكر بها الإنسان العالم ويصبح سيده." النقد الإبداعي يضيف بعدا آخر: ليس فقط السيطرة على العالم بالخيال، بل فهمه وتحويله، وتحويل النصوص إلى أدوات للتغيير، لإعادة تشكيل وعي المجتمع، ولخلق مساحات حرية جديدة.
في المستقبل المفتوح، يصبح النقد والإبداع سلاحا مزدوجا في مواجهة القهر الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. الإبداع يفتح الأفق، النقد يحرّر النصوص والقارئ من القيود، ويحوّل المعاني إلى قوة جماعية. هكذا، يصبح الإبداع ليس فقط فعلا فرديا، بل فعلا جماعيا يشارك فيه المجتمع، ويصبح النقد ليس مجرد ممارسة أكاديمية، بل فعل مقاومة جماعية تتجاوز حدود النصوص إلى الفعل الاجتماعي والسياسي.
من هنا يمكن القول بأن نقد الإبداع وإبداع النقد ليسا مجرد مفاهيم نظرية، بل هما مشروع حياة، مشروع مقاومة، مشروع حرية. مشروع يجعل من الكلمة فعلا ثوريا، ومن النص أداة للتغيير، ومن القارئ شريكا في المعركة، ومن المجتمع كله ساحة للاشتباك مع القوى التي تريد فرض الصمت والخضوع.
☆الكلمة كفعل ثوري، والنقد كإبداع مطلق:
عندما ننظر إلى رحلة الإبداع والنقد عبر العصور، ندرك أن ما يجمعهما ليس مجرد صلة شكلية أو علاقة تقليدية، بل هو صراع مستمر، جدلي وعميق، بين الحرية والقيود، بين الوعي والاستلاب، بين الفرد والمجتمع، بين الإنسان والطغيان. فالإبداع يولد من صرخة الإنسان في وجه الظلم، ومن حاجته الميؤوس منها للتعبير عن ذاته وسط قيود التاريخ والطبيعة والسياسة. أما النقد، فهو ليس مجرد تعليق على هذه الصرخة، بل هو امتداد لها، معول لهدم الحواجز التي تمنع الكلمة من أن تصبح قوة حية.
الإبداع بلا نقد يصبح مجرد ترف، وجمال بلا معنى، أما النقد بلا إبداع فيتحول إلى رقابة جامدة، إلى سلطة تخنق النصوص بدل أن تفتحها، وإلى أداة استلاب بدل أن تكون فعل تحرر. ومن هنا نفهم لماذا كان الفلاسفة والنقاد الثوريون منذ سقراط وحتى روزا لوكسمبورغ، ومن ميخائيل باختين إلى أدوارد سعيد، يؤكدون على الترابط الجدلي بين الإبداع والنقد: كلاهما ركيزة للحياة الفكرية، وشرط لأي فعل تحرري حقيقي.
لقد حاولت هذه الرحلة التحليلية أن تبيّن أن النقد ليس تابعا للإبداع، وأن الإبداع لا يعيش إلا إذا رافقه نقدٌ قادر على تحريره من قيوده الداخلية والخارجية. النقد يفضح القيود، يكشف الاستلاب، يصنع لغة جديدة للوعي، بينما الإبداع يفتح آفاقا جديدة، يختبر التجريب، ويخلق عالما لا يمكن للسلطة أن تقيده بسهولة. هذا التزاوج بينهما يخلق ما يمكن أن نسميه إبداع النقد: شكل جديد من الكتابة والمعرفة، يوازي النصوص الإبداعية، ويحوّل القراءة إلى فعل مقاومة، والفكر إلى ساحة صراع، والفن إلى قوة سياسية واجتماعية.
وفي سياقنا العربي والعالمي، يصبح هذا التكامل بين النقد والإبداع أداة لمقاومة الهيمنة الثقافية والسياسية والاجتماعية. الإبداع يصرخ باسم الحرية، والنقد يفسر هذه الصرخة ويحوّلها إلى فعل جماعي. الشعر يصبح بيانا، الرواية تصبح تاريخا، النقد يصبح خطابا مقاوما، وكل نص يُقرأ على أنه خندق في حرب أكبر: حرب على الظلم، حرب على الفكر الجامد، حرب على استلاب الإنسانية.
كما أن المستقبل المفتوح، كما رأينا، لا يمكن تخيله بلا هذا الفعل المزدوج. الإبداع يفتح الأفق، والنقد يحرّر النص والقارئ والمجتمع من القيود القديمة والجديدة. كل نص جديد، كل نقد متجدد، هو فرصة لتفجير الأطر الميتة، لتوسيع حرية الفكر، ولخلق مساحات إنسانية جديدة. يقول نيتشه: "من يملك لماذا يعيش، يستطيع أن يتحمل أي كيف." في هذا السياق، الإبداع يمنح الإنسان "لماذا"، والنقد يمنحه القدرة على التعامل مع "كيف"، على فهم الواقع، تغييره، والانتصار على الاستلاب.
النقد والإبداع معا هما قلب المعركة الثقافية الكبرى: معركة الإنسان على ذاته، ومعركة الإنسان على العالم. هما رافدان متوازيان لا يمكن أن يعيش أحدهما من دون الآخر، لا يمكن أن يكون أحدهما بلا روح الثورة والتمرد والبحث المستمر عن المعنى. وهنا نصل إلى خلاصتنا الكبرى: نقد الإبداع وإبداع النقد ليسا مجرد مفاهيم نظرية، بل هما مشروع حياة، مشروع مقاومة، مشروع حرية متجدد بلا نهاية، مشروع يجعل من الكلمة فعلًا، ومن النص أداة، ومن الفكر قوة تحررية حقيقية.
في النهاية، تظل الكلمات والفكر والأصوات أدواتنا. وعلينا أن نكتب، أن نقرأ، أن ننتقد، أن نبدع، أن نثور بالكلمة والفكر، لأن الإنسان بلا هذه الثورة يصبح أسيرا لماضيه، حاضر لا يعي ذاته، ومستقبل يظل غائبا. الإبداع والنقد هما الطريق، هما الثورة، وهما الأمل. وهكذا، كما قال درويش: "على هذه الأرض ما يستحق الحياة." وما يستحق الحياة، هو الكلمة الحرة، والنقد المبدع، والإبداع الثوري، والوعي الذي لا يهدأ، والقدرة على أن نكون أحرارا في كل فعل فكر، وفي كل كلمة، وفي كل نص نكتبه أو نقرأه.
#رياض_الشرايطي (هاشتاغ)



ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

|
حفظ
 |
بحث |
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
| إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
بقايا الطلائع القديمة: الثورة بين الخطاب والممارسة والخيبة.
-
اللّجوء بين إنسانية العالم وابتزاز السياسة: في أزمة النظام ا
...
-
قراءة نقدية تفكيكية لرواية -أنا أخطئ كثيرا- للاديبة اللبناني
...
-
11 سبتمبر 2001 ، انطلاق اللّعبة الامبريالية الكبرى.
-
الحرب كحقل تجارب للذكاء الاصطناعي: كيف أصبحت غزة مختبرا للمر
...
-
رؤوس أقلام حول أمريكا: الإمبريالية الحربية والاقتصادية من ال
...
-
أحفاد مانديلا . تحرير العمل: الدرس الجنوب إفريقي.
-
البيروقراطية
-
السودان يحترق... والطبقات الحاكمة تتقاسم الخراب
-
قراءة نقدية لديوان -في أن يستكين البحر لفرح موج- لإدريس علوش
...
-
البناء القاعدي: من فكرة التحرر إلى أداة الهيمنة؟
-
الحداثة والظلامية: وجهان لعملة واحدة في مأزق التاريخ العربي.
-
ما بعد الجمهورية: زمن الوحوش أم زمن الاحتمال؟
-
الخديعة الأمريكية الكبرى: الإمبريالية وخراب فلسطين.
-
اليسار التونسي: بين الأمس الإيديولوجي واليوم السياسي.
-
الأخلاق في الميزان السياسي في القرن 21.
-
الشعبية: من التحرير الرمزي إلى بناء السيادة الفعلية
-
قراءة في رواية -1984- لجورج أورويل.
-
الكتابة فعل نضال
-
جنوب يخرج من ظلّ الأمم المتّحدة: مقترحات للفكاك من نظام الغل
...
المزيد.....
-
-لا تُجارِ خطابًا هابطًا-.. أنور قرقاش: تعامل الإمارات مع ال
...
-
هل استعانت روسيا بخبراء من حماس وحزب الله في حربها السرية ضد
...
-
جنود إسرائيل بخوذات ذكية.. هل يصبح التواصل على الجبهات ذهنيً
...
-
فقدان الأمل وتشويه الوعي من أخطر ما نواجه.
-
صفقة تبادل موقوفين وأسرى بين الحكومة السورية والحرس الوطني ب
...
-
الشرطة تعتقل شخصا من منزله بسبب خطأ في برمجيات التعرف على ال
...
-
على خلفية حراك غزة.. جامعة كاليفورنيا تتحصن ماليا ضد إجراءات
...
-
سجال بين -غروك- وخبير بالشأن الكوري حول مزاعم تعيين ابنة كيم
...
-
اتفاق أمريكي صيني على تجنب الحرب وروبيو يتحدث عن استقرار في
...
-
هل تعيد واشنطن هندسة العملية السياسية في العراق؟
المزيد.....
-
قواعد الأمة ووسائل الهمة
/ أحمد حيدر
-
علم العلم- الفصل الرابع نظرية المعرفة
/ منذر خدام
-
قصة الإنسان العراقي.. محاولة لفهم الشخصية العراقية في ضوء مف
...
/ محمد اسماعيل السراي
-
الثقافة العربية الصفراء
/ د. خالد زغريت
-
الأنساق الثقافية للأسطورة في القصة النسوية
/ د. خالد زغريت
-
الثقافة العربية الصفراء
/ د. خالد زغريت
-
الفاكهة الرجيمة في شعر أدونيس
/ د. خالد زغريت
-
المفاعلة الجزمية لتحرير العقل العربي المعاق / اسم المبادرتين
...
/ أمين أحمد ثابت
-
في مدى نظريات علم الجمال دراسات تطبيقية في الأدب العربي
/ د. خالد زغريت
-
الحفر على أمواج العاصي
/ د. خالد زغريت
المزيد.....
|
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

 |
بحث
|
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
|
إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة