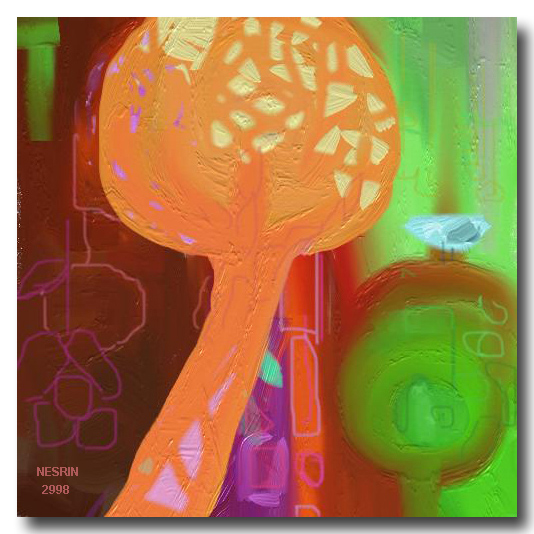|
|
قواعد التنوير الأربعون | القاعدة السادسة: ضرورة معرفة تاريخ تحرير العقل الأوروبي وانتصار الحداثة
محمد بركات


الحوار المتمدن-العدد: 8452 - 2025 / 9 / 1 - 22:00
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
من يوم أن فوجئت المجتمعات العربية بالحملة الفرنسية والإستعمار الإنجليزي والأوروبي، وما هالهم من قوة وعظمة الحضارة التي أتوا بها والتقدم المذهل الذي رأوه بأعينهم يتفجر عنفواناً وفتوة، إلا وهناك نوع من الحقد عليهم ومحاولة إقصائهم بحجة أنهم كفار، بسبب اليأس من اللحاق بهم، لأن اللحاق بهم يحتاج أولاً إلى استعادة مكانة العقل محل سلطة النقل، وهذا ما يقف ضده رجال الدين في كل زمان ومكان، ويحتاج أيضاً إلى معاناة مشقة البحث العلمي وخوض غمار العلم التجريبي وتكاتف وتعاون العلماء في كافة المجالات، حتى تظهر بوادر الحضارة، وهذا ما لم يكن لأنه أمر شاق وصعب، ولذلك تلجأ الشعوب إذا كانت غير متدينة، إلى التقليد، يقول ابن خلدون في مقدمته: «إن المغلوب مولع أبداً بالإقتداء بالغالب في شعاره وزيه و نحلته و سائر أحواله و عوائده» هذا إذا لم يكونوا تحت سلطة كهنوتية، وأما إن كانوا كذلك، فإنهم يلجأون إلى الإعتصام بالدين واتخاذه بديلاً عن العلم والبحث، فإن أداء الشعائر والعبادات وانتظار نصر السماء أمر أسهل بكثير من دخول المختبر ومعرفة أسرار الصناعة والتقدم التكنولوجي.
سوف أقوم في هذا الفصل باختصار موجز لكتاب مدخل إلى التنوير الأوروبي، للدكتور هاشم صالح، مترجم أعمال المفكر الكبير د. محمد أركون. يقول:
عندما نفكر بالقطيعة بيننا وبين أوروبا لماذا نراها مطلقة؟ لماذا نعتقد أننا جنس، وهم من جنس آخر؟ لأننا نسينا كيف كانوا في العصور الوسطى. ولا يخطر على بالنا لحظة واحدة أنهم كانوا متخلفين،متعصبين ريفيين جبلتين، معادين للعلم والفلسفة، فهم يبهروننا بحداثتهم الساطعة التي تخطف الأبصار. لأننا نسينا أنهم كانوا تلامذتنا يوماً ما وكانوا يترجموننا ويعتبروننا منارة العلم والحضارة. كيف يمكن أن نصدق أن هؤلاء الأوروبيين المتفوقين علينا الآن في كافة المجالات كانوا يستشهدون بمفكرينا كما نستشهد نحن الآن بكانط أو هيغل أو كارل ماركس؟ أعتقد أن أحد أسباب القطيعة النفسية العميقة بيننا وبين الأوروبيين واعتقادنا أننا من جنس وهم من جنس آخر يعود إلى نقص الرؤية التاريخية أو ضمورها في الساحة الثقافية العربية.
لا يمكن مقارنة الوضع الراهن للمجتمعات العربية والإسلامية بالوضع الراهن للمجتمعات الأوروبية المتقدمة جداً. هذا محال وعبث وفيه ظلم كثير لنا وتثبيط لعزائمنا. ولكن يمكن أن نقارن وضعنا الراهن وتخبطنا في مشكلة الأصولية بوضعهم قبل مائتين أو ثلاثمائة سنة عندما كانوا يتخبطون هم أيضاً في نفس المشكلة هنا تصبح المقارنة مفهومة ومشروعة.
لكن ما هذه السمات الأساسية التي تميز إنسان العصور الوسطى أو عقلية العصور الوسطى؟ يمكن تلخيصها بحسب "جاك لوغوف" في التالي:
• هيمنة العقيدة اللاهوتية المسيحية على العقول.
• صورة الإنسان المتشائم الضعيف الخائف من ارتكاب الخطايا والذنوب في كل لحظة.
كانت الخطيئة الأصلية تلاحق الإنسان المسيحي في العصور الوسطى ولم يكن يعرف كيف يتخلص منها، ولم يكن واثقاً أنه سينجو بروحه في الدار الآخرة. فإغراءات الشيطان دائماً مستمرة، وتصعب مقاومتها باستمرار. وأما فيما يخص الأمان المعنوي أو الروحي فلم يكن مضموناً على الرغم من كل الصلوات والابتهالات والأعمال الخيرية التي كانوا يقومون بها لإنقاذ أرواحهم ونيل مرضاة الله. وكان أحد الدعاة المسيحيين في القرن الثالث عشر يقول إن نسبة الناجين يوم القيامة لا تتجاوز الواحد من كل مائة ألف شخص ! أي عشرة على مليون وأما البقية فمصيرهم في النار وبئس المصير. وكان مجرد التفكير بهذا المنظور يرعب الإنسان المسيحي ولا يتركه ينام قرير العين.
• الزهد في الحياة الدنيا واحتقارها
واعتبارها دار عبور إلى الحياة الحقيقية، حياة النعيم والخلود في الدار الآخرة. وبالتالي فلا ينبغي على الإنسان أن ينال من متع الأولى إلا القليل، أو حتى اللاشيء إذا أمكن. وكلما افتقر الإنسان أصبح أقرب إلى الله، وكلما اغتنى وبطر ابتعد عن الله. وبالتالي فإن الفقر لم يكن يمثل عاراً أو عيباً في القرون الوسطى، بل على العكس كان دليلاً على التقى والورع والقرب من الله . إذ ما جدوى الاهتمام بهذه الحياة الدنيا وتجميع الأموال والأرزاق إذا كانت فانية زائلة وإذا كانت الحياة الحقيقية هي في الآخرة وليست فيها؟ وكلما أصيب الإنسان بالمصائب شعر بالسعادة أكثر لأن الله يبتليه ويمتحنه بذلك، وسوف يكافئه على صبره وتحمله وصلابة إيمانه في الدار الآخرة. وكان أكثر شيء يخشاه إنسان العصور الوسطى هو ألا يحظى بعفو الله ومرضاته يوم القيامة. ولذلك كان دائماً قلقاً على آخرته ومصيره.
• هيمنة العقلية الرمزية أو الخيالية على وعي الناس.
بمعنى أنهم كانوا سريعي التصديق لما يُروى لهم، وكلما كانت الحكاية بعيدة عن الواقع ومبالغاً فيها كانت أقوى وحظيت بإعجابهم أكثر.. من تعلقهم بالمعجزات وبكل ما هو ساحر خلاب أو خارق للعادة. فبما أن الوعي التاريخي أو الواقعي المحسوس كان ضامراً لديهم، فإن الوعي الأسطوري أو الرمزي كان يتغلب عليه إلى حد كبير.
وكما أن فكر الفيلسوف في أيامنا هذه لا يمكن أن يتم إلا على قاعدة المبادئ العامة للعلوم التاريخية والاجتماعية، فإن فكر الفيلسوف في العصور الوسطى لم يكن يتم إلا على قاعدة العقيدة اللاهوتية المسيحية. وكما أننا لا نناقش أولوية العلم اليوم فإنهم ما كانوا يناقشون أولوية الإيمان ولا يطرحون عليها أي سؤال. هذا يعني أن أولوية الإيمان كانت تشكل معطى نهائياً جاهزاً لا يناقش ولا يُمس. وكان الإنسان المذنب أصلاً مدعواً للعمل من أجل إنقاذ روحه في الدار الآخرة عن طريق الخضوع لكنيسة الله وتعاليمها. ينبغي أن نعلم أن العلم الحديث كان قد تولد عن طريق نزع أغلال القدسية عن الواقع على عكس المعرفة السائدة في العصور الوسطى والتي كانت تغطي كل مظاهر الواقع والطبيعة بأسدال كثيفة من التقديس، ولذلك اعتبرت الاكتشافات العلمية في البداية بمثابة تجديف أو كفر أو فضيحة لا تحتمل. لا يمكننا أن نفهم النظرية القروسطية للمعرفة إلا إذا عاكسناها بالنظرية العلمية الحديثة. فالإنسان الحديث ينظر إلى العلم باعتباره استكشافاً أولاً: أي بحثاً عن شيء غير معروف بشكل مسبق، ولا يمكن التوصل إليه إلا في نهاية البحث، وذلك لأن الحقيقة تختبئ خلف الظواهر الطبيعية وليست مودعة على سطوحها الخارجية. وينبغي تشريح الظواهر في المختبر أو فحصها تجريبياً لكي نفهم حقيقتها أو تركيبتها الداخلية. فالظواهر تخدعنا ولا يمكن الركون إلى وجوهها الخارجية، ففعل المعرفة يبتدئ أولاً بالسلب قبل التوصل إلى الإيجاب، ولا بد من الهدم قبل البناء . أما إنسان العصور الوسطى فكان يركن إلى ظواهر الأشياء ويصدقها ويتوهم أنه عرفها بمجرد أنه رآها ولم يكن يفكر في تفكيكها أو تشريحها لكي يتوصل إلى حقيقتها. كان يعتقد بإمكانية التوصل إلى الحقيقة الكاملة والمعرفة المليئة عن العالم بمجرد قراءة النصوص. فالحقيقة كلها مودعة في الاعتقاد أو قانون الإيمان المسيحي. يلخص روجيه بيكون هذا الموقف بما معناه: لا يوجد إلا علم واحد كامل وتام أعطاه الله للإنسان من أجل التوصل إلى غاية واحدة هي النجاة في الدار الآخرة، دار النعيم والخلود. وهذا العلم متضمن كله في الإنجيل ولكن ينبغي شرحه وتفسيره عن طريق القانون الكنسي والفلسفة وكل ما هو مضاد لهذا العلم المقدس أو غريب عنه. هذه الأطروحة هيمنت على كل عقلية القرون الوسطى، وباسمها أدانت المحكمة الكهنوتية غاليليو. تعني هذه الأطروحة أن الحقيقة ليست موجودة في العالم الواقعي نفسه، وإنما في النصوص فهي مودعة بكليتها في هذه النصوص. وما علينا لكي نتوصل إليها إلا أن نعرف كيف نقرأ هذه النصوص ونفسرها. كانوا يميلون للشروحات والشروحات على الشروحات إلى ما لا نهاية. وكانوا ميالين للتعصب الذي يؤدي إلى الدوغمائية في الفكر. كان الناس يأخذون علومهم آنذاك من بطون الكتب الصفراء التي علاها الغبار، وليس من ملاحظة الطبيعة بشكل عياني وتجريبي دقيق فحتى عندما كانوا يريدون دراسة علم الحيوان مثلاً كانوا يلجأون إلى استشارة الكتب العتيقة بدلاً من مراقبة الحيوانات كما هي عليه في الطبيعة. من هو المسؤول عن هذا الوضع؟ من الذي أوقف حركة التقدم العلمي طيلة ألف سنة تقريباً؟ إنها الكنيسة المسيحية. وذلك لأن الثقافة كانت محتكرة كلياً بين أيديها.. كان المتعلمون الوحيدون آنذاك هم رجال الدين. هذه هي أطروحة فلاسفة التنوير الذين شنوا حرباً شعواء على الكنيسة، وقالوا إن الكهنة والخوارنة والمطارنة هم الأعداء الألداء للعقل. واعتبروا أن كل الكوارث عائدة إلى خداع الكهنة وغشهم واحتيالهم على الناس فالثقافة التي كانوا يبثونها في المجتمع كانت تقليدية خاضعة لمبدأ الهيبة أي هيبة النصوص والأقدمين. كانت ثقافة مستديرة نحو الماضي ومهووسة بالوعظ الأخلاقوي أكثر مما هي مهووسة بالتعليم، وقد رسخت في المجتمعات الأوروبية مفهوماً خاطئاً عن المعرفة، ولم تكن الملاحظة المباشرة للطبيعة تلعب فيها أي دور، فالكاهن لم يكن يهتم إطلاقاً بالعلم التجريبي، بل كان ينفر منه ويزدريه باعتبار أنه يمثل تطاولاً على القدرة الإلهية. وبالتالي فقد ضحت التربية الكهنوتية بملكة الملاحظة والاكتشاف والعيان لصالح الخضوع للنصوص والتعليق عليها إلى ما لا نهاية فكل الحقائق موجودة في النصوص، وبالتالي فلا يمكن اكتشاف أي شيء جديد تحت الشمس.
ولم يكن أناس القرون الوسطى يصدقون شيئاً إلا إذا كان له سند في الماضي، وبخاصة لدى السلطات العليا المأذونة للعقيدة المسيحية. إذ يكفي أن تقول بأن أحد آباء الكنيسة قد ذكر هذا الشيء لكي يصدقه الناس من دون مناقشة. ينبغي أن تنقل كلامك عن سيادات الماضي أو تدعمه بأقوالها لكي يحظى بالموافقة الفورية. يكفي أن تقول فلان عن فلان أو قال بولس أو بطرس لكي يصدق الناس. كانت برامج التعليم القروسطية تضيع في التحديدات والتفاصيل الصغيرة والسطحية وتنسى العمق أو الجوهر. كانت الحجة آنذاك تعتمد على الهيبة أي هيبة القديس المُستَشهد به أكثر مما كانت تعتمد على إعمال العقل والمنطق فيكفي أن يقول القائل سمعت القديس بطرس يقول كذا وكذا، أو قرأت للقديس بولس كذا وكذا، لكي يصبح كلامه منزلاً بغض النظر عن محتوى هذا الكلام، هل هو صحيح أم لا، منطقي أم لا . فالشيء المهم بالنسبة للعقلية التقليدية أو القروسطية هو القائل لا المقول وهذه هي الحجة القائمة على هيبة الأقدمين لا على البرهان والإقناع.
هكذا نجد أن التعلق بالماضي أو مرجعية الماضي كانت قوية جداً. وكانوا يخشون أي تجديد ويعتبرونه بدعة شيطانية. وكانت الكنيسة تسارع إلى إدانة البدع. وقد فتحت مكتباً للتفتيش: أي لملاحقة البدع والزنادقة والخارجين عن "الطريق المستقيم" . وقد أدانت التقدم التقني أي المخترعات والآلات الحديثة، كما أدانت التقدم الفكري سواء بسواء. فللبرهنة على أي شيء ينبغي أن تذكر استشهاداً من النصوص أو من أقوال القديسين وآباء الكنيسة، وإلا فإن كلامك لا معنی له. وذلك لأن عقلك لا يكفي للبرهنة على صحة ما تقول. وما هي قيمة العقل أمام كلام منقول عن القدماء؟ آخر شيء كان له معنى هو العقل، خصوصاً بالنسبة للفلاحين الفقراء، أي معظم الشعب.
بالطبع لم تكن المعرفة أو الفضول المعرفي غاية بحد ذاتها كما هو عليه الحال في وقتنا الحاضر. لا، أبداً. فكل الغايات البشرية تُعتبر ثانوية بالقياس إلى الغاية الأساسية للإنسان على هذه الأرض: إنقاذ روحه في الدار الآخرة.
ابتدأت العقلانية تدخل إلى أوروبا منذ القرن الثاني عشر وبلغت أوجها في القرن الثالث عشر. ثم استمرت في التصاعد أثناء القرنين الرابع عشر والخامس عشر وصولاً إلى مشارف عصر النهضة في القرن السادس عشر. وإذن فالعصور الأكثر إظلاماً وقتامة هي تلك التي تمتد منذ القرن الخامس الميلادي وحتى القرن العاشر أو الحادي عشر. بعدئذ ابتدأ الفكر العقلاني يدخل إلى الساحة الأوروبية عن طريق العرب. وعامة البشر ظلوا واقعين تحت تأثير الحساسية الأسطورية أو العقلية الخيالية الرمزية ليس فقط طيلة العصور الوسطى، بل حتى مشارف عصر التنوير والقرن التاسع عشر حين انتصرت العقلانية وترسخت نهائياً. وحدها النخبة المثقفة أو المتعلمة أخذت تتحرر شيئاً فشيئاً من عوالم العصور الوسطى أو من ظلماتها الشديدة العتمات. هذا لا يعني بالطبع أن العقلية الخيالية أو الرمزية قد اختفت من الساحة بمجرد دخول الفلسفة العربية والأرسطوطاليسية. لا، وإنما حصل تعايش بين كلتا المنهجيتين إذا جاز التعبير أو كلتا العقليتين: العقلية الأسطورية والعقلية الفلسفية بل وتعايش هذان النظامان داخل وعي الشخص الواحد نفسه . وعبر هذا التناقض والتضاد والتعارك بينهما راح النظام العقلاني يتغلب شيئاً فشيئاً ويقلص من أهمية المنهجية الأسطورية. لنستمع إلى مؤسس علم الاجتماع الفرنسي دوركهايم يتحدث عن خفايا ذلك الصراع ورهاناته: «لقد أدخلت المنهجية المدرسانية بذرة العقل إلى رحم العقيدة بين الدينية، في الوقت الذي رفضت فيه إنكار هذه العقيدة. وحاولت أن تقیم توازناً هاتين القوتين الكبيرتين اللتين كانتا تسيطران على أناس القرون الوسطى: قوة العقل الأرسطوطاليسي، وقوة العقيدة المسيحية. وفي هذا التوازن الحرج كانت تكمن عظمتها وبؤسها في آن معاً. لقد قدمت لنا تلك الفترة المعذبة والقلقة مشهداً مأساوياً ومثيراً حقاً. فقد كانت شديدة البلبلة والاضطراب وكانت متمزقة تتراوح بين احترام التراث وبين جاذبية الفكر الحر أو التفحص الحر للظواهر والقضايا، كانت تتراوح بين الرغبة في البقاء مخلصة للكنيسة المسيحية، وبين الحاجة المتزايدة للفهم والتعقل. فهذه العصور التي صوّروها أحياناً وكأنها غاطسة في نوع من السكون والفتور العقلي، لم تعرف هدوء الروح ولا طمأنينة البال. لقد كانت منقسمة على نفسها ومشدودة في عدة اتجاهات متضادة. لقد كانت العصور الوسطى إحدى اللحظات التي شهدت فيها الروح البشرية القدر الأكبر من التوتر والغليان والمخاض. لقد كانت فترة زرع البذور وتمهيد الأرض، ولم تكن فترة الحصاد فالحصاد جاء فيما بعد في العصور التالية، وسط الفرح وبهجة الشمس، وفي عزّ تألق القرنين السابع عشر والثامن عشر. وكل تاريخ الغرب الحديث ليس إلا صراعاً بين هذين التيارين: التيار الإيماني الناسك والزاهد والتيار العقلاني أو العلماني الدنيوي. وقد استمر الأمر على هذا النحو طيلة عدة قرون حتى انتصر التيار الثاني بشكل حاسم في القرن التاسع عشر. وينبغي أن نقرأ ملحمة هذا الصراع الكبير بكل حلقاته ومراحله لكي نفهم كيفية تشكل الغرب الحديث، أو كيفية تشكل الحداثة. فالأمور أكثر تعقيداً أو تشعباً مما نظن. ويمكن القول بأنه لم يتح للعقل البشري أن يخوض مثل هذه المغامرة الكبرى بمثل هذا الاتساع والشراسة إلا في أوروبا الغربية، وبدءاً من عصر النهضة. أما في العصور الوسطى المتأخرة فقد زرعوا البذور الأولى كما يقول دوركهايم، ولكنهم لم يشهدوا قطف الثمار وهذه هي مسيرة التاريخ: الأوائل يزرعون والأواخر يحصدون.
فنحن أيضاً سوف نشهد عصر نهضة بعد عصورنا الوسطى الطويلة أو المتطاولة التي لا تعرف كيف تنتهي. وربما كنا نقع الآن على هو اللحظة المفترق التاريخي الفاصل بين العصور الوسطى وعصر النهضة، بين العصور القديمة والعصور الحديثة وبالتالي فمن الممتع والمفيد أن نعرف كيف تخبط الأوروبيون كثيراً قبل أن ينهضوا، وما هي العراقيل التي واجهتهم، وكيف حاولوا التغلب عليها. فالاستئناس بتجربة الآخرين شيء مهم من أجل توضيح الصورة والسير على هدى من الأمر. ولا أقول ذلك من باب التقليد الأعمى لأوروبا، وإنما من باب الدراسة المقارنة ومحاولة استخلاص الدروس والعبر فبضدها تتبين الأشياء.
في الواقع إن لكل نهضة روحية أو فكرية دعامة مادية تحميها أو تعطيها الدفع اللازم لكي تقوى وتترعرع. ولا ينبغي أن نكون مثاليين جداً، فنتوهم أن الفكر معلق في الفراغ، أو أنه ينمو ويستمر بدون دعامة مادية تسنده نقول ذلك ونحن نعلم أن انهيار البورجوازية التجارية في بغداد وبعض المراكز الإسلامية الأخرى ساهم في انهيار الفكر العقلاني المتمثل بالمعتزلة والفلاسفة.
هذا ما برهنت عليه البحوث التاريخية الجادة. فقد كان افتقار العالم العربي - الإسلامي بعد تحول الخطوط التجارية عنه هو الذي أدى (من جملة عوامل أخرى بالطبع) إلى تراجع الفلسفة في أرض الإسلام فالفكر لكي يترعرع تلزمه شروط محيطة وملائمة نسبياً، ومن يفتقر ويجوع لا يعود يعرف كيف يفكر. من يفتقر تسود الدنيا في عينيه وتصبح الحرية الفكرية بالنسبة له ترفاً ما بعده ترف ليس غريباً، والحالة هذه، أن تقوى الحركات المتشددة والمتجهمة في ظروف الفقر الشديد، وأن تتراجع وتنحسر عندما تتحسن الأمور المادية للناس وتنتعش الظروف الاقتصادية وإذن فهناك علاقة بين الفقر المادي والفقر الروحي أو الفكري. وهذا الأمر ينطبق علينا وعلى غيرنا. إنه ظاهرة أنثروبولوجية (أي إنسانية عامة تنطبق على الإنسان في كل زمان ومكان. فنفس السبب يؤدي إلى نفس النتيجة. وقد ابتلي العرب - المسلمون بالفقر المادي قبل أن يبتلوا بالفقر الروحي، أو قل أن كلا الأمرين تزامنا مع بعضهما البعض. ولذلك شاعت حركات الدروشة والطرق الصوفية التي تدعو إلى التواكل وهجران العالم، وانحسر الفكر العقلاني والعلمي حتى كاد أن ينقرض كلياً. وبالتالي فينبغي أن نكفَّ عن القول بأن سبب انهيار الفكر الفلسفي لدينا هو تدخل هذه الشخصية الفقهية الكبرى أو تلك الغزالي مثلاً: تهافت الفلاسفة). لا ريب في أن الفتاوى الفقهية المضادة للفلسفة، أي للفكر العقلاني في نهاية المطاف قد ساهمت في صرف الناس عن كتب الفلسفة والفلاسفة وشجعتهم على الاكتفاء بقراءة الكتب الصوفية والتبجيلية التقليدية. ولكن الشروط الاجتماعية المتدهورة والظروف السياسية القلقة وغير المستقرة هي التي كان لها الدور الأكبر في هزيمة العقل في أرض الإسلام بعد أن شهد ازدهاراً رائعاً طيلة الحضارة الكلاسيكية أي طيلة القرون الهجرية الستة الأولى، أي حتى موت ابن رشد عام ۱۱۹۸ والواقع أن تدهور الشروط الاجتماعية هو الذي أدى إلى ازدهار الطرق الصوفية، وليست الطرق الصوفية هي التي أدت إلى انهيار الظروف الاجتماعية وبالتالي فلا ينبغي الخلط بين السبب والنتيجة. بل ويمكن القول إن هجوم الغزالي نفسه على الفلسفة ليس إلا نتيجة لهذا التدهور العام والأوضاع القلقة التي تتجاوزه كشخص وتؤثر عليه دون أن يشعر. والسؤال الذي ينبغي أن نطرحه هنا هو: لماذا فشلت الفلسفة الرشدية في أرضها الخاصة بالذات، ولقيت لها مرتعاً خصباً على الضفة الأخرى من المتوسط، أي عند الأوروبيين؟ ينبغي أن نطبق هنا منهجية سوسيولوجيا الإخفاق أو الفشل على المجتمعات الإسلامية لكي نعرف سبب هزيمة العقلانية ونجاح الدروشة واللاعقلانية والانسحاب من العالم. وينبغي أن نعترف هنا بأنه إذا لم تتوافر الأطر الاجتماعية المحبذة لانتشار هذا النوع من المعرفة فإنه لا ينتشر أو يموت في أرضه. وهذا هو سبب موت الفكر العلمي عندنا وازدهاره عند الأوروبيين بدءاً من عصر النهضة. لقد كانت الأرضية عندهم مؤاتية لذلك أورق الفكر العلمي وأينع وكانت عندنا قاحلة بواراً فضمر ومات. وإذن فينبغي عن السبب في البنى العميقة والجماعية من دون أن نهمل بالطبع الدور السلبي الذي لعبته الشخصيات الفردية، خصوصاً إذا كانت مهمة وتتمتع بهيبة كبيرة كالغزالي وابن تيمية مثلاً.
النزعة الإنسانية (هيومانيزم)
التي تعطي ثقتها للإنسان وتتفاءل بقدراته وإمكانياته. فالأهمية التي أعطيت للإنسان لم تكن عبثاً، وإنما كانت لها بواعثها ومسبباتها. فالإنسان عندما ينجح مادياً ويهيمن على العالم يتفاءل بالحياة ويشعر بالزهو والإعجاب بنفسه وعندما يفتقر ويفشل يزهد في الحياة الدنيا ولا يعود يفكر إلا في الآخرة كتعويض عنها. وما ينطبق على الأفراد ينطبق على الجماعات والشعوب. نقول ذلك ونحن نعلم أن العصور الوسطى كانت تزهد بالإنسان عموماً، ولا تعتبر تحققه الذاتي على هذه الأرض أو نجاحه المادي شيئاً مرغوباً، على العكس كانت تعتبر أنه يبعده عن الله. فالغنى يبطر الإنسان وبالتالي فإن الانتقال من العصور الوسطى الإقطاعية الفقيرة، المنغلقة على نفسها، إلى النهضة الواثق بنفسه، لم يتم إلا بعد أن جرت تحولات مادية على أرض الواقع. فالنهضة إما أن تكون مادية ومعنوية، أو أنها لن تكون.
كانت النزعة الإنسيَّة أو الإنسانية "هیومانیزم" تعتقد أن الإنسان هو مقياس كل شيء، وهو مركز الكون، وهو المخلوق المتميز المدعو إلى تجسيد إرادة الله على الأرض، وذلك بفضل العقل والنعمة الإلهية وبالتالي فإن النزعة الإنسانية التي سادت آنذاك مؤمنة لا إلحادية كما حصل في الغرب لاحقاً. بل إن النزعة الإنسية المسيحية لا تزال تمثل تياراً فلسفياً حتى هذه اللحظة في أوروبا. يكفي أن نذكر كأمثلة عليها فلاسفة كبار من أمثال كارل ياسبرز الألماني أو غابرييل مارسيل الفرنسي أو إيمانويل مونييه أو حتى بول ريكور أهم فيلسوف فرنسي الآن. فهو مؤمن بروتستانتي، ولم يمنعه إيمانه من أن يكون فيلسوفاً كبيراً ملما بكل علوم العصر. الحداثة وإذن فليس من الضروري أن تكون ملحداً لكي تكون فيلسوفاً كبيراً كما توهم بعض المثقفين العرب "التقدميين" أكثر من اللزوم وأعتقد أن هؤلاء المثقفين فهموا من ذنبها أكثر مما فهموها على حقيقتها. وهذا شيء ينبغي تصحيحه لأنه يعطي صورة مشوهة ـ أو لاتاريخية ـ عن تشكل الحداثة مهما يكن من أمر، فإن النزعة الإنسانية في عصر النهضة لم تكن تعني التمرد على الله من أجل الاهتمام بالإنسان فقط، وإنما كانت تعني الاهتمام بالإنسان لأنه أعظم مخلوق خلقه الله وزوده بالعقل الله في أرضه). ولذا ينبغي التمييز بين النزعة الإنسانية المؤمنة، والنزعة الإنسانية الملحدة التي يمثلها في هذا العصر سارتر أو هيدغر وعموم التيارات الوضعية المسيطرة على الساحة الغربية بشكل عام ولكن إذا كانت النزعة الإنسانية الإلحادية قد سيطرت في الآونة الأخيرة، فإن ذلك لا يعني أن التيار الآخر غير موجود. بل إنه يعود الآن بقوة إلى الساحة نتيجة فراغ المعنى في المجتمعات الأوروبية المعاصرة. وربما تحققت نبوة أندريه مالرو التي يقول فيها: إن القرن الحادي والعشرين سوف يكون روحانياً أو أنه لن يكون فبعد أن شبع الغرب من الماديات وتاه كثيراً في تيارات العبث والعدمية والإلحاد واللامعقول ربما راح يعود إلى الإيمان من جديد. ولكنه سيكون إيمان ما بعد التنوير لا ما قبله.
الفلسفة الإنسانية لعصر النهضة والتمايز عن العصور الوسطى
في الواقع إن التصور الحديث لعصر النهضة لم يتشكل تماماً إلا في عصر التنوير، وهو تصور يركز على القطيعة والبداية من نقطة الصفر. وقد بلوره مفكرو التنوير بعد أن أحسوا بالتوجه الجديد لمصير التاريخ البشري. اعتبر فونتنيل عصر النهضة بمثابة التنوير الأدبي والفني الذي سبق التنوير العلمي ومهد له الطريق. يقول: عندما ابتدأت العلوم والصناعات تولد من جديد في أوروبا بعد فترة همجية طويلة، كانت الفصاحة والشعر والرسم وفن العمارة قد سبقتها. كانت أول من خرج من الظلمات وأما العلوم الرياضية والفيزيائية فلم تنهض إلا بعد قرن من نهوض الآداب والفنون، وذلك لأنها تحتاج إلى تأمل أعمق وأطول.
هكذا نجد أن عصر النهضة يبدو بمثابة العتبة التي تفصل الظلمات عن النور، أو فترة البربرية عن فترة الحضارة. مهما يكن من أمر فيمكن تحديد عصر النهضة على أساس أنه اكتشاف معنى جديد للحياة، وبلورة هذا المعنى الذي يتمثل فيما يلي: لقد أصبحت الحياة قيمة بحد ذاتها هذا في حين أنها كانت تافهة ولا تساوي شيئاً في نظر أناس العصور الوسطى. كانت الحياة الوحيدة التي لها الحياة الآخرة. هنا يكمن الانقلاب المعنوي الأساسي الذي طرأ فعلاً في عصر النهضة، ثم ترسخ أكثر فأكثر على مدار العصور التي تلتها.
والآن ينبغي أن نتحدث عن موقف النهضويين من الدين، وكيف وفقوا بين إعجابهم الشديد بالحضارة اليونانية - الرومانية التي هي وثنية من جهة، وبين تعلقهم بالمسيحية من جهة أخرى؟ فالحضارة الإنسيّة (أو الإنسانية) عرَّفت نفسها بأنها حركة للإنسان عن طريق اكتشاف القيم الأخلاقية والفكرية المطمورة في الأدبيات الإغريقية - اللاتينية وتعديلها لكي تتأقلم مع الحاجات الجديدة. ألا يمكن القول، والحالة هذه بأنها تتعارض مع التصور المسيحي للعالم والإنسان والله؟ إن النهضويون بعد أن حجوا إلى مصادر الفكر الإغريقي - اللاتيني استخلصوا منها أن الفلسفة الأفلاطونية أو الرواقية ما هي إلا تمهيد لـ " فلسفة المسيح " أي للدين المسيحي الأصلي، دين الإنجيل والرسائل التقوية لبولس وآباء الكنيسة. واحد ولم يكن من قبيل الصدفة أن القديس أوغسطينوس والقديس جيروم اللذين أنجزا في وقتهما تلك التوليفة المتناغمة الوثنية اليونانية - الرومانية والتراث اليهودي - المسيحي هما اللذان ألهما الأدبيات النهضوية في القرن السادس عشر، وألهما فن الرسم أيضاً .
وبالتالي، فلا أعرف كيف تشكلت تلك الصورة اللاتاريخية عن حداثة أوروبا لدى بعض قطاعات المثقفين العرب الذين توهموا بأن الغرب كان متخلصاً من الدين منذ البداية، أو أنه لا وجود للدين في الغرب! ... ينبغي أن نعيد النظر في كل تصوراتنا عن الغرب وعن كيفية تشكل الحداثة فيه منذ القرن السادس عشر. فالغرب كان متديناً، بل ومتشدداً . في تدينه مثلنا وأكثر. ولم تحصل عقلنة الدين لدى قطاعات واسعة من الشعب إلا بعد معارك طاحنة استمرت عدة قرون. ولا يمكننا أن نفهم الحركة النهضوية أو الإنسانية إلا إذا موضعناها ضمن منظور صراعها الجدلي مع التراث الديني المسيحي لنحاول أن نقدم هنا مرة أخرى تعريفاً جديداً للحركة الإنسية أو الإنسانية (هيومانيزم). يمكن القول بأنها تمثل أخلاقية النبل البشري وكانت موجهة في اتجاه الدراسة النظرية والتطبيق العملي في آن معاً. إنها تعترف بعبقرية الجنس البشري، بل وتمجد عظمة الإبداع الإنساني وتواجه قوة الطبيعة الميتة بالقوة الحية للإنسان. إن النزعة الإنسانية هي ذلك الجهد الذي يبذله الإنسان لكي ينمي في داخله، وبواسطة النظام الصارم،والمنهجي كل الطاقات البشرية، فلا يترك شيئاً يضيع مما يعظم الإنسان ويمجده. وقد عبر عن ذلك غوته عندما قال: (إن النزعة الإنسانية هي ذلك الجهد المتواصل والمبذول من أجل التوصل إلى أروع صيغة للوجود البشري). وأما ستندال فيوجه النصيحة التالية إلى الرسام دولاكروا: لا تهمل شيئاً مما يجعلك عظيماً وكبيراً. ولكن إيتيان جيلسون الميال إلى العصور الوسطى والكاره للحداثة يحاول النيل من النزعة الإنسانية وعصر النهضة عندما يقول: «النزعة الإنسانية ليس زائداً الإنسان، وإنما ناقصاً الله» !... وهذا تعريف جائر لعصر النهضة. فهذا العصر لم يكن ملحداً ولا كافراً كما قلنا ولكن يبقى صحيحاً القول بأن كل نزعة إنسانية تميل إلى تعظيم الإنسان وتضخيم دوره وأهميته وتميل بالتالي إلى أن تعتقه من ربقة البعد اللاهوتي من دون أن تهمله كلياً. ولهذا السبب فإن نظرية حقوق الإنسان غير مفهومة من قبل المجتمعات التي لا يزال اللاهوت القروسطي يسيطر عليها حتى الآن فهي ترى في هذه الحقوق نوعاً من الوثنية أو التمرد على الله!
لماذا كل هذا الكره للعصور الوسطى؟ لسبب بسيط هو أن إيراسموس كبقية النهضويين والإنسانيين كان يختنق في ذلك الجو الكئيب الذي تشيعه الأديرة المسيحية. وعندما تعرف على النصوص اليونانية لأول مرة فوجئ بروح الأمل والتفاؤل التي تنبثق منها. وأُعجب إعجاباً شديداً بتلك الثقة التي يوليها الفكر اليوناني للإنسان، وذلك على عكس العصور الوسطى المسيحية التي تحتقر الإنسان وتزهد فيه. هذا هو السبب الأساسي لتعلق النهضويين بالحضارات القديمة السابقة على المسيحية، وبخاصة مسيحية القرون الوسطى. واكتشفوا عندئذ أن المسيحية في بداياتها - أي مسيحية الإنجيل والحواريين - كانت مختلفة جداً عن المسيحية المتكلسة والمتحجرة للعصور الوسطى. ولذلك دعا إلى العودة إلى عصور البراءة الأولى حيث كان الدين لا يزال غضاً في أوله.
من هنا يتضح خطأ من يربط بين تاريخ نهضة أوروبا والإلحاد. ويكفي بهذا الصدد أن نذكر بتصريحات ديكارت العديدة التي يعلن فيها انتماءه للدين المسيحي وإخلاصه له. يقول في كتابه الشهير مقال في المنهج: وكان أول مبدأ اتبعته هو أن أخضع لقوانين بلادي وعاداتها، وأن أستمر على هدي الدين الذي أنشأني الله فيه منذ نعومة أظفاري، وأن أتبع في جميع المجالات الآراء الأكثر اعتدالاً والأبـعـد عـن روح والمغالاة) ولكنه طبق منهجيته في الشك على كل شيء ما عدا العقيدة الدينية، لأن الأصولية المسيحية كانت في هذا الوقت في ذروة جبروتها وكانت قادرة على الضرب مباشرة، وديكارت كان حذراً ويريد أن ينجو بجلده ويتابع أ[حاثه بهدوء، ولذلك اتهم بالجبن والتقية، ولكن معظم علماء تلك الفترة بمن فيهم نيوتن، كانوا مؤمنين كباراً. وبالتالي فلا ينبغي أن نخلط بين التنوير والإلحاد أو بين التنوير والكفر كما يزعم الأصوليون المتزمتون اليوم. فالتنوير لا يعني الكفر. ولا يعني الإيمان على الطريقة التقليدية القروسطية. التنوير يعني توليد إيمان جديد ينهض على أنقاض الإيمان القديم. هنا تكمن روح عصر التنوير أو جوهره، ينبغي أن نميز هنا بين التنوير المؤمن (فولتير، روسو...) والتنوير الملحد (ديدرو، هولباخ، لامتري). كان البارون هولباخ في كتابه "الفلسفة الطبيعية" يدين بشدة الكتابة التقليدية القائمة على الخنوع والخضوع للقوى الغيبية. وكان يقول بأن ذلك هو الذي يشجع الناس على الخنوع للجبابرة الأرضيين ويمنعهم من التفكير باستقلالية واستلام زمام أمورهم بأيديهم. ومعلوم أن فولتير كان يعتبر الإيمان بالله قيمة أساسية لا يمكن التخلّي عنها. ولكن هولباخ كان يعتبر ذلك موقفاً هجيناً أو تسوية جبانة مع رجال الدين. ففي رأيه أنه ينبغي استئصال الدين جملة وتفصيلاً، واعتناق المذهب العقلاني، المادي، العلمي المحض. ولكن فولتير كان ربوبياً إذا جاز التعبير أي يختصر عقيدته إلى مبدأ أساسي واحد هو : الإيمان بوجود خالق للكون ولكن من دون الاعتقاد بالوحي. لقد انتشرت العقيدة الربوبية انتشار النار في الهشيم أثناء عصر التنوير. ومعظم الفلاسفة والعلماء كانوا ربوبيين وقلة منهم كانوا ماديين تماماً أو ملحدين (ديدرو في المرحلة الثانية من حياته، البارون هولباخ..) وهذا ينسف تلك الصورة الشائعة عن التنوير في العالم العربي أو الإسلامي والقائلة بأنه ملحد كله.
لا ينبغي أن نعتقد بأن عصر التنوير كان فترة مضادة للدين كلياً، ولكل اعتقاد. وإنما قامت نهضة أوروبا على العلم والفلسفة، وهما لا يستلزمان الإلحاد بالضرورة، ولكن يستلزمان تغيير نظرة الإنسان لنفسه وللدين وللعالم من حوله.
ينبغي العلم بأن الوعي الأوروبي أو المسيحي وقع في تناقض مع نفسه منذ عام ١٦٨٥، أو حتى قبل ذلك بقليل. وكل ذلك بسبب ظهور رؤية جديدة للعالم تنافس الرؤية المسيحية التي كانت مسيطرة على الأذهان والعقول طيلة ألف سنة على الأقل، أي طيلة العصور الوسطى. ولم يكن من السهل أن تقبل بظهور رؤية منافسة أو بديلة، ولم يكن من السهل على الناس أن يغيروا عقولهم فجأة لكي يتبنوا التصور الجديد. فالتصور القديم يكون عادة راسخاً في النفس ومحبباً إليها بحكم العادة والألفة والزمن المتطاول أو المتوارث أباً عن جد لا . ليس من السهل أن تنفصل عن نفسك أو عن تصوراتك السابقة: أي عن كل ما شكلك منذ نعومة أظفارك عندما كنت لا تزال غضاً طرياً بعمر الورد.
وهكذا سارت حركة التنوير شيئاً فشيئاً، فبعد مائة سنة من لحظة ديكارت يجيء ء كانط لكي يكمل القفزة الفكرية صراحة: أي لكي يمدَّ سلاح الشك المنهجي على مجال الدين أو العقائد المقدسة أيضاً. كذا نجد الأمور اختلفت من لحظة ديكارت إلى لحظة كانط . فما كان مستحيلاً التفكير فيه أصبح ممكناً التفكير فيه. وما كان عصياً على النقد (أو يتعالى على كل نقد) أصبح الآن خاضعاً له. هنا تكمن لحظة التنوير الأساسية. هنا تكمن اللحظة التي بدونها لا يمكن أن ينشأ أي تنوير فلأول مرة أصبحت العقائد الدينية المسيحية، أي قدس الأقداس عرضة للدراسة العقلانية النقدية. وهذه اللحظة التنويرية هي التي شكلت فيما بعد أكبر حضارة شهدها التاريخ البشري قصدت الحضارة الأوروبية الحديثة. ولكن براعم التنوير الأولى ابتدأت في الواقع قبل كانط، وإن كانت قد نضجت على يديه . فبدءاً من النصف الثاني من القرن السابع عشر، أي بعد موت ديكارت، راح بعض المفكرين الجريئين يطبقون منهجيته على النصوص الدينية نفسها. وكان في طليعتهم بالطبع سبينوزا. ولكنه لم يكن الوحيد. فقد كان هناك البروتستانتي بيير بايل، واللاهوتي ريشار سيمون والفيلسوف مالبرانش، وجون لوك، وأنطوني كولينز، وجون تولاند، وآخرون عديدون هؤلاء المفكرون الذين عاشوا أو كتبوا في الفترة الواقعة بين عامي ١٦٨٠ و ۱۷۱۵ هم الذين مهدوا لعصر التنوير.
وقد حصلت معركة كبرى بين الطرفين: أي الطرف العقلاني والطرف الأصولي، لم تشهد لها أوروبا مثيلاً من قبل. وعن هذه المعركة الهائجة تمخضت الحداثة. فالحداثة القديمة في أوروبا كانت مبنية على فكرة الواجب أساساً: أي واجب الإنسان تجاه رجال الدين والملوك وتقديم الطاعة والخضوع من دون سؤال أو مناقشة. وإذ بالفلاسفة الجدد يؤسسون لحضارة جديدة مبنية على فكرة الحقوق: أي حقوق الضمير الفردي، وحقوق النقد، وحقوق العقل، وحقوق الإنسان والمواطن.
كان التعصب الديني ضارباً أطنابه آنذاك في فرنسا وكل أنحاء أوروبا. وكان الملك لويس الرابع عشر قد قرر تنظيف المملكة الفرنسية من البروتستانتيين طبقاً للشعار المشهور مذهب،واحد قانون واحد، ملك واحد! وقد أرسل لهذا الغرض الأصوليين المتعصبين الذين هجموا على الأحياء البروتستانتية وهم يصرخون: «اقتلوا اقتلوا كل من ليس كاثوليكياً وهكذا راحوا يشنقون الناس نساء ورجالاً، من شعرهم أو من أرجلهم كانوا يعلقونهم في السقوف فوق المداخن لكي يحرقوهم على نار بطيئة . . وكانوا ينتفون لحى الرجال أو شعر النساء حتى آخر شعرة. وبعدئذ كانوا يرمونهم في النار المتوهجة التي أشعلوها خصيصاً لهذا الغرض، ولا يخرجونهم منها إلا إذا تخلّوا عن معتقداتهم ... وفي أحيان أخرى كانوا يربطونهم بحبال ويغطّسونهم في آبار عميقة ويعيدون تغطيسهم مرات ومرات حتى يغيروا مذهبهم.
نعم هذا ما حصل في أوروبا القرن السابع عشر بل وحتى الثامن عشر. وهو ليس إلا غيض من فيض مما فعلته الأصولية آنذاك. فهناك مجزرة "سانت بارتيليمي" الشهيرة التي ذهب ضحيتها عدة آلاف من البشر خلال ليلة واحدة فقط، وأصبحت رمزاً على التعصب المذهبي أو الديني وهناك حرب الثلاثين سنة بين الكاثوليكيين والبروتستانتيين والتي اجتاحت ألمانيا ومختلف أنحاء أوروبا وأحرقت الأخضر واليابس. وهناك، وهناك ... لهذا السبب نهض المفكرون الأحرار الذين راعهم هذا "الإيمان" الذي يقتل. فالأصوليون المسيحيون كانوا يدعون إلى الذبح والاغتيال صراحة، ويبررون ذلك بفتاوى دينية مستمدة من لاهوت القرون الوسطى. ولكن بقدر ما كانت جرائم الأصوليين شنيعة ومريعة، بقدر ما كان رد فعل فلاسفة التنوير عميقاً وراديكالياً. نعم لقد نقدوا العقائد اللاهوتية القروسطية حتى استأصلوها من جذورها ولم تقم للأصولية بعدها قائمة في كل أنحاء أوروبا.
الأصولية المسيحية في الغرب
نشأت محاكم التفتيش في أوروبا المسيحية منذ عام ١٢٣٣ بقرار من البابا غريغوريوس التاسع واستمرت حتى القرن الثامن عشر. وبلغت ذروتها في إسبانيا الكاثوليكية المتشددة، حيث تم طرد المسلمين العرب حتى بعد أن اعتنقوا المسيحية وتخلوا عن دينهم تحت الضغط. واستمرت أيضاً محاربة المفكرين والعلماء منذ ذلك الحين وحتى مشارف القرن العشرين. وقد أنشئت لجنة خاصة لتحريم الكتب في الفاتيكان، ومهمتها تكمن في ملاحقة الكتب الفلسفية أو العلمية التي يُشتبه فيها أو في انحرافها عن العقيدة المسيحية الصارمة. هكذا حوربت كتب غاليليو وديكارت وسبينوزا وديدرو وجان جاك روسو وفولتير وغيرهم كثير. وكان الفلاسفة يطبعون عادة كتبهم في هولندا - البلد الأكثر حرية في ذلك الزمان - ثم يُدخلونها "تحت المعطف" إلى فرنسا. وبما ان كل ممنوع مرغوب فان الناس كانوا ينكبون على هذه الكتب المحرمة ويبحثون عنها في كل مكان.
أصبحت محاكم التفتيش السيئة الذكر مثلاً يضرب على ذروة التعصب وعدم التسامح .. وكان هدفها محاربة الهرطقة في كل أنحاء العالم المسيحي. والمقصود بالهرطقة هنا أي انحراف ولو بسيط عن العقائد المسيحية الرسمية. وقد كلف بها رجال الدين في مختلف المحافظات والأمصار فكل واحد منهم كان مسؤولاً عن ملاحقة المشبوهين في أبرشيته وكانت الناس تساق سوقاً إلى محكمة التفتيش عن طريق الشبهة فقط، أو عن طريق وشاية أحد الجيران كانوا يقدمون المشبوه للاستجواب حتى يعترف بذنبه، فإذا لم يعترف انتقلوا إلى مرحلة أعلى فهددوه بالتعذيب. وعندئذ كان الكثيرون ينهارون ويعترفون بذنوبهم ويطلبون التوبة. وأحياناً كانت تُعطى لهم وينالوا البراءة. ولكن إذا شكوا في أن توبتهم ليست صادقة عرضوهم للتعذيب الجسدي حتى ينهاروا كلياً وإذا أصر المذنب على أفكاره ورفض التراجع عنها فإنهم يشعلون الخشب والنار ويرمونه في المحرقة وقد قتل خلق كثير بهذه الطريقة الوحشية التي أصبحت علامة دالة على العصور الوسطى.
الأصولية المسيحية والعصور الحديثة
ننتقل الآن إلى ما حصل بعد عصر النهضة والإصلاح الديني في القرن السادس عشر. فمنذ تلك الفترة يؤرخ عادة للعصور الحديثة، نقول ذلك على الرغم من أن هذه العصور لم تنتصر حقيقة إلا بعد مائتي سنة، أي في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر. عندئذ حصلت القطيعة المعرفية الكبرى بين العصور الوسطى والعصور الحديثة.
بعد اندلاع حركة الإصلاح الديني وحركة النهضة في القرن السادس عشر اصبح العدو الأول لروما والفاتيكان شخصان اثنان هما: البروتستانتي والنهضوي. بمعنى آخر اصبح لوثر هو العدو، وكذلك إيراسموس زعيم عصر النهضة. ولذلك أطلق البابا فتواه الشهيرة بتكفير لوثر وفصله من الكنيسة عام ١٥٢١. وبدءاً من تلك اللحظة انقسم العالم المسيحي في أوروبا إلى قسمين: قسم كاثوليكي وقسم بروتستانتي. ودارت بينهما المعارك والحروب على مدار مائتي سنة تقريباً. وهي حروب المذاهب الشهيرة التي ذهب ضحيتها عشرات الآلاف، بل ومئات من القتلى. وفي أواخر القرن السادس عشر تمت ملاحقة كتب إيراسموس ولوثر وأدرجت في قائمة الكتب الممنوعة أو المحرمة، بل وأحرقت في الساحات العامة. وفي القرن السابع عشر حصل الشيء نفسه لكتب ديكارت التي اعتبرت خارجة على الدين. وأما الفيلسوف سبنيوزا فقد عانى من التعصب اليهودي والمسيحي في آن معاً، فقد حاول أحد اليهود المتعصبين اغتياله، ولكن ضربة الخنجر لم تمزق إلا معطفه السميك لحسن الحظ. وأما في القرن الثامن عشر، فإن المعركة اندلعت على المكشوف بين فلاسفة التنوير وبين زعماء الأصولية المسيحية وكانت معركة ضارية استخدمت فيها كافة فكرية وغير فكرية. وتُوجت أخيراً بانتصار عصر التنوير على الظلامية المسيحية. وهكذا انتصرت القوى الجديدة الصاعدة على القوى القديمة الماضوية. منذ تلك اللحظة انطلقت أوروبا وأقلعت حضارياً بسرعة مذهلة وسيطرت على العالم. ولكن هذا لا يعني ان القوى الأصولية قد سلمت نفسها بسهولة. فالواقع أنها ظلت تحارب قوى الاستنارة وتحاول عرقلة التقدم طيلة القرن التاسع عشر وحتى مشارف القرن العشرين. وهكذا اندلع الصراع من جديد بين الحداثة الفكرية الصاعدة وبين الأصولية المسيحية المتشددة. ولم يحسم هذا الصراع إلا عام ۱۹٦٢ عندما انعقد المجمع الكنسي الشهير باسم الفاتيكان الثاني فقد شعر المسيحيون عندئذ انه لا جدوى من مناطحة العصر إلى ما لا نهاية وانهم سوف يخسرون آخر مواقعهم إذا ما استمروا على خط التشدد والتزمت وهكذا اعترفوا لأول مرة بشرعية المنهج التاريخي والتأويل الحديث للدين. كما وقدموا تنازلات أخرى عديدة لأفكار وتوجهات العصور الحديثة. وهكذا توصلوا إلى صيغة تصالحية بين المسيحية والحداثة، صيغة توفيقية تُعطي كل ذي حق حقه. ولكن بقيت هناك نواة متشددة ترفض مقررات هذا المجمع الكنسي الجريء وتصر على مواقعها التقليدية واندلع الصراع عندئذ بين المسيحيين أنفسهم: أي بين الاتجاه الليبرالي التحديثي والاتجاه الأصولي المنغلق. ولا يزال هذا الصراع دائراً . حتى اليوم وإن كانت الغلبة قد تحققت للاتجاه الأول. والواقع إنه لولا تطور المجتمعات الأوروبية على كافة الأصعدة من علمية وتكنولوجية واقتصادية وارتفاع مستوى المعيشة لما استطاع الاتجاه العقلاني أن ينتصر على الاتجاه السلفي المتشدد. هكذا نجد أن هذه المعركة أي معركة الأصولية، قد استغرقت من أوروبا مدة ثلاثمائة حلت مما يدل على مدى صعوبتها ووعورتها وخطورتها. ولولا انتشار العقلانية والروح العلمية في أوساط واسعة من المسيحيين الأوروبيين لما استطاع خط التقدم والتنوير أن ينتصر أخيراً.
إن أزمة الأصولية المسيحية، وكل الأصوليات، هي أنها تخلط بين الله، وتعتبر ذاتها الطريق الوحيد والإجباري إلى الله. إنها لا تستطيع تفهم أنه يمكن أن يوجد طريق آخر للتدين وفهم النصوص أو تأويلها. يقول المفكر الفرنسي المعاصر جورج غوسدروف بهذا الصدد ما يلي: في النظام المسيحي التقليدي كانت المؤسسة الكهنوتية هي المحل الوحيد لإقامة العلاقة بين الإنسان والله. كانت الكنيسة هي وسيلة التوصل إلى التعالي ولكنها أصبحت فيما بعد غاية بحد ذاتها. وهكذا خلعت القدسية على نفسها وطابقت بين ذاتها وبين الحقيقة الإلهية، على الرغم من أنها مؤسسة بشرية. وأصبح من المستحيل التفريق بين خدمة الله وخدمة الكنيسة.
لقد فرض اليسوعيون الطاعة المطلقة للبابا على الناس فرضاً ولعبوا دوراً كبيراً في ترسيخ الأرثوذكسية الدينية. نقصد بالأرثوذكسية هنا احتكار التأويل المستقيم للدين، أو الخط المستقيم، وما عداه فهرطقات وبدع فتفسيرهم للدين أصبح هو وحده التفسير الصحيح القويم، وأما تفسير الآخرين كالبروتستانتيين أو الفلاسفة أو العلماء فهرطقة في هرطقة. هذا هو تعريف الأصولية: فهي تزعم بأنها هي وحدها التي تمتلك التأويل الصحيح للنصوص التأسيسية، أو للأصول. وبالتالي فينبغي تكفير كل من ينحرف عن هذا التأويل ولو شعرة واحدة. وإذا أمكن فينبغي حرقه أو قتله، أو اغتياله. وهذا هو الإيمان القروسطي: أي الإيمان الذي يقتل أو يخلع المشروعية اللاهوتية على عملية القتل والتصفية الجسدية. وقد ذهب ضحيته عشرات بل مئات العلماء والمفكرين في شتى أنحاء أوروبا.
وظلت الكنيسة تحجر على العلم ولعلماء قرون طويلة، ويقول جورج غوسدورف بهذا الصدد ما يلي: «لقد ظلت الجامعات الفرنسية طيلة القرن الثامن عشر متجاهلة لتقدم علم الفيزياء، وذلك بسبب هيمنة الكهنوت الديني عليها ) . يحصل ذلك كما لو أن اكتشاف قوانين الطبيعة يعتبر تطاولاً على القدرة الإلهية . . . وأما عن إيطاليا وإسبانيا فحدث ولا حرج. ذلك أن تأثير التزمت الديني عليهما كان أكبر مما هو عليه الحال في فرنسا. ولذلك توقفت فيهما الحركة العلمية طيلة قرنين من الزمن. وبعد أن كانت إيطاليا متقدمة على جميع دول أوروبا أثناء عصر النهضة أصبحت متخلفة ولم تستدرك تأخرها إلا في العقود الأخيرة. وأما إسبانيا فقد ظلت بالإضافة إلى البرتغال الدولة الأكثر تخلفاً في أوروبا. وكل ذلك بسبب هيمنة الأصولية المتزمتة عليها ولكنها كسرت قيود الأصولية والديكتاتورية بعد موت ،فرانكو ومشت خطوات حثيثة في العشرين سنة الأخيرة من أجل اللحاق ببقية الأمم الأوروبية المتقدمة. في الواقع إن الأصولية المسيحية لم تصحح موقفها من غاليليو والعلم الحديث إلا ١٩٦٢. فقد عبر العديد من رجال الدين المستنيرين " الفاتيكان الثاني " مجمع عندئذ عن رغبتهم في أن تعلن الكنيسة اعتذارها أو توبتها عن الخطأ الذي ارتكبته بحق مؤسس العلم الحديث. وطالبوا بإعادة الاعتبار لغاليليو أو رفع تهمة الكفر والزندقة ولكن ذلك لم يحصل إلا عام ۱۹۸۲ ، أي بعد ثلاثة قرون ونصف على محاكمته وإدانته.
في الواقع أنه ينبغي التفريق هنا بين المذهب الكاثوليكي والمذهب البروتستانتي داخل الدين المسيحي. فالبروتستانتية كانت أكثر تحبيذاً للعلم وانفتاحاً عليه. وتشهد على ذلك الحقائق التالية : في الوقت الذي نشر فيه العالم البروتستانتي إسحاق نيوتن كتابه الحاسم "مبادئ الفلسفة الطبيعية" كان بوسويه زعيم الأصولية الكاثوليكية ينشر كتابه "تاريخ تقلبات الكنائس البروتستانتية". وفيه يعيب على البروتستانتيين تغيرهم أو ملاحقتهم لتطورات العلم ومحاولة التأقلم معها لاهوتياً بل ويعتبر التغير أو التجدد انحطاطاً وضعفاً. وفي الوقت الذي كانت فيه كتب كوبرنيكوس وغاليليو وديكارت ممنوعة رسمياً في البلدان الكاثوليكية، كانت البلدان البروتستانتية تستقبل بكل حفاوة النظريات العلمية الجديدة بما فيها نظرية الجاذبية الكونية وفي الوقت الذي كانت فيه البلدان الكاثوليكية تضع علماءها على قائمة الكتب المحرمة أو تجبرهم على النفاق والازدواجية والكتمان، أو تشعرهم بالذنب إذ يحققون اكتشافاتهم العلمية، كانت البلدان البروتستانتية تكرم علماءها، وتنشر أبحاثهم، وتتبنّى أفضل نتائجهم . لم يُفهم العلم على أساس أنه ضد الدين لدى البروتستانتيين كما حصل لدى الكاثوليكيين.
سبينوزا ومشكلة النص
كان سبينوزا هو أول من طبق المنهج العقلاني الديكارتي على النصوص المقدسة، ونشر كتابه الشهير "رسالة في اللاهوت والسياسة" حول هذا الموضوع لأول مرة في أوروبا، ومع أنه نشره بلا توقيع، أي بدون ذكر اسمه ولا اسم المطبعة، إلا أن المتعصبين من رجال الدين عرفوه لأنهم يعرفون أفكاره وفلسفته، ولاقى من أجل ذلك أهوالاً لا تطاق، من الكنيسة الكاثوليكية وحتى من قبل البروتستانت أنفسهم، وعاش مشرداً طريداً من مدينة لأخرى في هولندا، ولم يحتضنه إلا الليبراليون في عصره، وقد نجح في دفع الفكر الإنساني خطوات كبيرة إلى الأمام مع أنه مات ولم يتجاوز عمره الخمس وأربعون عاماً. كان يرى أن الاعتماد على تراث الأقدمين أو الهيبات المأذونة للحاخامات والبابوات من أجل التوصل إلى التفسير الصحيح للنصوص المقدسة يعني بكل بساطة إلغاء عقولنا. ولهذا فإن سبينوزا يتجرأ لأول مرة في التاريخ على اتخاذ القرار الخطير التالي: وهو أن الكتاب المقدس عبارة عن نصوص مكتوبة بلغة طبيعية مثله في ذلك مثل أي نص بشري آخر! أن ننظر إليه بشكل طبيعي مثله في ذلك مثل أي ظاهرة طبيعية أخرى! هذا الكلام في عصر سبينوزا كان يمثل جرأة انتحارية أو مخاطرة بالنفس بكل بساطة. يقول موضحاً قواعده المنهجية لقراءة الكتب المقدسة أو لتأويلها: ينبغي أن نعلم متى ظهر النص وفي أي مكان وتلبية لأي حاجة تاريخية؟ من الذي كتبه؟ ولمن كتب؟ ينبغي أن نعلم بقدر الإمكان سيرة الكاتب (أي النبي) أو حياته ثم الهدف الذي كان يبتغيه من كتابة هذا النص. هذا يعني أنه ينبغي أن نقوم ببحث تاريخي شامل لكي نتعرف بشكل دقيق على أنبياء التوراة وعصرهم وبيئتهم. هكذا نلاحظ أن سبينوزا أسس النقد التاريخي للنصوص المقدسة من دون أن يعلم. وسوف تشهد هذه المنهجية التاريخية تطوراً كبيراً في العصور اللاحقة حتى تبلغ ذروتها في القرن التاسع عشر. وسوف تثير حفيظة الكنيسة ورجال الدين الذين قاوموها بعنف لأنهم رأوا فيها نزعاً للقدسية عن النصوص المقدسة وكل تاريخ الحداثة الغربية بعد سبينوزا على مدار ثلاثة قرون لن يكون إلا صراعاً حول هذه النقطة الجوهرية.
وأخيراً نطرح هذا السؤال : ماذا كان موقف المعاصرين من كتاب سبينوزا "رسالة في اللاهوت والسياسة" بعد صدوره؟ على الرغم من أنه لم يوقع اسمه عليه، وعلى الرغم من كل الاحتياطات التي اتخذها، إلا أنهم عرفوا بأنه هو من ألفه. وقد أجمع اللاهوتيون على تكفيره والتنديد بأفكاره الهدّامة والخطرة على الدين. ففي رأيهم إنه لا يمكن اختزال الدين إلى مجرد طاعة الله ومحبة الآخرين، وإنما هناك أشياء أخرى غير ذلك أو بالإضافة إلى ذلك . هناك الطقوس والشعائر والعقائد. ثم قالوا بأن فكر سبينوزا يتعارض مع تعاليم الكنيسة المسيحية وبالتالي فلا يمكن القبول به لأن ذلك يعني الخروج عن الدين. ولكن هذه الإدانات الصادرة عن رجال الدين والتي كانت متوقعة لم تمنع انتشار الكتاب وحصول ضجة كبيرة حوله. وبما أنه مكتوب باللاتينية أي لغة الثقافة في كل أنحاء أوروبا آنذاك، فإنه انتشر خارج هولندا أي في ألمانيا وفرنسا، وانجلترا. وتصدى الكثيرون له إما لشرحه وإما لدحضه، وإما للاثنين معاً. في الواقع إن أطروحته القائلة بأن الفلسفة لا تهدّد الدين لم تقنع الكثيرين، وبخاصة إذا ما أخذنا الدين بالمعنى الشائع في المجتمع لا كما يتصوره هو . فالدين بالنسبة للمسيحي العادي، عبارة عن طقوس وشعائر وأسرار ربانية غيبية قبل كل شيء آخر. وبالتالي فالمفهوم العقلاني الذي قدمه عن الدين ما كان بإمكانه أن يواجه المفهوم التقليدي الراسخ منذ مئات السنين. سوف ينتصر مفهومه عن الدين ولكن لاحقاً: أي بعد مائتي سنة بعد أن تتقدم الشعوب الأوروبية، وتتعلم، وتستنير. حقاً لقد جاء سبينوزا قبل الأوان بوقت طويل.
والواقع أن سبينوزا كان يهدف من وراء كل ذلك إلى اختزال الكتاب المقدس إلى جملة مبادئ بسيطة، بل وإلى مبدأ واحد هو : إطاعة الله بكل قلوبنا عن طريق ممارسة العدالة والمحبة ومعاملة الآخرين بإحسان. هذا هو كل الدين ملخصاً بجملة واحدة، وكل ما عدا ذلك فهو قشور سطحية . كان یری أن الدين هو المعاملة، وحسن الطوية، ومساعدة الفقير، ومحبة الآخر ولو لم يكن ينتمي إلى ديننا أو طائفتنا. وهذا الفهم الواسع للدين، والذي هو أخلاقي بالدرجة الأولى، كان غريباً جداً على عقلية الأصوليين المتزمتين الذين يختزلون الدين إلى جملة من الطقوس والشعائر الشكلانية الخارجية، وجملة من المحظورات والمحرمات وجملة من العقائد اللاهوتية التي تخرج عن سيطرة العقل . هكذا نجد أنه كان يوجد داخل المسيحية نفسها مفهومان للدين : مفهوم أصولي متحجر، ومفهوم ليبرالي متحرر وكان الأصوليون يتهمون الليبراليين بأنهم من عبدة الشيطان! لماذا؟ لأنهم يرفضون رجال الدين ولا يعتقدون بضرورة أداء الطقوس والشعائر.. ولأنهم كانوا عقلانيين أو روحانيين في فهمهم للدين فإنهم أتهموا بالهرطقة، أو حتى بالإلحاد والكفر. فالأصولي يهمه قشور الدين وطقوسه الخارجية، لا جوهره ولا مضمونه. وفهم الأصولي للدين يكون عادة قمعياً، متجهماً، إرهابياً. وبالتالي فلا يستطيع أن يتحمل وجود هذه الطوائف المتسامحة جداً في فهمها للدين.
وهكذا قام سبينوزا بأكبر عملية تعزيل أو تنظيف داخلية للتوراة والإنجيل فلم يُبْقِ منها إلا على بعض المبادئ الأخلاقية الخاصة بالتعامل والحياة الاجتماعية. فحذف مثلاً الشريعة الموسوية أو اليهودية ما عدا الوصايا العشر لأنها تهدينا إلى الطريق المستقيم في الحياة. لماذا حذف الشريعة؟ لأنها خاصة بالدولة العبرانية في العصور القديمة ولا تعني لنا شيئاً الآن في دولة ليبرالية متقدمة كالدولة الهولندية وهكذا حرّر الناس من مبادئ الشريعة التي لا تحصى ولا تعد ومن محظوراتها وأوامرها القسرية التي تشل الحياة، والإبداع، والإنسان.
فولتير والإصلاح الديني والسياسي
لم يعرف تاريخ الفكر شخصاً كرس حياته كلها لمحاربة التعصب الديني مثل فولتير (١٦٩٤ - ١٧٧٨). ولهذا السبب أصبح اسمه رمزاً يستنجد به الناس في كل مكان في العالم : أي عندما يزيد التزمت والإكراه في الدين عن حدّه، أو عندما يعيث المتطرفون فساداً في الأرض. وللتسامح أو التعايش السلمي بين الأديان والمذاهب المختلفة راح فولتير يدعو ويكتب مؤلفاته الواحد بعد الآخر، من دون كلل أو ملل. وربما لهذا السبب أهداه نيتشه أحد كتبه قائلاً: إلى فولتير أحد كبار محرّري الروح البشرية. بل لم يكتف بالكتابة والتنظير وإنما نزل إلى ساحة المعركة مدافعاً عن كل المضطهدين لسبب عقائدي أو فكري وهكذا دافع عن البروتستانتيين، وهو الكاثوليكي أباً عن جد، وخاطر بحياته في بعض الفترات ودشن بذلك أسلوباً جديداً للمثقف المنخرط في القضايا العامة، المثقف الذي لا يقف مكتوف الأيدي أمام الفظائع التي ترتكب باسم الدين، والدين الحق من ذلك براء. وكان بإمكان فولتير، وهو الغني جداً، أن يعيش في برجه العاجي، مرتاح البال، يستمتع بالحياة بعيداً عن المشاكل ومن غير أن يعرض نفسه للمخاطر والأحقاد. ولكنه عرف أنه إذا ما سكت عن الجرائم التي يرتكبها المتعصبون الكاثوليكيون باسم الدين المسيحي، فإنه سوف يتخلى عن أعز وأغلى شيء يميز المثقف: ألا وهو الدفاع عن قضايا الحق والعدل.
بعد صدور الرسائل الفلسفية ابتدأ الانخراط الفلسفي لفولتير حقيقة. وكان آنذاك قد بلغ الأربعين من العمر وأحس بأنه مكلف بمهمة تنوير الشعب الفرنسي، أو على الأقل الأوساط المتعلمة منه. وعندئذ ارتسمت الخطوط العريضة لمعركته مع الأصوليين، وأخذ يواجه بكل حزم وقوة أنصار الدين الرسمي للدولة .. فالفلسفة كانت تعني بالنسبة له العمل من اجل الحقيقة وهي بالدرجة الأولى وسيلة لتحرير العقول من الأحكام المسبقة والخرافات. ومن ينشر هذه الخرافات والحزازات في أوساط الشعب إن لم يكن الكنيسة؟ كانت هي التي تسيطر على المعاهد التعليمية والمدارس والجامعات، وبالتالي فقد كان فولتير مضطراً للدخول في حالة منافسة شديدة . مع هذه المؤسسة العريقة والمقدسة التي كانت تحتل الموقع منذ قرون وقرون فإما أن يكسب الشعب إلى صفه - أو الشرائح المتعلمة منه على الأقل - وإما أن يظل في أيدي "الإخوان المسيحيين" . وهكذا ابتدأت المعركة الطاحنة للتنوير : كتاب ضد كتاب تفسير ضد تفسير، فكرة ضد فكرة. إنها حرب من اجل تحرير العقول أو إبقائها مكبلة بالسلاسل والأغلال. وسوف يخوضها فلاسفة التنوير شبراً ،شبراً وفتراً فتراً حتى تنتهي أخيراً بانتصارهم على الطرف المهيمن تاريخياً. ولم يشهد تاريخ البشرية معركة أكبر منها ولا أعظم.
في الواقع إن فلاسفة التنوير كانوا يريدون أن يعيدوا للفلسفة قيمتها من أجل أن يصبح العقل هو سيد الموقف وليس تراث الأقدمين الذي يفرض نفسه من فوق بهيبته القدسية التي رسخها الزمن المتطاول أو القرون العديدة. ولم يعودوا يقبلون أي شيء إلا بعد وضعه على محك العقل وكشف المسبات المنطقية التي أدت إليه.
ويمكن القول بأن فلسفة التنوير أدت بشكل عام إلى بلورة المقترحات التالية:
أولاً: أن الفلاسفة يرفضون التراث المسيحي التقليدي القائم على المعجزات. لماذا؟ لأن العقل لا يستطيع أن يقبلها ولأنها تنتهك قوانين العلم والمنطق. وهم في ذات الوقت يدعون إلى بلورة فهم جديد للدين مخالف للفهم الانغلاقي أو الأصولي السائد.
وثانياً: أنهم لم يعودوا يقبلون بأخلاقية التقشف والزهد في الحياة الدنيا وانتظار الفوز والنجاة في الدار الآخرة. وكانت هذه هي الأخلاقية الصارمة التي تفرضها المسيحية منذ القرون الوسطى. وإنما راحوا يدعون إلى بلورة أخلاق طبيعية أكثر إنسانية أي أخلاق تعترف للإنسان بالسعادة وحقه بالتمتع بمباهج الحياة على هذه الأرض.
وثالثاً: كان فلاسفة التنوير يعتقدون بأن هذا المفهوم البسيط والجديد للدين والأخلاق معاً موجود كنواة في جميع الأديان، ولكنه مغطّى بالقشور والشوائب. صحيح أن الطقوس والشعائر والعقائد تختلف من هذا الدين إلى ذاك، ولكن جوهر الدين يبقى واحداً ألا وهو: محبة الآخرين، والعمل الصالح، وخدمة المجتمع، والسلوك المستقيم وأما ما عدا ذلك فقشور وقوالب خارجية لا يُعتد بها.
لقد أضيفت إلى الكتب المقدسة نصوصاً تمجد الحكام وتوجب طاعتهم طاعة عمياء، وهذا ما هاجمه فولتير وغيره من فلاسفة عصر الأنوار في أوروبا، ولكن هذا ما لم يعجب رجال الحكم، فقد أمر برلمان باريس (الذي لم يكن يحمل من كلمة برلمان إلا الإسم) والذي كان يسيطر عليه المتزمتون بحرق كتاب فولتير "رسائل فلسفية" عام ١٧٣٤. لماذا؟ لأنه كتاب فضائحي مضاد للدين، والأخلاق الحسنة، والطاعة الواجبة تجاه الحكام كما جاء في قرار الاتهام. ولكن هذا الحرق لم يمنع الناس من شرائه والإقبال عليه.
هل كان فولتير مؤمناً؟ على هذا السؤال يمكن أن نجيب بنعم ولا. نعم، إذا كان المقصود بهذه الكلمة الإيمان بإله خالق للكون، أو المهندس الأكبر للكون بحسب تعبير فولتير شخصياً. نعم إذا كان المقصود بها الإيمان بالله الذي يعاقب الشرير ويكافئ الإنسان الطيب، ويقيم الحق والعدل في الكون كله، وأما كل ما عدا ذلك فحشو لا لزوم له. ولا، إذا كان المقصود الإيمان بدين محدد بعينه بكل عقائده وطقوسه بكل عجره وبجره ثم التعصب له ورفض كل ما عداه رفضاً قاطعاً حتى من دون تفحص أو تفكير، فالطقوس والشعائر ليست ضرورية إلا لعامة الشعب بحسب ما يرى فولتير. وأما الفلاسفة والمتنورون بشكل عام فيمكنهم الإستغناء عنها وليسوا بحاجة إليها لكي يؤمنوا، أو لكي يسلكوا سلوكاً مستقيماً في المجتمع.
تعريف الحداثة
یری هانز كونغ أن كلمة "حديث" Moderne قديمة ولكنها لم تستخدم للدلالة الايجابية على الحساسية الجديدة إلا في بداية عصر التنوير أو حتى قبله بقليل. لقد استخدمت كاحتجاج ضد التصور الدوري للتاريخ، هذا التصور الذي كان مستديراً بنظره نحو العصور اليونانية - الرومانية القديمة. وكان يرى فيها ذروة الحضارة . وهو تصور عصر النهضة كما هو معلوم. فالنهضة التي تعني في اللغات الأجنبية الولادة الثانية Renaissance كانت تنظر إلى الوراء لا إلى الأمام على عكس ما نتخيل. فقد كان مثلها الأعلى اليونان والرومان اللذين تريد إحياء تراثهما أو بعثه من جديد. وبالتالي فلم تستخدم مصطلح الحديث ولم تخترعه القرن السابع عشر الفرنسي هو الذي استخدمه وروجه لأنه أحس بالتفوق حتى على اليونان والرومان وذلك بعد النجاحات التي حققها العلم والفلسفة الحديثة على يد كوبرنيكوس وغاليليو وديكارت. وهكذا اندلع الصراع بين القدماء والمحدثين. أما كلمة حداثة Modernity فلم تشتق إلا في منتصف القرن التاسع عشر وفي عام ١٨٤٩ تحديداً. ويعتقد بان الشاعر بودلير هو أول من استخدمها وقد اعتبرت وقتها شاذة أو قبيحة من قبل الجمهور، وذلك قبل أن تنتشر وتلقى كل النجاح الذي لقيته في ما بعد.
أما فكرة التقدم وهي فكرة علمانية مميزة للعصور الحديثة، فقد انتشرت في الفترة نفسها أيضاً، وأصبحت النموذج الأعلى لكل التاريخ في القرن الثامن عشر، أي في عصر التنوير. وبلغ الإيمان بالتقدم ذروته في القرن التاسع عشر، عصر ازدهار العلم والصناعة والتكنولوجيا بامتياز وراح يحل محل الدين المسيحي ويصبح ديناً جديداً بدوره (وذلك بالنسبة للمفكرين الليبراليين أو البورجوازيين كما بالنسبة للمفكرين الاشتراكيين). الجميع في أوروبا راحوا يعلقون الآمال على العلم والتقدم العلمي لحل مشاكل البشرية. ولكن هذا الإيمان شبه الديني بالتقدم العلمي لم يدم أكثر من قرنين. فقد تلقى أول ضربة موجعة له مع اندلاع الحرب العالمية الأولى، وتلقى الضربة الثانية الحرب العالمية الثانية. ولذا فان هانز كونغ يؤرخ لما بعد الحداثة بعام ١٩١٨ أي تاريخ نهاية الحرب العالمية الأولى. ففي رأيه أن الحداثة توقفت منذ ذلك التاريخ، ودخلنا أو قل دخل الغرب في عصر ما بعد الحداثة من دون أن نشعر.
فقد استغرب الناس كيف يمكن لأمم حضارية كالأمم الأوروبية أن تتقاتل في ما بينها بمثل هذه الوحشية وتدمر بعضها بعضاً. عندئذ أخذ الناس يكفرون بفكرة التقدم والحداثة أو يشكون بها لأول مرة. فقد كان من المتوقع أن تنتهي الحروب والمذابح بانتشار التنوير الفكري وانتهاء عصر البربرية والهمجية والعصور الوسطى. لكن هذا ما لم يحدث خلافاً لكل التوقعات . لقد تميز عصر الحداثة بتغلب العقل على الإيمان والفلسفة على اللاهوت، والعالم المتعلمن شيئاً فشيئاً على الكنيسة. وهكذا اختفت الروحانية أو كادت من الحياة العامة وأصبح مسألة شخصية ليس إلا. (يدعو هانز كونغ إلى العودة إلى الدين بشكل مستنير، ولكني استبدلت عبارة العودة إلى الدين بالعودة إلى الإيمان بالله، العودة إلى الروحانية فحسب، لأن هذا هو الجوهر المطلوب، ولأنه لا أمل في إصلاح الدين).
ويعترف هانز كونغ بأن رد فعل عصر التنوير على التعصب المسيحي كان ضرورياً، بل ومشروعاً. فقد دفع بالمفكرين المسيحيين أو علماء اللاهوت إلى تجديد دينهم وتراثهم وتشكيل لاهوت جديد أو ليبرالي يتناسب مع عصر العلم والتقدم. ولولاه لظلوا سجناء اللاهوت القديم أو القروسطي - التقليدي. ولكن مشكلة الحداثة أنها في رد فعلها هذا ضد الأصولية المسيحية والتزمت الديني كادت أن تقضي حتى على الروحانية نفسها! وهنا يكمن النقص الكبير للحداثة على الرغم من كل ايجابياتها التي لا تنكر. وأخذت المجتمعات الأوروبية المتقدمة تشعر أكثر فأكثر بالحاجة إلى تغيير هذا الموقف أو تعديله.
من المعلوم أن هابرماس كان قد نشر عام ۱۹۸۰ مقالة شهيرة بعنوان الحداثة مشروع لم يكتمل . وهاجم فيها دعاة ما بعد الحداثة باعتبار أنهم يريدون القضاء على الانجازات الايجابية للحداثة، هذه الانجازات التي تحققت على مدار مائتي سنة أي منذ القرن الثامن عشر وحتى القرن العشرين. واعتبر هابرماس أن اليسار المتطرف يلتقي مع اليمين المتطرف في محاولته القضاء على الحداثة أو تشويهها أو تسفيهها . وقد أثارت مقالته هذه ضجة كبيرة في الأوساط الباريسية وأزعجت كثيرا فوكو ودريدا وغيرهما. لقد اعترف هابرماس بأن الحداثة وصلت إلى مأزق أو جدار مسدود، واخترع مصطلحاً ناجحاً جداً للتعبير عن هذا المأزق هو : الظلمة الجديدة أو العتمة الجديدة وقال: نحن نقف الآن أمام عتمة جديدة وكبيرة من تلك العتمات أو الأكمات التي واجهت الفكر البشري في مراحل المنعطفات التاريخية أو القطيعات الكبرى. وهي مراحل يصعب التنبؤ بها أو التكهن بها لأنها شديدة العتمة والظلام، ولأنها مفتوحة على كافة الاحتمالات ككل المراحل التدشينية في التاريخ . لكي يطمئن إذن هانز كونغ زميله هابرماس فانه يقول له إنه لا يريد بأي حال من الأحوال التنكر لمنجزات الحداثة كما يفعل البعض من المتهورين أو المتعصبين الرجعيين الحاقدين على الحداثة ولكنه لا يستطيع أن يهمل بعد اليوم مشكلة الروحانية كما يفعل معظم مفكري الحداثة من هيدغر إلى يوير إلى دريدا إلى فوكو إلى هابرماس نفسه، فالحداثة حلت مشكلة الدين عن طريق طرد الروحانية من الساحة. وهذا حل سلبي لا يمكن أن يدوم إلى الأبد. فعاجلاً أو آجلاً ينبغي أن نعيد الروحانية إلى الساحة الأوروبية من جديد ليس على طريقة القرون الوسطى المتعصبة بالطبع، ولكن على طريقة ما بعد الحداثة.
لماذا كل هذه الاستهانة بالروحانية في عصر الحداثة؟ لماذا كل هذا الاحتقار لها من قبل مفكري الغرب الذين يفتخرون صراحة بأنهم ملحدون؟ في رأي هانز كونغ، إن إعادة الاعتبار إلى مسألة الروحانية بعد أن غيبت طيلة مائتي سنة هي التي ستنقذ الحضارة الغربية من المأزق الذي وصلت إليه، وهي التي ستدشن عصر ما بعد الحداثة. وإذا لم نشخص الأزمة الروحية ولم نسيطر عليها، فإننا لن نستطيع تشخيص الأزمة العامة التي يتخبط فيها الغرب منذ عدة عقود من السنين. فالأزمة الحالية هي أزمة روحية أو أخلاقية قبل كل شيء. بعد أن وصل هانز كونغ في الحديث إلى هذه النقطة فإنه يخشى أن يُطرح عليه هذا الاعتراض : ألن يُتهم بالرجعية أو بالمحافظة إذ يعطي الدين كل هذه الأهمية. ويجيب فوراً: إنني لا أريد قطعاً أن أقع في النزعة المضادة للحداثة أو للتنوير، هذه النزعة التي يشجعها البعض حالياً من جهة الكنيسة أو غير الكنيسة. فإذا كان فلاسفة أمثال من فویرباخ، مارکس، نيتشه، فرويد. قد انتقموا من الدين وأعلنوا عن الله" أو غياب الله، فانه لا يريد أن ينتقم منهم ويعلن عن "موت الحداثة " . لنحترم إذن مشروع الحداثة فقد كان فيه من الخير الشيء الكثير. كل التقدم العلمي والطبي وتخفيف آلام البشر حصل في عصر الحداثة. ينبغي ألا ننسى ذلك . الحداثة "موت ولكن ينبغي أن نعترف بأن مشروع الحداثة قد وصل إلى نهاياته واستنفد كل إمكانياته بعد أن جرب نفسه طيلة المائتي سنة الماضية كل ما كان يمكن أن يعطيه أعطاه. وإذ نقول ذلك فإن هذا لا يعني أننا نهاجم الحداثة أو ننقص من قدرها. ثم يوجه هانز كونغ هذا النداء إلى اليسار النقدي واليمين الوضعي في آن معاً : اعلموا أن موت الروحانية الذي تنبأت به الأزمنة الحديثة على يد فوير باخ وماركس ونيتشه لم يحصل. فالإيمان لا يزال موجوداً حتى في أكثر المجتمعات الأوروبية تقدماً. صحیح أن الإيمان الطفولي وغير المستنير للجماهير قد مات، وخيراً ما حصل، ولكن الإيمان في المطلق لم يمت. فهناك إيمان قديم متعصب ،قروسطي، وهناك إيمان حديث، متسامح، مستنير، وشتّان ما بينهما ولا ينبغي أن نحمل الأول جريرة الثاني. ويرى هانز كونغ انه بعد تراجع التيارات الإلحادية العابرة في الخمسينات والستينات والسبعينات، فان الكثيرين من مفكري الغرب حاليا أصبحوا يشعرون بالحاجة إلى شيء آخر.
ففي هذه الفترة الصعبة من مأزق الحداثة، فان المشكلة لا تكمن فقط في نسيان الكينونة " كما توهم هيدغر، وإنما في نسيان الله . فالإنسان ذو البعد الواحد على حد تعبير ماركوز لا يستطيع أن يخلق بنفسه بعد التعالي والأمل لا يمكن أن يتحقق في حالة انعدام المعنى المطلق الذي يُشْعِر الإنسان بالطمأنينة . والمعنى المطلق عجزت الحداثة عن توفيره ووحده الإيمان إذا ما فهم بشكل صحيح قادر على ذلك. لماذا انتشرت الاتجاهات العدمية في الفكر والمسرح والأدب الحديث؟ لأن الإنسان الأوروبي فقد الإيمان ولم يعد يعرف كيف يعود إليه هنا تكمن الأزمة الحقيقية للحداثة. وقد أصبح حكماء الغرب وعقلاؤه يعترفون بذلك الآن. وعندما تسألهم يقولون لك: نعم إن الحضارة الغربية حققت تقدماً كبيراً على المستوى التكنولوجي والعلمي والصناعي، ولكنها لم تحقق نفس التقدم على المستوى الأخلاقي والروحي. هناك اختلال توازن في هذه الحضارة. والدليل على ذلك أنانيتها وجشعها الذي لا يشبع وتكالبها على أسواق العالم الثالث الفقير الذي يئن من الجوع.
والآن نطرح هذا السؤال : ما هي ملامح عالم "ما بعد الحداثة" الذي يدعو إليه هانز كونغ؟ يرى هذا المفكر أن فترة ما بعد الحداثة لا يمكن أن تكون مجرد انقلاب على الحداثة والتنوير وعودة إلى الوراء كما يحلم المحافظون والرجعيون. إنه لا يوافق على تقديس الحداثة ولا على إدانتها وإنما يدعو إلى غربلتها لفرز الصالح عن الطالح فيها. وهو يختلف أيضاً مع هابرماس الذي يدعو إلى مواصلة الحداثة على نفس الخط لأنها مشروع لم يكتمل في رأيه. ويرى هانز كونغ أن الحداثة مشروع شاخ واكتمل وقد آن الأوان لتجاوزه من خلال المراحل التالية : ينبغي أن نحافظ على الحس النقدي لعصر التنوير من أجل أن نحمي أنفسنا من كل الانغلاقات العقائدية أو الأصوليات الظلامية أياً يكن مصدرها . ولكن ينبغي في نفس الوقت أن نقول لا للنزعة الاختزالية التي تميزت بها الحداثة. فالحداثة الأوروبية (أو الغربية) بترت الجوانب الروحية أو الدينية التي تشكل الطبقات العميقة من الواقع واكتفت بدراسة الجوانب المادية أو الظاهرية من الواقع وقالت إنها هي وحدها الموجودة وما عداها فخرافات وأوهام. وهنا تكمن النزعة الاختزالية للحداثة الوضعية التي سيطرت على القرنين التاسع عشر والعشرين. ولكن عصر ما بعد الحداثة يرهص بالعودة إلى الإيمان من جديد، فالعقل والعلم والتقدم أشياء ممتازة بدون شك، ولكنها ليست كافية لوحدها، وإنما ينبغي أن نضيف إليها البعد الإيماني والروحي. ويأسف هانز كونغ لأن هابرماس الذي يمثل آخر ممثل كبير لمدرسة فرانكفورت لم يأخذ بعين الاعتبار تجربة أستاذه هوركهايمر، أحد مؤسسي هذه المدرسة بالذات . فبعد أن جرب هذا الأخير كل الاتجاهات العقائدية والماركسية والنقدية راح يدعو للعودة إلى الإيمان بالله وإلا فلا يوجد أي معنى للحياة يتجاوز الأكل والشرب والجنس. إن الإيمان هو الذي يخلع على حياتنا معنى يتجاوزها، وإلا فإنها تصبح مثل حياة الحيوان أكل وشرب وتناسل . لقد شعر هوركهايمر بخيبة الأمل بعد أن تعلق طويلاً بشوبنهاور ونيتشه ولم يجد له من حل في نهاية المطاف إلا في العودة إلى الإيمان الديني على الطريقة الصوفية. وعندما نقول "الله" فإننا نقصد الحقيقة العليا أو المطلقة، الحقيقة الأولى التي تتجاوز الحقيقة المادية الظاهرة. وبدون هذه الحقيقة المطلقة أو الغاية النهائية فان حاجتنا للعزاء تظل غير مشبعة في هذا العالم والفلسفة وحدها لا تكفي لتعزيتنا. وحدها الروحانية قادرة على ذلك. اهـ.
ولذلك فنحن لا ندعو إلى الإلحاد في عالمنا العربي لكي ينهض بل على العكس ندعو إلى إيمان بالله بلا حدود، ولكن بعيداً عن التمسك بحرفية النصوص الدينية وسلطة رجال دين والمؤسسات الدينية على حرية الفكر والتعبير.
#محمد_بركات (هاشتاغ)



ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

|
حفظ
 |
بحث |
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
| إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
قواعد التنوير الأربعون | القاعدة الخامسة: العلاقة بالآخر ومش
...
-
قواعد التنوير الأربعون | القاعدة الرابعة: تاريخية النص الدين
...
-
قواعد التنوير الأربعون | القاعدة الثالثة: الكهنوت العدو الأخ
...
-
قواعد التنوير الأربعون | القاعدة الثانية: لا يوجد دين رسمي ع
...
-
قواعد التنوير الأربعون | القاعدة الأولى: الله ظاهر في خلقه
-
المختار من الفتوحات المكية (23) محيي الدين بن عربي
-
المختار من الفتوحات المكية (22) محيي الدين بن عربي
-
المختار من الفتوحات المكية (21) محيي الدين بن عربي
-
المختار من الفتوحات المكية (20)
-
المختار من الفتوحات المكية (19) محيي الدين بن عربي
-
المختار من الفتوحات المكية (18) محيي الدين بن عربي
-
المختار من الفتوحات المكية (17) محيي الدين بن عربي
-
المختار من الفتوحات المكية (16) محيي الدين بن عربي
-
المختار من الفتوحات المكية (15) محيي الدين بن عربي
-
المختار من الفتوحات المكية (14) محيي الدين بن عربي
-
المختار من الفتوحات المكية (13) محيي الدين بن عربي
-
المختار من الفتوحات المكية (12) محيي الدين بن عربي
-
المختار من الفتوحات المكية (11) محيي الدين بن عربي
-
المختار من الفتوحات المكية (10) محيي الدين بن عربي
-
المختار من الفتوحات المكية (9) محيي الدين بن عربي
المزيد.....
-
المرشد الأعلى الإيراني يقر بمقتل الآلاف في المظاهرات
-
قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي يستقبل جمعا غفيرا من
...
-
قائد الثورة الإسلامية: نعتبر الرئيس الأمريكي مجرما بسبب الاف
...
-
قائد الثورة الإسلامية: نعتبر ترامب مجرما بسبب الأضرار التي أ
...
-
اعتراف مرشح يهودي للكونغرس بوقوع الإبادة الجماعية في غزّة
-
بعد البهائيين واليهود.. حملة اعتقالات تطال المسيحيين في اليم
...
-
وفاة إمام مسجد نيجيري أنقذ حياة عشرات المسيحيين في 2018
-
شيخ الأزهر: الأقصى ركن من هوية المسلمين ومحاولات طمسه مرفوضة
...
-
بوتين لبزشكيان: خروج ملايين الإيرانيين في مسيرات دعماً للنظا
...
-
بين وطنين.. حكاية يهود إيران في لوس أنجلوس
المزيد.....
-
رسالة السلوان لمواطن سعودي مجهول (من وحي رسالة الغفران لأبي
...
/ سامي الذيب
-
الفقه الوعظى : الكتاب كاملا
/ أحمد صبحى منصور
-
نشوء الظاهرة الإسلاموية
/ فارس إيغو
-
كتاب تقويم نقدي للفكر الجمهوري في السودان
/ تاج السر عثمان
-
القرآن عمل جماعي مِن كلام العرب ... وجذوره في تراث الشرق الق
...
/ مُؤْمِن عقلاني حر مستقل
-
علي قتل فاطمة الزهراء , جريمة في يترب
/ حسين العراقي
-
المثقف العربي بين النظام و بنية النظام
/ أحمد التاوتي
-
السلطة والاستغلال السياسى للدين
/ سعيد العليمى
-
نشأة الديانات الابراهيمية -قراءة عقلانية
/ د. لبيب سلطان
-
شهداء الحرف والكلمة في الإسلام
/ المستنير الحازمي
المزيد.....
|
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

 |
بحث
|
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
|
إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة