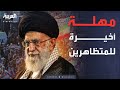|
|
كراسات شيوعية (العالم إنقلب رأسًا على عقب – النظام في أزمة)قراءة ماركسية. [Manual no: 56]. الأممية الشيوعية الثورية.
عبدالرؤوف بطيخ


الحوار المتمدن-العدد: 8504 - 2025 / 10 / 23 - 14:59
المحور:
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
تُغيّر أحداثٌ جسيمة وجه العالم كما نعرفه. فمع إحداث ترامب اضطراباتٍ سياسيةً واقتصاديةً عالميةً، بلغت التناقضاتُ المكبوتة لعقدين تقريبًا من الأزمة والركود الرأسمالي ذروتها. من الإبادة الجماعية في غزة إلى هزيمة الغرب في أوكرانيا، ومن ارتفاع الرسوم الجمركية إلى تضخم الدين العالمي، تُهزّ تطوراتٌ تُحدّد مسارَ عصرٍ جديدٍ وعيَ مليارات البشر.
لتقييم هذا الوضع، ستعقد الأممية الشيوعية الثورية (RCI) مؤتمرها العالمي الأول في إيطاليا بعد ثمانية أسابيع فقط من الآن. هناك، سينخرط المندوبون والزوار في مناقشات معمقة حول مسودة وثيقة "آفاق العالم" التي أقرتها لجنتنا التنفيذية الدولية. وللتعامل مع تقلبات الوضع العالمي، لا بد من فهم واضح للفترة الحالية، فبدونه، تصبح المنظمة الثورية أشبه بسفينة بلا بوصلة.
على مدار العامين الماضيين، شهد المؤتمر الدولي للثورة الشيوعية نموًا هائلًا. أصبحنا الآن متواجدين في 70 دولة حول العالم. سيمثل المؤتمر العالمي خطوةً حاسمةً في إعداد أمميتنا للصدمات الهائلة والصراعات الطبقية والاضطرابات الثورية التي تلوح في الأفق.نعيش مرحلةً من التحولات الحادة والتغيرات المفاجئة في الوضع العالمي. لقد أحدث انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة وسياساته حالةً من عدم الاستقرار الهائل في السياسة العالمية والاقتصاد العالمي والعلاقات بين القوى.لم يُحدث ترامب هذه الاضطرابات، الناتجة عن أزمة الرأسمالية، لكن أفعاله سرّعت العملية بشكل هائل. التناقضات التي تراكمت تحت السطح لفترة طويلة انفجرت فجأةً، مُزعزعةً الوضع برمته. ما يُسمى بالنظام العالمي الليبرالي، الذي كان قائمًا لعقود، ينهار الآن أمام أعيننا.
عند تحليل الوضع العالمي، علينا البدء بالأساسيات. الرأسمالية نظامٌ تجاوز دوره التاريخي. في عصر انحطاطه، يُنتج حروبًا وأزماتٍ وتدميرًا بيئيًا، مما يُهدد على المدى البعيد وجود الحياة على كوكب الأرض. تهدف هذه الوثيقة إلى تحديد السمات الرئيسية لهذه الأزمة والتأكيد على ضرورة بناء منظمة ثورية قادرة على الإطاحة بها، وهو السبيل الوحيد لضمان مستقبلٍ للبشرية.
في نهاية المطاف، يُعزى سبب الأزمة إلى عجز النظام الرأسمالي عن تطوير قوى الإنتاج. فالاقتصاد مُقيّد بحدود الدولة القومية والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. ولعقود، استخدم الرأسماليون أساليب متنوعة لتجاوز هذه القيود: زيادة السيولة، وتنمية التجارة العالمية، وغيرها. لكن كل هذه الإجراءات تحولت الآن إلى نقيضها.
• انتخاب ترامب
مثّل انتخاب دونالد ترامب في نوفمبر 2024 تحولاً سياسياً هاماً، وتعبيراً عن أزمة شرعية الديمقراطية البرجوازية، وهي أزمة لا تقتصر على الولايات المتحدة فحسب، بل تشمل جميع الدول. ورغم الجهود المكثفة التي بذلتها الشريحة الرئيسية من الطبقة الحاكمة والمؤسسة الأمريكية لمنع فوزه، حقق ترامب فوزاً حاسماً.وقد تم تفسير هذه النتيجة على نطاق واسع، وخاصة من قبل المعلقين الليبراليين ووسائل الإعلام السائدة وقطاعات من "اليسار" باعتبارها دليلا على تحول أوسع نحو اليمين في السياسة الأميركية والعالمية.
هذه "التفسيرات" سطحية ومضللة. علاوة على ذلك، فهي تدعونا إلى استخلاص استنتاجات بالغة الخطورة. على سبيل المثال، أن جو بايدن والديمقراطيين يمثلون، بطريقة ما، بديلاً أكثر تقدمية و"ديمقراطية" وهو ادعاء يتناقض تمامًا مع الحقائق.
نت إدارة بايدن رجعية تمامًا، وهي حقيقةٌ كانت جليةً بشكل خاص في مجال السياسة الخارجية. لنتذكر أن "جو الإبادة الجماعية" منح نتنياهو تفويضًا مفتوحًا للمضي قدمًا في المذبحة الجماعية للفلسطينيين في غزة. وقاد حملة قمع شرسة ضد الطلاب وغيرهم ممن تجرأوا على معارضة هذه السياسة الرجعية.وعلى نحو مماثل، في حالة أوكرانيا، كان بوتن مسؤولاً عن إثارة صراع متعمد أدى إلى مذبحة دموية، وتسليم مليارات الدولارات نقداً ومساعدات عسكرية للنظام الرجعي في كييف، والانخراط في سياسة استفزازية خطيرة ضد روسيا.
خلال الحملة الانتخابية، قدّم ترامب نفسه كـ"مرشح السلام" مُعارضًا سياسات جماعة بايدن المُحرضة على الحرب. وكان لهذا التمييز تأثيرٌ خاصٌّ لدى الناخبين في المناطق ذات الكثافة السكانية المسلمة والعربية الكبيرة.
صحيحٌ أن مجموعةً من العناصر الرجعية ساهمت في دعم ترامب، إلا أن هذه العوامل وحدها لا تُفسر حجم نجاحه وزيادة حصته من الأصوات في جميع الفئات الديموغرافية تقريبًا، ولا سيما بين مجتمعات الطبقة العاملة من السود واللاتينيين. في الواقع، في العديد من الولايات التي حقق فيها ترامب أداءً قويًا أو حسّن حصته من الأصوات، أيّد الناخبون في الوقت نفسه مبادراتٍ تقدمية في صناديق الاقتراع، مثل تدابير حماية حقوق الإجهاض أو زيادة الحد الأدنى للأجور.إن العامل الرئيسي وراء فوز ترامب يكمن في قدرته على استغلال وحشد مشاعر مناهضة للمؤسسة راسخة الجذور ومتغلغلة في المجتمع الأميركي.
من الأمثلة الصارخة على هذه الظاهرة رد الفعل الشعبي على اغتيال الرئيس التنفيذي لشركة "يونايتد هيلثكير" المزعوم على يد لويجي مانجيوني. فبينما كان الفعل نفسه صادمًا، كان رد الفعل الشعبي - الذي اتسم بالتعاطف مع المعتدي المزعوم لا الضحية - أكثر دلالة. فقد أصبح مانجيوني يُنظر إليه في نظر الكثيرين كبطل شعبي. والجدير بالذكر أن هذا الرد لم يقتصر على اليسار السياسي، بل شارك فيه أيضًا قطاع من المحافظين والناخبين الجمهوريين، بمن فيهم مؤيدو ترامب.يُمثل هذا الوضع مفارقة. فرغم كونه مليارديرًا وإحاطته بمليارديرات آخرين، نجح ترامب في ترسيخ مكانته كصوتٍ للغضب المناهض للمؤسسة. يُبرز هذا التناقض الطبيعة المُشوّهة والمُفككة للمزاج السياسي الحالي. ومع ذلك، فإنه يعكس استياءً حقيقيًا وواسع النطاق من المؤسسات الرئيسية: من الشركات الكبرى، والنخب السياسية، وأجهزة الدولة ككل.
يكمن السبب الجذري لهذا الغضب المناهض للمؤسسة في أزمة الرأسمالية. فقد بلغ هذا الغضب أبعادًا هائلة منذ أزمة عام ٢٠٠٨، والتي لم يتعافَ منها النظام تمامًا بعد. لسنا نمرّ بأزمة دورية أخرى للرأسمالية، بل بأزمة رأسمالية عضوية. لقد بُني دعم الديمقراطية البرجوازية في الدول الرأسمالية المتقدمة لعقود على فكرة أن الرأسمالية قادرة على تلبية بعض الاحتياجات الأساسية للطبقة العاملة (الرعاية الصحية، والتعليم، والمعاشات التقاعدية...) وعلى توقع تحسن مستويات معيشة كل جيل، ولو بشكل طفيف، مقارنةً بمستويات معيشة الجيل السابق.
لم يعد هذا هو الحال. ففي الولايات المتحدة، عام ١٩٧٠، كان أكثر من ٩٠٪ من البالغين من العمر ٣٠ عامًا يحصلون على دخل أعلى من دخل آبائهم في نفس العمر. ومع ذلك، بحلول عام ٢٠١٠، انخفضت هذه النسبة إلى ٥٠٪. وبحلول عام ٢٠١٧، توقع ٣٧٪ فقط من الأمريكيين أن يحقق أبناؤهم مستويات معيشية أفضل مما حققوه هم أنفسهم.وفقًا لمكتب إحصاءات العمل، ظلت الأجور الحقيقية للأمريكيين من الطبقة العاملة ثابتة أو انخفضت منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي، لا سيما مع نقل الوظائف إلى دول أخرى. وبالمثل، أفاد معهد السياسة الاقتصادية بأن أجور الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط لم تشهد أي نمو يُذكر منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، في حين استمرت تكاليف المعيشة في الارتفاع.
في الوقت نفسه، هناك استقطابٌ فاحشٌ للثروات. فمن جهة، تُكثِّف حفنةٌ صغيرةٌ من أصحاب المليارات أصولهم. ومن جهةٍ أخرى، يواجه عددٌ متزايدٌ من العاملين صعوبةً أكبر في تلبية احتياجاتهم. فهم يواجهون تخفيضاتٍ تقشفية، وتآكلًا في القدرة الشرائية للأجور بسبب التضخم، وزيادةً في فواتير الطاقة، وأزمةً سكنيةً، وغيرها.من الصحيح تمامًا أن وسائل الإعلام والسياسيين والأحزاب السياسية القائمة والبرلمانات والقضاء، كلها يُنظر إليها على أنها تمثل مصالح نخبة صغيرة متميزة، وتتخذ القرارات للدفاع عن مصالحها الضيقة والأنانية بدلاً من خدمة احتياجات الكثيرين.
أعقبت أزمة عام ٢٠٠٨ تخفيضات تقشفية وحشية في جميع البلدان. وتعرضت جميع مكتسبات الماضي للهجوم. وشهدت الجماهير هجمات على مستويات معيشتها، بينما أُنقذت البنوك. وأدى ذلك إلى غضب عارم، وحركات احتجاج جماهيرية، والأهم من ذلك، إلى أزمة شرعية غير مسبوقة لجميع المؤسسات البرجوازية.في البداية، وجد هذا المزاج، الذي تجسد في الحركات الجماهيرية المناهضة للتقشف حوالي عام ٢٠١١، تعبيرًا له في اليسار. وشهدت أوروبا والولايات المتحدة صعود شخصيات وأحزاب يسارية مناهضة للمؤسسة الحاكمة: بوديموس، سيريزا، جيريمي كوربين، بيرني ساندرز، وغيرهم. إلا أن كلًا من هذه الحركات خان في النهاية التوقعات التي وُضعت. وانكشفت حدود السياسة الإصلاحية لقادتها.لقد كان الفشل الذريع لهذه الشخصيات اليسارية هو الذي مهد الطريق لصعود الديماغوجيين الرجعيين مثل ترامب.
إن العمليات نفسها تجري في أغلب البلدان الرأسمالية المتقدمة: أزمة الرأسمالية، والهجمات على الطبقة العاملة، وإفلاس اليسار، وصعود الديماغوجيين اليمينيين الذين يركبون موجة المزاج المناهض للمؤسسة.
• خطر الفاشية أو البونابرتية؟
حتى قبل انتخاب ترامب، كانت هناك حملة صاخبة في وسائل الإعلام البرجوازية واليسار للتنديد به باعتباره فاشيًا.
الماركسية علم. وكسائر العلوم، لها مصطلحاتها العلمية. كلمات مثل "الفاشية" تحمل في طياتها معانٍ دقيقة بالنسبة لنا. إنها ليست مجرد مصطلحات شتائم، أو أوصافًا يمكن إلصاقها بسهولة على أي فرد لا يلقى استحساننا.
لنبدأ بتعريف دقيق للفاشية. بالمعنى الماركسي، الفاشية حركة ثورية مضادة - حركة جماهيرية تتكون أساسًا من البروليتاريا الرثة والبرجوازية الصغيرة الغاضبة. تُستخدم كأداة لسحق الطبقة العاملة وتفتيتها، وإقامة دولة شمولية تُسلم فيها البرجوازية سلطة الدولة إلى بيروقراطية فاشية.السمة الرئيسية للدولة الفاشية هي المركزية الشديدة والسلطة المطلقة للدولة، حيث تحظى البنوك والاحتكارات الكبرى بالحماية، لكنها تخضع لسيطرة مركزية قوية من قِبل بيروقراطية فاشية ضخمة وقوية. في كتابه " ما هي الاشتراكية الوطنية؟" يوضح تروتسكي:
"الفاشية الألمانية، شأنها شأن الفاشية الإيطالية، صعدت إلى السلطة على حساب البرجوازية الصغيرة، التي حوّلتها إلى كبش فداء لمنظمات الطبقة العاملة ومؤسسات الديمقراطية. لكن الفاشية في السلطة ليست حكم البرجوازية الصغيرة، بل هي على العكس من ذلك، أشدّ ديكتاتورية لرأس المال الاحتكاري قسوة"هذه، بشكل عام، هي السمات الرئيسية للفاشية. كيف يُقارن هذا بأيديولوجية ومضمون ظاهرة ترامب؟ لقد مررنا بالفعل بتجربة حكومة ترامب، التي - وفقًا للتحذيرات المُقلقة للديمقراطيين والمؤسسة الليبرالية بأكملها - كانت ستُمضي قدمًا في إلغاء الديمقراطية. لكنها لم تفعل شيئًا من هذا القبيل.لم تُتخذ أي خطوات جادة للحد من حق الإضراب والتظاهر، ناهيك عن إلغاء النقابات العمالية الحرة. أُجريت الانتخابات كالمعتاد، وأخيرًا، ورغم الضجة العامة، خلف جو بايدن ترامب في الانتخابات. قل ما شئت عن حكومة ترامب الأولى، لكنها لم تكن ذات صلة بأي شكل من أشكال الفاشية.علاوة على ذلك، تغير ميزان القوى الطبقي بشكل ملحوظ منذ ثلاثينيات القرن العشرين. ففي الدول الرأسمالية المتقدمة، تقلص عدد الفلاحين، الذين كانوا يمثلون شريحة كبيرة من السكان، إلى أعداد ضئيلة للغاية، وأصبحت المهن التي كانت تُعتبر سابقًا من "الطبقة الوسطى" (الموظفون الحكوميون والأطباء والمعلمون) بروليتارية، حيث انضمت هذه القطاعات إلى النقابات ودخلت في إضرابات. وتعزز الثقل الاجتماعي للطبقة العاملة بشكل هائل بفضل تطور القوى المنتجة خلال الانتعاش الاقتصادي الهائل الذي أعقب نهاية الحرب العالمية الثانية.
إن أيديولوجية ترامب - بقدر ما هي قائمة - بعيدة كل البعد عن الفاشية. فبعيدًا عن الرغبة في دولة قوية، فإن مُثُل دونالد ترامب هي رأسمالية السوق الحرة، حيث لا تلعب الدولة دورًا يُذكر (باستثناء التعريفات الجمركية الحمائية).
أثار آخرون فكرة أن ترامب يُمثل نظامًا بونابرتيًا. والفكرة هنا، مجددًا، هي تصوير ترامب كديكتاتور يسعى لسحق الطبقة العاملة. لكن هذا الوصف لا يُفسر شيئًا. في الواقع، بدلًا من محاولة سحق الطبقة العاملة، يُخاطبها ترامب بطريقة ديماغوجية ويحاول استرضائها. وبطبيعة الحال، كونه سياسيًا برجوازيًا، فهو يُمثل مصالح مُتعارضة جوهريًا مع مصالح العمال. لكن هذا لا يجعله ديكتاتورًا.
من الممكن الإشارة في الوضع الراهن إلى عنصر أو آخر يُمكن اعتباره من عناصر البونابرتية. ربما يكون الأمر كذلك. ولكن يُمكن توجيه تعليقات مماثلة إلى أي نظام ديمقراطي برجوازي حديث تقريبًا.إن مجرد احتواء بعض عناصر ظاهرة ما لا يعني بالضرورة ظهورها الفعلي. يمكننا بالطبع القول بوجود عناصر من البونابرتية في الترامبية. لكن هذا لا يعني إطلاقًا وجود نظام بونابارتي فعلي في الولايات المتحدة.
تكمن المشكلة في أن مصطلح "البونابرتية" مصطلحٌ مطاطٌ للغاية. فهو يشمل طيفًا واسعًا من الأمور، بدءًا من المفهوم الكلاسيكي للبونابرتية، وهو في جوهره حكمٌ بالسيف. ليس من المفيد تحليل حكومة ترامب الحالية في واشنطن بهذه الطريقة، فهي، على الرغم من خصوصياتها العديدة، لا تزال ديمقراطية برجوازية. مهمتنا ليست إطلاق تسميات على الأمور، بل متابعة العملية وهي تتكشف وفهم جوانبها الأساسية.
• التحولات التكتونية في العلاقات العالمية
تُمثل سياسة ترامب الخارجية تحولاً جذرياً في العلاقات العالمية، ونهايةً للنظام العالمي الليبرالي الذي استمر ثمانين عاماً بعد الحرب العالمية الثانية. وهي اعترافٌ بالتراجع النسبي للإمبريالية الأمريكية، وبوجود قوى إمبريالية منافسة، روسيا، وخاصة الصين، منافستها الإمبريالية الرئيسية على الساحة العالمية.مع نهاية الحرب العالمية الثانية، خرجت الولايات المتحدة الأمريكية أقوى بكثير. فمع الدمار الذي لحق بأوروبا واليابان جراء الحرب، أصبحت أمريكا تُمثل 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و60% من الناتج الصناعي العالمي. وكان منافسها الرئيسي الوحيد على الساحة العالمية هو الاتحاد السوفيتي، الذي خرج أقوى من الحرب، بعد أن هزم ألمانيا النازية وتقدم في جميع أنحاء القارة.
عزّزت الثورة الصينية الكتلة الستالينية. وعملت الولايات المتحدة على إعادة بناء أوروبا الغربية واليابان في محاولة لاحتواء "تقدم الشيوعية" لم تكن البيروقراطية السوفيتية مهتمة بالثورة العالمية، وكانت مستعدة تمامًا للتوصل إلى تسوية مؤقتة مع واشنطن، تُجسّدت في سياسة "التعايش السلمي"وهكذا تلت فترة من التوازن النسبي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، القوتين النوويتين، عُرفت بالحرب الباردة. وعلى أساس الهيمنة الأمريكية، أُنشئت سلسلة من المؤسسات متعددة الأطراف رسميًا لإدارة العلاقات الدولية (الأمم المتحدة) والاقتصاد العالمي (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذان أُنشئا في مؤتمر بريتون وودز) وقد تعزز هذا التوازن بالانتعاش الاقتصادي الذي أعقب الحرب، وهي فترة شهدت تطورًا استثنائيًا للقوى الإنتاجية والسوق العالمية.
استمرت هذه الفترة حتى انهيار الستالينية بين عامي ١٩٨٩ و١٩٩١ وعودة الرأسمالية إلى روسيا والصين. وقد أحدث ذلك تحولاً جذرياً آخر في الوضع العالمي. أصبحت الولايات المتحدة القوة الإمبريالية المهيمنة، لا يتحداها أحد.
شُنّت الحرب الإمبريالية على العراق عام ١٩٩١ برعاية الأمم المتحدة، حيث صوّتت روسيا لصالحها، بينما امتنعت الصين عن التصويت. ولم يُبدِ أي معارضة لهيمنة الإمبريالية الأمريكية. من الناحية الاقتصادية، دفعت واشنطن بالعولمة و"الليبرالية الجديدة":
"أي تعزيز تكامل السوق العالمية، تحت سيطرة الإمبريالية الأمريكية، وتقليص دور الدولة.لقد تآكلت تلك الفترة من الهيمنة غير المقيدة للإمبريالية الأمريكية ببطء على مدى السنوات الخمس والثلاثين الماضية، إلى الحد الذي نشأ فيه الآن وضع جديد تماما".
بدافع من غطرستها المفرطة، شنت الولايات المتحدة غزوي العراق وأفغانستان. لكن هنا، بدأ التاريخ يتراجع. غرق الأمريكيون في هاتين الحربين اللتين لا سبيل لكسبهما لمدة 15 عامًا، متكبّدين خسائر فادحة في النفقات وخسائر في الأرواح. في أغسطس/آب 2021، أُجبروا على انسحاب مُهين من أفغانستان.تركت هذه التجارب الشعب الأمريكي بلا رغبة في المغامرات العسكرية الخارجية، وترددت الطبقة الحاكمة الأمريكية بشدة في إرسال قوات برية إلى الخارج. ومع صعود قوى إقليمية وعالمية جديدة، كان ميزان القوى النسبي عالميًا يتغير. لم تتعلم الإمبريالية الأمريكية شيئًا من هذه التجارب. رفضت الاعتراف بميزان القوى الجديد، وسعت بدلًا من ذلك إلى الحفاظ على هيمنتها، فتورطت في سلسلة من الصراعات التي لم تستطع كسبها.
• عالم متعدد الأقطاب؟
يُهيمن على الوضع العالمي حالةٌ من عدم الاستقرار الشديد في العلاقات الدولية. وهذا نتيجة الصراع على الهيمنة العالمية بين الولايات المتحدة، أقوى قوة إمبريالية في العالم، والتي تشهد تراجعًا نسبيًا، والصين، قوة إمبريالية صاعدة أكثر حيويةً وحداثةً. نشهد تحولًا هائلًا، يُضاهي في حجمه حركة الصفائح التكتونية على قشرة الأرض. وتصاحب هذه الحركات انفجاراتٌ من مختلف الأنواع. وتُعدّ الحرب في أوكرانيا - حيث يُجهّز لهزيمةٍ مُذلّةٍ للولايات المتحدة وحلف الناتو - والصراع في الشرق الأوسط، تعبيرًا عن هذه الحقيقة.
يُمثل نهج ترامب في العلاقات العالمية محاولةً للاعتراف بأن الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون الشرطي الوحيد للعالم. ففي رأيه، ورأي معاونيه المقربين، فإن سعي الولايات المتحدة للحفاظ على هيمنتها وسيطرتها الشاملة مكلفٌ للغاية، وغير عملي، ويضر بمصالحها الأمنية الوطنية الأساسية.
هذا لا يعني أن الولايات المتحدة لم تعد قوة إمبريالية، أو أن سياسات ترامب تخدم مصالح شعوب العالم المضطهدة. هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة. تُمثل سياسة ترامب الخارجية فصلًا صارخًا بين ما هو جوهري وما هو ليس جوهريًا في المصالح الأمنية الوطنية الأمريكية، بدءًا من أمريكا الشمالية.عندما يقول ترامب إن أمريكا بحاجة للسيطرة على قناة بنما وغرينلاند، فإنه يُعبّر عن احتياجات الإمبريالية الأمريكية. تُعدّ قناة بنما طريقًا تجاريًا حيويًا، إذ تربط المحيط الهادئ بخليج المكسيك، وتمر عبرها 40% من حركة الحاويات الأمريكية.
أما بالنسبة لجرينلاند، فلطالما تمتعت بموقع جيوستراتيجي مهم، وهذا هو سبب الوجود العسكري الأمريكي على الجزيرة. وقد أدى الاحتباس الحراري إلى زيادة حركة النقل البحري بين المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي عبر القطب الشمالي. ويعني انخفاض الجليد القطبي سهولة الوصول إلى قيعان البحار، حيث توجد احتياطيات هائلة من المعادن الأرضية النادرة. كما تحتوي الجزيرة نفسها على رواسب مهمة من المعادن الأساسية (العناصر الأرضية النادرة واليورانيوم)، بالإضافة إلى الغاز والنفط، والتي أصبحت الآن أكثر سهولة في الوصول إليها، نتيجةً للاحتباس الحراري. وهنا تتنافس الولايات المتحدة مع الصين وروسيا على السيطرة على هذه الطرق التجارية والموارد.
تقوم سياسة ترامب الخارجية على إدراك محدودية القوة الأمريكية. ويترتب على ذلك محاولة تخليص أمريكا من سلسلة من الصراعات المكلفة (في أوكرانيا والشرق الأوسط) عبر صفقات، بهدف إعادة بناء قوتها والتركيز على منافستها الرئيسية على الساحة العالمية، الصين.
طوال الفترة الممتدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أو ربما حتى قبل ذلك، حافظت الإمبريالية الأميركية على ذريعة العمل نيابة عن حقوق الإنسان، ونشر الديمقراطية و"النظام القائم على القواعد" والدفاع عن "المبدأ المقدس المتمثل في حرمة الحدود الوطنية" وما إلى ذلك.كانوا يتصرفون من خلال مؤسسات دولية "متعددة الأطراف"، ظاهريًا محايدة، حيث كان لجميع الدول رأي: الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية، وصندوق النقد الدولي، وغيرها. في الواقع، لم يكن هذا سوى غطاء. لطالما كان ذريعةً للسخرية. فإما أن تُعبَّر عن مصالح الإمبريالية الأمريكية من خلال هذه المؤسسات، أو أنها ستتجاهلها تمامًا. الفرق الآن هو أن ترامب لا يكترث إطلاقًا لأيٍّ من هذه الادعاءات. يبدو أنه عازم على تمزيق القواعد برمتها والتعبير عن الأمور بصراحة أكبر، كما هي في الواقع.
جادل البعض بأنه في مواجهة القوة الأمريكية الجامحة، كانت فكرة عالم متعدد الأقطاب فكرة تقدمية، من شأنها أن تمنح الدول المضطهدة قدرًا أكبر من السيادة، وهو مثالٌ يجب أن نناضل من أجله. والآن، يمكننا أن نرى لمحةً عمّا قد يبدو عليه عالم "متعدد الأقطاب": قوى إمبريالية تُقسّم العالم إلى مناطق نفوذ، وتُرهب الدول وتُجبرها على الخضوع لأحدهما أو الآخر.
• الانحدار النسبي للإمبريالية الأمريكية
يجب التأكيد على أنه عندما نتحدث عن تراجع الإمبريالية الأمريكية، فإننا نشير إلى تراجع نسبي ، أي تراجع مقارنةً بمكانتها السابقة مقارنةً بالقوى المنافسة الأخرى. لا تزال الولايات المتحدة، بكل المقاييس، القوة الأقوى والأكثر رجعية في العالم.
في عام ١٩٨٥، كانت الولايات المتحدة تُمثل ٣٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وانخفضت هذه النسبة الآن إلى ٢٦٪ (٢٠٢٤). وفي الفترة نفسها، نمت حصة الصين من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من ٢.٥٪ إلى ١٨.٥٪. أما اليابان، التي بلغت ذروتها عند ١٨٪ عام ١٩٩٥، فقد انهارت الآن إلى ٥.٢٪ فقط.لا تزال الولايات المتحدة تُهيمن على الاقتصاد العالمي من خلال سيطرتها على الأسواق المالية. ويُحتفظ بنسبة هائلة تبلغ 58% من احتياطيات العملات العالمية بالدولار الأمريكي (بينما لا تتجاوز 2% بالرنمينبي الصيني)، على الرغم من انخفاض هذه النسبة عن 73% في عام 2001. كما يُمثل الدولار 58% من فواتير الصادرات العالمية. ومن حيث صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر (الذي يُمثل مؤشرًا لتصدير رأس المال)، تتصدر الولايات المتحدة العالم بـ 454 مليار دولار أمريكي، بينما تأتي الصين (بما في ذلك هونغ كونغ) في المرتبة الثانية بـ 287 مليار دولار أمريكي.إن النفوذ الاقتصادي لأي دولة هو ما يمنحها قوة دولية، لكن هذا يتطلب قوة عسكرية. يمثل الإنفاق العسكري الأمريكي 40% من إجمالي الإنفاق العالمي، وتأتي الصين في المرتبة الثانية بنسبة 12%، وروسيا في المرتبة الثالثة بنسبة 4.5%. وتنفق الولايات المتحدة أكثر من الدول العشر التالية في الترتيب مجتمعةً .مع ذلك، لم يعد بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية ادعاء أنها سيدة العالم بلا منازع. فالقوة الاقتصادية الهائلة للصين، وما تبعها من تقدم في قوتها العسكرية، إلى جانب التفوق العسكري الذي أظهرته روسيا في ساحات القتال في أوكرانيا، تُشكّل لها تحديًا هائلًا. وهكذا، تنكشف حدود القوة العالمية الأمريكية بقسوة على جميع الأصعدة.يتجلى هذا التراجع النسبي اقتصاديًا في هروب رؤوس الأموال الجزئي بعيدًا عن الدولار وسندات الخزانة الأمريكية والأسهم الأمريكية. فمع تزايد المنافسة بين الاحتكارات الأمريكية من المنافسين الدوليين، وخاصةً الصين، لم تعد الأسهم الأمريكية تُعتبر رهانًا مضمونًا كما كانت في السابق بالنسبة للمستثمرين. وبالمثل، مع تنامي الدين الفيدرالي الأمريكي، ولجوء الحكومة الأمريكية إلى تمويل العجز بشكل أكبر، لم تعد سندات الخزانة الأمريكية (سندات الدين الحكومية) تُعتبر الملاذ المالي الآمن كما كانت في السابق. وقد أدى ذلك إلى إضعاف الدولار - على الرغم من الرسوم الجمركية الأمريكية - وهيمنته على الساحة المالية العالمية.يُمثل هذا "تصحيحًا للسوق"، يُقرّب سعر العملة الأمريكية وأصولها وسنداتها من الوضع الاقتصادي المتردي الحقيقي للرأسمالية الأمريكية. ومع ذلك، وكما هو الحال مع القوة العسكرية الأمريكية ودور أمريكا السابق كشرطي العالم، لا يوجد بديل عملي للدولار في التجارة والتمويل العالميين. ومن هنا يأتي القلق المتزايد بين الاستراتيجيين البرجوازيين من التأثير الفوضوي على النظام المالي العالمي والاقتصاد العالمي في حال انهيار الثقة بالدولار.
هذه طريقة أخرى يُسهم بها التراجع النسبي للرأسمالية الأمريكية و"التعددية القطبية" الناشئة في تفاقم حالة عدم اليقين وعدم الاستقرار على الصعيد العالمي. فجميع أركان نظام ما بعد الحرب تتآكل وتُقوّض، واحدة تلو الأخرى، بما يُسفر عن عواقب وخيمة اقتصاديًا وعسكريًا وسياسيًا.
• النفوذ العسكري الروسي
مع أن روسيا ليست عملاقًا اقتصاديًا يُضاهي الصين، إلا أنها أرست قاعدة اقتصادية وتكنولوجية متينة. مكّنها هذا من الصمود بنجاح في وجه العدوان الاقتصادي غير المسبوق الذي فرضه عليها الغرب تحت شعار "العقوبات". بل إنها حققت ذلك وهي تخوض حربًا هزمت فيها جميع أنظمة الأسلحة التي أطلقتها عليها الإمبريالية الغربية. لقد بنت جيشًا قويًا يضاهي القوات الأوروبية مجتمعة؛ وبنت صناعة دفاعية هائلة تتفوق في إنتاجها على الولايات المتحدة وأوروبا في الدبابات والمدفعية والذخيرة والصواريخ والطائرات المسيرة؛ وهي تمتلك أكبر ترسانة نووية في العالم، ورثتها من الاتحاد السوفيتي.بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والنهب الشامل للاقتصاد المخطط، راودت الطبقة الحاكمة الروسية فكرة القبول بها على طاولة المفاوضات العالمية على قدم المساواة. حتى أنها طرحت فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكنها رُفضت. أرادت الولايات المتحدة فرض سيطرتها الكاملة والمطلقة على العالم، ولم ترَ حاجةً لتقاسم السلطة مع روسيا الضعيفة والمثقلة بالأزمات.
لقد انكشفت الإذلالات التي تعرضت لها روسيا بشكل صارخ، أولا عندما هندست ألمانيا والولايات المتحدة عملية تفكيك يوغوسلافيا في مجال النفوذ التقليدي لروسيا، ثم مع قصف صربيا في عام 1999. وكان يلتسين، السكير المهرج والدمية في يد الإمبريالية الأميركية، ممثلا لتلك العلاقة التابعة.مع ذلك، ومع تعافي روسيا تدريجيًا من الأزمة الاقتصادية، لم تعد الدوائر الحاكمة مستعدة لقبول إذلالها على الساحة الدولية. وهذا ما كان وراء صعود بوتين، البونابرتي الماكر، الذي شق طريقه إلى السلطة عبر مختلف أنواع المناورات.
لقد بدأوا في صد التقدم شرقا لحلف شمال الأطلسي، وهي الخطوة التي خالفت كل الوعود التي قدمت للروس في عام 1990 عندما وعدوهم بعدم التوسع شرقا لحلف شمال الأطلسي، في مقابل قبول ألمانيا الموحدة داخل التحالف.
في عام ٢٠٠٨، شنت روسيا حربًا قصيرة وفعّالة في جورجيا، مُدمِّرةً جيشها الذي درَّبه وسلَّحه حلف الناتو. كانت تلك أول طلقة تحذيرية أطلقتها روسيا، مُؤشِّرةً على أنها لن تقبل بعد الآن بتجاوزات الغرب. تلتها سوريا وأوكرانيا. في كلٍّ من هذه الدول، وُضِعَت قوة روسيا في مواجهة الإمبريالية الأمريكية على المحك. في غضون ذلك، تجلَّى التراجع النسبي للإمبريالية الأمريكية بشكل أكبر في انسحابها المُهين من أفغانستان في أغسطس ٢٠٢١.
كان الغزو الروسي لأوكرانيا النتيجة المنطقية لرفض الغرب قبول مخاوف الأمن القومي الروسي، والتي تم التعبير عنها في المطالبة بالحياد لأوكرانيا ووقف التوسع الشرقي لحلف الناتو. عندما يؤكد دونالد ترامب أن هذه الحرب لم تكن ضرورية، وأنه لو كان رئيسًا لما حدثت أبدًا، فمن المحتمل أن يكون هذا صحيحًا. كانت الإمبريالية الأمريكية وحلفاؤها الأوروبيون يدركون جيدًا أن عضوية أوكرانيا في الناتو كانت خطًا أحمر من وجهة نظر مصالح الأمن القومي لروسيا. على الرغم من ذلك، قرروا دعوة الأوكرانيين للتقدم بطلب عضوية الناتو في عام 2008. كان هذا استفزازًا صارخًا، والذي من المنطقي أن يؤدي إلى أخطر العواقب. كانت هذه الخطوة القاتلة هي التي أدت في النهاية إلى الحرب.
أصرّ الغرب على "حق أوكرانيا في الانضمام إلى حلف الناتو" - في حين أن وضعها المحايد، وحظر وجود القواعد العسكرية الأجنبية، وعدم مشاركتها في التكتلات العسكرية، كان أمرًا متفقًا عليه، بل ومُدوّنًا في إعلان استقلال أوكرانيا. وقد حذّر رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ويليام ج. بيرنز، مرارًا وتكرارًا من ذلك. لكن زمرة دعاة الحرب الذين أداروا السياسة الخارجية لإدارة بايدن - وجو بايدن نفسه - كان لديهم رأي آخر.اعتقد بايدن أنه يستطيع استخدام أوكرانيا كوقودٍ في حملةٍ لإضعاف روسيا وشلِّ دورها العالمي. لا يُمكن السماح لدولةٍ مثل روسيا، المُنافسة للإمبريالية الأمريكية، بتهديد الهيمنة العالمية الأمريكية. لكن التدخل الأمريكي في أوكرانيا له هدفٌ آخر، وإن كان أقل وضوحًا، وهو ألمانيا والاتحاد الأوروبي. إن قطع الصلة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا يعني إضعاف قاعدة الرأسمالية الألمانية. وهذا يُفسر لماذا كانت ألمانيا، ولا سيما ألمانيا، أقلَّ حماسًا للحرب في البداية، ولكن لكونها أضعف من أن تكون "مركزًا ثالثًا"، اضطرت حتمًا إلى اتباع الإمبريالية الأمريكية في الحرب بمجرد اندلاعها.
في مارس/آذار 2022، أثار بايدن، متغطرسًا بغطرسته، فكرة تغيير النظام في موسكو! وكان، إلى جانب الأوروبيين، مقتنعًا بأن العقوبات الاقتصادية والاستنزاف العسكري سيقودان روسيا إلى حافة الانهيار. لقد قللوا بشكل كبير من شأن القوة الاقتصادية والعسكرية الروسية. ونتيجةً لذلك، وجدت الإمبريالية الأمريكية نفسها متورطة في حرب خاسرة، مما مثّل استنزافًا هائلًا لمواردها المالية والعسكرية.
يُصرّ ترامب الآن على أن هذه الكارثة لم تكن من صنعه. يقول: "هذه ليست حربي، إنها حرب جو بايدن" وهذا صحيح. فاستراتيجيو رأس المال مُعرّضون تمامًا لارتكاب الأخطاء بناءً على حسابات خاطئة. وهذا مثالٌ واضح. عندما يقول ترامب إن الحرب في أوكرانيا لا تُمثّل "المصالح الجوهرية" لأمريكا، فهو مُحقّ تمامًا. تواجه أمريكا تهديدًا أكبر بكثير في آسيا والمحيط الهادئ، متمثّلًا في صعود قوة الصين، بالإضافة إلى مشاكل أخرى في الشرق الأوسط وأزمة اقتصادية مُتفاقمة. وهذا يُفسّر تسرّعه في مُحاولة انتشال الإمبريالية الأمريكية من مستنقع أوكرانيا المُؤلم. لكن المشاكل التي خلقها بايدن وعملاؤه الأوروبيون تُثبت صعوبة حلّها.
لقد دأب رجال ونساء واشنطن ولندن، الذين يُديرون المشهد السياسي فيهما، على تخريب كل محاولة للتوصل إلى حل سلمي حتى قبل اندلاع الحرب. في أبريل/نيسان 2022، كانت المفاوضات في تركيا بين أوكرانيا وروسيا متقدمة للغاية، وكان من الممكن أن تُفضي إلى إنهاء الحرب، على أساس قبول عدد من المطالب الروسية. لكن الإمبريالية الأمريكية، بدعم من كلبها المدلل البريطاني بوريس جونسون، أفسدت المحادثات، ضاغطةً على زيلينسكي لعدم التوقيع على وعد الدعم غير المحدود الذي من شأنه أن يُفضي إلى انتصار كامل لأوكرانيا. واليوم، فإن الأوروبيين، بقيادة ألمانيا وفرنسا، ثم المملكة المتحدة مجددًا، هم من يضغطون على ترامب لمواصلة دعم أوكرانيا، وهم أنفسهم يُؤججون نيران الحرب. حساباتهم ساخرة للغاية:
"إنهم يريدون تقييد الولايات المتحدة ومنع الانسحاب العسكري من أوروبا. وفي الوقت نفسه، وبدماء عشرات الآلاف من الأوكرانيين والروس، يريدون كسب الوقت - لإعادة تسليح أنفسهم"في بداية الحرب، اعتقدت إدارة بايدن أنها قادرة على تحويل روسيا إلى دولة منبوذة على الساحة العالمية، وبوتين إلى شخص غير مرغوب فيه. لكن الحرب عمّقت التوترات القائمة في العلاقات العالمية، وكشفت بدورها كذب "المجتمع الدولي" المتغطرس والملتفّ حول الإمبريالية الأمريكية.
إلى جانب الاتحاد الأوروبي واليابان وبريطانيا وكندا، كافحت الولايات المتحدة لإقناع الغالبية العظمى من الطبقات الحاكمة في العالم بدعم حربها بالوكالة مع روسيا. وكان هذا تأكيدًا صارخًا على عجز الولايات المتحدة عن ممارسة نفوذها السياسي كما فعلت قبل ثلاثين عامًا. وكما حذّر لاري سامرز، وزير الخزانة الأمريكي الأسبق، من تزايد عزلة الغرب: "هناك قبول متزايد للتشرذم، وربما الأكثر إثارة للقلق هو شعور متزايد بأن تشرذمنا قد لا يكون الخيار الأمثل للانضمام إليه".
تواجه الولايات المتحدة اليوم هزيمةً مُذلة في أوكرانيا. لم تُحقق العقوبات الأثر المرجو. فبدلاً من الانهيار الاقتصادي، تمتعت روسيا بمعدلات نمو اقتصادي مُطردة تفوق بكثير معدلات نمو الغرب. وبدلًا من أن تُصبح معزولة، أقامت الآن علاقات اقتصادية أوثق مع الصين وعدد من الدول الرئيسية التي يُفترض أن تكون ضمن نطاق النفوذ الأمريكي. وقد ساعدتها دولٌ مثل الهند والمملكة العربية السعودية وتركيا وغيرها على الالتفاف على العقوبات.
أصبحت الصين وروسيا الآن حليفتين أوثق بكثير، يجمعهما معارضتهما للهيمنة الأمريكية على العالم، وقد جمعتا حولهما سلسلة كاملة من الدول الأخرى. وعندما تتحقق هزيمة الولايات المتحدة في أوكرانيا أخيرًا، سيكون لها عواقب وخيمة ودائمة على العلاقات الدولية، مما سيزيد من إضعاف قوة الإمبريالية الأمريكية في جميع أنحاء العالم.ستُرسل هزيمة الولايات المتحدة وحلف الناتو في أوكرانيا رسالةً قوية. لا تستطيع أعظم قوة إمبريالية في العالم فرض إرادتها دائمًا. علاوةً على ذلك، خرجت روسيا من هذه الهزيمة بجيشٍ ضخم، مُجرّبٍ لأحدث أساليب وتقنيات الحرب الحديثة، وبمجمعٍ عسكريٍّ صناعيٍّ قوي.تُمثل سياسة ترامب هنا تحولاً حاداً عن السياسة السابقة للإمبريالية الأمريكية. فقد أدرك ترامب استحالة كسب هذه الحرب ضد روسيا، ولذلك يسعى لإخراج الولايات المتحدة منها. وهناك أيضاً حسابات مفادها أن التوصل إلى اتفاق مع روسيا يُقر بمصالحها الأمنية القومية (أي مصالح الإمبريالية الروسية) قد يُبعدها عن تحالفها الوثيق مع الصين، المنافس الرئيسي للإمبريالية الأمريكية على الساحة العالمية. ومع ذلك، من غير المرجح أن تُجدي هذه الحسابات نفعاً، فخلال سنوات الحرب الثلاث، دفع الغرب روسيا إلى التقارب مع الصين أكثر مما يسمح له بتفكيك هذه العملية بسهولة. وتشير التصريحات والإجراءات الأخيرة للحكومتين الروسية والصينية إلى أن كلا الجانبين يعتبر تقاربهما استراتيجياً.
• صعود الصين كقوة إمبريالية
إن التحول السريع للصين من تخلف اقتصادي شديد إلى دولة رأسمالية قوية لا مثيل له في التاريخ الحديث. ففي فترة زمنية قصيرة للغاية، ارتقت إلى مكانة تُمكّنها من تحدي قوة الإمبريالية الأمريكية الجبارة.
إن الصين اليوم لا تربطها أي صلة على الإطلاق بتلك الدولة الضعيفة، شبه الإقطاعية وشبه المستعمرة، الخاضعة للهيمنة التي كانت عليها في عام 1938. في الواقع، في الوقت الحاضر، ليست الصين مجرد دولة رأسمالية، بل دولة تتمتع بكل سمات القوة الإمبريالية.من المستحيل تفسير هذا التحول دون فهم الدور الحاسم الذي لعبته الثورة الصينية عام 1949، والتي ألغت نظام الإقطاع والرأسمالية وخلقت الأساس للاقتصاد المخطط المؤمم، والذي كان الشرط المسبق لتحويل الصين من دولة متخلفة وشبه مستعمرة إلى وضعها الحالي كعملاق اقتصادي.
باعتبارها وافدةً متأخرةً على الساحة الدولية، اضطرت إلى النضال للسيطرة على مصادر المواد الخام والطاقة اللازمة لصناعاتها، ومجالات استثمار رؤوس أموالها، وطرق وارداتها وصادراتها، وأسواق منتجاتها. وقد حققت في جميع هذه المجالات نجاحاتٍ ملحوظة.كان صعود الصين على مدى ثلاثين عامًا نتيجةً للاستثمارات الضخمة في وسائل الإنتاج والاعتماد على الأسواق العالمية. في البداية، استغلت احتياطياتها الكبيرة من العمالة الرخيصة لتصدير سلع كالمنسوجات والألعاب إلى السوق العالمية.والآن أصبح الاقتصاد الرأسمالي متقدما من الناحية التكنولوجية، ويتمتع بموقع مهيمن عالميا في سلسلة من أسواق التكنولوجيا الفائقة (السيارات الكهربائية وبطاريات السيارات الكهربائية، والخلايا الكهروضوئية، ومكونات المضادات الحيوية، والطائرات بدون طيار التجارية، والبنية التحتية لاتصالات الهاتف الخلوي 5G، ومحطات الطاقة النووية، وما إلى ذلك)، ليس فقط من حيث حجم المبيعات، ولكن أيضا من حيث الابتكار.تُعدّ الصين أيضًا رائدةً عالميًا في مجال الروبوتات. فهي تحتل المرتبة الثالثة عالميًا من حيث كثافة الروبوتات الصناعية، بمعدل 470 لكل 10,000 عامل في قطاع التصنيع، على الرغم من أن قوتها العاملة في قطاع التصنيع تتجاوز 37 مليونًا. هذا يضعها خلف كوريا الجنوبية (1012) وسنغافورة (770) وتتقدم على ألمانيا (429) واليابان (419) بينما تتفوق بكثير على الولايات المتحدة (295) هذه الأرقام لعام 2023، ومن المرجح أن يكون ترتيب الصين قد تحسن منذ ذلك الحين، حيث مثّلت في عام 2023 نسبة 51% من جميع تركيبات الروبوتات الصناعية الجديدة في العالم.
فيما يتعلق بتصدير رأس المال، تأتي الصين في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة. في عام 2023، شكلت الولايات المتحدة 32.8 في المائة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية، حيث مثلت الصين وهونغ كونغ مجتمعتين 20.1 في المائة. ومن حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر المتراكم، كان لدى الولايات المتحدة 15.1 في المائة من الإجمالي العالمي، بينما شكلت الصين وهونغ كونغ 11.3 في المائة. وعلى الرغم من الهيمنة الأمريكية في هذا المجال، فإن الخطة الاستراتيجية طويلة الأجل لهذه الصادرات الرأسمالية مكنت الصين، على مدى العقدين الماضيين، من تنفيذ عملية كبيرة للسيطرة على طرق التجارة البحرية وإنتاج وتكرير المعادن التي تعتبر حيوية للغالبية العظمى من التقنيات الحديثة. تهيمن الصين على استخراج المعادن الأرضية النادرة عالميًا (69 في المائة) والتكرير (92 في المائة). كما تهيمن على تكرير المعادن الهامة مثل الكوبالت (80 في المائة) والنيكل (68 في المائة) والليثيوم (60 في المائة). علاوةً على ذلك، تُعزز الصين سيطرتها على استخراج الاحتياطيات الرئيسية، كما هو الحال في الكونغو (حيث تُسيطر على 15 من أفضل 19 منجمًا للكوبالت في البلاد) والأرجنتين (حيث تذهب 43% من صادراتها من الليثيوم إلى الصين، مُقارنةً بـ 11% إلى الولايات المتحدة). وقد كان هذا الأمر ضروريًا ليس فقط للسيطرة على إنتاج القطاعات التكنولوجية المهمة المذكورة آنفًا، بل أيضًا لفرض ضوابط مُعينة على تصدير هذه المعادن إلى الولايات المتحدة، والتي تُمثل ورقة تفاوضية مهمة في المفاوضات مع ترامب بشأن الرسوم الجمركية.نتيجةً لعودة الرأسمالية إلى الصين، تلعب الدولة دورًا هامًا في الاقتصاد. وقد انتهجت سياسةً واعيةً لرعاية وتمويل تطوير التكنولوجيا. وكان هدف برنامج "صنع في الصين 2025" تحقيق قفزة نوعية في الصناعات الرئيسية، وجعل البلاد مكتفية ذاتيًا وغير معتمدة على الغرب. وقد زاد إنفاق الصين على البحث والتطوير بشكل ملحوظ، وأصبح يُضاهي تقريبًا إنفاق الولايات المتحدة.
ولم يتحقق هذا النجاح من دون خلق تناقضات وصراعات متزايدة مع الدول الرأسمالية الأخرى، مما أدى في نهاية المطاف إلى الحرب التجارية الحالية مع الولايات المتحدة.في أعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي وفتح أسواق جديدة في ظل سياسة العولمة، نظر الاقتصاديون والمستثمرون الغربيون في البداية إلى نمو الاقتصاد الرأسمالي في الصين باعتباره فرصة ذهبية.سارع المستثمرون الغربيون إلى إنشاء مصانع في الصين، حيث تمكّنوا من استغلال وفرة العمالة الرخيصة التي تبدو لا نهاية لها. بين عامي ١٩٩٧ و٢٠١٩، سُجّل ٣٦٪ من نموّ رأس المال العالمي في الصين. كان تغلغل رأس المال الأمريكي في الصين هائلاً لدرجة أن الاقتصادين بدا وكأنهما مترابطان لا فكاك منهما.في الواقع، لعب النمو في الصين دورًا حاسمًا في تطور الاقتصاد العالمي لعقود. في عام ٢٠٠٨، تأمل البرجوازيون الغربيون أن تُسهم الصين في انتشال الاقتصاد العالمي من الركود. لكن، كما أشرنا آنذاك، كان لذلك جانب سلبي خطير وخطير للغاية بالنسبة لهم.
هذه المصانع، التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة، ستنتج حتمًا كميات هائلة من السلع الرخيصة التي كان لا بد من تصديرها، نظرًا لبقاء الطلب عليها في الصين نفسها محدودًا. في نهاية المطاف، تسبب هذا في مشاكل خطيرة للولايات المتحدة والاقتصادات الغربية الأخرى.انقلب كل شيء إلى نقيضه. وتزايدت التساؤلات: من يُساعد من؟ صحيح أن المستثمرين الغربيين كانوا يحققون أرباحًا طائلة، لكن الصين كانت تُرسي قدرات تصنيعية متقدمة، وخبرة تكنولوجية، وبنية تحتية، وقوى عاملة ماهرة. وأصبح هذا يُنظر إليه على أنه تهديد، لا سيما في أمريكا.
أصبحت الصين الآن موردًا لا غنى عنه للمصنّعين العالميين، سواءً كانوا ينتجون منتجات استهلاكية جاهزة مثل هواتف آيفون أو سلعًا ومكونات رأسمالية أساسية. تُعدّ الصين المورد الرئيسي لـ 36% من واردات الولايات المتحدة، مُلبّيةً أكثر من 70% من الطلب الأمريكي على هذه المنتجات.
أصبحت الصين منافسًا منهجيًا للولايات المتحدة على الساحة العالمية. وهذا هو المعنى الحقيقي لحرب ترامب التجارية عليها. إنه صراع بين قوتين إمبرياليتين لتأكيد نفوذهما النسبي في السوق العالمية.
وقد استخدمت واشنطن التدابير الأكثر تطرفا للقيام بذلك، فحظرت بيع الرقائق الدقيقة الأكثر تقدما إلى الصين، ومنعت بيع آلات الطباعة الحجرية الأكثر تقدما، ومنعت شركات مثل هواوي من التقدم بعطاءات للحصول على عقود البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس في العديد من البلدان، إلخ.
لكن محاولات الولايات المتحدة لعرقلة تطور الصين في مجال التكنولوجيا المتطورة أتت بنتائج عكسية. وردًا على ذلك، سارعت الصين إلى تسريع وتيرة تحقيق الاكتفاء الذاتي. وبينما لا تزال تواجه صعوبات، على سبيل المثال، نتيجة عدم قدرتها على الوصول إلى أحدث آلات الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية (EUV) المستخدمة في تصنيع أحدث المعالجات الدقيقة، فقد لجأت الصين إلى الإبداع لإيجاد حلول جزئية.صحيحٌ أنه على الرغم من التقدم الذي أحرزه الاقتصاد الصيني، إلا أن هناك تناقضاتٍ عديدةً فيه. فقد شهدت إنتاجية العمل في الصين نموًا ملحوظًا بفضل تطور العلوم والصناعة والتكنولوجيا، بينما ظلت راكدةً في أوروبا لفترة طويلة، ولم تشهد الولايات المتحدة سوى نموٍّ طفيفٍ في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، لا تزال إنتاجية العمل في الصين، إجمالًا، متأخرةً عن نظيرتها في الولايات المتحدة بهامشٍ كبير. وسيستغرق سدّ هذه الفجوة وقتًا.
من المنطقي أيضًا افتراض أن معدلات النمو غير المسبوقة التي حققتها الصين خلال العقود القليلة الماضية لن تستمر. في الواقع، بدأ التباطؤ بالفعل. في تسعينيات القرن الماضي، نمت الصين بوتيرة مذهلة بلغت 9% سنويًا، وبلغت ذروتها عند 14%. وبين عامي 2012 و2019، تراوحت نسبة النمو بين 6 و7%. وهي الآن حوالي 5%. ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد الصيني ككل ينمو بوتيرة أسرع من الدول الرأسمالية المتقدمة في الغرب.بطبيعة الحال، نظرًا لتحول الصين إلى اقتصاد رأسمالي واندماجها الوثيق في السوق العالمية، فإنها ستواجه في نهاية المطاف جميع المشاكل التي يترتب على ذلك. فهناك بالفعل تفاوتات إقليمية في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى تفاوت هائل في الدخل. وقد ارتفعت معدلات البطالة بين العمال المهاجرين والشباب.أدت حزم التحفيز الاقتصادي الضخمة، والإجراءات الكينزية، إلى زيادة الدين. ارتفعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي كانت 23% فقط عام 2000، إلى 60.5% عام 2024. تُعدّ هذه زيادة كبيرة، لكنها لا تزال أقل من معظم الاقتصادات الرأسمالية المتقدمة. مع ذلك، وصل إجمالي الدين (للدولة والشركات والأسر) إلى 300% من الناتج المحلي الإجمالي.لا شك أن تصاعد الحمائية وتباطؤ التجارة العالمية سيؤثران على الصين. والطريقة الوحيدة لتجاوز هذه الأزمة هي بذل جهود أكبر لتفريغ فائض إنتاجها في السوق العالمية، مما سيزيد بدوره من التوترات على الصعيد العالمي، ويعمق في الوقت نفسه أزمة النظام ككل.في هذا الصراع المحتدم بين عملاقين اقتصاديين، يُطرح السؤال مباشرةً: من سينتصر؟ تمتلئ أعمدة الصحافة الغربية بتقييمات سلبية وتحذيرات مُقلقة لمستقبل الاقتصاد الصيني.تسعى الصحافة الغربية باستمرار إلى تقديم صورة قاتمة للغاية عن الاقتصاد الصيني، كما تفعل دائمًا فيما يتعلق بالاقتصاد الروسي، الذي لا يزال يحافظ على معدل نمو جيد يتراوح بين 4% و5% سنويًا. وهذا لا يوحي بأن الاقتصاد على وشك الانهيار.من المؤكد أن الصين ليست بمنأى عن الأزمات، لكنها تمتلك أيضًا احتياطياتٍ هائلةً لمواجهة هذا التحدي والخروج منه بأقلّ أضرارٍ بكثير مما يُروّج له في الصحافة الغربية. وفوق كل ذلك، يجب الأخذ في الاعتبار أن الصين، رغم كونها دولةً رأسمالية، لا تزال تتمتّع بخصائصَ عديدة.في الواقع، إنه اقتصاد لا يزال يحتفظ بعناصر مهمة من سيطرة الدولة وتدخلها وتخطيطها. وهذا يصب في مصلحته بشكل كبير، مقارنةً بدول مثل الولايات المتحدة.هناك أيضًا عوامل سياسية وثقافية ونفسية مهمة يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في أي صراع مع القوى الإمبريالية الأجنبية. يحتفظ الشعب الصيني بذكريات طويلة ومريرة عن قهره واستغلاله وإذلاله على يد الإمبريالية في الماضي.
ولكن على الرغم من مدى كرههم للطبقة الحاكمة في بلادهم، فإن كراهية الإمبرياليين الأجانب أعمق بكثير ويمكن أن توفر دعماً قوياً للنظام في صراعه ضد الولايات المتحدة.راقبت الدوائر الحاكمة في الولايات المتحدة صعود الصين بقلق متزايد. وتبنّت موقفًا عدائيًا، عبّر عنه من جهة بزيادات ترامب الصارخة في الرسوم الجمركية، ومن جهة أخرى باستفزازاته المستمرة بشأن تايوان.
إن دعاة الحرب في واشنطن يتهمون الصين باستمرار بالتخطيط لغزو ما يعتبره الصينيون جزيرة متمردة هي ملك لهم بحق.لكن الدوائر الحاكمة في الصين يديرها رجالٌ أتقنوا منذ زمنٍ طويل فن الصبر في الدبلوماسية. لا حاجة لهم لغزو تايوان. إنهم يعلمون أنها ستعود إلى البر الرئيسي عاجلاً أم آجلاً. لقد انتظروا عقوداً لاستعادة السيطرة على هونغ كونغ من البريطانيين. ولا يرون أي مبررٍ للسعي إلى حلٍّ عسكريٍّ متسرّعٍ للمشكلة.لن يدفعهم إلى اتخاذ إجراء عسكري إلا سوء تقدير خطير من دعاة الحرب في واشنطن، أو قرار متسرع من القوميين التايوانيين بإعلان الاستقلال. في ظل هذه الظروف، ستكون كل الأوراق في قبضتهم.
لا يمكن لتايوان بأي حال من الأحوال أن تصمد طويلاً في وجه قوة الجيش والبحرية الصينية، التي يتمركز على بعد بضعة أميال فقط، في حين سيتعين على الأميركيين تحريك قوة كبيرة لمواجهة ظروف صعبة وخطيرة عبر المحيط بأكمله.
على أي حال، ليس هناك ما يشير إلى أن دونالد ترامب نفسه يسعى إلى صراع عسكري مع الصين. فهو يفضل أساليب أخرى - فرض عقوبات مُرهقة ورسوم جمركية مرتفعة - لإجبار الصين على الخضوع. لكن الصين لا تنوي الخضوع، لا في حرب اقتصادية ولا في صراع عسكري فعلي.حتى وقت قريب، اعتمدت الصين على القوة الاقتصادية بشكل رئيسي، لكنها تعمل أيضًا على تعزيز قوتها العسكرية. أعلنت الصين مؤخرًا عن زيادة إنفاقها الدفاعي بنسبة 7.2%. تمتلك الصين بالفعل جيشًا بريًا ضخمًا وقويًا، وهي الآن بصدد تطوير بحرية حديثة وقوية بنفس القدر للدفاع عن مصالحها في أعالي البحار.ذكرت مقالة حديثة لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن الصين تمتلك الآن أكبر قوة بحرية في العالم، متجاوزةً بذلك قوة الولايات المتحدة. كما أن القول بأن قواتها المسلحة تعتمد على تقنيات ومعدات قديمة ليس صحيحًا. إذ تنص المقالة نفسها على ما يلي:
"أصبحت الصين الآن ملتزمة بشكل كامل بتطوير الحرب "الذكية"، أو الأساليب العسكرية المستقبلية القائمة على التقنيات المبتكرة - وخاصة الذكاء الاصطناعي، وفقًا لوزارة الدفاع الأمريكية"ويضيف أن:
"كُلِّفت أكاديمية العلوم العسكرية الصينية بضمان تحقيق ذلك، من خلال "الاندماج المدني العسكري"، أي ربط شركات التكنولوجيا الصينية من القطاع الخاص بصناعات الدفاع في البلاد. وتشير التقارير إلى أن الصين ربما تستخدم الذكاء الاصطناعي بالفعل في الروبوتات العسكرية وأنظمة توجيه الصواريخ، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة والسفن البحرية المسيرة".
علاوة على ذلك، تمتلك الصين أحد أنشط برامج الفضاء في العالم. ومن بين مهماتها الأخرى، لديها خطط طموحة لبناء محطة فضائية على القمر وزيارة المريخ. وبغض النظر عن اهتمامها العلمي الجوهري، ترتبط هذه الخطط بوضوح ببرنامج طموح للغاية لإعادة التسلح.لقد أصبح تطور الرأسمالية في الصين حقيقةً راسخة. لا جدوى من إنكار ذلك. كما أنه، من الناحية الموضوعية، ليس تطورًا سلبيًا من منظور الثورة العالمية، لأنه خلق طبقة عاملة ضخمة، اعتادت على ارتفاع مطرد في مستويات معيشتها على مدى فترة طويلة. إنها طبقة عاملة شابة ونضرة، لم تُثقلها الهزائم، ولم تُقيدها المنظمات الإصلاحية"الصين تنين نائم. دع الصين تنام، فعندما تستيقظ ستهز العالم" مقولة تُنسب كثيرًا إلى نابليون. وسواءً قالها أم لم يقل، فهي تنطبق بالتأكيد على البروليتاريا الصينية القوية في الوقت الحاضر. قد تتأخر لحظة الحقيقة بعض الوقت. ولكن عندما تبدأ تلك القوة الجبارة بالتحرك، فإنها ستُحدث انفجارًا زلزاليًا.
• التوازن بين القوى الامبريالية
أدى التراجع النسبي للإمبريالية الأمريكية وصعود الصين إلى خلق حالةٍ تُمكّن بعض الدول من تحقيق التوازن بينها، والحصول على قدرٍ محدودٍ من الاستقلالية في تحقيق مصالحها الخاصة، على الأقل على المستوى الإقليمي. ويشمل ذلك دولًا مثل تركيا والمملكة العربية السعودية والهند وغيرها، بدرجاتٍ متفاوتة.إن صعود مجموعة البريكس، التي تم إطلاقها رسميا في عام 2009، يمثل محاولة من جانب الصين وروسيا لتعزيز مكانتهما على الساحة العالمية، وحماية مصالحهما الاقتصادية، وربط سلسلة كاملة من البلدان في مجال نفوذهما.
وقد سرّع تطبيق الإمبريالية الأمريكية عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على روسيا هذه العملية. وفي سعيها لإيجاد آليات لتجنب العقوبات والتغلب عليها، أقامت روسيا سلسلة من التحالفات مع دول أخرى، منها المملكة العربية السعودية والهند والصين وغيرها الكثير.بدلاً من إظهار قوة الولايات المتحدة، كشف فشل العقوبات عن محدودية قدرة الإمبريالية الأمريكية على فرض إرادتها، ودفع عددًا من الدول إلى التفكير في بدائل للهيمنة الأمريكية على المعاملات المالية. توسعت عضوية مجموعة البريكس بدعوة دول جديدة أو طلبها الانضمام.
عند التعامل مع هذا السؤال، من المهم مراعاة التوازن. على الرغم من أهمية هذه التغييرات، إلا أن دول البريكس مليئة بتناقضات شتى. فالبرازيل، رغم كونها عضوًا في البريكس، هي في الوقت نفسه عضو في ميركوسور، تكتل التجارة الحرة في أمريكا الجنوبية، الذي يتفاوض على اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.الهند جزءٌ من الحلف، لكنها مترددة في السماح بانضمام أعضاء جدد، لأن ذلك سيقلل من وزنها فيه. كما تربطها "شراكة استراتيجية" مع الولايات المتحدة، وهي جزءٌ من التحالف الأمني والعسكري الرباعي مع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا، وتُجري قواتها البحرية تدريبات عسكرية منتظمة مع الولايات المتحدة.المهم هنا هو أن دولةً مثل الهند، حليفة الولايات المتحدة ومنافسة الصين، لعبت دورًا هامًا في مساعدة روسيا على تجاوز العقوبات الأمريكية. تشتري الهند النفط الروسي بسعر مخفّض، ثم تعيد بيعه إلى أوروبا على شكل منتجات مكررة بسعر أعلى. في الوقت الحالي، قررت الولايات المتحدة عدم اتخاذ أي إجراءات ضد الهند.حتى الآن، لا تعدو مجموعة البريكس كونها تحالفًا فضفاضًا من الدول. إن سياسة الترهيب الإمبريالية التي تنتهجها الولايات المتحدة تجاه منافسيها هي ما يدفعهم إلى التقارب ويشجع آخرين على الانضمام.
• الأزمة في أوروبا
بينما عانت الولايات المتحدة من تراجع نسبي في قوتها ونفوذها العالمي، تراجعت القوى الإمبريالية الأوروبية العريقة - بريطانيا وفرنسا وألمانيا وغيرها - بشكل ملحوظ عن أيام مجدها الغابر، لتصبح قوى عالمية من الدرجة الثانية. تجدر الإشارة إلى أن الدور الإمبريالي للدول الأوروبية قد ضعف بشكل ملحوظ في العقد الماضي. على سبيل المثال، أدت سلسلة من الانقلابات العسكرية إلى نزوح فرنسا من أفريقيا الوسطى ومنطقة الساحل، مما ساهم بشكل كبير في هيمنة روسيا.
اتبعت القوى الأوروبية نهج الإمبريالية الأمريكية في حربها بالوكالة ضد روسيا في أوكرانيا، الأمر الذي كان له أثرٌ مدمر على اقتصادها. منذ انهيار الستالينية بين عامي 1989 و1991، انتهجت ألمانيا سياسة توسيع نفوذها شرقًا، وأقامت روابط اقتصادية وثيقة مع روسيا. استفادت الصناعة الألمانية من الطاقة الروسية الرخيصة. قبل حرب أوكرانيا، كان أكثر من نصف الغاز الطبيعي الألماني، وثلث النفط، ونصف وارداتها من الفحم، تأتي من روسيا.
كان هذا أحد أسباب نجاح الصناعة الألمانية عالميًا، أما السببان الآخران فهما تحرير سوق العمل (الذي نُفذ في ظل حكومات ديمقراطية اجتماعية) والاستثمارات المُستثمرة في الصناعة في النصف الثاني من القرن الماضي. وقد أتاحت هيمنة الطبقة الحاكمة الألمانية على الاتحاد الأوروبي، والتجارة الحرة مع الصين والولايات المتحدة، لألمانيا الخروج سالمةً ظاهريًا من أزمة عام ٢٠٠٨.
كان الوضع مشابهًا للاتحاد الأوروبي ككل، حيث كانت روسيا أكبر مورد للنفط (24.8%)، وغاز الأنابيب (48%)، والفحم (47.9%). أدت العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا بعد اندلاع حرب أوكرانيا إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة، مما أثر سلبًا على التضخم وتراجع القدرة التنافسية للصادرات الأوروبية. في النهاية، اضطرت أوروبا إلى استيراد غاز طبيعي مسال (LNG) أغلى بكثير من الولايات المتحدة، ومنتجات نفطية روسية أغلى بكثير عبر الهند.
في الواقع، لا يزال جزء كبير من غاز ألمانيا يأتي من روسيا، إلا أنه الآن يأتي على شكل غاز طبيعي مُسال، وبسعر أعلى بكثير. لقد أضرّت الطبقات الحاكمة الألمانية والفرنسية والإيطالية بنفسها، وهي الآن تدفع ثمنًا باهظًا. في عهد رئاسة بايدن، كافأت الولايات المتحدة حلفائها الأوروبيين بشن حرب تجارية ضدهم من خلال سلسلة من الإجراءات الحمائية والدعم الصناعي.
مثّلت الجماعة الاقتصادية الأوروبية، ثم الاتحاد الأوروبي لاحقًا، محاولةً من القوى الإمبريالية الضعيفة في القارة للتجمع معًا بعد الحرب العالمية الثانية، أملًا في أن يكون لها تأثيرٌ أكبر في السياسة والاقتصاد العالميين. عمليًا، هيمن رأس المال الألماني على الاقتصادات الأضعف الأخرى. وبينما كان هناك نمو اقتصادي، تحقق قدرٌ من التكامل الاقتصادي، بل وعملة موحدة.
ومع ذلك، ظلت الطبقات الحاكمة الوطنية المختلفة التي شكلتها قائمة، ولكل منها مصالحها الخاصة. ورغم كل هذا الجدل، لا توجد سياسة اقتصادية مشتركة، ولا سياسة خارجية موحدة، ولا جيش واحد لتنفيذها. فبينما اعتمد رأس المال الألماني على الصادرات الصناعية التنافسية، وكانت مصالحه في الشرق، تحصل فرنسا على مبالغ طائلة من الدعم الزراعي من الاتحاد الأوروبي، وتتركز مصالحها الإمبريالية في المستعمرات الفرنسية السابقة، وخاصة في أفريقيا.
لقد استنزفت أزمة الديون السيادية التي أعقبت ركود عام 2008 الاتحاد الأوروبي إلى أقصى حدوده. وقد تفاقم الوضع الآن أكثر. ويصور التقرير الأخير لرئيس البنك المركزي الأوروبي السابق، ماريو دراغي، أزمة الرأسمالية الأوروبية بعبارات مثيرة للقلق، ولكنه محق في ذلك. ففي جوهر الأمر، يكمن سبب عجز الاتحاد الأوروبي عن منافسة منافسيه الإمبرياليين في العالم في حقيقة أنه ليس كيانًا اقتصاديًا سياسيًا واحدًا، بل هو مجموعة من عدة اقتصادات صغيرة ومتوسطة الحجم، لكل منها طبقتها الحاكمة، وصناعاتها الوطنية، ومجموعاتها التنظيمية الخاصة، وما إلى ذلك. إن اقتصاد أوروبا متصلب، وقد تجاوزه منافسوه من حيث نمو الإنتاجية.
لقد أصبحت القوى الإنتاجية أكبر من الدولة القومية، وتزداد حدة هذه المشكلة بشكل خاص في الاقتصادات الصغيرة ولكن المتقدمة للغاية في أوروبا.
كان التراجع المطول للقوى الإمبريالية الأوروبية مُخفىً بحقيقة أن الولايات المتحدة كانت تُؤمّن دفاعها، وتدعم الاتحاد الأوروبي سياسيًا. فعلى مدار ما يقرب من ثمانين عامًا، دعمت الإمبريالية الأمريكية أوروبا، تحت سيطرتها، كحصن منيع ضد الاتحاد السوفيتي. كان هذا ترتيبًا مفيدًا للغاية للرأسمالية الأوروبية، إذ مكّنها من إسناد جزء كبير من تكاليف دفاعها العسكري إلى جارتها القوية على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي.انتهى هذا الأمر الآن. قررت الإمبريالية الأمريكية في عهد ترامب إدارة تراجعها النسبي من خلال محاولة التوصل إلى اتفاق مع روسيا للتركيز بشكل أفضل على منافسها الرئيسي في الساحة العالمية: الصين. لم يعد المحيط الأطلسي هو مركز السياسة والاقتصاد العالمي، بل المحيط الهادئ. كان هذا التحول قيد التشكل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ولكنه برز الآن بشكل متفجر.
هذه صدمةٌ كبرى للعلاقات العالمية لا يُمكن لأحدٍ تجاهلها. إذا أرادت الولايات المتحدة التوصل إلى تفاهمٍ مع روسيا، فهذا يُضع الإمبريالية الأوروبية في موقفٍ ضعيفٍ للغاية. لم تعد الولايات المتحدة صديقتها وحليفتها. بل ذهب البعض إلى حدّ القول إن واشنطن باتت تعتبر أوروبا منافسًا أو عدوًا.على أقل تقدير، أوضح ترامب أن الولايات المتحدة لم تعد مستعدة لدعم دفاع أوروبا. إن سحب المظلة الأمريكية الواقية، كما وصفه البعض، كشف بوضوح عن جميع نقاط الضعف المتراكمة للإمبريالية الأوروبية، والتي تراكمت على مدى عقود من التراجع.لأزمة الرأسمالية الأوروبية تداعيات سياسية واجتماعية بالغة الأهمية. ويُعدّ صعود القوى اليمينية الشعبوية والمشككة في الاتحاد الأوروبي والمناهضة للمؤسسة في جميع أنحاء القارة نتيجةً مباشرة لها. ولن تقبل الطبقة العاملة الأوروبية، بقواها التي لا تزال سليمة إلى حد كبير وغير مهزومة، جولة جديدة من إجراءات التقشف والتسريح الجماعي للعمال دون مقاومة. فالساحة مهيأة لانفجار الصراع الطبقي.
• الحرب في الشرق الأوسط
لا يمكن فهم الصراع الحالي في الشرق الأوسط إلا في ضوء الوضع العالمي. فقد ضعفت الإمبريالية الأمريكية في الشرق الأوسط، بينما تعززت روسيا والصين وإيران. شعرت إسرائيل بالتهديد. شكّل هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول ضربة موجعة للطبقة الحاكمة الإسرائيلية. فقد حطم أسطورة القوة التي لا تُقهر، وطرح تساؤلات حول قدرة الدولة الصهيونية على حماية مواطنيها اليهود، وهو السؤال المحوري الذي استخدمته الطبقة الحاكمة الإسرائيلية لحشد الشعب خلفها.
كما كشف بوضوح عن انهيار اتفاقيات أوسلو، التي وُقِّعت في أعقاب انهيار الستالينية. كان الأمر برمته خدعة ساخرة من البداية إلى النهاية. لم تُفكِّر الطبقة الحاكمة الصهيونية قط في منح الفلسطينيين وطنًا قابلًا للحياة. لقد اعتبروا السلطة الوطنية الفلسطينية مجرد وسيلة للاستعانة بمصادر خارجية لمراقبة الفلسطينيين. وقد أدى هذا التشكيك في مصداقية فتح والسلطة الفلسطينية - اللذان يُنظر إليهما، عن حق، على أنهما مجرد دمى في يد إسرائيل - إلى صعود حماس، التي اعتبرها الكثيرون القوة الوحيدة التي تُناضل من أجل الحقوق الوطنية الفلسطينية.
ولكن في واقع الأمر فإن الأساليب الرجعية التي تنتهجها حماس قد قادت الفلسطينيين إلى طريق مسدود يصعب عليهم أن يروا فيه أي مخرج.
كان الهدف من اتفاقيات إبراهيم، التي وُقِّعت عام ٢٠٢٠ بضغط من إدارة ترامب الأولى، ترسيخ مكانة إسرائيل في المنطقة كطرف فاعل شرعي، وتطبيع العلاقات التجارية بينها وبين الدول العربية. كان هذا يعني دفن التطلعات الوطنية الفلسطينية، وهو أمرٌ كانت الأنظمة العربية الرجعية سعيدةً به. وكان هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول ردًّا يائسًا على ذلك.
استقبل الفلسطينيون الهجوم في البداية بابتهاج، لكن عواقبه كانت وخيمة. فقد منح نتنياهو، الذي واجه قبل ذلك مباشرة موجة طويلة من الاحتجاجات الجماهيرية، ذريعة مثالية لشن حملة إبادة جماعية ضد غزة. رأى نتنياهو وبن غفير وسموتريتش وشركاؤه في هجوم 7 أكتوبر فرصة ذهبية. وتحت غطاء "الأمن" و"السلامة" الإسرائيليين، سعوا إلى تطهير أرضهم عرقيًا من أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين. كما سعوا إلى إعادة تأكيد دورهم الإمبريالي في المنطقة من خلال فتح باب الحرب على جبهات متعددة.بعد عام، حوّل الإسرائيليون غزة إلى كومة من الأنقاض، لكنهم لم يحققوا أهدافهم المعلنة: إطلاق سراح الرهائن والقضاء على حماس. كان هذان الهدفان الحربيان متناقضين تمامًا. فالأول يتطلب تسوية تفاوضية مع حماس، بينما الثاني يمنع إجراء مثل هذه المفاوضات. ساد غضب واسع النطاق لأن الحكومة الإسرائيلية انشغلت فقط بتدمير عدوها. أدى ذلك إلى مظاهرات حاشدة شارك فيها مئات الآلاف من الإسرائيليين، بل وحتى إضراب عام قصير في سبتمبر/أيلول 2024.لم تكن هذه المظاهرات دعمًا للقضية الفلسطينية، ولا معارضةً للحرب بحد ذاتها. ومع ذلك، فإنّ هذا القدر من المعارضة الجماهيرية لرئيس الوزراء في خضمّ الحرب يُشير إلى عمق الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي.
دفعه انهيار شعبيته إلى تصعيد الموقف بغزو لبنان وشن هجوم على حزب الله، مصحوبًا باستفزازات مستمرة ضد إيران. ولإنقاذ نفسه سياسيًا، أبدى نتنياهو مرارًا استعداده لشن حرب إقليمية، مما سيجبر الولايات المتحدة على التدخل المباشر لصالحه.رغم خطر أن تؤدي مجزرة غزة إلى زعزعة استقرار الأنظمة العربية الرجعية (في السعودية ومصر، والأردن تحديدًا)، أوضح بايدن أن دعمه لإسرائيل "لا يتزعزع"، وصرف نتنياهو هذا الدعم على بياض مرارًا وتكرارًا، متبعًا مسارًا تصعيديًا نحو حرب إقليمية. فإلى جانب المجزرة الإبادة الجماعية في غزة، شنّ غزوًا بريًا على لبنان، وشن غارات جوية على إيران واليمن وسوريا، ثم غزوًا بريًا على سوريا.على الرغم من أن الدافع الرئيسي لنتنياهو لتوسيع الصراع ليشمل إيران كان خلاصه السياسي بسبب مشاكله الداخلية، إلا أنه يبدو واضحًا أن الحرب المحدودة التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران في يونيو الماضي حظيت بدعم أوسع نطاقًا بين الطبقة الحاكمة الإسرائيلية. وقد اعتبرت البرجوازية الصهيونية تعزيز النظام الإيراني في المنطقة على مدى السنوات العشرين الماضية تهديدًا لإسرائيل. لكن إيران تُركت في وضع أكثر هشاشة في المنطقة مع القضاء على نظام الأسد السوري وإضعاف حزب الله وحماس بشكل خطير. وبالتالي، فإن حربًا صغيرة يمكن أن تدمر البرنامج النووي الإيراني، أو حتى تؤدي إلى الإطاحة بالنظام، كانت قضية تستحق الدعم. في النهاية، فشلت إسرائيل في تحقيق ذلك، وتكرار مواجهة عسكرية جديدة بينهما ليس سوى مسألة وقت.
لقد غيّر الانهيار المفاجئ وغير المتوقع لنظام الأسد في سوريا موازين القوى الإقليمية مجددًا. تُعدّ تركيا قوة رأسمالية صغيرة في الاقتصاد العالمي، لكنها ذات طموحات إقليمية كبيرة. وقد استغلّ أردوغان بمهارة فائقة الصراع بين الإمبريالية الأمريكية وروسيا لمصلحته الخاصة.بعد أن شعر أردوغان بانشغال إيران وروسيا، اللتين عقد معهما صفقة في سوريا عام ٢٠١٦، بأمور أخرى (روسيا في أوكرانيا وإيران في لبنان)، قرر دعم هجوم جهاديي هيئة تحرير الشام من إدلب. ولدهشة الجميع، عجّل ذلك بالانهيار الكامل للنظام. لقد كان حجم تآكله بفعل العقوبات الاقتصادية والفساد والطائفية أكبر بكثير مما كان يُدركه أحد. إن التقسيم الحالي لسوريا هو استمرار لأكثر من مئة عام من التدخل الإمبريالي، بدءًا من اتفاقية سايكس بيكو.في نهاية المطاف، لا يمكن أن يتحقق السلام في الشرق الأوسط ما لم تُحل القضية الوطنية الفلسطينية. لكن هذا لا يمكن تحقيقه في ظل الرأسمالية. فمصالح الطبقة الحاكمة الصهيونية في إسرائيل (المدعومة من أقوى قوة إمبريالية في العالم) لا تسمح بإقامة وطن حقيقي للفلسطينيين، ناهيك عن حق العودة لملايين اللاجئين.من وجهة نظر عسكرية بحتة، لا يستطيع الفلسطينيون هزيمة إسرائيل، القوة الإمبريالية الرأسمالية الحديثة التي تمتلك أحدث التقنيات العسكرية وجهاز استخبارات لا يُضاهى. كما أنها مدعومة بالكامل من الإمبريالية الأمريكية.فما هي القوى الأخرى التي يمكن للفلسطينيين الاعتماد عليها؟ لا يمكن وضع أي ثقة في الأنظمة العربية الرجعية، التي تدّعي خدمة القضية الفلسطينية لفظيًا، لكنها خانتها وتعاونت مع إسرائيل والإمبريالية في كل خطوة.الأصدقاء الحقيقيون الوحيدون للفلسطينيين موجودون في الشارع العربي - جماهير العمال والفلاحين وصغار التجار والفقراء في المدن والأرياف. لكن مهمتهم المباشرة هي تصفية حساباتهم مع حكامهم الرجعيين. وهذا يطرح مسألة إلغاء الرأسمالية من خلال مصادرة أملاك الملاكين والمصرفيين والرأسماليين. بدون ذلك، لن تنجح الثورة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط أبدًا.
توجد طبقة عاملة قوية في المنطقة، لا سيما في مصر وتركيا، وكذلك في السعودية ودول الخليج والأردن. إن نجاح انتفاضة في أيٍّ من هذه الدول، ووصول الطبقة العاملة إلى السلطة، سيُغيّر موازين القوى، ويهيئ بذلك ظروفًا أكثر ملاءمةً لتحرير الفلسطينيين، ويُمهّد الطريق لحرب ثورية ضد إسرائيل، وهي حربٌ ستنبثق لا محالة من الوضع برمته.لا يمكن هزيمة دولة إسرائيل وطبقتها الصهيونية الحاكمة إلا بتقسيم سكان البلاد على أسس طبقية. في الوقت الحالي، يبدو احتمال حدوث انقسام طبقي في إسرائيل بعيدًا. ومع ذلك، فإن استمرار الحرب والصراع قد يدفع في النهاية شريحة من الجماهير الإسرائيلية إلى استنتاج أن السبيل الوحيد للسلام هو حل عادل للقضية الوطنية الفلسطينية.
بدون منظور التحول الاشتراكي الثوري للمجتمع، لن تُحلّ الحروب التي لا تنتهي، التي تشنها الحكومات الرجعية بتحريك القوى الإمبريالية، شيئًا. في ظل حكم الإمبريالية، لن تُمهّد وقف إطلاق النار المؤقت واتفاقيات السلام الطريق إلا لحروب جديدة. لكن عدم الاستقرار العام، الذي يُشكّل سبب الحروب ونتيجتها في آنٍ واحد، سيهيئ الظروف لحركة ثورية جماهيرية في الفترة القادمة.
ستنتصر الثورة الفلسطينية كثورة اشتراكية، كجزء من انتفاضة عامة لجماهير العمال والفلاحين الفقراء ضد الأنظمة الرجعية في المنطقة، أو لن تنتصر إطلاقًا. تمتلك دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موارد هائلة غير مستغلة، من شأنها ضمان مجتمع مزدهر. لكن على العكس، لم يكن تاريخ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكمله، بعد ما يُسمى بالاستقلال عن الحكم الإمبريالي المباشر، سوى كابوس لغالبية الشعوب. لقد أثبتت البرجوازية عجزها عن حل أيٍّ من المشاكل الأساسية.لقد لعب الستالينيون دورًا ضارًا للغاية، إذ استندوا إلى نظرية "المرحلتين" الزائفة، التي تفصل بشكل مصطنع الثورة البروليتارية عما يُسمى بالثورة الديمقراطية البرجوازية. وقد أدت هذه النظرية الرجعية إلى هزيمة نكراء تلو الأخرى، مهدت الطريق لصعود حكم ديكتاتوري رجعي وقمعي، وجنون الأصولية الدينية في بلد تلو الآخر. وحدها الثورة الاشتراكية المنتصرة قادرة على وضع حد لهذا الكابوس.وحده الاتحاد الاشتراكي قادر على حل القضية القومية نهائيًا. سيتمتع جميع الشعوب، فلسطينيين ويهود إسرائيليين، بل وأكراد وأرمن وغيرهم، بالحق في العيش بسلام ضمن هذا الاتحاد الاشتراكي. ستُستغل الإمكانات الاقتصادية للمنطقة على أكمل وجه في إطار خطة إنتاج اشتراكية مشتركة. ستصبح البطالة والفقر شيئًا من الماضي. على هذا الأساس وحده، يُمكن التغلب على الأحقاد القومية والدينية القديمة، التي ستصبح بمثابة ذكرى كابوس.وهذا هو الأمل الحقيقي الوحيد لشعوب الشرق الأوسط.
• سباق التسلح والعسكرة
تاريخيًا، كان أي تغيير جوهري في القوة النسبية للقوى الإمبريالية المختلفة يُحسم بالحرب، لا سيما الحربان العالميتان في القرن العشرين. أما اليوم، فإن وجود الأسلحة النووية يُستبعد نشوب حرب عالمية مفتوحة في الفترة المقبلة.
يخوض الرأسماليون الحروب لتأمين الأسواق ومجالات الاستثمار ومناطق النفوذ. ستؤدي حرب عالمية اليوم إلى تدمير شامل للبنية التحتية والحياة، ولن تستفيد منها أي قوة. يتطلب الأمر قائدًا بونابرتيًا مجنونًا يحكم قوة نووية كبرى لوقوع حرب عالمية. لن يكون ذلك ممكنًا إلا على أساس هزائم ساحقة للطبقة العاملة. هذا ليس المنظور الذي نراه أمامنا.ومع ذلك، يُهيمن الصراع بين القوى الإمبريالية، الذي يعكس صراعًا لفرض إعادة تقسيم جديدة للكوكب، على الوضع العالمي. ويتجلى ذلك في العديد من الحروب الإقليمية التي تُسبب دمارًا هائلًا وتُودي بحياة عشرات الآلاف من البشر، بالإضافة إلى التوترات التجارية والدبلوماسية المتصاعدة باستمرار. وقد شهد العام الماضي أعلى عدد من الحروب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.أدى ذلك إلى سباق تسلح جديد، وتنامي النزعة العسكرية في الدول الغربية، وتزايد الضغوط لإعادة بناء وتجهيز وتحديث القوات المسلحة في كل مكان. ومن المقرر أن تنفق الولايات المتحدة ما يُقدر بـ 1.7 تريليون دولار على مدى 30 عامًا لتجديد ترسانتها النووية. وقد قررت الآن نشر صواريخ كروز على الأراضي الألمانية لأول مرة منذ الحرب الباردة.هناك ضغط شديد على جميع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) لزيادة إنفاقها الدفاعي. أعلنت الصين عن زيادة بنسبة 7.2% في الإنفاق الدفاعي. ونتيجةً للحرب، ارتفع الإنفاق العسكري الروسي بنسبة 40% في عام 2024، ليصل إلى 32% من إجمالي الإنفاق الفيدرالي و6.68% من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ الإنفاق العسكري العالمي في عام 2023 ما قيمته 2.44 تريليون دولار، بزيادة قدرها 6.8% عن عام 2022. وتُعدّ هذه أكبر زيادة منذ عام 2009، وأعلى مستوى مُسجّل على الإطلاق.هذه مبالغ طائلة، ناهيك عن هدر قوة العمل والتطور التكنولوجي، والتي كان من الممكن استخدامها لأغراض اجتماعية ضرورية. هذه نقطة يجب على الشيوعيين التأكيد عليها في دعايتنا وتحريضنا.من التبسيط القول إن الرأسماليين يشرعون في سباق تسلح جديد لتعزيز النمو الاقتصادي. في الواقع، يُعدّ الإنفاق على الأسلحة تضخميًا بطبيعته، وأي تأثير على الاقتصاد سيكون قصير الأجل، وسيُعوّض بتخفيضات في قطاعات أخرى. على المدى البعيد، يُشكّل هذا الإنفاق استنزافًا للاقتصاد الإنتاجي من خلال امتصاص فائض القيمة. بل إن الصراع بين القوى الإمبريالية على إعادة تقسيم العالم هو ما يُغذّي زيادة الإنفاق العسكري. فالرأسمالية في مرحلتها الإمبريالية تؤدي حتمًا إلى صراعات بين القوى، وفي نهاية المطاف إلى الحرب.
لقد أصبح النضال ضد العسكرة والإمبريالية محورًا أساسيًا في عصرنا. نحن نعارض بشدة الحروب الإمبريالية والإمبريالية، لكننا لسنا مسالمين. يجب أن نؤكد أن السبيل الوحيد لضمان السلام هو القضاء على النظام الرأسمالي المُولِّد للحرب.
• الرأسمالية الأوروبية تتدافع لإعادة التسلح
وفي حالة أوروبا، فإن التوجه نحو العسكرة والإنفاق على الأسلحة هو نتيجة لتعزيز الإمبريالية الروسية مع خروجها منتصرة من الحرب في أوكرانيا، وسحب الدعم العسكري الأميركي، ومحاولة القوى الأوروبية إظهار أنها لا تزال تلعب دوراً في الساحة العالمية.بلغ الإنفاق العسكري الروسي لعام 2024 حوالي 13.1 تريليون روبل (145.9 مليار دولار)، وهو ما يمثل 6.68% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ويمثل هذا زيادةً بنسبة تزيد عن 40% مقارنة بالعام السابق. وعند تعديله وفقًا لتعادل القوة الشرائية، يبلغ هذا الرقم حوالي 462 مليار دولار.
في غضون ذلك، زادت أوروبا إنفاقها العسكري بشكل ملحوظ بنسبة 50% بالقيمة الاسمية منذ عام 2014، ليصل إجماليه إلى 457 مليار دولار أمريكي في عام 2024. في هذه الحالة، يُعدّ تعديل الرقم الروسي للقدرة الشرائية أمرًا منطقيًا، لأن ما نقارنه هو كمية الدبابات والمدفعية والذخيرة التي يمكن شراؤها مقابل كل دولار، في روسيا وأوروبا. بمعنى آخر، تنفق روسيا على الجيش أكثر من أوروبا بأكملها.
تتفوق روسيا أيضًا على حلف الناتو بأكمله، بما في ذلك الولايات المتحدة، من حيث إنتاج الذخيرة والصواريخ والدبابات. ووفقًا لتقديرات استخبارات الناتو، تنتج روسيا 3 ملايين ذخيرة مدفعية سنويًا. في حين أن حلف الناتو بأكمله، بما في ذلك الولايات المتحدة، لديه القدرة على إنتاج 1.2 مليون فقط، أي أقل من نصف الرقم الروسي.علاوة على ذلك، غيّرت الحرب في أوكرانيا أسلوب إدارة الحرب بشكل كامل. وكما هو الحال دائمًا، تتيح الحرب اختبار تقنيات وأساليب جديدة في ظروف واقعية، والتي تُحفّز وتُكيّف بسرعة مع ساحة المعركة. تُجبر الجيوش المقاتلة على تطوير وسائل وتكتيكات سريعة لمواجهتها. لقد شهدنا إدخال أعداد كبيرة من الطائرات المسيّرة (جوية، برية، وبحرية)، وتقنيات المراقبة الإلكترونية والتشويش، وغيرها.
الجيشان الوحيدان اللذان يمتلكان خبرة عملية في استخدام هذه الأساليب الجديدة هما جيشا أوكرانيا وروسيا. الغرب متأخرٌ جدًا في جميع هذه المجالات. لقد غيّرت حرب أوكرانيا ميزان القوى العسكري بشكل جذري لصالح روسيا.
هذا لا يعني أن لروسيا مصلحة في غزو أوروبا، ولا حتى جزء منها. لقد ضخّمت الطبقة الحاكمة هذا التهديد المزعوم بشكل كبير لتبرير زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري، وفي محاولة للحد من المعارضة الشعبية. لا مصلحة لروسيا في غزو غرب أوكرانيا - وهو مشروع أكثر تكلفةً وإرهاقًا بكثير من الحملة العسكرية الروسية الحالية - ناهيك عن غزو دول الناتو.من وجهة نظر الرأسمالية الأوروبية، لا يتمثل التهديد في الواقع في غزو روسي أو صراع عسكري مفتوح بين الجيوش الروسية والأوروبية. فهذا سيكون مكلفًا للغاية لكلا الجانبين. علاوة على ذلك، سيتضمن امتلاك كلا الجانبين للأسلحة النووية، وهو أمر بالغ الخطورة.
إن التهديد الحقيقي للإمبريالية الأوروبية في الأزمة هو أن يتم التخلي عنها أو تخفيض مرتبتها من قبل أكبر قوة إمبريالية في العالم، وفي الوقت نفسه تصبح جارة لإمبريالية قوية أخرى، والتي تخرج من الحرب الحالية معززة بشكل كبير.
تتمتع روسيا بنفوذ كبير (عسكريًا وموارد طاقة)، وتمارس بالفعل نفوذًا قويًا على الساحة السياسية الأوروبية. وقد انشقّت دول مثل المجر وسلوفاكيا عن التوجه الأطلسي للقوى الأوروبية المهيمنة. وفي دول أخرى، هناك قوى سياسية تتحرك في اتجاه مماثل بدرجة أو بأخرى (ألمانيا، النمسا، رومانيا، جمهورية التشيك، إيطاليا)إن ما تدافع عنه الإمبريالية الأوروبية ليس أرواح شعوب أوروبا ومنازلها، بل أرباح شركاتها متعددة الجنسيات والطموحات الإمبريالية الاستغلالية لطبقاتها الرأسمالية الحاكمة. روسيا منافسة للرأسمالية الألمانية في أوروبا الشرقية والوسطى، وخصم للإمبريالية الفرنسية في أفريقيا.الأزمة طويلة الأمد للرأسمالية الأوروبية تعني أنه بمجرد سحب حماية الولايات المتحدة، لن تتمكن من الاعتماد على نفسها. إنها مهددة بالانقسام بين المصالح المتنافسة للولايات المتحدة وروسيا والصين. تتزايد النزعات الطاردة المركزية قوةً، حيث تبدأ كل طبقة رأسمالية في تأكيد مصالحها الوطنية. وليس من المستبعد إطلاقًا أن تؤدي هذه النزعات في النهاية إلى تفكك الاتحاد الأوروبي.
• الاقتصاد العالمي: من العولمة إلى الحروب التجارية والحمائية
شكّل فرض ترامب تعريفات جمركية واسعة النطاق في الثاني من أبريل نقطة تحول في الاقتصاد العالمي. لكن عملية تباطؤ العولمة والتوجه نحو الحمائية كانت قد بدأت قبل ذلك.
كان الركود العالمي عام ٢٠٠٨ نقطة تحول في الأزمة الرأسمالية. في الفترة التي سبقت الأزمة مباشرةً، كان الاقتصاد العالمي ينمو بمعدل ٤٪ سنويًا. بين أزمة ٢٠٠٨ وصدمة جائحة ٢٠٢٠، لم يتجاوز معدل النمو ٣٪. قبل فرض ترامب للرسوم الجمركية، كان الاقتصاد العالمي يتجه نحو ٢٪، وهو أدنى معدل نمو له منذ ثلاثة عقود.في الواقع، لم يتعافَ الاقتصاد العالمي قط من ركود عام ٢٠٠٨. كانت هناك عمليات إنقاذ ضخمة للبنوك آنذاك، في إجراءٍ يائسٍ لإنقاذ القطاع المالي. تراكمت ديونٌ هائلةٌ وعجزٌ في الميزانيات على الدول الأوروبية، واضطرت إلى تطبيق إجراءات تقشفية. أُجبرت الطبقة العاملة على دفع ثمن أزمة الرأسمالية.
استجابت الطبقة الحاكمة، في حالة من الذعر، ببرنامج ضخم من التيسير الكمي، وضخّ مبالغ طائلة في الاقتصاد، وخفض أسعار الفائدة إلى الصفر أو حتى إلى الصفر. إلا أن ذلك لم يُسفر عن انتعاش، إذ أثقلت الديون كاهل الأسر. ولم يكن هناك مجال استثماري إنتاجي في الإنتاج، فضخّمت السيولة الفائضة فقاعات في أسعار الأسهم والعملات المشفرة، إلخ.
لقد أدت إجراءات التقشف التي طبقتها الحكومات في كل مكان إلى حركات جماهيرية في جميع أنحاء العالم في عام 2011:
"الثورة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وحركة احتلوا وول ستريت في الولايات المتحدة، وحركة "السخط" في إسبانيا، وحركة ساحة "سينتاجما" في اليونان، وغيرها".
عكس ذلك استياءً متزايدًا من النظام الرأسمالي الذي كان يُحمّل الطبقة العاملة تكاليف إجراءات إنقاذ البنوك، مما أدى إلى تشويه سمعة جميع المؤسسات البرجوازية. وقد وجد هذا التغيير في الوعي - كما رأينا - تعبيرًا سياسيًا في صعود نوع جديد من الإصلاحية اليسارية حوالي عام ٢٠١٥: بوديموس، سيريزا، كوربين، ميلينشون، ساندرز، و"الحكومات التقدمية" في أمريكا اللاتينية.
انجذبت الجماهير إليهم لمعارضتهم الجذرية الواضحة للتقشف. وانتهت هذه العملية عندما انكشفت حدود الإصلاحية: بخيانة حكومة سيريزا في اليونان؛ ودعم ساندرز لكلينتون؛ وانهيار الكوربينية؛ ودخول بوديموس في حكومة ائتلافية في إسبانيا.
في البلدان الخاضعة لهيمنة الإمبريالية، شهدنا انتفاضاتٍ وتمرداتٍ جماهيرية (في بورتوريكو، وهايتي، والإكوادور، وتشيلي، والسودان، وكولومبيا، وغيرها). وكانت التعبئة الجماهيرية خلال النضال من أجل الجمهورية في كاتالونيا عامي ٢٠١٧ و٢٠١٩ جزءًا من هذا التوجه العام نفسه.ولكن الافتقار إلى القيادة كان يعني أن أياً من هذه الثورات لم تنتهِ بالإطاحة بالرأسمالية، وهو الأمر الذي كان ممكناً.مثّلت جائحة كوفيد-19 في عام 2020 صدمةً خارجيةً للاقتصاد في وقتٍ كان يتجه فيه بالفعل نحو ركودٍ جديد (بعد أن لم يتعافَ تمامًا من أزمة عام 2008). وقد دفع هذا الاقتصاد العالمي أخيرًا إلى حافة الهاوية.
مرة أخرى، وفي حالة ذعر، لجأت الطبقة الحاكمة إلى تدابير يائسة لمنع انفجار اجتماعي. في الدول الرأسمالية المتقدمة، دفعت الدولة للعمال أجورًا للبقاء في منازلهم، مما أثقل كاهل المالية العامة، المثقلة أصلًا بديون الأزمة السابقة.
على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، فشلت المحاولات المتكررة لإنعاش الاقتصاد العالمي بضخ كميات هائلة من السيولة في النظام المالي، عبر التيسير الكمي، وأسعار الفائدة المنخفضة القياسية (2009-2021)، وغيرها من التدابير المذعورة المماثلة، فشلاً ذريعاً في تحقيق أي نمو اقتصادي ملموس. ورغم غزارة الأموال التي تُغدَق على الرأسماليين، إلا أنهم لم يستثمروا.
كان العامل الرئيسي هو حاجة الرأسماليين إلى سوقٍ لبيع منتجاتهم لتحقيق الأرباح. فالتراكم الهائل للديون يعني عجز الأسر والشركات عن تحفيز الاستهلاك.
بلغ مجموع ديون الأسر والدولة والشركات في العالم نحو 313 تريليون دولار، أو 330% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ارتفاعا من نحو 210 تريليون دولار قبل عقد من الزمان.إن الدين هو انعكاسٌ لحقيقة أن حدود النظام قد استُنزفت إلى حدّها الأقصى، وباتت تُشكّل عائقًا هائلًا أمام أي تطور إضافي. وقد أدّى الجمع بين ارتفاع مستويات الدين العام وارتفاع أسعار الفائدة إلى دفع سلسلة من الدول المُهيمنة إلى حافة الهاوية. وسيتبعها المزيد.وكان للوباء تأثير على الوعي أيضًا، حيث كشف عن عجز النظام الرأسمالي القائم على الربح الخاص عن التعامل مع حالة طوارئ صحية، وكيف جاءت الأرباح قبل حياة الإنسان بالنسبة لشركات الأدوية العملاقة.في تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية الثانية، شهد الاقتصاد العالمي نموًا ملحوظًا، وإن كان معدل النمو أقل بكثير مما كان عليه خلال فترة ازدهار ما بعد الحرب العالمية الثانية (1948-1973)، التي شهدت تطورًا ملحوظًا في القوى الإنتاجية. علاوة على ذلك، استند النمو الاقتصادي في الفترة التي سبقت عام 2008 إلى توسع الائتمان و"العولمة". وقد سمح هذا للنظام بتجاوز حدوده، جزئيًا ولفترة من الزمن. وقد مثّلت العولمة توسع التجارة العالمية، وخفض الحواجز الجمركية، وتخفيض أسعار السلع الاستهلاكية، وفتح أسواق ومجالات استثمار جديدة في الدول الخاضعة لهيمنة الإمبريالية.
الآن، انقلبت كل هذه العوامل إلى نقيضها. فتحوّل توسّع الائتمان والسيولة إلى جبل من الديون.كانت العولمة (توسع التجارة العالمية) أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي لفترة طويلة بعد انهيار الستالينية في روسيا، وعودة الرأسمالية في الصين واندماجها في الاقتصاد العالمي. أما الآن، فما نشهده هو حواجز جمركية وحروب تجارية بين جميع الكتل الاقتصادية الرئيسية (الصين، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة)، حيث يسعى كلٌّ منها إلى إنقاذ اقتصاده على حساب الآخرين.في عام 1991، مثلت التجارة العالمية 35% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو رقم ظل دون تغيير إلى حد كبير منذ عام 1974. ثم بدأت فترة من النمو الحاد حتى بلغت ذروتها عند 61% في عام 2008. ومنذ ذلك الحين ظلت راكدة.قبل جولة التعريفات الجمركية الأخيرة، توقع صندوق النقد الدولي نمو التجارة العالمية بنسبة 3.2% فقط سنويًا على المدى المتوسط، وهي وتيرة أقل بكثير من متوسط نموها السنوي للفترة 2000-2019، البالغ 4.9%. لم يعد توسع التجارة العالمية محركًا للنمو الاقتصادي كما كان في الماضي. الآن، انعكست العملية برمتها.كان الميل نحو الحمائية، أحد أعراض أزمة الرأسمالية، يتزايد منذ فترة. في عام ٢٠٢٣، طبقت الحكومات حول العالم ٢٥٠٠ إجراء حمائي (حوافز ضريبية، ودعم موجه، وقيود تجارية)، وهو ما يزيد ثلاثة أضعاف عن العدد المسجل قبل خمس سنوات.خلال رئاسة ترامب الأولى، تبنت الولايات المتحدة موقفًا حمائيًا صارمًا، ليس فقط تجاه الصين، بل أيضًا تجاه الاتحاد الأوروبي، وهي سياسة استمرت في عهد بايدن. سنّ بايدن سلسلة من القوانين (مثل قانون تشيبس، وما يُسمى بقانون خفض التضخم، وغيرها) وتدابير تهدف إلى تعزيز الإنتاج الأمريكي على حساب الواردات من بقية العالم. منذ إعادة انتخاب دونالد ترامب، تسارعت جميع التوجهات نحو الحمائية بشكل حاد، مما أدى الآن إلى حرب تجارية مفتوحة.سيُشكّل تصاعد الحمائية وتطبيق الرسوم الجمركية صدمةً أخرى للاقتصاد العالمي، عقب الجائحة وحرب أوكرانيا. وسيُفاقم هذا من الضغوط التضخمية المُستمرة في الاقتصاد، بالإضافة إلى عجز الموازنة، والإنفاق العسكري، والتغيرات الديموغرافية، وتغير المناخ، كما سيُضعف الطلب.مع ذلك، فإن الوضع الاقتصادي هش للغاية. وهناك احتمال لحدوث ركود اقتصادي جديد في الفترة المقبلة، بل لا يُستبعد حتى حدوث كساد اقتصادي.
• رسوم ترامب الجمركية
إن انعطاف ترامب الحاد نحو الحمائية وحربه التجارية المفتوحة مع الصين هو أحد أعراض أزمة الرأسمالية الأمريكية. هذا يعني إدراكًا منه أن شركات التصنيع الأمريكية لا تستطيع المنافسة في السوق العالمية دون تدخل الدولة. في الوقت نفسه، تُعدّ الحمائية وسيلةً تستخدمها الدول الرأسمالية المتنافسة لإجبار الدول الأخرى على دفع ثمن الأزمة. فشعار "أمريكا أولاً" يعني بالضرورة "الجميع في النهاية"يسعى ترامب، من خلال إجراءاته الحمائية واسعة النطاق، إلى تحقيق عدة أهداف. 1) فرض قيود على استيراد السلع المصنعة، وبالتالي إعادة فرص العمل في قطاع التصنيع إلى الولايات المتحدة. 2) وقف صعود الصين كمنافس اقتصادي. 3) استخدام عائدات الرسوم الجمركية لتخفيف عجز الموازنة الأمريكية، بما يسمح له بالاحتفاظ بالتخفيضات الضريبية. 4) استخدام الرسوم الجمركية كورقة مساومة في المفاوضات مع الدول الأخرى لانتزاع تنازلات سياسية واقتصادية.صحيح أن بعض الشركات أعلنت عن استثمارات في الولايات المتحدة كوسيلة للالتفاف على الرسوم الجمركية والحفاظ على الوصول إلى السوق الأمريكية (أكبر سوق استهلاكية في العالم). لكن إنشاء مصانع جديدة عملية تستغرق بعض الوقت، ومن المرجح أن يُعوّض التأثير قصير المدى للرسوم الجمركية على سلاسل التوريد أي مكاسب في خلق وظائف جديدة.اليوم، وبعد 30 عامًا من العولمة، أصبحت سلاسل التوريد طويلة للغاية، حيث تتخصص مختلف الدول في جوانب مختلفة من العملية الإنتاجية. وتتميز صناعة السيارات في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بتكاملها الشديد، حيث تعبر قطع الغيار الحدود عدة مرات قبل تجميعها على مراحل في دول مختلفة. وسيكون لأي تحرك نحو تقصير خطوط التوريد تأثيرٌ مُزعزعٌ للاقتصاد فورًا، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات أو حتى ندرة وجودها في بعض الحالات. كما أن حالة عدم اليقين الناجمة عن استخدام ترامب للرسوم الجمركية كأداة تفاوضية لها تأثيرٌ سلبي على قرارات الاستثمار.الاقتصادان الأمريكي والصيني متشابكان بشدة ويعتمدان على بعضهما البعض. بالنسبة للولايات المتحدة، لا يوجد حاليًا بديل عملي للصناعة الصينية، فالسلع الصينية بأسعار معقولة وجودة عالية. ومن المرجح أن تُلحق جهود إخراجها من السوق الأمريكية، كما يسعى ترامب، ضررًا اقتصاديًا جسيمًا قبل وقت طويل من بدء أي انتعاش للصناعة الأمريكية، إن تحقق أصلًا.
أي محاولة لفك هذه العلاقة ستكون لها عواقب سلبية على الاقتصاد العالمي ككل. لنتذكر أنه بعد عام ١٩٢٩، كان هناك تحول عام نحو الحمائية التجارية، مما دفع العالم من الركود الاقتصادي إلى الكساد. انخفض حجم التجارة العالمية بنسبة ٢٥٪ بين عامي ١٩٢٩ و١٩٣٣، وكان جزء كبير من ذلك نتيجة مباشرة لزيادة الحواجز التجارية.لفترة طويلة، سمحت العولمة للنظام الرأسمالي بتجاوز حدود الدولة القومية جزئيًا ومؤقتًا. تُمثل الحمائية محاولةً لحصر القوى الإنتاجية في الحدود الضيقة للدولة القومية، بهدف إعادة ترسيخ هيمنة الإمبريالية الأمريكية على الآخرين. وكما حذّر تروتسكي في ثلاثينيات القرن الماضي:
على جانبي الأطلسي، تُهدر جهودٌ فكريةٌ لا يستهان بها في محاولة حلِّ المعضلةِ العويصة المتمثلة في كيفيةِ إعادةِ التمساحِ إلى بيضةِ الدجاجة. القوميةُ الاقتصاديةُ الحديثةُ محكومٌ عليها بالزوالِ لا محالةَ بطابعِها الرجعيِّ؛ فهي تُعيقُ وتُخفِّضُ القوى الإنتاجيةَ للإنسان. ( القوميةُ والحياةُ الاقتصادية ، ١٩٣٤)كما كان متوقعًا، يستجيب قادة النقابات العمالية في كل مكان للحمائية بالاصطفاف خلف طبقاتهم الحاكمة "دفاعًا عن الوظائف" في بلدانهم. يجب على الشيوعيين أن يتبنوا وجهة نظر طبقية أممية مستقلة. عدو الطبقة العاملة هو الطبقة الحاكمة، وبالأخص طبقتنا المحلية، وليس عمال البلدان الأخرى.في مواجهة إغلاق المصانع، علينا أن نرفع شعار الاحتلال. بدلًا من المزيد من عمليات الإنقاذ الحكومية للشركات الخاصة، نطالب بفتح الحسابات والتأميم تحت سيطرة العمال. إذا لم تتمكن المصانع من تحقيق الربح في ظل الرأسمالية، فيجب مصادرتها وإعادة تأهيلها وتوظيفها لتحقيق أغراض اجتماعية نافعة، في ظل خطة إنتاج ديمقراطية. لا التجارة الحرة ولا الحمائية في مصلحة الطبقة العاملة. هاتان سياستان اقتصاديتان مختلفتان تحاول من خلالهما الطبقة الحاكمة التعامل مع أزمات الرأسمالية. بديلنا هو إسقاط النظام الذي يسببها.
• أزمة شرعية المؤسسات البرجوازية
إن أزمة الرأسمالية، كنظام اقتصادي غير قادر الآن على تطوير القوى الإنتاجية إلى أي درجة كبيرة، وبالتالي غير قادر على تحسين مستويات المعيشة من جيل إلى جيل، أدت إلى أزمة عميقة ومتنامية في شرعية جميع المؤسسات السياسية البرجوازية.هناك استقطاب فاحش للثروة، مع قيام حفنة صغيرة من المليارديرات بزيادة أصولهم، في حين يجد عدد متزايد من أفراد الطبقة العاملة صعوبة متزايدة في تلبية احتياجاتهم ويواجهون تخفيضات التقشف، والقدرة الشرائية للأجور التي تلتهمها التضخم، وزيادة فواتير الطاقة، وأزمة الإسكان، وما إلى ذلك.
إن وسائل الإعلام، والسياسيين، والأحزاب السياسية القائمة، والبرلمانات، والقضاء، كلها يُنظر إليها على أنها تمثل مصالح نخبة صغيرة متميزة، وتتخذ القرارات للدفاع عن مصالحها الأنانية الضيقة بدلاً من خدمة احتياجات الكثيرين.
هذا أمر بالغ الأهمية، إذ تحكم الطبقة الحاكمة في الأوقات العادية من خلال هذه المؤسسات، التي يُنظر إليها عمومًا على أنها تُمثل "إرادة الأغلبية" أما الآن، فقد أصبح هذا الأمر موضع تساؤل من قِبَل شرائح متزايدة من المجتمع.
بدلاً من الآلية المعتادة للديمقراطية البرجوازية، التي تعمل على تخفيف حدة التناقضات الطبقية، يزداد قبول فكرة العمل المباشر لتحقيق الأهداف. حذّر مقال في صحيفة لوموند ماكرون في فرنسا من أنه بمنعه الحزب الحائز على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية من تشكيل حكومة، يُخاطر بأن يستنتج الشعب أن الانتخابات لا جدوى منها. في الولايات المتحدة، يعتقد واحد من كل أربعة أن العنف السياسي قد يكون مُبررًا "لإنقاذ" البلاد، بزيادة عن 15% قبل عام. في هذا الصدد، من المهم تسليط الضوء على تزايد النزعات الإرهابية في الولايات المتحدة. ففي غضون بضعة أشهر، شهدنا مقتل الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد هيلث كير على يد لويجي مانجيوني، كوسيلة للتنديد بإساءة معاملة شركات الرعاية الصحية الخاصة الكبرى، ومقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن على يد ناشط مؤيد للفلسطينيين، ومقتل عضوة في الكونغرس من الحزب الديمقراطي وزوجها في مينيسوتا، بالإضافة إلى هجوم آخر في اليوم نفسه على سيناتور ديمقراطي، أيضًا في مينيسوتا. هذه الأخيرة ارتكبها متعصبون يمينيون. هذه الظاهرة المتكررة للإرهاب السياسي في الولايات المتحدة تُعبّر عن القلق العميق والتناقضات الهائلة التي تهزّ المجتمع الأمريكي.إن صعود الديماغوجيين المناهضين للمؤسسة دليل على تآكل شرعية الديمقراطية البرجوازية ومؤسساتها. في الماضي، عندما تفقد حكومة يمينية مصداقيتها، تُستبدل بحكومة "يسارية" ديمقراطية اجتماعية، وعندما تفقد هذه الحكومة مصداقيتها، تُستبدل بحكومة محافظة. لم تعد هذه العملية تلقائية.بل هناك تقلبات عنيفة يسارًا ويمينًا، تُصوَّر في وسائل الإعلام على أنها تنامي "التطرف السياسي". لكن تنامي التطرف في السياسة ليس إلا تعبيرًا عن عملية الاستقطاب الاجتماعي والسياسي، التي تُمثل بدورها انعكاسًا لاشتداد الصراع الطبقي. إن انهيار المركز السياسي الناتج عن ذلك هو ما يُثير الرعب في نفوس الطبقة الحاكمة. فهم يرغبون في إيقافه بكل الوسائل المتاحة لهم، لكنهم عاجزون عن ذلك.ليس من الصعب إدراك سبب ذلك. فالحكومات اليمينية واليسارية اليوم تُطبّق سياسات التخفيضات والتقشف نفسها. وهذا يُؤدي إلى فقدان الثقة بالسياسة بشكل عام، وتزايد مُطرد في الامتناع عن التصويت، وظهور بدائل متنوعة من أحزاب ثالثة، غالبًا ما تكون عابرة. وقد تمكّن الديماغوجيون اليمينيون من استغلال المزاج المُعادي للمؤسسة الحاكمة، أيضًا بسبب عجز "اليسار" الرسمي عن تقديم أي بديل حقيقي.إن صراخ المؤسسة الرأسمالية الليبرالية حول "خطر الفاشية" و"تهديد اليمين المتطرف" يهدف إلى حشد الدعم لفكرة الشرور الأقل، أي فكرة "علينا جميعًا أن نتحد للدفاع عن الديمقراطية"، و"الدفاع عن الجمهورية". هذا في وقتٍ يسيطر فيه الليبراليون على السلطة في معظم الدول، ويشنون هجمات على الطبقة العاملة، ويؤججون النزعة العسكرية... ويهاجمون الحقوق الديمقراطية.وهكذا يُوصف ترامب بأنه "فاشي" أو "سلطوي" عندما ينتهج سياسة طرد غير المواطنين لدعمهم فلسطين. فماذا نُسمي إذن حكومات الدول الأوروبية التي حظرت وقمعت المظاهرات المؤيدة لفلسطين بوحشية؟ ماذا نُسميها عندما يُعتقل غير المواطنين في ألمانيا وفرنسا ويُرحّلون لدعمهم فلسطين؟يستغلّ الليبراليون المحاكم لتطبيق إجراءات غير ديمقراطية تمامًا لمنع السياسيين الذين لا يعجبهم من الترشح للانتخابات (مثل لوبان في فرنسا)، أو، كما في حالة رومانيا، لإلغاء الانتخابات عندما لا تروق لهم النتيجة! ثم يلتفتون ويدعون إلى "الوحدة للدفاع عن الديمقراطية" و" الحصار الصحي ضد اليمين المتطرف"وهذه سياسة إجرامية، تعمل في واقع الأمر على زيادة الدعم للديماغوجيين اليمينيين الذين يستطيعون أن يقولوا بعد ذلك: "انظروا، اليمين واليسار، كلهم نفس الشيء"سوف يقاوم الشيوعيون أي إجراء رجعي ضد مصالح الطبقة العاملة وضد الحقوق الديمقراطية، ولكن سيكون من المميت أن يُنظر إليهم بأي شكل من الأشكال على أنهم يدعمون "الديمقراطية" بشكل عام (وهو ما يعني دعم الدولة الرأسمالية) أو أن يخلطوا اللافتات مع الليبراليين عندما يهاجمون الديماغوجيين اليمينيين.في الواقع، سيكشف جاذبية الديماغوجيين اليمينيين دائمًا عن زيفها بقدر ما تتعارض مع الواقع. ترامب في السلطة بالفعل في الولايات المتحدة، وقد قطع وعودًا كثيرة. إنه يستغل توقعات ملايين الناس الذين يعتقدون أنه سيعيد أمريكا عظيمةً مجددًا. لكن هذا وهمٌ محض. بالنسبة للطبقة العاملة، يعني "إعادة أمريكا عظيمةً مجددًا" وظائف لائقة بأجور جيدة. هذا يعني أنهم يستطيعون الوصول إلى نهاية الشهر دون أن يُجبروا على العمل في وظيفتين أو ثلاث وظائف مختلفة، أو أن يضطروا لبيع بلازما الدم لتغطية نفقاتهم.
هناك أوهام قوية لدى ملايين الأمريكيين بأن ترامب سيعيد "الأيام الخوالي" لما بعد الحرب العالمية الثانية. لكن المؤكد هو أن هذا لن يحدث. فأزمة الرأسمالية تعني أن العودة إلى العصر الذهبي لطفرة ما بعد الحرب، أو إلى ازدهار عشرينيات القرن الماضي، أمرٌ مستبعدٌ اليوم.ليس من المستبعد أن يكون لبعض هذه الإجراءات - على سبيل المثال، الرسوم الجمركية التي تُعزز التنمية الصناعية في الولايات المتحدة على حساب دول أخرى - تأثيرٌ طفيفٌ لفترةٍ وجيزة. كما سيُعطي الكثيرون ترامبَ فرصةً للشكّ لفترةٍ من الزمن. ويمكنه أيضًا التذرع بأن المؤسسة، "الدولة العميقة" هي التي تمنعه من تنفيذ سياساته.لكن بمجرد إدراك الواقع وتبدد هذه الأوهام، سيؤدي المزاج المتجذر المناهض للمؤسسة الذي دفع ترامب إلى السلطة إلى تحول حاد نحو الجانب الآخر من الطيف السياسي. وقد نشهد تأرجحًا حادًا وعنيفًا في اتجاه اليسار.
هناك مقال كتبه تروتسكي بعنوان " إذا ما أصبحت أمريكا شيوعية" ، حيث تحدث عن المزاج الأمريكي الذي وصفه بأنه "نشط وعنيف":
"سيكون مناقضًا للتقاليد الأمريكية إجراء تغيير كبير دون اختيار الجانبين وتكسير الرؤوس"العامل الأمريكي عملي ويطالب بنتائج ملموسة. إنه مستعد للتحرك لتحقيق الأهداف. فاريل دوبس، قائد إضراب سائقي الشاحنات الكبير في مينيابوليس عام ١٩٣٤، انتقل مباشرةً من كونه جمهوريًا إلى قائد تروتسكي. في روايته للإضراب، يشرح دوبس سبب ذلك. بالنسبة له، كان التروتسكيون هم من قدموا الحلول الأكثر عملية وفعالية في التعامل مع المشاكل التي واجهها العمال.
• وضع متفجر: تطرف الشباب
الحقيقة هي أن الوضع العالمي يزخر بإمكانيات ثورية. قُطعت جزئيًا موجة التمرد في عامي 2019 و2020 بسبب إجراءات الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19، لكن الظروف التي أشعلت فتيلها لم تختفِ. في عام 2022، أطاحت الانتفاضة في سريلانكا بالرئيس مع دخول الجماهير القصر الرئاسي. وضعت الإضرابات الجماهيرية ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا عام 2023 الحكومة في مأزق. في عام 2024، اقتحمت الجماهير في كينيا، بقيادة الشباب الثوري، البرلمان وأجبرت على سحب مشروع قانون المالية. في بنغلاديش، أدت حركة الشباب الطلابي، التي واجهت قمعًا وحشي، إلى انتفاضة وطنية والإطاحة بنظام حسينة المكروه.من السمات المشتركة بين جميع هذه الحركات الدور القيادي للشباب. فكل من لم يتجاوز الثلاثين من عمره عاش حياته السياسية الواعية في ظل ظروف اتسمت بأزمة ٢٠٠٨، وجائحة كوفيد-١٩، والحرب في أوكرانيا، ومجزرة غزة.شهدنا مؤخرًا تحركات جماهيرية واسعة النطاق في تركيا وصربيا واليونان. في حالة اليونان، أدى الغضب من التستر على كارثة قطار تيمبي، إلى جانب الغضب المتراكم من الإفقار الشامل الناتج عن التقشف الدائم والطريق المسدود للرأسمالية اليونانية، إلى إضراب عام حاشد وأكبر مظاهرات احتجاجية شهدتها البلاد منذ سقوط الديكتاتورية. إن الطابع الجماهيري للإضراب العام، الذي لم يقتصر على الطبقة العاملة فحسب، بل شمل أيضًا شرائح أخرى من المجتمع (أصحاب المتاجر الصغيرة، وغيرهم)، يُظهر توازن القوى الحقيقي في المجتمع الرأسمالي الحديث. فعندما تتحرك الطبقة العاملة، يمكنها أن تجذب خلفها جميع الشرائح المضطهدة.في صربيا، أحدثت حركة الاحتجاج على انهيار مبنى محطة نوفي ساد أزمة ثورية، حيث شهدت أكبر مظاهرة احتجاجية في تاريخ البلاد. لعب الطلاب دورًا حاسمًا، فاحتلوا الجامعات ونظموا احتجاجاتهم من خلال المجالس الطلابية، ويحاولون جاهدين نشر الحركة بين الطبقة العاملة وعامة الشعب من خلال تشكيل "زبوروفي" (zborovi) وهي تجمعات جماهيرية في البلدات والمدن، بالإضافة إلى بعض أماكن العمل. استمرت الحركة لأكثر من تسعة أشهر، حيث بائت جميع محاولات نظام فوتشيتش لإيقافها بنتائج عكسية، مما منحها زخمًا إضافيًا للاستمرار.إن هاتين الحركتين تبرزان سمتين أساسيتين للوضع الحالي: القوة الكامنة الهائلة التي تتمتع بها الطبقة العاملة ووزنها الاجتماعي المهيمن من جهة، والضعف الشديد للعامل الذاتي من جهة أخرى.
وعلاوة على ذلك، أصبحت فئات من الشباب متطرفة أيضاً بشأن قضايا الحقوق الديمقراطية، والحركة النسائية الجماهيرية ضد العنف والتمييز (المكسيك، إسبانيا)، ومن أجل حقوق الإجهاض أو الدفاع عنها (الأرجنتين، تشيلي، أيرلندا، بولندا)، ومن أجل زواج المثليين (أيرلندا)، والحركة الجماهيرية ضد وحشية الشرطة ضد السود (الولايات المتحدة وبريطانيا)، إلخ.لقد أصبحت أزمة المناخ أيضًا عاملًا متطرفًا بالنسبة لهذا الجيل من الشباب الذين يشعرون بقوة وبحق أنه ما لم تتغير الأمور جذريًا، فإن الحياة على الأرض معرضة للخطر وأن النظام هو المسؤول عن ذلك.
إن النفاق والمعايير المزدوجة التي تتبناها الإمبريالية فيما يتعلق بالمذبحة في غزة، وما يسمى بـ"القواعد الدولية" والقمع البوليسي لحركة التضامن مع فلسطين، قد فتحت أعينها على طبيعة الدولة الرأسمالية، ووسائل الإعلام الرأسمالية، والمؤسسات الدولية.في جميع هذه الحركات، نواجه طيفًا واسعًا من الأفكار، بما في ذلك النسوية والإصلاحية والستالينية والقومية. مهمتنا هي إرساء موقف طبقي، والوقوف بوضوح في بحر من ارتباك البرجوازية الصغيرة. لكن هذا دائمًا سؤال ملموس، ينطلق من الأفكار التي نواجهها، بالإضافة إلى المهام والأسئلة التي تطرحها الحركة نفسها. وحسب الظروف، نبدأ عادةً بطريقة ودية، بدءًا بالأمور التي نتفق عليها، ثم نشير إلى عدم كفاية الحلول المقترحة، ونربطها بالمهام الأوسع للنضال من أجل الاشتراكية. وكما قال لينين في أبريل 1917: "تقديم شرح صبور ومنهجي ومثابر لأخطاء تكتيكاتهم، شرح مُكيّف خصيصًا للاحتياجات العملية للجماهير"في الوقت نفسه، من الواضح أن شريحة متنامية من الشباب تُقرّ بالأفكار الشيوعية باعتبارها البديل الأكثر جذرية ضد النظام الرأسمالي، ويمكن الوصول إليها مباشرةً من خلال برنامجنا الكامل. هذه ليست أغلبية، حتى بين الشباب، ولكن هذا بلا شك تطورٌ مهم.لقد مرّ الآن 35 عامًا على انهيار الستالينية، لذا فإن دعاية الطبقة الحاكمة حول "فشل الاشتراكية" لا معنى لها بالنسبة لهذا الجيل. ما يقلقهم ويعانيه مباشرةً هو فشل الرأسمالية!.
• أزمة القيادة
هناك تراكمٌ للمواد القابلة للاشتعال في جميع أنحاء العالم. وقد أثارت أزمة النظام الرأسمالي، بكل مظاهرها، انتفاضةً ثوريةً تلو الأخرى. وما يُسمى بالنظام العالمي الليبرالي، الذي شكّل العالم لعقود، ينهار أمام أعيننا. ويؤدي اللجوء إلى الحمائية والحروب التجارية إلى اضطرابات اقتصادية هائلة.السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا ليس ما إذا كانت هناك حركات ثورية ستحدث في الفترة المقبلة. هذا مؤكد. السؤال هو: هل ستؤدي هذه الحركات إلى انتصار الطبقة العاملة؟لقد شهدنا عددًا من الحركات الثورية والانتفاضات على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية. وقد أظهرت هذهالحركات الحماس الثوري الهائل وقوة الجماهير بمجرد انطلاقها. لقد استطاعت التغلب على القمع الوحشي، وحالات الطوارئ، والتعتيم الإعلامي، والأنظمة الأكثر قمعًا. ولكن في نهاية المطاف، لم يُقد أيٌّ منها الطبقة العاملة إلى السلطة.
ما كان ينقص، في كل مناسبة، هو قيادة ثورية قادرة على إيصال الحركة إلى نهايتها المنطقية. انتهت ثورة 2011 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأنظمة بونابرتية قمعية (مصر وتونس)، أو ما هو أسوأ من ذلك، حروب أهلية رجعية (ليبيا وسوريا). أُعيد توجيه الانتفاضة التشيلية إلى المسار الآمن للدستور البرجوازي. وانتهت الثورة السودانية أيضًا بحرب أهلية رجعية تمامًا.
كتب تروتسكي في البرنامج الانتقالي أن:
"الأزمة التاريخية للبشرية تُختزل في أزمة القيادة الثورية" كلماته اليوم أصدق من أي وقت مضى. فالعامل الذاتي - أي تنظيم الكوادر الثورية المتجذرة في الطبقة العاملة - ضعيف للغاية مقارنةً بالمهام الجسيمة التي يفرضها التاريخ. لعقود، كنا نكافح ضد التيار، وتراجعنا بفعل تيارات موضوعية عاتية.هذا يعني حتمًا أن الأزمات الثورية القادمة لن تُحل على المدى القريب. لذلك، نواجه فترة طويلة من الصعود والهبوط، والتقدم والهزائم. لكن من خلال كل هذه العمليات، ستتعلم الطبقة العاملة وستتعزز طليعتها. أخيرًا، بدأ تيار التاريخ يتدفق في اتجاهنا، وسنتمكن من السباحة مع التيار، لا ضده.مهمتنا هي المشاركة، جنبًا إلى جنب مع جماهير الطبقة العاملة، وربط البرنامج المكتمل للثورة الاشتراكية بالتطلعات غير المكتملة للعناصر الأكثر تقدمًا من أجل تغيير ثوري أساسي.كان تأسيس الأممية الشيوعية الثورية عام ٢٠٢٤ خطوةً بالغة الأهمية، ولا ينبغي الاستهانة بما حققناه: منظمة دولية قائمة بثبات على النظرية الماركسية. في الفترة الأخيرة، ازداد عددنا بشكل ملحوظ. ومع ذلك، يجب أن نحافظ على التوازن: فقواتنا لا تزال غير كافية تمامًا للمهام المنتظرة.
إن ضعف العامل الذاتي يعني حتمًا أن تطرف الجماهير في الفترة القادمة سيتجلى في صعود وسقوط تشكيلات وقيادات إصلاحية يسارية جديدة. قد يستخدم بعضها خطابًا متطرفًا للغاية، لكنها جميعًا ستواجه القيود الأساسية للإصلاحية: عجزها عن طرح السؤال الأساسي المتعلق بإسقاط النظام الرأسمالي ووصول الطبقة العاملة إلى السلطة. لهذا السبب، الخيانة متأصلة في الإصلاحية. لكن لفترة من الزمن، ستُولّد بعض هذه التشكيلات والقادة حماسًا وتحظى بدعم جماهيري.يجب أن يكون هناك شعورٌ بالإلحاح في بناء المنظمة في كل مكان. فليس الأمرُ نفسه عندما تندلع الانتفاضات الجماهيرية من جديد. كان بإمكان منظمةٍ تضم ألفَ كادرٍ مُدرَّبٍ في بداية الثورة البوليفارية في فنزويلا، أو منظمةٌ تضم خمسةَ آلافِ كادرٍ متجذِّرٍ في الطبقة العاملة عندما فاز كوربين بقيادة حزب العمال في بريطانيا، أن تُغيِّر الوضع. على الأقل، لو اتبعت سياسةً ونهجًا صحيحين تجاه الحركة الجماهيرية، لكانت قد نمت لتصبح قوةً مؤثرةً داخل حركة الطبقة العاملة، وأن تُصبح مرجعًا لشرائحٍ أوسع.
في ظل الظروف المناسبة، وفي خضم الأحداث، يمكن حتى لمنظمة صغيرة نسبيًا أن تتحول إلى منظمة أكبر بكثير، وتناضل من أجل كسب قيادة الجماهير. هذا ما سيحدث في المستقبل. المهمة الآن هي العمل الدؤوب لتجنيد الكوادر، وقبل كل شيء تدريبها وتثقيفها، لا سيما بين شباب الطبقة العاملة والطلاب.
إن منظمة راسخة الجذور في الجماهير ومسلحة بالنظرية الماركسية ستكون قادرة على الاستجابة بسرعة للتحولات والانعطافات المتسارعة في الوضع. لكن القيادة الثورية لا يمكن ارتجالها بمجرد اندلاع الأحداث الثورية، بل يجب الاستعداد لها مسبقًا. هذه هي المهمة الأكثر إلحاحًا التي تواجهنا اليوم. على نجاحنا أو فشلنا يعتمد الوضع برمته في النهاية. يجب أن تكون هذه الفكرة المحرك الرئيسي لجميع أعمالنا وتضحياتنا وجهودنا. بالعزيمة والمثابرة اللازمتين، يمكننا أن ننجح، وسننجح.
نشربتاريخ6 يونيو 2025
*******
الملاحظات:
المصدر(مجلة دفاعا عن الماركسية)انجلترا.
رابط الدراسة التحليلية الأصلى بالانجليزية:
https://marxist.com/world-perspectives-2025.htm
رابط قسم وجهات نظر عالمية:
https://marxist.com/home/topics/world-perspectives.htm
رابط الصفحة الرئيسية لمجلة دفاعا عن الماركسية:
https://marxist.com/
-كفرالدوار5أغسطس2025.
#عبدالرؤوف_بطيخ (هاشتاغ)



ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

|
حفظ
 |
بحث |
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
| إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
مقال(موت الفنان؟)منظور ماركسي للفن المُولّد بالذكاء الاصطناع
...
-
العثورعلى وثيقة سوفيتية مفقودة تبرئ تروتسكي: لم يكن هناك حقً
...
-
مقال (البلشفية في مواجهة الستالينية )ليون تروتسكي.1937.
-
بيان (من أجل فن ثوري مستقل).ليون تروتسكى. 1938.
-
وثيقة سوفيتية مفقودة تبرئ تروتسكي: لم يكن هناك حقًا -بلشفي أ
...
-
[كراسات شيوعية ]بعض من كتابات تروتسكي عن الفن والأدب [Manual
...
-
نص سيريالى (رخام الروائح له أوردة متدفقة)عبدالرؤوف بطيخ.مصر.
-
تحديث:تعليقات من شيوعي فرنسى.بقلم ( بوريس سوفارين)ارشيف الما
...
-
نص سيريالى بعنوان(رخام الروائح له عروق متدفقة)عبدالرؤوف بطيخ
...
-
تعليقات من شيوعي فرنسى:بوريس سوفارين.ارشيف الماركسيينالقسم ا
...
-
نص سيريالى بعنوان(رخام الروائح له أوردة متدفقة)عبدالرؤوف بطي
...
-
قرار[1] اللجنة التنفيذية لحزب العمال الماركسي الموحد (poum)
...
-
قرار[2] اللجنة التنفيذية بشأن محاكمة تروتسكي:حزب العمال الما
...
-
مقال عن (الحركة النقابية الفرنسية) بقلم ألفريد روزمر(يوليو 1
...
-
مقدمة كتاب (الستالينية في إسبانيا) بقلم كاتيا لاندو .اسبانيا
...
-
مقال(الأساس الاجتماعي لثورة أكتوبر) بقلم: إيفغيني ألكسيفيتش
...
-
ينشر لأول مرة بالعربية(بيان صحفى بشأن -وصية- تروتسكي) بقلم ن
...
-
رسالة(فيودور راسكولينكوف) المفتوحة الى ستالين.1939.
-
مقال (الوضع الداخلى وطبيعة الحزب) بقلم كلا من:جيمس.P.كانون &
...
-
3رسائل حول انتفاضة كانتون .من (ليون تروتسكي الى.A.E. بريوبرا
...
المزيد.....
-
تضامنوا مع معرض دار مرايا للنشر
-
A Dangerous Attack on Free Speech: Matt Taibbi Sues for Defa
...
-
The Train of Regeneration: Green Peace for the Oases from Bé
...
-
After Bondi, Australia Faces a Foreign Policy Choice
-
Review of James Douglass’ Martyrs to the Unspeakable
-
ليسقط إرهاب الإسلام السياسي، الإيقاف الفوري للحملات العسكري
...
-
الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب تعلن تضامنها م
...
-
صور أوجلان ورموز -العمال الكردستاني- في مقار قسد.. ما دلالته
...
-
تيسير خالد : خيال دونالد ترامب واسع ... لكنه خيال مريض
-
The Streets of Iran Are Burning, and So Is the Myth of Stabi
...
المزيد.....
-
الرأسمالية والاستبداد في فنزويلا مادورو
/ غابرييل هيتلاند
-
فنزويلا، استراتيجية الأمن القومي الأميركية، وأزمة الدولة الم
...
/ مايكل جون-هوبكنز
-
نظريّة و ممارسة التخطيط الماوي : دفاعا عن إشتراكيّة فعّالة و
...
/ شادي الشماوي
-
روزا لوكسمبورغ: حول الحرية والديمقراطية الطبقية
/ إلين آغرسكوف
-
بين قيم اليسار ومنهجية الرأسمالية، مقترحات لتجديد وتوحيد الي
...
/ رزكار عقراوي
-
الاشتراكية بين الأمس واليوم: مشروع حضاري لإعادة إنتاج الإنسا
...
/ رياض الشرايطي
-
التبادل مظهر إقتصادي يربط الإنتاج بالإستهلاك – الفصل التاسع
...
/ شادي الشماوي
-
الإقتصاد في النفقات مبدأ هام في الإقتصاد الإشتراكيّ – الفصل
...
/ شادي الشماوي
-
الاقتصاد الإشتراكي إقتصاد مخطّط – الفصل السادس من كتاب - الإ
...
/ شادي الشماوي
-
في تطوير الإقتصاد الوطنيّ يجب أن نعوّل على الفلاحة كأساس و ا
...
/ شادي الشماوي
المزيد.....
|
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

 |
بحث
|
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
|
إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة