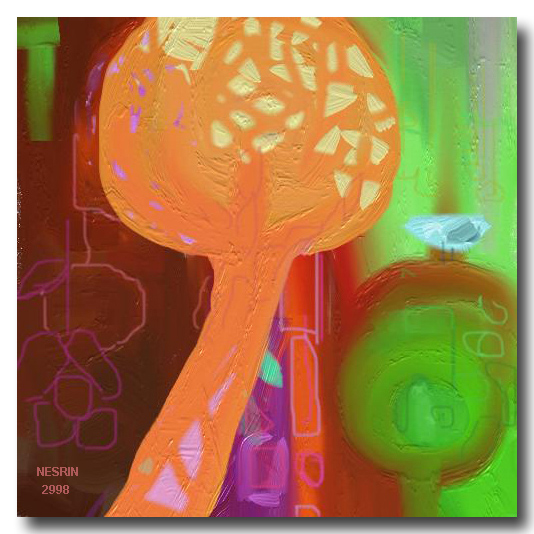|
|
دينٌ بلا وصاية ، وعي بلا خوف
سعد كموني
كاتب وباحث
(Saad Kammouni)


الحوار المتمدن-العدد: 8500 - 2025 / 10 / 19 - 16:13
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
دين بلا وصاية، وعي بلا خوف.
تأملات في حرية الضمير
أ.د. سعد كموني
في زمنٍ تتسارع فيه التحولات الثقافية والاجتماعية بوتيرةٍ تكاد تُذهل الوعي، وتتشابك فيه التيارات الفكرية الوافدة مع الهويات المحلية في نسيجٍ معقّد من التفاعل والتنافر، تبرز الحاجة الملحّة إلى إعادة التفكير في المرجعية الأخلاقية التي توجه الإنسان في اختياراته وسلوكياته. لم يعد السؤال الأخلاقي ترفًا فكريًا، بل أصبح ضرورة وجودية في عالمٍ تتداخل فيه القيم وتتنازع فيه المرجعيات، حتى بات الفرد معرّضًا للتيه بين ما يُطلب منه وما يريده، بين ما يُملى عليه وما يختاره بحرّيته.
هل القيم ثابتة وموروثة، تُنقل عبر الأجيال بوصفها جزءًا من الهوية الجمعية؟ أم أنها متغيرة، يُعاد تشكيلها تبعًا لسياق العمل، ومتطلبات الحياة، وتحديات العصر؟ وهل يمكن للتراث، بما يحمله من رمزية وعمق، أن يكون بوصلة معيارية تُرشد الإنسان دون أن يتحول إلى عبءٍ يُشعره بالذنب أو يُقيّده في خياراته؟ وهل النصّ المقدّس، لأنه نصٌّ مقدّسٌ، يوجّه الإنسان نحو غايات أخلاقية موضوعية تتجاوز السياق، أم أن هذا التوجيه ليس إلا انعكاسًا لحاجة الإنسان إلى الاجتماع والتنظيم، يُسقطها على النص في لحظة تأويل؟
هذه الأسئلة لا تبحث عن أجوبة حاسمة تُغلق باب التفكير، بل تفتح أفقًا رحبًا للتأمل في العلاقة الجدلية بين النص والواقع، بين الموروث والمعاصر، بين الحرية الأخلاقية والالتزام القيمي. إنها دعوة إلى مساءلة المفاهيم، لا إلى مصادقتها، وإلى إعادة بناء المرجعية الأخلاقية على أسسٍ من الوعي من دون وصاية؛ وعلى أسس من الحرية المسؤولة، من دون إكراهات الطاعة والخوف.
في هذا السياق، يصبح الحديث عن القيم والمرجعية الأخلاقية حديثًا عن الإنسان ذاته: عن قدرته على الاختيار، وعن حاجته إلى المعنى، وعن سعيه الدائم إلى التوازن بين الانتماء والتحرر، بين الأصالة والتجديد، وبين ما يُورث وما يُكتسب. فهل يمكن أن نعيد بناء هذه المرجعية بطريقةٍ تُنير الطريق دون أن تُضيّق الخُطى؟ وهل يمكن أن نُفعّل التراث والقرآن الكريم بوصفها مصادر إلهام، لا أدوات إلزام، تُحرّر الإنسان من الشعور بالذنب، وتمنحه أفقًا أخلاقيًا يختار فيه بحريةٍ ووعي؟
أولًا: القيم بين الثبات والتحول
القيم ليست كائنات جامدة تُحفظ في متاحف الذاكرة، بل هي مفاهيم حية تنبض في فضاء التفاعل بين الإنسان والواقع، وتتشكل باستمرار عبر جدلية المعنى والسياق. إنها ليست مجرد مبادئ أخلاقية تُلقّن، بل منظومات دلالية تتجدد في ضوء التجربة، وتُعاد صياغتها كلما تغيّرت وظيفة الإنسان في العالم.
من جهة، هناك من يرى أن القيم تُستمد من التراث، وتُحفظ على أنها جزء من الهوية الثقافية والدينية. هذه القيم، مثل الكرم، الأمانة، احترام الكبير، الوفاء، وغيرها، تُنقل عبر الأجيال لا بوصفها تعليمات سلوكية، بل بوصفها أنماطًا وجودية تُعبّر عن الانتماء، وتُشكّل الإطار المرجعي الذي يُقاس عليه الفعل الإنساني. في هذا التصور، تُحتسبُ القيم معيارًا للسلوك القويم، ومصدرًا للتماسك الاجتماعي، ووسيلةً لصون الهوية في وجه التغيرات.
لكن في المقابل، هناك من يرى أن القيم ليست ثابتة، بل تتغير تبعًا لسياق العمل، والتكنولوجيا، والعولمة. فالقيمة الأخلاقية اليوم قد تكون "المرونة"، أو "الابتكار"، أو "الشفافية"، وهي قيم لم تكن مركزية في المجتمعات التقليدية، لكنها أصبحت ضرورية في بيئات العمل الحديثة، حيث تُقاس الفاعلية لا بالامتثال، بل بالقدرة على التكيف، والتفكير النقدي، والانفتاح على الآخر.
هذا التوتر بين الثبات والتحول لا يُحلّ بالتفضيل بين أحد الطرفين، بل بفهم القيم، باحتسابها بنياتٍ تأويلية يُعاد صياغتها بحسب السياق، دون أن تفقد جوهرها؛ فالقيمة لا تُقاس بثباتها الزمني، بل بقدرتها على الاستمرار في توليد المعنى، وعلى التفاعل مع الواقع دون أن تُفرّط بذاتها.
إن الكرم، مثلًا، قد يُعاد تفسيره في سياق العمل على أنه "مشاركة المعرفة"، والأمانة قد تُترجم إلى "الشفافية الإدارية"، واحترام الكبير قد يتحول إلى "الاعتراف بالخبرة"، وهكذا تُفعّل القيم التراثية في سياقات جديدة، دون أن تُفرغ من مضمونها الأخلاقي.
لكن هذا التفعيل لا يتم تلقائيًا، بل يحتاج إلى وعي تأويلي يُدرك أن القيم ليست أوامر جاهزة، بل إمكانات مفتوحة، وأن الثبات لا يعني الجمود، كما أن التحول لا يعني الانفلات. فالقيم، في جوهرها، هي محاولة دائمة لتأسيس علاقة متوازنة بين الإنسان والعالم، بين الذات والآخر، بين الحرية والمسؤولية.
ولعلّ أخطر ما يُهدد القيم اليوم ليس التحول، بل الانفصال عن المعنى. حين تتحول القيم إلى شعارات تسويقية، أو أدوات نفعية، تُفقد قدرتها على التوجيه، وتتحول إلى قشرة بلا لبّ. لذلك، فإن التحدي الحقيقي ليس في الحفاظ على القيم كما هي، ولا في تغييرها كيفما اتفق، بل في إعادة وصلها بالمعنى، وإعادة تأويلها بما يُناسب السياق من دون التفريط بالجوهر.
في هذا الأفق، يمكن القول إن القيم ليست موروثة ولا مكتسبة فقط، بل هي مشروعٌ دائم، يُعاد بناؤه في كل لحظة، ويُختبر في كل موقف، ويُفعّل في كل علاقة. إنها ليست ما نُلقّن، بل ما نُجسّد، وما نُعيد التفكير فيه، وما نُقرّره بحرية ووعي.
ثانيًا: التراث بين المعيارية والحنين المرَضيّ
ليس التراثُ استعادةً عاطفيةً لماضٍ انقضى، ولا هو تعلّقٌ نوستالجيّ بذاكرةٍ متخيَّلة، بل هو حضورٌ فكريّ ومعنويّ مستمرّ، يمدّ الحاضر بجذوره ويمنح المستقبل توازنه. إنّه منظومة معرفيّة وأخلاقيّة تتجاوز حدود الزمان لتصبح مرجعًا معياريًا في بناء الوعي وتشكيل الرؤية. فالتراث، حين يُستعاد بوصفه تجربةً حيّة لا متحفًا ساكنًا، يتحوّل إلى طاقة تأويلية تتيح للإنسان فهم ذاته وتاريخه وعالمه في ضوء قيمٍ أصيلةٍ أثبتت قدرتها على البقاء والتحوّل في آنٍ معًا.
حين نقول إنّ التراث يوفّر بوصلةً قيمية، فإنّ المقصود ليس الإلزام باتّباع طريقٍ واحدٍ أو تكرار نماذج ماضية، بل تمكين الإنسان من امتلاك أدوات الفهم والمساءلة والاختيار. فالقيمة في التراث ليست وصايةً على الوعي، بل دعوةٌ إلى التبصّر بما يجعل الفعل الإنسانيّ ذا معنى. ومن هنا تتجلّى وظيفته التوجيهية: فهو لا يفرض شكلًا بعينه للحياة، بل يساعد على إدراك المضمون الأخلاقي للحياة ذاتها.
التراث في جوهره حمايةٌ من الذوبان شريطة أن لا يتحوّلَ تحصّنًا بالجمود، بل عبر امتلاك القدرة على التمييز بين الأصيل والدخيل، بين التفاعل والإلغاء. إنه لا يغلق الباب أمام التغيير، بل يفتح له الأفق حين يُؤسَّس على المعنى. فالمجتمع الذي يُدير ظهره لتراثه يفقد توازنه الرمزيّ، بينما الذي يتعلّق به تعلّقًا عاطفيًا أعمى يتحجّر ويتحوّل إلى ظلٍّ لتاريخه.
ومن هنا، فإنّ التعامل مع التراث لا يكتمل إلا بوعيٍ تأويليّ يَفصل بين ما هو جوهريّ خالد وما هو عرضيّ تاريخيّ. فليس كلّ ما ورثناه صالحًا للبقاء، ولا كلّ ما تخلّينا عنه دليلَ تحرّر. النقد هنا ليس فعل هدم، بل فعل إحياءٍ مبدع، إذ يُعيد للتراث حيويّته عبر قراءته في ضوء أسئلة الحاضر، لا عبر ترديد نصوصه.
إنّ التراثَ، حين يُفهم بهذه الروح، لا يكون عبئًا على النهضة، بل شرطًا من شروطها. فهو لا يقدّم أجوبةً جاهزة، بل يُعلّمنا فنّ السؤال، ولا يفرض معايير مغلقة، بل يُلهمنا بناء المعنى في عالمٍ يتسارع فيه التبدّل وتضطرب فيه المرجعيات. بذلك، يغدو التراث ليس ذكرى للماضي، بل ضميرًا للإنسان وهو يعيد تعريف ذاته في كلّ عصر.
🧠 ثالثًا: القرآن الكريم خطابًا توجيهيًّا
القرآن الكريم، في بنيته ومضمونه، خطاب يحمل توجيهًا نحو غايات أخلاقية ومعرفية. من أبرز ملامح هذا التوجيه:
1. الغايات القرآنية بين المقصد والتأويل: مقاربة أسلوبية ودلالية
إنّ الخطاب القرآني ــ في بنيته الكلية ــ لا يقدّم التوجيه الأخلاقي أو العمراني أو التوحيدي بوصفه أمرًا إجرائيًا أو موعظة عابرة، بل بوصفه تأسيسًا لرؤية كونية تندمج فيها الحقيقة بالقيمة، والعقيدة بالفعل، والمعرفة بالمسؤولية. فالآيات التي تُوجّه الإنسان نحو العدل أو الإحسان أو التعمير أو التوحيد، ليست مجرّد تعليمات أخلاقية، بل هي صيغ وجودية تُعيد تعريف علاقة الإنسان بالكون وبالآخر وبذاته.
1. الغاية الأخلاقية:
قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ﴾ (النحل: 90)، يُعَدّ من أكثر المواضع القرآنية اكتمالًا في بناء النسق القيمي.
أسلوبيًا، تقوم الآية على تركيب توازني يجمع بين أمرٍ ونهيٍ، فيُنشئ جدلية بين الإيجاب والسلب، بين ما يُبنى وما يُزال. ودلاليًا، يَرِدُ الأمر بالعدل قبل الإحسان لأن العدل قيمة نظامية تحفظ توازن المجتمع، بينما الإحسان قيمة تجاوزية تكمّل العدل بالرحمة. فالنظام الأخلاقي القرآني لا يقوم على الإلزام وحده، بل على السموّ الاختياريّ الذي يجعل الفعل الأخلاقي تجلّيًا للإيمان لا استجابةً للردع.
وهنا تتجلّى الغاية الأخلاقية بوصفها توحيدًا في مستوى السلوك، إذ يعكس الإحسان في الفعل ما يعبّر عنه التوحيد في العقيدة: نفيُ الأنانية وتحريرُ الوعي من النزعة المركزية للذات.
2. الغاية التوحيدية:
قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ (الإخلاص: 1-2)، وقوله: ﴿اللَّهُ لا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ (البقرة: 255)، يُظهران مركزية التوحيد أكثر مما يظهران الشعار الإيماني، مبدأ تنظيميّ للوجود. ففي سورة الإخلاص، يُقدَّم التوحيد في بنية لغوية مكثّفة ذات إيقاع تكراري يوحي بالإطلاق والدوام: "هو"، "أحد"، "صمد" — ثلاث كلمات تحصر الوجود في المطلق وتُنهي تعدّد المرجعيات.
أما في آية الكرسي، فالبنية تتجاوز العقيدة إلى الفعل الحضاري؛ إذ إن وصفه تعالى بأنه "القيّوم" يشير إلى قيام كلّ شيء به، أي إلى مبدأ التناغم الكونيّ الذي يُلزم الإنسان بتأسيس علاقته بالعالم على الاتساق لا على التنازع؛ فالغاية التوحيدية هي في جوهرها وعي بالعلاقة لا بالإيمان المجرّد، إنها تربية للإنسان على وحدة النظام، ووحدة المعنى، ووحدة المقصد، بحيث يصير الفعل البشري امتدادًا لمسؤولية الخلافة في الأرض.
3. الغاية العمرانية:
قوله تعالى: ﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ (هود: 61)، يحمل بنية لغوية مزدوجة تجمع بين النشأة والتكليف. فالفعل "أنشأكم" يُحيل على البعد الوجوديّ: خلق الإنسان من الأرض، أي ارتباطه بالمادة والطبيعة، بينما "استعمركم" يدل على بعدٍ غائيّ: أي طلب منكم العُمران، أي البناء الماديّ والمعنويّ للوجود.
ـ أسلوبيًا، إنّ قوله تعالى: ﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ (هود: 61) يحمل توازياً أسلوبيًا دقيقًا بين فعلين خبريين يجمعان في الدلالة بين الوجود والتكليف. فالفعل الأول "أنشأكم" يُحيل على الوجود التكوينيّ، أي فعل الخلق والإيجاد، بينما الفعل الثاني "استعمركم" يشير إلى الوجود الوظيفيّ، أي الإلزام بالعمل في الأرض وعمارتها. فكلا الفعلين خبرٌ عن فعلٍ إلهيّ، غير أن الفعل الثاني يتضمّن في بنيته معنى الطلب من حيث دلالة "استفعل" على الطلب، أي طلبَ منكم العُمران.
وبذلك يكون التحوّل من "أنشأكم" إلى "استعمركم" انتقالًا من مستوى الإخبار عن النشأة إلى الإشارة إلى الغاية منها، أي من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل. فالآية لا تكتفي بإثبات أصل الخلق، بل تُضمر تكليفًا مستترًا في الخبر، يقوم على معنى الأمانة والمسؤولية، وهو ما يتّسق مع قوله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ (البقرة: 30).
إذًا، ليست المسألة هنا تحوّلًا من الخبر إلى الإنشاء من حيث الصيغة النحوية، بل تحوّلٌ في المقام الخطابيّ من التوصيف الكونيّ إلى التوجيه المقصديّ. فالبنية الخبرية في القرآن ليست دائمًا محايدة، إذ كثيرًا ما تحمل طاقة إنشائية مضمرَة حين تتعلّق بالتكليف الإلهي أو بوظيفة الإنسان في الوجود. ومن ثمّ فإنّ "استعمركم" خبرٌ يُفصح عن أمرٍ، وإخبارٌ يتضمّن مسؤولية، ليغدو العمران في القرآن غاية وجودية لا مجرد فعلٍ نَفعيّ أو اقتصاديّ.
2. بين الموضوعية والإسقاط: أفق التأويل القرآني
يبقى السؤال: هل هذه التوجيهات موضوعية صادرة من النص، أم أنها انعكاس لإسقاطات الإنسان واحتياجاته التاريخية؟
الجواب لا يُختزل في أحد الطرفين، لأنّ النص القرآني يتجاوز الثنائية بين الذات والموضوع؛ فالمعنى في القرآن ليس معطًى جامدًا ولا إسقاطًا حرًّا، بل هو تفاعُل بين النص والقارئ. إنّ النص يحمل في بنيته إمكانات دلالية متعدّدة، لكنه يوجّه القارئ من خلال مقاصده الكلية نحو اتجاهٍ قيميّ معيّن.
من هنا، فإنّ الوعي التأويلي يقتضي التمييز بين ما هو تاريخي في القراءة وما هو مقاصدي في الخطاب؛ فالنص يُفهم بأدوات بشرية، لكنه لا يُختزل فيها، إذ تظلّ بنيته البلاغية والروحية تقاوم الاختزال الأيديولوجي وتعيد توجيه القارئ نحو المعنى المقصود.
وهكذا، لا يكون التوجيه القرآني وهمًا، بل حقيقة متجدّدة تتعيّن بتجدّد القراءة الواعية التي ترى في النص مجالًا للفهم لا ميدانًا للإسقاط، وفي الوحي منارةً للعقل لا نقيضًا له.
رابعًا: الحرية الأخلاقية دون شعور بالذنب
أن نمنح الإنسان حريةً أخلاقية دون أن نُثقل ضميره بعقدة الذنب، يعني أن نعيد تعريف الأخلاق نفسها بأنها ليست منظومة أوامر ونواهٍ، بل هي فضاءٍ للاختيار المسؤول؛ فالأخلاق في جوهرها ليست سلطة تُمارس على الوعي، بل قوة داخلية تُنظّم فعله انطلاقًا من علاقته بالخير والمعنى، اللذين يتنافيان مع القيد على الإرادة،كما يتنافيان مع العشوائية والعبثية والهوى.
ومن هنا، تتأسّس الحرية الأخلاقية في التصور القرآني على التوازن بين الضمير الحرّ والمسؤولية الواعية؛ فالخطاب القرآني ــ بخلاف ما اعتادته الأنماط الوعظية الزجرية ــ لا يستدرّ الشعور بالذنب بوصفه وسيلة للامتثال، بل يستثير قدرة الإنسان على التفكر والتبصّر. ومن تأمل قوله تعالى: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (البقرة: 44، آل عمران: 65، الأنعام: 32...)، و﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ (النساء: 82، محمد: 24)، يتبيّن أن النداء القرآني موجّه إلى الملكة العاقلة لا إلى الغريزة الخائفة. إنّ هذه الصياغات الاستفهامية تحريض بلاغيّ على التفكير، حيث يتحوّل السؤال إلى أداة لاستنهاض الوعي.
القرآن، في بنائه الخطابي، يعامل الإنسان في كونه كائنًا قادرًا على الفهم والتمييز، مؤتمنًا على حرّيته. ولهذا نجد أن البنية الأسلوبية لآيات كثيرة تعتمد على التنبيه الذهني. فبدل أن يقول: "اتّعظوا"، يقول: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (الرعد: 4)، فيربط الهداية بالفعل العقلي الذي لا يستقيم صراطه بالإكراه العاطفي.
من هنا تنبثق فكرة الحرية الأخلاقية في الإسلام بوصفها ممارسةً للوعي في ضوء قيمٍ مرجعية. فالتكليف في جوهره تأكيدٌ للحرية؛ لأنّ الإنسان لا يُكلّف إلا بقدر وعيه واختياره: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة: 286). إنّ هذه الآية تُعبّر عن احترامٍ إلهيّ لحدود الإنسان، أي اعتراف بأن الحرية الأخلاقية مشروطة بالقدرة على الفهم والتقدير.
وعليه، فالتربية القرآنية التي تقوم على بثّ الخوف أو ترسيخ الإحساس بالذنب، تقصي إمكان تكوين الضمير القادر على النقد الذاتي والانطلاق في رحابة الحياة، إنّها تربيةٌ تنقل الإنسان من الانقياد إلى الاختيار، ومن الطاعة الميكانيكية إلى المسؤولية التأملية، بحيث يصبح الفعل الأخلاقي ترجمةً للوعي لا استجابةً للتهديد.
وهكذا، حين يُخاطب القرآن الإنسان بقوله: ﴿فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ (الكهف: 29)، فهو لا يترك له الخيار عبثًا، بل يكرّسه كائنًا حرًّا أمام الحقيقة. فحرية الاختيار هنا ليست نفيًا للمعنى، بل شرطٌ لوجوده، لأنّ القيمة لا تُبنى إلا على وعيٍ حرٍّ ومسؤول.
بهذا الفهم، تتحوّل الأخلاق من سلطة تُراقب السلوك إلى حكمةٍ تُنظّم الوعي، ومن نظامٍ للجزاء إلى نظامٍ للمعنى. فلا يكون الدين هنا مصدرًا للشعور بالذنب، بل أفقٌ للتحرّر من الخوف والادّعاء، ومن ثمّ يصبح الإيمان فعلًا من أفعال الوعي.
خامسًا: نحو مرجعيةٍ أخلاقيةٍ متحرّرةٍ ومستنيرةٍ بالمعنى
أيعقل أن تكون المرجعية الأخلاقية قفصًا من الأوامر والنواهي؟
إنها أبعد من ذلك بكثير؛ هي نَفَسٌ في الوعي، وصدى في القلب، ومجال يتخلّق فيه الإنسان كلّما أصغى إلى نداء الخير فيه. المرجعية ليست سلطة تفرض أو تراقب، بل ضوءًا يُضيء طريق الضمير في العتمة، ويستفزّ الفكر ليبحث عن معنى فعله وجدواه. الأخلاق لا تُسقى بالخوف، بل تنمو في تربة الحرية، حيث يتحوّل الواجب إلى رغبة، والطاعة إلى اختيار. وعندما ندرك أن التراث والقرآن لا يحدّاننا بنمط واحد من السلوك، بل يفتحان أمامنا أفقًا للتفكّر والإبداع، نتحرّر من وهم الامتثال الأعمى، ونبلغ مقام الوعي الذي يختار مسؤوليته بفرح.
فالإنسان الأخلاقي ليس من يطيع بلا وعي، بل من يسائل النص في ضوء الحياة، ويسائل نفسه في ضوء النص. بهذا المعنى، يتحوّل القرآن من كتاب أحكام إلى كتاب وعي، ومن خطاب إلزام إلى خطاب إنارة؛ إذ يقول تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ﴾، والنور لا يُفرض، بل يُتَّبع بإرادة البصيرة.
في زمن الانفتاح والاغتراب، لسنا بحاجةٍ إلى وصايةٍ أخلاقيةٍ جديدةٍ تُعيد إنتاج الخضوع، بل إلى وعيٍ أخلاقيٍّ حرٍّ يُحرّر الإنسان من الشعور بالذنب دون أن يُعفيه من الشعور بالمسؤولية. فالقيم ليست حراسًا على السلوك بقدر ما هي نوافذ على المعنى. ولا تُقاس أخلاقية الإنسان بمدى امتثاله للمألوف، بل بقدرته على أن يحيا الحقّ في ذاته، حتى حين يعارض السائد. إنّنا لا نحتاج إلى إجاباتٍ جاهزة تُسكّن القلق، بل إلى أسئلةٍ تُوقظ الوعي وتفتح الأفق أمام مغامرة المعنى.
خاتمة: الإنسان بين النصّ والواقع.
بين الحرية والمعنى الإنسان، في جوهره، ليس مخلوقًا لتلقّي النصوص، بل لشراكتها في إنتاج المعنى. النصّ الإلهي لا يكتمل إلا بالفعل الإنساني الذي يُعيد تأويله في الزمن. وحين يُقرأ النصّ بوصفه نصًّا مفتوحًا على الحياة لا مغلقًا دونها، يصبح الدين طريقًا إلى الحرية لا إلى القيد، وإلى الوعي لا إلى الوصاية.
في هذا الأفق، يمكن للتراث أن يكون بوصلةً لا قيدًا، وللقرآن أن يكون نورًا لا سوطًا، وللإنسان أن يكون حرًّا دون أن يفقد المعنى. فالأخلاق الحقّة ليست ما يفرضه المتشددون باسم “الحقّ المطلق”، بل ما يستنبطه الأحرار باسم الأمانة والمسؤولية. إنّها ليست حربًا بين القديم والجديد، بل لقاءٌ عميق بين الإلهيّ والإنسانيّ في سعيٍ واحد نحو المعنى.
وهكذا، لا تكون المرجعية الأخلاقية عودةً إلى ماضٍ مغلق، ولا ارتماءً في حاضرٍ منفلت، بل هي مسارٌ حيٌّ متجدّدٌ، ينهل من الوحي نوره، ومن الإنسان حريته، ومن التاريخ حكمته. عندها فقط، نستطيع أن نكون أبناء التراث دون أن نكون أسرى له، وأبناء الحداثة دون أن نذوب فيها — أن نكون بشراً أحراراً يضيئون الطريق لا لمن بعدهم فحسب، بل لأنفسهم في رحلة المعنى.
#سعد_كموني (هاشتاغ)


 Saad_Kammouni#
Saad_Kammouni#



ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

|
حفظ
 |
بحث |
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
| إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
أزمة الوعظ في المجتمعات العربية المعاصرة
-
الرحمة مبدأ كوني شامل /قراءة أسلوبية دلالية ومقاصدية في الآي
...
-
طمأنينة التفكيك الكاذبة
-
الإهلاك الإلهي ناموس غير اعتباطي
-
ذنوب الذين كفروا وإهلاكهم
-
آللهُ يهلكنا!؟
-
الأسلوب ما يجب أن يتغير راهناً
-
لا شيء يستدعي الثقة
-
نحن فاعل هلاكنا
-
لن نستفيد من عزلتنا
-
لن نأسف على شيء
-
يتوقعون ما يرغبون به
-
الإيمان ليس مرادفاً للجهل
-
ليس الإنسان ضعيفا
-
لا بد من ثورة تقدمية
-
الوحش ليس شكلاً بل مضمون
-
كورونا والثورة
-
أنت المسؤول
-
تهافت التأويل العلمي عند زغلول نجار وآخرين
المزيد.....
-
حقوق المسيحيين في إيران
-
بالصور.. قبة الصخرة بالمسجد الأقصى من الداخل
-
المرشد الأعلى الإيراني يقر بمقتل الآلاف في المظاهرات
-
قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي يستقبل جمعا غفيرا من
...
-
قائد الثورة الإسلامية: نعتبر الرئيس الأمريكي مجرما بسبب الاف
...
-
قائد الثورة الإسلامية: نعتبر ترامب مجرما بسبب الأضرار التي أ
...
-
اعتراف مرشح يهودي للكونغرس بوقوع الإبادة الجماعية في غزّة
-
بعد البهائيين واليهود.. حملة اعتقالات تطال المسيحيين في اليم
...
-
وفاة إمام مسجد نيجيري أنقذ حياة عشرات المسيحيين في 2018
-
شيخ الأزهر: الأقصى ركن من هوية المسلمين ومحاولات طمسه مرفوضة
...
المزيد.....
-
رسالة السلوان لمواطن سعودي مجهول (من وحي رسالة الغفران لأبي
...
/ سامي الذيب
-
الفقه الوعظى : الكتاب كاملا
/ أحمد صبحى منصور
-
نشوء الظاهرة الإسلاموية
/ فارس إيغو
-
كتاب تقويم نقدي للفكر الجمهوري في السودان
/ تاج السر عثمان
-
القرآن عمل جماعي مِن كلام العرب ... وجذوره في تراث الشرق الق
...
/ مُؤْمِن عقلاني حر مستقل
-
علي قتل فاطمة الزهراء , جريمة في يترب
/ حسين العراقي
-
المثقف العربي بين النظام و بنية النظام
/ أحمد التاوتي
-
السلطة والاستغلال السياسى للدين
/ سعيد العليمى
-
نشأة الديانات الابراهيمية -قراءة عقلانية
/ د. لبيب سلطان
-
شهداء الحرف والكلمة في الإسلام
/ المستنير الحازمي
المزيد.....
|
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

 |
بحث
|
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
|
إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة