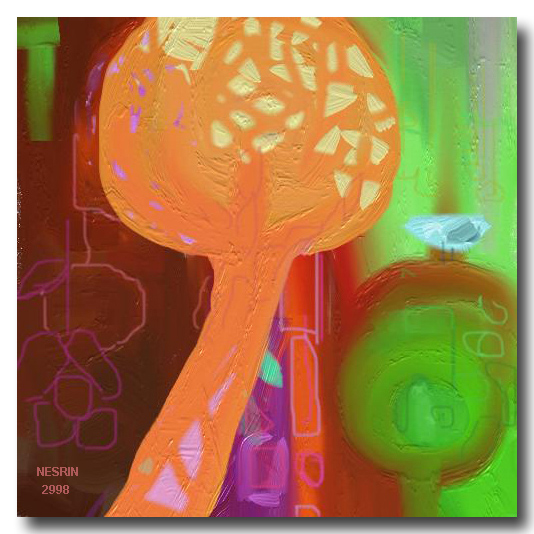|
|
الديني و الماركسي في خندق المقاومة وحدود الالتقاء: من طهران إلى غزة.
رياض الشرايطي


الحوار المتمدن-العدد: 8496 - 2025 / 10 / 15 - 16:16
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
مقدمة : حين تتقاطع العقيدة والثورة في معركة الوجود.
في كل تجربة من تجارب الصراع البشري ضد الظلم والقهر، يظهر الالتقاء بين الديني والماركسي كظاهرة نادرة ومثيرة للانتباه، تجسد لحظة استثنائية في التاريخ، حيث تتقاطع العقيدة الروحية مع الإيديولوجيا الطبقية في مواجهة عدو مشترك. هذه اللحظة ليست مجرد تحالف عابر أو تلاقي استراتيجي، بل هي صورة حية لصراع الإنسان مع نفسه ومع محيطه، صورة يلتقي فيها المختلفون فكريًا وروحيًا على خط النار، حيث الدم واحد والتهديد واحد والهدف واحد: تحرير الإنسان من القهر، الأرض من الاستعمار، والكرامة من الذل.
إن دراسة هذه الظاهرة عبر التاريخ الحديث، من الثورة الإيرانية 1979، إلى غزة وفلسطين، لبنان، ونيكاراغوا مع القساوسة الحمر، تكشف لنا أن الالتقاء بين الديني والماركسي لا يتم إلا في ظل ضرورة ميدانية أو تكتيكية صارمة، حيث تتجاوز الحاجة المشتركة كل الاختلافات الفكرية العميقة، ويصبح الإنسان موحدا في مواجهة الطغيان، ولو كان مشروعه الاجتماعي والسياسي بعد التحرير مختلفًا جذريًا عن رفيقه في السلاح.
في طهران، على سبيل المثال، التقى حزب توده الماركسي بالتيار الديني للخميني ضد نظام الشاه، متحدين في الشارع، وفي الميدان، في مواجهة قمع وحشي ودعم إمبريالي لا محدود للديكتاتور. وفي اللحظة نفسها، في فلسطين وغزة، شهدت مقاومة الاحتلال الإسرائيلي تعاونا غير مسبوق بين الماركسيين والفصائل الدينية، حيث كانت البنادق ترفع ضد العدو الموحد، رغم أن الهوية النهائية للدولة المستقبلية كانت مسألة خلافية عميقة بين الطرفين.
أما في نيكاراغوا، فقد قدم القساوسة الحمر مثالا كذلك للتقاء الديني بالماركسي، حيث حمل رجال الدين السلاح إلى جانب الماركسيين ضد دكتاتورية سوموزا، متحدين في مواجهة الظلم والطغيان، ليصبحوا رموزا للتضحية والجمع بين الإيمان والعمل الطبقي، رغم الاختلاف الجذري في المشروع المستقبلي بعد النصر. كل هذه التجارب تؤكد أن الالتقاء في خندق المقاومة مؤقت ومحدود، لكنه يحمل قيمة إنسانية وسياسية لا يمكن تجاهلها، فهو يظهر قدرة الإنسان على تجاوز الانقسامات الفكرية حين يكون وجوده على المحك، ويجسد لحظة نادرة من الوحدة في اللحظة الاستثنائية.
إن هذا الالتقاء لا يقتصر على البعد العسكري فقط، بل يمتد إلى الجانب الرمزي والفكري: إذ يختبر الإنسان قدرته على العمل مع المختلف عنه فكريا وروحيا، على أن يسقط الاختلافات جانبا لحظة مواجهة الطغيان، قبل أن تعود هذه الاختلافات لتفرض نفسها بعد النصر، في صراع حول السلطة، والعدالة الاجتماعية، وطبيعة الدولة المستقبلية. وهنا يكمن الدرس التاريخي العميق: التحالف في خندق المقاومة هو لحظة تكتيكية مؤقتة، لكنها حاسمة وضرورية.
كما يقول غرامشي:
"الوحدة بين القوى المختلفة ليست مسألة توافق دائم، بل مسألة تكتيكية لمواجهة العدو المشترك."
ومن هذا المنطلق، تصبح دراسة هذا الالتقاء بين الديني والماركسي ليست مجرد تحليل لمواقف عسكرية أو سياسية، بل تحقيقا فلسفيا واجتماعيا في طبيعة الصراع البشري، وفي حدود الوحدة الممكنة بين مختلف الأيديولوجيات حين تكون الحرية والكرامة على المحك. إنها دراسة لللحظة الاستثنائية التي يتحد فيها الإنسان مع المختلف عنه، قبل أن تبدأ ملامح الخلافات الجوهرية في الظهور، لتكشف أن الانتصار العسكري أو التحرر من الاحتلال لا يكفي لتحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية أو الحرية الكاملة.
وبناء على هذا الفهم، يظهر النص الذي بين أيدينا كمسعى لفهم حدود الالتقاء بين الديني والماركسي، لحظة النضال المشترك، وتجربة الإنسان في مواجهة القهر التاريخي، عبر كل الأزمنة والمواقع. إنه نص يسعى إلى رصد اللحظة التاريخية والنفسية والسياسية التي تتلاقى فيها البنادق مع العقائد، والدم مع الإيمان، والواقع مع الأيديولوجيا، في سبيل تحقيق مشروع التحرر الإنساني، مهما كانت الصراعات الفكرية بين الأطراف مستمرة بعد انتهاء المعركة.
كاميلو توريس القس الكولمبي، الذي حمل السلاح إلى جانب الماركسيين في ستينيات القرن العشرين، قال عبارته الشهيرة:
“من لم يكن ثوريا من أجل العدالة، لا يمكن أن يكون مسيحيا حقيقيا.”
1. الالتقاء الاضطراري بين العقيدة والثورة.
إنّ هذا الالتقاء بين التيارين ، الديني والماركسي — ليس وليد قناعة فكرية مشتركة، بل ثمرة ظرف تاريخيّ تضطر فيه الشعوب إلى تعليق خلافاتها النظرية في سبيل مواجهة الخطر الخارجي. وكما يقول المفكر اليساري اللبناني مهدي عامل:
“حين تهاجم الإمبريالية الوطن، يصبح الدفاع عنه جزء من الصراع الطبقي نفسه.”
من هذا المنطلق، يصبح الدين والثورة في لحظة من التاريخ جبهة واحدة، لا لأنّهما متصالحان، بل لأنّ العدوّ مشترك. هذه الجدلية ظهرت بوضوح في تجارب حركات التحرر الوطني في القرن العشرين: من الجزائر إلى فيتنام، ومن كوبا إلى فلسطين. فالإمام والماركسي وجدا نفسيهما في خندقٍ واحد ضدّ الاستعمار الفرنسي أو الأمريكي أو الصهيوني، لأنّ التناقض الأساسي لم يكن بين السماء والأرض، بل بين الحرية والعبودية.
لكنّ المعضلة تبدأ عندما يتحول هذا الالتقاء الاضطراري إلى مشروع سياسي دائم. فحين تنتهي المعركة، ويبدأ النقاش حول شكل الدولة، القانون، الاقتصاد، والتعليم، تتفجّر الهوّة بين الطرفين. الديني يسعى إلى تثبيت مرجعية مطلقة فوق البشر، والماركسي يسعى إلى تحرير البشر من كلّ مرجعية غيبية. الأول ينطلق من الوحي، والثاني من المادة. ومن هنا تتضح حدود الالتقاء: إنه لقاء تاريخي لا فلسفي، ميداني لا نظري، مرحلي لا استراتيجي.
ولعلّ المفكر الماركسي المصري محمود أمين العالم عبّر عن هذه الإشكالية حين قال:
“قد نلتقي في الميدان، لكننا نفترق في الغاية؛ فالماركسية تنشد تحرير الإنسان من كل سلطة خارجة عنه، بينما الدين يبقي تلك السلطة في السماء.”
2. من طهران إلى غزة: حدود التحالف ومآلاته.
لعلّ التجربة الإيرانية تعدّ النموذج الأوضح على طبيعة هذا الالتقاء وحدوده. فحين اشتدّ الصراع ضدّ الشاه في سبعينيات القرن الماضي، وجد حزب تودة الشيوعي نفسه متحالفا مع التيار الخميني الذي رفع شعار “الاستقلال، الحرية، الجمهورية الإسلامية”. كان العدوّ واحدا: نظام تابع للغرب، فاسد، وقامع لكل القوى الشعبية. رأى الشيوعيون في الثورة الإسلامية فرصة تاريخية لإسقاط نظام التبعية وفتح الطريق أمام القوى الوطنية والديمقراطية لبناء إيران جديدة، تخرج من عباءة الاستعمار الأمريكي وتحقق العدالة الاجتماعية.
لكن ما إن سقط الشاه سنة 1979 حتى تبيّن أن التحالف كان تكتيكيا أكثر منه استراتيجيا. فالخمينية، التي اعتمدت على الجماهير الكادحة في الشارع، لم تكن مستعدة لتقاسم السلطة أو لتبني برنامج اشتراكيّ يهدد مصالح البورجوازية الدينية الصاعدة. وهكذا، تحوّل الحليف الأمس إلى عدوّ الداخل، وأُعدم المئات من مناضلي حزب تودة، وسجن قادته، وأُغلقت جرائده، فيما رفعت شعارات “تطهير الثورة من الملحدين”.
كتب أحد قادة حزب تودة من زنزانته آنذاك:
“لقد قاتلنا ضد الشاه من أجل الحرية، فوجدنا أنفسنا في سجونٍ أشدّ ظلمة من سجونه، تحت راية الله لا راية أمريكا.”
هذا المشهد المأساوي ليس فريدا في التاريخ، بل يتكرر في أكثر من ساحة. ففي غزة، على سبيل المثال، يتقاطع الماركسي والإسلامي اليوم في مقاومة العدوّ الصهيوني؛ فالمقاتل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يقاتل إلى جانب المقاتل من كتائب القسام أو سرايا القدس، متحدين ضد الاحتلال. لكن ما إن ننتقل من خندق المواجهة إلى ساحة السياسة الداخلية، حتى تعود التناقضات القديمة: حول العلمانية، والمرأة، والاقتصاد، والعلاقة بالدولة الحديثة. فالمعركة ضدّ الصهيونية توحّد، أما بناء المستقبل فيفرّق.
وهكذا تتكرر المفارقة ذاتها التي شهدتها طهران قبل عقود: تحالف الضرورة الذي ينتهي إلى تصفية الفكر اليساري أو تهميشه حين تنتصر الثورة. والسبب الجوهري أنّ التيار الديني، مهما كان وطنيا أو مقاوما، لا يتصالح مع المشروع اليساري على المدى البعيد، لأنّهما يستندان إلى منظومتين معرفيتين متعارضتين جذريا: الأولى غيبية تسعى إلى تثبيت “الحق الإلهي في الحكم”، والثانية مادية ترى في “الشعب مصدر السلطة”.
3. الالتقاء التكتيكي وحدود البقاء في ساحة المقاومة.
إنّ الالتقاء بين الديني والماركسي في ساحة المقاومة لا يتجاوز في جوهره البعد التكتيكي، رغم عمقه الإنساني الظاهري. فكلّ منهما يحمل مشروعا مختلفا جذريا، وإن التقيا مؤقتا على أرضية الكفاح المسلح أو النضال ضدّ العدو الخارجي. الماركسي يناضل من أجل تغيير بنية المجتمع وتحريره من الاستغلال الطبقي، بينما يسعى الديني إلى تحرير الأمة من “الغزو الروحي” أو “الفساد الأخلاقي”، دون أن يمسّ جوهر العلاقات الاجتماعية والاقتصادية التي تولّد الفقر والظلم.
من هنا، يصبح الخندق المشترك ساحة لقاء لا بيتا دائما. وما أن تهدأ المعارك، حتى يتذكّر كل طرف موقعه في البنية الطبقية للمجتمع. فالماركسي يرى في الكفاح الوطني وسيلة لتحرير الإنسان من كل سلطة — سياسية أو دينية — أما الديني فيراه طريقا إلى إقامة سلطة “الحقّ الإلهي”. هذه المفارقة هي التي تجعل التحالف بينهما مؤقتا بطبيعته، لأنّ ما يجمعهما هو النضال ضدّ العدو، وما يفرّقهما هو تعريف الإنسان والحرية والعدالة نفسها.
في هذا السياق، كتب المفكر الماركسي اللبناني مهدي عامل:
“حين تتحرّر الأرض دون أن يتحرّر الإنسان، تكون الثورة قد انقلبت على ذاتها.”
وهذا بالضبط ما يحدث عندما تنتصر المقاومة المسلحة دون أن يتبعها مشروع اجتماعي تحرري. فالديني يميل إلى إعادة إنتاج البنية التقليدية للسلطة، أما الماركسي فيسعى إلى قلبها رأسا على عقب. وبين هذين الموقفين تتكسر وحدة الخندق.
في فلسطين اليوم مثلا، يقاتل الماركسي إلى جانب الإسلامي في مواجهة الاحتلال الصهيوني. لكن هذا الالتقاء لا يعني تطابق المشروعين، بل هو تحالف الضرورة. فالماركسي يرى في الكفاح ضدّ الصهيونية معركة ضدّ الرأسمالية العالمية ونظام التبعية، بينما الإسلامي يراها جهادا لتحرير الأرض المقدّسة. كلاهما يقاتل بشجاعة، لكن دوافعهما مختلفة جذريا. وهذا ما يجعل من لحظة الانتصار المحتملة أيضا لحظة انفجار الخلافات الكبرى حول طبيعة “التحرير” نفسه: تحرير من ماذا؟ ولمن؟ وتحت أي راية؟
وهكذا، فإنّ الالتقاء بين الديني والماركسي في خندق المقاومة هو اتحاد ضدّ العدو لا اتحاد من أجل المستقبل. وما لم يتحوّل هذا الالتقاء إلى رؤية مشتركة للحرية الاجتماعية والإنسانية، فإنه سيظلّ تحالفا محكوما بالزوال بمجرد أن يرفع البندقية من فوق الكتف.
4. من طهران إلى غزة: الدرس الدموي للتحالفات المستحيلة.
تعدّ التجربة الإيرانية المثال الأوضح على مآلات هذا الالتقاء المؤقت. فحين اشتدّ الصراع ضدّ نظام الشاه في سبعينيات القرن الماضي، وجد الحزب الماركسي تودة نفسه في خندقٍ واحد مع التيار الخميني الذي رفع شعار “الاستقلال والحرية والجمهورية الإسلامية”. كان العدوّ مشتركا: نظام تابع للغرب، قمعيّ، متواطئ مع الإمبريالية الأمريكية.
الخمينيون استثمروا الغضب الشعبي واحتجاجات الطبقات المسحوقة، بينما رأى الماركسيون في الثورة الإسلامية فرصة تاريخية لإقامة نظام وطنيّ مستقلّ يقطع مع التبعية الاقتصادية والسياسية للغرب. لكنّ ما إن سقط الشاه سنة 1979 حتى انكشف وجه الثورة المحافظ، وبدأت مرحلة تطهير الداخل. أُعدم المئات من مناضلي حزب تودة، وسجن و شرد قادته، وحظرت صحفه، وتمّ اتهامه بالإلحاد والخيانة.
كتب أحد مثقفي تودة من منفاه بعد المجزرة قائلا:
“ظننا أن الثورة ستحرّر الإنسان من القيصر والشاه، فإذا بها تعيده إلى كهنوت أشدّ بطشا.”
كانت المأساة الإيرانية درسا قاسيا لكلّ من ظنّ أن بإمكان الماركسي والديني بناء مشروع واحد. فبينما أراد الأول ثورة اجتماعية، أراد الثاني ثورة دينية تعيد تشكيل المجتمع وفق الشريعة. وبين العدالة الأرضية والعدالة السماوية سقط الجسر.
الشيء ذاته يتكرر — وإن بأشكال مختلفة — في فلسطين. فهناك، يقف الماركسي إلى جانب الإسلامي في مواجهة الاحتلال الصهيوني، ويقاتلان معا في خندقٍ واحد دفاعا عن الأرض. غير أن المشروعين يتباينان في العمق: فالماركسي الفلسطيني، المنتمي إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين و الجبهة الديمقراطية، يريان في الكفاح المسلح جزء من الثورة العالمية ضدّ الرأسمالية والإمبريالية، بينما ترى الحركات الإسلامية كـ“حماس” و“الجهاد الإسلامي” في المعركة تحقيقا لوعد إلهيّ واستعادة للأرض بوصفها وقفا دينيا.
هكذا يلتقيان على خطوط النار، لكنهما يختلفان في وجهة السهم. الماركسي يوجّه البندقية نحو النظام العالمي غير العادل، والإسلامي يوجّهها باسم السماء. وكما في طهران، فإنّ لحظة النصر — إن تحققت — قد تتحوّل إلى لحظة تصفية فكرية جديدة، حين يتحوّل الحليف إلى “ملحد”، والمقاوم إلى “خارج عن الشريعة”.
تاريخ التحالف بين الديني والماركسي إذا هو تاريخ الالتقاء الضروري والانفصال الحتمي. إنه لقاء في الخندق وانفصال في الحلم. من طهران التي أعدمت أبناء تودة، إلى غزة التي ما زالت تتلمّس الطريق بين البنادق والعقائد، تتكرّر المعضلة نفسها: كيف يمكن أن يجتمع من يرى السلطة تفويضا من الله مع من يراها عقدا اجتماعيا بين البشر؟ وكيف يمكن أن تلتقي الشريعة مع الديالكتيك؟
كما قال تروتسكي :
“الثورة لا تتصالح مع الكهنة، لأنها تضع الإنسان في مركز الكون، لا الإله.”
لكن الشعوب المقهورة، حين تجد نفسها بين فكيّ الاحتلال والرأسمالية، تضع هذه الأسئلة جانبا مؤقتا، وتقاتل أولا من أجل الحياة، ثم تبحث لاحقا عن معنى العيش.
5. من طهران إلى دروس التاريخ القاسي.
أكثر التجارب دلالة على هشاشة هذا الالتقاء كانت في إيران عام 1979، حيث انطلقت الثورة ضد نظام الشاه محمد رضا بهلوي، رمز العمالة الإمبريالية في المنطقة. هناك، التقت التيارات الإسلامية الثورية بقيادة الخميني مع القوى الماركسية، وعلى رأسها حزب توده، في خندق واحد ضدّ نظام تابع لواشنطن وتل أبيب، حوّل إيران إلى قاعدة للهيمنة الأمريكية في الخليج، وإلى مختبر لاستغلال الطبقات العاملة والفلاحية.
في تلك اللحظة، ظنّ الماركسيون أنّ الثورة الإسلامية قد تفتح أفقا جديدا لتحرير الطبقة العاملة من الهيمنة الإمبريالية، خاصة بعد أن رفع الخميني شعار "الاستقلال والحرية والجمهورية الإسلامية"، وهو ما ظنّ كثيرون أنه يعبّر عن مضمونٍ معادٍ للإمبريالية وقريب من روح الاشتراكية. فدعم حزب توده الثورة، وشارك في تعبئة الشارع، ووقف إلى جانب رجال الدين في وجه نظام الشاه وأجهزته القمعية.
لكن ما إن سقط النظام، حتى انقلب المشهد. فالدولة الجديدة التي تأسست على المرجعية الدينية لم تحتمل التعدد الأيديولوجي، واعتبرت الماركسية "عدوا داخليا" يهدد وحدة الأمة. بدأت مرحلة القمع الممنهج لليسار الإيراني: أُغلقت الصحف، وحظر حزب توده، وسجن الآلاف من مناضليه، وأُعدم العشرات من قياداته في محاكمات صورية. لقد تم سحق الماركسيين الذين كانوا بالأمس شركاء في الثورة، في مشهد يعكس قول كارل ماركس في "الثامن عشر من برومير":
“إن الثورات تلد أحيانا أبناءها الذين يلتهمونها باسم الطهارة الثورية.”
وهكذا تحوّل التحالف الثوري إلى مأساة تاريخية. اكتشف الماركسيون الإيرانيون أن الدين الذي حمل راية التحرر من الإمبريالية كان — في بنيته العميقة — يحمل مشروعا سلطويا لا يقبل المساواة الطبقية ولا الفكر النقدي. لقد ظنّ حزب توده أن «مناهضة الإمبريالية» تكفي لتوحيد الصفوف، لكنه نسي أن الصراع الطبقي لا يمحى بشعارات الوحدة الروحية، وأن الثورة التي لا تمسّ البنية الاقتصادية للسلطة ستعيد إنتاج الاستبداد بأسماء جديدة.
ومن هذه التجربة، يمكن القول إنّ الالتقاء بين الماركسي والديني في الثورة الإيرانية كان التقاء الضرورة التاريخية لا التقاء الوعي الطبقي. فقد التقى الطرفان في لحظة المواجهة مع الإمبريالية، لكنّهما لم يلتقيا في رؤية المجتمع ما بعد التحرير. ولذلك ما إن تغيّرت موازين القوة حتى أصبح الماركسي "مرتدا" في نظر الدولة الدينية، وأُعيد إنتاج الاستبداد بلغة لاهوتية جديدة.
06. غزة ولبنان، وعودة الالتقاء في خندق المقاومة.
في المقابل، شهدت المنطقة العربية نموذجا آخر من هذا الالتقاء — هذه المرة في فلسطين ولبنان، حيث تلاقت الحركات الإسلامية الثورية مع القوى الماركسية والقومية في خندق المقاومة ضد الصهيونية. هنا، لم يكن اللقاء بين الماركسي والديني تحالفا سياسيا مؤسساتيا بقدر ما كان تقاطعا ميدانيا في ساحات النضال.
في فلسطين، على سبيل المثال، نجد مقاتلين من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين و الجبهة الديمقراطية يقاتلون إلى جانب مقاتلي حماس والجهاد الإسلامي ضد الاحتلال، رغم التناقض الجذري بين رؤيتهم للمجتمع والدولة. كلاهما يدرك أن العدوّ الرئيسي هو الكيان الصهيوني، وأن مقاومته لا يمكن أن تختزل في بعد ديني أو طبقي فقط. يقول المفكر الماركسي الفلسطيني غسان كنفاني:
"العدوّ لا يفرّق بين مؤمن وشيوعي، بل بين من يقاوم ومن يستسلم."
وفي لبنان، يتكرر المشهد مع المقاومة الإسلامية (حزب الله) التي خاضت معارك مشتركة مع اليسار اللبناني والفصائل الفلسطينية الماركسية ضد الاحتلال الصهيوني في الجنوب. ومع أنّ لكل طرف مشروعه العقائدي المختلف، إلا أنّ الدم في الميدان كان يوحّد ما فرّقته الأيديولوجيا.
لكن حتى في هذه التجارب، تبقى حدود الالتقاء واضحة. فالمقاومة العسكرية قد توحّد البنادق، لكنها لا توحّد الرؤى الاجتماعية والسياسية. فحين ينتقل الصراع من جبهة التحرير إلى جبهة بناء الدولة، يعود التناقض بين الماركسي الذي يريد دولة العدالة والمواطنة والمساواة، والديني الذي يريد دولة المرجعية والتكليف الشرعي.
هكذا يبقى هذا الالتقاء رهين اللحظة الثورية، لا المشروع التاريخي. ومع ذلك، فإن وجوده نفسه دليل على أنّ التحرر لا يمكن أن يختزل في أيديولوجيا واحدة، وأنّ الإنسان، حين يهدّد وجوده، يجد طريقه الطبيعي إلى رفاقٍ يشبهونه في الألم أكثر مما يشبهونه في الفكر. كما قال الشاعر محمود درويش:
"على هذه الأرض ما يستحق الحياة... وعلى هذه الأرض يلتقي المختلفون حين يقررون أن يعيشوا أحرارا."
07. التناقضات الفكرية بعد التحرير: متى ينفصل الحليف عن الحليف؟.
إنّ لحظة الانتصار أو التحرير ليست نهاية الصراع، بل بداية الامتحان الحقيقي للتحالفات. فالماركسي والديني، الذين قاتلا جنبًا إلى جنب في خندق المقاومة، يجدان أنفسهما فجأة أمام سؤال السلطة: من يقرر؟ ومن يُحدّد أولويات المجتمع؟ وما المشروع الذي سيبنى على أرضٍ تحررت من الاحتلال؟
لقد أشار تروتسكي في كتابه الثورة والروسية إلى أن:
"التحالفات العسكرية ليست تحالفات أيديولوجية. ما يربط الثوار في الجبهة يختلف جذريا عن ما يربطهم بعد الجبهة."
في فلسطين وغزة، يمكن ملاحظة هذا التباين بوضوح. فالماركسي الفلسطيني يرى في مقاومة الاحتلال فرصة لتطبيق برامج اجتماعية عادلة، لتعزيز المساواة الاقتصادية، ولتمكين النساء والفقراء، ولخلق مجتمع مستند إلى العدالة والمواطنة. أما الديني، فيسعى لتأسيس سلطة تمثل المرجعية الدينية، وتبني القيم الاجتماعية على أساس الشرع، وقد تتعارض هذه القيم أحيانا مع الحقوق المدنية التي يطالب بها الماركسيون.
إنّ هذا التناقض ليس نظريا فقط، بل يتحوّل إلى حرب بالوكالة بعد التحرير، حيث يختبر كل طرف قوة الآخر في إدارة المجتمع، وفي رسم السياسات الاقتصادية، وفي وضع القوانين. وهذا ما يوضحه مثال إيران التاريخي بعد سقوط الشاه، حيث أصبح الحزب الماركسي توده مستهدفا من الدولة الجديدة، التي صارت مرجعية السلطة فيها دينية خالصة.
ويؤكد المفكر اللبناني مهدي عامل هذا التحليل، بقوله:
"التحالف في خندق المقاومة يعطي وهم الوحدة، لكن الانتصار يكشف دائما الفرق بين الذين يرون السلطة تكليفا إلهيا، والذين يرونها أداة تحرير الإنسان."
وفي هذا السياق، تتحول لحظة الوحدة التاريخية إلى تجربة تعليمية دموية لكل طرف. فالماركسي يتعلم أن العدو قد يتخفى وراء شعار المقاومة، والديني يتعلم أن التعدد الأيديولوجي يشكل خطرا على سيطرته بعد التحرير. ومن هنا نفهم أن التحالف في خندق المقاومة هو تحالف مرحلي، وليس تحالفًا استراتيجيا دائما.
يقول غرامشي:
"الوحدة بين القوى المختلفة ليست مسألة توافق دائم، بل مسألة تكتيكية لمواجهة العدو المشترك."
وبالتالي، يجب النظر إلى كل تجربة تحالف بين الديني والماركسي على أنها درس مزدوج: درس في أهمية الوحدة التاريخية ضد الاستعمار، ودرس في حدود هذه الوحدة عندما يتعلق الأمر بإعادة بناء المجتمع بعد التحرير.
08. التحرر المزدوج: رؤية الماركسي مقابل الديني.
التحرر في سياق المقاومة له بعدان أساسيان: التحرر من العدو الخارجي، والتحرر من قيود السلطة الداخلية. هنا يبرز التباين العميق بين الماركسي والديني:
-التحرر الماركسي يعني تحرير الإنسان من كل أشكال الاستغلال، سواء كانت اقتصادية، اجتماعية، أو سياسية، كما يؤكد لينين في الدولة والثورة:
"الثورة لا تكتمل إلا عندما تتحرر الطبقة العاملة من ربقة الرأسمالية، ويصبح الشعب صاحب السلطة الحقيقية."
-التحرر الديني غالبا ما يقتصر على تحرير الأرض أو الأمة باسم الله، ويضع السلطة النهائية في يد المرجعية الدينية، كما يرى الخميني في كتاباته:
"الدولة الإسلامية ليست مجرد سلطة سياسية، بل تجسيد للحق الإلهي على الأرض."
هذا الاختلاف يعكس أن التحالف بين الماركسي والديني قائم على مشروع مقاومة مشترك فقط، وليس على مشروع بناء المجتمع أو السلطة بعد التحرير. ففي غزة، يتقاسم المقاتلون من مختلف الأطياف المقاومة ضد الاحتلال، لكنهم يختلفون حول طبيعة الدولة المستقبلية، وحقوق الإنسان، والمساواة، والسيادة على الموارد، والسياسات التعليمية والاجتماعية.
ومن هنا نشأ مفهوم التحرر المزدوج عند الماركسي: التحرر من الاحتلال والتحرر من أي نظام سلطوي داخلي، سواء كان دينيا أو رجعيا. بينما يرى الديني أن التحرر الحقيقي هو التحرر من الاحتلال باسم الله، أما بقية البعد الاجتماعي والاقتصادي فيتم تفسيره وفق ما يراه الشرع.
الدرس هنا واضح: التحالف الميداني لا يساوي تحالفا فكريا. كما يقول مالك بن نبي:
"المجتمعات لا تنهض إلا إذا اجتمعت القوى على هدف واحد واضح، لكن البقاء والاستمرار يحتاج إلى مشروع عقلاني متوافق مع احتياجات الإنسان."
هذا يعني أن اللحظة الثورية، مهما كانت موحّدة على الأرض، تحمل في طياتها بذور الانقسام المحتملة، وبذور الصراع بعد انتهاء المعركة العسكرية. فالديني والماركسي يقاتلان جنبا إلى جنب اليوم، لكن المستقبل السياسي والاجتماعي يبقى مرهونا بمشروع كل طرف.
وختاما، يظهر أن التاريخ المتكرر من طهران إلى غزة، ومن لبنان إلى فلسطين، يعلّمنا أن الالتقاء بين الديني والماركسي في خندق المقاومة هو لحظة نادرة وقيمة، لكنها مؤقتة ومرحلية بطبيعتها. إنه اختبار حقيقي للإرادة الإنسانية أمام الظلم، ولكنه أيضا اختبار لصبر الفكر الماركسي، الذي يرى أن التحرر لا يكتمل إلا عندما يتحقق تحرر الإنسان من كل قيد، سواء كان احتلالًا أو سلطة داخلية.
09. التحالفات التكتيكية في مسرح الحرب: من لبنان إلى أمريكا اللاتينية.
إنّ ما يربط الديني بالماركسي في ساحات المقاومة هو العدو المشترك، وليس مشروع الدولة أو إعادة البناء الاجتماعي بعد الانتصار. فالعدو المشترك في لبنان وفلسطين، وكذلك في نيكاراغوا، هو القوة الخارجية أو الديكتاتورية المحلية التي تسلب الشعب حقه في العيش بحرية وكرامة.
في لبنان، شهدت السبعينيات والثمانيات تحالفات تكتيكية بين المقاومة الإسلامية والفصائل الماركسية الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني، وأيضا ضد الميليشيات الطائفية المتحالفة مع القوى الخارجية. كل طرف، رغم اختلاف مشروعه النهائي، كان يرى أن النجاة والبقاء السياسي للشعب يتطلب مواجهة فورية للعدو. وهنا نجد صورة واضحة لما كتبه غرامشي:
"الوحدة بين القوى المختلفة ليست مسألة توافق دائم، بل مسألة تكتيكية لمواجهة العدو المشترك."
الأمر ذاته يتكرر في أمريكا اللاتينية، وتحديدا في تجربة نيكاراغوا مع حركة الساندينية. فقد وجد الماركسيون أنفسهم في خندق واحد مع قساوسة مسيحيين ثوريين، الذين حملوا السلاح إلى جانب الشعب ضد دكتاتورية سوموزا القمعية. هؤلاء القساوسة الذين ارتدوا ثوب المقاومة وأصبحوا رموزا لمواجهة الاستبداد أُطلق عليهم لاحقا اسم "القساوسة الحمر"، لأنهم جمعوا بين الإيمان الديني والعمل الماركسي على أرض الميدان، متحدين في مواجهة الظلم والطغيان.
كان القساوسة الحمر مثالا حيا على إمكانية الالتقاء بين الديني والماركسي في خندق مسلح واحد، لكن هذه الوحدة كانت مشروطة بالحاجة الفورية للتحرر من الدكتاتورية. وما إن انتهت الحرب، حتى بدأت التناقضات الفكرية والاجتماعية تظهر، كما حدث مع أي تجربة مشابهة في الشرق الأوسط أو إيران. فقد بدأ السؤال الأولي: من سيحدد مصير الدولة؟ وكيف يتم توزيع السلطة بعد الانتصار؟
كتب المفكر السانديني كارلوس فوينتس:
"حين تقاتل مع القساوسة الحمر، تدرك أن الوحدة في المعركة ليست امتدادا للاتفاق على رؤية المستقبل."
وهكذا يظل التحالف بين الديني والماركسي في زمن الحرب مؤقتا واستراتيجيا، وليس أيديولوجيا. لكنه يظل مهما لأنه يخلق لحظة تاريخية نادرة، يظهر فيها الإنسان بما هو الإنسان، قبل أن يظهر بما هو مؤمن أو ماركسي.
10. المأساة والدرس التاريخي: نهاية التحالف وبداية الانقسام.
التاريخ المعاصر مليء بالمفارقات التي تكشف حدود الالتقاء بين الديني والماركسي بعد الانتصار. فبين إيران، فلسطين، لبنان، ونيكاراغوا، نجد أن كل تجربة تحمل الدرس ذاته: التحالف العسكري أو المقاوم قائم على ضرورة مواجهة العدو، لكن انتهاء الأزمة يكشف الخلافات الجوهرية حول السلطة والمشروع الاجتماعي.
في تجربة نيكاراغوا، مثّل القساوسة الحمر مثالا على تضحية الدين لمصلحة الحرية والتحرر، لكنهم بعد استقرار النظام السانديني واجهوا صعوبات في الحفاظ على استقلاليتهم ومشروعهم الديني داخل الدولة الجديدة، التي اتخذت منحى ماركسيا أكثر وضوحا في السياسات الاجتماعية والاقتصادية. وهنا يظهر التناقض بين القيم الدينية الفردية والمشروع الطبقي الجمعي: فالماركسي يسعى إلى تقويض كل سلطة فوقية غير متساوية، أما الديني فيسعى إلى حفظ سلطة أخلاقية وروحية فوق المجتمع.
وفي فلسطين ولبنان، تكشف التجارب الميدانية أن الانتصار العسكري ليس نهاية الصراع، بل هو مرحلة انتقالية محفوفة بالصراعات الداخلية بين القوى التي قاتلت جنبا إلى جنب. فالماركسي يسعى إلى توسيع قاعدة الحقوق والمساواة والعدالة الاجتماعية، بينما يسعى الديني إلى ترسيخ المرجعية الدينية في الدولة والمجتمع. ويؤكد هذا الواقع ما قاله المفكر الماركسي الفلسطيني غسان كنفاني:
"العدوّ لا يفرّق بين مؤمن وشيوعي، بل بين من يقاوم ومن يستسلم، لكن بعد المقاومة، يبدأ كل طرف في رسم حدود سلطته الفكرية والاجتماعية."
ومن هنا يظهر الدرس التاريخي الأساسي: الالتقاء في خندق المقاومة مؤقت، لكنه ضروري. وهو لحظة تاريخية فريدة تسمح للشعوب المقهورة بمواجهة القوى الطامعة والمستعمرة، لكنها لا تكفي لبناء مجتمع حر ومستقل بعد التحرير. وهذا ما يجعل كل تجربة مقاومة اختبارا مزدوجا: اختبار للقدرة على الصمود في مواجهة العدو، واختبار لمشروع كل طرف في بناء المستقبل بعد الانتصار.
كما يقول لينين في سياق التحالفات التاريخية:
"الثورة قد تجتمع فيها جميع القوى ضد العدو، لكن ما بعد الثورة يكشف جوهر كل قوة ويضعها على المحك."
وبالتالي، من طهران إلى غزة، ومن لبنان إلى نيكاراغوا، تتكرر القاعدة نفسها: التحالف بين الديني والماركسي قائم على الضرورة، ومحدود بزمن الحرب والمواجهة، وحين تتحقق النصر تتفجر التناقضات الفكرية والاجتماعية. ومع ذلك، تبقى هذه التجارب قيمة لأنها تظهر إمكانية تجاوز الفوارق الأيديولوجية مؤقتا في سبيل الحرية والكرامة والعدالة، وأن الإنسان حين يواجه الظلم المشترك يكتشف في ذاته قدرة على التعاون مع المختلف عنه فكريا وروحيا، ولو كان ذلك مؤقتا.
ويقول محمود درويش في هذا السياق:
"على هذه الأرض ما يستحق الحياة... وفي لحظة المقاومة، قد تتحد القلوب المتباينة، حتى ولو اختلفت الرؤى."
الخاتمة : درس التاريخ بين خنادق المقاومة والواقع بعد التحرير.
إنّ دراسة التجارب المتعددة من إيران 1979، إلى فلسطين وغزة، لبنان، ونيكاراغوا، تكشف بوضوح أن الالتقاء بين الديني والماركسي في خندق المقاومة ليس تحالفا أيديولوجيا دائما، بل لحظة تاريخية تكتيكية، مشروطة بالضرورة الميدانية لمواجهة عدو مشترك. هذه الوحدة المؤقتة، رغم هشاشتها الفكرية والسياسية، تُظهر قدرة الإنسان على تجاوز اختلافاته الجذرية حين يكون مصيره ومصير شعبه على المحك.
التجربة الإيرانية تقدم المثال الأكثر وضوحا: التحالف بين حزب توده والمراجع الدينية ضد الشاه كان تحالفًا نابعًا من ضرورة مواجهة الإمبريالية والديكتاتورية، لكنه سرعان ما تحوّل إلى مأساة بعد سقوط النظام، حين اكتشف الماركسيون أن الدولة الدينية الجديدة لا تقبل تعددية الأيديولوجيات، وأن قسوة السلطة الدينية قد تقضي على كل مشروع تحرري متماسك. هذا المشهد يذكّرنا بما كتبه كارل ماركس:
"الثورات تلد أحيانا أبناءها الذين يلتهمونها باسم الطهارة الثورية."
وفي فلسطين وغزة، يظهر الالتقاء بين حماس والجهاد الإسلامي والفصائل الماركسية في الجبهة العسكرية، حيث توحدت البنادق ضد الاحتلال، لكنه بقي محدودا بالبعد العسكري، دون أن يشمل مشروعا مشتركا لإعادة بناء المجتمع بعد التحرير. يقول غسان كنفاني:
"العدوّ لا يفرّق بين مؤمن وشيوعي، بل بين من يقاوم ومن يستسلم."
وفي لبنان، تكرر المشهد نفسه مع المقاومة اللبنانية ضد الاحتلال الصهيوني، حيث تعاون الماركسيون مع حزب الله، رغم التباين الجذري في الرؤى المستقبلية، مؤكدين أن الدم في الميدان يوحّد ما فرّقته الأيديولوجيا. وفي نيكاراغوا، تجلت صورة الالتقاء بشكل فريد عبر القساوسة الحمر الذين شاركوا الماركسيين في خندق واحد ضد دكتاتورية سوموزا. لقد جمع هؤلاء القساوسة بين الإيمان والعمل الماركسي، متحدين في مواجهة الطغيان، لكنهم بعد الانتصار واجهوا صعوبات في الموازنة بين مشروعهم الديني والدولة الماركسية الوليدة، مما يؤكد قاعدة التاريخ: الوحدة في المقاومة لا تعني الوحدة بعد التحرير.
هذه التجارب المتنوعة تؤكد حقيقة مركزية: الالتقاء بين الديني والماركسي قائم على ضرورة مواجهة العدو المشترك، وليس على توافق أيديولوجي. إنه التقاء تكتيكي، مؤقت، ومرهون بزمن الحرب أو المواجهة. وما أن تنقشع سحب المعركة، تبدأ الانقسامات الفكرية والاجتماعية بالظهور، وكأن التاريخ نفسه يذكّرنا بأن كل تحالف ضد الظلم، مهما كان موحدا في الظاهر، يواجه تحديات بعد التحرير.
ومع ذلك، فإن هذا الالتقاء يحمل قيمة إنسانية عظيمة، فهو يثبت أن الإنسان قادر على تجاوز الاختلافات الفكرية والدينية حين يكون الحرمان والظلم على المحك. إنها لحظة تاريخية نادرة تظهر أن الإنسان، حين يهدد وجوده، يستطيع أن يجد في المختلف عنه رفيقا في المعركة، حتى ولو لم يلتقِ معه في الرؤية النهائية للمجتمع.
تكشف هذه التجارب عن أن التحرر لا يكتمل إلا عندما يلتقي التحرر الوطني مع التحرر الاجتماعي. فالماركسي يرى أن مقاومة الاحتلال يجب أن تترافق مع مقاومة الاستغلال الطبقي، بينما يرى الديني أن مقاومة الاحتلال تكفي لإثبات مشروعية السلطة الروحية. وهنا يبرز التناقض الجذري بعد الانتصار: كيف يمكن بناء مجتمع حر ومتساو إذا كانت السلطة في يد المرجعية الدينية؟ وكيف يمكن الحفاظ على الوحدة الوطنية إذا تم إقصاء مشروع المساواة الاقتصادية والاجتماعية؟
تجارب إيران ونيكاراغوا وغزة ولبنان تؤكد أن التقاء الماركسي بالديني في الخندق هو لحظة إنسانية وتاريخية فريدة، لكنها دائما محدودة ومؤقتة. وعليه، يمكننا استخلاص ثلاثة دروس أساسية:
+التحالف العسكري أو المقاوم قائم على الضرورة، وليس على التوافق الفكري أو الاجتماعي. الوحدة تكتيكية ومرحلية، وهدفها مواجهة العدو المشترك لا بناء مجتمع مشترك.
+انتهاء الصراع العسكري يكشف التناقضات الجوهرية بين الرؤى الاجتماعية والأيديولوجية. الماركسي يسعى للعدالة والمساواة، والديني يسعى للمرجعية الدينية وسيطرة القيم الروحية. هذه التناقضات غالبا ما تؤدي إلى صراعات داخلية بعد التحرير.
+القيمة الحقيقية لهذه التجارب تكمن في الدرس الإنساني: الإنسان قادر على تجاوز الاختلافات حين يكون مصيره على المحك، ويستطيع أن يتحد مع المختلف عنه فكريا وروحيا في سبيل العدالة والحرية.
في الختام، يمكن القول إن التاريخ من طهران إلى غزة، ومن لبنان إلى نيكاراغوا، يقدم درسا مزدوجا: درسا في ضرورة الوحدة التاريخية لمواجهة الظلم، ودرسا في حدود هذه الوحدة بعد الانتصار، حيث يظهر أن بناء مجتمع حر وعادل يتطلب رؤية موحدة تتجاوز اللحظة العسكرية أو الرمزية. كما يقول غرامشي:
"الثورة ليست فقط في إسقاط الظالم، بل في بناء الإنسان والمجتمع الجديد."
إن الالتقاء بين الديني والماركسي في خندق المقاومة، مهما كان مؤقتا ومحدودا، يظل شاهدا حيا على قدرة الإنسان على المقاومة، وعلى البحث عن العدالة والحرية، وعلى أن الاختلافات الفكرية يمكن تجاوزها حين تكون الكرامة والوجود على المحك. إنه درس نادر، لكنه أساسي لكل من يسعى لفهم طبيعة الصراع بين القوة، والعدالة، والإنسانية، عبر كل الأزمنة والمواقع.
#رياض_الشرايطي (هاشتاغ)



ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

|
حفظ
 |
بحث |
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
| إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
اتفاق شرم الشيخ: عودة الانتداب بثوب أمريكي – قراءة في مشروع
...
-
غزة والمقاومة: غنيمة التّاريخ وبوصلة الأحرار
-
من -الشعب يريد- إلى -النهضة تقرر- إلى -الرئيس يقرر
-
الأفقية والقاعدية: تفكيك مفاهيمي وتحليل تطبيقي.
-
البناء القاعدي والتسيير الذاتي: بين النظرية، التجارب، والتحو
...
-
السلاح ، المخدرات و الادوية ، اسلحة للثراء و اخضاع الشعوب.
-
تحليل مقتضب للنرجسية الفردية و السّلطة والشعبوية.
-
الاعتراف بالدولة الفلسطينية: خطوة ناقصة في معركة طويلة ضد ال
...
-
الأدب العربي والترجمة: ساحة المقاومة والوعي.
-
الأدب والتكنولوجيا: بين انفتاح النص وقلق المستقبل.
-
نقد الإبداع وإبداع النقد.
-
بقايا الطلائع القديمة: الثورة بين الخطاب والممارسة والخيبة.
-
اللّجوء بين إنسانية العالم وابتزاز السياسة: في أزمة النظام ا
...
-
قراءة نقدية تفكيكية لرواية -أنا أخطئ كثيرا- للاديبة اللبناني
...
-
11 سبتمبر 2001 ، انطلاق اللّعبة الامبريالية الكبرى.
-
الحرب كحقل تجارب للذكاء الاصطناعي: كيف أصبحت غزة مختبرا للمر
...
-
رؤوس أقلام حول أمريكا: الإمبريالية الحربية والاقتصادية من ال
...
-
أحفاد مانديلا . تحرير العمل: الدرس الجنوب إفريقي.
-
البيروقراطية
-
السودان يحترق... والطبقات الحاكمة تتقاسم الخراب
المزيد.....
-
ترامب يكشف عن مكالمة مع رئيس فنزويلا ويوضح ما قصده بغلق مجال
...
-
مفاوضات فلوريدا.. تفاؤل بإنهاء حرب أوكرانيا رغم الخلافات
-
وزير خارجية بولندا: نرغب في إنهاء عادل للحرب وبحدود آمنة لأو
...
-
مواجهات في جنين والاحتلال يقتحم مناطق عدة بالضفة والقدس
-
طالبو اللجوء بين رغبات ترامب بالترحيل وقرارات القضاء الأميرك
...
-
تونس.. رجال الرئيس ينتفضون ضده
-
عاجل | ترامب: أجريت اتصالا مع مادورو ولا أريد الخوض في التفا
...
-
فيضانات استثنائية تشرد آلاف السكان بماليزيا
-
محادثات ميامي تمهد لعرض خطة ترامب على موسكو
-
مدغشقر.. ساحة تنافس جديدة بين باريس وموسكو؟
المزيد.....
-
اليسار الثوري في القرن الواحد والعشرين: الثوابت والمتحركات،
...
/ رياض الشرايطي
-
رواية
/ رانية مرجية
-
ثوبها الأسود ـ قصص قصيرة جدا
/ حسين جداونه
-
تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ
/ غنية ولهي- - - سمية حملاوي
-
شيوعيون على مر الزمان ...الجزء الأول شيوعيون على مر الزمان
...
/ غيفارا معو
-
حكمة الشاعر عندما يصير حوذي الريح دراسات في شعر محمود درويش
/ د. خالد زغريت
-
التاريخ يكتبنا بسبابته
/ د. خالد زغريت
-
التاريخ يكتبنا بسبابته
/ د. خالد زغريت
-
جسد الطوائف
/ رانية مرجية
-
الحجز الإلكتروني المسبق لموسم الحنطة المحلية للعام 2025
/ كمال الموسوي
المزيد.....
|
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

 |
بحث
|
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
|
إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة