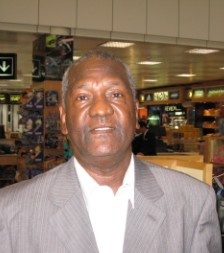|
|
كتاب التعليم في السودان : الحصاد والاصلاح
تاج السر عثمان


الحوار المتمدن-العدد: 8352 - 2025 / 5 / 24 - 00:50
المحور:
التربية والتعليم والبحث العلمي
التعليم في السودان : الحصاد والاصلاح
تأليف: تاج السر عثمان
الخرطوم : فبراير 2023
المحتويات
الموضوع الصفحة
تقديم
اولا : في يومه العالمي حتى لا يصبح التعليم للقادرين.
ثانيا : التعليم في السودان القديم .
ثالثا: التعليم في ممالك النوبة المسيحية.
رابعا : التعليم في مملكة الفونج
خامسا : التعليم في فترة الحكم التركي
سادسا : التعليم في فنرة المهدية
سابعا : التعليم في فترة الاستعمار البريطاني
ثامنا : التعليم في الفنرة 1956 – 1989م.
تاسعا : تجربة تخريب التعليم بعد انقلاب 25 مايو 1969.
عاشرا : التخريب الممنهج للتعليم في فترة الاتقاذ.
احدى عشر: التعليم بعد ثورة ديسمبر
ثاني عشر : حصاد التعليم بعد الاستقلال.
ثالث عشر : اصلاح وأهداف التعليم.
تقديم :
يتناول هذا الكتاب قضية التعليم باعتبارها حجر الزاوية في تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة ، بحيث لا يمكن الحديث عن نجاح الفترة الانتقالية دون تصفية آثار نظام الانقاذ وما يُسمى بالمشروع الحضارى الذي دمر مؤسسات القطاع العام ونهبها ، ولا سيما في المؤسسات التعليمية والصحية والذي في ظله اصبح التعليم للقادرين ، وسلعة بعد سياسة التحرير الاقتصادي التي اعلنها وزير المالية حمدى في بداية تسعينيات القرن الماضي .
كما لا يمكن تحسين التعليم وتطويره بدون دعم الدولة للتعليم ورفع ميزانيته ، وتوفير مقومات التعليم من اساتذة وكتاب ومعامل ، وتحسين واستقرار وضع المعلمين المعيشي والمهنى ، وتحسين بيئة المدارس ، وتعميق ديمقراطية التعليم حتى يصبح متاحا للجميع غض النظر عن الوضع الطبقي أو الدين أو اللغة أو العرق أو النوع ، ويصبح شاملا للتعليم المهنى والاكاديمي ،ووضع الأساس لتعليم جيد ، باعتبار أن التعليم معيار لتقدم المجتمع في مختلف المناحى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، واصبح في عالم اليوم أداة جبارة واستثمار بشري لا يقدر بثمن لمستقبل البلاد والبشرية ، وكل التحولات الجارية في الميادين المختلفة ترجع الى تطور المعرفة والتعليم التى راكمتها البشرية خلال سنوات طويلة ورتبتها في حقائق منطقية منظمة تناقلتها الأجيال جيلا بعد جيل الى أن وصلتنا بعد ان اضفنا اليها الجديد المبتكر في عالم المعرفة والحضارة.
تناول الكتاب في فصله تطور التعليم في السودان منذ السودان القديم وحتى بعد الاستقلال ، وختم بحصاد التعليم بعد الاستقلال ، وكيف يتم اصلاح التعليم وتحقيق أهدافه.
أخيرا’ نأمل أن يثير الكتاب تقاشا مثمرا حول تطوير نظام التعليم في السودان ، وتحقيق أهدافه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
تاج السر عثمان
23 نوفمبر 2023
أولا
في يومه العالمي حتى لايصبح التعليم للقادرين
بقلم : تاج السر عثمان
1
يصادف 24 يناير يوم التعليم العالمي الذي اقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها المنعقدة في 23 ديسمبر 2018 باعتبار أن التعليم يُعد من حقوق الانسان الأساسية ، فالمادة (26) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان تدعو الي التعليم الابتدائي المجاني والالزامي، بل ذهبت اتفاقية حقوق الطفل عام 1989 لتوسيع الحق في التعليم " حتى توفير تعليم جيد وشامل وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة"، وباعتبار انه لا تنمية وتقدم وازدهار بدون تعليم ، وهدف التعليم التنمية والسلام وتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين ، وكسر دائرة الفقر.، لكن التعليم في ظل الأزمة العامة للرأسمالية الراهنة اصبح للقادرين مع الاستقطاب الطبقي الجارى في العالم وفي كل دولة ، فحسب احصائية الأمم المتحدة وضع التعليم مزرى في العالم ، حيث يوجد 244 مليون طفل خارج المدرسة و771 مليون امي ، بالتالي جاء شعار العام 2023 " ايلاء الأولوية للتعليم كوسيلة للاستثمار في البشر " ، ويصبح من المهم التعبئة السياسية الفورية حول تحسين التعليم كما ونوعا الذي بدونه لن تتقدم الشعوب، وحنى لايصبح التعليم للقادرين.
2
لكن من المؤسف أن يمر يوم التعليم العالمي والبلاد تشهد تدهورا غير مسبوق في التعليم ، فحسب احصاية منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( يونسيف) في بيانها بتاريخ : 12 /9/ 2022 "يوجد في السودان 6,9 مليون طفل خارج التعليم ، و12 مليون يواجهون عدم الاستقرار في التعليم" بمعني أن هناك 12 مليون طفل ستنقطع دراستهم بسبب الحروب وعدم الاستقرار اوالكوارث المحدقة بالبلاد ، ومشاكل البنية التحتية ونقص المعلمين والكتاب المدرسي ، وانهيار المباني ، والحروب والتجنيد الاجبارى للمليشيات والحركات المسلحة، وتهريب البشر، وتصفية الداخليات في المدارس. الخ ، هذا بلا شك وضع خطير يهدد مستقبل الوطن واجياله القادمة.
هذا اضافة لتدهور أوضاع المعلمين المعيشية الذين يشكلون ركيزة التعليم ، فبدون استقرار المعلم وتحسين أوضاعه المعيشية والمهنية وتأهيله باستمرار، وتحسين بيئة العمل ، لا يمكن توفير التعليم الجيّد، مما أدي لاضراب المعلمين من أجل تحقيق مطالبهم التي تتلخص في : زيادة الحد الأدنى للاجور الي 69 الف جنية ، ودفع كامل المستحقات من بدلات وعلاوات لمدة 3 اشهر ، وتحسين بيئة التعليم في المدارس الحكومية.
تصاعد اضراب المعلمين ودخل شهره الثاني ، وزاد الأمر تعقيدا تعنت السلطة الانقلابية التي اغلقت المدارس بهدف كسر الاضراب حتى 26 يناير الحالي ، واعلنت لجنة المعلمين مواصلة الاضراب عقب انتهاء العطلة والتصعيد بمختلف الأشكال في حال عدم تحقيق مطالبهم، والتمسك بتنفيذ كافة القرارات الصادرة في حق المعلمين من مجلس الوزراء التي تشمل كل العاملين في قطاع التعليم من عمال وموظفين ، وتعديل العلاوات بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي في البلاد، اضافة الى رفض الرسوم التي تطالب بها لجنة الاتحاد المهنى ل"لفلول" التي انتهت مدتها منذ العام 2019 بهدف مواصلة النهب وافقار المعلمين.
كما تدهورت الاوضاع في التعليم العالي جراء تدهور اوضاع اساتذة الجامعات وعدم توفير مقومات التعليم العالي ، ومضاعفة الرسوم الدراسية على الطلاب ، مما أدي الى تصاعد الاضرابات ، ورفض سياسة تحرير التعليم ، حتى لا يصبح للقادرين فقط ، كما في اضرابات الطلاب الرافضة لتلك الزيادات الكبيرة التى سوف تخرج الكثيرين من التعليم الجامعي وتكون وبالا على البلاد، اضافة لاضراب الأساتذة في الجامعات من أجل تحسين الهيكل الراتبي .
يكذب وزير المالية جبريل إبراهيم حين يقول " 40 % من ميزانية السودان تذهب للتعليم والصحة!! (الراكوبة 23 يناير 2023)، واذا كان الأمر كذلك لاصبح السودان في مصاف الدول المتقدمة ، والواقع أن 76 % من الميزانية تذهب للأمن والدفاع بهدف قمع المواكب السلمية ، وتهرب عشرات المليارات من الدولارات ( عائدات الذهب والمحاصيل النقدية للخارج)، وتستحوذ شركات الجيش والأمن والشرطة والدعم السريع علي 82% من موارد البلاد ، فضلا عن دفع الدولة لمرتبات مليشيات الدعم السريع ، ونهب السلطة الانقلابية و حركات جوبا لجيب المواطن من خلال الضرائب الباهظة التي فاقت جبايات الحكم التركي ، مما ادي للرفض الواسع لها كما في اضرابات التجار والمزارعين واصحاب الشاحنات والحافلات. الخ. بالتالي الذي يذهب للتعليم والصحة صئيل جدا كما يوضح التدهور الحالي في التعليم والصحة ونقص الأدوية المنقذة للحياة، تدهور الأوضاع في المستشفيات الحكومية ، وتدهور اوضاع العاملين في القطاع الصحي كما عكست اضراباتهم ووقفاتهم الاحتجاجية.
3
الحديث عن نجاح الفترة الانتقالية لا يستقيم دون تصفية آثار نظام الانقاذ وما يُسمى بالمشروع الحضارى الذي دمر مؤسسات القطاع العام ونهبها ، ولا سيما في المؤسسات التعليمية والصحية والذي في ظله اصبح التعليم للقادرين ، وسلعة بعد سياسة التحرير الاقتصادي التي اعلنها وزير المالية حمدى في بداية تسعينيات القرن الماضي .
كما لا يمكن تحسين التعليم وتطويره بدون دعم الدولة للتعليم ورفع ميزانيته ، وتوفير مقومات التعليم من اساتذة وكتاب ومعامل ، وتحسين واستقرار وضع المعلمين المعيشي والمهنى ، وتحسين بيئة المدارس ، وتعميق ديمقراطية التعليم حتى يصبح متاحا للجميع غض النظر عن الوضع الطبقي أو الدين أو اللغة أو العرق أو النوع ، ويصبح شاملا للتعليم المهنى والاكاديمي ،ووضع الأساس لتعليم جيد ، باعتبار أن التعليم معيار لتقدم المجتمع في مختلف المناحى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، واصبح في عالم اليوم أداة جبارة واستثمار بشري لا يقدر بثمن لمستقبل البلاد والبشرية ، وكل التحولات الجارية في الميادين المختلفة ترجع الى تطور المعرفة والتعليم التى راكمتها البشرية خلال سنوات طويلة ورتبتها في حقائق منطقية منظمة تناقلتها الأجيال جيلا بعد جيل الى أن وصلتنا بعد ان اضفنا اليها الجديد المبتكر في عالم المعرفة والحضارة.
بالتالي النظرة للتعليم يجب أن تكون شاملة حتى تساعد الأجيال الجديدة على توسيع آفاقهم ومداركهم ، وتنمى فيهم روح الخلق والايتكار والابداع واضافة الجديد ، ورفض الاستظهار وربط المعرفة بالممارسة والنظرية بالتطبيق ، والانطلاق من الواقع الى المجرد ومن المجرد الى الواقع ، وتنمية النظرة الناقد ة ، ومواصلة التعليم مدى الحياة، فالانسان كلما ازداد معرفة ازداد حبا للمزيد منها، ورفض التعصب والانغلاق وادعاء احتكار الحقيقة المطلقة .
التعليم هو المرآة لتطور المجتمع واتجاهه العام في الفترات المختلفة التي يمر بها و يعكس احتياجاته المختلفة في تلك الفترات كما يعكس أهدافه التى نريد غرسها في الناشئة حتى يستطيعوا هضمها واستيعابها.ومن أهداف التعليم ايضا تعريف الأبناء علي تراثهم وجذورهم وثقافتهموتمثلها نقديا ، وتدريبهم مهنيا وعلميا لمواجهة احتياجات المجتمع المعينة ولاكتساب حرفة أو تدريب معين وتشريب الأجيال الجديدة بثقافات ومعارف مجتمعاتهم والعالم من حولهم، علما بأن التعليم طبقي وينطلق من موجهات الطبقات السائدة، ولكنه كجزء من البنية العلوية في المجتمع له استقلاله النسبيظ وكجزء من الوعى الذي يصبح قوة مادية يؤدي الي تغيير المجتمع في ظل التبادل الديالكتيكي المتشابك بين البنية التحتية والعلوية للمجتمع .
في اليوم العالمي للتعليم مهم مواصلة المقاومة من أجل اسقاط الانقلاب ، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية ومجانية التعليم والصحة ودعم الوقود والكهرباء والدواء والخبز وبقية السلع الأساسية ،وتأهيل المشاريع الزراعية والصناعية والمؤسسات التعليمية والصحية ، مما يضع الأساس لتعليم يسهم في ترقية وتطور البلاد .
ثانيا
التعليم في السودان القديم (2)
أشرنا في المقال السابق الي دور التعليم في تطور المجتمع وكاستثمار بشري ، و ضرورة دعم الدولة للتعليم ورفع ميزانيته ( الميزانية الحالية للتعليم لا تتجاوز 1%) ، وتوفير مقومات التعليم من: اساتذة وكتاب ومكتبات ومعامل، ونشاط مدرسي مصاحب للعملية التعليمية والتربوية ، وتحسين واستقرار وضع المعلمين المعيشي والمهنى ، وديمقراطية واستقلالية نقابات المعلمين واتحادات الطلاب، وحرية البحث العلمي والأكاديمي واستقلالية الجامعات، وتحسين بيئة المدارس ، وأن يكون التعليم شاملا ومجانيا وديمقراطيا ومتاحا للجميع غض النظر عن السكن في المدينة أو الريف أو الأصل الطبقي ، أو الدين أو النوع ، أو اللغة أو العرق ، وأن يكون شاملا للتعليم المهنى والاكاديمي ، ووضع الأساس لتعليم جيد ، باعتبار أن التعليم معيار لتقدم المجتمع في مختلف المناحى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، واصبح في عالم اليوم أداة جبارة واستثمار بشري لا يقدر بثمن لمستقبل البلاد والبشرية ، وكل التحولات الجارية في الميادين المختلفة ترجع الى تطور المعرفة والتعليم التى راكمتها البشرية خلال سنوات طويلة ورتبتها في حقائق منطقية منظمة تناقلتها الأجيال جيلا بعد جيل الى أن وصلتنا بعد ان اضفنا اليها الجديد المبتكر في عالم المعرفة والحضارة..
التعليم في السودان القديم
في السودان القديم لم يكن التعليم معزولا عن المجتمع من العصور الحجرية وحتى نشأة الحضارة السودانية في ممالك كرمة ونبتة ومروي، كما في بقية أنحاء العالم في تطور الصناعة الحرفية وفنون التجارة والعمارة واللغة المكتوبة، وعلم الفلك ، وفنون الحرب والرسم والنحت والموسيقي.الخ
1
فمنذ عصور ما قبل التاريخ ( العصر الحجري ) ترك التعليم والتدريب النابع من الممارسة وحاجات المجتمع ، سواء اليدوي أو الذهني بصماته علي نشاط الانسان السوداني في العصور الحجرية ، كما أوضحت الحفريات التي قام بها علماء الآثار في خور أبي عنجه ، والشهيناب والخرطوم وما عثروا عليه من آثار تلك الحفريات ، نجد أن الإنسان السوداني عاش علي الصيد وجمع الثمار ،كما استخدم أدوات إنتاج مصنوعة من الخشب والحجر والعظام واكتشف في مراحل متقدمة تقنية النار التي طهي بها الطعام ، وحمي بها نفسه من الحيوانات المفترسة، كما عرف صناعة الفخار وبناء المسكن من الأجر (الطين)في العصر الحجري الحديث بدلاً من السكن في الكهوف أو جذوع الأشجار الضخمة.
كان هذا الإنسان يتعلم ويتدرب ويتطور مع تطور التقنية وأدوات الإنتاج ،ومع وجود فائض من الأغذية (فائض اقتصادي) يساعده علي أيجاد وقت الفراغ اللازم لتنمية مهاراته وصناعاته الحرفية الأخرى. ودار فن ونشاط الإنسان في تلك العصور حول الصيد، فنلاحظ رسوم الحيوانات علي الكهوف، وفن الرقص والدراما الذي يدور حول الصيد. وقياساً علي ما حدث في اغلب المجتمعات البشرية القديمة.
( للمزيد من التفاصيل راجع، تاج السر عثمان : الدولة السودانية : النشأة والخصائص ، الشركة العالمية 2007).
2
في نهاية العصر الحجري الحديث (النيوليتي)، تطور التعليم والتدريب مع اكتشاف الزراعة وتربية الحيوانات، وتطور التجارة والصناعة الحرفية ، أي بعد ما يُعرف الثورة "النيولوتية" ، وهي أول ثورة اقتصادية عرفها الإنسان ، والتي تم فيها الانتقال من مجتمع يقوم اقتصاده علي الصيد والتقاط الثمار إلى مجتمع زراعي رعوي .
وفي حضارة المجموعة (أ) وحضارة المجموعة (ج) اللتين أشار أليهما علماء الآثار بعد العصور الحجرية ، نجد أنفسنا أمام تشكيلة اجتماعية انتقالية ، ونلاحظ أن الإنسان السوداني مارس الزراعة والرعي بدرجات متفاوتة في تلك الحضارتين ، ولاريب أن انتقال المجتمع السوداني من تشكيلة اجتماعية بدائية ، كانت تقوم علي الصيد والتقاط الثمار إلى مجتمع زراعي رعوي اخذ فترة تاريخية طويلة ومعقدة.
من خلال عمليات التبادل التجاري كما أوضحت أثار حضارة المجموعة (أ) ، نلاحظ أن تلك الحضارة عرفت الفائض الاقتصادي .كما عرفت تلك الحضارة استخدام المعادن تلك التقنية المتطورة التي ارتبطت بمرحلة ارقي من العصر الحجري فيما يختص باستخدام المعادن (نحاس، برونز،..الخ.) بدلاً من استخدام الخشب والحجر والعظام وصناعة الأواني وأدوات الزينة وأدوات الإنتاج كما يظهر لنا من وجود المواد المصنوعة من النحاس ضمن مخلفات أثار تلك الحضارة .وطبيعي انه مع اكتشاف الزراعة وتربية الحيوانات أن قبائل وشعوب تلك الحضارة بدأت تشهد بذور الفوارق الاجتماعية نتيجة التفاوت في امتلاك الفائض من الغذاء في و ملكية الماشية كما أن الدولة لم تتبلور بشكل واضح في حضارة المجموعة (أ) لسبب الانخفاض في الفائض الاقتصادي وضعف أو بدايات بذور الفوارق الطبقية ،وبالتالي لم تظهر السلالات الحاكمة والتي أصلا تعيش علي إنتاج الفائض ، وتكون مهامها ممارسة الحكم وشئون السياسة مع الموظفين والكهنة ، وفيما يختص بالبنية الفوقية أو البنية الثقافية - الفكرية ، نلاحظ أن حضارة المجموعة (أ) لم تعرف اللغة المكتوبة ، وربما حدث تطور في فنون تلك الحضارة نتيجة لاكتشاف الزراعة فالرقص يعبر بشكل من الأشكال عن العمليات الزراعية من بذر وحصاد كما أن الرعي وتربية الحيوانات كان له أثره علي رسوما تهم وفنونهم ورقصهم وأغانيهم ودياناتهم كما أن الانتقال إلى مجتمع زراعي رعوي ارتبط ايضاً بتطور دياناتهم الوثنية التي ارتبطت بحياتهم نفسها مثل ألا لهه التي تنزل الأمطار فتسقي الزرع والضرع وخوفهم من غضبها الذي يتجلي في الجفاف وانحسار النيل أو الفيضانات المدمرة هذا إضافة لتطور الديانات الوثنية المرتبطة بالأيمان والخلود والحياة بعد الموت كما نلاحظ ذلك من الأشياء والطعام الموجود مع الموتى في الجبانات والتي ترتبط بالمجتمعات الزراعية الرعوية ( بقر ، خيول ، خبز ، لبن.الخ) وكانت الديانات تتطور مع تطور المجتمع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .أما سكان حضارة المجموعة (ج) فقد اتضحت لنا طبيعتهم الرعوية كما يظهر من اهتمامهم الشديد بالأبقار التي رسموها علي الصخور وشكلوها من الطين ورسموها علي أسطح انيتهم كما نلاحظ أن منازلهم كانت من الخيام والقطا طي وغير ذلك مما يتطلبه الترحال من وقت لاخر. ( تاج السر عثمان، الدولة السودانية مرجع سابق)
هكذا نلاحظ تطور المجتمع السوداني والتعليم والتدريب الذي كان يعيش حالة المخاض ليشهد ميلاد الحضارة السودانية وانه كان يعيش مرحلة انتقالية طويلة ومعقدة من مجتمع بدائي إلى مجتمع زراعي رعوي وان التشكيلة الاجتماعية الانتقالية بدأت تشهد بذور الفوارق الاجتماعية الطبقية وبدايات الإنتاج الفائض وعمليات التبادل التجاري مع المملكة المصرية المجاورة وبدايات استخدام المعادن وغير ذلك من بذور التطور الحضاري .
3
مملكة كرمة:
التراكمات الحضارية السابقة آدت إلى تحولات نوعية، فقد شهد سودان وادي النيل اقدم دولة سودانية هي مملكة كرمة كان ذلك نتاج التطور واتساع الفروق الاجتماعية وظهور الطبقات المالكة والتي كانت من وظائفها حماية امتيازات ( ملوك ، كهنه، إداريين ، موظفين،.الخ) وحماية التجارة وبسط الأمن وبالتالي ظهر الجيش ليقوم بتلك الوظائف وتحت ظل هذه الدولة شهد السودان قيام أول مدن كبيرة وشهد أول انقسام بين المدينة والريف كما تطورت التجارة مع المملكة المصرية وتطورت الصناعة الحرفية مثل الفخار ، السلاح، العناقريب أدوات الزينة ..الخ. وشهد السودان أول انقسام طبقي وعرف المجتمع طبقتين أساسيتين : الطبقة المالكة التي تشمل الملوك، وحكام الأقاليم، والكهنة، والإداريين، والموظفين، والتجار، وطبقة الشعب التي تضم المزارعين، والحرفيين، الرقيق ، الرعاة. كما عرفت دولة كرمة الفائض الاقتصادي الناتج من تطور الزراعة والرعي والتجارة والصناعة الحرفية ويتضح ذلك من الاكتشافات الأثرية التي أمدتنا بمعلومات عن التطور في تلك الجوانب .وعلي أساس هذه القاعدة الاقتصادية ولعوامل متداخلة ومتشابكة دينية وسياسية نشأت الدولة ويبدو أن تراكم الفائض الاقتصادي في يد الكهنة من العوامل التي أدت إلى قيام الدولة ونشأة المدينة التي قامت حول معبد أو مبني ديني ويتضح ذلك من الأراضي الزراعية التي كان يملكها الكهنة والتي كانت تمد الدولة والمعابد بالاحتياجات.
ويفيدنا عالم الآثار شارلس بونية في مؤلفه (كرمة مملكة النوبة) . بان المدينة عرفت التنظيم الإداري وبوجود ملك علي قمة المجتمع وكهنة وطبقات واداريين في المدينة والريف وكان قادة الجيش جزءاً من الطبقة الحاكمة .كما تطور فن الحرب كما يتضح من خلال بناء الحصون والخنادق والأسلحة ( سيوف ، خناجر ، سهام ) قامت الدولة بتنظيم النشاط التجاري وكانت الأساطيل البحرية القادمة من وسط إفريقيا أو من المناطق القريبة من البحر الأحمر ( في الآثار وجدت نماذج من المراكب من الطين أو الحجر) ويمتلك البحارة عدداً من المراكب المتنوعة التي صنعت من خشب السنط أو الحراز إضافة للنقل النهري كانت هناك القوافل المؤلفة من الرجال والدواب تحت حماية عسكرية ، وفي التبادل التجاري مع مصر ،هناك عدد من البضائع المنتجة بالمصانع المصرية ، تتوجه نحو كرمة كذلك المواد الغذائية المعبئة في جرار. وعرفت كرمة الطبقة التجارية التي كانت تتكون من مجموعة المصريين المستوطنين بكرمة .( شارلس بونية ، كرمة مملكة النوبة ، دار الخرطوم للطباعة والنشر 1997 ، ترجمة احمد محمد علي حاكم وإشراف : صلاح الدين محمد احمد.).
أشار بونيه إلي أن الكهنة كانوا يمتلكون ثروة كبيرة وهذه الثروات مع نفوذهم الديني مكنت لهم في الأرض، ووجد الكهنة وقت الفراغ الذي جعلهم يفكرون آو ربما كان لهم علم بالفلك وأسرار بعض الصناعات والهندسة.الخ وكان لهم تنظيم إداري دقيق جعلهم يتمكنون من جمع الزكاة أو الهدايا من المواطنين ، كما توضح السلال والأختام والصناديق الخشبية ،كان من وظائف الكهنة مساعدة الفقراء والمحتاجين من الفوائض الاقتصادية والعينية التي كانت تصلهم ، وربما كان المعبد الكبير ضمن مخلفات آثار تلك الحضارة ، وبحكم وضعه الديني كان التجار والأغنياء يحفظون فيه ثرواتهم وبضائعهم النادرة .
واخيراً لا نعرف شيئا عن البنية الفوقية ( الثقافية ـ الفكرية) لمملكة كرمة لان الآثار لم توضح لنا إن ملوك كرمة تبنوا اللغة الرسمية مكتوبة وبالتالي لم يتركوا وراهم أي سجلات تساعدنا في معرفة أسمائهم أو حدود مملكتهم ، واعمالهم ونشاطاتهم الأخرى ولكن نسمع عن ثقافة كرمة المتطورة التي نتجت عن الاحتكاك مع العالم الخارجي وتبادل الفنون وحاصل هذا التفاعل أدى إلى ثقافة كرمة المتطورة والمتميزة .علي إن حضارة كرمة لم يكتب لها الاستمرار ، إذ قضي عليها التدخل المصري في السودان في زمن الأسرة الثامنة عشر الذي عجل بنهاية مملكة كرمة فوقعت بلاد النوبة بين الشلال الأول والرابع تحت الاحتلال المصري.
4
مملكة نبتة :ـ
التطور الآخر في مسار الدولة السودانية والحضارة السودانية هو قيام مملكة نبتة (850 ق.م ـ300ق.م) التي اتسعت حدودها شمالاً وضمت في فترة معينة مصر نفسها وأسست الأسرة المالكة الخامسة والعشرون وكانت وظائف تلك الدولة هي جمع وتركيز الفائض الاقتصادي ، ومساعدة الفقراء والمحتاجين من الرعايا وخدمة الآلهة ببناء المعابد، وحفظ أمن المملكة من هجمات القبائل الصحراوية المجاورة ، وحماية مصالح الطبقات الحاكمة . كما تطور الانقسام الطبقي واتسعت الهوة بين الحكام والشعب كما يتضح من أن الملوك والحكام جمعوا ثروات ضخمة ويظهر ذلك من آثارهم سواء كان ذلك في بناء المعابد والتماثيل الضخمة أو امتلاك المعادن الثمينة ( الذهب ، الفضة ،.الخ ).
من الناحية الثقافية الفكرية ظل التأثير المصري قوياً في مملكة نبتة فمثلاً صار ملوك الآسرة الخامسة والعشرون يحملون الألقاب الفرعونية ويستعملون اللغة الهيروغليفية المصرية ويعبدون إلهة مصر (آمون ) لمدة طويلة . كان الكهنة يتحكمون في الدولة والملوك من زاوية أن الكهنة كانوا ينتخبون الملوك ويعزلونهم وكان بعض الملوك يصارعون ضد هذا التحكم.
5
مملكة مروي :ـ
كانت مملكة مروي (300ق.م -350م) تطوراً ارقي واوسع في التعليم والتدريب ، و مسار الدولة والحضارة السودانية ، وفيها تجسد الاستقلال الحضاري واللغوي والديني.
- في الجانب الاقتصادي: تطورت أساليب وفنون الرعي وتربية الحيوانات حيث ظهر اهتمام اكبر بالماشية وبناء الحفائر لتخزين المياه واستعمالها في فترات الشح.
- دخلت الساقية السودان في العهد المروي ، واحدثت تطوراً هائلاً في القوه المنتجة حيث حلت قوة الحيوان محل قوة الإنسان العضلية ، وتم إدخال زراعة محاصيل جديدة ، أصبحت هنالك اكثر من دورة زراعية واحدة.
- ازدهرت علاقة مروي التجارية مع مصر في عهود البطالمة واليونان والرومان ، وكانت أهم صادرات مروي إلى مصر هي: سن الفيل والصمغ والروائح والخشب وريش النعام بالإضافة إلى الرقيق ، وكانت التجارة تتم بالمقايضة.
- شهدت مروي صناعة الحديد الذي شكل ثورة تقنية كبيرة. وتم استخدامه في صناعة الأسلحة وأدوات الإنتاج الزراعية مما أدى إلى تطور الزراعة والصناعة الحرفية ، كما تطورت صناعة الفخار المحلي اللامع .
وفي الجانب الثقافي - الفكري شهدت هذه الفترة اختراع الكتابة المروية ،وكان ذلك خطوة كبيرة في نضوج واكتمال حضارة مروي، وظهرت آلهة جديدة محلية : ابادماك ،ارنستوفس , سبوي مكر .
تفاعل المرويون مع ثقافات وحضارات اليونان والرومان كما يتضح في فنون ونقوش المرويين في المعابد ، وكانت حصيلة التفاعل حضارة مروية سودانية ذات خصائص وهوية مستقلة ، كما تطورت فنون الرسم.والموسيقي نتيجة للتطورات الاقتصادية والثقافية والتفاعل مع العالم الخارجي .
(نواصل)
ثالثا :
التعليم في ممالك النوبة المسيحية (3)
اوضحنا سابقا أن عملية التربية والتعليم ترجع جذورها الى السودان القديم وحضاراته الباذخة مثل حضارة مملكة مروي، وكتابتها المميزة التي تقف دليلا على قدم التعليم في السودان، وظل التعليم مستمرا بعد العهد المروي.
فقد شهد التعليم تطورا في حضارة النوبة في السودان الوسيط ( 500 – 1500م) التي عرفت قيام ممالك النوبة "نوباطيا ، المقرة، علوة” التي اصبحت مسيحية فيما بعد، وتميزت بالازدهار الاقتصادي والثقافي ، وكانت البنية الاقتصادية مترابطة تقوم علي الزراعة والرعي والصيد والصناعة الحرفية والتجارة.
كما اتسمت البنية الطبقية للمجتمع النوبي بالتفاوت ، فقد كان المجتمع يتكون من طبقة الحكام والإداريين وقادة الجيش ورجال الدين والتجار والحرفيين" الحدادين، النجارين،. الخ"، والمزارعين والرقيق.
اما فيما يختص بالبنية الثقافية للمجتمع، فقد تميزت بتطورات مهمة حيث ازدهرت الثقافة النوبية التي تجلت في التحف الأثرية القيّمة من التصوير وتصميم الكنائس وصناعة الآواني الفخارية التي تدل علي مستوي رفيع للثقافة النوبية، كما تم التوصل الي تأليف ابجدية من الحروف القبطية واليونانية ، تم استخدامها في كتابة اللغة النوبية التي اصبحت لغة القراءة والتجارة والأدب والعبادة ( للمزيد من التفاصيل راجع ، تاج السر عثمان، تاريخ النوبة الاقتصادي – الاجتماعي ، دار عزة 2003).
ونتوقف هنا عند تطور الفن واللغة النوبية الذي يقف دليلا على تطور التربية والتعليم في حضارة النوبة المسيحية.
1
االفن النوبي:
من الحفريات التي قام بها العلماء في النوبة (1960 – 1970) اكتشف العلماء العاملون في مواقع مدينة فرص – النوبية السودانية كنيسة كاتدرائية تحت رمال كوم فرص بها تحف فنية رائعة من خلالها تم التعرف علي ما كان غائباً عن الثقافة والفن النوبي هذا إضافة للتحف القيّمة التي اكتشفت في سنقي وغرب ابريم ويتجلي ازدهار الثقافة النوبية في التحف الأثرية القيّمة من التصوير وتصميم الكنائس وصناعة الأواني الفخارية التي تدل علي مستوى رفيع للثقافة النوبية.
أورد الأب . ج. فانتيني مثالاً عن كنيسة فرص التي أعاد بناءها الياس مطران فرص بأسلوب جديد وميزته الرئيسية القبب بدل السقف المسطح وتم تزيين جدرانها الداخلية بصورة في غاية الفن والجمال كما يبدو من النماذج التي تم إكتشافها وهي محفوظة في المتحف القومي ( تم تدشين الكاتدرائية حوالي 952م) ويشير ذلك المثال إلي أن الأبحاث الحديثة أثبتت أن حوالي ستين كنيسة قد تم بناءها في أرض النوبة إقتداءً به ( للمزيد من التفاصيل راجع ،الأب جون فانتيني : تاريخ المسيحية في ممالك النوبة القديمة والسودان الحديث ، الخرطوم 1978)..
ومن أهم الصور التاريخية صورة الملك جرجة في كنيسة سنقي غرب ويظهر فيها هذا الملك تحت حماية السيد المسيح (عما نويل) والملك يرتدي كل الرموز التقليدية الدالة علي سلطانه ومن بينها التاج الذهبي المزدان بحجارة كريمة والقرنان وتتدلي منها سلسلتان وجرسان ويستنتج فانتيني من ذلك أن تنصيب الملك النوبي كان يتم بوضع التاج الذهبي علي رأسه.
تطور الفن والمعمار النوبيان وتم إتباع أسلوب جديد في بناء الكنائس فبينما كانت قديماً تبني علي أعمدة حجر الجارنيت المستدير بقطع كبيرة مستطيلة وكان عرض الكنائس مسطحاً أصبح (في القرن العاشر) بناء الكنائس علي أعمدة مبنية من الطوب الأحمر علي شكل مربع تستند إليه السطوح المقوسة مع القباب ( فانتيني، تاريخ المسيحية ، ص 121)
كان من عادة النوبة أن ترسم صور ملوكهم في الكنائس أما عن أسلوب الفن التصويري، فحسب فانتيني الذي قال عنه " أجمع العلماء المتخصصون علي أنه تابع للأسلوب البيزنطي، ويستنتج فانتيني من ذلك أن العلاقات بين النوبة والمملكة اليونانية كانت متعددة وذلك بسبب الحجيج من النوبة إلي الأماكن المقدسة بأورشليم ( القدس) وكانت العلاقات بين النوبة ولا سيما الرهبان النوبيين ومدينة القدس مثمرة، مفيدة بتطوير الفنون بالنوبة لأن أهل الفنون النوبية كانوا ينسخون النماذج البيزنطية ويكيفونها حسب الظروف المحلية وذوق مواطنيهم " وإذا صح استنتاج فانتيني هذا – وليس هناك ما يمنع من صحته – فيمكن أن نبني عليه استنتاجاً آخر وهو أن أهل النوبة تفاعلوا مع الفن البيزنطي الرفيع وهذا مثل جيد للأصالة والمعاصرة من التراث الفني النوبي فأهل النوبة كانوا معاصرين وفي الوقت نفسه لم يفقدوا أصالتهم وكيفوا الوافد إليهم من الخارج مع ظروفهم وبيئتهم. ولا شك أن هذا مثال من التعليم الجيّد الذي يربط الوافد بالبيئة المحلية..
أما عن صناعة الفخار وفن التصوير والفن المعماري في مملكة علوة فلم يتبق منها مع الأسف ما يكفي لمعرفة أنواعها وكل ما نعرفه عن مملكة علوة وحالة الكنيسة في هذه المملكة ما ورد في كتاب أبي صالح الأرمني – الذي أشرنا إليه سابقاً – حوالي سنة 1190م والذي ذكر أن في مملكة سوبا زهاء أربعمائة وتملك بعض الكنائس شيئاً كثيراً من الذهب في شكل صلبان وأواني وفيها الصور المقدسة.
كما أشار إلي الكنيسة منبلي بمدينة سوبا التي وصفها بأنها كبيرة وتحيط بها البساتين والمزارع، ويبدو أن أهالي علوة كانوا يبنون كنائسهم بالجالوص الذي لا يصمد مع مرور الزمن ولا يقاوم عوامل التعرية والأمطار وغير ذلك.
2
اللغة النوبية:
معلوم أن اكتشاف الكتابة في مصر تم حوالي سنة 3000 سنة ق.م وكان ذلك باللغة المصرية القديمة، والقارئ يعلم أنه توجد مجموعة من الكتابات باللغة المصرية تركها ملوك كوش ( نبتة ومروي) وهي عبارة عن لوحات من الحجر تحتوي علي سجل بأعمالهم في خدمة الآلهة أو بناء المعابد لها أو في خدمة رعاياهم بتوفير الغذاء لهم وضرب الأعداء المارقين (سامية بشير دفع الله ، التعريف بتاريخ السودان القديم ، مجلة الدراسات السودانية ، العدد 1 مجلد "10" ، ابريل 1990) .
منذ قيام مملكة نبتة كانت اللغة المروية هي لغة المخاطبة وقد كتبت لأول مرة في القرن الثاني قبل الميلاد منذ الثمانينيات من القرن الماضي وحتى الآن بذلت جهود كبيرة لحل رموزها، انتهت بنا إلي التمكن من قراءتها وفهم معاني بعض المفردات والتراكيب إلا أن الجهود لفهم قواعدها ونحوها فهماً كاملاً ما زالت متعثرة.( عبد القادر محمود ، اللغة المروية ، الجزء الأول ، الرياض 1986).
أستند النوبة في العصر الوسيط علي هذا التراث فنجد من ظواهر ازدهار الثقافة النوبية التوصل إلي تأليف أبجدية من الحروف القبطية واليونانية تصلح للاستعمال في كتابة اللغة النوبية لأول مرة في التاريخ، ويرى الأب فانتيني أن هذا تم في عصر الملك قرقي وحلفائه ولذلك تميز هذا العصر عن العصور السابقة له بكتابة الإنجيل والصلوات وبعض الكتابات التذكارية بلغة النوبة الوطنية وقل استعمال اللغتين القبطية واليونانية في الكتابات الرسمية.
وهذه واحدة من مظاهر الاستقلال الثقافي والأصالة الوطنية في النوبة المسيحية وهو امتداد لاستقلال وأصالة المرويين الذي استنبطوا لغتهم المكتوبة الخاصة بهم والتي أشار إليها عالم الآثار ب. ج هيكوك بقوله " إن لغة التخاطب في الحديث في نبتة ومروي السابقتين للنوبة كانت اللغة السودانية التي تطلق عليها اللغة المروية، إلا أنهم كانوا يكتبون تلك اللغة بالخط والحروف المصرية " الهيرغلوفية" ( الهيروغلوفية تعنى كتابة الكهنة)، وانتقلت تلك اللغة معهم إلي موطنهم الجديد في وسط السودان ( منطقة كبوشية ) ولقد تمكن الكوشيون (المرويون) بعد عدة قرون واجهتهم فيها صعوبات بالغة في كتابة تلك اللغة الأجنبية من أن يحدثوا ويبتدعوا طريقة مكنتهم من كتابة لغتهم السودانية في حروف أبجدية تبلغ ثلاثة وعشرين حرفاً.
طوّر النوبة هذا الجانب في حضارة مروي وأصبحت اللغة النوبية هي اللغة الأصلية في الوثائق المدنية مثل العهود والصلوات والإنجيل في الكنيسة، وكانت الحروف التي دونت بها اللغة النوبية مأخوذة من اللغتين اليونانية والقبطية وأدخلوا الفهرست لابن النديم ،يستعملون الحروف اليونانية في الكتابات الرسمية وفي كنائسهم.. ولكن المصادر لم توضح لنا عدد الحروف الأبجدية التي استخدمت في كتابة اللغة النوبية
( للمزيد من التفاصيل راجع، تاج السر عثمان : تاريخ النوبة الاقتصادي – الاجتماعي ، مرجع سابق). ذكر ابن الفقيه (المتوفى سنة 903م) أن الروم ( المقصود المسيحيين الروم) يقرأون الإنجيل بالملكية ( أي اللغة اليونانية) أما اليعاقبة (المسيحيون الأرثوذكس) فيهذون ( باليونانية ) دون إدراك تلك اللغة ثم يفسر القساوسة لهم بلهجاتهم المحلية.
لكن من جانب آخر فإن اللغة النوبية المكتوبة كانت خاصة بالملوك والكنيسة وجهاز الدولة ولم يتم تعليمها للجماهير بشكل واسع مما ساعد في اندثار هذه اللغة المكتوبة بعد أن عجزت عن إنشاء حركة ثقافية تعليمية في الشمال ويقول ترمنجهام " ما ساعد في مقاومة اللغة النوبية وبقائها أمام طوفان اللغة العربية أنها حولت إلي لغة تكتب بفعل القسيس في العهد المسيحي وظلت صامدة حتى الآن أمام التيار الجارف للغة العربية.
ونكمل ما أورده ترمنجهام مما ساعد علي بقاء اللغة النوبية هو تفاعلها مع اللغة العربية يقول د. عون الشريف قاسم بامتزاج العرب بالسكان الأصليين للبلاد من النوبة والبجة والقبائل النيلية والفوراوية وما إليها ترسبت في لغتهم مجموعات كبيرة من ألفاظ هؤلاء الأقوام بحكم المجاورة.، تأثرت بها القبائل الجعلية المستقرة علي النيل فنجد في صلب لهجاتها مجموعات كبيرة من الألفاظ النوبية والمصرية القديمة الدالة علي ذلك، وخير شاهد علي ذلك مصطلحات الساقية والأنواء والرياح التي تهب علي النيل شمالاً وجنوباً ( د. عون الشريف قاسم: قاموس اللهجة العامية في السودان ط 2 القاهرة 1985م، ص 24).
إذاً اللغة النوبية تركت بصماتها الواضحة علي اللغة العربية وكانت حصيلة ذلك التفاعل هي اللغة العربية السودانية أو اللهجات السودانية العربية المتميزة في شمال السودان، ويقول محمد متولي بدر كان بين العربية والنوبية صراع طويل الأمد كانت الغلبة فيه للغة العربية فاندثرت لغة النوبيين من السودان الأوسط بكامله وانكمشت رقعتها فانزوت في ناحية من بيئتها بين الشلال الأول والرابع (محمد متولى بدر ، اللغة النوبية، القاهرة 1955).
اختلف العلماء في أصل هذه اللغة فمنهم من قال أنها حامية الأصل كالنوبيين أنفسهم، ومنهم من يظن أن الصبغة الحامية هي الغالبة عليها سواء من ناحية المفردات أو النحو أو الصرف وعليه يرونها حامية الأصل دخلتها مؤثرات أجنبية حسب رأس راينش وموري..
وصفوة القول أن الثقافة والحضارة النوبية كانت عظيمة فيما يختص بالفنون واللغة المكتوبة ، وأن التعليم شهد ازدهارا لكن كانت اللغة المكتوبة صفوية، أي كانت متداولة وسط الكهنة والإداريين والكتبة في البلاط الحاكم، ولم تنتشر جماهيريا.
رابعا
التعليم في مملكة الفونج (4)
توسع التعليم في مملكة الفونج (1504- 1823) التي كانت تطورا أوسع في مسار الدولة السودانية سياسيا وإداريا ، ازدهرت فيها التجارة، وانتعشت الطبقة التجارية ، واقتصاد السلعة – النقد ، والزراعة وتربية الماشية ، والصناعة الحرفية، وقامت المدن التجارية والصناعية، كما ساعد اقتصاد السلعة النقد علي ازدياد الإنتاج الزراعي ، وظهرت الملكية الخاصة للارض وتمليكها بعقود ، بالتالي تم استنباط نظام للتعليم كان ملائما لاحتياجات النظام الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، فما هي سمات التعليم في عهد الفونج؟
1
بدأ التعليم في مملكة الفونج أو سلطنة سنار كما هو معلوم بالخلوة باعتبارها الوحدة التعليمية الأساسية أو الخلية التعليمة الأولية التي تطور منها نظام التعليم فيما بعد .
كانت الخلوة تلبي حاجة مجتمع الفونج في بداية تكوينه والذي كان بسيطاً (اقتصادياً وسياسياً) فاقتصاد الفونج كان أغلبه اقتصاداً معيشياً ، ولم يكن ذلك الاقتصاد يتطلب أكثر من المعلومات الأولية في القراءة والكتابة ، ولكن بتطور النظام الاقتصادي والسياسي فيما بعد بفضل اتصال الفونج بالعالم الخارجي بشكل أوسع من البداية وتطور اقتصاد السلعة – النقد وازدياد حاجة النظام إلى كتبة وموظفين وعمال وقضاة لمواجهة احتياجات الجديدة التي نشأت بفضل تطور التجارة وتمليك الأرض وتوثيق العقود وقياس الأرض والفصل في قضايا الميراث وجمع الضرائب ، تحديد مقدارها (زكاة ، مكوس) ، وإزدياد هذه الحاجات أدت إلى تطور نظام التعليم عند الفونج .. حيث نلاحظ في الفترات اللاحقة تطور نظام التعليم من الخلوة إلى تعليم أوسط يتم فيه تدريس التصوف كما كان عليه الحال عند المجاذيب في الدامر ( للمزيد من التفاصيل راجع تاج السر عثمان الحاج ، لمحات من تاريخ سلطنة الفونج الاجتماعي، مركز محمد عمر بشير 2004) .
لتلبية هذا الغرض ازدادت البعثات التعليمية إلى الأزهر والحجاز ولتأهيل الكادر من الفقهاء والقضاء والمعلمين والشيوخ الذين بدورهم فتحوا مراكز لنيل العلم في مواقع السودان المختلفة : سنار ، الحلفايا ، شندي ، الدامر ، بلاد الشايقية (نورى) ، كترانج ، بربر ،. الخ لتلبية هذه الحاجات، كان يفد اليها الطلاب أبناء دارفور بقية المناطق. .
لم تكن فرص التعليم متساوية لكل أبناء وبنات الناس في عهد الفونج فقد كان تعليماً طبقياً وغير طبقي بمعني أن الآباء الذين كانوا يملكون الرقيق ويستخدمونهم في الزراعة أو الرعي كانوا لا يحتاجون لأبناءهم في هذه الأعمال ، وبالتالي كانوا يستغنون عن خدمات أبناءهم في هذا الجانب طوال فترة الدراسة في الخلوة (حوالى سبع أو خمس عشر سنة) وبالتالي كانت فرص هؤلاء في التعليم أكبر .
الحديث هنا عن الفرص الأكبر ذلك أن الموضوع معقد ولا يجوز التبسيط فيه ، فنظام التكافل الاجتماعي الذي كان في عهد الفونج كان يسمح أيضاً لأبناء الفقراء الراغبين في مواصلة تعليمهم .
2
ونحن نتأمل النظام الفريد الذي أبتدعه الفونج نحاول أن نستلخص أهم سمات هذا النظام في الأتي :
أ/ أن نظام التعليم عند الفونج لم يكن مركزياً أي لم يكن تابعاً للدولة ولم يكن للدولة سلطة على الشيوخ بهدف فرض أيديولوجية معينة أو طريقة معينة أو فكر معين ، وهذا إذ جاز الاستنتاج – نوع من استقلال العلم والعلماء عن حكام الفونج ونوع من التعليم الأهلى البعيد عن سيطرة الدولة وهذا نلمسه في أن سلاطين الفونج لم يكن يدفعوا لمعلمي الخلاوي مرتبات ، وكان الشيوخ ومعلمو الخلاوي يكتفون بما يقدمه الطلاب أو أباؤهم من هدايا وهبات ، كما كان لشيوخ الخلاوى أراضيهم الخاصة التي كانوا يزرعونها في المواسم لمساعدة طلابهم كما كانوا يعفون من دفع الضرائب والعشور .
وبهذا المعني استطاع الفقهاء والشيوخ والعلماء في عهد الفونج أن يقدموا إلى السودان نوعاً من التعليم ملائماً لظروف البلاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية واحتياجاتها وقتئذ ، ومهم هنا التركيز على هذه النقطة ، صحيح أن المعلمين الأوائل الذين تلقوا تعليمهم في الحجاز ومصر استفادوا من النظم التعليمية هذه أو درسوا وفقاً لتلك النظم التي كانت قائمة على التعليم في الخلاوي أو المساجد أو المراكز التعليمية الدينية المشهورة مثل الأزهر وغيره ( للمزيد من التفاصيل راجع محمد عمر بشير ، تطور التعليم في السودان، 1989- 1956، ترجمة همرى رياض وآخرون الخرطوم 1970) .
لكن نظام التعليم عند الفونج رغم أنه استفاد من النظم التعليمية التي كانت سائدة في العالم الإسلامي وقتئذ إلا أنه جاء أصيلاً وبخصوصية معينة ولم يكن نقلاً أعمى لتلك النظم ، وإنما أخذ خصوصية السودان في الاعتبار ، وبالتالي . إذا جاز التعبير كان نظاماً سودانياً فريداً تفاعل فيه الوافد مع المحلي .
نأخذ على سبيل المثال أن ود ضيف الله عندما كتب الطبقات استفاد من كتابة التاريخ على نحو الذي كان سائداً في العالم الإسلامي من ناحية الشكل مثل : الطبقات الكبرى ، طبقات الشعراني في الأولياء والصالحين ، ولكن ود ضيف الله عندما كتب الطبقات أخذ خصوصية السودان في الاعتبار .
ولم يكرر ما هو معروف ومشار إليه في طبقات الشعراني مثلاً أو الطبقات الكبرى ، ولكنه أشار إلى طبقات أو تاريخ الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء في السودان وبالتالي جاء المؤلف بتلك الخصوصية السودانية التي قدم فيها معرفة جليلة وقيمة بالتاريخ السوداني الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والفني والأدبي والعلمي والديني ، بل حتى استخدم اللهجة السودانية التي كانت سائدة .
فود ضيف الله كان محلياً ، ولكنه هذه المحلية هي التي اضفت على هذا الكتاب أن يكون مصدراً هاماً من مصادر دراسة التاريخ السوداني في تلك الفترة .
ود ضيف الله إذن هو نتاج ذلك التعليم الذي أبتدعه أهل الفونج والذي جاء أصيلاً ونابعاً من احتياجات الواقع السوداني .
وهذه نقطة هامة في تقديرى بالتوسع فيها يمكن أن تشكل المفتاح أو المنهج السليم لفهم نظام التعليم عند الفونج بالنسبة للباحثين والدراسين في نظام التعليم في السودان .
ب. النقطة الثانية في نظام التعليم عند الفونج أنه كان مرتبطاً بالإنتاج ، أي أنه لم يكن يعرف الفصل بين التعليم الذهني والتعليم اليدوي (إذا جاز استخدام مصطلحات علماء التربية المعاصرة) فنظام التعليم عند الفونج لم يقتصر على الدراسة فقط، بل كان الطلاب يساهمون في زراعة أراضي الشيوخ وغيرها من هبات الخلاوي من الأراضي التي كان يدفعها الأغنياء والملوك وكان الطالب يملك حق العمل في أراضي أخرى أو الاحتطاب لتوفير بعض المال الذي كان يحتاج إليه رغم مجانية الإعاشة والسكن في الخلاوى ، وكان هذا النظام سائداً عند المجاذيب في الدامر .
ج/ كان نظام التعليم عند الفونج مفتوحاً بمعني أنه لم يكن يعرف الدرجة أو الشهادة النهائية من شيخ معين أو فكي معين فكان طلاب العلم الباحثون عن المزيد من العلم والمعرفة يتنقلون من شيخ لآخر ويسعون للمزيد من المعرفة إلى شيوخ عملهم أوسع واغرز من الشيوخ السابقين الذين تعلموا على أيديهم وبالتالي كان نظاماً فريداً متعدد المعارف ومتعدد المستويات ومتفاوت الخبرات ، كل بحسب جهده .
وكل بما تيسر له وينطبق عليه مقولة " طلب العلم من المهد الى اللحد " وكان يرسخ قيم التواضع واحترام العلماء والشيوخ لا لشيء إلا أنهم أكثر علماً ومعرفة .
وهذا الشكل هو الذي ساعد على أنتشار التعليم في السودان وفي بقاعة المختلفة بتلك السرعة في فترة الفونج ، كما ساعد على أنتشار اللغة العربية والديانة الإسلامية بشكل من الكثير من التسامح وهذا الشكل كما لاحظ بروفيسور محمد عمر بشير أنتج علماء في دولة الفونج كانوا لا يقلون درجة عن رصفائهم في العالم الإسلامي يؤمئذ .
د/ أهداف ونظم التعليم : كانت أهداف التعليم هي التفقه في الدين والتصوف الذي تطور في العالم الإسلامي (مصر ، الحجاز ، شمال أفريقيا) ، وقام التعليم على أساس تعليم القرآن وحفظه .
وكانت وحدات التعليم الإساسية الخلاوى والمساجد وأغلب الشيوخ لم يكن يستخدمون كتباً أو محفوطات بل كانوا يملون دروسهم على تلاميذهم من ذاكرتهم (كانوا يقولون العلم في الرأس لا في الكراس) .
وكان القرآن يقسم إلى سور ليحفظها الطالب عن ظهر قلب وكانت السور تكتب على لوح من الخشب وتمسح بالماء بعد حفظها لتكتب عليها سورة جديدة ونتوقف قليلاً هنا عند ثقافة إنسان الفونج في أدوات الكتابة .
في تلك الفترة عرفت أروبا صناعة الورق واختراع المطبعة ،وبدأ الفونج يستوردون الورق من أوربا ولكن استخدامه كان محدوداً للحكام وفي المحاكم ولم يتم تصنيعه بشكل واسع .
هـ/ المناهج : في مناهج التدريس بعد القرآن ترد الفقه في المرتبة الثانية ، وكانت الرسالة ومختصر الخليل المالكي تشكلان المصدر الرئيسي للتدريس (أغلب السودانيين أخذو المذهب المالكي).
وكان مما يلي ذلك أهمية علوم التوحيد والكلام وكانت أكثر الكتب المستخدمة هي مقدمة السنوسية والطالب الذي يرغب في زيادة حصيلته العلمية بعد أن يكون قد أتم دراسة تلك العلوم ، يدرس تجويد القرآن أو الحديث أو التفسير أو التصوف الإسلامي بشكل موسع وفي كتاب الطبقات وردت إشارة عن بعض الطلاب الذين تفوقوا في علوم النحو والبلاغة .
و/ تدريب المعلمين : كان الشيخ أو الفكي أوالمعلم أما يكون قد تخرج في أو تدرب في السودان ، أو تخرج في الأزهر الشريف أو معاهد مكة .
ز/ نظم الأمتحانات : لم تكن تعقد اختبارات أو أمتحانات كما لم تكن الدراسة محددة بزمن معين ، وعندما كان الطالب يفرغ من دراسته كان يمنح شهادة تسمى الإجازة حيث كان يستطيع بمقتضاها فتح مدرسة ليعلم فيها سالكاً نفس المنهج الذي سلكه مع إضافة الجديد من تجربته ومحصول علمه الإضافي بعد ذلك .
3
من وسائل التربية هناك العقوبة البدنية التي كانت تسمى " الفلقة " والفلقة هي عقوبة يعاقب بها الفكي أو الشيخ المذنبين أو المهرجين من الطلاب حيث كان الفكي يجلس على عنقريب صغير ويلقى بالطالب على الأرض ويرفع راحة قدميه مع ضمهما إلى أعلى وينهال الفكي ضرباً بالعكاز أو العصا التي تصنع من فروع السلم وغيرها ، أي الضرب على أخمص القدمين ، وهي عقوبة غير مبرحة ولكنها مؤلمة وفي بعض المناطق مثل الدامر أرتبط التعليم بالتجارة والسلطة حيث جمع فقهاء المجاذيب بين العلم والتجارة الشيء الذي مكن لهم في الأرض وأستطاعوا أن يستولوا على السلطة السياسية في مجتمع الدامر في سنوات الفونج الأخيرة عندما ضعف النظام المركزي ، وكما لاحظ بركهارد أن الفقيه الكبير لم تكن سلطته دينية فقط بل كان يمارس السلطة السياسية ويفصل في قضايا الناس ، وأشار بركهارد إلى ما يفهم منه أن في الدامر نظام جمع السلطة الزمنية والدينية أي الدولة دينية مصغرة إقامها المجاذيب في الدامر .
بهذا المعني كان التعليم إضافة لوظائفه الاقتصادية في الزراعة والرعي والحرف والتجارة مصدراً من مصادر الجاه والسلطة السياسية، وكانت مملكة الفونج متباينة في التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ، بالتالي جاء التعليم معبرا عن هذا التفاوت والتباين.
نخلص من ذلك إلى أن التعليم النظامي الذي بدأ في السودان بشكل واسع في فترة الفونج كان يعبر عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية القائمة ، وكما لاحظ مؤرخو التعليم في السودان مثل: محمد عمر بشير وعبد المجيد عابدين ، وعبد العزيز أمين عبد المجيد ، أن التعليم الذي تم استنباطه في دولة الفونج هو الذي شكل النواة لتطور التعليم في السودان فيما بعد.
للمزيد من التفاصيل راجع :
- عبد المجيد عابدين : تاريخ الثقافة العربية في السودان،طبعة ثانية 1967.
- عبد العزيز أمين عبد المجيد : التربية في السودان – ثلاثة أجزاء ، القاهرة ، وزارة المعارف 1949.
- محمد عمر بشير: تطور التعليم في السودان، ترجمة هنرى رياض وآخرون ، دار الثقافة بيروت 1970.
خامسا :
التعليم في فترة الحكم التركي (5)
في هذه الفترة تطور التعليم ، ويمكن القول أن جذور التعليم المدني والتبشيري قد تمّ غرسه في هذه الفترة الذي قام ليلبي احتياجات الدولة التي شكلت تطورا جديد في مسار تطور الدولة السودانية كما في: دولة كرمه ، نبته ، مروى، والنوبة المسيحية، الفونج ودارفور.الخ. وتلك الدول كانت مستقلة وكانت نتائج تطور باطني. ولكن الجديد أن السودان خلال فترة الحكم التركي (1821م-1885م) عرف دولة تابعة ضمت رقعة واسعة في البلاد،بعد ضم دارفور والمديريات الجنوبية الاستوائية، أعالي النيل ، بحر الغزال، وكانت مفرطة المركزية وتقوم علي القهر والنهب والضرائب الباهظة مما أدي لانفجار الثور المهدية التي اطاحت بالحكم التركي.
1.
كان من أهداف احتلال محمد على باشا للسودان نهب ثروات البلاد (ذهب ، معادن أخرى ،محاصيل نقدية، والقوى البشرية - الرقيق)، بهدف تحقيق التراكم الراسمالي اللازم لمشاريعه الزراعية والصناعية والعسكرية ، في أكبر احتلال بربري ودموي تم فيه تدمير القوى الاقتصادية واالبشرية السودانية ، حققت منه الطبقات الحاكمة في مصر ارباحا هائلة ( للمزيد من التفاصيل ، راجع تاج السر عثمان الحاج ، التاريخ الاجتماعي لفترة الحكم التركي (1821- 1885)، مركز محمد عمر بشير نوفمبر 2004).
لتحقيق تلك الأهداف تم الآتي :
- شهدت دولة الحكم التركي توسعا في مساحة الأراضي الصالحة للزراعة ، مما أدى ألي زيادة المحاصيل الزراعية في الأسواق ، فنجد أن الحكومة في هذه الفترة تجلب عدداً من خوليه الزراعة ، وتعمل على تطور زراعة القطن وتشق القنوات للتوسع في زراعة الأحواض وتشجيع تعمير السواقي وترسل الطلاب إلى مصر للتعليم والتدريب الزراعي وتجلب المحاريث لحراثة الأرض وتعمل على بناء المخازن في المراكز الرئيسية على طول الطريق إلى مصر لتوفير مياه الشرب لتسهيل الحركة التجارية وتصدير المواشي بشكل خاص كما اهتمت الحكومة بإدخال محاصيل نقدية جديدة مثل الصمغ، السنامكي ،النيلة.الخ.واهتمت بالثروة الحيوانية وجلبت الفلاحين والعمال المهرة في الزراعة واهتمت بالتقاوي المحسنة والأشجار المثمرة واهتمت بمكافحة الآفات مثل الجراد .
- رغم تلك التحسينات التي أدخلتها الحكومة بهدف تطوير القوى المنتجة في الزراعة والإنتاج الحيواني ألا أن الضرائب الباهظة التي كانت الحكومة تفرضها على المزارعين والرعاة أدت إلى هزيمة هذا الهدف، فقد هجرالاف المزارعين سواقيهم في الشمالية ، كما هرب الاف الرعاة بمواشيهم إلى تخوم البلاد.
هكذا نجد أن سياسة الحكومة التي كانت تعتمد على القهر والضرائب الباهظة أدت إلى انخفاض الإنتاج الزراعي والحيواني، وبالتالي أدي ألي تدهور الأحوال المعيشية وأدي ذلك ألي المجاعات والأمراض والخراب الاقتصادي وغير ذلك مما شهده السودان في السنوات الأخيرة للحكم التركي- المصري عشية انفجار الثورة المهدية.
- شهدت تلك الفترة قيام صناعات جديدة مثل صناعة البارود وصناعة النيلة وصناعة حلج القطن وصناعة الذخيرة كما تطور قطاع الخدمات حيث تطورت المواصلات (بواخر نهرية) إدخال التلغراف، تم تحسين ميناء سواكن وتم توصيل خط السكة الحديد إلى مدينة وادي حلفا (الشلال).
2
نتيجة لتلك التحولات في الزراعة والصناعة وخدمات النقل الاتصالات ، تطور التعليم الأكاديمي والمهنى في تلك الفترة اعلاه ليلبي احتياجات جهاز الدولة التركي وقامت مدارس ارقى من الخلاوى مثل :
- فتح مدارس حكومية جديدة لسد احتياجات جهاز الدولة في المجالات الجديدة التي فتحها، وارسال بعثات للتدريب في فنون الزراعة والهندسة ، اضافة لاستمرار التعليم في الخلاوى، واضافة لتزايد اقبال السودانيين لدراسة بالأزهر الشريف، وتم قيام رواق السنارية في الأزهر.
- قام الخديوي عباس (1848- 1854م) بتأسيس مدرسة ابتدائية في الخرطوم، كان رفاعة رافع الطهطاوى أول ناظر لها.
في عهد الخديوي اسماعيل (1863- 1879) تم تأسيس خمس مدارس صغيرة في عواصم المديريات : الخرطوم ، بربر ، دنقلا، التاكا ، كردفان ، وقد سارت هذه المدارس وفق مناهج المدارس الابتدائية المصرية ، وكان التلاميذ يدرسون اللغتين العربية والتركية والحساب والهندسة والخط.
كما تم ايضا فتح مدرستتين في سواكن وسنار، وعندما تمّ مد خطوط التلغراف الي بين الخرطوم والابيض وفازوغلى وبربر وكسلا وسواكن ، والكوة ،فُتحت تباعا مدرستان في الخرطوم وكسلا لتدريب العاملين في تلك الخطوط تدريبا مهنيا ، وكان يقبل لها التلاميذ الذين اكملوا المدرسة الايتدائية ، كما انشأت مصلحة الوابورات فرقة تدريبية لخريجي المدارس الابتدائية بهدف استيعابهم كعمال مهرة وحرفيين( للمزيد من التفاصيل ، راجع تاج السر عثمان الحاج ، التاريخ الاجتماعي لفترة الحكم التركي ، مرجع سابق).
- كانت فترة الخديوى اسماعيل في التعليم مثمرة ، فقد تم خلق كادر من العاملين والموظفين السودانيين ، كتاب ومحاسبين وعمال التلغراف و ترسانة الخرطوم .
- تم دخول بدايات علوم الطب والصيدلة والكيمياء والعلوم الطبيعية في تلك الفترة..
- شهدت تلك الفترة التعليم التبشيري كما في مدارس الأب كمبوني التي قامت في الخرطوم والأبيض، وجنوب السودان ،الخ وشمل التعليم التبشيري تعليم البنات والتدريب المهني.
ساعد عل انتشار التعليم التبشيرى صدور أمر من محمد على باشا للولاة في الخرطوم لتقديم كل عون للتعليم التبشيري ولللارساليات واعفائها من الضرائب.
- بالنسبة للمعلمين تم توفير معلمين من الحكومة المصرية لتدريس اللغة العربية واللغة التركية ، ومعلم لكل مدرسة ، وكانت المدارس تشرف عليها وزارة المعارف المصرية، واستمر تدريب معلمين لانشاء مدارس جديدة .
- تم تكوين فرق تدريبية في أعمال الطب والصيدلة ليلتحق بها من أكملوا التعليم الابتدائي، لاحقا تم تأسيس مدرسة للطب لتحل محل الفرق التدريبية ، وقد عُين معلم للكيمياء والعلوم الطبيعية من مصر في 1879 ، وفعلا حضر من مصر ليتولى هذه المسؤولية.
3
التحولات التي أحدثها نظام الحكم التركي كانت محدودة (الاقتصاد ، التعليم ، الصحة، المواصلات . الخ).وظل الجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي في السودان خلال تلك الفترة حبيس القطاع المعيشي ( التقليدي) وظلت قوي الإنتاج وعلائق الإنتاج بدائية ومتخلفة.
فضلا عن أن التعليم لم يكن معزولا عن مصالح الفئات الحاكمة وأهدافها في نهب ثروات البلاد، وكان التركيب الطبقي للدولة يتكون من : الحكام وكبار موظفي الدولة الأجانب والمحليين ،زعماء ومشايخ الطرق الصوفية، الجنود، المزارعون، العمال والموظفين.
بالتالي يجب الا نبالغ في حجم التعليم في فترة الحكم التركي الذي شهد بدايات التعليم الحديث ، فقد كان حجم التعليم ضئيلا بالنسبة لعدد السكان في العهد التركي الذي بلغ 8,525,000 ،بينما كان عدد المدارس سبع ، كما أن الحكومة ركزت المدارس في عواصم المديريات مهملة بذلك القرى والبوادى مأوى الكثرة الغالبة من السكان.
للمزيد من التفاصيل راجع:
- بشير كوكو حميدة : الخديوى اسماعيل والتعليم الديني والمدني في السودان، مجلة الدراسات السودانية ، العدد الأول ، المجلد "7" ، ديسمبر 1982.
- تاج السر عثمان الحاج : التاريخ الاجتماعي لفترة الحكم التركي، مركز محمد عمر بشير 2004م.
- محمد عمر بشير : تطور التعليم في السودان ، ترجمة هنرى رياض وآخرون ،دار الثقافة بيروت 1970
- ناصر السيد : تاريخ السياسة والتعليم في السودان ، دار جامعة الخرطوم 1990.
سادسا
التعليم في فترة المهدية (6)
1
ذكرنا في الحلقة السابقة عن التعليم في فترة الحكم التركي أن السودان شهد في تلك الفترة نوعا من التعليم الأكاديمي والمهني الحديث ، حيث قامت سبع مدارس ابتدائية ومدارس للتدريب المهني مثل : مدرسة التلغراف ومدرسة مصلحة النقل النهري. الخ ، وكانت من وظائف هذا التعليم تخريج كتبة وموظفين وعمال مهرة لمد الدولة باحتياجاتها منهم.
جاءت دولة المهدية نتاج ثورة شعبية مسلحة بعد القضاء علي دولة الحكم التركي التي كانت دولة مدنية ، وحلت محلها دولة المهدية ذات الطبيعة الدينية والتي استمدت نموذجها من الدولة الإسلامية التي قامت في عهد النبي (ص) ومن بيت مال ودار قضاء وإفتاء وجيش . الخ ، واصبح الامام المهدي علي راس الدولة باعتباره خليفة رسول الله ، ويليه خلفاؤه وأمناؤه الذين كان يستعين بهم في تصريف الشؤون المدنية والإدارية والعسكرية والقضائية وغيرها، اضافة ألي أن الأمام المهدي ومن بعده الخليفة جمع بين السلطة الدينية والزمنية وكان مصدر التشريع ، وبحكم انه خليفة رسول الله وله صلة مباشرة به ، وهذه الصلة قد تتم في حضرة، في يقظة أو منام.
كانت وظائف هذه الدولة متعددة ومتنوعة فهي دولة عسكرية، أي أنها كانت في حالة حروب داخلية وخارجية مستمرة وكان لها وظائفها الاقتصادية وكانت الدولة عن طريق بيت المال لها أراضيها (ملكية الدولة) التي تؤجرها للمزارعين بنسب معينة من المحصول وكانت مصادر دخلها من الغنائم والضرائب والزكاة والعشور.
2
قضت دولة المهدية ( 1885 – 1898 م ) على التعليم المدني الحديث الذي تمّ في فترة التركية ، وحل محله تعليم ديني في عدد محدود من الخلاوي التي أصبحت المنهل للتعليم في السودان ، حتي دخول جيوش الاحتلال الانجليزي في عام 1898 م.
كما قضت المهدية علي التعليم التبشيري والنشاط التبشيري بأسره في السودان واغلقت مدارس الارساليات التي تم فتحها ابان الحكم التركي – المصري ( محمد عمر بشير : تطور التعليم في السودان ، 1970 ، ص 55 ) . ولقد تأثرت العلائق التعليمية والثقافية بين السودان ومصر في فترة المهدية للاختلاف بين نظامي الحكم في البلدين ، ولم تعد مصر وأزهرها قبلة الطلاب السودانيين لتلقي العلم والتدريب فيها ، كما تأثر التعليم في السودان ايضا من جراء الحروب الكثيرة التي شهدتها فترة المهدية ولم يتطور في وقتئذ أى جهاز تعليمي ذى بال ( المصدر السابق: 57 ) .
بالرغم من موقف الخليفة عبدالله تجاه تعليم الارساليات، الا أن خريجي تلك المدارس كانوا يمثلون العمود الفقري للعمل المكتبي والفني في دواوين الحكومة ( للمزيد من التفاصيل، راجع ، تاج السر عثمان الحاج ، التاريخ الاجتماعي للمهدية، مركز عبد الكريم ميرغني 2010م ) .
ويعزى د . محمد سعيد القدال ذلك الى أنه كان مرتبطا بالفترة التي كان فيها ابراهيم عدلان امينا لبيت المال والذي اعاد توظيف التركية ( أولاد الريف ) في وظائف الحسابات ومسك الدفاتر والتي كانت لها بعيد الأثر في دقة العمل الحسابي ، ومن الأمثلة لهؤلاء الموظفين محمد شكري كاتب شمال البقعة ، والحاج سعد المغربي من طرابلس كاتب بيت المال وفتي أفندي الذي كان ضابط بوليس في التركية فأصبح كاتبا ، رستم محمد رشدي الذي كان كاتب تلغراف بدارفور فأصبح كاتبا ، عبد الدائم من اسنا كان يعمل في بيت مال دنقلا ، عمر موسي حمدي الذي كان باشكاتبا فأصبح ( قباني ) بالبقعة ، يوسف افندي نديم ، عبدالله المحلاوى ( محمد سعيد القدال ، السياسة الاقتصادية للدولة المهدية ، دار جامعة الخرطوم 1986، ص 179 ) .
اى أن دولة المهدية استفادت من ثمرة التعليم الحديث باستفادتها من هؤلاء الكتبة والمحاسبين ، ولكنها أغلقت المنبع الذي تخرج فيه هؤلاء الموظفون والكتبة وهى مدارس التعليم المدني الحديث !!! .
3
كانت ايديولوجية المهدي تنادي بوجوب العودة لروح الاسلام ونقائه ونبذ الطرق الصوفية وتوجيه الناس الى القرآن والسنة ، كما لم يكن المهدى متعاطفا مع العلماء الذين ساندوا الادارة الأجنبية ، ولذلك كانت دعوته لاتؤيد بطبيعة الحال النظم التعليمية التي ادخلها الحكم التركي (محمد عمر بشير، مرجع سابق،ص، 55 ) ، وفي فترة المهدية انتشرت الخلاوى حتي بلغ عددها في امدرمان وحدها ثمنمائة خلوة في عهد الخليفة ( بشير : 55 ) ، وبالرغم من انشغال الخليفة عبدالله في الحروب الخارجية والمنازعات الداخلية، الا أنه كان يدعو قومه لحفظ القرآن ، وقد أمر ذات مرة ان تعد 4500 لوحا ليكتب عليها الدارسون سور القرآن ، وقد شدد على أنصاره من الكبار أن يحفظوا من سور القرآن على أدني تقدير ما يؤدون بها الصلاة ، وأن يتعلم الاطفال مبادئ التعليم الثلاثة : القراءة والكتابة والحساب مع حفظ القرآن ( نفسه : 56 ) .
كما كانت الدولة تقوم بدفع مرتبات المعلمين في هذه الخلاوى ، أى أنها استمرت في سياسة الحكم التركي نفسها الذي كان يدفع مرتبات معلمى الخلاوى.
4
أضحت امدرمان مركز التعليم والثقافة وقبلة العلماء والمعلمين في فترة المهدية ، كما استفاد المعلمون والعلماء من مطبعة الحجر التي غنمها الثوار عند سقوط الخرطوم فطبعوا نسخا كثيرة من الكتب والمحفوظات واستطاع اسماعيل عبدالقادر الكردفاني أن يصدر كتابين احدهما عن المهدي، وآخر عن اثيوبيا عندما كان مقيما بامدرمان (محمد إبراهيم ابوسليم : الحركة الفكرية في المهدية، دار جامعة الخرطوم ، 1970 ) ، وأصدر ودتاتاى كتابا عن أقوال المهدي ، كما اسهم كل من عوض الكريم المسلم والحسين الزهراء.
في مجال الكتابة أيضا كان هناك أهم مركز للتعليم في شرق السودان حيث تقيم أسرة المجاذيب وقد اشتهر منها شخصان بكتاباتهما في بث دعوة المهدية هما ابوبكر يوسف وحمد المجذوب الطاهر ، وكان المجذوب ابوبكر كاتبا لعثمان دقنة وقد قام بتصنيف رسائل المهدي الى عثمان دقنة ، أما حمد المجذوب ، فقد أعد مخطوطا عن وقائع الشرق وصف فيه الحوادث والمواقع في شرق السودان في عهد المهدية ، وكان المركز السابق في دنقلا، التي كانت معسكرا كبيرا من معسكرات جيوش المهدية، وهناك عكف عدد كبير من الانصار في تدوين ونقل راتب المهدي لنشره وتوزيعه على المواطنين .
وخلاصة القول ، يمكن أن نصل الى الآتي :
- المهدية قضت على التعليم المدني الحديث الذي بدأ في فترة الحكم التركي.
- انتشرت الخلاوى.
- استمر ارتباط معلمي الخلاوى بالدولة.
- انتشرت مراكز الثقافة المرتبطة بنشر تاريخ وترسيخ الايديولوجية المهدية.
سابعا :
التعليم في فترة الاستعمار البريطاني (7)
1
بعد سقوط دولة المهدية ، جاءت فترة الاستعمار البريطاني (1889- 1956) ، التي كانت وظيفة الدولة فيها ، الاشراف على مصالح الشركات والبنوك البريطانية في السودان ، وتنظيم عمليات تصدير الفائض الاقتصادي للخارج واستنزاف موارد السودان الاقتصادية بعلاقات التبادل غير المتكافئ :السودان مصدرا للمواد الخام ، ومستوردا للسلع الراسمالية، وسد حاجات بريطانيا بزراعة القطن لمصانعها في لانكشير علي حساب المحاصيل الغذائية..
لتحقيق تلك الأهداف تصدت الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقامت مشاريع القطن في الجزيرة والنيلين الأبيض والأزرق والقاش وطوكر وجبال النوبا . الخ، والسكك الحديدية ،النقل النهري ، والميناء ومؤسسات العلاج، ومؤسسات التعليم المدني الحديث مثل المدارس الحكومية و كلية غردون.الخ ، وأصبحت هذه المشاريع تابعة لقطاع الدولة ، ولم يلعب القطاع الخاص ( محلى وأجنبي ) دورا حاسما أو قياديا في قيام المنشات الهامة ، وكانت التنمية التي تمت كانت مقتصرة على شمال السودان ، ولم يكن هناك تطور موازى لها في جنوب السودان ، حيث كانت الإدارة هناك تركز على الأمن والنظام ، إضافة لتجاهلها مسالة تسريع وثائر التطور فيه ، وهذا أدي ألي التطور غير المتوازن الذي نشأ فى البلاد فيما بعد،مما أدي للقنابل الموقوتة بانفجار حرب الجنوب وحركات المناطق الطرفية الأخرى بعد الاستقلال، وجاءت أهداف وسياسة الاستعمار في التعليم لتلبية تلك الحاجات.
2.
كانت أهداف الاستعمار البريطاني حسب تصور اللورد كرومر ( المندوب البيريطاني في مصر) ايجاد نوع من التعليم يخرج موظقين وكتبة للمساعدة في إدارة الحكم ، وفي الوقت نفسه يلهى المتعلمين عن الثورة ، ويؤهلهم أو يكيّفهم للتوظف بالحكومة. ولم يهتم كرومر بالتعليم الصناعي والمهني لدوره السياسي وفي ذلك كتب " بأن كل نجار أو بناء تخرجونه يمثل فئة تنفصل من صفوف الحانقين الذين يصبحون وطنيين مهرجين" ، وكان كرومر يهدف من ذلك الي اضعاف الحركة الوطنية ، لذا كان يوجه دائما بأن يقتصر التعليم على نفر تحتاج اليهم الدولة في وظائفها ، وكانت آراء كتشتر وونجت وكرى مماثلة لأفكار كرومر. ( للمزيد من التفاصيل راجع ، تاج السر عثمان ، دراسات في التاريخ الاجتماعي لفترة الحكم البريطاني، بحث غير منشور)
عندما عُين جيمس كرى مديرا لمصلحة المعارف في عام 1900 وضع الأهداف التالية للتعليم وعمل على تحقيقها وهي:
- خلق طبقة من الصناع المهرة .
- نشر نوع من التعليم بين الناس بالقدر الذي يساعدهم على معرفة القواعد الأولية لجهاز الدولة ، وخاصة فيما يختص بعدالة وحيدة القضاء .
- تدريب طبقة من أبناء لتشغل الوظائف الحكومية الصغرى في جهاز الإدارة.
( للمزيد من التفاصيل ، راجع محمد عمر بشير، تطور التعليم في السودان ، 1898- 1956 ،مرجع سابق).
كان من أهداف التعليم تدريب سودانيين ليحلوا محل المصريين في الجيش ، ويخلفوا المصريين والسوريين في وظائف الإدارة الصغرى ، فقد كان معظم ضباط الجيش في السودان أما بريطانيين أو سوريين. كما عمل كرى على اصلاح الخلاوى بايجاد مدارس كتاتيب نموذجية ودفع اعانات مالية لعدد قليل من الخلاوى ، وتشجيع الفقراء أو شيوخ الخلاوى على ادخال المواد العلمية كالحساب في الخلاوى المعانة. وبذلك اصبح التمازج بين التعليمين المدني والديني سواء أكان ذلك في الكنائس أم الخلاوى المعانة أساس التعليم في السودان ( محمد عمر بشير ، المرجع السابق).
لتحقيق أهداف سياسة المستعمر أُنشئت أول مدرستين ابتدائتين أحدهما في أم درمان 1900 ، والأخرى في الخرطوم 1901 ، كما انشئت كلية تدريب المعلمين والقضاء بام درمان في 1900 ، فضلا عن تأسيس مدرسة الصناعة في ام درمان 1901.
وعلى هذا كان الهيكل التعليمي في 1901 مكونا من تلك المدارس الآربعة ، فضلا عن مدرستين ابتدائيتين احداهما في سواكن والأخرى بحلفا ( تاج السر عثمان ، دراسات في التاريخ الاجتماعي لفترة الحكم الاستعماري ، 1898- 1956، بحث غير منشور.)
وكانت مدة الدراسة الابتدائية اربع سنوات ، ومقررات التعليم مماثلة لمقررات المدارس المصرية.
كما أنشئت مدرسة القضاء لتخريج القضاة الشرعيين والحقت في البداية بمدرسة أمدرمان الايتدائية ، وكانت مدة الدراسة فيها خمس سنوات ، والعلوم التي دُرست بها هي الشريعة واللغة العربية والحساب.
وكانت العلوم التي تُدرس بمدرسة الصناعة بأم درمان هي العلوم النظرية التطبيقية على درجة من الإنتاج في البناء وأعمال الخزف والحدادة والبرادة وجنى القطن ، وكانت فترة الدراسة ثلاث سنوات.
كما عاد التعليم التبشيري في فترة الحكم البريطاني من جديد بعد أن اوقفته المهدية، وكان من أهداف كل من الحكومة والارساليات التبشيرية بالجنوب هى الحد من نفوذ الإسلام في الجنوب. وفي عام 1900 سُمح للارساليات بأن تؤسس مدارس للأطفال المسيحيين في الخرطوم ، وفي عام1901 صُدق لها بفتح مدارس خارج الخرطوم ، كما سُمح لأبناء المسلمين بالالتحاق بها بشرط أن يفى الآباء ويلتزموا بالشروط التي سُمح لابنائهم بالدراسة بها والتي أهمها موافقة الآباء وتفتيش الحاكم العام لها.
هكذا تطور في الشمال نظام تعليمي تديره وتوجهه الحكومة ونظام تقليدي وتبشيري لم يخضع لاشراف الحكومة.
من المشاكل التي حدت من تطور وانتشار التعليم :
- نسبة نفقات التعليم أقل من 1% من المصروفات الكلية حتى عام 1903 ، وبلغت حدها الأعلى 4% عام 1912 ( محمد عمر بشير ، المرجع السابق).
- عدم توفر المعلمين ، وجرت محاولات لسد هذا النقص بانشاء معهد تدريب النعلمين والاستفادة من الإداريين المعلمين مع فتح فرص للترفي.
3
قيام كلية غردون :
التطور الآخر في التعليم هو قيام كلية غردون التي وضع حجر الأساس لها اللورد كرومر باسم الملكة فيكتوريا التي قبلت أن تكون راعية لها ، بتبرعات من انجلترا وبلدان أخرى، وتم افتتاح الكلية رسميا عام 1902 ، كخطوة في التعليم الثانوى والتي اصبحت مركزا للتدريب العالى والمصدر الأساسي لتدريب الإداريين والفنيين والمدرسين للعمل بخدمة الحكومة.
استمر التعليم في التوسع كما في قيام المدرسة الحربية 1905 ، وتأسيس المدارس الأولية والوسطى للبنين والبنات في المدن الرئيسية، كما تم انشاء مدارس حكومية بجنوب السودان ، اضافة للتعليم التبشيري هناك .
تعليم البنات :
كان تعليم البنات ضعيفا ، فخلال العشرين عاما الاولي من الحكم الاستعمارى لم تؤسس الا خمس مدارس للبنات في كل من رفاعة والكاملين ومروى ودنقلا والأبيض ، كما ساهمت المدارس الارسالية في التوسع في تعليم البنات، وفي عام 1921 افتتحت مدرسة أولية بام درمان كجزء من كلية تدريب المعلمات.
التعليم الفنى :
كان تطور التعليم الفتى بطيئا ، وفي عام 1914 بلغ عدد طلاب الفنية 281 طالبا.
تمويل التعليم :
لتمويل التعليم في بداية الحكم الاستعماري ، فرضت الحكومة ضريبة للتعليم في بعض المناطق تتراوح 1/10 ، 1/20 منقيمة العشور ، وكانت تتحصل نقدا أو عينا للتوسع في التعليم العالي ، وكانت حصيلة الضرائب تستخدم جميعها في انشاء المدارس الأولية في المناطق التي دفعتها ، ويلاحظ محمد عمر بشير أن المناطق التي دفعت أكثر من غيرها نتيجة زيادة سكانها وازدهار أحوالها الاقتصادية حظيت بمدارس أكبر.
4
خلال الفترة : 1924- 1946 ، تم انشاء كلية الطب " كلية كتشنر الطبية 1924" ، معهد بخت الرضا ، وتطور التعليم العالي ( انشاء مدارس عليا للزراعة ، الطب البيطري عام 1939) ، وقيام كليات الهندسة والعلوم 1939 ، وانشاء كلية الآداب 1945. في عام 1946 تم تحويل كلية غردون الي كلية جامعية.
وكان التعليم العالي ضئيلا ففي العام 1956 بلغ عدد الطلاب في الكليات والمدارس العليا 722 طالبا ، أما عن عدد الاساتذة الجامعيين ، فقد كان عدد السودانيين 3 من 150 أستاذا( تاج السر عثمان دراسات ي التاريخ الاجتماعي، مصدر سابق)
في عام 1940 تم تأسيس أول مدرسة أوسطى للبنات.
كان من نتائج حملة مؤتمر الخريجين لتوسيع التعليم وانشاء مدارس أهلية جديدة في الفترة 1941- 1952 ،أن أُسست 31 مدرسة وسطى اهلية في شتى ارجاء البلاد ، كما أُسست 4 مدارس ثانوية أهلية حتى عام 1956.
كما تطور التعليم المصرى ، ففي عام 1936 ارتفع عدد المدارس المصرية الي سبع بتأسيس مدارس الأبيض وبورتسودان ،ووأم درمان ، اضافة لمدارس عطبرة والخرطوم والخرطوم بحرى وكريمة.
هذا اضافة للطلاب السودانيين في مصر الذين بلغ عددهم 789 طالبا في العام 1949 .
5
حصيلة الحكم الاستعماري في التعليم :
في العام 1956 كانت حصيلة الحكم الاستعمارى في التعليم علي النحو التالي :
- التوزيع غير العادل بين المناطق المختلفة، نتيجة للتنمية غير المتوازنة التي خلفها الاستعمار.
- لم تكن هناك مساواة بين المرأة والرجل ، فقد كانت نسبة تعليم الذكور 22,9% ، بينما كانت الاناث 4%، أي أن نسبة الأمية بين الذكور بلغت 79,1% ، ووسط الاناث 96% .
- كان التعليم الفني ضئيلا مقارنةً بالتعليم الأكاديمي ، فقد كان جملة المستوعبين في المدارس والكليات والجامعة (219,831) طالبا، بينما عدد المستوعبين في المدارس الفنية (1027) طالبا،أي بنسبة 0,5%.
- كانت نسبة التعليم منخفضة ، فقد كانت 10% سنة 1956 ، أي أن نسبة الامية كانت 90%.
- تعدد مصادر التعليم في السودان ، فقد كان هناك تعليم الخلاوى المعاهد الدينية الإسلامية، والتعليم المسيحي التبشيري ، والتعليم المصري وفق المنهج المصري ، والتعليم في المدارس التي شيدتها الحكومة أو أفراد من القطاع الخاص، وكان لكل من تلك المدارس والنظم أغراضها وأهدافها الخاصة، ولم يكن لخريجي تلك النظم المختلفة أساس مشترك في التعليم ، ومن ثم كان لكل نوع ميول وقدرات مختلفة عن الآخرين.
هكذا نصل الي هذا الحصاد البائس فيما يختص بسياسة الاستعمار البريطاني التعليمية في السودان .
ثامنا :
التعليم في الفترة : 1956-1989 (8)
1
بعد الاستقلال لم يحدث تغيير جذرى في التعليم في هذه الفترة التي شملت فترات الديمقراطية الأولي والثانية والثالثة ، وفترتي انقلاب 17 نوفمبر 1958 وانقلاب 25 مايو 1969 ، بل سارت الحكومات المتعاقبة في هذه الفترة المدنية ولعسكرية في جوهر سياسات النظام الاستعماري القائم على التنمية غير المتوازنة بين أقاليم السودان، والتبعية للنظام الراسمالي عن طريق التبادل غير المتكافئ ، واستمرت حرب الجنوب وانفجار قضايا جماهير الهامش ، وتدهور الإنتاج الزراعي والصناعي والاوضاع المعيشية ، مما أدي لمجاعة 1982/ 1983 والنزوح الكبير الي الى اطراف العاصمة.
على أن التخريب في التعليم والتدخل في الجامعات كان واضحا في فترتي الانقلاب العسكري ، فقد اعلنت ديكتاتورية 17 نوفمبر التعديل في قانون الجامعة عام 1961، وبموجب القانون الجديد تم إلغاء استقلال الجامعة ، وحولها الي مؤسسة تابعة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ، فالرئيس عبود يعين مدير الجامعة ، ومحلس الجامعة يعينه مجلس الوزراء ليصبح عبود هو الرئيس الفعلي للجامعة ، وقد قاوم طلاب جامعة الخرطوم هذا القرار.
أما في انقلاب 25 مايو فتدخل النظام العسكرى في الجامعات والغى قانون 1956 الذي تم اعادته بعد ثورة اكتوبر الذي كفل استقلال الجامعة وحرية الفكرالبحث العلمي، واصبح النميري راعيا للجامعة الذي يعين المدير والمدير يعين عمدء الكليات، وقاوم الطلاب والاساتذة هذا القانون المعيب ، وتم قمع الطلاب وتشريد واعتقال قصل الأساتذة والطلاب.
كما استمر تدهور التعليم ، فقد كانت نسبة الأمية 85% في العام 1986 ، وحسب الاحصائيات الرسمية في العام 1986 رغم قصورها ، كانت نسبة الاستيعاب في بداية التعليم 52,8% من الأطفال البالغين سن التعليم، ونسبة الاستيعاب في المدارس الابتدائية 49,8% ، ونسبة المستوعبين في التعليم الثانوي 16.6% ، ونسبة التعليم وسط البنيين 59,56% ، والبنات 40,44% ( المصدر احصاء التعليم العام في السودان 1986).
أما نسبة المحظوظين في التعليم العالي فلا تتعدى 2% ، مما يؤكد طبقية وصفوية التعليم ، و استمرار مشاكل التعليم كما في ضعف نسبة الاستيعاب في المراحل المختلفة ، ونقص المعلمين وتدهور اوضاعهم المعيشية والمهنية ، والهجرة الواسعة للمعلمين ،اضافة للحروب الأهلية والنزوح ، وكوارث السيول والفيضانات التي أدت للمزيد من التدهورالضعف في التعليم كما ونوعا ، وفي مفاصله أو محاوره الأساسية التي أشرنا لها في الحلقات السابقة وهي:
- السياسات والأهداف التي كان من نتائجها التخريب الكبيرللتعليم الذي حدث في نظام مايو ، وبشكل أكبر في ظل نظام الانقاذ، التخطيط والاحصاء التربوي، السلم التعليمي ، التطور والتغيير العشوائي في المناهج ، المعلمون وطريقة اختيارهم وعددهم و تدريبهم، تمويل التعليم.
2
على أن التدهور كان كبيرا بعد انقلاب 25 مايو 1969 ، وإعلان السلم التعليمي الجديد ( 6: 3:3) عام 1970 ، والتسرع الذي صاحب هذه العملية ، هذا فضلا عن عدم استشارة المعلمين ، والتطبيق الأعمى للنظام التعليمي المصري دون نظرة ناقدة ، فقد تدهور التعليم العام والحكومي في الكم والكيف ، وهاجر الأساتذة الأكفاء خاصة في العلوم والرياضيات ، اضافة لقلة الكتب ، وعدم استقرار المناهج وغير ذلك.
جاء ذلك في وقت تدهورت فيه كل الخدمات أو كل ما هو تابع للدولة ، وازدهر فيه كل ما هو خاص أو أجنبي سواء كان ذلك في مجال التعليم أو العلاج ( د. صديق امبدة، سياسة القبول للتعليم العالى ، دار جامعة الخرطوم 1985.
على سبيل المثال نجد أن عدد المدارس الثانوية العليا ارتفع من 11 مدرسة في العام 55/ 1956 الي 318 مدرسة عام 1982 /1983 ، الا أن هذا التوسع في التعليم الثانوى لم يقابله توسع مماثل في فرص القبول للتعليم العالى ، فقد تدنت فرص القبول لجامعة الخرطوم مثلا من 10,6% عام 1974/ 1975 الي 2,2 % في 84/1985 ، كما تدنت نسبة للناججين من 18,2% الى 3,2% ، كما تدنت نسبة قبول الناحجين الي 13%.
هذا اضاف لاستمرار التفاوت في التعليم بين الأقاليم كانعكاس للتنمية غير المتوازنة ، على سبيل المثال في قبول جامعة الخرطوم العام 1983/ 1984 كان طلاب العاصمة يشكلون نسبة 35% من طلاب الجامعة ، في الوقت الذي يشكل فيه طلاب العاصمة 25% من طلاب السودان للمرحلة الثانوية (صديق امبدة، مرجع سابق).
هذا اضافة لاستمرار غلبة التعليم الأكاديمي على التعليم الفنى، فقد كانت نسبة التعليم الأكاديمي ( 80% ، ونسبة التعليم الفنى 20%)
3
أما من حيث الكم في فقد قامت في هذه الفترة جامعة الخرطوم ، والقاهرة الفرع ، والمعهد الفنى ، وجامعة ام درمان الإسلامية ، و ازداد عدد المؤسسات التعليمية العليا التابعة لوازرة التربية والتعليم العالي بعد توحيدها تحت إدارة المجلس القومي للتعليم العالي في عام 1975 ، وأُنشات جامعات وكليات عليا خارج العاصمة الخرطوم الي مدن أخري مثل: جامعتي جوبا والجزيرة ، كلية التربية بعطبرة وكليات ابونعامة وابو حراز.
كما قامت تخصصات جديدة داخل المؤسسات القديمة : طب الأسنان ، المساحة ، مدرسة العلوم الرياضية ، مدرسة العلوم الادارية ، والإنتاج الحيواني . الخ بجامعة الخرطوم ، كلية العلوم بجامعة القاهرة الفرع، أقسام الاقتصاد والتأمينات بكلية التجارة.
ارتفع أعداد الطلاب المستوعبين في الجامعات ، وعدد الطالبات وعدد المدارس الثانوية.، وبدات ظاهرة الانتساب تشكل نسبة كبيرة ، وكذلك توسع التعليم الاضافي. الخ.
مشاكل التعليم العالى:
استمرت مشاكل التعليم العالي في الثمانينيات كما في الآتي:
- مشكلة عدم توافق التعليم العالى مع احتياجات البلاد الاقتصادية ، يتضح ذلك من الأعداد الكبيرة للعطالة وسط خريجي الكليات النظرية ، عاى سبيل المثال كانت نسبة العطالة وسط خريجي الكليات النظرية 36% من اجمالى المسجلين ، ونسبة العطالة بين المهندسين 33% ، والزراعيين 33% ، وخريجي الكليات المهنية 10% عام 1980 ( المصدر محمد أدهم على، توجهات الطلاب في التعليم العالى ومشاكل الاستخدام ، شركة الطابع السوداني، يونيو 1987م). كما أن معظم خريجي الكليات العلمية يعملون في مجالات الإدارة.
- التوسع الذي جدث في التعليم العالى في سبعينيات القرن الماضي لم يأخذ في الاعتبار الآتي:
أ- نكلفة الطالب في التعليم العالى.
ب- توافق أعداد الخريجين مع احتياجات الاقتصاد الوطني .
ج – الأسبقية هل للتوسع في التعليم الأكاديمي أم المهني؟
د – توفر الأعداد الكافية من الأساتذة ، ولا سيما فالمؤسسات التعليمية كانت تعانى من نقص حاد في هيئات التدريس نتيجة لهجرة الكفاءات المتزايدة ، مثال بعض الكليات في جامعة جوبا كانت تعاني تقصا حادا وتعمتمد على مساعدى التدريس.
- كما استمرت وتعمقت ضعف التعليم الفنى اللازم للتنمية ، على سبيل المثال في العام 1984/1985 كان عدد القبولين في الجامعات والمعاهد الفنية والمعاهد المتخصصة وفي المنح الخارجية (3664) طالبا ، والمقبولين في معهد الكليات التكنولوجية (1015) ، اي نسبة المقبولين في التعليم الفنى حوالي 27%.( المصدر احصائيات المجلس القومي للتعليم العالي).
4
خلاصة الأمر في نهاية هذه الفترة ازدادت مشاكل التعليم تفاقما نتاج للتخريب المايوي للتعليم الذي يتلخص في الآتي:
- تدهور اليئة المدرسة كما في انهيار المباني المدرسية التي اصبحت غير صالحة للدراسة.
- القمع والنظام الشمولي الذي ادي لمصادرة حريات الطلاب في قيام اتحاداتهم الطلابية وجمعياتهم المدرسية والابداعية في الفن والمسرح والموسيقي .
- تعرضت المناهج للتخريب التي اصبح وضعها حسب مزاج الفترة السياسية، بدون اشتراك المعلمين والآباءوالأمهات ، حتى اصبحت مليئة بالحشو والتكرار، الذي لا يساعد عااى التفكير الناقد والابداع و اعداد الطلاب لمواصلة التعليم من المهد الي اللحد، اضافة لعدم التسلسل فيها ، وضعف وسائل الايضاح ، وتدهور المكتبات المدرسية، وغياب المعامل التي تعزز الدراسة النظرية.
- تعمقت مشاكل المعلمين المعيشية والمهنية، اضافة للنقص في التدريب والتأهيل اضافة للنقص في عدد المعلمين وهجرتهم الكبيرة ، ومصادرة حقوقهم في التنظيم النقابي منذ العام 1971 .
- تمويل التعليم: ،كان تمويل التعليم ضعيفا ، على سبيل المثال في العام 82/ 1983 كانت نسبة الانفاق على التعليم والصحة 8,5% بينما كانت نسبة الانفاق علي الأمن الدفاع 21% !!!، بالتالي تفاقمت المشكلة بعد التوسع في التعليم .
- عدم التصدى لمحو الأمية التي استمرت الزيادة فيها.
نواصل
تاسعا
تجربة تخريب التعليم بعد انقلاب 25 مايو 1969 (9)
أشرنا سابقا الى أن التخريب في التعليم بعد الاستقلال كان كبيرا بعد انقلاب 25 مايو 1969 ، وبشكل أكبر بعد انقلاب الانقاذ في 30 يونيو 1989.
فقد كان انقلاب 25 مايو المشؤوم مقدمة للخراب في كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والقومية، ومن ضمنها التعليم والذي واصل في تخريبه وتدميره بشكل كبير الاسلامويون بعد إنقلاب 30 يونيو 1989م، وإعلان السلم التعليمي (8- 3) فالمحتوي كان واحدا ، وهو فرض مناهج وسلم تعليمي بطريقة فردية ومتعجلة ودون مشاركة المعلمين ونقاباتهم والمهتمين والمختصين في الجانب التربوي.
سوف نركز في هذه الحلقة على تجربة تخريب التعليم بعد انقلاب مايو 1969.
1
جاء اعلان السلم التعليمي (6- 3-3) الذي فرضه وزير التربية يومئذ د. محي صابر بعد إنقلاب 25 مايو استجابة لضغوط القوميين العرب الذين كانوا قابضين علي السلطة ، وكان نقلا أعمي للتجربة المصرية في التعليم دون مراعاة التنوع الثقافي والقومي والديني في البلاد، وكان كارثة بحق علي التعليم في بلادنا.
وجد السلم التعليمي معارضة من الوطنيين والتربويين والمختصين والمعلمين و الشيوعيين الديمقراطيين والمهتمين بالتعليم والثقافة في البلاد، فقد تم فرضه بطريقة فردية ومتعجلة ودون مشاركة المعلمين والمختصين والمهتمين، والذي تم فيه تجاهل توصيات وقرارات مؤتمر التربية القومي الذي عقد في اكتوبر 1969م وكان هذا مثار نقد الشيوعيين لذلك ، وقد أثار الشهيد عبد الخالق محجوب ذلك في وثيقته التي قدمها للمؤتمر التداولي لكادر الحزب الشيوعي في اغسطس 1970 ، حيث أشار الي:-
- أعلنت الحكومة السلم التعليمي الجديد بطريقة متعجلة، لم يتم فيها التشاور مع المعلمين والمختصين، ، يقول عبد الخالق من زاوية السياسة التعليمية: ان نضال القوي التقدمية من طلاب ومعلمين لدفع وزارة التربية والتعليم في طريق المساهمة في النهضة الثقافية الوطنية في بلادنا، نضال قديم وله جذوره . ومنظمات المعلمين الديمقراطية لها نقد متعدد الجوانب للبرامج ولنظم التعليم في بلادنا، ولكننا نلحظ أن هذا المرفق المهم يسير علي طريق خاطئ:
- الكثير من الخطوات التي اتخذها الوزير ذات طابع دعائي ولم تستهدف تغييرا جوهريا في التعليم لخدمة الثورة الديمقراطية. مشروع الاستيعاب الذي يستهدف ديمقراطية التعليم لم يستفد منه الا ميسورو الحال من أبناء المدن التي فيها مدارس غير حكومية ( علي سبيل المثال: في 21 /يونيو/1969م، اصدرت الحكومة قرارا برفع عدد التلاميذ المقبولين في المدارس المتوسطة من 24 الفا الي 38,500 وفي المدارس الثانوية من سبعة الآف الي 10,400 وذلك للعام الدراسي القادم) (تيم نبلوك، صراع السلطة والثروة في السودان ،ص 232).
- لم يتم اشراك نقابات المعلمين في التخطيط التربوي، وفي تنفيذ البرامج الديمقراطية التي ناضلت من قبل لتحقيقها. ان الاتجاه الرسمي للوزارة يتجاهل الطرق الديمقراطية في العمل ويعمل لفرض سياسة لا تتلاءم مع ظروف بلادنا واهداف ثورتنا الثقافية. انه يطبق ما يجري في ج.ع,م (مصر) تطبيقا اعمي.
يواصل عبد الخالق الي أن يقول: (ونستطيع القول أن هذه الوزارة التي تلعب دورا مهما في ميدان أساسي للثورة الديمقراطية- واعني البعث الوطني الثقافي تعاني من سلبيات وأخطاء فاحشة، لابد من النضال ضدها. وأخطر هذه السلبيات هو الفهم القاصر والتصور الخاطئ للثورة الثقافية المنبعثة من خصائص شعبنا ومن حضارته العربية والزنجية، واللجوء الي النقل الاعمي بلا تمييز ولا نظرات ناقدة) ص،133 – 134
2
كما جاء في المؤتمر التداولي لكادر الحزب الشيوعي المنعقد في اغسطس 1970م حول هذه القضية ما يلي (في مايختص بالثورة الثقافية النابعة من المرحلة الوطنية الديمقراطية فالتوجيهات الأساسية في هذه القضية خاطئة.
- اقتصر المجهود علي حيز التعليم المدرسي، ولم تطرح قضايا الثقافة الشعبية من محو للأمية ومن بعث ثقافي يعبر عن ثروات شعبنا الحضارية ويساهم في ازاحة المؤثرات المختلفة عن كاهل المواطنين.
- المجهود التعليمي لايستهدف ديمقراطية التعليم من حيث تحقيق الزاميته، من حيث توجيهه نحو ابناء الكادحين. اننا نحتاج بالوتائر الراهنة الي اكثر من 38 سنة لاستيعاب كل الأطفال من الذين هم في سن التعليم في المدارس الابتدائية، .
– لم يرتبط التعليم بحاجيات الخطة الخمسية وما ينتظر بلادنا من ثورة اقتصادية) ، ص ، 159، قرارات المؤتمر التداولي
3
جاء في خطاب للحزب الشيوعي للديمقراطيين 1971م حول السلم التعليمي مايلي:
لقد استطاع الوزير الحالي محي الدين صابر، أن يوهم الرأي العام وجمهور المعلمين بأن في ادخاله لنظام السلم التعليمي الجديد قد احدث ثورة في التعليم مستغلا في ذلك الاستجابة العظيمة التي قابل بها المواطنون المشاكل التي نتجت عن تطبيق السلم التعليمي الجديد ولكننا امام ادعاء يجب علي كل شيوعي وثوري ان يحدد موقفنا منه ، الا وهو هل ما يجري الآن في بلادنا من تطبيق لسلم تعليمي جديد وتغيير في بعض المناهج هو الثورة الثقافية التي ننشدها جميعا؟ وكيف يمكن أن نتحدث عن ثورة تعليمية أو ثقافية اذا كانت هذه الثورة التعلمية المزعومة لاتمس جوهر الحقيقة التي تؤكد أن 82% من سكان بلادنا مازالوا يعانون من الأمية. كيف يمكننا أن نتحدث عن أية ثورة ونحن لانستطيع أن نتقدم بأى مشروع لمحاربة هذا التحدي العظيم؟ ان الثورة الثقافية نفسها لن يكتب لها الانتصار اذا بقيت غالبية شعبنا تعيش في امية وفي جهل مطبق. ثم كيف يجوز لنا أن نتحدث عن الثورة التعليمية بينما نحن لانستطيع ان نتقدم بأى مشروع يقدم من التعليم المهني في بلادنا ، ذلك التعليم الذي تعتمد علي وجوده تطوير كل مشاريع التنمية الصناعية والزراعية التي نصبوا الي انجازها في خططنا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؟
ثم كيف يجوز لنا ان نتحدث عن ثورة ثقافية بينما تراثنا الثقافي يرقد بين الاطلال يبحث عن من ينقب فيه ؟ ماهي مشاريعنا لاحياء ذلك التراث ؟ ماهي مشاريعنا في ميادين الفنون والآداب ، في الغناء والموسيقي والرقص الشعبي ، في ميادين الشعر والتأليف والقصص ؟ ان الحديث عن الثورة الثقافية لايستقيم في نظر أى عاقل ما لم يعالج بصورة جادة قضية احياء التراث الثقافي للشعب السوداني)( ص، 11- 12 ).
هذا وقد اصدر د.محمد سعيد القدال كتابا ممتازا بعنوان: (التعليم في مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية، 1971م)، أوضح فيه التمايز بين الشيوعيين وسلطة البورجوازية الصغيرة حول مفهوم التعليم وأهدافه في مرحلة الثورة الديمقراطية، والكتاب خلاصة لما توصلت اليه حركة المعلمين الديمقراطية ونقاباتها في مضمار اصلاح التعليم، ويمكن للقارئ الراغب في المزيد أن يرجع له.
عاشرا :
التخريب الممنهج للتعليم في فترة الانقاذ (10)
1
التخريب الآخر الأكبر للتعليم والممنهج هو الذي حدث بعد انقلاب 30 يونيو 1989م الذي دبرته الجبهة االقومية الإسلامية بقيادة د. الترابي ، وصادر الحريات والحقوق الأساسية ، ومارس القمع الوحشي للمعارضين السياسيين والنقابيين من اعتقالات واعدامات وتعذيب وحشي في بيوت الأشباح ، وقام بتشريد أكثر من 450 الف من العاملين ، وزاد نيران الحرب الجهادية اشتعالا في الجنوب ، وجبال النوبا وجنوب كردفان ، حتى تم انفصال الجنوب ، واصبح البشير مطلوبا للجنائية الدولية نتيجة الجرائم ضد الانسانية و الإبادة الجماعية التي تمت في دارفور بواسطة قوات الحكومة والجنجويد ، كما تم عقد مؤتمرات كانت قراراتها وتوصياتها جاهزة ومعروفة سلفا والدعوة فيها تتم علي أسس فردية ومن الاذاعة مثل: مؤتمرات الصحافة والاعلام والحوار الوطني، والتعليم.الخ .
كما سارت سياساته الاقتصادية في طريق التنمية الرأسمالية التقليدي الذي سارت عليه حكومات مابعد الاستقلال المدنية والعسكرية، رغم شعارات الاسلام التي رفعها، فهي تنمية مستندة علي الفكر التنموي الغربي: " تحرير الاقتصاد والأسعار واقتصاد السوق ، والتصديق بمدارس وجامعات ومستشفيات خاصة لرموز الإسلامويين، بعد أن اصبح التعليم والصحة سلعة لتحقيق أكبر قدر من الأرباح والتراكم الرأسمالي ،اضافة للخصخصة أو تصفية مؤسسات القطاع العام وبيعها بأثمان بخسة لمحاسيب النظام، التخفيضات المتوالية للعملة، ونهب عائدات البترول التي قُدرت بأكثر من مائة مليار دولار ، اضافة لنهب عائدات الذهب ، تهريبها للخارج وتم ادخال نظم مثل: السلم في الزراعة والزكاة وتجربة البنوك الاسلامية وشركات الاستثمار الاسلامية، فالبنوك الاسلامية، كما هو معروف، استغلت الشعار الاسلامي للحصول علي سيولة كبيرة استخدمت في صفقات تجارية قصيرة المدي بأسلوب المرابحة، ولم تساعد الاستثمار ولم تقدم بديلا وظيفيا لسعر الفائدة.
بعد الاستيلاء علي السلطة تم التمكين في الارض للرأسمالية الطفيلية الاسلاموية والتي تضاعفت ثرواتها بشكل هائل بعد الانقلاب وكان من اهم مصادر تراكمها الرأسمالي: نهب اصول القطاع العام، اصدار قانون النظام المصرفي لعام 1991م والذي مكن لتجار الجبهة ولمؤسساتها من الهيمنة علي قمم الاقتصاد الوطني، والتسهيلات والرخص التجارية من وزارة التجارة والبنوك التجارية والإعفاء من الضرائب، والاستيلاء علي شركات التوزيع الأساسية وتمليكها لتجار وشركات الجبهة الاسلامية، والمضاربة في العقارات، والاستثمار في مشاريع الزراعة الآلية، والاستيلاء علي مؤسسات تسويق الماشية، اضافة لنهب عائدات البترول والذهب والجبايات واقفار المزارعين، ودعم رأس المال الإسلامي العالمي، اضافة للاستثمار في التعليم والصحة والذي اصبح مصدرا للتراكم الرأسمالي كما اشرنا سابقا..
2
وصلت البلاد في ظل نظام الانقاذ الى أدنى مستوي لها في التعليم ، فمنذ إعلان سياسة الانقاذ بعد صدور قرارات وتوصيات مؤتمر التعليم الذي دعت له السلطة الانقلابية في 17 سبتنمبر 1990 ، وتمّ وصفها بانها ثورة تعليمية كبرى!!! تهدف الى إعادة صياغة الانسان السوداني ، وتحقيق نظام تعليم مستمد من موروثات المعارف الإسلامية عقيدةً واخلاقا .
وهو في جوهره مشروع يخدم فكر الاسلامويين الظلامي باسم المشروع الحضاري ، ولتحقيق هذا لم يراعو حتى توصيات مؤتمر التعليم في التمويل والأحصاء التربوي، وتدريب المعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية.الخ.
لكنهم قاموا بصياغة المناهج على عجل بواسطة عناصرهم ، ودون مشاورة المعلمين واولياء الأمور والمختصين والمهتمين ، وهى مناهج مليئة بالأخطاء المعرفية اولإملائية والحشو والتكرار ، اضافة لعدم مراعاة أذهان الطلاب بزحمتهم بمواد فوق طاقتهم الذهنية ، وعدم مراعاة خصائص الييئة والواقع السوداني المتعدد دينيا ولغويا وثقافيا وعرقيا.
إما في السلم التعليمي فقد كانت ابرز معالمه :
- قام على 8 :3 ، أي جعل المرحلة الابتدائية 8 سنوات، والثانوي 3 سنوات
- إلغاء المرحلة المتوسطة.
- انقاص سنوات الدراسة عاما.
(للمزيد من التفاصيل راجع عمر على محمد طه شرارة ، تطور التعليم العام خلال خمسين عاما 1956- 2006 ، دار مدارات ، 2012)
كان هذه القرارات وبالا على التعليم ، فقد تم خصم عام دراسي كامل من الطلاب أدى لتدهور في مستوى تعليمهم ، اضافة لتجاهل ملاحظات وانتقادات المعلمين والمهتمين واولياء الأمور الذين ارهقوهم في متابعة أبنائهم بمناهج طويلة مليئة بالحشو الذي لا معنى له.
كان من نتائج ذلك تدهور مستويات الطلاب في اللغة العربية وبقية المواد ، وعودة البلاد الى الوراء جراء تلك المناهج للتعليم.
تدهورت اوضاع المعلمين المعيشية والمهنية، والبيئة المدرسة، فقد اصبحت 90% من المدارس غير صالحة. .
ضعف ميزانية التعليم التي لم تتجاوز 2,5% ،على سبيل المثال في العام 2012 ، بلغ الصرف على التعليم 44 مليار جنية ، في حين بلغ الصرف لجهاز الأمن (1) ترليون جنية ( الترليون الف مليار) و 30 مليارجنية.
كان من نتائج ذلك الخراب الكبير الذي نشهده في التعليم العام الذي عبرت عنه لجنة المعلمين في اضرابها الجارى حاليا ، حيث اشارت لضرورة زيادة الحد الأدني لأجور المعلمين ، وزيادة الانفاق على التعليم ليصل الي 20%، وتدهور بيئة المدارس التي زادت تدهورا بعد انقلاب 25 أكتوبر ، واصدار ميثاق للتعليم باعتباره اساس تقدم وتطور البلاد واستثمار بشرى لا غنى عنه، اضافة الى أن اجبار الطلاب على دفع الرسوم أدي لتسرب أعداد كبيرة منهم خارج المدارس.
وبعد خراب سوبا بعد 20 عاما من التجربة اقروا بالفشل .
3
في التعليم العالي الغت الحكومة الانقلابية قانون الجامعة ، واعلنت ما يسمي بثورة التعليم العالي الذي التي كانت كارثة ، وصادرت استقلال الجامعات والاتحادات الطلابية في الجامعات كما حدث في الثانويات.
كما شردت الأساتذة المؤهلين مما كان له الأثر السلبي علي التعليم العالي ، والغت نظام الاعاشة والسكن ،وقام صندوق دعم الطلاب الذي اوغل في الفساد ونهب ممتلكات الجامعات، ومارست اقصي انواع العنف ضد الطلاب من قتل وتشريد وتعذيب وحشي ، وقمع مفرط لاضراباتهم ومظاهراتهم ، وكونوا الوحدات الجهادية الطلابية التي حولت الجامعات لساحات حرب بدلا من ساحات للحوار والفكر المستنير، وحرية البحث العلمي والأكاديمي ،وسالت الدماء ، واشتدت موجة العنف والإرهاب ، ومصادرة حرية الفكر والحوار، ومنع فوز قوائم المعارضة في الاتحادات ، وتم استشهاد عدد كبير من الطلاب ( محمد عبد السلام، التاية، ابو العاص ، . الخ)، كما تم استخدام القمع الوحشي لطلاب دارفور، ولكن رغم ذلك تواصلت مقاومة الطلاب بمختلف الأشكال من اعتصامات ومظاهرات ومذكرات وعرائض ، وقيام اوسع تحالفات تم فيها انتزاع بعض الاتحادات ، واستخدم "رباطة" المؤتمر الوطني العنف لالغائها، أو تجميد الاتحادات ، كما حدث في جامعة الخرطوم والجامعة الأهلية، وكردفان. الخ.
قامت انتفاضات الطلاب في سبتمبر 1995 ، وسبتمبر 1996 ، و2012 ، والتي كانت قوية هزت النظام، وتم مواصلة النضال من أجل شرعية الاتحادا الطلابية وحرية وديمقراطية النشاط الطلابي السياسي والفكري والأكاديمي واستقلال الجامعات، وتوفير مقومات التعليم من سكن واعاشة ، الغاء الرسوم الدراسية الباهظة و توفير المكتبات والأساتذة، وميادين رياضية ومعامل، وابعاد الوحدات الجهادية المسلحة من الجامعات وعودة الطلاب المفصولين ، والتحقيق في اغتيال الشهداء .الخ.
4
في هذه الفترة يونيو 1989- ديسمبر 2019 ، حدثت متغيرات كبيرة في التعليم العالي حيث بلغت جملة مؤسسات التعليم العالي أكثر من 72 مؤسسة منها 44 جامعة خاصة وأهلية و28 حكومية ، منه 11 بالعاصمة، وبلغ القبول بها أكثر من 250 ألف طالب.
هذا التوسع كما شرنا سابق ، لم يقابله توسع في الصرف علي التعليم ، وفي توفير الأساتذة المؤهلين والمراجع والمكتبات والمعامل والمباني اللائقة ، والبيئة الجامعية مثل : الميادين الرياضية وأماكن النشاط الثقافي والترفيه . الخ من مقومات التعليم العالي. كما تم تصفية نظام السكن والاعاشة والزيادة في الرسوم الدراسية، كما تواصلت اعداد الزيادات في الطالبات مما يتطلب دراسة وحل مشاكل الطالبات.
كما تدنت مستويات البحوث العلمية ، وضعف ميزانية التعليم التي بلغت في المتوسط 1,3% من ميزانية الدولة، مما أدى لفرض الرسوم الباهظة على الطلاب المقبولين للجامعات هذا العام ، التي وجدت مقاومة كبيرة من الطلاب والأساتذة ، ومجالس إدارات الجامعات، اضافة لنهب ممتلكات الجامعة ( أراضي ، مزارع. الخ)، وضعف العلاقات والتدريب الخارجي، وتراجع جامعة الخرطوم وغيرها في التصنيف العالمي .
فضلا عن مشكلة القبول الخاص التي جعلت الكفاءة تتراجع في وحه من يمتلكون المال، اضافة لمشكلة التدريب النظرى دون العملي ، كما تم حشو المناهج بمطلوبات الجامعة ، تدن اللغة الانجليزية جراء التعريب غير المدروس.
لمواجه ذلك تبرز أهمية زيادة الصرف على التعليم ، وشروط الخدمة المجزية للاساتذة لمواجهة خطر الهجرة للكفاءات ، الغاء القبول الخاص ، واستقلالية الجامعات وحرية البحث العلمي والأكاديمي ، وتوفير مقومات التعليم العالي من معامل ومكتبات ، وسكن واعاشة للطلاب ، وعودة الداخليات للجامعات .
نواصل
احدى عشر
التعليم بعد ثورة ديسمبر (11)
1
أشرنا في الحلقة السابقة الى التخريب الممنهج الذي جرى للتعليم في فترة الانقاذ الذي أدي لتدهور مريع في التعليم بشقيه العام والعالي ، الذي استمرت آثاره بعد ثورة ديسمبر2018 وحتى انقلاب 25 أكتوبر، كما في ضعف الميزانية، والعجز المالي والفشل في تمويل الكتاب المدرسي، ومع استمر تضخم ميزانية الأمن والدفاع التي استحوذت 76% من الميزانية العامة ، واستحواذ شركات الجيش والدعم السريع والشرطة والأمن على 82% من موارد الدولة ، اضافة لدفع الدولة لمرتبات الدعم السريع والصرف على اتفاق جوبا الذي تحول لمحاصصات ومنافع لا علاقة لها بمطالب أهل دارفور والمنطقتين ، وزاد من عوامل التدهور إغلاق المدارس ، وفقدان العام الدراسي 2018 /2019، وكان من المفارقات أن 2056 طالب وطالبة حازوا علي 90% في الشهادة السودانية لم يجدوا مقاعد في الجامعات الحكومية !!،، اضافة لأزمة الاغلاق في فترة "الكرونا "، وكوارث السيول والفيضانات التي أدت لانهيار مدارس كثيرة ، واستمرار الحرب والابادة الجماعية لنهب الموارد في دارفور والمنطقتين والشرق ، اضافة للفوضي الإدارية التي حدثت في التعليم بعد الثورة ، ومحاولات احلال تمكين بتمكين دون وعدم وضع الكفاءات المناسبة في إدارات التعليم ، وكان من القرارات التي وجدت تأييدا عودة المرحلة المتوسطة خلال العام الدراسي 2021 ، لكن لم تتوفر مقوماتها من مباني واثاثات كتب ومناهج ومعامل .
تدهور التعليم بعد الثورة لم يكن معزولا عن الفشل في تحقيق أهداف الثورة، اضافة لهجوم الفلول علي الثورة وتخريبها بدعم من اللجنة الأمنية ، والهجوم على محاولة تغيير المناهج في التعليم ، حتى قيام انقلاب 25 أكتوبر الذي زاد الوضع تدهورا في التعليم.
2
بعد الثورة استمر انهيار التعليم ، وكانت هناك محاولات اصلاح الوضع في ظروف انقلاب اللجنة الأمنية، واستمرار التمكين في الخدمة المدنية والنظامية ، وتم عقد ثلاثة مؤتمرات لاصلاح التعليم وكان آخرها مؤتمر المناهج مع المعلمين وأولياء الأمور والإداريين والخبراء التربويين واصحاب المصلحة لاشراكهم في وضع المناهج ، اضافة لمحاولة اصدار قانون التعليم العام 2020، رغم استمرار هجوم "الفلول" ، وخاصة بعد تعيين د. القراى مديرا للمركز القومي للمناهج .
كما أشرنا في مقال سابق ، جاء ء قرار رئيس الوزراء حمدوك في البيان الصحفي بتاريخ الأربعاء 6 يناير 2021 تجميد العمل بمقترحات المناهج الدراسية حلقة جيدة في مسار تصفية ثورة ديسمبر المجيدة التي قدم فيها الثوار مئات الشهداء ، وما زالت جذوتها مستمرة ومتقدة ، رغم حدة التأمر الداخلي والخارجي عليها، ودون دراسة موضوعية لتجربة اللجنة الحالية ، وتحديد نواقصها لمعالجتها، فقد نص قرار حمدوك علي تكوين لجنة قومية تضم التربويين والعلماء والمتخصصين ، وتمثل كافة أطياف الآراء والتوجهات في المجتمع لتعمل علي إعداد المناهج الجديدة ، حسب الأسس العامة المعروفة في إعداد المناهج، وشدد علي أن تراعي لجنة المناهج التنوع الثقافي والديني والحضاري والتاريخي للسودان ، ومتطلبات التعليم في العصر الحديث ، وأن الفترة الانتقالية لسودان يسع الجميع ، وضرورة حصر المناهج التي تحتاج الي توافق اجتماعي واسع وهي قضية قومية تهم الجميع، وضرورة أن تستند المناهج التربوبة علي المنهج العلمي الذي يشحذ التفكير وينمي قدرات النشء ويحفز القدرات الإبداعية علي التفكير الاجتماعي.
أشار حمدوك أن مجلس الوزراء ظل يتابع الجدل والتشاور مع المجمع الصوفي ، هيئة شؤون الختمية ، الانصار ، وانصار السنة المحمدية ومجمع الفقة الإسلامي، والطوائف المسيحية وعدد من الفاعلين في المجتمع المدني، لكن دون أن يتصل بإدارة المناهج القومية لمعرفة ما حدث بالضبط !!، ودون طلب تقرير لمجلس الوزراء عن طريق وزير التربية للوقوف علي جهود لجنة المناهج ، كما هو متبع في المتابعة الدورية لمجلس الوزراء لأداء وزاراته المختلفة ، لكن اتضح أنه استجاب حسب بيانه لضغوط القوى الدينية الإرهابية التي تصاعدت حملتها دون أسس موضوعية علي د. القراي لأنه جمهوي، وتهديده بالقتل!! ، فضلا عن تصاعد الحملة مع ظهور كتاب الصف السادس الأبتدائي صورة خلق آدم للرسام العالمي مايكل انجلو ، اضافة لحملة الائمة في المساجد التي طالبت بتكفير د. القراي وهدر دمه!!! ، واضح أن رئيس الوزراء استجاب لضغوط القوي السلفية التكفيرية، واتخذ قراره بتجميد عمل لجنة المناهج التي كانت قومية في طابعها ، وتضمن منهجها كل أو أغلب النقاط والحيثيات التي قدمها حمدوك لتكوين لجنة جديدة، مما يصبح عبثا ، كل لجنة جديدة تلغي جهود اللجنة السابقة ، فالخطأ وارد في عمل اللجان، ويتم تصويبه في إطار عمل اللجان، استنادا لملاحظات التربويين والمهتمين، و لكن الاستجابة لضغوط القوي المضادة للثورة يدمر التعليم ، والتمسك بمناهج النظام البائد التي فشلت بعد تجربة 30 عاما ، وكانت النتيجة تخريج أجيال رافضة للنظام الفاسد وساهمت في اسقاطه في ثورة ديسمبر المجيدة.فضلا عن أنه لا يمكن الاصلاح بطريقة خاطئة مثل: تخطي مدير المركز القومي للمناهج ووزير التربية والتعليم في شأن يخص وزارته ، دون الرجوع اليه لمعرفة ما حدث !!
3
وجد القرار بتجميد عمل لجنة المناهج استنكارا واسعا مثل ماجاء في بيانات : لجنة المعلمين ، والحزب الشيوعي، ورابطة المعلمين الاشتراكيين بالخرطوم والحملة القومية لدعم تغيير المناهج السودانية، والعرائض والمذكرات من أفراد لرفض القرار، بيان تجمع القوي المدنية بتاريخ 7 يناير ، بعنوان " تغيير المناهج الدراسية واجب لاكمال الثورة" الذي طالب بتكوين جبهة واسعة من كل قوى الثورة لرفض قرار رئيس الوزراء ، تدخله الفج لاعاقة تطور مهام الدولة المدنية ، دون الرجوع لوزير التربية والتعليم المختص.
كما استقال د. عمر القراي من منصبه كمدير للمركز القومي للمناهج والبحث التربوي التي استنكر فيها القرار، وأشار الي أنه مؤهل أكاديميا لتولي المنصب في الحكومة التي ناضل من أجلها ، ورفض مطالب الفلول لعزله لأنه "جمهوري"، وكأن المعتقد يحرم المواطنين من تولي المناصب العامة!!، وأشار الي الموجة الثانية في الهجوم عليه بالتهديد بالقتل ، وكشف أكاذيب حملة ائمة المساجد بأنه حذف القرأن الكريم عن المقرارات الدراسية ، فهو لم يطالب بإلغاء القرأن ، ولكنه طالب بتخفيف سور الحفظ علي الأطفال . ، إضافة " للزوبعة" التي أثيرت بسبب صورة مايكل انجلو في كتاب التاريخ، وأشار الي أنه قابل فايز السليك وأعطاه نسخة من الكتاب ليطلع رئيس الوزراء عليها، فضلا عن أن رئيس الوزراء لم يستدعيه للسمع منه ، بل استمع لوفود الصوفية ، الختمية ، الأنصار ، انصار السنة ، والإخوان المسلمين، وفقهاء السلطان مثل: الشيخ التكفيري محمد الأمين اسماعيل في وضع المناهج التي تفترض أن تحقق أهداف الثورة، بدلا من التشاور مع لجان المعلمين ونقابتهم ومدراء التعليم في الأقاليم المختلفة!!!، علما بأن لجنة المناهج تضم مختلف القوي السياسية والمهنية.
وختم د. القراي : بأنه لن يتعاون مع حكومة ضعفت أمام المكون العسكري ، ورضخت لضغوط فلول النظام المدحور ، ورأت دون الرجوع لشعبها أن تسلم الثورة التي مهرت بدماء الشهداء لقمة سائغة لفلول النظام البائد، فلقد اختارت حكومة حمدوك" جانب سدنة النظام ، واخترت انا جانب الشعب.
أما بروفيسور محمد الأمين التوم وزير التربية والتعليم، فقد أصدر بيانا بتاريخ 10 يناير 2021 أشار فيه الي : أن السودان غدا وطنا ديمقراطيا يحتفي بتنوع أعراقه وثقافاته ، يلتزم بحقوق الإنسان ، ينشد التنمية المستدامة والمساهمة في تطور الحضارة الإنسانية، وأنه حدد رؤيته للتعليم في مؤتمر صحفي عقدته وكالة سونا للأنباء في 10 نوفمبر 2019 ، وتمت دعوة المشرفين في كل الولايات لعمل مؤتمر للتفاكر في راهن التعليم وبمشاركة: المعلمون، أولياء الأمور، والتلاميذ والطلاب والاداريون والتربويين ومنظمات المجتمع المدني والحكومة.
اضافة للمشاركة في مؤتمرات أصحاب المصلحة ( عدا الولاية الشمالية، والنيل الأزرق لأسباب لوجيستية)، كما تم عقد مؤتمر ثورة ديسمبر في أغسطس 2020 للنهوض بالتعليم اسفيريا في جميع الولايات، وبتنا نمتلك مشروعا قوميا متكاملا لتغيير التعليم العام تغييرا جذريا ، وتم انجاز في : المناهج والقوانين والتشريعات ووضع المعلمين المادي والمهني وتدريب المدرسين ، ومجانية التعليم والتعليم الالكتروني.
أشار محمد الأمين التوم الي تجاوز رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم في أمر يقع في اختصاصات وزارته الحصرية ، بإلغائه جهود اللجان التي أعدت المناهج دون إخضاعها لدراسة، وهي محاولة لدفع وزير التربية والمدير القومي للمناهج للاستقالة الفورية وتساءل لماذا قابل رئيس الوزراء المجموعات الدينية ، بدلا من توجيهها لمقابلة مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي ابتداءا، ثم مقابلة الوزير إن تعذر التوصل لحل مقبول لقضيتها؟. وأشار الي أن ذلك يندرج في إطار مخطط الفلول لاجهاض الثورة ، وايقاف مشروع التغيير الجذري في التربية والتعليم. وأشار الي أن مأزق (قحت) الذي يصيب الثوار في مقتل بالسماح للعناصر الاسلامية والمعادية للثورة للولوج لمواقع متقدمة في الجهاز التنفيذي، وأن مستقبل اطفال السودان والوطن يرنبطان بمشروع التغيير الجذري في نظام التعليم ، وختم بأنه جزء من المعركة الدائرة الآن من أجل انتصار لثورة ديسمبر المجيدة .
4
واضح أن قرار حمدوك بتجميد عمل المركز القومي للمناهج ، جاء ضمن حلقات التأمر علي الثورة، بايقاف اصلاح عملية التعليم باعتبارها ركنا أساسيا في الثورة، والإبقاء علي المناهج البائدة ومحتواها الذي يكرّس الجهل والتفكير المستقل، والتي أكدت فشلها بعد ثلاثين عاما، وهو امتداد لقرارات حمدوك وحكومته في تجاوز "الوثيقة الدستورية" التي أشارت الي : " معالجة الأزمة الاقتصادية بايقاف التدهور الاقتصادي ، وتحسين الأوضاع المعيشية ، والتزام الدولة بدورها في الدعم الاجتماعي وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال سياسات دعم الصحة والتعليم والاسكان مع ضمان حماية البيئة ومستقبل الأجيال".
ولكن ما حدث خضعت الحكومة لسياسات صندوق النقد الدولي التي أدت لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، والارتفاع المستمر في الأسعار والتدهور المستمر في قيمة الجنية السوداني ، ورفع الدولة يدها عن التعليم والصحة والدواء، وغيرها من المعاناة التي تعيشها جماهير شعبنا.
- مكن حمدوك المكون العسكري للتغول علي صلاحيات مجلس الوزراء في تكوين مفوضية السلام، وهيمنة المكون العسكري علي السلام ، والاتفاق مع الجبهة الثورية لتأخير تكوين التشريعي والمفوضيات ، والتوقيع علي اتفاق جوبا الجزئي اللذي كرّس المحاصصات والمسارات التي تهدد وحدة البلاد، و وخرق الوثيقة الدستورية في عدم اجازتها من التشريعي ، وجعل بنودها تعلو علي الوثيقة الدستورية.
- البطء في تفكيك النظام البائد واستعادة الأموال المنهوبة ، بل التراجع أمام ضغوطه، وتأخير نتيجة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام ، والمحاسبة لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وعدم تسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، وعدم إلغاء القوانين المقيدة للحريات، واجازة قانون النقابات الذي تمّ التوافق عليه، وعدم اكمال المحكمة الدستورية ، وعودة شركات الذهب والبترول وشركات الجيش والدعم السريع والأمن والاتصالات والمحاصيل النقدية والماشية لولاية المالية وتغيير العملة. والبطء في اصلاح الأجهزة العدلية والأمنية بما يحقق الأمن والاستقرار الذي انفلت بسب نشاط الفلول وفتنهم القبلية في الشرق والغرب، ومواكب الزحف الأخضر، وتهريب المواد التموينية والذهب والبترول ، ورفع سعر الدولار. الخ، اضافة لانتهاكات الدعم السريع، وتكوين بيوت اشباح ، تم التعذيب فيها حتى الموت ، مما يؤكد ضرورة حل الدعم السريع وكل مليشيات النظام البائد ، وجيوش الحركات ، وجمع كل السلاح وتكوين جيش قومي مهني موحد.
- هذا اضافة للتفريط في السيادة الوطنية، وفي ثروات وموارد وأراضي وموانئ البلاد ، والاستمرار في حلف اليمن ، وتوقيع الاتفاق علي التطبيع مع اسرائيل في غياب مؤسسات الشعب المنتخبة ، والتوقيع علي اتفاقات عسكرية مع الروس حول عمل قاعدة عسكرية في منطقة البحر الأحمر، والمناورات العسكرية مع القوات المصرية في مروي في ظل احتلالها لحلايب وشلاتين. الخ، ، والتوقيع علي اتفاقات عسكرية جديدة مع امريكا مما يضع السودان في قلب الصراع الدولي في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، مما يعرض السيادة الوطنية ووحدة البلاد للخطر.
5
وأخيرا في تلك الفترة و منذ تراجع قوي "الهبوط الناعم" في (قحت) بالتوقيع علي الوثيقة الدستورية مع اللجنة الأمنية للنظام البائد التي كرّست السلطة السياسية والعسكرية والمالية والإعلام في يد المكون العسكري، والدفاع عن مصالح الرأسمالية الطفيلية، وتعطيل تفكيك التمكين، والمثابرة في تصفية الثورة بمختلف الأشكال من مجزرة فض الاعتصام ، وانتهاك حق الحياة، ومواصلة المقاومة بالمواكب المليونية ، وتراجع حمدوك عن مجانية الصحة والدواء في ابعاد وزير الصحة السابق د. أكرم علي التوم بعد ضجة اثيرت حول أنه شيوعي علما بأن الحزب الشيوعي ، رفض التوقيع علي الوثيقة الدستورية "المعيبة" ورفض المشاركة في المجلسين الوزاري والسيادي، وهي نفس الطريقة الحالية لابعاد د.القراي من رئاسة اللجنة القومية للمناهج ، وإثارة الضجة حول لوحة مايكل انجلو ، بهدف التراجع عن اصلاح المناهج وتطوير التعليم رضوخا للقوي السلفية الظلامية الفاسدة التي فشلت في مناهجها التعليمية السابقة، وثار الشعب والجيل الجديد ضدها، ولكن سوف تواصل قوى الثورة نشاطها في اوسع تحالف من أجل انجاز أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية.
ثاني عشر
حصاد التعليم بعد الاستقلال (12)
1
تابعنا في في الحلقات السابقة حصاد تطور التعليم بعد الاستقلال الذي كان بائسا ، فرغم التوسع في التعليم العام والعالي، وفتح جامعات حكومية وخاصة جديدة ، اضافة للجامعات الأهلية مثل الأحفاد ، لكن التطور لم يكن كبيرا لا في الكم مقارنة بزيادة عدد السكان، ولا في الكيف ، وزاد تدهورا مع تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والفشل في انجاز مهام النهضة الوطنية الديمقراطية، كما أن فترات الديمقراطية على قصرها لم تشهد تطورا في التعليم سواء أكان ذلك في السياسات أو الأهداف أو البرامج أو المناهج ، ولم تُحل مشاكل المعلمين باعتبارهم حجر الزاوية في العملية التعليمية.
لكن التخريب الكبير في التعليم تمّ في فترتي انقلاب مايو 1969 عندما تبنت خط القوميين العرب في بداية الانقلاب بالنقل الأعمي للتجربة المصرية ، أو في ايامها الأخيرة في الدجل باسم الدين والتوجه الإسلامي في المناهج بعد قوانين سبتمير 1983 ، وانقلاب الاسلامويين في يونيو 1989 الذي استغل الدين في تدمير البلاد والتعليم ، وبعد ثورة ديسمبر كما في منهج "تاج الحافظين" الذي يواصل في استغلال الدين لأهداف دنيوية،، كما تابعنا ورصدنا ذلك التخريب.
2
تدهور التعليم حتى وصل الى الانهيار الحالي الذي نعيشه كما في الآتي:
- اصبحت البيئة التعليمية غير مناسبة ، كما في انهيار المدارس التي اصبحت أكثر من 60% منها غير صالحة للدراسة ، مع تكدس الفصول في المدارس والمدرجات في الجامعات، اضافة لمشاكل غياب أو ضعف المعامل والمكتبات ، والميادين الرياضية .
اضافة للقوانين المقيدة و للحريات التي تصادر حرية الجمعيات والاتحادات الطلابية والعمل النقابي للمعلمين ، وانتهاك استقلال الجامعات ، وحرية البحث العلمي.
- في الجامعات حدث توسع باسم ثورة التعليم العالي في عهد الانقاذ دون توفير مقومات التعليم من أساتذة ومكتبات ومعامل.الخ، بل تم تصفية السكن والاعاشة في بداية الانقلاب.
اضافة لمضاعفة القبول في الجامعات والمدارس دن توفر مقومات ذلك الزيادات في البنيات الأساسية والمكتبات والمعامل والأساتذة المؤهلين.الخ. فضلا عن تراجع الكفاءة العلمية امام القادرين في القيول الخاص. اضافة لارتفاع نسبة الطلاب الي الأساتذة أدي الى تدهور العملية التعليمية.
- الرسوم الباهظة التى فُرضت علي الطلاب أدت لتسرب الكثيرين من الفصول ، وزادت من جيش الأمية، وجعلت التعليم للقادرين وكرّست طبقيته.
- تدهور أوضاع المعلمين المعيشية والمهنية اضافة للنقص في التأهيل والتدريب ، مما أدي لهجرة الالاف منهم ، فضلا عن قيام نظام الانقاذ بتحويل معاهد تدريب المعلمين الي كليات تربية ، وتدمير بخت الرضا بدلا من تطوير وتقويم تجربتها ، وتأسيس المركز القومي للمناهج والبحث التربوي 1996 ليكون بديلا لها ، وعمل مناهج اتسمت بالحشو والتلقين وبدون مشاركة المعلمين والمهتمين والآباء.الخ أدت لتدهور مستويات الطلاب ، فضلا عن كارثة حذف سنة كاملة في السلم التعليمي، هذا اضافة لعدم التفرغ الكامل للاساتذة بسبب ضعف المرتبات .
أدي الفصل التعسفي في الأنظمة الشمولية والديكتاتوية الي فقدان كفاءات من المعلمين وأساتذة الجامعات مما اضر بالتعليم.
- تراجع التعليم الفني ، حتى اصبح أكثر من 80% من التعليم أكاديميا ، فالتعليم الفني هو ركيزة مهمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، فلا خير في تعليم نظرى غير مرتبط بالعمل، زاد الطين بله تحويل الممعاهد الفنية الي جامعات في التخريب الذي تم في ظل نظام الانقاذ.
- النفاوت في التعليم واضح بين الذكور والاناث ، وأبناء الأغنياء والفقراء ، وبين سكان الحضر والريف انعكاس للتطور غير المتوازن بين اقاليم السودان المختلفة ، بالتالي فهو ليس ديمقراطيا ، ومتاحا للجميع.
- تراجع البحث العلمي في الجامعات .
- تراجع الجامعات السودانية في التصنيف العالمي، وتدهور التعليم فيها مما أدي لهجرة أعداد كبيرة من الطلاب للدراسة بالخارج.
- عدم ارتباط المناهج باحتياجات البلاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ومراعاة التنوع الثقافي والديني واللغوي والعرقي بالبلاد، والنأي عن التلقين في المناهج ، واعدادها بحيث تحفز الطلاب للتفكير ومواصلة التعليم من المهد الى اللحد ، وتنمية النفكير الناقد والمبدع والخلاق. أدي التهدور في المناهج الى تدنى اللغة الانجليزية والعربية ، ومستوى البحوث العلمية
- عدم مواكبة التكنولوجيا واتباع طرق حديثة في التعليم تربط التعليم بالعمل.
- ضعف ميزانية التعليم التي وصلت الي 1,3% من ميزانية الدولة ، وضرورة زيادتها الي ما لايقل عن 20% اذا اردنا تعليما جيدا ينهض بالبلاد.
لقد ظل تمويل التعليم مشكلة منذ الاستقلال ، وحاولت القوى السياسية التي حكمت التوسع في التعليم على حساب خفض ميزانية التعليم ، حتى وصلت في عهد الانقاذ الى 2% من ميزانية الدولة.
- ساهم التعليم الأهلى، والخلاوى والمعاهد الدينية الاسلامية ، والمدارس المسيحية والمصرية في توسيع قاعدة التعليم ، ومحو الأمية وتوسيع الوعي، وتقليل الفاقد، لكن دون خطة عامة لوحدة وشمولية التعليم العام ، في اطار السياسة العامة للدولة ، وأهدافها في ربط التعليم باحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومراعاة التنوع الدبني والثقافي واللغوى في السودان.
- نسبة الاستيعاب في سن التعليم 52% ، مما يعني اضافة 48% كل عام الي جيش الأمية ، وحسب تقرير اليونسيف الأخير أن هناك 6,9 مليون طفل خارج التعليم، مما يعنى أننا لم نصل الي استيعاب كل الأطفال في سن التعليم في المدارس ، فضلا عن التفاوت في التعليم بين المدن والريف ، وبين الذكور والإناث كما اوضحنا في الحلقات الماضية، فضلا عن التفاوت الطبقي بانتشار المدارس والجامعات الخاصة برسومها الباهظة ، التي تقود في النهاية الى احتكار السلطة والثروة والتعليم في يد القادرين.
3
الأمثلة اعلاه للتردي تتطلب وضع التعليم في اسبقيات عملنا اذا اردنا التطور والتقدم للبلاد ، وتوفير مقومات التعليم باعتبار ه استثمار بشرى مهم كما في الآتي:
- توفير بيئة التعليم الصالحة من مباني ومكتبات ومعامل وميادين رياضية، ونشاط ابداعي مصاحب للطلاب ، حرية تكوين اتحاداتهم وجمعياتهم ، وإعادة الداخليات الي الجامعات لتقوم بادارتها، وفي الريف السوداني التي بدونها لا يستطيع أطفال الرعاة الرحل مواصلة الدراسة.
- زيادة ميزانية التعليم لتصل على الاقل 20% حسب المعايير العالمية للتعليم الجًيد.
- توفير المعلمين المؤهلين ، وتلبية احتياجاتهم في رفع الأجوروالمعيشة والسكن والاطلاع والتدريب والتأهيل المستمر عاى الجديد في العلوم التربوبة، وشروط الخدمة المجزية.
- أن تتحول الجامعات والمدارس الي مراكز للاشعاع في كل مدينة وقرية.
- استيعاب كل الأطفال البالغين سن التعليم، ومحو الأمية والتوسع في تعليم الكبار.
- التوسع في التعليم الفني ربط التعليم الأكاديمي بالفني في نظام تعليمي شامل.
- مراجعة أهداف وفلسفة التعليم والمناهج التي يشارك في وضعها المعلمون واولياء الامور والمخنصين والمهتمين ،بحيث تلبي احتياجات البلاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتراعي تنوع البلاد الثقافي واللغوي والديني والعرقي، تسهم في مواصلة التعليم مدى الحياة.
- تعديل قوانين التعليم العالي بحيث تعزز الديمقراطية واستقلال الجامعات والبحث العلمي وكفالة الحريات واشاعة الديمقراطية، وانتخاب ندير الجامعة الادارات العليا.
- تحقيق ديمقراطية التعليم بحيث يكون متاجا للجميع غض الظر عن الدين أو اللغة او الثقافة أو الوضع الطبقي أو النوع أو السكن في المدينة أو الريف.
نواصل
ثالث عشر :
اصلاح وأهداف التعليم ( 13 والأخيرة)
1
برز من الحلقات السابقة أن اصلاح التعليم وتحقيق أهدافه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لاينفصل عن تحقيق الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع والحرية والعدالة والسلام، فالتخريب الكبير في التعليم كان في عهود الأنظمة العسكرية التي وظفت الجزء الأكبر من ميزانية الدولة للأمن والدفاع ، وأهملت التعليم والصحة والتنمية، وفرطت في السيادة الوطنية، وفتحت الباب علي مصراعيه للشركات الأجنبية المتحالفة مع الرأسمالية المحلية لنهب ثروات البلاد ، وتصدير الفائض الاقتصادي اللازم للتنمية للخارج. بالتالي من المهم الخروج من الحلقة الجهنمية للانقلابات العسكرية واستقرار النظام الديمقراطي ، وحل مشاكل الديمقراطية بالمزيد من الديمقراطية ، مما يفتح الطريق لقيام نظام وطني ديمقراطي يلعب فيه التعليم دورا مهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الشاملة، وقيام المجتمع الزراعي الصناعي المتطور. فالتعليم له علاقة مباشرة بالحياة والمجتمع ، ولا يتم لذاته مثل " التعليم من أجل التعلم" أو " الفن من أجل الفن" وغير ذلك من المقولات التي تعزل النظرية عن الممارسة، فالانسان عبر التاريخ كان يتعلم من خلال الممارسة ويستنبط النظرية والمعرفة منها، فالتعليم يأخذ من الناس ويعطيهم .
2
الهدف من التعليم توفير المعارف الأساسية والضرورية للطلاب بهدف اعدادهم للحياة ، وتجعلهم يواصلون التعليم و الدراسة باستمرار مع ثورة المعلومات التي نعيشها ، كما تهدف الى تأهليهم بالمهارات والحرف المعينة لكي يساهموا في بناء المجتمع وتغييره الي الأفضل.
يبقي من المهم توفير مقومات التعليم من مباني وبيئة صالحة ومعلم وطالب ومناهج. فلابد من تأهيل المعلم باعتباره حجر الزاوية في التعليم لمساعدة الطلاب في شق طريقهم المستقل مع تدفق المعلومات عبر الوسائط المختفة ، واستقراره في المعيشة والسكن ، والمنهج الشامل الذي يربط بين التعليم الذهني واليدوي، والمرتبط بإهداف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والملائم لتنوع السودان الثقافي والديني والعرقي واللغوي والجغرافي.، ويغرس في الطلاب روح البحث والتفكير الناقد ، اضافة للنشاط المدرسي المكمل للعملية التعليمية. اضافة للقيم والمثل التي يجب أن ترسخها المناهج مثل: حب الوطن، التواضع، نبذ العنصرية الأمانة والنظافة وحماية البيئة ، وحب المعرفة والتعلم باستمرار ، واحترام المرأة و الحقوق والحريات الأساسية، والتسامح واحترام والمعتقدات والرأي الآخر. الخ.
فلا ريب في أن التعليم شرط مهم لتقدم وتطور المجتمع، فقد أجمع المخططون على اختلاف ميولهم ومشاربهم السياسية والفكرية أن التعليم استثمار بشري له مردود عالى في المستقبل ، فالتعليم رغم أنه خدمة طبيعتها استهلاكية ، الا أنها إنتاجية في الوقت نفسه..
منذ اندفاع الثورة الصناعية في نهاية القرن الثامن عشر ، ازدادت أهمية التعليم العام والجامعي ، وازدادت أهمية مواكبة هذه الثورة التي اصبح فيها العلم مرتبطا بالإنتاج ، بالتالي زادت أهمية البحث العلمي وتخريج الكوادر التقنية والادارية والاقتصادية .الخ التي اصبح دورها مهما في تطوير الإنتاج والعملية الإنتاجية.
مع تطور مستوى المعيشة ازدادت أهمية رفع المستوى الثقافي والتعليمي ، وتدريجيا في القرن الثامن عشر كان هناك ضرورة في بلدان الغرب الرأسمالي لمحو الأمية وتعميم التعليم الالزامي ، ومساهمة رجال الأعمال والشركات والقطاع الخاص في التعليم بعد أن اتضحت فوائده الملموسة في تطوير الإنتاج.
الاقتصاديون الذين عالجوا أسباب التخلف في البلدان النامية، اشاروا الي من مؤشرات التخلف الأمية التي تبلغ حوالي 70% ، كما اشاروا الى النسبة الكبيرة من عدد الأطفال في سن التعليم الذين لا يجدون الفرصة في تلقى التعليم الالزامي، هذا فضلا عن عدم الاستيعاب الكامل للتلاميذ الذين بلغوا سن التعليم الالزامي.
3
اشرنا في الحلقات السابقة الى ارتباط التعليم باحتياجات المجتمع منذ حضارات السودان القديمة، فنجد في تلك الحضارات ان السودانيين استطاعوا ابتكار لغة خاصة بهم ( المروية ، النوبية) استقلوا بها عن اللغة المصرية القديمة "الهيروغلوفية" ، وأن المجتمعات في تلك الحضارات كانت مترابطة ومتوجهه داخليا، والتعليم مرتبط باحتياجات المجتمع ، وأن تلك المجتمعات مكتفية ذاتيا بمعنى توفر غذاءها ، والتجارة مع الخارج كانت في السلع الكمالية. .
لكن بدخول الاستعمار التركي 1821 والبريطاني 1898 م ، اصبح الاقتصاد متوجها خارجيا بمعني تلبية احتياجات الدولة المحتلة كما في فترة الاستعمار البريطاني عندما اصبح هدف التعليم تلبية احتياجات الدولة الاستعمارية في زراعة القطن وقام مشروع الجزيرة والمشاريع الأخرى للقطن والسكة الجديد والنقل النهري . الخ ، كما تم تدمير الصناعة الوطنية لاغراق البلاد بالسلع المستوردة ، وفي تخريج موظفين لتسيير جهاز الدولة ، كما ركز على التعليم النظري زالأكاديمي كما اوضحنا سابقا ، وفي نهاية عهد الاستعمار البريطاني كانت نسبة التعليم الفنى 20%.
وبعد الاستقلال استمر الخلل في التعليم العام والعالي كما في : قصل التعليم الفتى عن الأكاديمي، وعدم ارتباطه باحتياجات التنمية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية ، ولا ربط للتكنولوجيا بالبيئة ، ومناهج فقيرة تقوم على الحفظ والحشو ، ولاتساعد في روح الخلق والابتكار، والتوجه الطبقي للتعليم حتى اصبح للقادرين مع تزايد أعداد المدارس والجامعات الخاصة ، وازداد التفاوت بين الأقاليم في التعليم والقبول في الجامعات، فضلا عن تدهور نوعية التعليم نفسه نتيجة لهجرة الأكفاء من الاساتذة والمعلمين والفصل والنشريد ، والنقص في المعامل والمكتبات والكتاب المدرسي ، والتوسع في التعليم العالي على حساب الكم لا الكيف ودون توفير مقومات هذا التوسع ، اضافة لتحويل المعاهد الفنية الي جامعات ومعاهد تدريب المعلمين الي كليات تربية، وغير ذلك من التخريب الذي وصفنته سابقا.
4
المدخل لاصلاح التعليم وتحقيق أهدافه بأن يكون التعليم ديمقراطيا من حيث الكم والكيف، وفي التخطيط وفي رسم سياساته وتنفيذها، يستوعب كل الأطفال البالغين سن التعليم والتخطيط الواعي والجاد لتحقيق هذا الهدف الذي اصبح من ضمن مواثيق حقوق الانسان، فضلا عن تحقيق مجانية والزامية التعليم العام.
- لا يكفي تحقيق الزامية ومجانية التعليم العام ، بل يجب التخطيط لمحو امية جميع الأميين. فلا يمكن تحقيق تغيير اقتصادي واجتماعي في بلد تتجاوز فيه الأمية 70% من سكانه.
- ديمقراطية التعليم لا تنفصل عن الديمقراطية السياسية والاجتماعية والثقافية ، بل هي مكملا لها.
- المناهج تكون بعيدة عن الحشو ومرتبطة بالبيئة المحلية، وتربط العملي بالنظري ، والتكنولوجيا بالبيئة المحلية، و تربط التعليم النظري بالعملي، وتغرس حب المعرفة والتواضع ، ومواصلة التعليم مدى الحياة، وتغرس روح التعاون والجماعية في العمل ، وتطوير قدرات الانسان وتفجير طاقاته الابداعية الايجابية باستمرار، وبحيث لا يكون التعليم مصدرا للخوف من المستقبل وعدم الثقة فيه ، وفتور من العمل لحد اليأس ، وبعث الثقة في النفوس والمستقبل، غرس التفكير الناقد والخلاق والمبدع ، واستخدام المنهج العلمي الذي يستخلص النتائج من الواقع لا من أفكار مسبقة ،ودراسة الواقع من أجل فهمه وتغييره.
- تصحيح تركيب التعليم العام والعالي بحيث يكون التعليم الفنى هو الغالب، وتحسين اوضاع خريجي المعاهد الفنية، باعتبار التعليم الفنى هو اساس التنمية ، كما أن الثورة العلمية التقنية الجارية اليوم تقود الي هذا الاتجاه الذي يربط النظرية بالعمل ، ودون التقليل من أهمية التحصيل النظري.
- توفير مقومات التعليم من اساتذة وإعادة تأهيلهم باستمرار لمواكبة الجديد وتحسين اوضاعهم المعيشية والالمام بأهداف المادة التي يدرسها ،وتوفيرالمكتبات والكتب ودوريات ومعامل وميادين رياضية ، ونشاط مدرسي وجامعى، وتحسين اوضاع الطلاب والطالبات في السكن والمعيشة والترحيل والخدمات الصحية ، ورفع ميزانية التعليم باعتباره استثمار عالي المردود، وتحقيق المساواة الفعلية بين الطلبة والطالبات في مختلف التخصصات، والتناسب بين المعلم وعدد الطلاب.
- السلم التعليمي لايقل عن 12 عاما للتعليم العام بحيث يمتلك الطلاب المعارف الأساسية التي تؤهلهم للحياة والتعليم العالي.
- أن تكون المدرسة أو الجامعة مركزا للاشعاع الثقافي في المجتمع.
- لغة التدريس مع أهمية اللغة العربية المشتركة بين كل السودانيين ، لكن هناك ضرورة لكفالة حق القوميات الأخرى في التعليم بلغاتها المحلية ، والاعتراف بالتنوع الثقافي الديني واللغوي والعرقي بالبلاد.
- تشجيع البحث العلمي الذي يرتبط بتراث وواقع السودان ، واحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- محو الأمية في التعليم العام وتطبيق نظام التعليم الشامل الذي يربط بين التعليم الفني والأكاديمي.
- قوانين ديمقراطية في المدارس والجامعات تتيح حرية تكوين الجمعيات والاتحادات والنشاط الابداعي ،واشراك الاساتذة والطلاب بما يدور في المؤسسات التعليمية ، وضمان استقلال الجامعات وحرية البحث العلمي.
السيرة الذاتية
• تاج السر عثمان الحاج
• اللقب : السر بابو.
• من أبناء أمبكول بمنطقة مروي بالولاية الشمالية.
• من مواليد مدينة عطبرة، يناير 1952م.
• تلقي تعليمه الأولي والاوسط والثانوي بمدينة عطبرة.
• تخرج في جامعة الخرطوم ابريل 1978م.
• باحث ومهتم بتاريخ السودان الاجتماعي.
• صدر له:
1- تاريخ النوبة الاقتصادي – الاجتماعي، دار عزة 2003م.
2- لمحات من تاريخ سلطنة الفونج الاجتماعي، مركز محمد عمر بشير 2004م.
3- تاريخ سلطنة دارفور الاجتماعي، مكتبة الشريف 2005م.
4- النفط والصراع السياسي في السودان، بالاشتراك مع عادل احمد ابراهيم، مكتبة الشريف 2005م.
5- خصوصية نشأة وتطور الطبقة العاملة السودانية، الشركة العالمية 2006م.
6- الجذور التاريخية للتهميش في السودان، مكتبة الشريف 2006م.
7- التاريخ الاجتماعي لفترة الحكم التركي في السودان، مركز محمد عمر بشير 2006م.
8- تطور المرأة السودانية وخصوصيتها، دار عزة 2006م
9- الدولة السودانية: النشأة والخصائص، الشركة العالمية 2007م.
10- تقويم نقدي لتجربة الحزب الشيوعي السوداني ( 1946- 1989م)، دار عزة 2008م.
11- دراسة في برنامج الحزب الشيوعي السوداني، الشركة العالمية 2009م.
12- أوراق في تجديد الماركسية، الشركة العالمية 2010م.
13- دراسات في التاريح الاجتماعي للمهدية، مركز عبد الكريم ميرغني 2010م
14- قضايا المناطق المهمشة في السودان، الشركة العالمية 2014
15- أسحار الجمال في استمرارية الثقافة السودانية ، مدارات للنشر 2021.
16- الهوية والصراع لاجتماعي في السودان ، دار المصورات ، 2021.
• كاتب صحفي وله عدة دراسات ومقالات ومنشورة في الصحف السودانية والمواقع الالكترونية، ومشارك في العديد من السمنارات وورش العمل داخل وخارج السودان.
• عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني
• أُعتقل مرتين خلال ديكتاتورية نميري عامي 1973م، و1977م، ومرتين خلال ديكتاتورية الانقاذ عام 1995م لمدة سنة وتعرض لتعذيب وحشي.، وفي مارس 2018 بعد الهبة الجماهيرية في 16 يناير 2018.
• متزوج وأب
#تاج_السر_عثمان (هاشتاغ)



ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

|
حفظ
 |
بحث |
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
| إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
تعيين د. كامل إدريس حلقة في المخطط لتصفية الثورة
-
الذكرى ال ٥٦ لانقلاب ٢٥ مايو ١¤
...
-
لا جدوى لتعيين رئيس وزراء من انقلاب غير شرعي
-
في ذكرى رحيله ٨٤ كيف كان معاوية نور شعلة من الإبدا
...
-
في ذكرى رحيله ٨٤ كيف كان معاوية نور شعلة من الإبدا
...
-
لا بديل غير وقف الحرب ومنع تكرارها
-
استمرار فساد ونهب الطفيلية الاسلاموية بعد الحرب
-
أوقفوا التصفيات على أساس عرقى وعنصري
-
عودة لزيارة ترامب لدول الخليج وحرب السودان
-
كيف كشف انقلاب القصر عن طبيعته الديكتاتورية؟
-
زيارة ترامب وضرورة الحل الداخلي
-
وقف الحرب مع دخولها مرحلة خطرة
-
كيف تقود حرب المسيرات الي تفاقم الصراع الدولي علي الموارد؟
-
وقف الحرب لمنع المزيد من الانهيار
-
حرب المسيرات وخطر التدخل الخارجي
-
كيف تكونت الطبقة العاملة السودانية؟
-
مفاهيم الطبقة الاجتماعية والمركز والهامش (٢/٢)
-
مفاهيم الطبقة الاجتماعية والمركز والهامش (١/٢)
-
ثورة ديسمبر متممة نورها ولو كره الاسلامويون
-
حتى لا تتكرر تجربة انفصال الجنوب بعد اتفاقية نيفاشا
المزيد.....
-
ترامب يكشف لـCNN رد بوتين على الدعوة للانضمام إلى -مجلس السل
...
-
دافـوس 2026: مـنـتـدى الـقـطـيعـة بـيـن تـرامـب وحـلـفـائـه؟
...
-
ترامب يستبعد اللجوء إلى القوة لضم غرينلاند ويتراجع عن فرض رس
...
-
البرلمان الأوروبي يعلق مسار الاتفاق التجاري مع واشنطن إثر ته
...
-
بعد تشبث ترامب بغرينلاند.. ما مصير علاقة أميركا بأوروبا؟
-
إلى أين يصل الخلاف الأميركي الأوروبي بسبب غرينلاند؟
-
?القدس.. إقامة بؤر استيطانية جديدة قرب تجمّع الخان الأحمر
-
ترامب يلتقي السيسي ويجدد عزمه التوسط لحل أزمة سد النهضة
-
حماس ترد على ترامب: إذا انتهى الاحتلال فلا حاجة للمقاومة ولا
...
-
واشنطن تفرض عقوبات على جمعيات فلسطينية بزعم صلتها بحماس
المزيد.....
-
أساليب التعليم والتربية الحديثة
/ حسن صالح الشنكالي
-
اللغة والطبقة والانتماء الاجتماعي: رؤية نقديَّة في طروحات با
...
/ علي أسعد وطفة
-
خطوات البحث العلمى
/ د/ سامح سعيد عبد العزيز
-
إصلاح وتطوير وزارة التربية خطوة للارتقاء بمستوى التعليم في ا
...
/ سوسن شاكر مجيد
-
بصدد مسألة مراحل النمو الذهني للطفل
/ مالك ابوعليا
-
التوثيق فى البحث العلمى
/ د/ سامح سعيد عبد العزيز
-
الصعوبات النمطية التعليمية في استيعاب المواد التاريخية والمو
...
/ مالك ابوعليا
-
وسائل دراسة وتشكيل العلاقات الشخصية بين الطلاب
/ مالك ابوعليا
-
مفهوم النشاط التعليمي لأطفال المدارس
/ مالك ابوعليا
-
خصائص المنهجية التقليدية في تشكيل مفهوم الطفل حول العدد
/ مالك ابوعليا
المزيد.....
|
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

 |
بحث
|
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
|
إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة