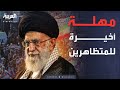|
|
العولمة انتهت، لكن النيوليبرالية ما زالت حيّة
حازم كويي


الحوار المتمدن-العدد: 8355 - 2025 / 5 / 27 - 22:47
المحور:
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
برانكو ميلاينوفيتش*
ترجمة: حازم كويي
عصر التجارة الحرة يشارف على نهايته، وفي الشمال العالمي الغني تتبلور أستراتيجية مزدوجة جديدة، يتم التخلي عن العولمة النيوليبرالية، لكن في المقابل، يتم تعزيز النيوليبرالية المحلية بصرامة متزايدة.
بمعنى آخر، بينما تُفرض قيود متزايدة على التجارة العالمية، وسلاسل التوريد تُعاد هيكلتها على أسس جيوسياسية، تُستخدم في الداخل آليات السوق والانضباط المالي بشكل أكثر عدوانية في سوق العمل، في السياسات الاجتماعية، وفي توزيع الموارد.
هذه المفارقة تُشير إلى أن نهاية العولمة لا تعني بالضرورة نهاية النيوليبرالية، بل ربما تحوّلها إلى نسخة أكثر قومية وصلابة.
دونالد ترامب عاد إلى السلطة، وهو – بعبارة معتدلة – ليس من محبي العولمة.
الرئيس الأمريكي أعلن صراحة أنه "ضد العولمية ومع الوطنية"، وصرّح بأن العولمة "دفعت بملايين وملايين من عمّالنا إلى الفقر واليأس".
لفهم المرحلة الحالية من العولمة، التي يسعى ترامب إلى إنهائها، وتقييم حصيلتها حتى الآن، من المفيد مقارنتها بمرحلة عولمة سابقة، وهي تلك التي جرت بين عامي 1870 واندلاع الحرب العالمية الأولى.
في كلتا الحالتين كانت هناك:تحركات كثيفة لرأس المال والبضائع عبر الحدود.توسع في التجارة الدولية.إ ختلالات كبرى في توزيع الثروات بين الدول وداخلها.
لكن هناك أيضاً فوارق حاسمة، عولمة ما قبل 1914 كانت مدفوعة بالإمبراطوريات الاستعمارية ونقل البشر قسراً أو بدافع الحاجة.
عولمة ما بعد الثمانينيات، النيوليبرالية، رُوّجت لها بوصفها طريقاً للنمو الشامل، لكنها زادت الفوارق وأضعفت النقابات وأفرغت الديمقراطية من مضمونها الاقتصادي.
وبينما حاولت العولمة القديمة التوسع من خلال القوة والسيطرة، جاءت العولمة الجديدة بوعد "السوق الحر" وتركت الكثيرين وراءها، ما خلق تربة خصبة لخطابات مثل تلك التي يطلقها ترامب، شعبوية وطنية ضد نخبوية كوزموبوليتية.
كلا المرحلتين من العولمة شكّلتا نقاط تحول حاسمة، سنوات مفصلية تركت بصماتها العميقة على العالم الذي نعيشه اليوم.
وفي كلتا الحالتين، رافقت العولمة أكبر توسّع أقتصادي عالمي في ذلك الوقت. عولمة ما قبل الحرب العالمية الأولى شهدت إنفجاراً في التجارة والاستثمارات العالمية، مدفوعاً بالتوسع الإمبريالي والابتكارات الصناعية.
أما عولمة أواخر القرن العشرين، فقد جلبت معها طفرة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، خاصة مع صعود الصين والأسواق الناشئة، إلى جانب تفكيك الحواجز التجارية والخصخصة.
ولكن كما في السابق، لم تكن هذه الطفرات الاقتصادية موزّعة بعدالة، لا بين الدول ولا داخلها.
فإذا كانت عولمة القرن التاسع عشر قد أنتهت بحروب كبرى وأزمات اقتصادية، فإن العولمة النيوليبرالية تثير اليوم أزمات سياسية وأجتماعية عميقة، مما يجعل التساؤل عن مستقبلها، بل عن بديلها، أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.
لكن هاتين المرحلتين من العولمة تختلفان أيضاً من نواحٍ عديدة،فالمرحلة الأولى من العولمة (1870–1914) كانت مرتبطة بالاستعمار وهيمنة الإمبراطورية البريطانية.مُربحِة بشدة للدول الصناعية الناشئة، وخاصة بريطانيا والولايات المتحدة.
إلا أنها أدت إلى ركود أو حتى تراجع في مستويات الدخل في باقي أنحاء العالم، لا سيما في الصين وأفريقيا.
وفقاً لبيانات "مشروع ماديسون" للتاريخ الاقتصادي، أرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي في المملكة المتحدة بين 1870 و1910 بمقدار 35٪.في الولايات المتحدة، تضاعف دخل الفرد الحقيقي في نفس الفترة (أي نمو سنوي بمعدل 1.7٪ – وهو رقم مرتفع جدًا حينها) .أما في الصين، فقد تراجع الدخل الفردي بنسبة 4٪.وفي الهند، لم يزد إلا بنسبة ضئيلة قدرها 16٪ خلال 40 عاماً.
نتيجة هذا التفاوت بدأت تتشكل ملامح ما سُمّي لاحقاً بـ "العالم الثالث" ، حيث أتسعت الفجوة بشكل كبير بين دول الغرب الصناعية وبقية دول العالم.
بعبارة أخرى، العولمة الأولى خلقت نظاماً غير متكافئ من الثراء والتقدم، رسّخ سيطرة المركز (الغرب) على الأطراف (المستعمرات والجنوب العالمي).
وهكذا أدّت المرحلة الأولى من العولمة إلى زيادة التفاوت العالمي بشكل ملحوظ، فقد نمت المناطق الغنية بسرعة أكبر، وأستفادت من التوسع الصناعي والتجارة العالمية.
بينما عانت المناطق الفقيرة من ركود إقتصادي أو حتى تراجُع في مستويات المعيشة.
بمعنى آخر:العولمة لم تساهم حينها في تقليص الفجوة بين الشمال والجنوب، بل على العكس، عمّقت الانقسام بين المركز الرأسمالي (مثل أوروبا الغربية والولايات المتحدة) والأطراف المستعمَرة أو التابعة (مثل آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية).وهذا التفاوت التأريخي ما زال يُلقي بظلاله على العالم حتى اليوم، ويُعدّ أحد الجذور البنيوية لللامساواة المعاصرة.
إلى جانب تزايد التفاوت بين الدول خلال الحقبة الأولى من العولمة، شهدت أيضاً العديد من الاقتصادات الغنية ارتفاعاً في التفاوت داخلها، وعلى رأسها الولايات المتحدة.
أبرز النقاط، في الولايات المتحدة، تشير البيانات إلى أن الشرائح العشر الأغنى من السكان كانت المستفيد الأكبر من النمو الاقتصادي، مما زاد من الفجوة الطبقية.
في المقابل، كان الوضع في المملكة المتحدة مختلفاً نسبياً، بلغت اللامساواة ذروتها في ستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشر.
بحسب الباحث روبرت دادلي باكستر، كان عام 1867 هو الأعلى من حيث التفاوت في الدخل في القرن التاسع عشر.بعد ذلك، ساهمت سلسلة من الإصلاحات التقدمية في الحد من التفاوت، مثل تحديد ساعات العمل.حظر عمالة الأطفال.توسيع حق الاقتراع.
في ألمانيا، برز أيضاً إرتفاع في التفاوت مع توحيد الدولة الألمانية في أواخر ستينيات القرن التاسع عشر، في ظل التحولات الصناعية والاجتماعية المصاحبة.
فالخلاصة هنا،لم تكن العولمة الأولى فقط، كونهاعمّقت الفجوة بين الشمال والجنوب، بل أعادت تشكيل التفاوت داخل الدول الصناعية نفسها، الذي مهّد لاحقاً لنشوء حركات عمالية وسياسية تطالب بالعدالة الاجتماعية.
فرانسوا بورغينيون وكريستيان موريسون، لم تكن لديهما معلومات كافية عن تطور التفاوت في الصين والهند خلال فترة العولمة الأولى. ونتيجة لذلك، تم تمثيل كلا البلدين بخط مستقيم، أي كما لو أن جميع شرائح السكان نمت بمعدل متساوٍ، وهو تبسيط لا يعكس الواقع بدقة.
لكن بيانات جديدة من العديد من الإقتصاديين مثل، فاكوندو ألفاريدو، أوغوستين بيرغيرون، وغيليام كاسان، أستخدموا بيانات مالية تاريخية جديدة للهند، أظهرت التالي:عدم حدوث تغير كبير في مستوى التفاوت خلال تلك الفترة، أي أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء ظلت واسعة وثابتة.
بعبارة أخرى، الهند لم تشهد تقليصاً للفجوة الطبقية رغم أي نمو اقتصادي مُحتمل، ما يعني أن النمو – إن وُجد – لم يكن شاملاً أو موزعاً بعدالة.
بناءاً على تحليل البيانات والملاحظات السابقة، يمكن تلخيص الفرق بين العولمة الأولى والعولمة الثانية على النحو التالي:
العولمة الأولى (1870–1914)
أدت العولمة الأولى إلى زيادة التفاوت بين الدول، حيث أستفادت الدول المتقدمة مثل بريطانيا والولايات المتحدة من نمو اقتصادي كبير بينما عانت دول أخرى مثل الصين والهند من ركود أو تراجع اقتصادي.
التفاوت داخل الدول:في هذه الفترة، شهدت الدول المتقدمة زيادة في التفاوت داخل حدودها. الدول الغنية مثل بريطانيا والولايات المتحدة شهدت إزدياداً في التفاوت الطبقي، حيث أستفادت الطبقات العليا بشكل أكبر من التوسع الاقتصادي.
الدوافع الرئيسية:تمحورت العولمة الأولى حول الاستعمار والتوسع الإمبريالي، حيث كانت القوى الاستعمارية تتحكم في التجارة والاستثمار العالمي.
في الفترة (من 1990 إلى 2020)، سجلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبقية دول العالم الغني نمواً، لكنه مقارنة بالدول الآسيوية كان نمواً معتدلاً،ففي الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للفرد بمعدل 1.4٪ سنوياً، وهو أبطأ من مرحلة العولمة الأولى.أماالمملكة المتحدة،فقد نما الناتج المحلي الإجمالي للفرد بمعدل 1٪ سنوياً، وهو أيضاً معدل منخفض نسبياً.في المقابل، حققت الدول الآسيوية ذات الكثافة السكانية العالية والنمو الاقتصادي السريع في هذه الفترة تقدماً أكبر بكثير:تايلاند 3.5٪ سنوياً،الهند 4.2٪ سنوياً،فيتنام 5.5٪ سنوياً،الصين بنمو مثير للإعجاب بنسبة 8.5٪ سنوياً.
هذا النمو السريع في البلدان الآسيوية يوضح كيف تغير المشهد الاقتصادي العالمي خلال الثلاثة عقود الماضية، حيث حققت العديد من الدول الآسيوية تقدماً كبيراً في تطوير إقتصاداتها بينما كانت الدول الغربية تشهد نمواً أبطأ.
للفترة من 1870 إلى 1910، يتضح بذلك بنمو (عشر الدخل) في البلدان الغنية بسرعة أكبر من البلدان الفقيرة. أما الفترة من 1988 إلى 2018، فإن معدلات النمو في جميع فئات توزيع الدخل في الصين والهند تتفوق على تلك الخاصة بجميع فئات توزيع الدخل في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
لقد تغيرت الاقتصاديات العالمية و الجغرافيا السياسية بشكل كامل، تحول أقتصادي نحو منطقة المحيط الهادئ وما تلاه من تأثيرات على العلاقات النسبية للدخول بين سكان الدول الغربية وآسيا.وتحول الصين إلى منافس جدي للهيمنة الأمريكية التي كانت سائدة في السابق، مما يعكس تغييرات كبيرة في الهيكل الاقتصادي والسياسي الدولي.
هذا التغير يعكس الفروق الكبيرة في النمو بين الدول الغنية والفقيرة في مختلف الفترات الزمنية، ويبرز التحول الذي شهدته العولمة من التركيز على الغرب إلى تعزيز دور الدول الآسيوية الكبرى.
من غير الممكن إنكار أنه في العقود الثلاثة الماضية، أصبحت وضعية دخل أجزاء كبيرة من الطبقة الوسطى والعاملة في الغرب أسوأ على الصعيد العالمي. كان هذا التدهور أكثر دراماتيكية في البلدان الغربية التي لم تتمكن من تحقيق نمو أقتصادي. على سبيل المثال، تراجعت فئة الدخل الأدنى في إيطاليا بين عامي 1988 و2018 من المركز 73 على مستوى العالم إلى المركز 55. كما تراجعت الفئتان الأدنى في الولايات المتحدة من حيث موقعهما العالمي، رغم أن هذا التراجع كان أقل مقارنة بإيطاليا.
بالإضافة إلى ذلك، عانت الطبقة الوسطى الغربية من إنخفاضات نسبية في الثروة مقارنة بمواطنيها في القمة. يمكن القول إن الطبقة الوسطى الغربية كانت خاسرة مزدوجة فمن جهة، كانت تواجه المنافسة من الطبقة الوسطى الآسيوية التي كانت تشهد صعوداً سريعاً، ومن جهة أخرى، كانت تخسر أمام مواطنيها الأغنى داخل دولها.
هذا التحول يعكس التحديات التي واجهتها الطبقة الوسطى في الغرب نتيجة للتغيرات الاقتصادية العالمية، التي تسببت في تحول مركز القوة الاقتصادية نحو آسيا وزيادة الفجوات الاقتصادية داخل البلدان نفسها.
بخلاف العولمة الأولى، أنخفضت التفاوتات العالمية في العولمةالثانية. ويرجع ذلك أساساً إلى معدلات النمو المرتفعة في الدول الآسيوية الكبرى. ومع ذلك، زادت التفاوتات داخل البلدان في الغالب. كان ذلك واضحاً بشكل خاص في الصين، حيث تضاعف مؤشر الصين(وهو مقياس شائع للتفاوت) بعد الإصلاحات الليبرالية. وينطبق الأمر نفسه على الهند. فإن نمو الدخل في صفوف الأغنياء في الهند والصين تفوق بشكل كبير على نمو الدخل للفقراء في تلك البلدان.
أما في الدول الصناعية، فقد أرتفعت التفاوتات أيضاً، بدءاً من الإصلاحات التي نفذتها مارغريت تاتشر ورونالد ريغان، وتواصلت تأثيراتها في حكومات توني بلير وبيل كلينتون، لتصل إلى ذروتها في العقد الثاني من هذا القرن.
بالتالي، بينما شهد العالم إنخفاضاً في التفاوتات بين البلدان بفضل النمو السريع في آسيا، زادت التفاوتات داخل البلدان في كل من الدول النامية والدول المتقدمة.
كان النمو الاقتصادي السريع في العولمة الأولى السبب في تحقيق معظم السكان الغربيين مرتبة متقدمة في هرم الدخل العالمي. في الواقع، مستويات الدخل للأفقر في الدول الغنية كانت أعلى بكثير مما يُتصور عادة في سياق التوزيع العالمي للدخل. كما يذكر الاقتصادي بول كولير في كتابه مستقبل الرأسمالية بنوع من الحنين إلى الحقبة التي كان فيها العمال البريطانيون يشعرون بأنهم في القمة. ولكن لكي يتمكن هؤلاء من الشعور بأنهم في القمة، كان لا بد أن يكون هناك آخرون في القاع.
هذه الديناميكية تُظهر كيف أن تقدم فئات معينة يتطلب في العديد من الحالات تدهور أو تراجع فئات أخرى في النظام العالمي.
التحولات الناتجة عن العولمة الثانية أدت إلى إزاحة جزء من الطبقة المتوسطة الغربية عن مواقعها المتقدمة، مما أدى إلى إعادة توزيع كبيرة للأرباح والدخول. بشكل مختصر، تم تجاوز هذه الطبقات المتوسطة الغربية من قِبل آسيا الصاعدة. هذا التراجع كان غير ملحوظ نسبياً، ولكن كان يصاحبه تراجع أكثر وضوحاً للطبقة المتوسطة الغربية مقارنةً بالأثرياء المحليين في نفس الدول. هذا التغيير الاقتصادي أدى إلى إستياء سياسي واسع إنعكس في صعود السياسات الشعبوية والأحزاب التي تتبنى مثل هذه السياسات.
من المهم أيضاً أن نلاحظ أن التقارب في الدخل على مستوى العالم لم يمتد إلى أفريقيا، حيث أستمر التراجع النسبي لهذه القارة. إذا لم يتغير هذا الوضع – وهو أمر غير مرجح في الوقت الحالي – فإن التراجع النسبي لأفريقيا في العقود القادمة قد يعكس الاتجاه الحالي الذي يشير إلى إنخفاض التفاوت العالمي، ويُحتمل أن يبدأ عصر جديد من التفاوت العالمي المتزايد.
هذه التحالف الغريب بين أغنى فئات العالم الغربي وأفقر فئات الجنوب العالمي كان في البداية غير ملحوظ، ولم يتم التعرف عليه بشكل كامل إلا مع تطور العولمة الثانية. من الوهلة الأولى، قد يبدو هذا التحالف غريباً أو غير منطقي، حيث لا يوجد تقارب كبير بين المجموعتين من حيث التعليم،أو الدخل. ومع ذلك، فإنها تمثل تحالفاً خفياً، لم تدركه أي من الجهتين بشكل كامل حتى أصبح واضحاً في وقت لاحق.
لقد أصبح هذا التحالف مع مرور الوقت أكثر ظهوراً، حيث أدت السياسات الاقتصادية والنظام العالمي الذي تطور من خلال العولمة إلى نتائج تسببت في تداخل مصالح هذه الفئات المتباينة، ما يطرح أسئلة عن ديناميكيات القوة في النظام العالمي الجديد.
لقد عزّزت العولمة الأغنياء في الدول الصناعية من خلال تغييرات في الهيكل الاقتصادي الداخلي، مثل التقليص في الضرائب، و إلغاء التنظيمات، و الخصخصة، وأيضاً من خلال تمكين الشركات من نقل الإنتاج المحلي إلى أماكن أخرى حيث الأجور أقل بكثير. هذه التغييرات أدت إلى زيادة ثراء مالكي رأس المال و رجال الأعمال في الجنوب العالمي. في الوقت نفسه، سمحت للعمال في الجنوب العالمي بالحصول على وظائف أفضل أجراً والهروب من البطالة المستمرة.الخاسرون في هذه العملية كانت الطبقة العاملة الغربية من الطبقة المتوسطة، التي تم إستبدالها بالقوى العاملة الأرخص من الجنوب العالمي. لذلك، ليس من المُستغرب أن يحدث تحلل صناعي في الشمال العالمي، ولم يكن هذا نتيجة الأتمتة أو زيادة أهمية قطاع الخدمات في الإنتاج الكلي، بل أيضاً بسبب حقيقة أن العديد من العمليات الصناعية قد نُقلت ببساطة إلى حيث يمكن تنفيذها بتكاليف أقل. هكذا أصبحت شرق آسيا بمثابة "ورشة العالم".
تم تجاهل تشكيل تحالف المصالح الخاص في النظريات السائدة حول العولمة، حيث كانت النظرة السائدة ترى أن العولمة كانت سيئة بشكل رئيسي بالنسبة للعمال في الجنوب العالمي، وأنهم تعرضوا للمزيد من الاستغلال مقارنة بما كانوا عليه سابقاً. يعود هذا الخطأ ربما إلى تجارب العولمة الأولى ،التي أدت فعلاً إلى تفكيك الصناعة في الهند و إفقار السكان في الصين و أفريقيا. ففي تلك الفترة، كانت الصين تحت سيطرة رجال الأعمال الأجانب، وفي أفريقيا فقد الفلاحون السيطرة على أراضٍ كانوا يزرعونها منذ القدم، مما جعلهم أكثر فقراً. لذلك كانت العولمة الأولى لها آثار سلبية على معظم دول الجنوب العالمي.
أما في العولمة الثانية، فقد كانت الأمور مختلفة. الأجور و فرص العمل تحسنت بشكل كبير في العديد من مناطق الجنوب.
صحيح أنه من الصعب العمل في الجنوب العالمي، حيث كانت ظروف العمل في بعض الأماكن قاسية للغاية، خاصة مع قوانين العمل التقليدية مثل (العمل من الساعة 9 صباحاً حتى 9 مساءاً لمدة 6 أيام في الأسبوع). هذه الحالات لا تقتصر فقط على الصين، بل هي شائعة في العديد من دول العالم النامي. ومع ذلك، كانت هذه الظروف تعتبر تحسناً ملحوظاً مقارنة بما كان عليه الوضع في الماضي، ولذلك تم قبولها إلى حد كبير.
في هذا السياق، فإن الإنتقاد الذي أفترض زيادة تدهور الأوضاع في الجنوب العالمي بسبب العولمة الثانية كان غير دقيق. على العكس، كما تم توضيحه، كان تأثير العولمة أسوأ على الطبقات الوسطى في الشمال العالمي. ولكن النقطة التي كان النقاد على صواب فيها هي مَنْ استفاد من هذه التحولات: أغنياء العالم الذين حققوا المزيد من المكاسب من العولمة.
النقد المهم الذي يجب أن نأخذه في الاعتبار عند دراسة النيوليبرالية هو التمييز بين النيوليبرالية المحلية و النيوليبرالية الدولية.
النيوليبرالية المحلية تتعلق عادةً بمجموع السياسات التي تتضمن خفض الضرائب، تحرير الأسواق من القيود التنظيمية، الخصخصة، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد. هذه السياسات تهدف إلى تعزيز القطاع الخاص وجعله المحرك الرئيسي للاقتصاد المحلي.
أما النيوليبرالية الدولية، فتركز على تقليص القيود التجارية مثل خفض الرسوم الجمركية و إزالة حصص التجارة، وهي تدعو إلى تشجيع التجارة الحرة على المستوى العالمي. بالإضافة إلى ذلك، تسعى إلى تسهيل حركة رأس المال، التكنولوجيا، السلع والخدمات عبر الحدود، مع تقليل الحواجز التي يمكن أن تعيق هذه التحركات.
من ناحية أخرى، كان العمال موضوعاً مختلفاً في هذه السياسات. في حين كانت حركة رأس المال حرة إلى حد كبير في السياق العالمي، إلا أن حرية حركة العمال كانت دائماً أكثر قيوداً. لم تكن حركة العمال بين البلدان مرنة كما هي حركة رأس المال، على الرغم من أن الحرية الاقتصادية للعمال كانت أحد الأهداف النظرية في النيوليبرالية.
التمييز بين السياسة النيوليبرالية المحلية و السياسة النيوليبرالية الدولية يصبح ذا أهمية خاصة عندما نتحدث عن الصين وفهم كيفية تصرفها في هذا السياق.
من الواضح أن الصين لا تتبع المبادئ النيوليبرالية في سياستها الداخلية. على الرغم من ذلك، فإنها تتبع هذه المبادئ في علاقاتها الاقتصادية الدولية. أي أن الصين لم تطبق التوجهات النيوليبرالية داخلياً من خلال سياسات مثل تقليص دور الدولة في الاقتصاد أو تخفيض الضرائب، لكن على الصعيد الدولي، قامت بإتباع سياسات تشجع التجارة الحرة، خفض الرسوم الجمركية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
هذا التوجه يميز الصين عن العديد من الدول الصناعية والنامية الأخرى التي تأثرت بالنموذج النيوليبرالي في سياستها الداخلية والخارجية على حد سواء. فعلى سبيل المثال، في الولايات المتحدة، بدأ التحول النيوليبرالي منذ الثمانينيات تحت قيادة رونالد ريغان، حيث شمل ذلك تخفيض الضرائب، خفض الرسوم الكمركية، إنشاء منطقة التجارة الحرة NAFTA، وزيادة الاستثمارات الأجنبية. وكان هذا التوجه مشابهاً في الاتحاد الأوروبي، روسيا والدول الشيوعية السابقة.
وبذلك، يظهر التباين بين السياسات الداخلية والخارجية للصين مقارنة مع البلدان الأخرى التي تبنت النيوليبرالية بشكل أكثر شمولاً على جميع الأصعدة.
الصين تمثل حالة أستثنائية فريدة في سياق النيوليبرالية العالمية. على الرغم من تبنيها لعديد من سياسات السوق الحرة في الاقتصاد الدولي، إلا أن دور الدولة في الداخل بقي قوياً للغاية. الصين لم تتبع النموذج النيوليبرالي الذي يعتمد على تقليص دور الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية. بل على العكس، حافظت الدولة على هيمنتها في القطاعات المالية والصناعية الرئيسية مثل الصلب، الكهرباء، صناعة السيارات، والبنية التحتية.
من خلال هذه السياسات، حافظت الدولة على السيطرة على "المناصب العليا" للاقتصاد، كما كان يصفها فلاديمير لينين في سياق الاقتصاد الاشتراكي. إذ يُشبه نهج الصين في الحفاظ على هيمنة الدولة في بعض القطاعات الاستراتيجية, فإن استراتيجية لينين الاقتصادية الجديدة التي سمحت بتوسع القطاع الرأسمالي في مجالات غير مهمة مع الحفاظ على الرقابة والتحكم في المجالات الأساسية للاقتصاد.
خصوصاً في عهد شي جين بينغ(الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني)، يمكن ملاحظة أن الدولة الصينية، رغم السماح للنشاط الرأسمالي بالتوسع في بعض القطاعات، تظل مسيطرة على الاتجاهات الاستراتيجية الأساسية للاقتصاد. الصين تُركِّز بشكل خاص على التطوير التكنولوجي في المجالات الرائدة مثل التكنولوجيا الخضراء، السيارات الكهربائية،إستكشاف الفضاء، وكذلك الذكاء الاصطناعي و الطيران.
هذا النهج يسمح للصين بالاستمرار في تطوير تكنولوجيا المستقبل، بينما تحتفظ في الوقت نفسه بالقدرة على توجيه الاقتصاد نحو الأهداف الإستراتيجية الوطنية.
فعلاً، إن تدخل الدولة في الصين في القطاع الخاص ليس مجرد تدابير أقتصادية تقليدية مثل خفض الضرائب أو تقديم حوافز مالية، بل يتعدى ذلك إلى الضغط المباشر على الشركات الخاصة لتلتزم بسياسات معينة من أجل الحفاظ على علاقة جيدة مع الحكومة.
مثال بارز على هذا التوازن بين الدولة والقطاع الخاص كان في عام 2020 عندما أوقفت الحكومة الصينية أكبر عرض عام أولي طرح عليها في تاريخ الصين، الذي كان من المقرر أن يتم من خلال شركة Ant Group التابعة لمجموعة Alibaba، والتي كان يقودها جاك ما. كانت شركة Ant Group تخطط للدخول إلى قطاع التكنولوجيا الماليةFintech)) غير الخاضع للرقابة في الصين، وهو ما كان سيمنح الشركة القدرة على النمو بشكل ضخم في هذا المجال سريع التطور.
لكن، الحكومة الصينية تدخلت بشكل مباشر وأوقفت هذا الطرح العام الأولي، مبررة ذلك بمخاوف تنظيمية وأمنية. هذا الحدث كان بمثابة رسالة قوية حول العلاقة بين القطاع الخاص والدولة في الصين، حيث تتمتع الدولة بالقدرة على التدخل بشكل حاسم في قرارات الشركات الكبرى، بغض النظر عن تأثير هذه القرارات على الأسواق أو القطاع الخاص.
مثل هذه التحركات تُظهر التوازن الدقيق بين السماح بالحرية الاقتصادية للشركات الخاصة، وفي الوقت نفسه، التحكم والسيطرة على القطاعات الاستراتيجية لتوجيه الاقتصاد الوطني وفقاً للأهداف السياسية والاقتصادية للحكومة.
عند الحديث عن نجاح العولمة في تقليل الفقر وتعزيز النمو في العديد من البلدان الآسيوية، وخاصة في الصين، يجب أن نأخذ في الاعتبار الاختلاف بين السياسات الداخلية والخارجية. يمكن القول إن نجاح الصين يعود إلى قدرتها الفائقة على دمج هذين الجانبين بطريقة فريدة: حيث بقيت سلطة الحكومة داخل البلاد قوية إلى حد كبير، وفي الوقت نفسه، تمت الاستفادة الكاملة من مزايا التجارة الحرة لاستغلال نقاط القوة الصينية على الصعيد الدولي. هذه الاستراتيجية قد تكون فعالة أيضاً بالنسبة لبعض الدول الكبرى النامية مثل الهند و إندونيسيا. ولكن بالنسبة للدول الصغيرة، فإن هذه الاستراتيجية تواجه حدوداً واضحة، نظراً لأن مزايا الحجم غير متوفرة لها، ولأنها ببساطة لا تملك نفس قوة التفاوض التي تمتلكها الصين تجاه رأس المال الأجنبي.
على سبيل المثال، تمكنت الصين من فرض نقل التكنولوجيا بشكل كبير من الدول المتقدمة واستفادت منها، وهو ما مكنها من النمو والتطور السريع في العديد من الصناعات عالية التقنية.
يبدو أن الموجة الثانية من العولمة، التي بدأت قبل أكثر من ثلاثين عاماً، تقترب من نهايتها. في السنوات الأخيرة، شهدنا زيادة في الرسوم الكمركية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ وتشكيل كتل تجارية؛ وفرض قيود أكثر صرامة على نقل التكنولوجيا إلى الصين وروسيا وإيران ودول أخرى تعتبر "غير صديقة"، وأستخدام وسائل الضغط الاقتصادية مثل حظر الواردات والعقوبات المالية؛ وفرض قيود صارمة على الهجرة،وأخيراً سياسة صناعية تتضمن دعم المنتجين المحليين.
لقد شكلت الولايات المتحدة، تحت قيادة دونالد ترامب، عنصراً محورياً في هذا التحول، حيث قام بتغيير العديد من السياسات الاقتصادية والتجارية التي كانت تمثل ركائز للعولمة الثانية. سياسات ترامب جاءت لتعكس تراجعاً عن العولمة الليبرالية والتزاماً بسياسات أقتصادية أكثر قومية.
عندما يتم إتخاذ مثل هذه الانحرافات عن النيوليبرالية التقليدية من قبل اللاعبين الرئيسيين فيها – مثل الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي – فإن المنظمات العابرة للحدود مثل صندوق النقد الدولي و البنك الدولي لن تكون قادرة بعد الآن على فرض مبادئ واشنطن المعروفة على بقية العالم كما كانت تفعل في السابق. وبالتالي، نحن ننتقل إلى عالم جديد من السياسات التجارية والاقتصادية الخارجية التي تركز على الدول والمناطق بشكل خاص. نحن نبتعد عن العولمة العالمية و الجامعة الدولية ونتجه نحو نوع من النيوميركانتيلية«نزعة للمتاجرة من غير اهتمام بأي شئ آخر»، حيث تصبح السياسات الوطنية والإقليمية هي المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي.
ترتبط سياسات ترامب بشكل كبير بهذا الاتجاه. فهو يعشق المركانتيليّة، ويرى أن السياسة الاقتصادية الخارجية يجب أن تكون أداة لانتزاع أكبر قدر ممكن من التنازلات من الدول الأخرى. على سبيل المثال، تهديده بفرض تعريفات كمركية على الدنمارك إذا رفضت كوبنهاكن التنازل عن غرينلاند، يعد مثالاً على هذا النهج. قد يبدو كل هذا مجرد هراء فارغ و تهديدات بلا أساس، لكنه يكشف عن قناعة ترامب بأن التهديدات الاقتصادية والابتزاز يجب أن تُستخدم كأدوات سياسية. من خلال هذه السياسات، سيستمر الاقتصاد العالمي في التفكك بشكل أكبر. الهدف الرئيسي لواشنطن في هذا السياق هو إبطاء صعود الصين والحد من قدرة الدولة الصينية على تطوير التقنيات الجديدة، التي يمكن أن تُستخدم في النهاية لأغراض اقتصادية وعسكرية على حد سواء.
في حين أن الجوانب الداخلية لحزمة النيو ليبرالية القياسية تحت قيادة ترامب قد يتم تعزيزها بدلاً من أن تُخفف. يظهر هذا بالفعل في خطط ترامب لخفض الضرائب على الدخل، تفكيك اللوائح التنظيمية، تسهيل أستغلال الموارد الطبيعية، ودفع الخصخصة للمهام التي كانت في السابق تحت إشراف الدولة. وبذلك، يواصل تطبيق المبادئ النيو ليبرالية الداخلية بشكل أكثر تسارعاً و صرامة. قد يظهر من ذلك ما يبدو متناقضاً للوهلة الأولى: مركنتيلية متزايدة على المستوى الدولي جنباً إلى جنب مع نيو ليبرالية قاسية على المستوى الداخلي. وبعبارة أخرى، هو نسخة معكوسة من النهج الصيني.
بعض الاقتصاديين يرون أن السياسة المركانتيلية لا بد أن تكون مرتبطة دائماً بسلطة حكومية قوية، ومراقبة وتنظيم داخلي. ومع ذلك، يظهر أن هذا ليس هو الحال في الحكومة الأمريكية الحالية. السياسة الجديدة التي يروج لها ترامب، والتي تتمثل في التحكم الصارم في الهجرة إلى جانب النيو ليبرالية المتطرفة في الداخل و المركانتيلية على الصعيد الخارجي، قد تجد صدى لدى بعض الأشخاص في دول مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا.
العالم يدخل بذلك عصراً جديداً، حيث تتبع الدول الغنية أستراتيجية مزدوجة غير معتادة. فبينما يتم التخلي عن العولمة النيو ليبرالية، يتم دفع المشروع النيو ليبرالي في الداخل بشكل أكثر تصميماً وقوة.
برانو ميلاينوفيتش* هو أقتصادي وأستاذ زائر في مركز الدراسات العليا بجامعة مدينة نيويورك.
#حازم_كويي (هاشتاغ)



ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

|
حفظ
 |
بحث |
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
| إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
عن سبل الخروج من أزمة المناخ
-
الحزب الشيوعي النمساوي.. حزب لا مثيل له؟
-
كيف يُعرض ترامب الدولار للخطر؟
-
أميركا أولاً،مهما كان الثمن،إلى أين؟
-
إلى أين يتجه اليسار الجديد؟
-
ترامب وأزمة المناخ
-
مقارنات الحقبة النازية وإستمراريتها
-
أميركا تستعد لتأثيرات ترامب في فترة رئاسته الثانية
-
دكتاتورية الليبراليون الجُدد
-
الرجعيات العالمية والشبكات اليمينية في أنحاء العالم
-
كيف سيتصدى حزب اليسار الألماني أمام صعود اليمين المتطرف
-
البدايات الأولى للتيارات الاشتراكية اليابانية
-
عودة حزب اليسار الألماني
-
تزايد المشاكل التي تواجه جورجيا ميلوني
-
هل هذه هي الفاشية الآن؟
-
اليسار يواجه ثورة ثقافية حقيقية
-
رياح منعشة تهب داخل حزب اليسار الألماني
-
-الاتحاد الأوروبي يواجه الإنكسار-
-
الأثرياء في ألمانيا لا يخلقون الثروة بل يستنزفوها
-
خمس عواقب لسياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها دونالد ترامب ع
...
المزيد.....
-
الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب تعلن تضامنها م
...
-
صور أوجلان ورموز -العمال الكردستاني- في مقار قسد.. ما دلالته
...
-
تيسير خالد : خيال دونالد ترامب واسع ... لكنه خيال مريض
-
The Streets of Iran Are Burning, and So Is the Myth of Stabi
...
-
So What Is It That Youth Should Aspire To?
-
Authoritarians’ Promise of “Law And Order” Always Translates
...
-
King’s Dream Was Never Finished
-
Does the Unthinkable Happen?
-
Resistance Grows as Border Wall Construction Threatens Jagua
...
-
Ending Republican Control Will Require Overcoming the Democr
...
المزيد.....
-
الرأسمالية والاستبداد في فنزويلا مادورو
/ غابرييل هيتلاند
-
فنزويلا، استراتيجية الأمن القومي الأميركية، وأزمة الدولة الم
...
/ مايكل جون-هوبكنز
-
نظريّة و ممارسة التخطيط الماوي : دفاعا عن إشتراكيّة فعّالة و
...
/ شادي الشماوي
-
روزا لوكسمبورغ: حول الحرية والديمقراطية الطبقية
/ إلين آغرسكوف
-
بين قيم اليسار ومنهجية الرأسمالية، مقترحات لتجديد وتوحيد الي
...
/ رزكار عقراوي
-
الاشتراكية بين الأمس واليوم: مشروع حضاري لإعادة إنتاج الإنسا
...
/ رياض الشرايطي
-
التبادل مظهر إقتصادي يربط الإنتاج بالإستهلاك – الفصل التاسع
...
/ شادي الشماوي
-
الإقتصاد في النفقات مبدأ هام في الإقتصاد الإشتراكيّ – الفصل
...
/ شادي الشماوي
-
الاقتصاد الإشتراكي إقتصاد مخطّط – الفصل السادس من كتاب - الإ
...
/ شادي الشماوي
-
في تطوير الإقتصاد الوطنيّ يجب أن نعوّل على الفلاحة كأساس و ا
...
/ شادي الشماوي
المزيد.....
|
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

 |
بحث
|
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
|
إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة