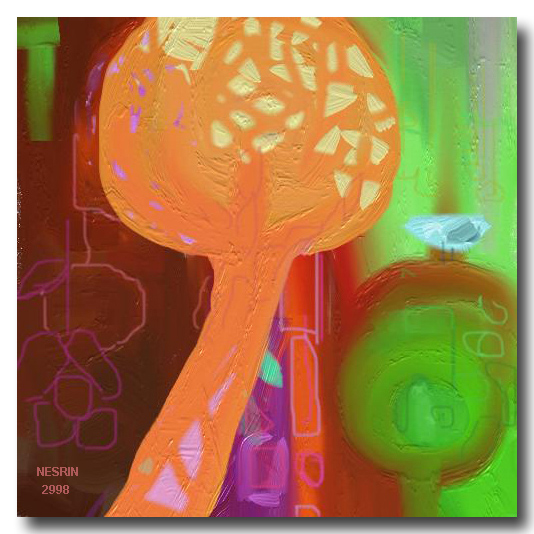|
|
أيكون إبراهيم عربياً؟! (في تأثيل بعض المشاهد الغامضة من سيرة إبراهيم التّوراتيّة (3) الفصل الأول (جزء 1/2) : الإرث والبنون والحميم
كمال محمود الطيارة


الحوار المتمدن-العدد: 8494 - 2025 / 10 / 13 - 15:09
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
أيكون إبراهيم عربيّاً؟!
(في تأثيل بعض المشاهد الغامضة من سيرة إبراهيم التّوراتيّة)
(3)
الفصل الثّاني (جزء 1)
الإرثُ والبَنونُ والحميم
" بعد هذه الأمور صار كلام الرّبّ إلى أبرام في الرّؤيا لا تخف يا أبرام أنا ترسٌ لك أجرك عظيم جداً فقال أبرام أيها السّيّد الرّب ما جدوى أن تعطيني وأنا ماضٍ عقيماً ووارث بيتي هو أليعازر الدّمشقي؟ [...] إنّكَ لم تعطني نسلاٍ وهو ذا ابن بيتي وارثٌ لي" (تك 15/ 1 ـ 3)
" بعد هذه الأمور" أي بعد استنقاذ لوط من الأسر بمساعدة الأموريين حلفاء أبرام وجيرانه (بالمعنى القديم للجوار) واسترجاع النساء والأملاك خلا هذا الأخير بنفسه فانتابه الخوف وهنا يشطحُ التفسير اللاهوتي الإيماني مرّة أخرى ويحْرِفُ معنى الكلام عن سياقه التّاريخي فيزعم بعض الحاخامات أنّ أبرام خاف من أن يناله عقاب الرّبّ لقتله النفوس (ولو كانت نفوس أشرار) بغرض استنقاذ ابن أخيه وهذا زعم خاطئ بالطبع وتوهّمٌ لأمرٍ لا أساس له والعلّة في ذلك أنّ هؤلاء يعملون على نصٍّ أو روايةٍ مرتبطة بمجتمع هم في جهلٍ تامٍّ لقواعده وتقاليده فمن أعراف البدو أنّ الغزو الناجح يكتفي فقط بالسلب والغنيمة والسّلامة في الإياب حتى أنّ البعض يفضّل ترك الغنيمة والعودة سالماً وعليه جرى في أمثالهم "رضيتُ من الغنيمة بالإياب" وينبغي أن لا يُخلّفَ الغزوُ المتبادل قتلى في هذا الجانب أو ذاك وإلاّ دخلت الأطراف المتنازعة في حرب ثأريّة ضروس قد تمتدّ لأعوام (والأمثلة على ذلك في مجتمعات البدو كثيرة) تجعل حياة أفراد القبيلة في تربّصٍ وخطرٍ دائمين زيادة إلى ما هم عليه أصلاً من شظف العيش وضيقٍ في حياة الحلّ والتّرحال سعياً وراء الكلأ والماء ثمّ أنّ النّصّ من جهة أخرى واضح كل الوضوح فهو لا يذكر البتّةَ أنّ نفوساً قد أزهقت في عمليّة أبرام وحلفائه ولا يذكر أنّ حرباً ثأريّةً تلتها فمن أين جاء إذاً بعض الحاخامات بهذا التفسير الخاطئ الذي يُرجِع ُ"خوف" أبرام إلى عقاب قد يناله من الرّبّ على زعم أنّه قتل نفوساً (؟!) إنّها الهوة المعرفيّة التي تفصل بين عصر المفسرين المستقرّين في مجتمعات حضريّة لها أنظمتها وقوانينها وسلطة مركزّيّة تحكمها وتقيم الميزان فيها وعصر الرّواية التي نشأت في مجتمع بدوي له تقاليده وأعرافه وكانت لكل قبيلة سلطتها فتوهّمُ سقوطِ قتلى بيد أبرام أو بيد رجاله أو أحدٍ من حلفائه (رغماً عن أنّ النّصّ لا يذكر هذا البتّة) ينمّ عن جهلٍ مطبقٍ من قِبَلِ المفسرين بتقاليد المجتمع البدوي الذي كان ينتمي إليه أبرام وبقِيَمِه وأعرافه وظنّ البعض الآخر من المفسرين أنّه أكثر حصافة فلم يزد على النّصّ مما ليس فيه لكنّه عزا خوف أبرام من "العين الشّريرة" أن تصيبه بسبب النّصر الكبير الذي أحرزه على أعدائه (!) وفي هذه الحال كما في التفسير السّابق تدخّل الرّبّ ليطمئن أبرام بأنّه ترسه وبأنّه الحامي له واللافتُ في الأمر هنا أنّ كِلا التّفسيرين اللاهوتيين قد أغفل عمداً أو سهواً العلاقة الوطيدة بين هذا المقطع الذي يشير إلى خوف أبرام والآية التّالية له مباشرة التي تحكي تذمّر أبرام من أنّ الرّبَ لم يرزقه البنين لا بل عتبه عليه في ذلك ثم "وعْد" الرّبّ له بنسلٍ عظيم وفي هذا بالضبط ما يمكن أن يرشدنا إلى مكمن الخوف الفعلي عند أبرام فلنرى ذلك في سياقه التّاريخي
إنّ أبرام إذ خلا بنفسه يتأملّ ما قد جرى لابن أخيه وما قد يجري له هو نفسه ربّما في يومٍ ما في مجتمع بدويّ عماده القوّة وديدنه الغزو والسّلب وهو في هذا السّياق قد قلّ عديده بانفصال لوط ورجاله عنه أدرك أنّ سلامته ورهطه منوطتان "بالرجال الذين ذهبوا معه عانر وأشكول وممرا" الأموريين (تك 14/ 24) لنجدته لحلف بينه وبينهم "وأخذوا من الغنائم نصيبهم" (تك 14/ 24) على ما تقرّه أعراف البدو (الخروج في غزو يعني المشاركة في الغنائم وبقي هذا العرف إلى عهد الإسلام وما بعده) فخافَ عاقبة الأمور مستقبلاً فالتفت إلى ربّه معاتباً ولسان حاله يقول: ما الفائدة في أن تعطيني وأن تعِدني بأنّك ستعطيني وليس لي نسل يرثني؟ "إنّكَ لم تعطني نسلاَ" (تك 15/ 3) يُخاطبُ أبرام ربّه معاتباً ليس لي نسل يحمي ما تعطيني إيّاه أو تعدني به ويدافع عنه؟ فلا وارث لي هنا إلاّ هذا الغريب الدّمشقي أليعازر مدبّر أموري والقيّم على ما أملك (!) فحاول الرّبّ أن يهدئ من روع أبرام فأخرجه من خيمته وقال له بل سيكون لك نسل بعدد نجوم السّماء هذه انظرْ "هكذا سيكون نسلك"(!) (تك 15/5) فوعدُ الرّبِّ أبرامَ بالذّريّة هنا تبديدٌ لمخاوف هذا الأخير وشعوره بالضعف الحقيقي في مجتمعٍ العزيزُ فيه من ملكَ وأنجبَ وما الآية "المال والبنون زينة الحياة الدّنيا [...]" (الكهف/16) والبنون هم الذّكور فقط إلاّ تقرير لواقع وتقليد في المجتمعات البدوية القديمة جدّاً بقي صداه يتردّد حتى في الحديثة منها اليوم (JAUSSEN, Coutumes des Arabes au Pays de Moab)
ويبدو أنّ الشّكّ بقي مساوِراً أبرام حول وعود الرّبّ إلى أن دفع له هذا بمعجزةٍ تصديقاً لكلامه وإزالةً للريبة (تك 15/5 ـ 11) فصدّق أبرام عندها وانتهى أمر شكّه ولكنّ السؤال هنا كيف كان لأبرام أن يقول أنّ الدّمشقي أليعازر ذاك لغريب الذي لا تربطه به صلةَ رحمٍ أو قرابة "هو وارثٌ لي" إن متُّ عقيماً من دون عقب؟ إلى أيّ قانون أو عُرفٍ استند في محاججته لربّه ليقول له إنّ ما تعطيني إياه أو تعدني به سيرثه غريب عني ليس من صلبي إن لم تمدّني بالولد؟ الجواب عن هذا السّؤال يكمن في معرفة أعراف البدو وتقاليدهم آنذاك
* الحميم في التّقليد البدوي
النّاسُ في المجتمعات البدوية كما في المجتمعات الحضريّة في الشّرق الأدنى القديم (من الأناضول وبلاد الرّافدين إلى مصر مروراً ببوادي الشّام وجزيرة العرب) أحرارٌ أو عبيد مملوكون من الأحرار وكان العبد من متاع الحرّ وممتلكاته فيذهب العبد والمال معاً إرثاً لمن له الحقّ في ذلك (سوف نتطرّق إلى هذه النقطة لاحقاً) وبالإجمال كان العبدُ لا يرثُ حرّاً إلاّ بوصيّة ومن غير ما وصيّة لعبد أو لغيره الورثةُ الشّرعيون في الغالب على ضربين منهم من تربطه بالمتوفي صلة رحم ورابطة دم ومنهم من تربطه به صلات عُرفية أو قانونيّة (مثل المُتَبَنّى والحميم)
وقد لَحَظَتْ القوانين والقواعد المكتوبة في المجتمعات الحضريّة في المنطقة المُشار إليها إمكان توريث من لا يمتّون إلى المتوفّي بِصِلةِ دمٍ كالجواري والعبيد وأولادهم وذلك وفق قواعد محدّدة من مثل اعتراف السّيد بأولاده من الجارية أو الاعتراف بالجارية زوجة أو عتق العبد وبقائه في خدمة سيّده أو ما شابه وكان من حالات الوراثة المشروعة أيضاً القائمة على ارتباطٍ قانوني من دون رابطة دم حالات التّبنّي ولا بدّ لهذا الحدث (أي التّبنّي)من أن يكون مُضّمّناً في وثائق قانونيّة ونصوص عقديّة غالباً ما تُحفظُ في دور العبادة وربّما كانت الآلهة شواهد عليها ومن أقدم الشّرائع المُنَظِّمَة لمسألة التّبني هنا ربما كانت "شرائع حمورابي" (حوالي 1750 ق.م.) التي تضمّنت العديد من المواد القانونيّة التي تخصّ التّبنّي مباشرة أو عَرَضاً ويكون التّبنّي غالباً للأطفال وشرطه الأوّل أن يُعطيّ المتبنّي اسمه للمتبَنّى ويُدخله في نسبه وبيته رسميّاً في عقد مكتوب وقد حفظت لنا ألواح نوزي بالكتابة المسماريّة (التي عُثر عليها في بداية القرن العشرين قرب كركوك في العراق وعددها يقرب من 5000 لوحة مسماريّة تعود إلى القرنين 14/15 ق.م, أي بعد حوالي ثلاثة قرون من شرائع حمورابي) العديد من عقود التّبنّي التي تحدّد شروط العقد وحقوق كلٍّ من المتبَنّي والمُتَبَنّى وواجبات كلّ منهما تجاه الآخر كما تُعيّن حالات فسخ العقد من جانب هذا الطّرف أو ذاك والعقوبات الواجبة في حالات الإخلال بالعقد وما إلى ذلك والثّابت الوحيد في جميع هذه الوثائق التّاريخيّة هو أن "يُدعى المُتَبَنّى باسم المتبنّي" ويُدوّن الاسم الجديد غالبا في العقد
وبعيداً عمّا ألِفناه من ترّهات الحاخامات ورجال الكنيسة ومن عجزهم عن تفسير الأقوال الملتبسة والمشاهد الغامضة في التّوراة وقول أبرام هنا تحديداً " أيها السّيّد الرّب ما جدوى أن تعطيني وأنا ماضٍ عقيماً ووارث بيتي هو أليعازر الدّمشقي؟" لحظ بعض المؤرخين تشابهاً بين هذه الممارسات القانونيّة والموثّقة في المجتمعات الحضريّة في بلاد ما بين النهرين وجوارها ووضع أليعازر الدّمشقي مع أبرام وكونه الوريث المحتمل لهذا الأخير مع أنّه "غريب" عنه وليس من صلبه فجنحوا إلى أنّ قولة أبرام هذه ليست اختلاقاً صِرفاً من قِبَلِ جامعي التّوراة بل إنّ مصدرها أو أنّها تعكس مباشرة الممارسات الشّرعيّة المتعارف عليها والقوانين التي كان معمولاً بها آنذاك في تلك الأصقاع ولكن لا يبدو لي أن الأمر يمكن حمله على هذا المحمل لسببين جوهريين الأول هو أنّ العلاقة بين أبرام وأليعازر ليست علاقة تَبَنٍ البتّة على نحو ما تحدده النّصوص القانونيّة في المجتمع الحضري فأليعازر قد احتفظ باسمه ونسبه (الدّمشقي) كاملين ولم يُنسب إلى أبرام والنسبة إلى المُتَبَنّي أي إعطاء الاسم للمتبنّى هو الشّرط الأول والأهم لصحّة العملية من النّاحية القانونيّة كما رأينا والسّبب الثاني هو الفارق الزّمني بين عصر أبرام من جهة وعصر الكتابات القانونيّة المشار إليها من جهة أخرى فلو أخذنا بفرضيّات التّوراتيين فإنَ عصر أبرام سابق قليلاً لزمن حمورابي أو بالكاد معاصرٌ له ويسبقُ بأكثر من ثلاثة قرون ألواح نوزي وعليه يكون قولُ أبرام هنا إقراراً مسبقاً بممارسة قانونيّة لاحقة عليه وهذا محال
وعليه فأنّ التّشابه الملحوظ بين حالة أليعازر مع أبرام وحالات التّبنّي المشار إليها في الآثار القديمة المحفوظة ما هو إلاّ تشابه في الظّاهر فقط يقوم على أنّ الأمر في الحالين يعود إلى "غريبٍ يَرِث من لا تربطه به رابطة دم" لكنّ الفرق بين هذا وذاك كبير
فإذا كان من المحال على أبرام أن يصدر في مقولته عن القوانين الحضريّة التي عرضنا وهي لاحقةٌ عليه وإذا كان جوهر العلاقة التي تشدّه إلى أليعازر مغايرة لرابطة التّبنّي كما رأينا فلا بُدَّ إذن وأنّه قد استند إلى قاعدة عُرفيّة أو قانونيّة ما في حجاجِه ربّه وادّعائه بأنّ ما يعطيه إياه وما يعده به سيذهب في نهاية المطاف إلى "غريبٍ" لا يمُتُّ إليه أو إلى رهطه بصلة نسب فهل هناك ما يثبت هذه الفرضيّة وفي أيّ المجتمعات يا تُرى سادت هذه الأعراف والتقاليد التي تشبه من بعيدٍ فقط ما جاء في هذه الألواح المسماريّة في هذا المضمار؟
نقول إنّ المجتمعات البدويّة العربيّة القديمة عرفت عادات وتقاليد تتوافق تماماً مع ما قاله أبرام عن أليعازر الدّمشقي فهذا الأخير لا تربطه بأبرام صلة رحم وليس عبداً مملوكاً له قد يرث بوصيّة ثمّ هو لم يتبنّه ويُغيّر له اسمه كما تنصّ على ذلك القوانين الحضريّة ومع ذلك يُقِرُّ أبرام أنّ لهذا الغريب الحق في أن يرثه فكيف يكون ذلك؟
في المجتمعات البدويّة القديمة يُعرَفُ من يقوم بما كان يقوم به أليعازر حِيال أبرام ب"الحميم" وهو الوليُّ القريب من سيّده العقيم المشفق عليه الذي يقوم بأمره وقد كانت العرب على ما يقول أبو عُبَيْد القاسم بن سلاّم الهروي (774 ـ 838) في كتابه "الأموال" تُورِّث " الموالي والحلفاء والحميم فإذا مات الرّجل لا ولد له ولا عَصَبة وَرِثَه حميمُه أو مولاه" والعَصَبةُ هنا (جواد علي المفصّل ج 5) "أقرباء الميت من الرّجال وهم مقدّمون على الأخوات في الإرث فإذا توفيّ الرّجل ولم يكن له من الذّكور من يرثه ولا أب صُرِفَ إرثه إلى إخوته أو عَصَبته إن لم يكن له إخوة ولا يُدْفَعُ إلى الأخوات [...] والعَصَبَة هم الذين يرثون الرّجل عن كلالة من غير والدٍ ولا ولد" فهم الأقارب الذّكور البعيدون من جهة الأب وهذا معنى قولهم من لم يكن من النّسب لحاً (أي قريب) فهو كلالة (أي بعيد) (لسان العرب/ عصب) وعليه فإنّ الورثة في التّراتبيّة هم على النحو التالي الأولاد الذّكور أوّلاً (دون الصغار والبنات) فالأب فالإخوة (دون الأخوات) فالعَصَبة (وهم الذّكور الأبعدون = أولاد عمّ كلالة من جهة الأب دون الإناث) فالحميم أخيراً
وقد زاد بعضهم فخصّص أن بعض قبائل قضاعة (وهي قبيلة عربيّة قديمة ربما أصلها من الجنوب وقد دخلت مع قبائل الشّمال في علاقات جوار ومصاهرة وكانت مضاربها ما بين الشّام والحجاز وكان لها حضور قويّ على أطراف بادية الشّام) كانوا يورّثون الحميم عند انقطاع العَصَبة وعلى هذا كان يُعتبر "الحميم" في حال انعدام الورثة الشّرعيين كما أسلفنا وريثاً كامل الشّرعيّة مما يسمح للقبيلة بالحفاظ على وحدتها وقوّتها ومقوماتها الاقتصاديّة داخل القبيلة وقد تكون للحميم حقوق ممتدّة من مثل نكاح زوجة سيّده المتوفّي في القبائل التي كان معمولاً فيها بزواج المقت أو زواج الضّيزن (زواج الابن البكر من وزوجة أبيه والأمر ذو هدف اقتصادي أساساً وهو إبقاء مهر المرأة داخل القبيلة وعدم إعادته لأهلها بعودتها إليهم) وقد ألغى القرآن هذا الضّرب من الزّواج ("ولا تنْكِحوا ما نَكَحَ آباؤكم من النّساءِ إلاّ ما قد سّلَفَ إنّه كان فاحِشّةً ومقْتاً وساءَ سبيلا" /النّساء ـ 22) كما أخرج كذلك الحميم والمتبّنّي من الميراث مقتصراً هنا على النّسب ورابطة الدّم بقوله "وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض" (الأنفال/ 75)
"الحميم" لغويا الصديق المقرب أمّا اصطلاحاً فهو خادم يدين بالولاء لسيّده فنال مكانة خاصة لديه وصار يُعهدُ إليه ليس فقط بالإدارة اليوميّة لأمور سيّده وإنّما أيضاً بأمور شخصيةٍ أو عائليّة فهو قد يمثل سيّده في المناسبات والمهام الخاصّة وعلينا أن نتذكّر هنا مثلاً أن إبراهيم (وقد غيّر له الرّب اسمه) إذ شاخ وتقّدمت به الأيّام كلّفَ أليعازر الدّمشقي كبير عبيده ومدبّر بيته لينوب عنه في الذّهاب إلى آرام النّهرين في طلب زوجة لابنه إسحاق فخرج "العبد كبير بيته المستولي على كلّ ما كان فيه" (تك 24/ 1 ـ 10 وسوف نتطرّق إلى هذه الرّواية لاحقا) بالجمال محمّلة بخيرات سيّده ثمّ عاد برَفْقَة (Rébecca)زوجةً لإسحاق وقد أتمّ المهمة بنجاح
و"الحميم" في الثقافة البدويّة القديمة ليس عبداً مملوكاً وإن أُطلق عليه مجازاً لقب عبد وليس طفلاً جرى تبنيه يوماً وأُدخِلَ في نسبِ المتبني فصار التّماهي قائماً بين المتبّنّي والمتبنّى (الأوّل يعطي اسمه للثاني) بل هو العبد المعْتق أو المولى أو الحليف المستقلّ بذاته ولكنّه على ولاءٍ مطلقٍ لسيّده في نطاق العصبيّة القبليّة المعروفة جيّداً في هذه المجتمعات قال الفرّاء مدَلّلاً على أهميّة العصبيّة التي تشدّ المولى إلى سيّده في هذا السّياق القبلي "الموالي ورثة الرّجل وبنو عمّه " فالولي ينزل من الرّجل منزلة "ابن العمّ" وكأنّ بينهما نسب وصلة دمّ وقد ذُكِرَ أنّ المولى على ستّة أوجه المولى ابن العم والعم والأخ والابن والعَصَبات كلهم والمولى النّاصر والمولى الوليّ الذي يلي عليك أمرك (وهو حال أليعازر مع أبرام فهو المتولّي أمره) والمولى المُعتَقُ والمولى ينزل منزلة ابن العمّ يجب عليك أن تنصره وترثُه إن مات ولا وارث له ولقوّة الولاء قالوا "الولاء كالنّسب فلا يزول بالإزالة" (لسان العرب/ولي) وعبّرت اللغة العربيّة عن هذه العلاقة الحميمة جدّا بين الطّرفين والتّماهي التّام بينهما فكانت كلمة "مَوْلى" تُطلق على السّيّد وعلى العبد سواسيَة وذلك للدّلالة على الآصِرَة التي تجمع بينهما فكأنّهما شيء واحد (ومن أشباه ذلك أيضاً للدلالة على قوة الرابط كلمات الحليف وكذلك الجار لمن أجار ولمن طلب الحماية والجوار) فالعلاقة بين الطّرفين أي بين السّيّد وحميمه قائمة
1) من جهة على الولاء التّام المستند إلى العصبيّة القبليَة وهذا مما لا يوجد بين المتبني والمتبنى فالعلاقة هنا قائمة على نصوص قانونيّة واضحة وعقد يُحرّرُ بين الطرفين ويحقّ لكلّ منهما فسخّه متى شاء ضمن شروط محدّدة مسبقاً
2) ومن جهة أخرى على التّمايز بين السيد والولي أو الحميم وليس أدل على هذا التمايز من أنّ أبرام قد أشار في حديثه عن وليّه ومدبّر أمره إلى موطنه الأصلي "دمشق" قبل أن يأتي على ذكر اسمه "أليعازر" فهو بذا أراد الإشارة إلى "غُرْبِيَّة" هذا الرّجل و"أجنبيّته" قبل الإشارة إلى شخصه والفرق في المعنى واضح جليّ بين عبارة "أليعازر الدّمشقي" التي تمنح الصّدارة لهوية الشّخص المشار إليه ويكون ذِكر الموطن الأصلي متمّماً للهويّة وعبارة "الدّمشقي أليعازر" التي تُحيلُ في المقام الأوّل إلى الأصل الأجنبي للشخص قبل التّعرّف إليه وبالفعل فإنّ النّصّ العبري رغم الارتباك الذي يعْتَوِرُ هذا الموضع فإنّه يُقدّم ذِكر دمشق على أليعازر (דַּמֶּשֶׂק אֱלִיעֶזֶר) ولكنّ بعض الترجمات العربيّة مثلاً ارتأت أن تقْلِبَ المعنى الذي قصد إليه أبرام فجعلت من دمشق نعتاً لأليعازر فجاءت التّرجمة على النحو التالي "أليعازر الدّمشقي"(!!!) فأضرّت بالمعنى ضرراً كبيرا وحرَفَت كلام أبرام عن مقصده
هناك اختلاف جوهريّ إذاَ بين نظام التبني الذي كان سائداً في المجتمعات الحضريّة (بلاد الرافدين والجوار) ويخضع لقوانين وعقود مكتوبة ونظام الولاء والحميم الذي كان تقليداً معمولاً به في المجتمعات البدويّة وليس هناك من أدلّة تاريخيّة على أنّ هذا التّقليد البدوي القديم كان ممارساً في المجتمعات الحضريّة المجاورة على هذا النحو المعروف عند البدو وعليه فمن المرجح جدّاً أنّ ابرام كان يصدر في خطابه لربّه بخصوص حرمانه من النسل وانتقال الميراث تلقائيّاً إلى وليّه وحميمه ذلك الدّمشقي أليعازر الغريب عن معرفة تامّة بتقاليد البدو في هذا المضمار كما بيّنّا سابقاً معرفته أيضاً بتقاليد الحِمى وقواعده ... وكيف لا يكون ذلك وهو البدوي الرّحل والتّوراة لا تَني تؤكد ذلك (!)
(يتبع)
كمال محمود الطّيارة ـ ليون ـ فرنسا ـ 13/10/25
#كمال_محمود_الطيارة (هاشتاغ)



ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

|
حفظ
 |
بحث |
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
| إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
أيكون إبراهيم عربيّاً؟! (في تأثيل بعض المشاهد الغامضة من سير
...
-
أيكون إبراهيم عربيّاً؟! (في تأثيل بعض المشاهد الغامضة من سير
...
-
أيكون إبراهيم عربياً؟! (في تأثيل بعض المشاهد الغامضة من سيرة
...
-
أيكون إبراهيم عربيّاً؟! (في تأثيل بعض المشاهد الغامضة من سير
...
-
أيكون إبراهيم عربيّاً؟! (في تأثيل بعض المشاهد الغامضة من سير
...
-
أيكون إبراهيم عربيّاً؟! (في تأثيل بعض المشاهد الغامضة من سير
...
-
-شاهد ما شفش حاجة- أو شرُّ البليّة ما يُضحِكُ (موتُ النّخْوَ
...
-
من إسلام الضّرورة ‘لى إسلام البزنس (تدنيس المقدّسفي المخيال
...
المزيد.....
-
واشنطن تصنف جماعة الإخوان المسلمين في مصر ولبنان والأردن -من
...
-
ما أبرز ردود الفعل على القرار الأميركي ضد الإخوان المسلمين؟
...
-
هل يستهدف تصنيف -الإخوان- بالإرهاب مسلمي أميركا؟
-
الجمهورية الإسلامية في معركة وجودية: هل تخشى دول الخليج سينا
...
-
السعودية ترحب بتصنيف أمريكا لفروع الإخوان جماعات إرهابية
-
الإخوان بعد التصنيف الأميركي.. المواجهة تدخل مرحلة جديدة
-
فرنسا تدرس إضافة الإخوان لـ-قائمة الإرهاب-
-
الأردن يردّ على تصنيف أمريكا لجماعة -الإخوان المسلمين- منظمة
...
-
واشنطن تصنف جماعة الإخوان المسلمين بعدة دول -منظمة إرهابية-
...
-
العربي الناصري: قرار واشنطن ضد الإخوان اعتراف متأخر بخطر الج
...
المزيد.....
-
رسالة السلوان لمواطن سعودي مجهول (من وحي رسالة الغفران لأبي
...
/ سامي الذيب
-
الفقه الوعظى : الكتاب كاملا
/ أحمد صبحى منصور
-
نشوء الظاهرة الإسلاموية
/ فارس إيغو
-
كتاب تقويم نقدي للفكر الجمهوري في السودان
/ تاج السر عثمان
-
القرآن عمل جماعي مِن كلام العرب ... وجذوره في تراث الشرق الق
...
/ مُؤْمِن عقلاني حر مستقل
-
علي قتل فاطمة الزهراء , جريمة في يترب
/ حسين العراقي
-
المثقف العربي بين النظام و بنية النظام
/ أحمد التاوتي
-
السلطة والاستغلال السياسى للدين
/ سعيد العليمى
-
نشأة الديانات الابراهيمية -قراءة عقلانية
/ د. لبيب سلطان
-
شهداء الحرف والكلمة في الإسلام
/ المستنير الحازمي
المزيد.....
|
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

 |
بحث
|
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
|
إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة