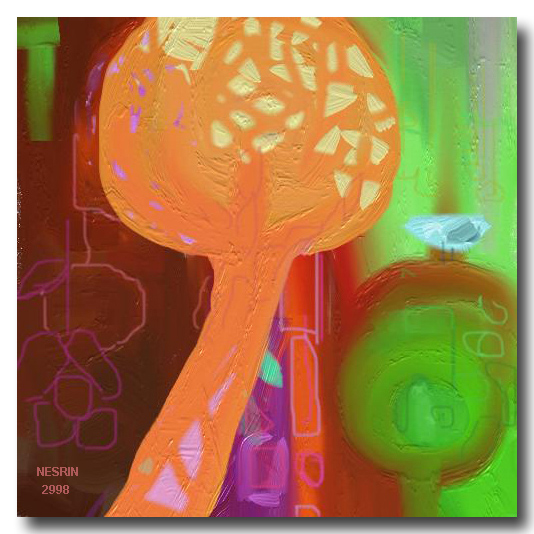|
|
المجموعة القصصية ( السقوط من البندول ) للكاتب أحمد عثمان على طاولة النقد بمنتدى السرديات.
مجدي جعفر


الحوار المتمدن-العدد: 8351 - 2025 / 5 / 23 - 13:58
المحور:
الادب والفن
تحلق أدباء منتدى السرديات باتحاد كُتّاب مصر – فرع الشرقية ومحافظات القناة وسيناء حول المجموعة القصصية ( السقوط من البندول ) للكاتب أحمد عثمان، وأدار الندوة الأديب والناقد محمد الديب، وقدم أيضا دراسة نقدية في المجموعة تحت عنوان : (الكتابة في وجه السقوط - قراءة في مشروع أحمد عثمان القصصي من خلال السقوط من البندول ) وجاء فيها :
" في زمن تتآكل فيه الحدود بين الأجناس الأدبية، ويتراجع فيه الوعي بالكتابة بوصفها مقاومة داخلية ضد فوضى العالم، ينهض مشروع أحمد عثمان القصصي كصوت مغاير، لا يروي العالم كما هو، إنما كما يُوجع ويُفتقد.
أحمد عثمان ليس كاتبًا يُغريه الحدث، أو يؤمن بصدام الشخصيات، أو يحتفي بالتقنيات الشكلية في ذاتها؛ هو كاتب قلق وجودي بالدرجة الأولى، يستخدم القصة القصيرة لا ليقول "ماذا حدث؟"، إنما "لماذا حدث هذا الألم؟"، أو بالأدق: "كيف نعي سقوطنا ونحن لا نزال نقف؟".
تُشكل مجموعته السقوط من البندول لحظة اكتمال لنبرة سردية خاصّة، قوامها القصّ النفسي المتوتر، واللغة الشعريّة المختزلة، والبناء المفتوح على تأويلات الذات والزمن والموت، القصص التي تتضمنها المجموعة مثل "فعل علني"، "نظرة، فابتسام.."، "بقايا مهترئة"، "أوجاع الضياع!!"، و"السقوط من البندول" وغيرها — لا تقدم عوالم متعددة، إنما تقدم وجوهًا متعددة لنفس الجرح الداخلي، نفس الوحدة المُغلّفة بالتذكّر، نفس الانهيار البطيء تحت عبء الزمن.
إن القارئ الذي يقترب من عوالم أحمد عثمان القصصية، لا بد أن يشعر أنه داخل مرآة مشروخة، يرى فيها شخوصًا تشبهه، لكنها لا تفعل شيئًا إلا أن تتذكر، تتألم، تتراجع، ف"الابتسامة" = الموت، و"البندول" لا يحدد اتجاهًا للحياة أو الموت، إننا إزاء سرد يكتب ما لا يُقال عادةً: الصمت، التردد، الإنهاك، النَفَس الأخير للحلم قبل موته، اللحظة التي يُصبح فيها كل شيء بقايا، حتى الإنسان.
من هنا، فإن كتابة أحمد عثمان تنتمي إلى ما يمكن أن نُسميه "السرد التأملي الرمزي"، وهو تيار غير صاخب في القصة القصيرة الحديثة، لا يعتمد على حبكة درامية أو مفاجآت أو مونولوجات حادة، إنما يعتمد على تشظي اللحظة الواحدة وتحميلها بثقل دلالي شفيف. هو امتداد ـ في روحه ـ لأعمال كتاب كبار مثل بهاء طاهر، وبعض قصص إدوارد الخراط الرمزية، لكنه يحمل خصوصية لغوية وبنائية تتقاطع مع التجريب من أجل التجريب، وتركز على التجريب كأداة لتوصيل عمق التجربة النفسية والوجودية.
إن إحدى السمات اللافتة في هذه المجموعة، هي اعتمادها على بنية زمنية متهالكة؛ فالزمن يدور حول نفسه ولا يتقدم ، ولا يمنح خلاصًا إنما يُعيد تدوير السقوط.
فالقصة الأولى "فعل علني" مثلًا، تجعل من اللحظة الأخيرة مساحة للتأمل أكثر من الفعل. وكأن الفعل لم يعد ممكنًا، أو لم يعد مجديًا. كل شيء يحدث داخليًا حتى الزمن، في "السقوط من البندول"، يُصوَّر عبر حركة البندول التي من الطبيعي أنها لقياسٍ الوقت، لكنها تأتي كـ"جلد ذاتي" لا ينتهي.
ويُقابل هذه البنية الزمنية اقتصادٌ لغوي حاد، حيث كل جملة تقف على حافة الشعر، دون أن تنزلق إلى التغني أو الترهل. إنه نصّ يرى أن اللغة إذا لم تكن جرحًا، فهي زينة لا ضرورة لها. فحين يقول في "أوجاع الضياع!!":
"لم يبقَ سوى خيط من الدخان.. يتلوى من فمه نحو السماء، كأنه آخر أحلامه التي لم تُروَ"،
فهو لا يصف موتًا، إنما يصف احتراق الرغبة في الحلم، احتضار الداخل بلا ضوضاء.
الأماكن في هذه القصص تأتي بمثابة مرايا نفسية. المقعد المهترئ، البندول، المرآة، السماء، النافذة.. وغيرها تأتي كرموز تتفاعل مع الحالة الشعورية للشخصيات، وتُشكّل عبر تكرارها شبكة دلالية تُفضي إلى تأويل فلسفي: أن الإنسان يُعرّف من خلال ذاكرته، وأن السقوط ليس لحظة خارجية، إنما فعل داخليّ مستمر.
ولا يخفى أن هذه البنية الرمزية واللغوية الدقيقة، تؤدي إلى تغريب متعمد للقارئ؛ فلا هو داخل القصة، ولا هو خارجها.
إنها كتابة تُشرك المتلقي في لعبة التأويل، في قراءة الصمت قبل الكلمات، والتردد قبل القرار، والظل قبل الضوء .. كتابة ضد السردية الخطية، وضد الحدث الجاهز، وضد النهايات المريحة.
بهذا المعنى، يمكن النظر إلى السقوط من البندول بوصفها مشروعًا سرديًا مكتمل النبرة، مفتوح التأويل، ناضج التوتر. مشروع يُعيد للقصة القصيرة نُبلها التأملي، ويقاوم الابتذال السردي، ويؤمن بأن الفنّ العظيم لا يُحدث فرقًا بالقول، إنما يحدث فرقا بالصمت الذي يخلقه في القارئ بعد القراءة.
.........................................................................
..........................................................................وتحت عنوان ( المجموعة القصصية " السقوط من البندول " للكاتب أحمد عثمان - قراءة في الرؤية والتشكيل - كتب الأديب والناقد مجدي جعفر :
" يقدم الكاتب أحمد عثمان في مجموعته القصصية ( السقوط من البندول ) تجارب إنسانية حميمة، يمتح فيها من واقعه المعيش، ويعيد لنا تشكيل هذا الواقع في صور مبهرة ومبدعة.
العنوان كما يقول الباحث السيميولوجي هو العتبة الأولى للولوج إلى النص، وهو النص الأصغر، المُضمر فيه الرسالة التي يريد الكاتب إيصالها إلى المتلقي، وكما اهتم بالعنوان اهتم أيضا بلوحة الغلاف، وبالنظر إلى لوحة الغلاف كفضاء بصري مهم، نرى اللون الغالب على اللوحة هو الأبيض، وفي أعلى الغلاف ساعة تبدو عتيقة، يتدلى من بندولها رجل يتأرجح في الفراغ، وعلى أعتاب السقوط، فالساعة ترمز إلى الزمن، فهل ينصب اهتمام الكاتب قبل الشروع في قراءة المجموعة بالذين يسقطون من الزمن؟.
ويأتي الاهتمام بالزمن من الإهداء أيضا، حيث يهدي مجموعته إلى سنين عمره التي توارت بالحجاب,
وقصة ( السقوط من البندول ) التي حملت المجموعة اسمها، هي إحدى قصص المجموعة الجياد، التي تؤكد وعي الكاتب بالزمن، وإدراكنا للزمن لا يتأتى إلا كلما تقدمنا في العمر، وقد أحسن صنعا باختيار بطل النص كاتبا ذاع صيته وطبقت شهرته الآفاق، وعلاقته بالزمن في طفولته وصباه وشبابه تغيرت مائة وثمانون درجة عندما بلغ من الكبر عتيا، وهذه العلاقة قدمها لنا الكاتب باقتدار من خلال الساعة المعلقة على الجدار، وهي أداة من أدوات قياس الزمن الفيزيقي، وكان إدراك الكاتب بطل النص، الشيخ الهرم الطاعن في السن الذي اشتعل رأسه بالبياض، كان إدراكه للزمن من خلال الآثار التي تركها عليه، ليس بتجاعيد الوجه واشتعال الرأس شيبا ووهن الجسد والاتكاء على العكاز فحسب، بل الآثار النفسية أيضا، والزمن النفسي لا يُقاس أبدا بمقاييس الزمن الفيزيائي، والزمن النفسي هو الزمن الأهم بالنسبة للكاتب، وإنشغاله به يفوق إنشغاله بالزمن الفيزيائي، وبدا الزمن النفسي / الأدبي حاضرا بقوة في العديد من القصص، وخاصة القصص التي اقترب فيها من تخوم الصوفية.
والساعة المعلقة على الجدار:
( أمست دقاتها المتتابعة مطارقا تقض مضجعه، وتشعل توتره، تجلد شيخوخته بسياط لا ترحم ) ص 56.
ولعل القارئ يكون قد تبين من خلال هذه الجُمل القليلة آثار الزمن في شيخوخته على حالته النفسية التي ساءت والمزاجية التي تعكرت، وهذا ما جعله يقبل على فعل غرائبي، وهو محاولته إيقاف هذا الزمن، بل تعدى الفعل من محاولة إيقافه إلى محاولة العودة به إلى الوراء!.
حاول أن يدير مفتاح الساعة بالاتجاه العكسي ! ليقدم لقصته نهاية قوية وحاسمة، وتثير في عقل المتلقي العديد من الأسئلة الوجودية، مثل : الحياة والموت، وصيرورة الزمن، وديمومته، والوجود والعدم، ... إلخ.
( 2 )
القرية المصرية وتحولاتها :
الزمن حاضرا بقوة في جُل القصص، يُغيب أشخاصا، وأماكن، وحرف ومهن، وعادات وتقاليد، وقيم وأخلاق، و.. و ..، ومن خلال وعي الكاتب بالزمن يرصد في قصص ( الزغلولة .. نخلة جدي، ماكينة داوود، آخر الدنيا ) التغيرات التي طرأت على القرية المصرية :
1 – في قصة ( الزغلولة .. نخلة جدي ) يقدم لنا باختزال وتكثيف شديدين من خلال الزغلولة / النخلة قرية ( العلواية ) ونشأتها، واعتمد فيها على الموروث الشفاهي، والحكايات المروية عن الأب عن الجد ..
والكاتب مغرما في هذه القصة بالحكي الشعبي، والحكاية هي العمود الفقري لقصته، وأظهر فيها قدرته الفائقة على انتقاء الحكايات التي ينقلها عن أبيه عن جده وعن جد جده، مستخدما خاصية الانتقاء، وهي خصيصة مهمة، ولأن الفن انتقاء واختيار من الواقع، فاختار الكاتب من الزمن الممتد منذ نشأة القرية المواقف والحوادث التي كانت مضيئة في سماء ذلك الزمن البعيد، منذ اللبنات الأولى للمكان وبعثه الأول، وصولا به إلى الآني والحاضر، ورصد حركة الزمان في المكان وجدليته معه، وإزاحته لبعض معالمه، ورصد أيضا التغيرات التي طرأت على الشخصية الريفية.
2 – في قصة ( ماكينة داود ) ص 67 يوقفنا كيف غيب الزمن ماكينة داود ( وابور الطحين )، ولم يبق منها غير صوت الماكينة الذي يطن في أذنيه، وحكايات أمه عن العفاريت التي تسكنها، والتقاط الطفل الشارد لذبحه على سيرها لكي تدور، ويرصد من خللها التحولات والتغيرات الخطيرة التي حدثت للقرية، فالعائدون من بلاد النفط تخلصوا من البيوت الطينية وشيدوا مكانها عمارات عالية بالطوب الأحمر والحديد والأسمنت، وعلى أرض الماكينة انتصب برجا شاهقا، يناطح السحاب!.
3 – وفي قصة ( آخر الدنيا ) ص 70، يختفي ( المسقى ) الذي يجري فيه الماء لري الأراضي المنزرعة، فالأجيال المعاصرة قاموا بردمه، واقتلعوا الاشجار، وعبدوه طريقا عريضا طويلا وعلى جانبية أقاموا البيوت والعمارات!.
4 – وفي قصة ( عم مهران .. الحاذق ) ص 73، هل يُسقط الزمن العم مهران الرجل الحاذق الذي يداوي بالأعشاب، ويعرف لكل مرض العشب الناجع لعلاجه، ويعف عن أخذ مقابل من مرضى القرية، ويعالج الذين يعانون من وجع في المفاصل، ومن الروماتيزم، يعالجهم بدهن الثعابين التي يصطادها له الأولاد، ويكافأهم على صيدهم الثمين بحبات ( الكرملة ),
الكاتب اهتم اهتماما كبيرا بالقرية القديمة التي رسخت في ذهنه مذ كان طفلا، ووصفها وصفا دقيقا، ويضعها في مقابلة ومواجهة مع القرية المعاصرة، ليكتشف القارئ أن البيوت الطينية قد غيبها الزمن وأزاحها البندول غير عابئ بصراخها، وحلت بدلا منها العمارات العالية والأبراج الشاهقة كما سقط وابور الطحين من البندول أيضا، ومساقي الأراضي سقطت هي الأخرى، وبارت الأرض وأُهملت وجُرفت، حتى ألعاب الأطفال اختفت مثل السيجة والبلي والاستغماية وغيرها، ومعرفة مقاييس الزمن التي كانت تُقاس بحركة الشمس والظل، غيبها الزمن، واختفت بعض الحرف والمهن، واختفت قيم أخلاقية في المجتمع الريفي ومنها قيمة التكافل الاجتماعي، فكان خراج الزغلولة يذهب إلى الفقراء والجيران والأصدقاء قبل أن يطعمه أصحابها.
( 3 )
المهمشون والفقراء :
يقترب الكاتب في بعض قصصه من الناس البسطاء والعاديين، والهامشيين والفقراء الذين يعيشون على أطراف الحياة،ومعاناتهم ومكابداتهم من أجل الحصول على كسرة خبز وحسوة ماء، من أجل لباس يسترهم، ويغوص الكاتب في دواخلهم، مستبطنا همومهم وأحزانهم الكثيرة، وأفراحهم القليلة.
1 – في قصة ( زفاف ) يقدم لنا أوجاع ( على الله ) وهذا هو اسمه، محدود الذكاء، قوي البنية، لا عمل له ليقتات منه، ويعتمد على ما يجود به الناس والباعة عليه من أطعمة، لا يمد يده أبدا لأحد طلبا لصدقة حتى لو تضور جوعا، ولا مأوى له، يتكور آخر الليل على رصيف محطة القطار، تتحلق حوله القطط والكلاب والجرذان، يلقي لها بما جادت به الناس عليه، تتعارك على الأكل، وحينما تشبع تهدأ، فيروح هو في النوم.
2 – قصة ( سياط ) ص 36 : مأساة أطفال الشوارع الذين يتم اسغلالهم من قبل عصابات الأشرار لتوظيفهم في السرقة والنشل، والصبي الذي يمر يومه ولا يجد صيدا، ويخشى سوط معلمه الذي ينهال على جسده، وكيه بسيخ الحديد المجمر إذا عاد من ( سرحته ) بكفي حنين، وكلما لاح له أساليب العقاب المؤلمة، يتكور على نفسه خوفا ورعبا، ولكنه يفيق على دقات حذاء لسيدة انيقة، فيتعقبها، ويغافلها، ويخطف حقيبتها، ويولي مسرعا، فتصرخ السيدة مستجيرة بالمارة، فيلاحقونه محاولين الامساك به، يروغ منهم، ويزوغ، ويجري في الاتجاه المعاكس لتصطدمه سيارة مسرعة
3 – قصة ( يوم مختلف ) ص 25 : الرجل الفقير الذي يخرج من بيته مع شروق الشمس، ولا يعود إلا مع غروبها، يجوب الشوارع والحواري والأزقة، وينادي : بيكيا .. بيكيا .. روبابيكيا، وبالكاد يتحصل على قروش قليلة لا تفي بمتطلبات حياته الأساسية، وضاقت زوجته به وبحياته، وتجرأت على جلده بلسانها السليط، ومعايرته بفقره، وشكواها التي لا تنقطع من طبق الفول الذي لا يفارقهما، ويداها اللتان برى جلدهما الغسيل، والديون التي تتراكم ولا أمل في سدادها، البقال، وبائع الخبز، و ..
4 – قصة ( قلوب ) ص 13 : المرأة التي تستخدم جمالها ودلالها وأنوثتها، مستغلة سطوتها على رجال السوق، فتلين قلوبهم، ويسيل لعابهم
5 – قصة ( سوق الجمعة ) ص 41 : الموظف الذي لا ينافق رئيسه ولا يهادن من أجل ترقية أو علاوة أو بدلات، ولا يسالم، ويتسم بالصدق والأمانة والأداء المثالي لوظيفته، وعُرف بين زملائه ب " الفقري "، فيرفض الرشى والمال الذي يأتي من استغلال الوظيفة والتربح منها بطرق ملتوية وغير مشروعة، هذا الموظف ( الفقري ) يُعاني ضيق اليد وعُسر الحال، ويعاني من شظف العيش، فراتبه الهزيل لا يسد أقل حاجيات أسرته الأساسية والضرورية، فيضطر للعمل بأحد المطاعم ليُحسن من دخله بعد انتهاء عمله الوظيفي، ويؤلمه حال ولده في هذا الشتاء القارس، الذي أصاب صدره وعظامه..
6 – قصة ( أرزاق! ) ص 44 : الرجل " الأرزقي " الذي يعمل يوما، ولا يجد من يطلبه للعمل أياما، ولا تجد زوجته في الدار، ما تسد به رمقهم، فيتألم الرجل ويبكي في صمت وهو يصيخ السمع إلى معدهم التي تصرخ وأمعاءهم التي تتلوى، وفي لحظة يأسه من العثور على عمل في هذا اليوم، يتفاجأ بيد حانية، تتأبط ذراعة، ويسير به صاحبها إلى مائدة كبيرة وعامرة بالخيرات، وبرقت في ذهنه فكرة بعد أن اجترح صيامه ببعض تمرات :
( مسرعا راح يجمع من حوله ما طالته يداه من أطباق " الفوم " التي لم تجد من يلتهم ما تحويه – في كيس كبير يلازمه، ثم انسل خارجا، بينما الحوار مستعر – على أشده – بين الأفواه والأطباق ) ص 45.
( 4 )
هموم الوطن والأمة :
انشغل الكاتب في بعض قصصه بالهم السياسي، وبالهموم الوطنية والقومية.
1 – قصة ( أزيز ) ص 48 :
ينقل الكاتب من سرادق عزاء عضو مجلس الشعب، الحوارات التي تدور همسا أحيانا، وزعيقا أحيانا أخرى بين وجهاء القوم الذين جاءوا لأداء واجب العزاء، وهذه الحوارات كاشفة وفاضحة للسياسيين ورجال الأعمال وغيرهم من صفوة المجتمع المصري :
هل هؤلاء من القطط السمان التي أثرت ثراء فاحشا، واستفادت من انفتاح السادات، انفتاح ( السداح مداح ) بتعبير الكاتب أحمد بهاء الدين؟
هل هؤلاء من رجال نهب المال في زمن مبارك، زمن الخصخصة وبيع القطاع العام بتراب الفلوس، فالبندول قد أزاح رجال الأعمال الوطنيين وأتى بأمثال هؤلاء الذين ارتبطوا مع الحكومة بزواج كاثوليكي، ولا ينفصم عرى هذه العلاقة إلا بالموت؟
2 – قصة ( أوجاع الضياع!! ) ص 33 :
يقدم الكاتب في هذه القصة جناية الحرب على الإنسان، من خلال أم وطفلها نزحا من بلدهما بسبب الحرب، ويعيشان في أحد المخيمات بالصحراء : ( وعيونهما تحتبس مشاهد خلفاها في فرارهما .. بيتهما وحديقته .. الشارع الممتد، والحارات الهابطة مع انحدار التلة .. الأهل والجيران ) ص 33.
ويرصد معاناتهما في لفح الحر القائظ صيفا في المخيم، والبرد القارص شتاء، ومعيشتهما : ( أياد تمتد إليهم بالعطايا، وأياد كسيرة تستقبلها .. تتحاشى نظرات الشفقة والرثاء ) ص 33.
وتتعلق عيونهما بالشاشة، تتابع ماتنقله الكاميرات، وما يقوله المراسلون والمحللون، وفي نبأ عاجل :
( انفجارات عاتية، ركام أسود كثيف يملأ المشهد، يحجب ماوراءه، .. )
يصرخ الصبي :
( -أماه .. أماه .. أليست المئذنة المتهاوية هذه للمسجد القريب من بيتنا؟
نعم هو .. أعرفه ) ص 34.
ومشهد جثة زوجها الغارق في دمه لا تفارق مخيلتها، فكان مطروحا على عتبة ذات المسجد الذي أطلقوا رصاصتهم الغادرة على المصلين، وأردت إحداها زوجها قتيلا.
والزوجة مكلومة بضياع الزوج وضياع الوطن، فما الذي يبقى بعد ضياعهما؟.
يقدم لنا الكاتب المرأة في هذه القصة ( مقاومة )، فالسكوت عن المقاومة في هذه الحالة طريق إلى الجنون!!.
( 5 )
محاولة السيرعلى درب المتصوفة :
لم يكن الطريق معبدا أمام المريد للوصول، فثمة حفر ومطبات، وجُدرا وأسوارا عالية، واجتيازها يحتاج إلى جهاد ومشقة.
ويستهل قصة ( حالة وجد ) ص 15 بالدرويش في حلقة الذكر:
( يتصبب عرقا، يتساقط من وجهه كالمطر، وهو يميل بجذعه يمنة ويسرة في حركة منتظمة تتجاوب مع دقات الدفوف وصوت المنشد : الله حي )
وهذه هي الصورة النمطية للكثرة الذين ينتظمون في حلقات الذكر، ومع اشتداد دقات الدفوف وتسارع صوت المنشد تتسارع وتتلاحق حركاته، حتى يغيب عن كل ما حوله من الموجودات، ويتهاوى على الأرض، وهنا يظهر له الشيخ الوقور صاحب اللحية البيضاء بابتسامته المحببه، يبشره :
(- مبروك يا ولدي .. خطوت خطواتك الأولى )
وبلل شفتيه بماء الإبريق، وناوله كسرة خبز، وقليلا من الملح.
هل يستطيع أن يواصل الطريق؟.
في قصة ( السبيل ) ص 17 تأتي الخطوات التالية والأهم، وعلاقة المريد بالشيخ، والوصول لنهاية الطريق ليس بالأمر السهل الميسور، فيسأل شيخه :
( - ماذا هناك يا مولانا؟
-السؤال واسع بلا انتهاء وعميق بلا ابتداء يا بُني، يلزمه علم كثير كثير .. )
حمل أطنانا من الكُتب والأسفار، وتزهد ناسكا في حضن النخلة، لا يكف عن القراءة والبحث والتقصي والاطلاع، ما ترك شاردة ولا واردة إلا وألم بها، ومضى بعد عام ونيف إلى شيخه يبشره، فيقول شيخه :
( - ما عرفت شيئا .. ما يُغني علمك عن عينيك .. )
فحلم المريد : ( العبور إلى حياة الرغد التي يهفو إليها قلبه، تلك المقيمة خلف الأستار الحاكمة )
فهل يمكن أن يجتاز ذلك البرزخ ويقف على الأسرار، ويصل؟
وهل يمكن ان يحل الله في الموجودات، يحل في شيخ ناسك وزاهد وعابد، ويكون عينه التي يرى بها واذنه التي يسمع بها ويده التي يبطش بها، إنها نظرية الحلول التي قال بها بعض العارفين، ومنهم ابن العربي، وراح يرصد ويتابع ( ذلك المُهاب الذي يسد المجاز ويحكُمُه، يحصي حركاته وسكناته، .. )
عاد لشيخه مبشرا :
( - راقبته – ما غمض لي جفن يا مولانا – يكاد يقتلني العطش، اتوق أن أبلل جفاف حلقي من إبريقك .. )
ويطلب منه الشيخ أن يعود مرة أخرى للتحقق، ويحذره من الغضب، ولكن المريد بعد هذه الرحلة الطويلة والشاقة، امتلأ بالمرارة والقنوط، غُمّ عليه دربه، واحتواه التيه، وتفرقت به السُبل
( 6 )
اغتراب الإنسان المعاصر وتشظيه والتمرد على القصة ( الموبسانيه ) :
التزم الكاتب في أكثر من ثلاثة أرباع قصص المجموعة بالقصة ( الموبسانية ) من خلال محافظته على الحدث، والزمان، والعقدة، ولحظة التنوير.
وتأتي بعض القصص ( ربع المجموعة تقريبا ) متمردة على هذا النموذج، وفي قصته الجديدة المتمردة لا نرى بناء تقليديا، وإنما نرى أنفسنا في مواجهة حدث جاد.
في قصة ( مطاردة ) ص 51 : الرجل الذي انتفخت رأسه، وصعدت حتى قبة السماء، ثم هوت على الأرض، ويواصل الركض خلفها، ويحاول أن يختطفها قبل أن تدهسها سيارة، ولكنها تفلت منه.
= ومن قصة ( حادث دهس ) ص 53 : الرجل الذي يفشل في بيع قلمه العتيق والنادر الذي ورثه أبا عن جد يرى الناس في السوق :
( رواد السوق يسيرون على رءوسهم! فيما تحملق فيه أقدامهم، ترمقه بنظرات ساخرة مستهزأة، تؤازرها قهقهات سكارى صاخبة .. تتعالى تارة، وحين تخفت يعلو نحيب لا يعرف مصدره .. )
لماذا الرأس انفصلت عن صاحبها في قصة ( مطاردة ) ولماذا الناس في قصة ( حادث دهس ) كانوا يسيرون على رءوسهم، وكانت الأقدام هي الأعلى؟
في هذه القصص لا يقدم لنا الكاتب قصص منطقية أو يقدم لنا حدوتة متتابعة الأحداث، إنما يعالج فكرته معالجة فنية متوسلا بالصورة والحدث والمفارقة والتداخل بين الأشياء، وهذا الأسلوب التقدمي في الكتابة اقتضته ظروف معاناة الإنسان المعاصر، وإحساسه بالوحدة والاغتراب، فمن حباه الله مثلا عقلا علميا جبارا لم يعد يجد له مكانا في هذا الزمن، فالمكان والمكانة أصبحت لمن موهبتهم في أقدامهم مثل لاعبي كرة القدم، والقلم رمز العلم لا يجد من يشتريه، بل دهسته الأقدام!!
إنه اغتراب صاحب العقل في وطنه، الذي اختلت منظومة قيمه.
المجتمع اليوم يقدم من موهبته في قدمه ومن موهبته في حنجرته ومن موهبتها في خصرها على العالم والفيلسوف والأديب والشاعر والفنان التشكيلي وغيرهم من الذين يعانون وأصبحوا غرباء في أوطانهم، فالقدم صارت في الأعلى والرأس في الأسفل، وتم دهس القلم بالأقدام!!
= وفي قصة ( حالة تلبس ) ص 22 : فقاعة صابون من الفقاعات التي يلهو بها الأولاد على الشاطئ، تتلبسه، وتصعد به إلى السماء، ويرى عجبا، وينقله لنا عبر الرحلة الغرائبية :
( في كبد السماء تراءت لي الأرض بكامل استدارتها .. تتباعد شيئا فشيئا، وجيوش الظلمة تتقاطر حولي تملأ الفراغ .. )
( انفجار رهيب مفزع ذاك الذي دوّى حين احتكت الفقاعة بنهاية الغلاف، فقذفني إلى فراغ سحيق )
( يختطف بصري جسم ضخم، كأنه جمرة عظيمة يهوي مخترقا نحو الأرض، فأتتبعه .. اصطدام هائل أراه ولا أسمع له صوتا، بدا لي عمودا عملاقا من أحجار وركام – تتخلله أجسام وأشياء لم أتبينها – يتصاعد مخلفا فجوة عميقة مستعرة باللهب، ربما باتساع قارة كبيرة، .. )
( شاهدت أقواما – لا حصر لهم – مجللة بالسواد تتطاير ثم تهوي، ومسوخا مخيفة تلاحقهم .. )
( أتفقد ما حولي من أجرام بكافة الأشكال والألوان والأحجام .. النور والظلام صنوان لا يفترقان هنا .. )
( كل يسبح في مساره بانسياب وهدوء وسلام، إلا هذه المصنوعات البشرية!!، أينما يممت أرى عجبا .. أقمار ومركبات وأجسام غريبة أجهلها، تنفر – فجأة – من مداراتها، وتختفي في غمضة عين .. )
( أُخريات – وبلا مقدمات – تفتك بعضها البعض، فتتناثر حُطاما يسبح في الفراغ .. في مدى بصري أرى مركبات عملاقة – وكأنها ثعبان موسى – تتمدد من بعضها أذرع ضخمة مخيفة، فتلقف ما يعنّ لها، وتسحبه – إلى جوفها – غنيمة .. )
هل محاولة غزو الإنسان للفضاء بصواريخه ومركباته سيكون له الأثر السيء على الكون؟، هل تدخل الإنسان يفسده، ويختل توازنه ونظامه الدقيق؟
القصة تثير العديد من الأسئلة.
وتأتي لغة هذه القصص مكثفة، لا تخضع لقواعد لغة البلاغة التقليدية، ويحاول جادا أن يُدخل قارئه في عالم قصته، ويورطه فيها، ويجعله شريكا معه في انتاج النص، فيترك فضاءت كثيرة وعلى القارئ أن يقوم بملئها، وهذا ما نادى به ( رولان بارت ) وغيره.
هذه النماذج القصصية المتمردة في المجموعة، ترينا أقكار الكاتب التقدمية، ومعالجاته غير التقليدية، فيقوم بتقطيع الحدث، وتفتيته أحيانا، واستعمل الحوار بذكاء، والأهم أنه سعى إلى تحطيم الحدوتة نفسها!.
وليست ( الحدوتة ) وحسب هي التي أخرجها من المتن، فأخرج أيضا ( الحدث، والحبكة، ولحظة التنوير ) وغيرها من مكونات القصة التقليدية.
والكاتب استفاد في هذه القصص من تجارب تيارات الحداثة، فاستطاع أن يمزج الشخص في المكان والزمان، ويشكل من خلال تقاطع هذه الخطوط إضاءة قوية لتجربته القصصية، ووضع قارئه بداخلها، كي يرى ويسمع ويلمس ويشارك ويعيش بالكلية مع النص.. لا أن يقف على الهامش!.
( 7 )
التناص واسترفاد التراث :
يسترفد الكاتب من مصادر التراث العديدة والمتنوعة :
أ – التراث الديني : يبدو تأثر الكاتب بالقرآن الكريم، وتناثرت ألفاظه في ثنايا قصص المجموعة، وتناص معها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر : " ثم ولى ولم يعقب " ص13.، " يتوجس منهم خيفة " ص20، " وكأن على رءوسهم الطير ص 24"، " توقفوا قبل أن يعودوا سيرتهم الأولى " ص36، " قبل أن يعودوا سيرتهم الأولى " ص 37، " أتوارى من القوم " ص 49، " وقد وهن العظم مني " ص54، " يعود سيرته الأولى " ص 54، "، " عادت سيرتها الأولى " ص 56.
= ويأتي عنوان قصة ( قبل الطوفان .. بعد الطوفان ) ص 19 ليثير الأسئلة، فالطوفان دال على ( نوح ) عليه السلام، وهو الأب الثاني للبشرية، والقصة تنبئ في نهايتها بطوفان آخر قادم :
( - لا فائدة .. لا فائدة .. رُدُّني إلى مأمني؟
" تلك كانت آخر صرخاته قبيل أن يغمرهم الطوفان من جديد .. وآخر ما دونت " )
ووازن الكاتب ببراعة بين البشرية في زمنها الأول، حيث كان الإنسان يعيش في الكهوف، والبشرية اليوم التي أصبح ( العلم ) هو دينها الجديد، والبعثة العلمية التي عثرت على كائن بشري يعيش في أحد الكهوف، اختلفوا فيما بينهم حول عمره، وحملوه إلى معاملهم، وبعث هذا الكائن البدائي من جديد، ومجابهته بهذا العصر وعلومه، كان له بالغ الأثر السيء على نفسه، وعلى سلوكه وتصرفاته، فأخضعوه بصرامة، وبلا إنسانية، لأحدث ما وصل إليه العلم من نظريات وتقنيات حديثة، تقيس كل شيء بدقة، إن اتخاذ العلم إلها لهذا العصر، سيكون السبب في قدوم طوفانا أخر!!.
ب – من التراث الفرعوني :
قصة ( أصداءُ البردي ) ص 58 :
يستعيد الكاتب لنا في هذه القصة أسطورة إيزيس وأوزوريس، ليصدمنا بالواقع الآني، والإشارة في نهاية القصة إلى النيل الغاضب والحزين من حفدة إيزيس وأوزوريس!!.
ج– التراث الفني وخاصة الرسم والفن التشكيلي، ففي قصة ( نظرة .. فابتسام .. ) يتماهى الكاتب مع لوحة الموناليزا للفنان العالمي ( ليورنادو دافينشي ) وهي من أشهر اللوحات.
د– توظيف التراث الموسيقي الشعبي في قصة ( الناي و المزمار )، فالناي في يد الشاب ( سالم ) هي الأداة الأنسب للتعبير عن الحزن والشجن، وعذابات الحب ولوعة الفراق، وحرمانه من حبيبته التي زوجها أبوها لغيره، وهذه الأله هي التي امتصت الكثير من أشجانه وأحزانه، وربما كانت بديلا لهذا الشاب القروي عن الانتحار، لفقده ليلاه، وفي المقابل يأتيه مشهد فرح ليلى عبر دقات الدفوف وصوت المزمار، لتعمق جراحه، وأحزانه، وكان الكاتب بارعا في الجمع بين الصوتين صوت الناي وصوت المزمار.
ورمزيتها، فهي قديمة قدم القرية، وشاهدة على تحولاتها، وما أصابها من عطب ومرض أصاب القرية كلها بشرا وحجرا، واستدعاء أهل العلم والخبرة لعلاجها حتى لا يغيبها الزمن وتسقط هي الأخرى من البندول، هي صرخة من الكاتب لإنقاذ الحجر، والبشر الذي أصابه العطب.
..........................................................................
وقدم الدكتور كارم محمود عزيز مقاربة نقدية في المجموعة جاء فيها :
في البدء كان السؤال! ..
إن التناول النقدي الحق بقدر ما يشخص الظواهر الفنية والأسلوبية في العمل المطروح من وجهة نظر الناقد بالطبع، فإنه في نفس الوقت يطرح أسئلة مهمة تخص ظواهر معينة في الكتابة ..
والسؤال هنا مرتبط بـ" الوعاء اللغوي" عند (أحمد عثمان) .. فالملاحظ على لغة السرد عنده؛ تلك " الفخامة والأناقة" في اختيار المفردات المعجمية، وهي ظاهرة كانت محط اهتمام الشعراء (بصفة خاصة) وفي زمن قديم ربما ..
إذن: هل ينبغي على القاص أن يوازن بين ما يطرحه من مضامين وأفكار، وبين درجة ومستوى الوعاء اللغوي الذي يحمل هذه الأفكار والمضامين ..
مثلا: في القصص ذات المنحى "الصوفي" قد نقبل بفخامة لغوية من نوع ما، لكن في القصص ذات المنحى "الشعبي البسيط" ـ مثلا ـ هل يمكن تمثيل القصة بأفكارها بنفس المستوى اللغوي؟!
*** ثم إضاءة سريعة على بعض قصص المجموعة:
(1) [فعل علني]:
قصة بسيطة من ( اليومي المعاش) .. سريعة الإيقاع .. كثيفة الوقائع، قصيرة الجمل غالبًا ـ تخلو من الوصف ـ بما يجانس فكرة القصة وأحداثها .. الدلالة فيها اقتصادية، وبراجماتية في نفس الوقت .. تأسست في أصلها على أهم عناصر القصة القصيرة (في نظري)، وهو عنصر "المفارقة" التي تحمل الألم والسخرية والكوميديا السوداء في النهاية
(2) [نظرة فابتسام]:
لوحة قصصية تبني دلالتها المتراكمة على عنصر (التشويق)، ما يحفز المتلقي بشدة، وغالبًا كانت تأمل في تحقيق صدمة (المفارقة) .. لكن يبدو أن الاهتمام الشديد من الكاتب بكيفية صنع المفارقة؛ جعلها غامضة إلى حد ما ـ باهتة، وربما ما أفسدها هو فكرة (المصادفة)!
(3) [التاي والمزمار]:
أن يتحدانا القاص ويخايلنا بأنه يقدم لنا نوعًا من ( الكتابة في المكتوب)، بما يهددنا بـ"ملل" سوف يصيبنا إن قرأنا قصته هذه، ثم نجد أنفسنا ـ مع ذلك ـ نقبل على القصة بهمة ونقرأها ، ويتحقق لنا شئ من المتعة، فربما يكون هذا تجسيدًا لتعريف "سارتر" للأدب: (الأدب ليس "ماذا نكتب"، بل "كيف نكتب"!)
موضوع القصة عادي جدًا، مألوف .. إلا أن "أحمد عثمان" كان من الذكاء الذي جعله يعتمد تقنية "التقابل/التناظر" حيث إنه (بضدها تتمتيز الأشياء) .. هذه الثنائية القطبية هي ما نفخت روح الجمال في القصة .. الثنائية القطبية تجسدت أولاً في: (المحب المغدور× العروس الغادرة)، وعنها تفرعت ـ بالتبعية ـ عدة ثنائيات أخرى، يكشف عنها بشكل أساسي عملية "التأويل وفك الرمزية": الأسى× البهجة، الفرد× الجماعة، الناي× المزمار، الأنين× الزغاريد، نوبة الغياب× نقرات الدفوف، حركة الداخل (وعي الفتى الذي يمضغه الحزن ببطء)× الحركة الخارجية (الأعيرة، الزغاريد، الأصوات الخشنة، الصخب) .. لكن حبذا لوكان الفتى (المسرود عنه) تكلم بنفسه، ولم يستعن براو ـ لن يمكنه ـ مهما فعلـ التعبير عن عمق التناظر بين الحالتين
(4،5) [حالة وجد]، [السبيل]:
قصتان ـ فيما أرى ـ مرتبطان، الأولى تنشغل بالتصوف "الحركي" ـ في بعده الشعبي، الذي يحفل بقرع الدفوف والإنشاد والترنح ـ كشكل من أشكال "الذكر" بحسب مفهومه الشعبي، وهو ما ذكرني بـ "إدوار وليم لين" عندما تكلم في كتابه (المصريون المحدثون) عن "اكتساب الولاية الشعبية" .. أما القصة الثانية، فتنشغل بالتصوف "المعرفي الفلسفي"، ويعكس ذلك عنوانها "السبيل"( وأتصور أن مصطلح "الطريق" هو أكثر ملاءمة) ..
وأراهما قصة واحدة تمثل مرحلتين من مراحل التصوف، لكنها في النهاية افتقرت إلى عنصر "المفارقة" التي كنت أتوقعها ـ كتقنية ضرورية ..
(6) [حالة تلبس]:
بداية بسيطة في عالم اللهو ولعب الصغار، ونهاية متسقة مع البداية، وما بينهما رؤية كابوسية تعكس عالمًا آخر من المشاهد الغريبة الرهيبة المفزعة .. هذا التحول بين عالمين مفارقين؛ يفرض أسئلة من نوع:
ــ هل هناك مبرر قصصي للدخول إلى العالم الكابوسي؟ ( مثلا مجرد تداعيات أخرى لصورة "الفقاعة"؟)
ـ هل هناك مفاتيح تأويلية لدلالات المشاهد، أم أنها للرعب المجاني؟!
..................................................................
وتوالت المداخلات من الكاتب والناقد العربي عبدالوهاب، والشاعر والمترجم السيد النماس، والمبدعة والقاصة صفاء أبو عجوة، والمهندس مصطفى كامل وغيرهم.
واختتمت الندوة بكلمة لرئيس مجلس الإدارة الشاعر الكبير إبراهيم حامد، وقام بتكريم المحتفى به الكاتب أحمد عثمان.
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

|
حفظ
 |
بحث |
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
| إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
التجربة الإبداعية لفكري داود بمنتدى السرديات باتحاد الكُتّاب
...
-
سردٌ يلامس الروح.. قراءة في رواية -زمن نجوى وهدان- لمجدي جعف
...
-
( السرد الحاوي ) لفرج مجاهد على طاولة النقد بالمركز الدولي ل
...
-
نظرات في شعر حسين علي محمد ( طائر الشعر المسافر )
-
مقاربة نقدية في الرواية الشعرية ( آخر أخبار الجنة ) لحزين عم
...
-
مقاربة نقدية
-
وداعا لآلام مرضى كسور الضلوع
المزيد.....
-
-خروج آمن- و-لمن يجرؤ- يشاركان في مهرجان برلين السينمائي
-
روسيا: الرواية الأمريكية حول تشكيل موسكو تهديدا على غرينلاند
...
-
الممثل الأميركي ويل سميث يزور أهرامات الجيزة في مصر
-
-الذكاء الاصطناعي.. ببساطة-: دليل جديد لهيلدا معلوف ملكي يفك
...
-
كضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب: رومانيا تستعرض تراثها ا
...
-
هل يقود العدوان على غزة لتعليق مشاركة إسرائيل في بينالي فيني
...
-
عقدان من تدريس الأمازيغية.. ماذا يحول دون تعميم تدريس لغة ال
...
-
-أوبن إيه آي- تطلق نسخة مخصصة للترجمة من -شات جي بي تي-
-
العمدة الشاعر الإنسان
-
إيران في مرآة السينما: كيف تُصوّر الأفلام مجتمعا تحت الحصار؟
...
المزيد.....
-
دراسة تفكيك العوالم الدرامية في ثلاثية نواف يونس
/ السيد حافظ
-
مراجعات (الحياة الساكنة المحتضرة في أعمال لورانس داريل: تساؤ
...
/ عبدالرؤوف بطيخ
-
ليلة الخميس. مسرحية. السيد حافظ
/ السيد حافظ
-
زعموا أن
/ كمال التاغوتي
-
خرائط العراقيين الغريبة
/ ملهم الملائكة
-
مقال (حياة غويا وعصره ) بقلم آلان وودز.مجلةدفاعاعن الماركسية
...
/ عبدالرؤوف بطيخ
-
يوميات رجل لا ينكسر رواية شعرية مكثفة. السيد حافظ- الجزء ال
...
/ السيد حافظ
-
ركن هادئ للبنفسج
/ د. خالد زغريت
-
حــوار السيد حافظ مع الذكاء الاصطناعي. الجزء الثاني
/ السيد حافظ
-
رواية "سفر الأمهات الثلاث"
/ رانية مرجية
المزيد.....
|
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

 |
بحث
|
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
|
إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة