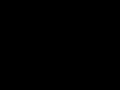|
|
إشتراكية القرن الحادي والعشرين: إستخلاص الدروس... وإحلال ديمقراطية الشعب مكان -ديمقراطية الأثرياء-
داود تلحمي


الحوار المتمدن-العدد: 3111 - 2010 / 8 / 31 - 21:05
المحور:
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
أسئلة كبيرة تقفز الى الذهن في التعاطي مع الخيار اليساري الجذري، أي خيار تجاوز النظام الرأسمالي، في هذا القرن الجديد: كيف سيجري تجاوز النظام السائد حالياً بعد الإحباطات الناجمة عن انهيارعدد غير قليل من تجارب التحول الإشتراكي في القرن العشرين، وخاصة التجربة الأولى والأكبر، تجربة الإتحاد السوفييتي؟ ماذا ستكون عليه ملامح عملية التحول نحو تجاوز النظام الرأسمالي في هذا القرن، أي عملية التحول نحو المجتمع الإشتراكي، بسماته المتميزة بالضرورة عن التجارب السابقة؟ وهل تفتح الأزمة الإقتصادية العميقة الراهنة للنظام الرأسمالي العالمي على إمكانية حدوث مثل هذه التحولات في أمد قريب؟
أولاً، ما ينبغي التأكيد عليه بكل وضوح مجدداً هو أن أية تجارب تحول إشتراكي في القرن الجديد ستكون، بالضرورة، مختلفة في جوانب عدة عن تجارب القرن الماضي، وبمعزل عن تقييمنا لتلك التجارب ومدى تأثيرها على أحداث وتطورات القرن العشرين بمجمله، وهو تأثير كبير بكل المعايير. وقد سبق وتناولنا في كتابات سابقة إيجابيات وسلبيات تجارب التحول الإشتراكي السابقة، وخاصة التجربة السوفييتية، التي تبقى، مهما انتهت اليه، حدثاً بالغ الأهمية في القرن الماضي، ترك بصمات قوية على تاريخ العالم كله في مجالات عدة، ليس هنا المجال للعودة للحديث عنها. ولكن ما حدث قبل زهاء القرن من الزمن لا يمكن أن يتكرر بالشكل ذاته في عصرنا الحالي، لأسباب عديدة، أولها التطور الهائل الذي حدث في العالم خلال هذا القرن على كل صعيد، وثانيها أن أية تجربة جديدة ينبغي أن تنطلق من التدقيق في الثغرات والنواقص والأخطاء، وهي كلمات ربما تكون مخففة، التي أدت الى انهيار التجارب السابقة. أي ان الإشتراكية الجديدة ينبغي أن تكون ذات سمات مختلفة عن تجارب القرن الماضي تستخلص دروس هذه التجارب التي انهارت، وتحديداً في مجال التعامل مع مركزية دور الإنسان في عملية التحول الإشتراكي، وليس الدولة أو عملية الإنتاج.
فالإشتراكية ليست فقط الملكية العامة لوسائل الإنتاج، التي كانت في التجارب السابقة، في واقع الحال، ملكية الدولة، التي غالباً ما كانت شديدة المركزية. والإشتراكية ليست فقط تحسيناً في توزيع الخيرات المنتجة على المواطنين، وسعياً الى تقارب أو شبه مساواة بين مستويات معيشتهم. هذا التأكيد هو المدخل الأول والأهم في مراجعة التجارب السابقة. فهناك جوانب أخرى للتحول الإشتراكي لا تقل أهمية، وهي، بالضرورة، من بين العناصر الأساسية لأية تجربة تحوّل جديدة بعد زهاء القرن على ثورة أكتوبر في روسيا في أواخر العام 1917.
هناك دور الإنسان - المنتج في المجتمع وفي عملية الإنتاج، ومشاركته الضرورية في القرار الخاص بهذه العملية، سواء في مكان إنتاجه أو على صعيد مجمل عملية الإنتاج في البلد المعني، كما مشاركته في مجمل الشأن العام، أي القرارات السياسية والإجتماعية-الإقتصادية، التي كان المواطنون في تجارب الماضي غالباً مغيبين عنها، وكان مركز القرار العام هو قيادة الحزب الحاكم والدولة، ومراكز قرار الإنتاج التطبيقي في المصانع والمزارع والمنشآت المختلفة هي غالباً المدراء المشرفين على كل منها، مع رأي استشاري، غالباً ما كان محدود التأثير، في بعض الحالات والتجارب، للعمال أو المنتجين في الموقع المعني.
الإنسان، وليست الدولة أو عملية الإنتاج، في مركز عملية البناء الإشتراكي
وكما يُورد عدد من المحللين وعلماء الإقتصاد والإجتماع والسياسة الماركسيين المتابعين لهذه القضايا في كتاباتهم خلال السنوات الأخيرة، فإن القضية المركزية في مرحلة الإشتراكية لا يمكن أن تكون مقتصرة على التنافس مع النظام الرأسمالي في الإنتاجية أو تطوير القوى المنتجة والإقتصاد بشكل عام، ولا على توفير ما كان يسمّى بـ"الديمقراطية الإجتماعية"، أي الحق في العمل والضمانات المتعلقة بالتعليم وبالصحة وبالسكن اللائق ورعاية الطفولة والأمومة وضمانات الشيخوخة وغير ذلك من الضمانات الإجتماعية، على أهمية هذه الحقوق والضمانات وضرورتها. فالقضية المركزية المهمة، في رأي هؤلاء المحللين أو العلماء، هي قضية "التنمية الإنسانية"، أي توفير إمكانية إزدهار شخصية وطاقات كل فرد في المجتمع بأقصى ما هو ممكن، بحيث تتوفر له فرصة العطاء بدون قيود أو حدود، فيكون المجتمع الإشتراكي بذلك هو مجتمع "المنتجين الأحرار"، وتتوفر لدى كل مواطن فيه إمكانية تطوير ذاته وتقديم أقصى ما يستطيع للمجتمع وكذلك تأمين احتياجاته الخاصة، ليس فقط المادية، وإنما أيضاً المعنوية و"الروحية"، إذا جاز التعبير. وهذه الفكرة واردة في كتابات كارل ماركس الرئيسية، بما في ذلك في "بيان الحزب الشيوعي" الذي أعده ونشره في العام 1848 مع رفيق دربه فريدريش إنغلز، حيث ورد في ما ورد فيه ان "التنمية الحرة لكل فرد هي شرط التنمية الحرة للجميع".
والفكرة واردة أيضاً في المخطوطة الواسعة المعروفة بالكلمة الأولى لعنوانها باللغة الألمانية "غروندريسّه"، التي كتبها ماركس بين العامين 1857 و1861 كمشروع أولي لبلورة أفكاره حول آليات عمل وخصائص النظام الرأسمالي، وهي مخطوطة جُمعت ونُشرت بعد عدة عقود من وفاته. وتضمنت الـ"غروندريسِّه" الأفكار الرئيسية لمشروعه الكبير، الذي بدأ في التبلور بصدور كتاب مكثف بعنوان "مساهمة في نقد الإقتصاد السياسي" في العام 1859، والأهم بإصدار الجزء الأول من القسم الأول من كتابه الأهم "رأس المال" في العام 1867. ومعروف أن أجزاء أخرى من هذا القسم نُشرت بعد وفاته إعتماداً على المخطوطات التي تركها، إلا ان ماركس كان يخطط لكتابة ستة أقسام حول الجوانب المختلفة لموضوعه، أي رأس المال ونظامه. ومعروف أن الـ"غروندريسّه"، فلم تُنشر إلا في أواسط القرن العشرين، في حوالي تسعمئة صفحة، واكتسبت أهمية خاصة باعتبار أنها تحيط بأفكاره الأوسع حول هذا الموضوع، الذي لم يتمكن من استكمال صياغته خلال حياته.
وكما ذكرنا في مقال سابق، فإن التشخيص التفصيلي الذي قدمه ماركس لآليات عمل النظام الرأسمالي وتناقضاته وأزماته الحتمية المتلاحقة هو تشخيص ما زال يحتفظ بقيمته حتى اليوم، لكون النظام الرأسمالي ما زال، بسماته الرئيسية، هو النظام السائد في العالم. ويشهد على أهمية تحليلات ماركس لهذا النظام تزايد الإهتمام بكتاباته هذه، وليس فقط من قبل الأوساط اليسارية الجذرية، إنما من جمهور أوسع، وحتى من بعض الإقتصاديين غير اليساريين، خاصةً بعد اندلاع الأزمة الإقتصادية الكبرى في العامين 2007-2008، وهي الأزمة التي لم يتمكن النظام الرأسمالي من تجاوزها حتى الآن.
وكما هو معروف، فإن ماركس، الداعي الى عدم الإكتفاء بتفسير التاريخ بل الى العمل على تغييره، وضع تناقضات النظام الرأسمالي الكبيرة، وغير القابلة للحل المستدام في إطارالنظام نفسه، في سياق رؤيته لضرورة تجاوز هذا النظام واستبداله بنظام جديد خالٍ من استغلال أقلية من البشر لجهد الأغلبية، وهو النظام الذي يُعرف باسم النظام الإشتراكي، أو مرحلة التحول الإشتراكي. وبطبيعة الحال، فإن التغيير الأساسي في عملية التحول هذه تتجسد في انتقال زمام القرار والأمور من أقلية صغيرة تسيطر على كل الثروات والقرارات والمصائر في النظام الرأسمالي الى الأغلبية الكبيرة من المجتمع، أولئك الذين ينتجون في شتى المجالات بجهدهم، وليس بمجرد إستثمار أموالهم أو باستخدام سطوتهم السلطوية والمالية. ومن هنا، فإن هذا النظام الجديد سيكون، بالضرورة، أكثر ديمقراطية من أكثر الأنظمة البورجوازية ديمقراطية، كما قال فلاديمير لينين في كتابه الشهير "الدولة والثورة" الذي صدر خلال صيف العام 1917 بين ثورة شباط/فبراير من العام ذاته في روسيا القيصرية وثورة أكتوبر الشهيرة اللاحقة التي كان لينين أبرز قادتها. وأكد لينين في كتابه هذا أن "الديمقراطية في المجتمع الرأسمالي... هي ديمقراطية لأقلية صغيرة، ديمقراطية للأثرياء"، بينما تقوم الثورة الإشتراكية بتوسعة الديمقراطية لتصبح "ديمقراطية الفقراء، ديمقراطية للقطاعات الشعبية"، حسب تعبيره.
وهنا ينبغي قول كلمات قليلة حول مفهوم "ديكتاتورية البروليتاريا"، الذي يحدث التباساً لدى بعض الناس، حيث يُقرن مرحلة التحول الإشتراكي بضرورة وجود نظام قمعي بوليسي، وهو المفهوم المتداول عادة لكلمة "ديكتاتورية". والواقع، وهو ما أوضحه لينين في كتابه ذاته، ان الفكر الماركسي يعتبر أن كل دولة هي، بالضرورة، ديكتاتورية طبقة أو تحالف طبقي، وأن كل الدول التي كانت قائمة منذ آلاف السنوات وحتى نشوء النظام الإشتراكي هي ديكتاتورية أقلية نافذة على أغلبية المواطنين، سواء أكانوا العبيد أو الأقنان أو العمال والشغيلة في النظام الرأسمالي. وبالتالي، فإن الديمقراطية والحرية الكاملتين لا تتحققان إلا بزوال الدولة، وهي عملية طويلة الأمد، حتى بعد بدء عملية التحول الإشتراكي، التي يُفترض أن تبدأ فيها عملية "الذبول" التدريجي للدولة، والتي تتحقق خلالها أوسع ديمقراطية للغالبية الساحقة من الشعب، لأول مرة في التاريخ، الى أن تنتهي عملية التحول الطويلة نسبياً هذه بزوال الدولة، إيذاناً بتحقيق الحرية الكاملة.
ولكن كل ذلك هو الآن في مجال الغيب والمستقبل غير المرئي، والذي لا يمكن التنبؤ به. المهم التأكيد أن مرحلة التحول الإشتراكي ليست أبداً، ولا ينبغي أن تكون، مرحلة قمع يُمارس على الشعب أو غالبيته، وإن كانت هناك تحديات خارجية، وداخلية بحدود معينة، تتطلب إجراءات دفاعية عن التجربة، دون المساس بالحقوق والحريات الديمقراطية للغالبية المنتجة من الشعب خلال هذه المرحلة.
ديمقراطية "شعبية تشاركية"، بديلاً عن ديمقراطية الأثرياء والأقلية النافذة
وبما اننا لن نعود هنا الى تناول السياقات التاريخية التي جعلت التجربة السوفييتية، وغيرها من التجارب الشبيهة، تفتقر الى ذلك الجانب الذي تحدث عنه لينين في كتابه المشار إليه أعلاه، حيث سبق وتناولناها في كتابات أخرى، من المهم التأكيد هنا أن تجارب التحول الإشتراكي الجديدة المحتملة في هذا القرن الجديد وفي أي مستقبل، قريب أو أقل قرباً، ينبغي أن تركّز على هذا الجانب، أي على جانب تحقيق الديمقراطية الشعبية الحقيقية بكل أبعادها، السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والفكرية.
وهي ديمقراطية مختلفة، بالضرورة، عما تجري ممارسته في بلدان النظام الرأسمالي، بالرغم من أن جوانب هامة من هامش الحريات الديمقراطية في هذه البلدان تم انتزاعه بفعل نضالات القطاعات الشعبية والفئات المستنيرة طوال قرون طويلة من الصراعات، الدموية أحياناً. دون أن نغفل أن هذه الحريات الديمقراطية في البلدان الرأسمالية تبقى معرّضةً باستمرار للنهش والإنتقاص والإفراغ من مضمونها من قبل الشرائح الحاكمة والمسيطرة في هذه البلدان، بحيث تصبح هذه الحريات الديمقراطية شكلية الى حد كبير في عدة مجالات. وسنتناول في ما يلي بعض النماذج التوضيحية.
لنأخذ، مثلاً، عمليات الإنتخاب للهيئات التشريعية والتنفيذية في الولايات المتحدة، كبرى الدول الرأسمالية التي تفاخر بـ"ديمقراطيتها" المتميزة، وتقوم حتى بشن حروب في أنحاء العالم تحت راية هذه الديمقراطية أو بحجة نشرها وتعميمها. وهو إدعاء أيديولوجي، طبعاً، يغطي حقيقة الأهداف الإستراتيجية والإقتصادية لهذه الحروب، التي تستهدف عادة خدمة مصالح الكتل الرأسمالية الكبرى المسيطرة داخل الولايات المتحدة نفسها. ومعروف أن عدة مناطق في العالم شهدت خلال العقدين الأخيرين، بما فيها منطقتنا العربية - الشرق متوسطية، حروباً من هذا النوع استهدفت بشكل رئيسي تأمين السيطرة الأميركية المباشرة على مصادر الطاقة الهامة في المنطقة، وخاصة المنطقة الخليجية، والمقصود طبعاً النفط والغاز الطبيعي، كما استهدفت استباق تنامي قوى عالمية منافسة للولايات المتحدة على أي صعيد، إقتصادي أو عسكري استراتيجي.
وقد عبّرت عن هذا التوجه بوضوح عدة وثائق أميركية باتت الآن معروفة، وإحدى أبرزها تلك الوثيقة الشهيرة التي تسرّبت من وزارة الدفاع الأميركية ونُشرت بنسختها الأولى الفجة في إحدى الصحف الأميركية الرئيسية في 7/3/1992، وتضمنت رؤية استراتيجية مستقبلية للسياسات العسكرية - الإستراتيجية الأميركية تركّز على الحفاظ على التفرد الأميركي بالهيمنة الكونية ومنع نشوء قوى منافسة للولايات المتحدة. وهذه الوثيقة معروفة الآن باسم "عقيدة وولفوويتز"، على اسم المشرف الرئيسي على إعدادها، بول وولفوويتز الشهير، الذي كان آنذاك مساعد وزير الدفاع لشؤون السياسات في إدارة جورج بوش الأب، وأصبح لاحقاً في إدارة جورج بوش الإبن نائباً لوزير الدفاع، بين مطلع العام 2001 وأواسط العام 2005، وهي الفترة التي شهدت بدء الحربين الأميركيتين على أفغانستان والعراق.
ولنعد الى العمليات الإنتخابية في الولايات المتحدة: معروف أن الولايات المتحدة تشهد، كل عامين، تجديد انتخاب كافة أعضاء مجلس النواب وحوالي ثلث أعضاء مجلس الشيوخ وعدد من حكام الولايات والهيئات الإقليمية والمحلية فيها، وكل أربعة أعوام، تشهد عملية انتخاب أو تجديد انتخاب رئيس الدولة الإتحادية، والتجديد هو لمرة واحدة فقط وفق الدستور الأميركي. لكن هذه الديمقراطية بالتمثيل، أي عبر انتخاب ممثلين عن الناخبين، تعتورها مشكلات كبيرة: فالعنصر الحاسم في غالب الحالات في العمليات الإنتخابية هو التمويل، الذي يمكّن المرشح من أن يقوم بحملة دعاوية واسعة، سواء في تجمعات يشارك فيها مباشرة، أو عبر وسائل الإعلام والدعاية، المكتوبة والمسموعة، والأهم المرئية- المسموعة، وخاصة شبكات التلفزيون، الى جانب شبكة الإنترنت في العقدين الأخيرين. وممولو الحملات الإنتخابية يلعبون، بالتالي، دوراً مهماً في إنجاح أو إفشال أي مرشح، عبر حجب الأموال عنه في الحالة الأخيرة. والممولون هم، في الغالب، مرتبطون بمؤسسات إقتصادية أو كتل مصالح كبرى، تعبّر عن نفسها أحياناً بشكل "كتلة ضغط"، أو "لوبي"، كما تسمّى هناك، وبعضها يعمل من خلال ما يسمّى "لجان العمل السياسي" التي نما دورها بعد فضيحة ووترغيت واستقالة الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون في العام 1974، وهي لجان تتيح للأفراد التكتل لتقديم الدعم للمرشحين.
ويتزايد، عاماً بعد عام، حجم الأموال التي تنفقها كتل الضغط للتأثير على العمليات الإنتخابية أو دفع التصويت لصالح قضايا أو ضد قضايا أخرى في مجلسي النواب والشيوخ. ففي حين بلغ حجم الأموال التي أنفقتها كتل الضغط المختلفة في العام 1998 أقل قليلاُ من مليار ونصف المليار دولار، وصل هذا الرقم الى ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار في العام 2009، بالرغم من الأزمة المالية والإقتصادية، التي انفجرت في الأساس في الولايات المتحدة نفسها قبل ذلك العام بأشهر قليلة. وقائمة كبار الممولين للحملات الإنتخابية ولعمليات الضغط على النواب والشيوخ المنتخبين تضم كبرى الشركات والمؤسسات في الولايات المتحدة في شتى مجالات المال والصناعة والإنتاج والخدمات، وأسماؤها وأرقام تمويلها موجودة على بعض المواقع المتخصصة بتعقب التمويل وكتل الضغط على شبكة الإنترنت.
وتُظهر بعض مواقع الإنترنت الأميركية في ما تُظهر أن 66 بالمئة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي حالياً، أي قبل انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر من العام الحالي 2010، هم من أصحاب الملايين، وأكثرهم ثراء هو هيرب كول، العضو في الحزب الديمقراطي، حزب الرئيس الحالي أوباما. في حين هناك 240 مليونيراً في مجلس النواب الذي يضم 435 عضواً، أي ان أكثر من نصف أعضائه هم من أصحاب ثروة لا تقل عن المليون دولار. وهو ما يعني أن الفئات الشعبية الواسعة، وكذلك الطبقة المتوسطة، وفق التعبير المستعمل هناك، غائبة أو محدودة الحضور في الهيئات التشريعية الأميركية، التي هي مسيطر عليها بشكل واسع من قبل الأثرياء.
وبذلك يبدو واضحاً أن الناخبين الذين تستهدف الحملات الإنتخابية في وسائل الإعلام كسب أصواتهم ليسوا، في النهاية، سوى منصات صعود للنواب والشيوخ، الذين يعمل غالبيتهم بعد انتخابهم، باستثناءات قليلة، لتلبية رغبات مموليهم أكثر من مصالح أولئك الذين انتخبوهم. ومن هنا نفهم ظاهرة الإستنكاف المتزايد من قبل قطاعات واسعة من المواطنين الأميركيين عن المشاركة في عمليات الإقتراع خلال العقود الأخيرة.
ففي حين كانت نسبة المقترعين فعلياً لمجمل أصحاب الحق في الإقتراع في الإنتخابات الرئاسية في العام 1960 أقل قليلاً من 63 بالمئة من أصحاب حق الإقتراع، لم تكفّ هذه النسبة عن التراجع منذ ذلك العام. وكانت هذه النسبة في العام 1996، مثلاً، أقل من 50 بالمئة. هذا، فيما تشهد الإنتخابات النيابية إقبالاً أقل من الناخبين. حيث كانت نسبة المشاركين في غالب الحالات في العقود الماضية أقل من النصف من أصحاب حق الإقتراع، وأحياناً أقل من الثلث، وهو ما كان عليه الحال، مثلاً، في العام 1990، حين كانت النسبة بالكاد أكثر قليلاً من 33 بالمئة ولكن أقل من الثلث، وفي العام 1998 كانت حتى أقل من 33 بالمئة. وتتزايد نسبة المشاركة في الإنتخابات الرئاسية في الحالات التي تبدو فيها هناك فروقات واضحة بين المرشحين الرئيسيين أو هناك أوضاع استثنائية تتطلب تغييراً معيناً، وهو ما كان عليه الحال في الإنتخابات الأخيرة في العام 2008، حيث بلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات الرئاسية 62 بالمئة.
لكن هذه النسبة ليست بالتأكيد ثابتة، خاصة وأن رهانات بعض الأوساط الشابة وتلك المتطلعة لتغيير حقيقي في أوضاع البلد، وهو التغيير الذي كان عنوان حملة باراك أوباما الإنتخابية، هذه الرهانات تبدو الآن وكأنها "ذهبت مع الريح"، وفق العنوان المعروف لإحدى الروايات والأفلام التاريخية الأميركية الشهيرة. ومعروف أن شعار أوباما الرئيسي خلال حملته كان"يِس، وِي كانْ"، أي "نعم، نحن نستطيع"، أي نستطيع التغيير. لكن التغيير المأمول لا يبدو مرئياً كثيراً حتى الآن في أي مجال، حيث لم يُحدث أوباما أية إنعطافات كبيرة في سياسات سلفه الجمهوري. وهو ما جعل الكاتب اليساري الباكستاني المولد البريطاني الإقامة والجنسية، طارق علي، ينشر مقالاً مطولاً عن هذه الإدارة ورئيسها في العدد الأول لهذا العام 2010 من مجلة "نيو ليفت ريفيو" اليسارية اللندنية، التي يشارك في هيئة تحريرها، تحت عنوان "بريزيدانت أوف كانت"، أي "رئيس الـ-لا نستطيع-"!
وجدير بالإشارة، في سياق الحديث عن تمويل الحملات الإنتخابية، أن محكمة العدل العليا في الولايات المتحدة، وهي أعلى هيئة قضائية هناك، أصدرت في الشهر الأول من العام الحالي 2010 حكماً يفسح مجالاً أوسع للشركات الكبرى لتمويل الحملات الإنتخابية، وهو قرار يعزّز، بطبيعة الحال، دور كبار الأثرياء والشركات الكبرى، ويضع علامات استفهام متزايدة حول المضمون الفعلي لـ"ديمقراطية" العمليات الإنتخابية في هذا البلد. وهو قرار عجيب يتناقض حتى مع التقاليد المتبعة في عدد من الدول الأوروبية الغربية، الى درجة أنه استفز حتى الرئيس الحالي باراك أوباما، الذي انتقده علناً، بما في ذلك في خطابه السنوي حول حالة الأمة أمام الكونغرس يوم 27/1/2010. حيث قال في هذا الخطاب ان هذا القرار هو "انتصار كبير لشركات النفط الكبرى، وبنوك وول ستريت... ومراكز نفوذ ومصالح أخرى"، في محاولة منه لإعادة استمالة الشركات والمشاريع الأصغر والفئات الوسطى من المجتمع ولاستنهاض القطاعات المستنكفة عن المشاركة في الإقتراع والمنتمية بالأساس للفئات الشعبية المتضررة من الأزمة الإقتصادية وتزايد نسبة البطالة في صفوفها، ومن سياسات الإدارات المتعاقبة الإقتصادية والإجتماعية، وهي قطاعات يعتمد الحزب الديمقراطي على أصوات قسم مهم منها.
هذا مع العلم بأن كلا الحزبين الرئيسيين، الديمقراطي والجمهوري على حد سواء، يتلقيان الدعم من المؤسسات والشركات الكبرى. إلا ان أغناها تميل عادةً لصالح الحزب الجمهوري، الذي يمكن اعتباره أكثر يمينية من الحزب الديمقراطي، الذي ليس، بالطبع، حزباً يسارياً، ولا حتى في موقع يسار الوسط، وفق التصنيف الرائج في دول أخرى.
وبعض الشركات الأميركية الكبرى يحتاط للمستقبل، فيتبرع لكلا الحزبين الرئيسيين في الإنتخابات: فبين العام 1989 والعام 2010، قدّمت مجموعة غولدمان ساكس العاملة في مجال الإستثمار والخدمات المصرفية والمالية، والتي جاءت في المرتبة الخامسة بين مجمل المتبرعين من حيث حجم المساهمة في هذا "التمويل السياسي"، 62 بالمئة من "تبرعاتها" الإجمالية خلال هذه الفترة للحزب الديمقراطي و36 بالمئة للحزب الجمهوري. وهو ما يمكن أن يفسّر حجم المساعدات الرسمية التي تلقاها هذا البنك في كلا العامين 2008 و2009، أي في عهدي بوش وأوباما على حد سواء، لدعم وضعه المالي خلال الأزمة الإقتصادية. هذا في حين تميل شركات النفط الكبرى لتفضيل الحزب الجمهوري، حيث موّلت شركة تشيفرون خلال الفترة الزمنية ذاتها هذا الحزب بنسبة 75 بالمئة مقابل 24 بالمئة للحزب الديمقراطي، في حين وصل حجم تبرع شركة إكسسون موبيل، الشركة النفطية الأكبر والأغنى في العالم، الى نسبة 85 بالمئة لصالح الحزب الجمهوري مقابل 14 بالمئة فقط للحزب الديمقراطي. والشركتان المذكورتان هما من بين أكبر أربع شركات عالمية تعمل في مجالي النفط والغاز، مع شركتي "شل" الهولندية - البريطانية و"بريتيش بتروليوم" البريطانية. والأخيرة ربما تكون مهددة بتراجع مكانتها بعد خسائرها الكبيرة في قضية التسرب النفطي الأخيرة في خليج المكسيك بالقرب من الشواطئ الأميركية الجنوبية.
كل هذه الشركات والعديد غيرها، مثل شركات صناعة السلاح والطيران والمصارف والمؤسسات المالية وغيرها، تؤثر بشكل حاسم على قرارات أعضاء الكونغرس، كما، بالطبع، على قرارات الرئيس، الذي يعتمد هو أيضاً على تمويل حملاته الإنتخابية، بما في ذلك، حملته القادمة المتوقعة لإعادة انتخابه في العام 2012، والتي لا بد أنه يفكر فيه من الآن. ومن هنا نفهم غضبه على قرار محكمة العدل العليا بشأن توسيع تمويل الشركات الكبرى للحملات الإنتخابية، حيث من المتوقع أن يصب هذا القرار لصالح الجمهوريين أكثر من الديمقراطيين، بالرغم مما رأيناه من تمويل مؤسسات مالية كبرى للحزب الديمقراطي.
وفي ما يتعلق بقضايا منطقتنا، رأينا في العقود الماضية بصورة واضحة كيف تمكن اللوبي الموالي لإسرائيل، والمعروف بالأحرف الأولى لاسمه "إيباك"، من إفشال مرشحين معينين للإنتخابات في الولايات المتحدة على أرضية مواقفهم المنتقدة لإسرائيل أو المعارضة لبعض سياساتها أو المتعاطفة مع حقوق الشعب الفلسطيني ومجمل الحقوق العربية، أو حتى الحيادية في الصراع العربي – الإسرائيلي. مع العلم بأن الأعوام القليلة الماضية شهدت تزايداً ملحوظاً في الأدبيات المنتقدة لدور هذا اللوبي وتأثيره على القرار السياسي الأميركي بشأن قضايا الشرق الأوسط، بما في ذلك بشأن المواقف من العراق وإيران ومجمل قضايا المنطقة. ونشير هنا، من بين هذه الأدبيات الجديدة، الى الكتاب الشهير للأستاذين الجامعيين جون ميرشايمر وستيفن والت حول "اللوبي الإسرائيلي وسياسة الولايات المتحدة الخارجية"، الذي صدر في العام 2007، بعد أن نشرا مقالاً مطولاً حول الموضوع ذاته في مجلة "لندن ريفيو أوف بوكس" قبل ذلك بعام واحد. وهذان الأستاذان لا يمكن تصنيفهما في خانة اليسار الأميركي المناهض للإمبريالية، على غرار أناس مثل عالم الألسنيات الشهير نوام تشومسكي. ولكن مجمل هذه الأصوات النقدية للسياسات الأميركية المنحازة لإسرائيل، رغم تناميها، لم تصل بعد الى حد تشكيل منافسة جدية للوبي الإسرائيلي، ولكنها مؤشر على بدايات تغيير يمكن أن يتطور في المستقبل.
وهناك، الى جانب اللوبي الموالي لإسرائيل، "لوبيات" أخرى ناشطة ومؤثرة في أروقة مراكز القرار في واشنطن، من بين أهمها لوبي الدفاع عن حرية شراء السلاح، وهو يميل عادةً لتمويل الحزب الجمهوري بنسبة عالية. وخلف العديد من هذه اللوبيات، هناك كتل وشركات ومصالح إقتصادية كبرى، وهي تقوم بتمويل مباشر أو عبر قنوات متعددة لعدد كبير من المرشحين. وهكذا يكون تأثير هذه الشركات على الممثلين المنتخبين، الشيوخ والنواب والرئيس وحكام الولايات وهيئاتها الإقليمية، أضعاف أضعاف تأثير الناخبين العاديين، الذين، كما سبق وأشرنا، يتحولون الى مجرد واجهة "ديمقراطية" شكلية لنظام هو في الواقع ديمقراطية للأثرياء بالدرجة الأولى.
وهكذا إذاً، يعتمد الحزبان الكبيران في الولايات المتحدة كلاهما على دعم الشركات الكبرى، ويدافعان عن مصالح هذه الكتل أو تلك. وهناك فروقات محدودة بين سياسات الحزبين، بالتالي، الداخلية والخارجية على حد سواء، مع الأخذ بعين الإعتبار أن الحزب الديمقراطي يجذب بعض الأقليات العرقية والقومية والإثنية أكثر من الجمهوري، مثل الأفارقة الأميركيين والى حد ما مهاجري أميركا اللاتينية، الى جانب بعض الأوساط الليبرالية، بالمعنى السياسي للكلمة، ولكنه يبقى حزباً يمثل، بالدرجة الأولى، مصالح الشركات الكبرى، مع ميل لحضور محدود لبعض الحالات التي يمكن أن تُحسب على اليسار أو يسار الوسط في صفوفه، مثل عضو مجلس النواب والمرشح السابق، قليل الحظ والأصوات، لترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة، دينيس كوسينيتش. هذا في حين يزداد ميل الحزب الجمهوري لتمثيل اليمين واليمين المتطرف، بما في ذلك التيار المسيحي الرجعي الموالي لإسرائيل، والتيار اليميني المتطرف الجديد الذي يُطلق على نفسه اسم "حفلة الشاي".
ومن المعروف أن غالبية الأميركيين اليهود يصوتون عادةً للحزب الديمقراطي، بسبب نزعة "ليبرالية" سياسية غالبة لدى قسم كبير منهم في العديد من القضايا، ما عدا قضية إسرائيل بالنسبة لغالبيتهم العظمى. لكن بعض الممثلين المنتخبين من الأميركيين اليهود يمثّل الجناح اليميني في الحزب الديمقراطي، كما هو حال عضو مجلس الشيوخ والمرشح السابق لنيابة الرئاسة في العام 2000، جوزيف، أو جو، ليبرمان. وفي بعض الحالات، خاصة عندما يبدي المرشح الجمهوري للرئاسة ولاءً مبالغاً فيه لإسرائيل ومصالحها وسياساتها، تزداد نسبة الأميركيين اليهود المصوتين للحزب الجمهوري، وهو ما حصل مع الرئيسين السابقين رونالد ريغن في الثمانينيات الماضية وجورج بوش الإبن في مطلع القرن الجديد. ولكن غالبية الأميركيين اليهود بقيت تصوت للحزب الديمقراطي، بما في ذلك في العام 2008، عام انتخاب باراك أوباما.
ونستذكر هنا الجدل الذي جرى في الإدارة الأميركية في العام 1948 عشية إعلان الحركة الصهيونية في فلسطين عن قيام دولة إسرائيل، حيث عارض وزير الخارجية، آنذاك، جورج مارشال، بحدة إعتراف الولايات المتحدة السريع بالدولة الصهيونية معبّراً عن مخاوفه من الإنعكاسات السلبية المحتملة لقرار كهذا على المصالح الأميركية المتزايدة في البلدان العربية، في حين أصرّ الرئيس، آنذاك، هاري ترومان، وهو من الحزب الديمقراطي، على الإعتراف السريع بدولة إسرائيل، قائلاً بأن لديه ناخبين يهود في الإنتخابات الرئاسية القريبة المقررة بعد ذلك بأقل من ستة أشهر، ولكن ليس لديه ناخبون عرب! طبعاً، هناك اعتبارات وحسابات أخرى لهذا الخيار الأميركي، ليس هنا المجال للخوض فيها.
هل باتت "السلطة الرابعة" في البلدان الرأسمالية في قبضة الكتل المالية؟
ومن المفيد في هذا المجال الحديث أيضاً عن مآل الصحافة ووسائل الإعلام الكبرى في البلدان الرأسمالية المتطورة، وتلك الأقل تطوراً، والتي باتت في معظمها ملكاً لشركات كبرى أو لمتمولين كبار، يسيطرون أحياناً على العديد من وسائل الإعلام في البلد نفسه، كما هو حال سيلفيو بيرلوسكوني، رئيس وزراء إيطاليا اليميني الحالي، الذي يسيطر على عدد من شبكات التلفزة ووسائل الإعلام الإيطالية الرئيسية، أو في عدة بلدان، كما هو الحال، على سبيل المثال لا الحصر، بالنسبة لمؤسسة بيرتيلزمان الألمانية التي بدأت في العام 1835 كمشروع ألماني محلي وهي الآن تمتد في مجال وسائل الإعلام المختلفة، المكتوبة والمسموعة والمرئية، وفي مجال طباعة وتوزيع الكتب وتسجيلات الموسيقى وغيرها، الى 63 بلداً في أنحاء العالم. وهناك كذلك مجموعة أكسل شبرينغر، الألمانية المنشأ أيضاً، التي تسيطر حالياً على وسائل الإعلام في 36 بلداً، خاصة في أوروبا، بما في ذلك في روسيا. والأمر نفسه ينطبق أيضاً على الأسترالي المولد روبيرت ميردوك الذي بدأ بتملك صحف أسترالية، ليتمدد بعد ذلك الى بريطانيا والولايات المتحدة ودول آسيوية وغيرها من خلال شبكته المعروفة باسم "نيوز كوربوريشن". ويمكن الحديث عن أمثلة عديدة أخرى في بلدان العالم المختلفة، وعن المؤسسات الضخمة التي التهمت معظم وسائل الإعلام الكبرى في الولايات المتحدة.
ويصبح طريفاً، في وضع كهذا، استمرار الحديث عن "سلطة رابعة" في عصرنا الحالي، في الوقت الذي يتمدد فيه أخطبوط المال ليسيطر على هذه "السلطة"، كما على السلطتين التنفيذية والتشريعية، وحتى الى حد كبير وبوسائل ملتوية على السلطة القضائية، وفق النماذج التي تحدثنا عن بعضها أعلاه. وقد شهدت العقود الثلاثة الأخيرة من تطبيقات "الليبرالية الجديدة" في البلدان الرأسمالية اتساعاً هائلاً لهيمنة رأس المال المالي على قطاعات التأثير المختلفة في هذه البلدان وإضعافاً كبيراً للمعارضين له.
وهناك العديد من المتابعين اليساريين لهذه الظواهر، حتى في الولايات المتحدة، مثل مجلة "مانثلي ريفيو" اليسارية ومنابر يسارية متعددة على شبكة الإنترنت، وهناك العديد من المثقفين اليساريين الذين يقومون بكشف وفضح جوانب مختلفة من هذه الهيمنة وتراجع الحريات الديمقراطية، أو تفريغها من مضمونها، في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان الرأسمالية، بدرجات متفاوتة. ولكن أصواتهم، وإن كانت قد ارتفعت بعض الشيء مع انفجار الأزمة الإقتصادية العالمية الجديدة في العامين 2007-2008، تبقى محصورة مقارنة بالمنابر الكبرى التي يسيطر عليها اليمين الرأسمالي والشركات الكبرى. ومع ان تطور شبكة الإنترنت يفسح المجال لمزيد من المشاركة في التعبير عن المواقف من قبل أي مواطن، مهما كانت آراؤه، إلا أن لدى أساطين النظام الرأسمالي من الإمكانيات المالية لمواجهة هذه الظاهرة الجديدة وإبقائها في حدود معينة لا تؤثر على استمرارية هيمنة النظام السائد.
وربما من المفيد هنا الإشارة الى ظاهرة مخرج سينمائي أميركي يتعامل بالأساس مع السينما التوثيقية التسجيلية ويحمل مواقف مناهضة لجوانب عديدة من النظام الرأسمالي السائد، وهو مايكل مور، الذي أخرج فيلماً من هذا النوع تناول هجمات 11/9/2001 في نيويورك وواشنطن وخلفيات سياسات إدارة جورج بوش الإبن وحروبه الخارجية، حيث وصل الفيلم الى مستوى من النجاح جعله يحوز على الجائزة الكبرى في مهرجان كان السينمائي الشهير في العام 2004. كما قام المخرج ذاته بعد ذلك بإنجاز فيلم تناول نظام الضمان، أو بالأحرى اللاضمان، الصحي في الولايات المتحدة، يتضمن نقداً حاداً لعمليات الخداع والنصب الممارسة بحق المواطنين من قبل الشركات والمؤسسات التي تتاجر بصحتهم وأموالهم. وفي لقطة سريعة في هذا الفيلم، وهو يحمل عنوان "سيكو"، يظهر المخرج مايكل مور، الى جانب ضريح كارل ماركس في لندن، في إشارة ملفتة للإنتباه ومعبّرة من قبله. وقد واصل بعد ذلك حملته السينمائية النقدية، فأخرج في العام 2009 فيلماً بعنوان "الرأسمالية...قصة حب"، وهو عنوان ساخر طبعاً، يتناول الأزمة المالية الإقتصادية الراهنة التي انفجرت في الولايات المتحدة، عبر تقديم نماذج ملموسة من استغلال المواطنين وإفقارهم من قبل أصحاب رأس المال في بلده، وينهي الفيلم بتصوير منطقة "وول ستريت" في نيويورك، حي البورصة والمضاربات المالية والمصارف، والمركز المالي الرئيسي في العالم الرأسمالي، محاطة من قبله بشريط وقائي على غرار الطوق الذي تضعه الشرطة الجنائية عادةً حول المناطق التي ترتكب فيها الجرائم الكبيرة.
ويمكن الحديث عن مخرجين سينمائيين آخرين غيره يتخذون مواقف قريبة من هذا المنهج النقدي للنظام الرأسمالي، من بينهم المخرج الأميركي الشهير أوليفر ستون، الذي أخرج فيلماً في العام 2003 عن فيديل كاسترو أجرى فيه مقابلات مباشرة معه، كما قام مؤخراً بإخراج فيلم آخر عن صعود اليسار في أميركا اللاتينية تضمن لقاءات مع قادة يساريين لعدة دول في تلك المنطقة، وخاصةً رئيس فنزويلا الحالي أوغو تشافيس، الذي شارك شخصياً مع المخرج في حضور عرض الفيلم في مهرجان البندقية السينمائي السنوي في أواخر العام 2009. كما قام ستون في العام الحالي 2010 بإخراج فيلم روائي عن الأزمة الإقتصادية بعنوان "وول ستريت: المال لا ينام أبداً". وكان قد سبق وأخرج فيلماً في العام 1987 حقق نجاحاً كبيراً وحصل على جائزة أوسكار حمل عنوان "وول سترتيت"، بحيث يمكن اعتبار الفيلم الجديد امتداداً له وتوضيحاً لخيارات المخرج السياسية.
كما يمكن الحديث أيضاً عن المخرج السينمائي البريطاني اليساري الشهير كين لوتش، وعن آخرين من مخرجي السينما في أنحاء العالم الذي يقدمون في أفلامهم قضايا الفئات المهمشة والمحرومة في مجتمعاتهم ونضالات شعوب العالم ضد إرهاب المحتلين والمتجبرين والمستغلين في مختلف القارات.
ودون أن نكون، بالضرورة، متوافقين مع كافة أفكار وخيارات هذا المخرج السينمائي أو ذاك، إلا إن للموضوع أهمية خاصة لكون السينما أداة تأثير جماهيري واسع، كما هو حال التلفزيون. لكن اليمين الرأسمالي، بطبيعة الحال، لديه من الإمكانيات المالية الهائلة ما يسمح له بغض النظر عن هذه الظواهر، مع محاولة محاصرتها، أحياناً بطرق فجة وأحياناً أخرى بأساليب ملتوية، عبر التحكم مثلاً في عملية التوزيع. وفي الوقت ذاته، يقوم الممولون والمنتجون اليمينيون بتشجيع وتمويل صانعي الأفلام وموجهي شبكات التلفزيون المناصرين لرأس المال ولحروب الولايات المتحدة الخارجية ومجمل سياساتها، وهؤلاء ما زال لديهم تأثير كبير في بلد مثل الولايات المتحدة، وغيرها من البلدان، على الأقل حتى إشعار آخر. وهذه، على كل حال، معركة أيديولوجية طويلة الأمد في مختلف وسائل الإعلام والتأثير على البشر في مختلف مناطق العالم وعلى صعيد العالم كله. ويمكن أن نستعيد هنا، بشكل عابر، مفهوم القائد والمفكر الإيطالي اليساري الشهير أنتونيو غرامشي عن "الهيمنة"، دون أن ندخل كثيراً في تفصيل هذا الموضوع الهام، الذي هو من أهم إسهامات غرامشي الماركسية.
ولكن حين يشعر أساطين رأس المال المتحكمين بالسلطة الفعلية في الولايات المتحدة، أو غيرها من البلدان الرأسمالية، مع الأخذ بعين الإعتبار بعض التلاوين والإختلافات بين بلد وآخر لها علاقة بتاريخ كل بلد وموازين القوى الداخلية بين مكونات كل مجتمع، حين يشعرون بأن سلطتهم أصبحت مهددة فعلياً، فهم سيلجأون الى أساليب أكثر شراسة ومباشرة في محاربة المعارضين. وهو ما رأيناه في البلدان التي شهدت صعود الفاشية والنازية في أوروبا في العشرينيات والثلاثينيات الماضية، وكذلك في الولايات المتحدة أبان حقبة المكارثية في أواخر الأربعينيات وطوال الخمسينيات الماضية، وكذلك ما نشهده منذ بداية تطبيقات "الليبرالية الجديدة" قبل زهاء الثلاثة عقود من ضربات للحركات النقابية والقوى اليسارية في بريطانيا وبلدان أوروبية أخرى.
ومؤخراً، وخاصة مع إنطلاق وتفاقم الأزمة الإقتصادية العالمية وتبعاتها على صعيد تنامي البطالة والإفقار المتسع لقطاعات متزايدة من السكان في المجتمعات الرأسمالية، نشهد من جديد تنامي التيارات الفاشية والعنصرية في عدة بلدان أوروبية. وفي الولايات المتحدة، شهدنا يوم 28/8/2010 الماضي تظاهرة تيار "حفلة الشاي" الأميركي، الذي سبق وأشرنا إليه، والتي رفعت شعارات عنصرية وعبّرت عن العداء للأميركيين من أصول إفريقية وأميركية لاتينية ومسلمة، وهي التظاهرة التي جرت في واشنطن أمام ضريح الرئيس الأسبق إبراهام لينكولن، في نفس اليوم، والمكان ،الذي كان مارتن لوثر كينغ، داعية حقوق الإنسان الأميركي الإفريقي، قد نظّم فيه تجمعاً ضخماً في العام 1963 شارك فيه مئات الآلاف من المواطنين الأميركيين الأفارقة ومناصريهم، وألقى فيه خطبته الشهيرة التي ردد فيها عبارة "لديّ حلم"، وتُعتبر الآن من أهم الخطب المؤثرة في تاريخ الولايات المتحدة.
***
بالمقابل، ما زلنا، على الأقل حتى الآن، نشهد استمرار تراجع وضعف الحركة اليسارية الجذرية في معظم البلدان الأوروبية، بما في ذلك في بلدان كانت فيها هذه الحركة تتمتع بحضور كبير ومؤثر، خاصةً منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى مطلع الثمانينيات، بلدان مثل فرنسا وإيطاليا والى حد ما إسبانيا، ناهيك عن الوضع المأساوي لليسار الجذري في معظم بلدان التجارب الإشتراكية السابقة، بما فيها جمهوريات الإتحاد السوفييتي السابق، باستثناءات قليلة.
ديمقراطية المشروع الإشتراكي تنطلق من إرادة وفعل الغالبية الشعبية
ربما استطردنا في الحديث عن نموذج "الديمقراطية" في ظل الأنظمة الرأسمالية، وهدفنا كان أن نبرز أن البديل الإشتراكي ينبغي أن يكون ديمقراطياً بالمعنى الحقيقي للكلمة، أي أن يحقق ديمقراطية من نوع آخر، ديمقراطية الغالبية الساحقة مقابل "ديمقراطية الأثرياء" في الولايات المتحدة، وبأشكال ودرجات مختلفة، في البلدان الرأسمالية الأخرى.
في الكتابات الحديثة عن المشروع الإشتراكي في القرن الجديد، يجري الحديث كثيراً عن "ديمقراطية تشاركية وتضامنية"، تتم فيها العودة للناخبين في القضايا الكبرى عبر الإستفتاءات العامة، ويكون التنظيم المجتمعي عبر هيئات محلية قاعدية تدير شؤونها بذاتها، تضم مئات العائلات في أحياء المدن أو المشاريع الصناعية والمرافق الإقتصادية الكبيرة، أو عشرات العائلات في الريف والقرى والمشاريع الصغيرة. والتوجه هو نحو تكوين شبكة من هذه الهيئات تفرز القيادات العليا من الأسفل، وتبقيها تحت الرقابة الشعبية الدائمة. وهذه الرقابة الشعبية هي مسألة أكد عليها كثيراً فلاديمير لينين في كتابه ذاته "الدولة والثورة".
وهذه الصيغة التنظيمية للـ"كومونات" تجري تجربتها حالياً بشكل خاص في فنزويلا. ولكنها ما زالت في مراحلها الأولية وتحتاج لمزيد من الإمتحان العملي مع الوقت. خاصة وأن عملية التنسيق والتنظيم الأوسع بين الهيئات المحلية هذه بحاجة الى بلورة عملية أكثر، بحيث يتم استكمال بناء جهاز إدارة المجتمع، على كل صعيد، إنطلاقاً من هذه البنى القاعدية، لتكون هناك ديمقراطية شعبية مباشرة، وفي الوقت ذاته، تكون قادرة على إدارة البلد وشؤونه المختلفة، ومواجهة التحديات المختلفة، بما في ذلك محاولات التخريب الخارجي المحتملة، سواء عبر عدوان خارجي أو من خلال دعم القوى الخارجية المعادية، وخاصة الولايات المتحدة، للقوى والكتل والهيئات المناهضة لمشروع التحول الإشتراكي في البلد نفسه. وهو تخريب سبق وتعرضت له فنزويلا، وكذلك بوليفيا، التي تخوض تجربة مشابهة. وما زال من الممكن أن تتعرض هاتان التجربتان وتجارب أخرى في القارة اللاتينية لمزيد من محاولات التخريب.
كما يجري الحديث في الكتابات الحديثة التي تتناول إشتراكية القرن الجديد عن أهمية العمل على مستوى إقليمي واسع نسبياً، وعدم الإكتفاء بالعمل في بلد واحد، خاصة إذا ما كان صغيراً ومحدود الإمكانيات. وذلك نظراً لحجم التحديات الإقتصادية والتهديدات الخارجية المحتملة. وهو ما تسعى التجارب الجديدة في أميركا اللاتينية الى العمل به من خلال التشكيلات الإقليمية، التي تضم عدداً من دول القارة.
فمع ان فنزويلا من البلدان الغنية نسبياً بمصادر الطاقة، فهي البلد السادس في العالم من حيث حجم الإحتياطي المكتشف من النفط، ومن بين الدول العشر الأولى في حجم الإحتياطي المكتشف من الغاز الطبيعي، والأولى في أميركا اللاتينية في هذين المجالين، ومع انها بلد أكبر من كوبا حجماً سكانياً (حوالي 27 مليون نسمة مقابل 11 مليوناً لكوبا) ومساحتها أكثر من ثمانية أضعاف مساحة كوبا، إلا انها تأتي في مرتبة متأخرة نسبياً في حجم اقتصادها وتنوع إنتاجها مقارنة بعمالقة أميركا اللاتينية، البرازيل والمكسيك والأرجنتين، وحتى كولومبيا المجاورة ووثيقة الصلة بالولايات المتحدة. ومن هنا أهمية الكتل الإقتصادية والسياسية الإقليمية لتحقيق مناعة تصون تجربة التحول الإشتراكي وتحول دون تعرضها للإنتكاسات أو لعمليات الإستنزاف الخارجية، كتلك التي تعرضت لها تجربة نيكاراغوا الساندينية في الثمانينيات الماضية. والأمر نفسه ينطبق على مناطق أخرى في العالم، يمكن أن يتحقق فيها مثل هذا التطور الجاري في أميركا اللاتينية في المستقبل. وهو ما يشمل، بالطبع، منطقتنا العربية- الشرق متوسطية. وإن كانت المهمات الراهنة في منطقتنا تتطلب تحالفات داخلية وإقليمية واسعة لمواجهة مجمل الإحتلالات وأشكال النفوذ الإمبريالي الواسع والدور الإسرائيلي والإمتدادات الداخلية لكل هذه الأطراف.
ويُنسب عادة استخدام تعبير "إشتراكية القرن الحادي والعشرين" لأول مرة، وذلك في العام 1996، الى عالم الإجتماع والمحلل السياسي الألماني المولد، هاينتس ديتيريش، المقيم في المكسيك منذ العام 1977 حيث يعلم في جامعاتها. لكن رئيس فنزويلا، أوغو تشافيس، هو الذي أعطى انتشاراً أوسع لهذا التعبير حين استخدمه في اجتماع المنبر الإجتماعي العالمي في العام 2005. وقد استخدمه من بعده قادة اليسار الناهض الآخرون في عدد من بلدان أميركا اللاتينية الأخرى، وخاصة قادة بوليفيا، إيفو موراليس، وإكوادور، رفائيل كورِّييا.
وهذه التجارب اليسارية على علاقة وثيقة مع كوبا، التي كانت قد طرحت مشروعها للتحول الإشتراكي منذ مطلع الستينيات الماضية، أي انها، من الناحية الزمنية، تنتمي الى ما يمكن أن يسمّى باشتراكية القرن العشرين، أو النصف الثاني من القرن العشرين. لكن لتجربة كوبا خصائص متميزة عن تجارب أوروبا الشرقية. ويمكن الحديث عن هذا التمايز في مجال آخر، خاصة وإنه سمح باستمرارية هذه التجربة في ظروف بالغة الصعوبة في التسعينيات الماضية بعد انهيار الإتحاد السوفييتي وكافة تجارب التحول الإشتراكي في أوروبا، التي كانت كوبا تتعامل معها إقتصادياً وتجارياً وتعتمد على مواردها، الى حد كبير. والتجربة الكوبية كانت، بالتأكيد، مرجعية هامة للعديد من الحركات اليسارية والتقدمية في مجمل القارة اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. ومن هذه الزاوية، فإن استعمال تعبير "إشتراكية القرن الحادي والعشرين" هو مجرد مصطلح، وإن كان، كما سبق وأشرنا، لا بد أن تتميز التجارب الجديدة للتحول الإشتراكي في العالم عن التجارب السابقة التي انهارت، حتى تتفادى الأخطاء والثغرات التي أدت الى فشلها.
جهود وإبداعات فكرية ونضالية مطلوبة... لإنضاج عملية التحول الجديدة
يبقى أن نشير الى أن إعادة الإعتبار لليسار الجذري ودوره، لا بل وتنمية وتطوير هذا الدور، تتطلب جهداً فكرياً ودعاوياً وسياسياً ونضالياً إبداعياً في أنحاء العالم، وربما يحتاج الى وقت غير قصير لتحقيق الإنضاج الضروري للشروط الذاتية، باستثناء حالة أميركا اللاتينية التي سبق وتناولناها. لكن المهمة تبقى ضرورية وملحة على جدول أعمال كل المتمسكين بمبادئ وتطلعات اليسار الجذري وأهداف تحرر الإنسان من ربقة الإستغلال ونهم رأس المال، الذي لا ينفك يولّد الحروب ويهدد وضع الكرة الأرضية بالتردي على صعيد المناخ والبيئة، كما يهدد بمزيد من إفقار غالبية سكان العالم ومفاقمة بؤسهم. وهو ما جعل بعض المفكرين اليساريين المعاصرين يعيدون طرح الشعار الشهير: "الإشتراكية أو البربرية". وربما من الأفضل اختيار كلمة أخرى غير "البربرية" باللغة العربية، لكونها تكتب بنفس الطريقة التي يكتب فيها اسم قبائل وشعوب أصيلة تسكن شمال إفريقيا منذ زمن طويل، وهي جزء ومكوّن أساسي وهام من ثقافة تلك المنطقة وتاريخها وحاضرها. علماً بأن التعبيرين يُكتبان بشكل مختلف في اللغات الأوروبية.
وحتى في ظل الأزمة الإقتصادية العالمية الطاحنة المستمرة، ليست هناك، على الأقل حتى الآن، بوادر ذات شأن للإستفادة من مناخها لتحقيق مثل هذا الصعود الجديد المأمول والضروري لليسار الجذري، ليس فقط في القارة الأوروبية، وإنما أيضاً في معظم "العالم الثالث"، بما فيه منطقتنا العربية - الشرق متوسطية. والمناشدة والحث هنا لا يكفيان، ولا بالطبع التمني والرغبة. هناك حاجة لجهد ومثابرة بنفس طويل نسبياً وإبداع لأشكال العمل والفعل على الأرض، كما حدث في أميركا اللاتينية. وإن كان من الممكن أن تحدث تطورات مساعدة غير متوقعة حالياً: ولكن، بالطبع، لا يمكن الرهان على ما هو غير مرئي.
***
باختصار، في الوقت الذي نحرص فيه على تقدم تجارب التحول الإشتراكي السابقة الموروثة من القرن العشرين والتي صمدت أمام موجة الإنهيارات الأوروبية الشرقية والجنوبية (والآسيوية في ما يتعلق بالجمهوريات السوفييتية السابقة الواقعة في آسيا، بالإضافة الى حالة مونغوليا الخارجية، التي كانت دولة مستقلة خارج الإتحاد السوفييتي، لكنها كانت عملياً معتمدة على الجار السوفييتي الكبير ومتأثرة بسياساته)، نتابع باهتمام وترقب تجارب أميركا اللاتينية الجديدة، وقدرتها على تجاوز الصعاب الكثيرة أمامها، وهي صعاب كبيرة وحقيقية، وليست فقط خارجية، لشق طريق جديد نحو التحول الإشتراكي في القرن الحادي والعشرين، وإعادة البريق لطموح كل اليساريين الجذريين وكل المراهنين على مستقبل أفضل للإنسانية، ولبناء مجتمعات تليق بها وتحقق تطلعاتها العميقة والتاريخية لإحلال الحرية الحقيقية للبشر، كل البشر، والعدالة للجميع واحترام كرامة الإنسان، كل إنسان، وحقه في العيش الكريم والتنمية الدائمة لشخصيته وعطائه ورخائه.
والتجربة العملية وحدها ستكون المحك، وليست هناك كتب إرشادية ونظريات معلّبة و"وصفات جاهزة" يمكن أن تحل المشكلة بمجرد تطبيق هذه "الوصفات". فالكتب والنظريات والتجارب الماضية هي مصادر هامة مساعدة، ولكن الإبداع العملي في التعامل مع الواقع الملموس، الذي هو دائماً أكثر تعقيداً بكثير من أية نظرية أو أي فكر مسبق، هو الذي يلعب الدور الحاسم. والإبداع هنا قد يبدأ مع نخبة طليعية، وقد يبدأ من حركة شعبية على الأرض، ولكنه لا يتحول الى قوة جبارة إلا إذا حملته القطاعات الشعبية الواسعة ذات المصلحة في تحقيق هذا التغيير التاريخي. فهذه القطاعات هي، في نهاية المطاف، صانعة التاريخ الفعلي والتحولات الجذرية التي شهدتها مسيرة البشرية في الماضي، وستشهدها، بالضرورة، في المستقبل.
#داود_تلحمي (هاشتاغ)



ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

|
حفظ
 |
بحث |
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
| إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
عندما اضطر كارل ماركس أن يقول... بأنه ليس ماركسياً!!
-
أزمات البلدان الأوروبية ومأزق أحزاب -يسار الوسط-
-
بعد 35 عاماً على النصر التاريخي... فييتنام تحث خطى التنمية و
...
-
وحدة اليسار مهمة... لكن تمايز مشروعه هو الأهم
-
خيارات الشعب الفلسطيني في ظل انسداد آفاق -الحلول القريبة-
-
العقد الثاني من القرن: الأزمة الإقتصادية الرأسمالية مستمرة..
...
-
يسار أميركا اللاتينية في عقده الثاني...التيار الجذري هو الذي
...
-
اليسار الياباني مرشّح لتأثير أكبر على سياسات البلد
-
هل تفتح الأزمة الإقتصادية العالمية آفاقاً جديدة أمام اليسار؟
-
اليسار الأوروبي: هل من مؤشرات للخروج من المرحلة الرمادية؟
-
لماذا تراجع اليسار في انتخابات الهند الأخيرة؟
-
على خلفية خطوات فنزويلا وبوليفيا التضامنية ابان محنة غزة...
...
-
من ستالينغراد، عام 1943، الى معارك جورجيا 2008... تطورات الق
...
-
حول سمات وآفاق الوضع الفلسطيني بعد الحرب على غزة (من ندوة لم
...
-
هل بالإمكان تجاوز الأزمة الإقتصادية العالمية بدون حروب كبيرة
...
-
نجاحات جبهة فارابوندو مارتي الإنتخابية في السلفادور تؤكد است
...
-
الحرب على غزة... وخطة شارون- داغان لتصفية مشروع الإستقلال ال
...
-
بعد عشر سنوات على رحيل عالم التاريخ والتراث هادي العلوي...ما
...
-
نهاية نهاية التاريخ..!
-
حول الموقف السوفييتي من مسألة فلسطين في العامين 1947-1948
المزيد.....
-
بمناسبة 14 شباط يوم الشهيد الشيوعي.. زيارة لنصب الشهيد سلام
...
-
المحكمة تنتدب خبيرًا هندسيًا لبحث تفادي ازالة المساكن
-
جريدة الغد الاشتراكي العدد 51
-
تجمعات بمدن فرنسية إثر مقتل شاب من اليمين المتطرف بعد تعرضه
...
-
فرنسا: ماكرون يدعو إلى الهدوء بعد وفاة شاب من اليمين المتطرف
...
-
ماكرون يدعو للهدوء بعد مقتل شاب من اليمين المتطرف
-
الحبكة النيوكولونيالية لترامب في الصحراء الغربية لشرعنة الضم
...
-
غدًا.. النطق بالحكم في قضية أهالي طوسون
-
اعتقال طبيب إيراني بعد إعلانه تقديم العلاج مجانيا للمتظاهرين
...
-
From Gaza to Cuba: How Canada Remains the World’s Most Tactf
...
المزيد.....
-
النظرية الماركسية في الدولة
/ مراسلات أممية
-
البرنامج السياسي - 2026
/ الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي
-
هل الصين دولة امبريالية؟
/ علي هانسن
-
كراسات شيوعية (الصراع الطبقي والدورة الاقتصادية) [Manual no:
...
/ عبدالرؤوف بطيخ
-
موضوعات اللجنة المركزية المقدمة الى الموتمر 22 للحزب الشيوعي
...
/ الحزب الشيوعي اليوناني
-
الرأسمالية والاستبداد في فنزويلا مادورو
/ غابرييل هيتلاند
-
فنزويلا، استراتيجية الأمن القومي الأميركية، وأزمة الدولة الم
...
/ مايكل جون-هوبكنز
-
نظريّة و ممارسة التخطيط الماوي : دفاعا عن إشتراكيّة فعّالة و
...
/ شادي الشماوي
-
روزا لوكسمبورغ: حول الحرية والديمقراطية الطبقية
/ إلين آغرسكوف
-
بين قيم اليسار ومنهجية الرأسمالية، مقترحات لتجديد وتوحيد الي
...
/ رزكار عقراوي
المزيد.....
|
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

 |
بحث
|
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
|
إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة