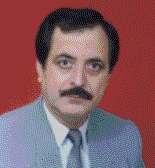|
|
علم العلم- الفصل الرابع نظرية المعرفة
منذر خدام


الحوار المتمدن-العدد: 8540 - 2025 / 11 / 28 - 09:27
المحور:
قضايا ثقافية
1-معنى المعرفة.
في تاريخ الفكر قلما انشغل الفلاسفة والعلماء بقضية من قضاياه مثلما انشغلوا بقضية المعرفة، حتى انقسموا بصددها إلى مدارس ومذاهب شتى. وفي الوقت الراهن فهي لا تزال القضية المحورية في النقاشات الجارية تفرق بين الفلاسفة والعلماء كما كانت تفعل في الماضي.
لقد اشتقت كلمة "معرفة"، بحسب لسان العرب، من الجذر "عرف" فالعرفان هو العلم، والعريف والعارف هما العليم والعالم. "عرفه الأمر: أعلمه إياه، وعرفه بيته: أعلمه مكانه، والتعريف: الإعلام [67].
وفي اللغة الإنكليزية، كلمة معرفة knowledgeمن فعل Know، وتعني امتلاك صورة خاصة من القدرة على عمل ما أو هي المعرفة باللقاء أو الاتصال المباشر أو الاطلاع [68]. ومنها اشتقت نظرية المعرفة في الانكليزية The theory of knowledge.
في اللغة العربية، كما في اللغة الانكليزية، تدور معاني كلمة "معرفة" حول الإدراك. أما في الاصطلاح فالمعرفة هي ما ينتج عن تقابل الذات العارفة بموضوع المعرفة، أي هي ما يحصل للذات العارفة بعد اتصالها بموضوع المعرفة. وقد عرفها أفلاطون " بأنها اعتقاد صادق مسوغ له ما يسوغه، أو يقوم عليه البرهان والدليل"[69].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
67-لسان العرب لابن منظور، المجلد الرابع، مادة "عرف" ص309
68-المعرفة في الفكر الغربي،www.islamonline.com،تاريخ الدخول إلى المسار 4/12/2009.
69-المرجع السابق، ص 1.
يتطلب تعريف أفلاطون للمعرفة، توافر ثلاثة شروط وهي:
وجود موضوع صادق للمعرفة (شرط الصدق). وجود ذات عارفة تمتلك ذهنا طبيعيا يقبل بالموضوع (شرط الاعتقاد). أن تمتلك الذات العارفة براهين وأدلة على صدق موضوع المعرفة (شرط التسويغ) [70].
لقد توسع كثيراً مضمون مصطلح " معرفة " في الوقت الراهن ليشمل الوعي الاجتماعي العام بما هو تعبير فكري (كلام، صور، رموز) عن علاقات الوجود الاجتماعي، وهذا ما سوف يتم النظر فيه بالتفصيل في مبحث الوعي الاجتماعي العام.
2- نظرية المعرفة.
يثير مفهوم "المعرفة"، مباشرة، التساؤل حول إمكانية المعرفة، وحول قدرة الإنسان على تحصيل معارف حقيقية عن الأشياء والظواهر التي تشكل موضوع المعرفة. وفي الجواب عن هذا التساؤل انقسم الفلاسفة إلى مدرستين كبيرتين:
المدرسة الأولى؛ وتضم أنصار النزعة اليقينية الذين يؤكدون على قدرة العقل على تحصيل المعرفة اليقينية عن الأشياء والظواهر التي يشتغل عليها. يعتقد أصحاب هذه المدرسة بأن العلم لا يقف عند حد وليس له سقوف غير قابلة للتجاوز. خير من عبر عن هذا الاتجاه، هم الفلاسفة العقليون rationalists.
المدرسة الثانية؛ وتضم أصحاب النزعة الشكية الذين يشككون في قدرة العقل على إنتاج معرفة صحيحة عن موضوعات المعرفة. والشك المقصود هنا هو غير الشك المنهجي الذي يعد ضروريا للبحث وتحصيل المعرفة.
يعود أصل مفهوم "نظرية المعرفة" إلى الكلمة اليونانية Epistemology وهي في الترجمات العربية للمصطلح تقابل مصطلح "فلسفة المعرفة" أو "علم المعرفة" أو "نظرية المعرفة". يعود التنوع، في ترجمة المصطلح إلى ترجمة المقطع "logos " الذي يترجم تارة "علم" وتارة "نظرية" وحتى "فلسفة".
ــــــــــــــــــــــــــــــ
70-المرجع السابق، ص2
بغض النظر عن "تعريف" نظرية المعرفة وتجاوزاً عن الاختلافات الكبيرة القائمة بصدده بين الفلاسفة فإنه يمكن الاتفاق على أن نظرية المعرفة هي فرع من فروع الفلسفة الذي يعنى بالمسائل الآتية [71]:
1-المعلومة (او المعرفة ذاتها) knowledge
2- المفاهيم التي تحتوي المعلومة أو تتفرع عنها related concepts
3-مصادر المعلومة sources
4-مميزات المعلومة criteria
5-أنواع المعلومات (المعرفة) the kinds of knowledge
6-التحقق من صدقية المعلومة (المعرفة) certainty
7-العلاقة بين موضوعات المعرفة والذات العارفة the relationships between the objects of knowledge and epistemologist
إن موضوع الخلاف الشديد بين الفلاسفة ليس "تعريف المعرفة" ولا "نظرية المعرفة" بل "أدوات المعرفة" أي كيف تتحقق المعرفة؟ وعن أية طريق؟ وما هي أدواتها؟ على هذا الطريق تبلور في الفكر الغربي عدد من المذاهب الفلسفية الكبيرة نعرضها باختصار:
أ-المذهب العقلي ratonalism: يعتقد أنصار هذا المذهب بأن العقل هو قوة فطرية في جميع الناس ويمكن بواسطته الاستدلال العقلي على المعرفة الحقيقية عن الأشياء والظواهر في الطبيعة بدون الحاجة إلى أية مقدمات تجريبية.
ب-المذهب التجريبي Empiricism: يؤكد التجريبيون على خلاف أنصار المذهب العقلي بأن التجربة أو الخبرة الحسية هي مصدر المعرفة وإن العقل يواجه موضوعاته خاليا من أية مبادئ عقلية أو معرفية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
71-أحمد إبراهيم أحمد، " حاجتنا للمعرفة " https://www.ababihail.com تاريخ الدخول إلى المسار 4/12/2009.
ت-المذهب الحدسي Intuitionism : يرى الحسيون بأن تحصيل المعرفة لا يقتصر على التفاعل مع الخارج (التجربة، أو الخبرة) بل يتعداه إلى ما يسمى التجربة الوجدانية أي الحدس intuition، وهو يكون:
- إما حدس حسي، وهو الإدراك عن طريق الحواس. مثلا تمييز الألوان، أو الروائح، أو المزاقات المختلفة.
- أو إدراك تجريبي وهو ينشأ عن طريق الممارسة المستمرة، والخبرة.
- أو حدس عقلي وهو الإدراك بدون براهين الذي يتعلق بالمعاني المجردة التي لا تدرك بالتجربة مثل الزمان والوجود والعدم وغيرها.
- أو حدس تنبؤي كالذي يحصل في الاكتشافات العلمية إذ إنها تخطر على بال العالم بعد طول تجريب واختبار [72).
ث- المذهب البراغماتي:
نشأت الفلسفة البراغماتية في الولايات المتحدة الأمريكية وهي تجمع في داخلها خليط من المذاهب التي تقول بمبدأ إن "صحة الفكر من صحة النتائج العملية للممارسة الناجحة". قد يصح هذا المذهب في مجال السياسة لكنه لا يصح في مجال الفكر وتحصيل المعرفة.
2-1-نظرية المعرفة عند أفلاطون.
إن تاريخ النقاش حول مصدر المعرفة وأدواتها لا يبدأ مع أفلاطون بل هو سابق عليه. ففي القرن الخامس قبل الميلاد عرف عن السفسطائي جورجياس Gorgias (485-380ق.م) أنه أنكر وجود الأشياء في الواقع لأنها، حسب رأيه، قد توجد دون أن تعرف وقد تعرف لكن يستحيل نقل المعرفة بها.
وقبل جورجياس كان بروتاجوراس Protagoras (480-411 ق.م) قد قال باستحالة التمييز بين صحة وجهة نظر معينة من وجهة نظر أخرى وذلك بسبب إن كل منهما تمثل حكماً ناتجاً عن الخبرة الفردية.
ــــــــــــــــــــــــــــ
72- المعرفة في الفكر الغربي، مرجع سبق ذكره، ص3
غير أن أفلاطون Plato (428-347 ق.م) يتميز عن غيره من الفلاسفة اليونانيين القدماء في أنه عرض نظرية في المعرفة شكلت مع مرور الزمن أساسا لاتجاه فكري كبير (النزعات المثالية) لا يزال عند النقاش حول مصادر المعرفة الجاري اليوم يعود إلى ذلك الأساس.
بحسب أفلاطون المعرفة الحسية قد تعطي إدراكا خاطئا عن الواقع المدرك، ولهذا ينبغي أن يتدخل العقل لتصحيح هذا الخطأ وإعادة إنتاج معرفة حقيقية عنه. في هذا الجانب من المسألة لا يتميز أفلاطون عن المذاهب الفكرية الأخرى. إلا إنه، مع ذلك، قال بوجود الحقيقة العقلية وجودا مستقلاً خالصاً. وإن الوصول إلى هذه الحقائق العقلية الخالصة لا يكون إلا عن طريق النفس التي هي ذاتها كانت في عالم المثل العقلية تدرك جميع الحقائق الأخرى. غير إنها عندما اتحدت بالجسد نسيت ما كانت تعرفه وأصبح السبيل إلى أن تذكره هو الفلسفة. المعرفة إذاً عند أفلاطون ليست سوى تذكر الحقائق الأزلية وأن دور العلم ينحصر في المساعدة على ذلك.
لقد ميز أفلاطون بين أربعة أدوات للمعرفة وهي [73]:
أ-الإحساسات: ويتم بواسطتها إدراك صفات الأشياء وعوارضها.
ب-الظن: وهو تعبير عن القلق الذي يدفع النفس لطلب العلم. ليس الظن شيئا مادياً، ولا مكسباً عقلياً، إنه، بحسب أفلاطون، نعمة إلهية.
ت-الاستدلال وهو أسلوب في إثبات صحة المعلومة أو نفيه وهو يذهب به مذهب الرياضيين.
ث-التعقل وهو أرقى أدوات المعرفة به يتم إدراك الماهيات المجردة.
لقد شيد أفلاطون نظريته، في المعرفة على قاعدة نظريته في المثل. فحسب رأيه، إن لجميع الموجودات صور مجرد في عالم المثل أو عالم الحقائق
ــــــــــــــــــــــــــــــ
73-نظرية المعرفة عند أفلاطون، https://www.ram1ram.com ، تاريخ الدخول إلى المسار6/12/2009.
الخالدة أو عالم الله لا فرق. وتتميز هذه الصور بالخلود أما تجسيدها الواقعي فهو الذي يتعرض للفساد والتغير.
يرى أفلاطون العالم، منقسما إلى عالمين: عالم المثل العقلية والصور الروحانية (عالم الإله) وعالم الظلال حيث توجد الموجودات الحسية.
يعتقد أفلاطون أن للكون نفس كلية كما للإنسان نفس تحركه وهذه النفس متصلة بعالم المثل من جهة، وبعالم الكون والفساد من جهة ثانية ولهذا فهي تنقسم إلى قسمين:
أ-العقل وهو الجزء الأرقى منها ومركزه في الرأس وهو خالد يدرك المثل.
ب-اللاعقل وهو قسمان: قسم شريف يتعلق بالعواطف النبيلة كالشجاعة ومركزه القلب. وقسم وضيعي تعلق بالشهوات البهيمية ومركزه البطن.
2-2 نظرية المعرفة عند أرسطو
يعد أرسطوAristotle (384- 322ق.م) كما أفلاطون مؤسس لنظرية في المعرفة هي الأخرى لا تزال حاضرة بقوة في النقاشات الراهنة حول طبيعة المعرفة ومصادرها وأدواتها. لقد تميز أرسطو بالموسوعية وينظر إليه كثيرون على إنه مؤسس علم المنطق، ومؤسس النزعات المادية في المعرفة. تعلم أرسطو في مدرسة أفلاطون وكان تلميذه الأول وأخذ عنه القول بأن المعرفة المجردة هي أرقى أشكال المعرفة، لكنه خالفه الرأي في مصدر المعرفة. فحسب أرسطو فإن المعارف جميعها نتاج الخبرة Experience وهذه المعارف يمكن استخلاصها مباشرة من موضوعاتها أو استنباطها من المعارف المتوفرة باستخدام قواعد المنطق Rules of logic [74].
لقد ميز أرسطو في الفلسفة بين: الجانب النظري الذي يتناول الوجود بمكوناته وعلله والجانب العملي الذي يتناول النشاط الإنساني والجانب الإبداعي الذي يتناول الآداب والفنون على اختلافها [75].
74-أحمد إبراهيم أحمد،نظرية المعرفة،www.adabihail.com تاريخ الدخول إلى المسار 6/12/2009.
75-عبد الله هادي، أرسطو، abdullahhadi.maktoobblog.com تاريخ الدخول إلى المسار ،6/12/2009
ومع إن العلم عند أرسطو هو العلم بالكليات (المفاهيم المجردة) الذي يمكن التوصل إليه عن طريق العقل إلا إن هذه الكليات لا توجد إلا في الجزئيات التي يمكن إدراكها عن طريق الحس. يحسب أرسطو الموجودات الأولية أربعة: المادة، والصورة (الماهية)، والحركة، والغاية، وهي تؤثر ببعضها وتتأثر باستمرار وفي الاتجاهين. المادة تتحول إلى صورة، والصورة تحرك المادة.
لقد ميز أرسطو بين نوعين من المعرفة: المعرفة اليقينية وهي التي يمكن الاستدلال عليها بالبرهان والمعرفة الاحتمالية وهي التي يمكن التوصل إليها عن طريق الظن. والظن يمكن التحقق منه عن طريق التجربة، أوعن طريق ما أسماه "المصادرات العليا للعلم" التي يؤكدها العقل بالتأمل وليس بالحس. غير أن التأمل في نهاية المطاف، ليس سوى تعميم لخبرات الممارسة (جمع الوقائع) عن طريق الجمع بين الاستقراء والاستنباط [76].
واستنادا إلى ذلك فقد قام أرسطو بدحض نظرية المثل عند أفلاطون واعتبرها متناقضة ولا حاجة إليها في النهاية. لقد ركز أرسطو في دحضه لها على علاقة المثال بتجسيده الواقعي، بمعنى كيف يمكن للشيء المحسوس أن يكون على صورة المثال ومختلف عنه في الوقت ذاته. وإن المعرفة بالمثل لا تفيد في معرفة العالم الواقعي الذي نعيش فيه. ولحل هذه المعضلة وجد أرسطو إن المعقولات ليست مفارقة لموضوعاتها بل هي كامنة فيها وإن كل موجود هو مادة وصورة تقبل التفسير بواسطة أربع مبادئ(علل) رئيسية وهي الآتية:
أ-العلة الفاعلة، وخص الفاعلين في الواقع وهم البشر. فلكل صنعة صانع هو علتها الفاعلة. النجار للنجارة، والحداد للحدادة، والعالم للعلم، وهكذا دواليك.
ب-العلة المادية وهي المادة التي يصنع منها الصانع موضوعاته الخشب للنجار، والحديد للحداد، والعلم للعالم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
76-أرسطو https://www.asmarna.org تاريخ الدخول إلى المسار 6/12/2009
ت-العلة الصورية وهي تعبير عن المفاهيم التي تعبر عن فكرة المصنوع مثلا خزانة، أو منجل، أو نظرية.
ث-العلة الغائية وتحدد الغاية من الصنع أي المنفعة التي يستهدفها الصانع ويحصل عليها. فالخزانة لوضع الثياب، والمنجل للحصاد، والنظرية لتفسير ظاهرة معينة [77].
يقول أرسطو " ما من فكرة في العقل إلا وأصلها في الحس" وكما أن العقل عقلان: عقل كامن أو بالقوة، وعقل بالفعل، فإن المعقولات توجد أيضاً في الأشياء بالقوة ومن ثم تنتقل إلى معقولات بالفعل في العقل. وإن عملية الانتقال من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل على مستوى العقل أو على مستوى المعقولات تحتاج إلى عقل آخر سماه أرسطو العقل الفعال أي العقل الذي هو دائما في حالة الفعل.
يعد أرسطو في تاريخ الفلسفة المؤسس لاتجاه النزعات المادية التي تحولت على يد فويرباخ وماركس وإنجليز، في العصر الحديث، إلى مذهب فلسفي متعدد المدارس.
2-3 نظرية المعرفة العربية الإسلامية.
لقد انشغل الفلاسفة والمفكرين العرب والمسلمين منذ وقت مبكر بقضايا الفلسفة، ومنها القضايا المتصلة بنظرية المعرفة وذهبوا بها مذاهب شتى متأثرين بزملائهم اليونانيين وأضافوا إليها من عندهم. لقد اشتهرت لدى المفكرين العرب المسلمين نظريتان لتفسير المعرفة: نظرية الفيض، ونظرية الخلق المستمر. فها هو الفارابي وابن سينا يبنون أراءهم في المعرفة والنفس والعقل الفعال والعقل المادي والعقل الهيولاني وغيرها، على نظرية الفيض التي تتسم بصبغة استشراقية. يرى ابن سينا والفارابي، إن المعرفة تتناسب مع الوجود فهي صورة عنه" فكما أن الموجودات تصدر عن الواحد عن طريق الفيض فإن المعرفة تصدر عنه عن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
77-المرجع السابق، ص4
طريق الإشراق"[78].
لا ترفض المدرسة الإشراقية في الواقع دور الحواس في المعرفة لكنها تجعل العقل مصدراً وطريقاً للمعرفة. العقل الفعال عندها هو الذي يهب الصورة والمعرفة. غير إن هذا العقل يعرف الواقع عن طريق الحواس، أي عن طريق ما يسمى بالعقل الهيولاني أو العقل بالقوة بعد أن يجرده من ماديته، وإذ يفعل فإنه يصل به إلى ما يسمى بالعقل المستفاد، إذ تكون الصورة العقلية فيه مجردة لكنها تأخذ قيمتها المعرفية من العقل الفعال.
أما أبن رشد فإنه على العكس ينطلق في أرائه في المعرفة من نظرية الخلق المستمر بما تعنيه من اتصال العقل الهيولاني بالعقل الفعال. فحسب رأيه " ترتبط جميع الموجودات على نحو ما بالوجود الأول وإن الوجود العقلي لها هو الذي يربط بينها برباط يجعلها على هيئة كائنات متدرجة في كمالها حتى ينتهي هذا التدرج إلى الوجود المطلق". لقد تأثر ابن رشد كثيرا بأرسطو وأخذ عنه مبادئه في تفسير المعرفة. لقد اهتم مثله بدراسة الإحساسات المختلفة وكيفية حدوثها من جراء المؤثرات الخارجية. العقل عنده قوة صرفه يستطيع بها أن يتعقل أي وجود كما هو وتكوين صورة عقلية عنه وإن المعرفة عبارة عن " إخراج ما هو بالقوة إلى ما هو بالفعل" (79)
من جهته، فقد تأثر الكندي بالقرآن في تفسيره للوجود والمعرفة أي بنظرية "الخلق من العدم". والنفس عنده " جوهر عقلي خالص "، لكنه لا يتحرك إلا من خلال الجسد. الوجود عنده نوعان: وجود واجب، ووجود ممكن. وإن معرفة واجب الوجود تندرج في إطار ما يسمى بالمعرفة اليقينية وإن العقل هو الطريق إليها. وللوصول إلى المعرفة اليقينية، عن طريق العقل، لا بد من حصول المعرفة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
78-راجح الكردي، تفسير نظرية المعرفة وعلاقته بنظرية الكون، https://www.balagh.com تاريخ الدخول إلى المسار22/12/2009.
79- المرجع السابق ص3
الحسية أولاً، أي تكوين صورة عن المحسوسات عن طريق قوة الحس." الأشياء الجزئية الهيولانية تقع تحت الحواس، وأما الأجناس والأنواع فهي لا تقع تحت الحواس، وليس لها وجود حسي، فهي تقع تحت قوى النفس أي العقل"[80]. بعبارة أخرى الموجودات تكون دائماً مميزة وهي تدرك بالحواس أولاً، أما الصور العقلية عنها من مفاهيم ومقولات فهي غير موجودة في الواقع بل في العقل.
إلى جانب الحواس والعقل يقول الكندي بطريق ثالث للمعرفة هو طريق القلب الذي يكون بالإيمان وهو يعلو على الحواس والعقل معا. القلب هو الذي يولد القلق المعرفي ويدفع باتجاه المعرفة.
2-4 نظرية المعرفة في العصر الحديث
دخلت الفلسفة ومعها بقية العلوم في ما يشبه الثبات في الفترة التي تلت سقوط الإمبراطورية الرومانية والتي تعرف في التاريخ باسم عصر الظلام أو عصر الانحطاط. وكان لا بد من انتظار القديس توما الإكويني (1225-1274م) كي يعيد الاحترام للعقل والتقدير لأهمية الممارسة العملية في المعرفة. لقد سار توما الاكويني على نهج أرسطو في اعتبار الإدراك الحسي نقطة الانطلاق في العملية المعرفية، وهو نشاط عقلي واع ينتج عن خبرات التجربة والتعرف على الموجودات الخارجية[81].
هل العقل Reason أو الحس Sense مصدر المعرفة؟ لقد ظلت هذه القضية الشغل الشاغل للفلاسفة منذ القرن السابع عشر وحتى القرن التاسع عشر وقد قسمتهم إلى تيارات مختلفة.
أنصار العقل منهم rationalists) ) وفي مقدمتهم الفرنسي رينيه ديكارت Rene Descartes، والألمانيان باروخ سبينوزا baruch Spinoza وجوتفريد فيلهلم ليبينز Gottfried Wilhelm Leibniz ، يعتقدون بأن العقل هو مصدر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
80-المصدر السابق. ص4
81-حاجتنا للمعرفة، https://www.adabihail.com مرجع سبق ذكره.
المعرفة وإن طريقه إليها هي الاستدلال العقلي انطلاقا من البديهيات Axioms.
أما أنصار الحس الذين يدعون بالتجريبيين Empiricists وفي طليعتهم الانجليزيين فرنسيس بيكون francis Bacon وجون لوك john locke يعتبرون إن إدراك المعرفة لا يكون إلا بالحواس فهي مصدرها. ويعود الفضل إلى باكون في تأسيس ما يسمى بالمنطق الاستقرائي Inductive logic وهو بذلك يكون قد وضع قواعد جديدة للمنهج العلمي. بحسب بيكون تأخذ المعرفة شكلين:
الشكل الأول ويحصل خارج الذات العارفة وهو انطباع عناصر البيئة الخارجية في الحواس نتيجة الخبرة المتكررة.
أما الشكل الثاني فإنه يحصل في العقل في سياق تفاعله مع انطباعات الحواس التي تنتج عن تفاعلها مع الطبيعة. ونظرا لأن الحواس لا تستطيع إدراك الحقائق بصورة أكيدة لذلك استنتج بيكون أن المعرفة الأكيدة بالوجود الفيزيقي أمر مستحيل.
وفي رده على الفيلسوف الأيرلندي بركليGeorge Berkeley قال لوك باستحالة فصل الأفكار عن الأشياء التي تعبر عنها. وعلى الطريق ذاته سار الفيلسوف البريطاني ديفيد هيوم David Hume رافضا مقولة بركلي في أن المعرفة نتاج خالص للأفكار. غير أن هيوم كان قد ميز بين المعرفة "بالعلاقات بين الأفكار" وهي من اختصاص المنطق والرياضيات وتتميز بالدقة والثبات لكنها لا تفسر الواقع. والمعرفة "بكينونة الأشياء" وهي نتاج الحواس. لكل نتيجة سبب في عالم الحواس، ونظراً للتغير المستمر في الأسباب فقد وجد هيوم أنه من المستحيل التوصل إلى معرفة أكيدة، بكينونة الأشياء. انطلاقاً من هذا الأساس، استنتج هيوم استنتاجا خطيراً، لا تزال بصماته ملموسة، على الفلسفة
وهو إن صحة القوانين، ودرجة مصداقيتها، تتغير مع الزمن [82].
82- المرجع السابق، ص8
من جهته، الفيلسوف الألماني إيمانويل كانتImmanuel Kant حاول المزج بين العناصر العقلية والعناصر التجريبية للخروج من معضلة هيوم ولوك وميز بين ثلاث أنواع للمعرفة:
أ--معرفة قبلية تحليلية Analytical priori تتضمنها التعريفات وهي كافية للتعلم.
ب-معرفة بعدية مخلقة Synthetic posteriori وهي معرفة حسية تنتج عن الخبرات بالعالم الخارجي وهي تحتمل الخطأ.
ت-معرفة قبلية مخلقة priori synthetic وهي انطباع الخارج في العقل ونتاج الحدث الخالص وتتميز بالدقة والثبات وتشكل موضوعا للفلسفة والرياضيات.
مع هيغل G.w.f.hegel، دخلت الفلسفة في مرحلة جديدة إذ أدخل التاريخ عنصراً في العملية المعرفية إلى جانب العقل (التفكير) مع الحس (الطبيعة) وهو بذلك قد وضع أساس المدرسة التاريخانية التي تابعها لا حقا الفيلسوف البريطاني هربرت سبنسر Herbert Spencer والفرنسي أوغست كومت Auguste comte لافتين الانتباه إلى أهمية علم الاجتماع كأحد فروع المعرفة مطبقين عليه المبادئ التجريبية.
2-5 نظرية المعرفة في القرن العشرين
في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين أسس الفلاسفة الأمريكيون المعاصرون تشارلز ساندرز بيرسCharles Sanders Peirce ووليام جيمس William James وجون ديوي John Dewey ما صار معروفاً باسم "المدرسة البراغماتية". من وجهة نظر هذه المدرسة فإن المعرفة أداة للفعل وان قيمة جميع المعتقدات تكمن في الفائدة التي تتحقق منها [83].
وفي مطلع القرن العشرين ظهرت في ألمانيا مدرسة فلسفية جديدة عرفت باسم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
83-المرجع السابق، ص10
فلسفة الظواهر Phenomenology أسسها الفيلسوف الألماني إدموند هسرلEdmund Husserl. لقد ميز هسرل بين ما سماه فعل المعرفة Act of knowledge، وموضوع المعرفة the object of knowledge ليتسنى التمييز بين ما تبدو عليه الأشياء والظواهر والصورة التي يشكلها العقل عنها. بحسب المدرسة الظاهراتية فإن عناصر المعرفة تتطابق مع عناصر الموضوع المراد معرفته.
من جهتها مدرسة الواقعية الجديدةNeorealist قالت بأن الإدراك الحسي يقف عند حدود الأشياء الطبيعية، في حين إن الإدراك العقلي يتجاوزها إلى كينونتها، إلى جوهرها مجرداً من وجودها الطبيعي.
أما المدرسة الواقعية النقدية The critical realism فقد قالت بأن الإدراك الحسي يتعلق بما تلتقطه الحواس من الوجود الخارجي وإن هذه الصور الانطباعية تدل بدورها على مصدرها.
في النصف الثاني من القرن العشرين أسس الفيلسوف النمساوي لودفيج فيتجن شتاين Ludwig wittgekstein مدرستين فكريتين تدعى الأولى المدرسة التجريبية المنطقية logical empiricism أو مدرسة المنطق الإيجابي logical positivism. تعترف هذه المدرسة بنوع واحد للمعرفة هو المعرفة العلمية التي تتحقق عن طريق الخبرة. وقد ميزت هذه المدرسة بين المقولات التحليلية Analytic statements والمقولات التركيبية synthetic statements واعتبرت أن "المعنى القابل للإثبات" يوجد في حالة تغير مستمر.
أما المدرسة الثانية فهي مدرسة التحليل اللغوي Analytic and linguistic philosophy أو مدرسة اللغة الدارجة ordinary language philosophy. لقد ركزت هذه المدرسة على حدود ودقة استخدام المصطلحات المعرفية منعا لما يمكن أن تحدثه اللغة من إرباك للمعرفة [84].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــ
84- المرجع السابق، ص10-12
فيما سبق تم استعراض موجز لبعض المحطات الرئيسية في تاريخ تطور نظرية المعرفة وسوف يستكمل بالحديث عن النظرية الماركسية في المعرفة التي تحوز على أهمية خاصة في هذا المجال.
وبعد هل تم استنفاد سؤال المعرفة؟ الجواب بالطبع هو النفي، وفي المستقبل سوف يستمر النقاش حول مصدر المعرفة: هل هو الحس؟ أو العقل؟ وسوف يستمر الفلاسفة ينقسمون إلى مذاهب ومدارس شتى.
2-6- نظرية المعرفة في الماركسية.
في هذا المبحث سوف تتم معالجة جانب من النظرية الماركسية في المعرفة، على أن يتم استكمالها في الفصل المخصص للمناهج الكلية. بصورة اكثر تحديدا سوف يجري الحديث على العلاقات التفاعلية بين الإنسان ووسطه الطبيعي أو الاصطناعي للكشف عن آلية حصول العملية المعرفية، وسوف يشمل الحديث المستويات التي تتكون منها المعرفة الاجتماعية الكلية وكيفية تفاعلها في سياق العملية المعرفية وكذلك عناصر العملية المعرفية على المستوى الكلي وعلى المستوى الجزئي.
2-6-1-ما بين الواقع والفكر
يوجد بين الفكر(العقل) والوجود الواقعي مسافة تشغلها الفعالية الإنسانية. عبر هذه المسافة باتجاه الفكر أولاً، ومن ثم باتجاه الواقع ثانياً، ثمة حركة دائمة تتسارع حيناً وتتباطأ أحياناً بعلاقة طردية لا تناسبية مع الميل نحو المحافظة في البناء الفوقي وبشكل خاص في حقل الممارسات السياسية [*].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* – إن حركة مكونات البنية الاجتماعية المختلفة تتناسب طردا" مع حركة البناء التحتي في الاتجاه، غير أن وتائر هذه الحركة تختلف. فالميل نحو المحافظة في البناء الفوقي، أكبر منه في البناء التحتي، وفي مجال السياسة أكبر منه في بقية المجالات الأخرى للبنية الاجتماعية. وإذا استمرت السلطة السياسية (أو أسلوب ممارستها) دون تغير تزيد البني الأخرى من ضغطها عليها، فترغمها على التغير، فتفتح بذلك فضاءً أوسعاً، لتجديد نشاط البناء الاجتماعي كله. أما عندما تتمسك السلطة بموقعها، وبأسلوب إدارتها تتحول عندئذ الأزمة في البنية الاجتماعية إلى أزمة عضوية يعاد إنتاجها باستمرار.
لذلك عندما يتخلف الفكر عن حركة الواقع ينبغي البحث عن السبب لا في الفكر ذاته، ولا في حقل إنتاجه، بل فيما يشغل المسافة الفاصلة بينه، وبين الواقع أي في مجال الفعالية الاجتماعية وبشكل خاص في حقل تحقيقها السياسي. ومن البديهي أن السياسي هنا يجب فهمه بالمعنى الواسع كتعبير عن العلاقات المتضمنة في مجموع النشاط الاجتماعي المنظم والموجه من حقل الفكر إلى الواقع بغرض إشباع الحاجات التي تقدم نفسها دائما في صيغة مصالح.
لكن السياسي(المصالح) في أثناء نشاطه يقدم نفسه دائماً في إطار أيديولوجي (مشاريع فكرية) يشكل حداً ومعياراً ومرجعاً لنشاطاته في مختلف الميادين. ومن الضروري أن يفهم الحد هنا لا بمعنى العازل الذي يحول دون تداخل الأيديولوجيات من خلال اشتراكها في الفضاء الأيديولوجي العام للمجتمع، بل كملتقى للتفاعل والتأثر مع البنى الأيديولوجية الأخرى في المجتمع. ومع أن معيار السياسة النهائي هو في نتائجها إلا أن هذه النتائج تحتاج دائماً إلى مرجعية أيديولوجية لمعايرتها وتبريرها.
من جهة أخرى فإن الايدولوجيا بصفتها وعياً اجتماعياً منظماً تقرأ بها القوى الاجتماعية مصالحها تأخذ بعد إنتاجها مساراً تفارقياً مع مسار حركة الواقع الذي يحتضن نتائج الفعالية السياسية على شكل موجودات اجتماعية جديدة. بمعنى أخر فإن توافق الأفكار الإيديولوجية مع الواقع لا يستمر سوى للحظة قصيرة لتسلك بعدها مساراً خاصاً بها بسبب ميلها بحكم العادة والتكرار إلى المحافظة. ويتسارع هذا الميل نحو المحافظة عندما تتباطأ حركة انتقال المعلومات عن تغير الواقع أو تضعف الحساسية بها فيعجز الفكر عن تقديم الصياغات النظرية الإيديولوجية المناسبة لتفعيل المتغيرات في الاتجاه المطلوب فتضطرب حركة الواقع وقد تتأزم إلى حد الانفجار وقد تنفجر أحياناً (الثورات) لعدم مناسبة الصياغات النظرية الإيديولوجية لما هو ناضج في الواقع للتغيير. تجدر الإشارة إلى ذلك لأن لكل شيء جديد في الوجود الاجتماعي ً بداية فكرية(85). ولهذا عندما تنتقل هذه الصياغات الفكرية إلى مجال الفعالية الإنسانية (مجال النشاط والممارسة) فإنها ترغمها على العمل وفق متطلبات أخرى غير متطلبات الجديد الناضج موضوعياً، أي القابل للتحقيق. ومع استمرار هذه الحالة يزداد التوتر عند الحد الواصل بين الفعالية الإنسانية(الاجتماعية) والواقع (الوسط الصناعي) فيتباطأ تطور قوى الإنتاج وتضعف إمكانية إشباع الحاجات الاجتماعية. وفي النهاية يفقد البناء الاجتماعي توازنه الداخلي النسبي ويصبح لزاما إزالة الباعث على التوتر في البناء الاجتماعي خصوصا من الحقل السياسي والذي يتجلى على شكل مصالح اجتماعية ضيقة أو وعي محدود لمصالح عامة. مرة أخرى ينبغي التشديد على أن وضعية (مصالح) السياسي وما يمثله من أشكال متنوعة للتسلط هي مصدر جمود الفكر عموما.
من الناحية الموضوعية يولد الإنسان في ظروف وشروط لم يخلقها وليس له خيار تجاهها ورثها عن أسلافه، ومنها بطبيعة الحال الفضاء الثقافي العام للمجتمع الذي ينتمي إليه بما فيه من أفكار وأيدولوجيات وعادات وتقاليد واستعدادات وغيرها. وفي إطار الفضاء الثقافي العام للمجتمع، ثمة فضاءات ثقافية عديدة تشكل مكونات بنيوية له وهي تعبر عن مختلف أشكال الوجود الاجتماعي للإنسان تحيط بها وتحكم صيرورتها بدرجات مختلفة. من هنا كان النظر إلى الفكر والايدولوجيا كعوامل خارجية بالنسبة للإنسان له ما يبرره موضوعيا وهو من الناحية المنهجية أمر مشروع يساعد على دراستهما كميادين خاصة للمعرفة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
85 – يقول ماركس في كتابه (رأس المال) إن العنكبوت يقوم بعمليات تشبه عمليات الحائك، والنحلة في بنائها، تبز الكثير من المهندسين المعماريين. غير أن ما يميز أسوأ معماري عن أبرع نحلة، هو انه يقيم البنيان في خياله قبل أن يبنيه من الشمع. ففي ختام كل عملية عمل نحصل على نتيجة كانت موجودة سلفا، في مخيلة العامل عند بدء العملية ".( رأس المال، الكتاب الأول، مبحث العمل وعملية تزايد القيمة، ص190، باللغة البلغارية، صوفيا 1979). انظر أيضا (رأس المال، المجلد الأول، الجزء الثاني " تحول النقد إلى رأسمال" ص 52. ترجمة فالح عبد الجبار، د. غانم حمدون وآخرون. دار ابن خلدون. الطبعة الأولى)
بطبيعة الحال تضيف الأجيال المتعاقبة إلى هذا الفضاء الثقافي العام والى مكوناته منجزاتها الخاصة فيحصل في كل زمن تطوري نوع من التكوين الجديد يتمفصل فيه التراثي مع المحدث بعلاقات تناسبية معينة، يتوقف على طبيعتها وعلى قابليتها للانكسار والتجاوز تسريع أو لجم الحركة الاجتماعية على مسار التطور العام. وإن الكشف عن وضعية هذه العلاقة ليس أمرا سهلا بل ليس متاحا دائما نظراً لأن التراثي والمحدث ليسا مشخصين خصوصا في ظروف التخلف والتبعية. إنهما بالأحرى موجودان على شكل مائع ينتشر في كامل النسيج الاجتماعي. إضافة إلى ذلك فان المصالح الفئوية والطبقية والمصالح الخارجية تلقي ظلالاً كثيفة عليهما فيبدوان بأكثر من شكل للوجود يخفي بعضه بعضا. منه ما هو رجعي يلجم الحركة التطورية العامة، ومنه ما هو تقدمي يدفع باتجاه التجاوز من خلال توافقه مع ضرورات التطور المحددة تاريخيا.
2-6-2 مكونات الوعي الاجتماعي.
يتكون الوعي الاجتماعي من ثلاث مستويات متداخلة هي الآتية:
المستوى الأول: يشغل هذا المستوى التكوين النفسي الذي يتكون من مجموع الاستعدادات والقابليات الخاصة التي تؤسس لاتخاذ المواقف المختلفة. تتكون هذه الاستعدادات والقابليات لدى الإنسان في سياق الممارسة وهي تختلف عن الاستعدادات والقابليات الوراثية إنها تجمع لخبرات الممارسة.
يمكن تشبيه المستوى الأول للوعي الاجتماعي بالقرص الصلب في الحاسوب فهو الحامل لبرامج المعرفة التي ترتسم عليه من سياق العلاقات بالخارج. وهو أيضاً مخزنا للمعارف المتحصلة التي تتحول بدورها إلى برامج لتحصيل معارف أخرى في مجالها.
إن العلوم المتخصصة في مجال دراسة النفس صارت على درجة كبيرة من التنوع إذ لم يبق مجال من مجالات الحياة الاجتماعية الجماعية أو الفردية إلا وله علم متخصص بنفسيته. وإن اكتشافات هذه العلوم بدأت تقدم خدمات ممتازة للمجالات الأخرى الاقتصادية، أو السياسية، أو الثقافية، أو الاجتماعية. من الناحية المنهجية فقد دخلت المفاهيم الخاصة بالعلوم النفسية مثل الشعور واللاشعور، الوعي واللاوعي، المكبوت المسكوت عنه وغيرها المجالات العلمية الأخرى، فأفادت في تكوين فهم أعمق، للعديد من الظواهر العلمية.
بطبيعة الحال ينبغي الحذر المنهجي عند استخدام بعض مفاهيم علم النفس في دراسة الظواهر السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية وغيرها من الظواهر. ومن باب الحيطة ينبغي التأكيد إنه لا يمكن أن يظهر أي راسب في اللاوعي (قاع النفس) ويعاود اشتغاله من جديد إلا إذا كان ثمة ما يحفزه على ذلك من دوافع اجتماعية أو ثقافية أو سياسية قد تتكثف على شكل أزمات أو اختناقات في حركة القوى الفاعلة في الواقع أو في مجرى التطور العام [86].
المستوى الثاني: تشغل هذا المستوى الايدولوجيا، التي تتكون من مجموع الأفكار المنظمة التي تصوغ علاقات الوجود الاجتماعي أو تقدم صياغات لعلاقات اجتماعية محتملة (مشروع) وتوجه سلوك مختلف الفئات الاجتماعية.
لكي توجد علاقة اجتماعية ما لا بد لها أولا من المرور عبر الوعي الذي يقدمها في البداية على شكل مشروع يسعى الفاعل الاجتماعي إلى تحقيقه. هذه قاعدة عامة للحراك الاجتماعي سوف نفصل القول فيها لاحقا.
المستوى الثالث ويشغله العلم الذي يشمل مجموع المعارف المتعلقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
86-" قد يكون من السهل جداً، صنع تاريخ العالم، لو كان النضال لا يقوم، إلا ضمن ظروف تؤدي حتما إلى النجاح. ومن جهة أخرى، قد يتسم التاريخ بطابع صوفي جداً لو كانت " الصدف " لا تضطلع بأي دور. فإن هذه الصدف تدخل هي ذاتها بالطبع كجزء لا يتجزأ في المجرى العام للتطور وتوازنها صدف أخرى. ولكن التسارع والتباطؤ رهن بمقدار كبير بهذه " الصدف " التي ترد بينها أيضا " صدفة " مثل طبع الناس الذين يقفون في البدء على رأس الحركة". /رسالة من ماركس إلى لودفيغ كوغلمان في هانوفر، مختارات ماركس إنجليز، الجزء الرابع، ص 152، دار التقدم، موسكو، بلا تاريخ نشر /
بموضوعاته المختلفة معروضة على شكل مفاهيم ومقولات ونظريات وقوانين.
يتوصل العلم إلى معارفه عن طريق البحث والاستقصاء المنهجي المنظم.
يشكل كل من المستويات الثلاث السابقة الذكر تكوينا بنيويا يتمايز داخليا بحسب الغايات التي يستهدفها وبحسب المواضيع التي يشتغل عليها والمصالح الاجتماعية الطبقية والفئوية التي يخدمها في كل مرحلة تاريخية تتفاعل مكوناته (بناه) فيما بينها وتتبادل التأثير والتأثر. فيما يخص العلوم الاجتماعية على سبيل المثال فان الأثر الاجتماعي يظهر فيها بحسب اقترابها أو ابتعادها عن المصالح الاجتماعية الطبقية أو الفئوية. أما العلوم الطبيعية فهي أقل تأثرا بالمتمايزات الاجتماعية.
2-6-3 - عناصر العملية المعرفية
على مستوى الكل الاجتماعي فإن تاريخ العلم يؤكد أنه تاريخ التفاعل بين عناصر ثلاث هي الآتية:
أ-عناصر نظرية. لكل علم لغته الخاصة به وهي تتكون من مفاهيم ومقولات وقوانين ونظريات ذات دلالة محددة في مجالها. وبقدر ما تكون لغة العلم غنية بالمفاهيم تسهل عملية التحصيل العلمي وتطوير العلوم في النهاية. غير أن غنى اللغة العلمية يتوقف على توافر العناصر الأخرى المجتمعية والنفعية للعملية المعرفية. فعلى سبيل المثال تتميز اللغة العربية بفقرها الشديد بالمصطلحات العلمية في حين تفيض غناً بالمصطلحات الأدبية. يعود السبب في ذلك إلى إن العرب لم يصنعوا حضارتهم العلمية الخاصة ولا تزال مساهماتهم في الحضارة العلمية الراهنة شديدة التواضع.
ب-عناصر اجتماعية (أفراد، ومؤسسات علمية، وسياسية، وقانونية وإدارية).
إن تطور المعرفة على علاقة متبادلة بمستوى التنظيم الاجتماعي وتبدو هذه العلاقات واضحة في الوقت الراهن. لم يعد العلم عملاً فردياً أو حرفياً بل عملاً منظماً في إطار مراكز بحثية ومؤسسات كبيرة على درجة عالية من التنظيم والتجهيز المادي والبشري. وأكثر من ذلك فهو يحتاج إلى بيئة تشريعية وقانونية
مناسبة، وإلى تمويل مناسب.
ت-عناصر نفعية عملية (تقدم اقتصادي، وتقني، ورفاه اجتماعي).
من حيث المبد لا توجد أية معرفة ولا يوجد تطبيق لها إلا وله دافعه الشخصي أو المجتمعي الذي يعبر عن ذاته على شكل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة. وقد تخرج هذه المصلحة عن تعبيراتها المادية وتكتفي بتعبيرها عن القلق المعرفي فحسب (حب الاطلاع). ومهما تعددت صور وأشكال المصلحة في المعرفة والتي تشكل الدافع إليها فإنها تظل تتمحور حول فكرة مركزية الذات Episentrism التي تعلي من شأن الذات في صورة عظمة شهرة مجد وغيرها.
بين التقدم الاقتصادي والتقدم التقني والرفاه الاجتماعي من جهة وتقدم العلوم والمعارف المختلفة علاقة طردية بالاتجاهين نلمسه. فالتقدم الاقتصادي يؤدي إلى الرفاه الاجتماعي وكلاهما يتطلبان تقدما تقنيا، وهذا من جهته يتطلب تطور العلم. وبالعكس كلما تطور العلم أدى إلى تطوير التقنية وتطبيقاتها. إن العلاقات المتبادلة بين العناصر السابقة الذكر ليست خطية بل دائرية تجعلها جميعها في وضعية تفاعلية مستمرة.
أما على الصعيد الجزئي أي على صعيد البحث في آلية حصول المعرفة فإنه لا بد من توفر خمسة عناصر هي الآتية:
أ-الذات العارفة.
ب-أدوات المعرفة ووسائلها المناسبة.
ت-طرق المعرفة وأساليبها.
ث-مادة المعرفة أو موضوعها.
ج-تنظيم العملية المعرفية، وإدارتها.
أ- الذات العارفة
الذات العارفة وهي الحامل لجهاز المعرفة أي الذهن أو الدماغ وبقدر ما تكون الذات العارفة سليمة يكون عمل الذهن سليماً. لكن سلامة الذهن لا تكفي لوحدها لكي يشارك في العملية المعرفية بل لا بد أن يكون متهيئا لذلك من خلال جهوزية قابلياته المعرفية واستعداداته. بكلام آخر ينبغي أن يكون قد حصل على مستوى من التأهيل المعرفي والخبرة في صورة تراكم معرفي في مجال معين. يدعى هذا التراكم المعرفي لدى الذات العارفة كما ذكر سابقاً بالعلم الحضوري، وهو جملة التصورات النظرية (مفاهيم، ومقولات..) التي تشكل عدة الشغل المعرفي.
ب- أدوات المعرفة ووسائلها المناسبة.
يختص كل علم بأدواته المعرفية ووسائله المناسبة. في مجال للعلوم النظرية فإن الأدوات والوسائل الخاصة بها تتكون من لغة، أي من مفاهيم ومقولات وغيرها. أما بالنسبة للعلوم المادية فإضافة إلى العدة اللغوية الضرورية لعملية المعرفة هناك أدوات ووسائل معرفية مادية مثل أدوات التجربة وتحليلها. أما في العلوم الاجتماعية فهناك الأدوات الرقمية الإحصائية.
ت-طرق المعرفة وأساليبها.
يجري الحديث هنا على المنهج المتبع في البحث وتحصيل المعرفة وهذا ما سوف يتم بحثه مفصلاً لاحقاً. من حيث المبدأ ينبغي أن يكون واضحاً أن لكل حقل معرفي مناهجه الخاصة التي تستخدم لتحصيل المعرفة في مجاله وإن اختيار منهج غير مناسب سوف يؤدي إلى تحصيل معرفة خاطئة. بطبيعة الحال يمكن إلى جانب المنهج الرئيسي استخدام مناهج أخرى مساندة.
ج-مادة البحث أو موضوعه.
توجد الموجودات المادية في الطبيعة مميزة دائما وفي حركة وتغير دائمين تنسج مع غيرها من الموجودات المادية العينية المميزة الأخرى علاقات كثيرة متبادلة تتفاعل معها باستمرار. هذا هو الوضع الطبيعي للأشياء والظواهر في الوجود العام الخارجي، غير إنه في سياق عملية البحث العلمي قد تقتضي ضرورة البحث عزل عينة من المادة البحثية أو تخصيصها في مكان تواجدها من أجل إجراء العملية البحثية العلمية عليها. في هذه الحالة ينبغي مراعاة المسائل المبدئية الآتية:
- أن تكون العينة المعزولة، أو المخصصة تحمل في ذاتها المجاهيل المستهدفة بالبحث، أي ما يسمى بالمشكلة البحثية.
- أن تكون العينة كافية ومناسبة بطبيعتها وحجمها وظروفها للإجابة عن أسئلة البحث.
ح-تنظيم العملية المعرفية وإدارتها.
لقد صار العلم في الوقت الراهن منظماً في مؤسسات ومراكز بحثية حديثة وهي على درجة عالية من التنظيم والتجهيز والإدارة. ورغم ذلك فإن الحدث المعرفي يبدأ دائما بصورة فردية. لكنه وهو في حالته الفردية لا يستطيع الاستغناء عن تنظيم العملية المعرفية وإدارتها بصورة سليمة تناسب الموضوع المبحوث.
يقصد بتنظيم العملية البحثية العلمية وضع كل عنصر من عناصرها في الوضعية المناسبة لإجراء البحث وتحديد العلاقات بينها، وتحديد مختلف الشروط البحثية الضرورية في ضوء أسئلة البحث.
من جهتها تقوم الإدارة بإجراء التفاعل المطلوب بين عناصر البحث في سيساق عملية البحث بصورة تناسب أسئلته وتأمين مختلف مستلزماته المادية والتجهيزية والذاتية.
إن تنظيم وإدارة العملية البحثية العلمية تشكل معاً ما يسمى بخطة البحث التي يتم إعدادها مسبقا في ضوء أسئلة البحث وتوزيعها زمنياً و تأمينها ماديا وماليا ولوجستياً.
3- المعرفة الحسية
يمتلك الإنسان خمسة حواس يتصل بواسطتها بالوسط الخارجي لينقل عنه معلومات أولية تشكل جملة انطباعاته الذاتية. يميز الإنسان بواسطة حاسة البصر الموجودات من حيث شكلها ولونها وحجمها. ويميز بواسطة حاسة السمع مختلف الأصوات في نطاق قدرة جهازه السمعي على استقبال الأصوات. ويميز بواسطة حاسة اللمس حرارة الموجودات وملمسها ويختبر الألم الجسدي والضغط والتوتر وغيرها. وبواسطة حاسة الذوق يختبر مذاق الأشياء وبواسطة حاسة الشم يميز الروائح المختلفة الصادرة عن الموجودات.
تؤدي الحواس دوراً مهما في عملية المعرفة ولا خلاف في ذلك بين مختلف المذاهب الفلسفية. ينشأ الخلاف عادة حول تقويم هذا الدور ونطاقه. فالتجريبيون والحسيون من الفلاسفة يبالغون في دور الحواس في عملية المعرفة، وقد يغالي بعضهم إذ ينسب للحواس المصدر الوحيد للمعرفة والسبيل الرئيس إليها. يزعم هؤلاء الفلاسفة بأن العقل يتبع الحواس إذ يعتمد عليها في تحصيل معلومات فهو يستقبل المعرفة من الحواس فحسب.
الإحساسات عند الأبيقوريين هي السبيل الوحيد للمعرفة فهي تعطي حسب رأيهم، صورة صادقة للأشياء أي صورة مطابقة لواقعها. وإن خطأ الحواس" لا يقع في الإدراك بل في الحكم، الذي يضيفه العقل إلى الإدراك".
ويبالغ الرواقيون في اعتبار الحواس طريقا وحيدة للمعرفة لأنها تتصل مباشرة بالعالم المادي الذي يشمل كل شيء حتى العقل ذاته. فالإنسان في رأيهم " يولد وعقله صحيفة بيضاء خالية من كل معرفة ثم تنطبع عليها صورة الأشياء عن طريق الحواس. والعقل حاسة من الحواس وهو يقوم بالتجريد والإضافة والتأليف والنقل والمضاهاة ولا يستطيع في عمله هذا الخروج عما تقدمه له الحواس الخارجية"[87].
التجريبية الحديثة من جهتها لا تقل مبالغة في دور الحواس في عملية المعرفة عن المدارس الفلسفية القديمة. فهي مثلهم تجعل الحواس أي التجربة طريقاً وحيداً للمعرفة. فالتجربة عند لوك مثلا نوعان: " تجربة حسية أو إدراك حسي يقوم على تلقي الانطباعات الحسية مباشرة وتجربة باطنية أو تأمل يعتمد على التفكير ويقوم على ربط الإحساسات الخارجية وتكوين أفكار منها"[88]. برأي لوك الأفكار ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
87-د. راجح الكردي،" دور الحواس في عملية المعرفة ومجالها وخصائصها وتقييمها، ص 1، تاريخ الوصول 12/2/2008
88- د. راجح الكردي، المرجع السابق، ص2
العقلية ليست سوى صور من التجربة.
يجمع لوك عمليا بين مرحلتي التفكير الحسي والتفكير العقلي. أما الفيلسوف كوندياك فإنه لا يؤمن إلا بالإحساس الظاهري ولا يقر بالتفكير كمصدر للمعرفة. بحسب رأيه " إن أي إحساس ظاهري كاف لتوليد جميع القوى النفسية، لتوجد شيء واحد في الشعور هو الإحساس لا غير.
يكون الإحساس الانتباه وبإضافة إحساس آخر تحصل الذاكرة وبتوجيه الإحساس الحاضر إلى الإحساس الماضي تحدث المقارنة أو المضاهاة وبإدراك المضاهاة مشابهة ومفارقة يتكون الحكم. وإذا تكررت المضاهاة والحكم، كان الاستدلال"[89]. يستنتج كوندياك من كل ذلك إن عمليات العقل ليست سوى إحساسات خارجية.
من جهته، الفيلسوف هيوم يعد الأفكار عبارة عن إحساسات باهتة للانطباعات الحسية القادمة من الحواس وهو يجرد العقل من أية فعالية. وإن ما "يحصل في العقل من انفعالات وإدراكات قوية فمنشؤها هو الحواس الخارجية إذ تحدث صوراً لهذه الانفعالات وتنشأ علاقات فيما بينها وبين المعاني بفضل قوانين تداعي المعاني أو التشابه والتقارن في الزمان والمكان والعلية. وهذه القوانين ليست أولية أو غريزية في العقل وإنما هي تكرار التجربة كما إنها ليست قائمة في الخارج".
بناء على ما تقدم يتبين إن الحسيين ينكرون القياس لأنه مبني على المعنى الكلي ويبرهن على وجود العقل وعلى دوره الفعال في المعرفة. في الوقت ذاته ينحازون إلى الاستدلال الذي هو عندهم انتقال من محسوس إلى محسوس عن طريق التداعي وليس من معنى عقلي إلى معنى عقلي آخر. لهذا كله فهم يفضلون الاستقراء باعتباره انتقال من محسوس جزئي إلى محسوس جزئي آخر، والاستقراء عندهم مجرد عادة يولدها التكرار.
من المآخذ التي تسجل على التجريبيين يمكن الإشارة إلى ما يأتي:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
89- المرجع السابق، ص2
أ- يحد التجريبيون من طاقة الفكر بتقليلهم من أهمية فعالية العقل طريقا إلى المعرفة. وعندما يقررون حكماً ما، فهو يكون من باب العقل وليس من باب الحواس؟ ولا يمكن إثباته حسياً.
ب- ثمة بعض الأحكام التي لا يمكن إثباتها تجريبيا مثل الحكم باستحالة وجود شيء ما وينطبق ذلك على جميع المفاهيم المجردة.
ت- المعرفة المتحصلة عن طريق الحواس يلزمها توفر شرط الضرورة وشرط صدق التعميم. إن صدق ما تدل عليه الحواس يرتبط بثبات الظروف غير أن الظروف تتغير باستمرار وهي تؤثر على التجربة ونتائجها.
ث- تجمع الحواس معلومات أولية عن الموجودات فقط، في حين معالجة هذه المعلومات وتنظيمها وتبويبها وتحليلها بحاجة كلها إلى العقل.
4- المعرفة العقلية
لا ينكر الفلاسفة العقليون دور الحواس في المعرفة لكنهم يخالفون التجريبيين في كون الحواس المصدر الوحيد للمعرفة. يقول العقليون:" إن التجربة التي تحصل بواسطة الحواس مضللة وموهمة، وإن الحواس لخداعة كذابة مخطئة لو اعتمدنا عليها كل الاعتماد في المعرفة، ذلك فإن الإدراك الحسي إنما يخبرنا عما يتعلق بحالة واحدة من أحوال الشيء، كما إن ما تظهره الحواس ليس إلا مظهر الأشياء فحسب ولا تطلعنا على حقيقتها" [90]
العقل عند العقليين هو أساس الحواس، وهو موجه الإدراك الحسي. من بين الفلاسفة القدماء يعد أفلاطون أكثرهم إنكاراً لدور الحواس في المعرفة مع أنه يقر بأنها المرحلة الأولى من مراحل المعرفة عبر "تذكيرها للنفس لتعود إلى عملها الأزلي الكامن فيها والذي نسيته بسبب تعلقها في البدن أو حلولها فيه"[91].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
90- راجح الكردي، المرجع السابق ص 3
91- المرجع السابق ص3
أما أرسطو فقد رفع من دور الحواس إلى مستوى العقل وقسمها إلى حواس ظاهرة وحواس باطنة وجمع بين عملها وعمل العقل. لقد جعل أرسطو "عمل العقل قائما على القوة المتخيلة من القوى الحاسة، وإن المحروم من حاسة محروم من المعارف المتعلقة بها"[92].
لقد حاول أرسطو أن يتخذ له موضعا بين المتطرفين الحسيين والعقليين إذ جعل الحواس والعقل جزء من النفس التي عرفها بأنها " ما به نحيا ونحس وننتقل في المكان ونعقل أولاً"[93].
من جهتهم العقليون الحديثون من أمثال ديكارت فإنهم ينكرون أن يكون للحواس الدور الأساسي في المعرفة، فهي حسب زعمهم مجرد طرق للفطرة تقدم أفكار فطرية كمادة للمعرفة، أما المعاني فإنما تستنبط من النفس أو تعود إلى العقل. وإن مصداقية ما تقدمه الحواس إنما يتأتى من وضوح البديهيات العقلية وتميزها. المحسوسات العقلية بحسب رأيهم، تكون قبل أن يوثقها العقل مصدر شك وخداع، وإنه لا قيمة لإحساساتنا من دون أن نعرفها معرفة واضحة متميزة [94].
5- عملية اكتساب المعرفة
تدعى عملية اكتساب المعرفة لدى الإنسان بالعملية العقلية أو بالتفكير وهي تسير على النحو الأتي:
أ-مواجهة المجهول وهو المشكل أو مادة المعرفة أو موضوعها.
ب-تحديد نوع المشكل المراد حصول معرفة حوله.
ت-حركة العقل، لمقارنة المشكل، مع المعلومات المخزنة، لدى الذات العارفة.
ث-فحص العقل للمعلومات وتأليف ما يناسب المشكل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
92- المرجع السابق ص3
93- انظر د. راجح الكردي، المرجع السابق ص 3
94- المرجع السابق ص 4
ج-مقارنة المعلومات التي تم تأليفها مع ما هو مطلوب.
يعد الفكر شغل ذهني يتحرك من المراد وهو المجهول إلى المعلومات المسبقة المخزنة لدى الذات المفكرة وهي المبادئ الأولية، ومن ثم من هذه المبادئ الأولية إلى المراد.
عندما يفكر الإنسان فإنه يقوم بعملية كشف للمجهول مستعينا بما لديه من مخزن علمي معرفي. في سياق عملية التفكير فإنه يقوم أولا بتحديد المشكلة ويعرضها على شكل تساؤلات ومن ثم يحدد نوعها وإلى أي مجال تنتمي، إلى مجال الكيمياء مثلاً، أو إلى مجال الطب. بعد تحديد المشكلة ونوعها، يبدأ العقل بمقارنة المشكل مع المعلومات المتراكمة لديه ليبحث فيها عما يعينه في إيجاد حل للمشكل. وتأخذ الحركة هنا شكلاً دائرياً بين المفاهيم ينتقي منها ما يناسب حل المشكلة. بعد إنجاز هذه المرحلة يصل العقل إلى صوغ استنتاجاته لينتقل بها إلى المطلوب وبذلك تكتمل عملية المعرفة أي عملية التفكير.
#منذر_خدام (هاشتاغ)



ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

|
حفظ
 |
بحث |
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
| إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
علم العلم: الفصل الثالث: منطق العلم
-
علم - العلم ( مناهج البحث العلمي،الفصل الثاني فلسفة العلم
-
مناهج البحث العلمي-الفصل الأول-ما هو العلم؟
-
أسئلة الديمقراطية في الوطن العربي في عصر العولمة(الفصل الساد
...
-
أسئلة الديمقراطية في الوطن العربي في عصر العولمة(الفصل الخام
...
-
أسئلة الديمقراطية في الوطن العربي في عصر العولمة(الفصل الراب
...
-
أسئلة الديمقراطية في الوطن العربي في عصر العولمة(الفصل الثال
...
-
أسئلة الديمقراطية في الوطن العربي في عصر العولمة(الفصل الثان
...
-
رهانات الاسد والسقوط الكبير
-
أسئلة الديمقراطية في الوطن العربي في عصر العولمة(الفصل الأول
...
-
العرب والعولمة( الفصل السادس)
-
العرب والعولمة( الفصل الخامس)
-
العرب والعولمة( الفصل الرابع)
-
العرب والعولمة( الفصل الثالث)
-
العرب والعولمة(الفصل الثاني)
-
العرب والعولمة( الفصل الأول)
-
العرب والعولمة( مدخل)
-
العرب والعولمة(مقدمة)
-
في المنهج-دراسة نقدية في الفكر الماركسي( الفصل الحادي عشر)
-
في المنهج-دراسة نقدية في الفكر الماركسي( الفصل الهاشر)
المزيد.....
-
عناصر دوريات الحدود يعتدون على متظاهر مناهض لإدارة الهجرة وا
...
-
الثانية عربيًا.. واشنطن تعلن انضمام الإمارات إلى تحالف -باكس
...
-
بينها مصر واليمن وإيران.. أمريكا تعلق معالجة تأشيرات الهجرة
...
-
تهديدات إيرانية .. أين تنتشر القواعد الأمريكية في الشرق الأو
...
-
مناورة عسكرية للدنمارك في غرينلاند وسط تصريحات ترامب عن دفاع
...
-
كيف يؤثر تصنيف أمريكا لـ-إخوان الأردن- على المعادلة الداخلية
...
-
ما الأهداف التي قد تضربها أمريكا في إيران وما نوع الأسلحة ال
...
-
مذيعة CNN تسأل عادل الجبير عن احتمال عمل عسكري أمريكي ضد إير
...
-
طلب بمغادرة أفراد من قاعدة العديد الأميركية.. هل يرتفع منسوب
...
-
على وقع الاحتجاجات في إيران.. هل باتت الحرب مع واشنطن أو تل
...
المزيد.....
-
قواعد الأمة ووسائل الهمة
/ أحمد حيدر
-
علم العلم- الفصل الرابع نظرية المعرفة
/ منذر خدام
-
قصة الإنسان العراقي.. محاولة لفهم الشخصية العراقية في ضوء مف
...
/ محمد اسماعيل السراي
-
الثقافة العربية الصفراء
/ د. خالد زغريت
-
الأنساق الثقافية للأسطورة في القصة النسوية
/ د. خالد زغريت
-
الثقافة العربية الصفراء
/ د. خالد زغريت
-
الفاكهة الرجيمة في شعر أدونيس
/ د. خالد زغريت
-
المفاعلة الجزمية لتحرير العقل العربي المعاق / اسم المبادرتين
...
/ أمين أحمد ثابت
-
في مدى نظريات علم الجمال دراسات تطبيقية في الأدب العربي
/ د. خالد زغريت
-
الحفر على أمواج العاصي
/ د. خالد زغريت
المزيد.....
|
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

 |
بحث
|
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
|
إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة