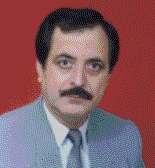|
|
علم العلم: الفصل الثالث: منطق العلم
منذر خدام


الحوار المتمدن-العدد: 8534 - 2025 / 11 / 22 - 10:07
المحور:
قضايا ثقافية
1-معنى المنطق
تجدر الإشارة، قبل توضيح معنى المنطق، إلى إن طبيعة أي علم تتحدد في ضوء موضوعه والغاية منه، غير أن غاية العلم هي التي تؤدي الدور الحاسم. فقد يشترك علمان في موضوع معين، ويختلفان في غاياتهما، فيصنفان كعلمين منفصلين. وإن الاشتراك في الغاية قد يؤدي إلى جمع موضوعات مختلفة. مثلا الاشتراك في زراعة ورعاية المحاصيل النباتية، يجمع علم التربة بعلم مقاومة الآفات بالعلوم الزراعية الأخرى ذات الصلة.
وبعد؛ ماذا يعني المنطق؟ ورد في لسان العرب:" المنطق من النطق، وهو يعني الكلام، والمنطيق: البليغ"[49]، والكلام هو "أصوات مقطعة يظهرها اللسان وتعيها الآذان"[50]، وصفة النطق تكاد تكون خاصية حصرية للإنسان، ولهذا يجري التمييز بين الناطق والصامت، فيقال لمن لديه صوت بالناطق ولمن ليس له صوت بالصامت.
أما المناطقة فيطلقون كلمة النطق على ملكة النطق وهي موجودة لدى الإنسان، وتسمى أيضا العقل أو الفكر، ومنها عرفوا الإنسان بأنه " حيوان ناطق"، أي الكائن الحي العاقل المتفكر. النطق لديهم هو التعقل وهو من مميزات الإنسان، وسمي العلم المختص بدراسة التعقل باسم المنطق.
يعود أصل علم المنطق إلى اليونان، حيث وضع أسسه ارسطوطاليس[51]، وكان متداخلاً كثيرا ًمع الفلسفة اليونانية. لقد نظر العرب في البداية إلى علم المنطق بتوجس كبير وحرم بعضهم الاشتغال فيه. المنطق بحسب السيوطي
ـــــــــــــــــــــــ
49-لسان العرب لأبن منظور، المجلد السابع، مادة: نطق، ص209.
50-إبراهيم الأنصاري، دروس في المنطق، المحاضرة الأولى، تاريخ الدخول إلى المسار18/6/2009
هو " فن خبيث مزموم، يجر إلى الفلسفة، يحرم الاشتغال به.."[52] لكن العرب لا حقا علي يد الغزالي وابن سينا وغيرهما أعادوا تقويم موقفهم من المنطق وأخذوا ينظرون إليه نظرة إيجابية. يقول ابن سينا " المنطق نعم العون على إدراك العلوم كلها". ويقول الغزالي " من لم يعرف المنطق فلا ثقة له في العلوم أصلا". ويقول عنه صديق بن حسن القنوجي في(أبجد العلوم) المنطق " هو علم يتعرف منه كيفية اكتساب المجهولات التصويرية والتصديقية من معلوماتها"[53].
تتعدد كثيرا تعريفات المنطق، وهي كما في حالة تعريف العلم تواجه مشكلة الإحاطة به من جميع جوانبه، وهذا أمر في غاية الصعوبة. ومهما تعددت تعريفات علم المنطق فإنها تظل تشترك في حقيقة واحدة وهي أن المنطق هو " قانون التفكير الصحيح".
يختص علم المنطق، إذاً، بتعليم كيفية التفكير الصحيح، و يعرض لهذا الغرض، جملة القواعد التي ينبغي مراعاتها، حتى يأتي التفكير بعيداً عن الانحراف، والخطأ. ولهذا فقد عرف علم المنطق أيضا، بأنه " علم يبحث عن القواعد العامة، للتفكير الصحيح"[54]. والمقصود بالقواعد، تلك التي تصح في
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
51-يعد أرسطو(348-322 ق.م)، هو واضع أسس علم المنطق، بصورته اليونانية الأكثر كمالاً، وقد عرضها في جملة مؤلفات تدعى (الأورغان Organon). ومن الذين ساهموا في تطوير علم المنطق فرفوريوس (304-233 ق.م)، من أهالي مدينة صور الساحلية، الواقعة في جنوب لبنان، وذلك في كتابه المدخل (إيساغوجي Isagoge) وقد ترجم كتابه، واختصره، أثير الدين المفضل بن عمر الأبهري (ت 663 هـ.ق = 1264). وكان للغزالي (توفي 505 هـ 1111م ) وللفارابي (950م) وابن سينا980-1037 م) مساهماتهم القيمة، في تطوير علم المنطق، وتأصيله، في الثقافة العربية الإسلامية.
52-إبراهيم الأنصاري، دروس في المنطق، مرجع سبق ذكره، المحاضرة التاسعة.
53-المرجع السابق
54- الموسوعة الحرة (ar.wikipedia.org www.)
مختلف مجالات وحقول التفكير الإنساني وهي مختلفة عن تلك القواعد التي تخص علماً بعينه. وهو الأداة التي يستعين بها الإنسان على العصمة من الخطأ" فكما أن النحو والصرف لا يعلمان الإنسان النطق، بل تصحيح النطق، كذلك علم المنطق لا يعلم الإنسان التفكير، بل يرشده إلى تصحيح التفكير"[55].
المنطق إذا، هو وسيلة للتفكير الصحيح في كافة مجالات العلوم على اختلافها، ولذلك سماه الأقدمون بالآلة وعرفوه بأنه " آلة قانونية تعصم الذهن، عن الخطأ في الفكر"[56]. وقيل عنه بأنه "علم الميزان" لأنه به توزن الحجج والبراهين. وقيل المنطق "علم الكلام" أو هو "خادم العلوم لأنه الوسيلة إليها"[57].
وبصفته هذه، فقد اعتبر من العلوم الآلية لا العلوم الذاتية، فهو في خدمة جميع العلوم الأخرى دون أن يكون هو ذاته علما مستقلاً. الإنسان عندما يفكر فإنه يفكر بمنطق أي أنه يراعي في تفكيره قوانين المنطق وقواعده بدقة حتى يتجنب الخطأ. وهو يحتاج إلى هذه القواعد والقوانين ليس فقط في مجال التفكير العلمي بل في المحادثات اليومية، وفي المجالات المعرفية. بدون المنطق، لا يستقيم تفكير الإنسان، ولا يستطيع الفصل بين الصواب والخطأ. ولهذا يسمى علم المنطق، أيضاً، بعلم القسطاس، والميزان[58]. فهو يحول دون الوقوع في الخطأ، مهما كانت أسباب الخطأ، نفسية، أم اجتماعية، أم اقتصادية، أم تربوية، أم بيولوجية، أم أخطاء ناجمة عن المنهج، وطرق البحث، غير السليمة. إن معرفة الأخطاء الناجمة،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
55- المرجع السابق
56-المنظومة ج 1 ص 6 والإشارات ص 9
57- أنظر المنطق: تعريفات الجرصاني ، مادة نطق. وشرح السمعية للقطب الرازي، والمنطق للشيخ محمد رضا المظفر.
58-اللمعات المشرقية ص 3 والمنظومة ج1 ص 3
عن صور الفكر، والفجوات بينها، يشكل، بمعنى معين، موضوع علم المنطق. بهذا المعنى، يندمج علم المنطق، بعلم المناهج.
2- أهمية المنطق
يعد التفكير ملكة الإنسان به يتميز عن غيره من الكائنات الحية. ولكي يكون تفكيره سليما صحيحا من ناحية الصورة والشكل، و من ناحية المحتوى والمضمون يحتاج إلى قوانين المنطق وقواعده من أجل تصويبه. بغير ذلك لا يستطيع الإنسان التفكير الصحيح، ولا يستطيع التمييز بين الخطأ والصواب. الغرض من المنطق" التمييز بين الصدق والكذب في الأقوال، والخير والشر في الأفعال، والحق والباطل في الاعتقادات"[59].
علم المنطق هو العلم الذي يستخدم لتصحيح عملية التفكير وتوجيهها بصورة سليمة في مختلف العلوم الأخرى. هنا لا بد من توافر شرطين: من جهة لا بد من توافر مخزون علمي لدى الذات المفكرة، ومن جهة ثانية لا بد من توافر قواعد المنطق. فمن ليس لديه مخزونات علمية لا يستطيع استخدام قواعد المنطق، وهو في حاله هذه كحال السباح بلا بحر أو النجار بلا خشب، أو الحداد بلا حديد.
يعد علم المنطق أساس التفكير السليم والصحيح فهو يبرمج ويرتب معلوماتنا الذهنية عن الموجودات الواقعية، بحيث تأتي صورة مطابقة لها،
ولهذا يسمونه أيضا بالمنطق الصوري لأنه يتعامل مع صورة التفكير وأسلوبه. فعلى سبيل المثال لتشكيل جملة من الكلمات الثلاثة الآتية: الولد، التفاحة، أكل، يوجد ست احتمالات هي: الولد التفاحة أكل، الولد أكل التفاحة، التفاحة الولد أكل، التفاحة أكل الولد، أكل الولد التفاحة. أكل التفاحة الولد. من بين هذه التراكيب اللغوي يساعد علم المنطق على اختيار الاحتمال الأكثر صحة والأكثر وضوحا، وهو في المثال السابق: أكل الولد التفاحة. لأن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
59-إبراهيم الأنصاري، دروس في المنطق، مرجع سبق ذكره.
الأصل في اللغة أن يتقدم الفعل الجملة الفعلية، يليه الفاعل ومن ثم يأتي المفعول به.
3- انقسام العلم إلى علم "حصولي" وعلم "حضوري".
صار واضحاً إذاً، إن موضوع علم المنطق هو قواعد التفكير الصحيح. غير إن التفكير لا يكون بدون تحصيل معلومات مسبقة في إطار منظومة متسقة من المفاهيم والقوانين والعلاقات والروابط التي تشكل قوام كل علم. وإذا كان العلم هو "انكشاف الشيء على ما هو عليه" فإنه من منظور علم المنطق ينقسم إلى علمين: علم حصولي، وعلم حضوري، تفرق بينهما ثلاثة فروق جوهرية[60].
الفرق الأول
-العلم الحصولي هو "حضور صورة المعلوم لدى العالم. أما العلم الحضوري فهو حضور نفس المعلوم لدى العالم".
في العلم الحصولي فإن ما ينعكس في ذهن العالم هو صورة المعلوم الذي هو الموجودات الخارجية، وما إن تنعكس فيه حتى تتحد معه لتكون صورة معقولة أو عقلاً أو تعقلاً للكائن الخارجي. فصورة الشيء الخارجي عندما يعلمها الإنسان تتجرد لتنسجم مع العقل الذي بها يتعرف على الموجودات الخارجية حتى بعد ابتعاد المعلوم عن صورته.
خلال هذه العملية المعرفية تنعكس صورة الأشياء في الذهن كما تنعكس صورة الأشياء في المرآة. لكن ثمة فوارق جوهرية بين الانعكاسين:
أولاَ؛ لا تدرك المرآة انعكاس الأشياء فيها، أما الإنسان فإنه يدرك انعكاس الأشياء والظواهر في عقله.
ثانياً؛ ترتبط الصورة المنعكسة في المرآة ارتباطاً ميكانيكياً بالشيء الموضوع أمامها، أما لدى الإنسان فالأمر أكثر تعقيداً. هنا ما إن يحصل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
60-إبراهيم الأنصاري، دروس في المنطق، مرجع سبق ذكره.
انعكاس صورة الأشياء في ذهنه حتى يعلم بها حضوريا، لأنها تصبح جزءاً من نفسه يعلم بها صدق وجود الشيء الذي انعكست عنه في الخارج. بكلام آخر يدرك الإنسان أن الذي حضر إلى نفسه هو نفس الكائن الموجود في الخارج في صورة ذهنية مطابقة وهذا هو جوهر العلم الحصولي.
يفرق العلم الحصولي بين نوعين من الموجودات: موجودات ذهنية، وموجودات خارجية مميزة. تسمى الموجودات الذهنية بالماهية التي هي نفس الشيء لا الشيء ذاته أي شيئيته. يعد الوجود الذهني للشيء وجوداً اعتبارياً ويبقى الوجود الأصيل في الخارج [61].
الفرق الثاني
في العلم الحصولي فإن "وجود المعلوم العلمي هو غير وجوده العيني"، أما في العلم الحضوري فإن "وجود المعلوم العلمي هو عين وجوده العيني". كيف يكون ذلك؟!
في العلم الحصولي تشكل صورة الشيء الموجودة في الذهن وجوداً علمياً له، في حين يبقى له في الخارج صورة أخرى هي صورة وجوده العيني المميز. وفي حين تتحد الصورتان في العلم الحصولي تظلان مختلفتين في السعة والضيق أو في الشدة والضعف.
أما في العلم الحضوري فالوجود العلمي للشيء هو عين وجوده العيني كما في علم النفس بذاتها وحالاتها من حزن وفرح وألم وحقد وحسد وحب وغيرها. إن العلم بهذه الموجودات لا يحصل في الذهن من خلال صورتها، بل من خلال حضورها ذاتياً فيه إذ يعرفها الإنسان معرفة حضورية.
الفرق الثالث
العلم الحصولي هو "تصور وتصديق"، لأن مكانه في الذهن حيث يحصل الإدراك الذي لا يكون بدون التصور والتصديق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
61- دروس في المنطق، مرجع سبق ذكره.
أما العلم الحضوري فإنه لا يعرف انقساماً كهذا لأن موطنه النفس. من جهته التصور هو إدراك الشيء إدراكاً بسيطاً خاليا من الحكم أما التصديق فهو إدراك الشيء والحكم عليه.
لا يقترن الإدراك البسيط (التصور) عادة، بتصديق وجود الشيء المتصور أو عدم وجوده كلاً أو جزءاً. والجزء هو العلم بكيفيات الشيء وحالاته من طول وعرض ولون وغيرها. مثلا تصور الهواء أو الجبل أو تصور الكرم والشجاعة، الخوف والحزن، أو تصور جمل بثلاثة رؤوس وهكذا دواليك. في حالة الإدراك البسيط لا تتم المطابقة مع الواقع، ولهذا فهو لا يصدقه، إنه من باب التصور الساذج.
أما الإدراك المقترن بالحكم مطابقا للواقع أو غير مطابق فهو من باب التصديق، أي إنه تصور يتبعه حكم وإذعان. مثلا عندما يقال " الكذب حرام"، ومن ثم يتم الإذعان لتحريم الكذب. كذلك الأمر في القول " العلم نور"و " الطقس حار" وغيرها من التصورات التي تتبعها مباشر أحكام معينة فهي من باب التصديق. وتكون من باب التصديق أيضاً الأحكام السلبية مادام يتم الإذعان لها كما في القول " الجو ليس حاراً". أما إذا لم يتم الإذعان للحكم وجرى التشكيك فيه يكون الإدراك من باب التصور فقط.
في ضوء ما سبق يمكن الاستنتاج أولاً؛ إن التصديق لا يتعلق بمفردات منفصلة بل بالعلاقة بينها كالفعل والفاعل، والموضوع والمحمول.
وثانياً؛ فإن النسبة التي يتعلق بها التصديق تتوقف على وجود طرفين رئيسيين هما؛ الموضوع والمحمول. يقوم الإدراك على تصورهما أولاً ومن ثم يدرك النسبة بينهما. بعبارة أخرى يتوقف التصديق على تصورات ثلاث هما: تصور الموضوع، وتصور المحمول، وتصور النسبة أو الرابط بينهما. فعلى سبيل المثال لكي يتم تصديق القول: أكل التفاحة ينبغي أولاً تصور كلمة (أكل)، وكلمة (التفاحة)، ومن بعد ذلك تصور العلاقة بينها التي بها يتم تصديق فعل الأكل.
نخلص من هذا التمييز بين العلم الحصولي والعلم الحضوري إلى القول بأن علم المنطق لا ينطبق على العلم الحضوري بل على العلم الحصولي وحده، فهذا الأخير هو الذي يشغل الذهن الذي به تتم عملية التفكير. وبناء عليه فإن التعريفات السابقة للعلم هي تعريفات للعلم الحصولي فقط.
غير أن العلم الحصولي لا يحصل ولا يبلغ مقاصده إلا بالعلم الحضوري، أي العلم بالصورة (مفاهيم، مقولات، لغة) الحاضرة في نفس الإنسان، مندمجة بها، وهي صور لمعلومات لها وجودها العيني خارج الذات العالمة، أو مندمجة في نفسه. بكلام آخر لا يستطيع الإنسان بالعلم الحصولي إدراك أي شيء خارجي بدون إدراكه لنفسه (أي لما فيها من مخزون معرفي سابق) ولحالاتها أولاً.
مما سبق يمكن استخلاص القاعدة الآتية؛ يتحول العلم الحصولي في النفس إلى علم حضوري ليستخدم لاحقاً في تحصيل العلم الحصولي.
4- انقسام العلم الحصولي إلى علم ضروري، وعلم نظري.
ينقسم العلم الحصولي إلى قسمين رئيسين هما: قسم ضروري أو بديهي، وقسم نظري أو اكتسابي. وحسب التصور والتصديق يكون العلم الحصولي أربعة أقسام: التصور الضروري، والتصديق الضروري، والتصور النظري، والتصديق النظري.
التصور الضروري أو البديهي فهو التصور الذي يحصل بداهة دون حاجة إلى تفكير وإمعان للنظر كتصور الوجود أو العدم.
أما التصديق الضروري فهو تصديق يحصل أيضاً دون الحاجة إلى التفكير أو إمعان النظر كتصديق إن الكل أكبر من الجزء، أو إن 2+2=4، أو إن النقيضين لا يجتمعان.
من جهته التصور النظري أو الاكتسابي فهو يحتاج إلى إمعان النظر فيه، وإلى إجراء عملية تفكير. مثلاً تصور الكهرباء أو الحرارة، أو تصور حركة الأرض.
قد يحصل التباس بين بعض التصورات النظرية مثلاً؛ لا يشبه تصور الكهرباء والذرة تصور الماء والشجر وغيرها من الموجودات التي يمكن مشاهدتها ومعايشتها. والفرق، في الحقيقة، ليس في التصور بحد ذاته بل في تصديق التصور. فعندما يتم تصور الشجرة نعلم إنها موجودة في الخارج أي يصدق تصورها وجودها العيني الضروري، أما تصور الكهرباء أو الروح وتصديقه يكون نظرياً أيضاً.
ويحصل أيضاً، التباس بين التصورات البديهية(الضرورية)، والتصورات النظرية، في حين أنها تختلف فيما بينها بصورة جذرية. ولإزالة هذا الالتباس ينبغي أن يكون واضحاً إن التصورات البديهية هي تصورات مفردة، أما التصورات النظرية فهي تصورات مركبة. بكلام آخر إذا كان المفهوم التصوري بسيطا فهذا يعني إنه مفهوم بديهي، أما إذا كان مركبا فهو على العكس يكون مفهوماً نظرياً. فعلى سبيل المثال مفهوم الإنسان هو مفهوم مركب لأن الإنسان هو تكوين مركب، لأنه كائن حي ينمو ويكبر ويموت وهو يحس وينطق وغيرها من مكونات. فلا يمكن إدراك حقيقة الإنسان بدون إجراء عمليات معرفية كثيرة.
أما تصور مفهوم "الوجود"، أو مفهوم "العدم"، أو مفهوم "الإمكان" أو مفهوم "الكل أكبر من الجزء"، فهذه المفاهيم وأمثالها تعد مفاهيم بسيطة واضحة لا تحتاج إلى إجراء عمليات فكرية معرفية عليها.
بتكثيف يمكن القول إن المفاهيم التي تحتاج إلى تعريف هي مفاهيم نظرية، إذ إن التعريف بها يتطلب ذكر أجزائها والفصل فيما بينها. أما المفاهيم التي لا تحتاج إلى تعريف وشرح وبسط لكونها بسيطة (غير مركبة) فهي مفاهيم ضرورية أي بديهية. التصورات النظرية تحتاج إلى التفكير أما التصورات الضرورية فإنها تحتاج إلى الحجة [62].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
62- دروس في المنطق، مرجع سبق ذكره، المحاضرة الثامنة
5- الجهل
يحسب المناطقة إن دراسة العلم تتطلب البحث في نقيضه، أي في الجهل الذي هو بالتعريف "عدم العلم". ويطلق الجهل على من شأنه أن يعلم ولا يستعمل إطلاقاً للحكم على الكائنات التي هي بطبعها غير قادرة على العلم. فلا يقال، مثلاً إن الشجرة جاهلة أو إن الحيوان الفلاني جاهل، بل يقال إن الإنسان الفلاني جاهل.
والجهل ليس واقعا ماديا أو ذهنيا. ففي الخارج كما في الذهن لا يوجد شيء أسمه الجهل. وإذا كان الإنسان لا يعلم شيئا ما فإن ذهنه يكون خاليا من صورته ولهذا يكون جاهلا بها. لا يمكن معرفة الجهل إلا بالعلم، ولولا المفاهيم التصورية أو التصديقية لفقد الجهل معناه. فلا يمكن تمييز الجهل إلا بواسطة الموجودات التي صورها الإنسان في ذهنه وعلم بها مسبقاً. فعلى سبيل المثال؛ الحكم بأن "الجو حار" يتطلب وضوحا مسبقا لمفهوم "الجو"، ومفهوم "الحر"، ومفهوم "الجو حار". وإذا كان جاهلا بالنسبة الحكمية بينهمافعليه أن يعرف المفاهيم الثلاثة السابقة.
يعرف الجهل بدلالة العلم كما ذكرنا. فقد ورد في لسان العرب تحت مادة "جهل"؛ الجهل: نقيض العلم، وجهلت الشيء إذا لم تعرفه، والجهالة: أن تفعل فعلاً بغير علم"[63].
وفي الاصطلاح إذا كان العلم هو "حضور صورة الشيء في الذهن"، فإن الجهل هو "عدم حضور صورة الشيء في الذهن". والجهل حاصل سواء علم الجاهل بعدم وجود صورة الشيء في ذهنه أو لم يعلم أصلاً [64].
وكما إن العلم ينقسم إلى علم تصوري وعلم تصديقي، كذلك الأمر ينقسم الجهل إلى جهل تصوري وجهل تصديقي. مثلاً عدم القدرة على تصور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
63-لسان العرب لابن منظور، المجلد الأول، مادة جهل، ص 480
64- دروس في المنطق، مرجع سبق ذكره، المحاضرة السابعة.
الكهرباء أو الذرة فهو جهل تصوري لأن الكهرباء والذرة والجن وغيرها ليست موجودات عينية. أما عدم تصور النسبة بين البرودة وحالة الجو فهو جهل تصديقي لأنه يتعلق بالنسبة بين الجو والبرودة.
ويكون الجهل بسيطاً ومركباً. فعندما تجهل شيئاً وتعلم أنك جاهل به يكون جهلك بسيطاً، أما عندما تجهل شيئاً ولا تعلم إنك جاهل به يكون جهلك مركباً. في هذه الحالة ثمة جهل بالواقع وجهل بالجهل ذاته.
إن العلم بجهل العلم بشيء ما هو نصف العلم به، ويبقى العلم بالشيء المجهول ذاته الذي يمكن العلم به من خلال القيام بعملية معرفة وتفكير. لقد جاء في المأثور من الكلام "حسن السؤال نصف العلم" [65].
أما من لا يعلم أنه جاهل فلا يمكنه الخروج من جهله، وهذه هي حال أدعياء العلم الذين يصرون على أوهامهم الباطلة. يقول ابن سينا في كتابه الإشارات والتنبيهات: " إياك وفطنة بتراء" يقصد الجهل المركب. فالجاهل الذي يعلم بجهله، يمكنه أن ينجح في الحياة من خلال ضبط تصرفاته حتى لا يتورط في المشاكل التي تنجم عادة عن ادعاء المعرفة. لقد قيل "إن الوجود الناقص للأشياء أفضل من عدمه المحض، إلا العلم بالشيء فوجوده الناقص ليس أفضل من عدمه، لأن الإنسان الذي لا يعلم الشيء علماً كاملاً ويتخيل أنه يعلمه لا يسعى في تعلمه فيتورط في الجهل المركب".
6- قواعد التوجه وأهميتها للمعرفة.
إن سلامة التوجه المعرفي ضروري لعملية اكتساب المعرفة بصورة عامة، ولمعرفة البديهيات بصورة خاصة. ثمة في الحياة بديهيات كثيرة نجهلها بسبب عدم التوجه إليها وأخذها بالحسبان. ولكي يتحقق التوجه بصورة صحيحة ينبغي مراعاة ما يأتي:
أ- الانتباه: وهو ضروري في جميع الأمور البديهية منها وغير البديهية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
65- نهج البلاغة، شرح ابن أبي الحديد المعتزلي، ج18، ص 108.
على حد سواء. فقد لا يسمع سليم السمع صوتاً لأنه غير منتبه إليه وقد لا يرى بعض الأشياء رغم أنه ينظر إليها بسبب عدم تركيز انتباهه. مثل هذه الأمور تحصل كثيراً في الحياة الواقعية لكن ينبغي أن لا تحصل في العلم، فالعلم لا يقبل أقل من الانتباه الكامل والتام.
ب- سلامة الذهن: سلامة الذهن(المخ) ضرورية أيضاً للإدراك بصورة عامة، فسقيم الذهن لا يستطيع إدراك الموجودات الضرورية أو التصورية على حقيقتها، بل ينتج تصورات غير حقيقية عنها. إن سلامة الذهن حسب بعض العلماء أهم شرط للتفكير السليم. ثمة شواهد كثيرة على إن الإنسان قد يفقد بعض حواسه لكنه بفضل ذهنه السليم يستطيع تصور الموجودات وحتى إنتاج معرفة بها تكون على درجة عالية من الغنى والعلمية. خير شاهد على ذلك أبو العلاء المعري وطه حسين، وديفد هوفكنز عالم الفلك البريطاني المشهور.
ت-سلامة الحواس: إن سلامة الحواس في حال سلامة الذهن تعد من الشروط اللازمة للمعرفة الصحيحة. فالأعمى لا يستطيع رؤية أوضح الأشياء وفاقد السمع لا يستطيع سماع أجهر الأصوات وينطبق ذلك على الحواس الأخرى.
ث-فقدان الشبهة: تسبب الشبهة الاختلاط والظن والشك. فقد يظن أحدهم بإمكانية اجتماع النقيضين كاجتماع النور والظلمة مثلاً. في المسائل البديهية قد لا يكون للشبهة تأثير ذو مغزى لأنها بطبيعتها لا تقبل الشبهة. غير إنها قد تحرفها ونتائجها عن مسارها الصحيح. إن ما يفقد الشبهة حضورها في مجال العلم هو التركيز والانتباه والتقيد بمناهج البحث العلمي بصورة صارمة ورصينة.
ج-عمليات غير عقلية: الكثير من البديهيات تحتاج إلى عمليات غير عقلية، أي إلى تشغيل الحواس، وإلى القيام بالتجربة. مثلاً؛ إذا كنت في غرفة مظلمة ولكي تتأكد من طلوع الشمس فعليك أن تخرج من الغرفة. فالنظر في المنظورات والسمع في المسموعات، والتجربة في التجريبيات، كلها بديهيات لا تحتاج إلى عمليات عقلية. في غير هذه المسائل مثلاً، لكي تحصل المعرفة العلمية ينبغي حصول العمليات العقلية.
بعد استنفاد أسباب التوجه المشار إليها يطرح السؤال الآتي: هل يفتقر المعلوم إلى الفكر والنظر لكي يدرك؟ فإذا كان الجواب بالإيجاب، عندئذ يكون المعلوم من النظريات، وإلا فهو من الضروريات( أي من البديهيات)[66].
#منذر_خدام (هاشتاغ)



ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

|
حفظ
 |
بحث |
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
| إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
علم - العلم ( مناهج البحث العلمي،الفصل الثاني فلسفة العلم
-
مناهج البحث العلمي-الفصل الأول-ما هو العلم؟
-
أسئلة الديمقراطية في الوطن العربي في عصر العولمة(الفصل الساد
...
-
أسئلة الديمقراطية في الوطن العربي في عصر العولمة(الفصل الخام
...
-
أسئلة الديمقراطية في الوطن العربي في عصر العولمة(الفصل الراب
...
-
أسئلة الديمقراطية في الوطن العربي في عصر العولمة(الفصل الثال
...
-
أسئلة الديمقراطية في الوطن العربي في عصر العولمة(الفصل الثان
...
-
رهانات الاسد والسقوط الكبير
-
أسئلة الديمقراطية في الوطن العربي في عصر العولمة(الفصل الأول
...
-
العرب والعولمة( الفصل السادس)
-
العرب والعولمة( الفصل الخامس)
-
العرب والعولمة( الفصل الرابع)
-
العرب والعولمة( الفصل الثالث)
-
العرب والعولمة(الفصل الثاني)
-
العرب والعولمة( الفصل الأول)
-
العرب والعولمة( مدخل)
-
العرب والعولمة(مقدمة)
-
في المنهج-دراسة نقدية في الفكر الماركسي( الفصل الحادي عشر)
-
في المنهج-دراسة نقدية في الفكر الماركسي( الفصل الهاشر)
-
في المنهج-دراسة نقدية في الفكر الماركسي( الفصل التاسع)
المزيد.....
-
كيف أثارت ملفات إبستين نظريات مؤامرة متضاربة حول عمله لصالح
...
-
سقوط -إل مينشو- يهزّ المكسيك… هل قتلته قوات أميركية؟
-
عشرون دولة أوروبية ومسلمة تحذر من مسار الضم الإسرائيلي في ال
...
-
روبيو يعتزم لقاء قادة الكاريبي وسط ضغوط على كوبا وفنزويلا
-
نجاة القيادي موسى هلال من هجوم للدعم السريع شمال دارفور
-
تفجير انتحاري وسط موسكو.. مقتل شرطي والمهاجم
-
فرنسا تقيد صلاحيات السفير الأميركي.. ما القصة؟
-
-أنا من يتخذ القرار-.. ترامب يجدد وعيده وينفي معارضة رئيس هي
...
-
على خلفية قضية إبستين.. الشرطة البريطانية توقف بيتر ماندلسون
...
-
أعنف هجوم منذ الإطاحة بالأسد.. داعش يقتل 4 من الأمن السوري
المزيد.....
-
قواعد الأمة ووسائل الهمة
/ أحمد حيدر
-
علم العلم- الفصل الرابع نظرية المعرفة
/ منذر خدام
-
قصة الإنسان العراقي.. محاولة لفهم الشخصية العراقية في ضوء مف
...
/ محمد اسماعيل السراي
-
الثقافة العربية الصفراء
/ د. خالد زغريت
-
الأنساق الثقافية للأسطورة في القصة النسوية
/ د. خالد زغريت
-
الثقافة العربية الصفراء
/ د. خالد زغريت
-
الفاكهة الرجيمة في شعر أدونيس
/ د. خالد زغريت
-
المفاعلة الجزمية لتحرير العقل العربي المعاق / اسم المبادرتين
...
/ أمين أحمد ثابت
-
في مدى نظريات علم الجمال دراسات تطبيقية في الأدب العربي
/ د. خالد زغريت
-
الحفر على أمواج العاصي
/ د. خالد زغريت
المزيد.....
|
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

 |
بحث
|
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
|
إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة