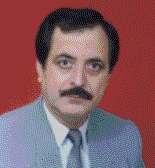|
|
علم - العلم ( مناهج البحث العلمي،الفصل الثاني فلسفة العلم
منذر خدام


الحوار المتمدن-العدد: 8524 - 2025 / 11 / 12 - 04:48
المحور:
قضايا ثقافية
1- معنى الفلسفة
يعود أصل كلمة "فلسفة" إلى اللغة اليونانية، وهي تعني "الحكمة"، والحكمة في لسان العرب تعني " معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم" ومنها "الحُكْمُ"؛ أي "العالم وصاحب الحكمة". وتعني أيضاً " العلم والفقه والحكم بالعدل" [30]، والفيلسوف هو الحكيم.
وفي الاصطلاح الفلسفة هي العلم الذي تشكل الأسئلة الكبرى موضوعه، مثل أسئلة الوجود، وأسئلة المعرفة، وأسئلة المسائل الأساسية في الحياة. إن تحديد معنى كلمة "فلسفة" يصطدم، في الواقع، بصعوبات جمة، بسبب كون الموضوعات التي تعالجها على درجة عالية من التعقيد، وتثير الجدل والاختلاف، ولهذا فإن الفلسفة اتجاهات ومدارس ومذاهب كثيرة.
ولد الإنسان في بيئة يحيط بها الغموض فأخذ يساءل نفسه لماذا هو موجود؟ ومن أوجده؟ لماذا هو يفكر؟ وكيف يتكون تفكيره؟ ما معنى الخير والشر؟، ما معنى القيم والمثل؟ ما معنى الجمال؟ ما معنى الحياة والموت؟ وهكذا أسئلة كثيرة أخذت تتناسل من حوله، تثير فيه التعجب وحب الاستطلاع، وتنمي فيه الرغبة في المعرفة والفهم.
الفلسفة في الوقت الراهن تجاوزت حدود التأمل في الوجود لتقوم بتفسيره، ونقده وتغييره. ولهذا فهي ضرورية في العلم والحياة، بل لا يكون التقدم، بصورة عامة، بلا فكر فلسفي يمهد له الطريق ويكشف له الأفق ويحدد له المعالم.
تتميز الفلسفة بتاريخها الطويل، لدى شعوب الهند والصين ولدى الشعوب الأوربية، على وجه الخصوص، الذين ساهموا بتطويرها بوتائر سريعة،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-لسان العرب لابن منظور، المجلد الثاني ، مادة حكم، ص129. أنظر أيضا المجلد الخامس منه ، مادة فلس، ص156
بتطويرهم العلوم الطبيعية. من المعلوم أن بين الفلسفة والعلوم الطبيعة علاقات متبادلة، فعندما تتطور العلوم الطبيعية وتكتشف حقائق علمية جديدة تدقق الفلسفة أطروحاتها. من جهتها تزود الفلسفة العلوم الطبيعية بالمفاهيم والمقولات العلمية وتعلمها كيفية طرح الأسئلة.
وإذا كانت الفلسفة شديدة الارتباط بالعلوم الطبيعية إلا أنها تنسج علاقات قوية مع غيرها من العلوم، مثل العلوم الاجتماعية ومنها العلوم الاقتصادية التي تشكل الحاضنة الاجتماعية والمادية لتطور الفلسفة.
تتكون الفلسفة من مذاهب ومدراس عديدة لكنها، رغم ذلك، تبقى في إطار مجالين كبيرين مجال الفلسفة المادية، ومجال الفلسفة المثالية. يتحدد مجال انتماء المذاهب الفلسفية ومدارسها إلى المجال المادي أو المجال المثالي في ضوء الإجابة عن السؤال: أيهما وجد أولاً؛ الوعي الاجتماعي أم الوجود الاجتماعي؟
وإذا كان الخوض في تصنيفات المذاهب والمدارس الفلسفية يقع خارج اهتمام هذا الكتاب، رغم ذلك، لا بد من الوقوف قليلا لقول بضع كلمات على الفلسفة التحليلية التي ظهرت في القرن العشرين وكان لها دور كبير في التقدم المعرفي لذي حصل فيه.
لقد شهد العالم في القرن العشرين تقدما كبيراً على صعيد العلوم التجريبية فغاص في أعماق الذرة والخلية والجزيئات الصغيرة مستكشفاً ومعيداً تطبيق مكتشفاته مراكماً تقدماً وازدهاراً في حياته العامة. وكان الفضل الكبير في حصول هذا التقدم للعلوم الرياضية والعلوم الأساسية بمنهجها الرياضي التحليلي.
إن السمة الأبرز للقرن العشرين هي سمة التحليل التي تتطلب الواقعية في الفكر، وهي سمة عنوانها التحول من المذاهب المثالية إلى المذاهب المادية، سمة أدت إلى ثورة المفكرين والفلاسفة على ما هو مطلق ومثالي مستفيدين من الحقائق العلمية الجديدة في العلوم المادية المختلفة. ولهذا تعد الفلسفة المادية التحليلية من أبرز المذاهب الفلسفية المعاصرة التي تعبر عن روح العصر العلمية، والرياضية [31].
2-سؤال الفلسفة الأول.
أيهما وجد أولاً؛ الوجود الاجتماعي أم الوعي الاجتماعي؟ هذا هو السؤال الأول في الفلسفة أجابت عنه المذاهب الفلسفية المختلفة بطرق مختلفة مما أدى إلى انقسامها إلى مذاهب مادية ومذاهب مثالية.
إن صيغة السؤال السابق هي صيغة خاطئة، فليس بين الوجود الاجتماعي والوعي الاجتماعي أولوية وجودية. فالوجود الاجتماعي لا يكون إلا وجوداً واعياً، وإن الوعي هو السمة الجوهرية والضرورية للوجود الاجتماعي.
لقد تحول الوجود البشري إلى وجود اجتماعي بواسطة الوعي، وبه أخذ يتطور. لقد صنع الإنسان بوعيه أدوات الإنتاج ونظم وجوده وشيد الدول والحضارات وغيرها. فالوعي ليس السمة الأكثر جوهرية للوجود الاجتماعي فقط، بل هو الشرط المادي الضروري لوجوده وتطوره.
أيهما وجد أولاً؛ الوجود البشري أم الوعي؟ هذا هو السؤال الصحيح. ويقصد بالوجود البشري وجود النوع البشري في حالة جماعية مهدت لوجود إمكانية الوعي لديه، ومن ثم الوعي ذاته في سياق حركة معقدة جداً. الوجود البشري سابق على الوعي من حيث الوجود لأن شرط وجود الوعي هو وجود الذات الواعية أي النوع البشري.
3- كيف يتكون الوعي؟
كيف يتكون الوعي؟ وما هي علاقته بالوجود الاجتماعي؟ للإجابة عن هذين السؤالين لا بد، في البداية، من تحديد المعنى الاصطلاحي لكل من مفهوم " الوجود الاجتماعي "، ومفهوم " الوعي الاجتماعي ".
ـــــــــــــــــــــــــــ
31- الفلسفة التحليلية، www.700b.net، تاريخ الوصول3/3/2008
يقصد بالوجود الاجتماعي جميع العلاقات والروابط القائمة فعلا بين الناس بعضهم تجاه البعض الأخر وبينهم من جهة والطبيعة من جهة ثانية.
ويقصد بالوعي الاجتماعي جميع الأفكار التي تصوغ هذه العلاقات والروابط وتعبر عنها، إضافة إلى التكوين النفسي للناس الذي يتجلى في جملة الاستعدادات والقابليات النفسية التي تؤسس لاتخاذ كل منهم مواقف مختلفة تجاه الخارج. بهذا المعنى فان الوجود الاجتماعي والوعي الاجتماعي لا يوجدان منفصلين ولا يسبق أحدهما الأخر.
إذا نظرنا إلى المجتمع في سياق حراكه وتغيره فإن لحظة الوعي الأولى(الفكرة) تسبق دائما من حيث الوجود العلاقة المطابقة لها في الوجود الاجتماعي. فعلاقات الوجود الاجتماعي لا تكون إلا بعد مرورها في الوعي أولاً، فهذه سمتها الجوهرية. ونظراً لأن الأفكار التي تسعى إلى خلق علاقات مطابقة لها في الوجود الاجتماعي تولد وتموت باستمرار ففي الوضعية السكونية للمجتمع، وهي وضعية افتراضية (في لحظة زمنية معينة)، توجد دائما أفكار ليس لها ما يطابقها في علاقات الوجود الاجتماعي، إما لأنها لم تولد بعد أو لم تتح لها الفرصة كي تولد أو لأنها اندثرت وانحجزت في التاريخ.
لكن هل يستطيع جهاز التفكير لدى الإنسان (المخ) مهما حاول الإمعان في التجريد والتخيل أن يخلق صورة ذهنية (فكرة)، لعلاقة واقعية أو متخيلة ليست مركبة من عناصر الوجود العام؟ الجواب هو بالنفي. فالفكرة (الصورة الذهنية) تتعلق دائما، عند ولادتها، بموضوع معين من مواضيع الوجود العام الذي يحفز وجودها بداية. غير أنه عندما تخلق الفكرة العلاقة المطابقة لها في الوجود الاجتماعي فإن هذه العلاقة تصبح حقيقية بغض النظر عن المسار اللاحق للفكرة التي أنتجتها أول مرة، وبغض النظر عن مدى اقتراب الفكرة أو العلاقة من حقيقة الأشياء بذاتها.
إن الوعي الاجتماعي، كفضاء عام، يعكس دائما الوجود الاجتماعي بشكل صحيح ومطابق. لكن إذا نظر إليه من الداخل فسوف يبدو بنية متمايزة ومختلفة، خصوصا، لجهة المصداقية المعرفية. من الناحية المنطقية يحاول الوعي أن يصوغ علاقات الوجود الاجتماعي بما يتطابق مع حقيقتها بذاتها، لكن ذلك لا يحصل مرة واحدة ونهائية، بل عبر حركة مستمرة ودائمة للاقتراب أكثر فأكثر منها. في سياق هذا الاقتراب اللامتناهي للوعي من حقيقة الأشياء بذاتها تتغير الأفكار تصير أكثر دقة ومصداقية فتتغير العلاقات بين الذات الواعية (الإنسان) وموضوعات وعيها.
وقد يحصل العكس تماماً، فتولد أفكار وتصورات تضخم ما هو واقعي، أو تصغره، أو تعيد تركيبه، بصورة مختلفة، في هذه الحالة فان الأفكار لا تعكس الواقع بشكل صحيح، ولا تقدم معرفة حقيقة به. وقد تبلغ درجة الخطأ في تصوراتنا وأفكارنا حداً كبيراً يبدو الواقع، عندها، مزيفاً تماماً. هذا ما يحصل عادة، في مجال التصورات الميتافيزيقية والأسطورية. لكن مهما كانت الفكرة خاطئة ومزيفة من ناحية صدقية حمولتها المعرفية فإنها تخلق ما يطابقها من علاقات في الوجود الاجتماعي.
إن تاريخ اقتراب معارفنا من حقيقة الأشياء الموضوعية، كما هي بذاتها، هو تاريخ وجود الإنسان الاجتماعي ذاته، أنه تاريخ الحقيقة التاريخية، كما تظهر في سياق تطور الإنسان، والحقيقة الموضوعية، كما هي في ذات الأشياء والظواهر. من هذه الزاوية تبدو الحمولة المعرفية للتصورات الأسطورية والدينية كحقائق تاريخية، تحوز على درجة عالية من المصداقية.
4- دور الفعالية البشرية (النشاط) في وجود الوعي.
ينشأ الوعي الاجتماعي في سياق الفعالية الإنسانية (التجربة)، ولهذا فإن الفعالية الإنسانية تسبق وجود الوعي بغض النظر عن الشكل الذي يأخذه.
إذا سرنا عكس حركة التاريخ (نحو الماضي) يبرز بوضوح الدور الكبير للفعالية الإنسانية المتعلقة بالإنتاج المباشر لشروط ومقومات وجود الكائن البشري. لكن مع تطور الإنسان والمجتمع، أخذت هذه الفعالية تكتشف ميادين جديدة، وتضيف مكونات للوجود الاجتماعي والوعي الاجتماعي. يجري الحديث، في الوقت الراهن، عن الفعالية في مجال الفكر كحقل مستقل نسبيا للممارسة الإنسانية.
لكن لماذا ينتج الوعي عن الفعالية الإنسانية بصفتها تفاعل مستمر بين الإنسان والطبيعة؟ من المعروف إن جميع الكائنات الحية تتفاعل مع وسطها الحيوي دون أن تنتج وعيا به (بحسب ما هو مستقر حتى الآن). الإنسان وحده يتميز عن جميع الكائنات الحية الأخرى بقدرته على التخيل والعمل الهادف (أيضا بحسب ما هو مستقر حتى الآن).
إن وظيفة المخيال (جهاز التخيل) عند الإنسان هي في إعادة إنتاج الواقع ذهنيا، ومن ثم إعادة تركيبه بصورة مختلفة إلى هذا الحد أو ذاك بما يلبي حاجة الإنسان إلى الوجود والتطور، أو بدافع منهما معاً. هذا هو الاتجاه العام لعمل المخيال. لكن قد يحصل العكس تماما فيتجاهل المخيال علاقات وروابط ونواميس الواقع، وعندما يقوم بإعادة تركيبه لاحقا، فإنه يخلق صورة مزيفة وواقعا مزيفا. لذلك يجري الحديث عن إمكانيتين للتخيل أو وضعيتين لعمل المخيال: في الوضعية الأولى يتميز المخيال بطابعه التجاوزي التقدمي الذي يقود إلى الكشف والإبداع ويحرض على التقدم. وفي الوضعية الثانية يتميز المخيال بطابعه النكوصي والرجعي الذي ينتج وهما يخضع الإنسان له، أو يكرس وعيا يشد حركة المجتمع إلى الوراء.
إن وجود المخيال في الوضعية الأولى أو الثانية ومدى فعاليته يتعلق بالشروط الاجتماعية والسياسية والثقافية للإنسان التي تحكم تفاعله مع وسطه الصناعي أو الطبيعي. كما إن انقسام المجتمع إلى طبقات وفئات اجتماعية وأشكال عديدة للوجود الاجتماعي ( قبائل، وعشائر وطوائف، ومذاهب، وإثنيات ،وعائلات، وأحزاب وغيرها ) واختلاف مصالحها يؤدي دورا كبيراً في وجود الوضعيتين السابقتين لعمل المخيال. ومن الأهمية بمكان على هذا الصعيد الكيفية التي تحقق بها مختلف أشكال الوجود الاجتماعي مصالحها.
من حيث المبدأ كلتا الوضعيتين للمخيال ضروريتان للتقدم الاجتماعي فهو يتحقق من جراء جدلهما. ويعد خطأً الحكم المطلق على وضعية المخيال وما ينتج عنه من خيال إلا في السياق التاريخي الملموس للحراك الاجتماعي ومنطق التاريخ في كل مرحلة من مراحله. إن ما ينسب في الوقت الحاضر إلى المخيال الرجعي كان تقدمياً، وما هو تقدمي اليوم قد يصبح رجعيا غدا. وما هو رجعي من زاوية معينة قد يبدو تقدميا من زاوية أخرى. في كل ذلك فإن معيار الحكم، هو جدل الحراك الاجتماعي، وضرورات تطوره [32] .
5- هل تفسر نظرية الانعكاس عملية تشكل الوعي لدى الإنسان.
إن صلة الوعي الاجتماعي بالوجود الاجتماعي هي صلة حقيقية. ولهذا يمكن تشبيه عملية تشكل الوعي بما يحصل في المرآة. فكما إن المرآة لا تعكس إلا صور الأشياء الحقيقية فالمخيال، من جهته، لا يخلق وعيا إلا للروابط والعلاقات الحقيقية يكون هو ذاته صورة ذهنية لها.
لا شك بأن عملية تشكل الوعي لدى الإنسان أكثر تعقيدا بما يحصل أمام المرآة فهي تفترض وجود تفاعل ملائم للإنسان بوسطه الصناعي والطبيعي. في داخل هذه العملية التفاعلية المعقدة يمكن تمييز مستوين مترابطين لتكوين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
32-يقول إنجليز ( لم يبقى الآن من الممكن أن تثير في نفوسنا الاحترام تلك المتضادات المستعصية على الميتافيزياء القديمة التي لا تزال مع ذلك واسعة الانتشار حتى الآن، كالمتضادات بين الحقيقة والخطأ بين الشر والخير، بين التشابه والاختلاف، بين الضرورة والصدفة. ونحن نعلم أن لهذه المتضادات قيمة نسبية فقط: أي أن ما هو معترف به في الوقت الحاضر كحقيقة له جانبه الخاطئ المختفي الآن ولكنه يظهر مع الزمن … وان ما هو معترف به الآن كخطأ له جانبه الحقيقي الذي بسببه كان من الممكن اعتباره سابقا كحقيقة، وان ما يعتبر ضروريا يتألف بكامله من صدف، وان ما يدعى بالصدفة إنما هو الشكل الذي تتستر وراءه الضرورة، وهكذا دواليك) ماركس، إنجليز، المختارات في عشر أجزاء/
المعرفة: مستوى المعرفة الحسية (وعي حسي)، ومستوى المعرفة المجردة (المفاهيم). في حدود المستوى الأول، تنطبع صورة العلاقات الواقعية في الذهن (وهو ذهن تاريخي بالضرورة) كما تنطبع الصور والإشارات في الأجهزة الفيزيائية (المرآة، المسجلة وغيرها) لأن مبدأ عمل الحواس، وهي أجهزة فيزيائية حيوية، لا يختلف عن مبدأ عمل الأجهزة الفيزيائية العادية.
أما في المستوى الثاني لإنتاج المعرفة؛ أي مستوى المفاهيم والمقولات فتجري عمليات معقدة جدا تحكمها الخبرة والتجربة واللغة. في هذا المستوى يكون المخيال في وضعية التقدم والتجاوز أو في وضعية النكوص والتراجع.
وإن علاقة المستوى الأول بالمستوى الثاني لعملية تكوين الوعي ليست علاقة ميكانيكية فالمخيال يستطيع إنتاج المفاهيم والمقولات والتصورات بالاعتماد على تراكمات الخبرة السابقة. وفي مجمل الأحوال فان معيار صدقية ما نتخيله من مفاهيم ومقولات وأفكار هو التجربة [33]
6-الفلسفة والعلم
لقد كان العلم، في مرحلة من التاريخ، مندمجا بالفلسفة، غير أن تطور المجتمع الإنساني، والنضج المعرفي الذي بلغه، حكم عليهما بالانفصال، فاكتفت الفلسفة بقضايا التفكير المجرد، والتأمل، والتدبر في الكون، والوجود. في حين حصر العلم اهتمامه، بالمجالات التي تطلب الملاحظة، والتجربة، والقياسات الكمية، والبراهين الرياضية، وصولا إلى صياغة الفرضيات، والنظريات، والقوانين[34]. لقد تحقق انفصالهما بصورة تدريجية، وفي زمن طويل، مع ذلك لا يزالان يحافظان على أوثق العلائق، والروابط فيما بينهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
33-انظر لينين في (المادية والمذهب التجريبي النقدي) ص 230 و (المادية التاريخية والجدلية) إصدار دار التقدم، موسكو ص 226.
5-دومينيك لوكورت (2001) فلسفة العلوم، من سلسلة Sais-je que, Presse universitaire Fransaise الرقم التسلسلي العالمي:5516522130-978 ISBN
من جهته لا يستطيع العلم الاستغناء عن الفلسفة فهي تكشف له الأفاق البعيدة وتزوده بأعم المناهج والمقولات والمفاهيم. بدورها الفلسفة لا تستطيع الاستغناء عن العلم لبناء عالمها الفكري وتطوير مقارباتها النظرية.
ويبقى للعلم فلسفته الخاصة به (Epistemology) التي تعبر عن منطقه الداخلي وعن انتظامه في كيانه الخاص الذي يؤطره مستقلاً نسبيا عن الفلسفة.
تعد فلسفة العلم (أو العلوم)، فرعا من فروع الفلسفة يشكل العلم موضوعها. بصورة أدق فهي تبحث في مبادئ العلوم وفي مناهجها ولغتها المفهومية. وهي التي تحدد الفرق بين العلم وغيره من العلوم الإنسانية، وفي أهمية ودور النظريات العلمية في حياة الإنسان. وهي تدرس أيضاً في مباحث خاصة منطق العلم ومناهجه بصورة تفصيلية وأساليب البحث العلمي وتحدد شروطه وظروفه.
من فضائل هذه الفلسفة أنها تسمح بتقدير القيمة المعرفية النظرية للنظريات العلمية وتحدد طبيعتها وتساعد في الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمصدر المعرفة، أي التجربة، أو المبادئ العقلية السابقة على التجربة.
بغض النظر عن الموضوعات التي تعالجها فلسفة العلم فهي تتطلب من الباحثين العلميين التقيد الصارم بأربعة مبادئ وهي الآتية:
أ-الصرامة في المنهج. يتطلب هذا المبدأ احترام المعايير العلمية، والتماسك المنطقي الداخلي بين الأفكار، وتطابق النظرية مع الظواهر التي تحكمها.
ب-الموضوعية وصلاحية التعميم. يفترض هذا المبدأ تحقق الإجماع والحيادية في قبول صحة المعرفة التي يتم التوصل إليها. مثلا العلاقة 2+2 = 4 تصح لدى مختلف الشعوب في أي مكان من الكرة الأرضية.
ت-تراكم المعرفة. يقتضي هذا المبدأ أن ينظر إلى المعرفة على إنها عملية تراكمية يضاف الجديد منها إلى القديم ويبنى عليه ليكونا معاً تاريخ العلم المستمر.
ث-التحقق والدحض. يتطلب هذا المبدأ من العلم أن ينقد نفسه باستمرار، ويعيد مواجهة الوقائع الجديدة بالبراهين، ويضع لنفسه قواعد معينة في زمن معين. الخطأ في العلم هو من طبيعة العلم ذاته وحقائق العلم ليست مطلقة بل نسبية، لكن لا يكون العلم علما بدون قواعد وضوابط ومعايير، وبدون نقد دائم ومستمر لحقائقه.
7- أنواع التعقل
التعقل أربعة أنواع وهي [35] :
أ-العقل بالقوة وهو جملة الاستعدادات والقابليات التي تولد مع الطفل. عند الولادة يكون ذهن الطفل خالياً من أية معلومات أو صور أو إشارات.
ب- العقل التفصيلي وهو العقل الذي يبدأ بالتشكل بعد الولادة، إذ يبدأ عقل الطفل يتلقى صوراً ومعلومات من الوسط الخارجي وتتجمع لديه بصورة أولية ليشكل منها معقولات فعلية. يستطيع العقل التفصيلي استنادا إلى المعلومات التفصيلية المتراكمة لديه أن يميز بين المعقولات بعضها عن البعض الأخر. تتشكل في هذه المرحلة أسماء الأشياء، فعندما يلفظ كلمة طاولة تظهر في ذهنه صورة معينة لها، وعندما يلفظ كلمة فرح فإن صورة الفرح لا تظهر في ذهنه، بل صورة لحالة فرح يكون قد عايشها بالتجربة.
ت- العقل الإجمالي هو العقل الذي يتشكل من جراء تراكم المعلومات والصور في الذهن بصورة أولية ليشكل منها معقولات بسيطة، لكنها في الغالب الأعم، تكون منطوية على تفاصيل كثيرة. فعلى سبيل المثال عندما تسترجع الذاكرة ما كانت حفظته من نصوص أو مواضيع فإن الاسترجاع يكون بصورة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
35-عبد الجبار الرفاعي، في أنواع التعقل،تاريخ الدخول إلى المسار22/5/2009
متدرجة ومتسلسلة بحسب ما يحضر في الذهن من الذكرى المسترجعة، على شكل كلمات أو صور ورموز. هذه التفاصيل لا توجد في الحافظة إلا في لحظة التذكر فما هو موجود هو الصورة الإجمالية للنص أو الموضوع الذي يجري تذكره ينوب عنها في الغالب الأعم عنوانه أو اسمه أو رمزه.
ث- العقل التفاعلي. تذكر المراجع عادة العقول الثلاثة الأولى التي تم ذكرها نضيف إليها عقلا رابعا ندعوه بالعقل التفاعلي. فبعد مستوى معين من التراكم المعرفي نتيجة التعلم أو التجربة يتكون ما يسمى بالعقل التفاعلي (المفهومي)، أي العقل الذي يعقل الأشياء بواسطة المفاهيم، ويمكنه إعادة إنتاجها انطلاقا من هذه الأخيرة. يستطيع العقل التفاعلي أيضاً، أن ينتج مفاهيم ونظريات جدية انطلاقا من حقل الفكر يعيد خلق ما يطابقها في الواقع. ندعو هذا العقل أيضا بالعقل العلمي أو العقل الإبداعي وهو عقل لا يكتفي بتمثيل الواقع بل يتجاوزه إلى واقع جديد بصورة مستمرة ودائمة.
8-الثنائية، وقضايا الفلسفة.
يتكون الوجود بما فيه الحياة الإنسانية من ثنائيات متضادة يقوم بينها علاقات تفاعلية تتميز بطابعها الصراعي. مثلا؛ الخير والشر، السالب والموجب، الوجود والعدم، الذكر والأنثى وغيرها. يدرس العقل هذه الظاهرة محاولاً كشف وظيفتها في الحياة والكون وكيف تقوم بوظيفتها.
يعد من الناحية التاريخية الفيلسوف الفرنسي بليز باسكال (1623-1662) أول من اشتغل على ظاهرة الثنائيات في الوجود وحاول تفسيرها بإحالتها إلى الطبيعة البشرية. يقول باسكال " إنا نعرف الحقيقة لا بالعقل وحده بل بالقلب أيضاً"[36]. يعرف القلب المبادئ الأولى(البديهيات) التي يعجز العقل عن البرهان عليها، فالمعرفة لا تكون إلا بالعقل والقلب معا مع أنهما متناقضان أيضاً.
تتمثل حقيقة الوجود في بنائه على مبدأ راسخ هو مبدأ الثنائية الذي منه تنبعث مختلف الأحكام في جميع الميادين. ومما يميز هذا المبدأ هو العلاقة
غير المتوازنة بين طرفيه والتي تشكل علة الحركة والتغير الدائمين فيه.
لقد حاول الفلاسفة عبر التاريخ، توحيد ثنائيات الوجود، في مبدأ واحد، وجاءت محاولاتهم على أوجه أربع: منهم من عدّ الوجود كله، روحاً خالصة، وما تبقى لا يعدو كونه أعراض لها.
ومنهم من عدّ الوجود، مادة خالصة، ترد إليها جميع الأرواح، إذا وجدت.
ومنهم من شطره إلى شطرين مستقلين: روح، ومادة، وحسبهما على مستوى واحد، من الأولية، والأصالة.
ومنهم من يرد الوجود إلى الكثرة، ويرى أنه لا داعي لجمعه في مبدأ واحد.
9- أخلاق العلم.
يكتشف العلم العالم ويصفه بطريقة افتراضية ويخبر بما وجد. غير إن نتائج العلم سوف تطبق على المجتمع الذي تحاول السياسة بناء نظامه على الصورة التي ترغب بها.
وإذ تبحث السياسة عن هذا النظام فهي، من الناحية العملية، تبحث في القيم والمعايير التي سوف يبنى عليها هذا النظام. تقوم بين العلم الذي يبحث في الوقائع والسياسة التي تبحث في القيم ثنائية يصعب حلها بالعلم والتقنية وحدهما.
العلم يكتشف ويبتكر وسائل تقنية تساعد في حل مشكلات كثيرة، وفي تحقيق أهداف معينة. ولكي يقوم العلم بوظيفته عليه أن يراعي العقلانية في الوسائل وأن يزيد قدرة الناس على تحقيق الغايات.
من جهتها السياسة تسأل: كيف سوف تستخدم هذه القدرة؟ وما هي الغايات التي سوف تحققها التقنية؟ بعبارة أخرى إن المشكلات الأخلاقية والسياسية تتجاوز عقلانية الوسائل إلى عقلانية الغايات، وإن هذه الأخيرة ينبغي أن تحوز على أهمية أكبر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
36- الإطار الفلسفي للتوفيقية: محاولة في تحليلها، ص 1، تاريخ الدخول إلى المسار10/2/2009.
من المعروف إن الوسائل يمكن أن تستخدم بطرق مختلفة بعضها ضار وبعضها نافع، ولهذا ينبغي إيجاد معايير معينة لطرق استخدامها. تجاه هذه المسألة ينقسم الفلاسفة. منهم من يركز اهتمامه على العلم وحده ولا يعير اهتماماً للمشكلات الأخلاقية والسياسية. ومنهم من يركز جل اهتمامه أولاً على المعايير الأخلاقية والسياسية قبل اختيار الوسائل. ففي حين يركز فلاسفة المدرستين الوضعية والوجودية اهتمامهم على عقلانية الخيارات السياسية والأخلاقية. فإن فلاسفة المدرسة النقدية العقلانية يرون بأن المشكلة يمكن حلها جوهريا عن طريق عقلانية القرارات التي هي ضرورية في العلم كما في السياسة.
إن حل المشكلة بين عقلانية الوسائل وعقلانية الغايات، أي بين التضاد الظاهري بين العقلانيتين يكمن في وحدة الإبداع والنقد. الإبداع يكتشف لنا الحلول للمشكلات أما النقد فإنه يتفحص النتائج، ولهذا فإن الإبداع والنقد ضروريان في العلم وفي جميع ميادين المعرفة.
10- العقلانية في العلم.
هل يحصل العلم بالعمل الشاق أو بالإلهام؟ أثار هذا السؤال ولا يزال يثير جدلاً في أوساط الفلاسفة. البعض منهم (الاستقرائيون) يظنون أن العلم يحصل من جراء تعميم الملاحظات الكثيرة التي يتم جمعها عن موضوع معين في فرضيات تشكل اكتشافاً جديداً، ولهذا فإن الإبداع في العلم، حسب رأيهم، ليس له معنى فهو زائد عنه.
غير إن فيلسوف العلم الحديث كارل بوبر (1959)، يميز بين سياق الاكتشاف وسياق التسويغ، أي بين سياق عملية تصور الأفكار الجديدة وعملية امتحانها نقدياً. يرى بوبر إن المخيلة الإبداعية ضرورية لتسويغ الفرضيات الجديدة، فالعمل الشاق لا يكفي لوحدة فهو بحاجة إلى المخيلة الإبداعية، أي إلى الإلهام [37].
37- " أسطورة الإطار " لكارل بوبر (1970)
ويرى الفيلسوف نوروود رسل هنسن (1958)، وتوماس س.كهن (1962)، إن الفرضية الجديدة التي تجعلنا نرى العالم بطريقة جديدة بحاجة إلى المخيلة الإبداعية. الفكرة الجديدة ضرورية وهي لا تحصل من جراء الملاحظة تلقائيا بل هي بحاجة إلى المخيلة الإبداعية، وإن الشعور بالخطأ في العلم، ضروري لتجاوزه [38].
بطبيعة الحال تحتاج الفرضيات الإبداعية الجديدة دائما إلى امتحان النقد الذي يحصل بالتجربة. غير أن التجربة قد تخطئ أيضا مما يعقد كثيراً من نقد الفرضيات الجديدة.
ثمة رأي يقول إن القبول الدغمائي لبعض نتائج العلم هو رأي خاطئ مادام يمكن اختبار الفرضيات الأساسية نقديا، وينطبق ذلك على الإطار النظري أيضاً.
ينبغي أن يكون واضحاً إن الاختبار النقدي لا يستطيع أن يظهر الحقيقة المطلقة ولهذا ليس ثمة من منهج لتسويغ الفرضيات العلمية، فالحقيقة " بجمالها المطلق والعاري غير مكشوفة لنا"[39]، لهذا فهي بحاجة إلى المخيلة الإبداعية، لابتكار فرضيات جديدة، تختبرها بكل جدية، وصرامة. وفي هذه الحالة أيضا، ينبغي أن يكون واضحاً، إن أشد الاختبارات صرامة، ليست معصومة عن الخطأ.
يعرف العلم، ما يسمى مفهوم "الريبية"، ومفهوم " النسبية "، ومفهوم " الشك"، وباستخدام المخيلة الإبداعية، والجرأة في النقد، يمكن الاقتراب من الحقيقة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
38-غونار اندرسن، الإبداع والنقد في العلم، من وكيبيديا، الموسوعة الحرة، ص 14
39- أنظر الموسوعة الحرة ص 15
11- الشك في العلم.
سيطرت لزمن الطويل المعتقدات الدينية والأسطورية على العقل العلمي، وكبلته بجملة من اليقينيات الدوغمائية مرغمة إياه على تقبلها دون تمحيص، ودون تساؤل، ودون شك. غير إن القرن السابع عشر أحدث تغيرات جوهرية في طرائق التفكير تحت تأثير الثورة المعرفية والمنهجية التي فجرها جاليليو ونيوتن والتي قامت أساسا على منهج الشك. ورغم المقاومة العنيفة التي واجهت طريقة جاليليو في التفكير من قبل المؤسسات الدينية الكنسية، إلا أنها شقت طريقها إلى عصر النهضة الذي أعاد إحياءها من جديد لتساهم في تطور العلوم، وفي الثورة الصناعية التي أدت إلى خروج أوربا إلى العالم.
والشك المقصود هو الشك المنهجي، وهو يختلف عن الشك المطلق مع أن لهما البداية ذاتها، ويستخدمان الحجج ذاتها في نقدهما للمعرفة الحسية أو العقلية. فالشك المنهجي يقر بوجود الحقيقة لكنه يرفض التسليم بها دون فحص وتمحيص واختبار على عكس التسليميين (الاعتقاديين) سواء أكانوا من التجريبيين أو العقليين. فهو يرى ضرورة تحليل المبادئ الأولى للمعرفة ويعتمد الحذر والحيطة كمنطلق للوصول إلى الحقيقة. الشك المنهجي لا يسلم بدون مناقشة ونقد، فكرة كون العقل عند العقليين قادر على تحصيل المعرفة وفكرة إن التجربة هي مصدر كل معرفة كما عند التجريبيين. فالشك بهذا المعنى هو طريقة في التفكير تتخلص أولاً من الأفكار التي لا تأنس لها النفس لتقيم على أنقاضها أفكارا أخرى ترتاح لها النفس وتأنس.[40]
بطبيعة الحال لم يكن أمام الفلسفة خيار سوى القبول بمذهب الشك خصوصا، بعد أن اتضح أن التفكير العلمي الرصين والفعال يبدأ من الشك بالأفكار والمعلومات والحقائق القائمة أو الجديدة. هكذا بدأت مسيرة تحرير
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
40- د. راجح الكردي، الشك المنهجي- المعرفي تاريخ الدخول إلى المسار6/4/2009
العلم من الإيمان إذ يعد الفيلسوف فرانسيس بيكون من أوائل من أسس فلسفة الشك كطريق لتحصيل المعرفة. يقول بيكون: الشك له فائدتان: الفائدةالأولى؛ وهي إنه يشبه الدرع في الفلسفة يحمي صاحبه. والفائدة الثانية؛ وهي إنه يحفز على المزيد من المعرفة.[41]
يرى بيكون، إن عملية المعرفة، تبدأ بالتجربة الحسية الغنية بالملاحظات الدقيقة ثم يأتي دور استخراج النتائج. بطبيعة الحال لا يكفي عدد قليل من الملاحظات أو الأمثلة لاستخلاص نتائج مقنعة، ومستقرة، بل لا بد من الكثير منها على أن تشمل الحالات المتشابهة والشاذة.
12- أهمية فلسفة العلوم في تكامل المعرفة.
إن مسألة كيفية إدراك الواقع شكلت على الدوام موضوع خلاف بين النظريات الفلسفية. فالوضعية [42] على سبيل المثال ترى أن الواقع يمكن فهمه من خلال وصف موجوداته المميزة، وكلما كان هذا الوصف دقيقاً وتفصيلياً وشاملاً أمكن بـ"القياس إدراك الظواهر المكانية في عزلة وانفصال كاملين" [43].
تكمن حجتها في كون الواقع مميزاً في موجودات منفصلة فلا يوجد واقع بالمعنى العام بل مفهوم عن الواقع. ما هو موجود ليس سوى موجودات منفصلة مميزة يشار إليها بأسمائها. يمكن مثلاً، رؤية الفراشة دون رؤية الزهرة التي تقف عليها. ويمكن الشعور بالنار دون رؤية اشتعال الحطب. فحسب الموقف الوضعي "الإحساسات هي كل ثروتنا من المعارف"[44].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
41- ولد فرانسيس بيكون في لندن في الثاني والعشرين من شهر يناير من عام 1561 ميلادية، وعمل في جامعة كمبريدج، ومن ثم رحل إلى فرنسا واشتغل في السفارة الانجليزية، ومن ثم عاد إلى وطنه ليشغل منصب مستشار الملكة إليزابيث.
42- مؤسس هذه الفلسفة هو الفرنسي أغوست كونت، فحسب رأيه فأن أساس المعارف جميعها هو المعطيات الحسية. لقد قسم تاريخ المعرفة إلى المرحلة الاسطورية ثم مرحلة الفلسفة ثم مرحلة الميتافيزيقا وأخيرا المرحلة الوضعية.
43-ناجح شاهين،"فلسفة العلوم ودورها في تكامل المعرفة"، تاريخ الدخول إلى المسار 20/10/2009.ص1
44- المرجع السابق،ص 1
ومع أن الفلسفة الوضعية لم تسد إلا مدة قصيرة من الزمن، في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، خصوصا، في البلدان الأنكلوسكسونية التي سيطرت عليها الوضعية، على امتداد النصف الأول من القرن العشرين فإنه يمكن القول بأن المعرفة في العصور الحديثة كانت تعبر خير تعبير عن الفهم الوضعي.
لقد تسببت الوضعية بإصرارها على القياس الحسي وخصوصا، المكمم منه بتراجع الفلسفة بصورة عامة، ومعها فلسفة العلوم بصورة خاصة. وقد ادت الثورة الصناعية الأوربية دوراً كبيراً وهاماً في هذا المجال بتركيزها على التجربة العلمية الوضعية المحسوبة كميا بدقة عالية. غير إن تعقيدات الواقع شكلت صدمة لما بشر به نيوتن في الميكانينا، فالواقع ليس كله ميكانيكا. كما أن مذهب ديكارت في الرياضيات هو الآخر، تعرض لصدمة قوية. لقد تبين إنه ليس " بناء منطقياً متسقاً ". وطالت الصدمة، أيضاً، الطموح الوضعي المشبع بالمادية الميكانيكية [45].
أمام هذا الوضع ونتيجة للتطورات التي حصلت في العلوم الفيزيائية، واكتشاف وجود ظواهر لا يمكن قياسها حسيا إضافة إلى اكتشاف وجود ظواهر جدلية في الطبيعة والمجتمع بحسب البراهين التي قدمها كل من هيغل وماركس والتي مهدت لحصول مراجعة جذرية وعميقة للمذهب الوضعي تتجاوزه إلى رؤية جديدة لفلسفة العلوم فكانت الكانتية.
لقد أحدثت الكانتية في حينه ثورة ضد الوضعية، وكان من المتوقع أن تخلي الوضعية مواقعها، لكنها لم تفعل إلا جزئيا (في الفيزياء، والعلوم الطبيعية) إذ بقيت مسيطرة على الضد من منطقها على العلوم الاجتماعية والإنسانية التي لا تقبل التكميم. لقد حصل ذلك بسبب هيمنة الولايات المتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
45- فلسفة العلوم ودورها في تكامل المعرفة ، مرجع سبق ذكره، ص 2.
الأمريكية على العالم الغربي ومنه امتدت تأثيراتها إلى العلوم الاجتماعية في أغلب دول العالم.
بحسب المذهب الوضعي فإن سلوك البشر لا يمكن فهمه إلا من جراء وصفه حسيا، ولهذا فهي تدعو إلى تجزئة العلوم الاجتماعية بحيث يتخصص كل منها بوصف جانب من سلوك الإنسان. غير إن الواقع العملي قد بين أنه من الصعب تجزئة الظواهر الإنسانية وإخضاعها للتجريب فقط. فسلوك الإنسان لا يمكن فهمه إلا بكليته، إي من خلال تداخل العوامل النفسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتاريخية وغيرها فيه[46]. فعلى سبيل المثال إن نجاح المشروع الإسرائيلي في فلسطين لم يكن ثمرة جهود الصهاينة المؤسسين فقط، بل تداخلت فيه عوامل عديدة مثل اتفاق المصالح الأوربية، وضعف العالم العربي، وظروف حياة اليهود المعزولة، والشحن الدينين والنفسي غيرها كثير. بكلام أخر، لا يمكن تفسير الظواهر الاجتماعية من خلال تأثير عامل واحد يمكن قياسه بالتجربة الحسية.
إن فشل الوضعية في تفسير الظواهر الاجتماعية ساعد في ظهور مذاهب فكرية وفلسفية جديدة مثل البنيوية التي ترى أن الوجود الواقعي يتكون من "مستويات تترابط بنيويا"، وإن أي " نقطة في المجال مشروطة ببقية النقاط وتؤثر فيها"، كما ظهرت المذاهب النقدية مستفيدة من التطورات التي أحدثتها الهيغلية والماركسية في حقل الفلسفة والدراسات الاجتماعية ومن أهمها ما صار معروفاً بمدرسة فرانكفورت [47].
لقد بدأت الوضعية مع ظهور هذه المدارس الفكرية الفلسفية بالتراجع عن مواقع كان وجودها راسخاً فيها. لكنها لم تخلي الساحة حتى حصلت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
46- تقول بذلك جميع المدارس الماركسية، أنظر بهذا الخصوص، سمير أمين، في كتابه " البعد الثقافي للأمة العربية".
47- من أبرز مفكري هذه المدرسة، التي أنشئت في منتصف عشرينات القرن العشرين في ألمانيا،هربت ماركوز وماكس هوركهيمر وهابر ماس.
الإضرابات الطلابية في فرنسا في عام 1968، إذ عجزت عن التنبؤ بها. وهكذا لم يعد المنطق الوضعي القائل بضرورة تفتيت الظواهر الاجتماعية أو العضوية الحية إلى أجزاء صغيرة من أجل دراستها حسيا مقبولاً. فهذا التفتيت، لا يفسر كيفية اشتغالها، كعضوية كاملة.
لم يكن ظهور الوضعية تعبيرا عن رغبة اعتباطية أو مدروسة لا فرق، لأغوست كومت أو غيره من فلاسفة هذه المدرسة الفلسفية الكبيرة، بل تعبيراً عن ظروف موضوعية وتطورات هائلة على صعيد العلوم المختلفة أدت في المحصلة لانفصالها عن الفلسفة وتخصصها في أطر أضيق فأضيق. هذه العملية المستمرة والأخذة في التعمق هي التي قادت الفلاسفة الوضعيين للقول بأن العلوم الدقيقة منفصلة ولا علاقة لها ببعضها البعض وان الموجودات الكلية يمكن فهمها من خلال فهم أجزائها وهذا ما تقوم به العلوم المتخصصة. غير إنه منذ النصف الثاني من القرن العشرين فقد حسمت تطورات العلوم هذه النظرة الجزيئية وأزاحت الوضعية عن عرشها.
لم تكن الوضعية هي النظرية الفلسفية الوحيدة التي تصدت للإجابة عن أسئلة مصادر المعرفة، بل تركت نظريات أخرى كبيرة بصماتها على تاريخ الفكر الإنساني عموما مثل الماركسية. فالقول بحتمية الظواهر الاجتماعية بالقياس إلى حتمية الظواهر الفيزيائية أوقع الماركسيين في تبسيط كبير. ربما تعود سيطرة هذا الاتجاه في الماركسية إلى أنجلس في كتابه جدليات الطبيعة، وإلى التوسير الذي زعم بأنه يمكن بناء نظام معرفي اجتماعي ماركسي يضاهي في دقته علوم الفيزياء. لم تأخذ الماركسية بجدية كبيرة مسألة الوعي ومسألة حرية الإنسان في تكوين وتغيير ظواهر الواقع فركزت فقط على العوامل المادية.
وللتغلب على العقل الأداتي الوظيفي الذي قالت به الوضعية وعلى المادية الجدلية الفجة بحتميتها بدأت في فرنسا وألمانيا حركة فكرية معاصرة تدعو إلى موقف يريد أن يقرأ " الكل بأدوات تعمل على رؤية التفاصيل في البناء الكلي ".
إن تكامل المعارف تنبع بالأساس من تكامل الواقع ذاته. ويبدو هذا التكامل أكثر وضوح في الظواهر الاجتماعية. مثلا لا يمكن فصل ظاهرة التعليم في مجتمع معين عن حاضنته الاقتصادية الاجتماعية، ولا يمكن فصل الاقتصاد عن التعليم وهكذا دواليك بالنسبة لظواهر أكثر جزئية وخصوصية.
إن حل الإشكالية القائمة في مقاربة الواقع معرفيا يطرح مخرجين متكاملين: الأول منهما يتمثل في تطوير العلم النظري والتطبيقي. والثاني يطرح تطوير المعرفة غير الرسمية بما تتضمنه من ثقافة شعبية. وفي كلا المجالين يؤدي التعليم الرسمي والشعبي دوراً مهماً جداً.
العقل البشري لا يعرف التخصص فعندما يحاول التفكير في موضوع معين تتزاحم لديه موضوعات كثيرة تحاول التأثير بعضها عاطفي وبعضها الآخر اقتصادي أو كيماوي أو تاريخي. بكلام آخر فإن العقل لا يعرف سوى الاتصال المعرفي وبخاصة على صعيد " الفعالية المدركة المنتجة للمعرفة"[48] أيا كان محتواها. من هنا يصير واضحا، مدى الأهمية التي تلعبها فلسفة العلوم، في تكامل المعرفة. رغم ذلك فهي تغيب بصورة شبه كاملة عن جامعاتنا.
ـــــــــــــــــــــ
48- فلسفة العلم ودورها في تكامل المعرفة، مرجع سبق ذكره،ص 9
#منذر_خدام (هاشتاغ)



ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

|
حفظ
 |
بحث |
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
| إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
مناهج البحث العلمي-الفصل الأول-ما هو العلم؟
-
أسئلة الديمقراطية في الوطن العربي في عصر العولمة(الفصل الساد
...
-
أسئلة الديمقراطية في الوطن العربي في عصر العولمة(الفصل الخام
...
-
أسئلة الديمقراطية في الوطن العربي في عصر العولمة(الفصل الراب
...
-
أسئلة الديمقراطية في الوطن العربي في عصر العولمة(الفصل الثال
...
-
أسئلة الديمقراطية في الوطن العربي في عصر العولمة(الفصل الثان
...
-
رهانات الاسد والسقوط الكبير
-
أسئلة الديمقراطية في الوطن العربي في عصر العولمة(الفصل الأول
...
-
العرب والعولمة( الفصل السادس)
-
العرب والعولمة( الفصل الخامس)
-
العرب والعولمة( الفصل الرابع)
-
العرب والعولمة( الفصل الثالث)
-
العرب والعولمة(الفصل الثاني)
-
العرب والعولمة( الفصل الأول)
-
العرب والعولمة( مدخل)
-
العرب والعولمة(مقدمة)
-
في المنهج-دراسة نقدية في الفكر الماركسي( الفصل الحادي عشر)
-
في المنهج-دراسة نقدية في الفكر الماركسي( الفصل الهاشر)
-
في المنهج-دراسة نقدية في الفكر الماركسي( الفصل التاسع)
-
في المنهج-دراسة نقدية في الفكر الماركسي( الفصل الثامن)
المزيد.....
-
السعودية.. فيديو وافد مصري خبأ مخدرات في -صهريج- وقود
-
سوريا.. الجيش الأمريكي يسحب آخر قواته من منشأة عسكرية رئيسية
...
-
سوريا.. الداخلية توضح عمليات احتيال فيما يسمى -الدولار المجم
...
-
-عناصر الهجرة يطاردون أشخاصاً في مينيابوليس أثناء خروجهم لرم
...
-
ترامب يلغي حكماً تاريخياً يقضي بأن الغازات الدفيئة تعرض الصح
...
-
هل تستطيع إيران إغلاق مضيق هرمز؟ وكيف سيؤثر ذلك على العالم؟
...
-
كوريا الشمالية تهدد بـ-رد رهيب- على أي توغل جديد لمسيرات كور
...
-
الحزب الوطني البنغلاديشي يحقق فوزا كاسحا بالانتخابات البرلما
...
-
جونسون يوجّه توبيخا نادرا لإدارة ترمب على خلفية وثائق إبستين
...
-
مرشح ترمب لمنصب بوزارة الخارجية يواجه عقبة بسبب -آرائه المعا
...
المزيد.....
-
قواعد الأمة ووسائل الهمة
/ أحمد حيدر
-
علم العلم- الفصل الرابع نظرية المعرفة
/ منذر خدام
-
قصة الإنسان العراقي.. محاولة لفهم الشخصية العراقية في ضوء مف
...
/ محمد اسماعيل السراي
-
الثقافة العربية الصفراء
/ د. خالد زغريت
-
الأنساق الثقافية للأسطورة في القصة النسوية
/ د. خالد زغريت
-
الثقافة العربية الصفراء
/ د. خالد زغريت
-
الفاكهة الرجيمة في شعر أدونيس
/ د. خالد زغريت
-
المفاعلة الجزمية لتحرير العقل العربي المعاق / اسم المبادرتين
...
/ أمين أحمد ثابت
-
في مدى نظريات علم الجمال دراسات تطبيقية في الأدب العربي
/ د. خالد زغريت
-
الحفر على أمواج العاصي
/ د. خالد زغريت
المزيد.....
|
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

 |
بحث
|
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
|
إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة