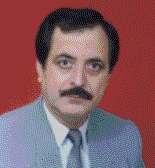|
|
مناهج البحث العلمي-الفصل الأول-ما هو العلم؟
منذر خدام


الحوار المتمدن-العدد: 8519 - 2025 / 11 / 7 - 08:38
المحور:
قضايا ثقافية
الفصل الأول
ما هو العلم؟
1-مقدمة
لقد صار العلم جزءا، من حياتنا، فحيثما توجهنا، نصادف منجزاته، من حولنا، هي معنا في الملبس، والمأكل، والمشرب، والمسكن، هي معنا في السفر، والترحال، هي معنا في اللعب، والترفيه، هي معنا، في كل ما يتعلق بحياتنا. وأكثر من ذلك، بفضل العلم، صرنا نتطلع، إلى عوالم أخرى، سواء الكبير منها، كعوالم الفلك، والمجرات، أو الصغير منها، كعوالم الخلية، والذرة. وتدخلنا، بفضله أيضا، في جوهر الحياة، فتمكنا من إعادة تخليقها، حسب الطلب، أو إعادة نسخها مطابقة، من عدم.. بفضل العلم، نصبح كل يوم، أكثر حرية.
وفي مجال الزراعة، يتدخل العلم، في كل شيء، في البذرة، والشتلة، والغرسة، يرشدنا كيف نستنبتها، ونرعاها، ونحميها، بل يتدخل، في قوامها الوراثي، فيستنبط أصنافاً جديدة، أكثر إنتاجية، وأقل تطلباً، تجاه شروط الزراعة.
ويتدخل العلم، في العمليات الزراعية، وشروطها، فيرشدنا إلى نوعية الخدمات، التي ينبغي تقديمها للمزروعات، وكميتها، وأوقاتها، وكيف نرعاها، ونحميها، من الأمراض، حتى تؤتي أوكلها. وفوق ذلك، يقدم لنا العلم الوسائل التقنية، لإنجاز العمليات الزراعية المختلفة. لقد ولى إلى غير رجعة، ذلك الزمن، الذي كان الإنسان ينجز فيه جميع العمليات الزراعية يدويا، أو بوسائل بدائية، بمساعدة الحيوانات.
وإذا كانت الزراعة، بسبب من موضوعاتها، التي هي كائنات حية، لا تزال ترسم حدودا للعلم، يصعب تخطيها، في الوقت الراهن، فإن الصناعة لا تعرف حدوداً، تعيق تقدم العلم، فبالعلم أعيد بناؤها، وبالعلم تشتغل، وبالعلم يعاد تشكيلها، باستمرار.
وفي مجال الطبيعة، والحياة، يخطو العلم واثقاً، يحطم قيود غاليليو، ونيوتن، وبافلوف، وغيرهما، إلى غير رجعة. لم يبقى مجال، من مجالات الوجود، إلا ودخله العلم بقوة، محققا النجاح تلوى النجاح، على طريق الاقتراب، من حقيقة أشياء، وظواهر الوجود، بذاتها.
لو حاولنا توصيف العصر الراهن، بكلمات قليلة، لصح منا القول؛ إنه عصر العلم والتكنولوجيا، بل عصر الثورة العلمية، والتكنولوجية. هو عصر علمي، وتكنولوجي، لأننا أينما ولينا نظرنا، سوف نشاهد منجزاته، وأثاره، وهو عصر ثورة علمية، وتكنولوجية بحق، لأن مفهوم الزمن العلمي، والتكنولوجي، قد تغير جذريا، فأصبحنا نسير معه، بسرعات كبيرة، غير مألوفة. لقد صدق القول؛ إن ما أنجز على الصعيد العلمي، والمعرفي، خلال القرن الماضي، يعادل ما اكتشفته البشرية، خلال تاريخها كله، وما يتم اكتشافه، في عقد من السنين، بل خلال بضع سنين، يعادل قرونا من الزمن، في الوقت الراهن.
ويبقى السؤال هل للعلم علم؟
للوهلة الأولى؛ يبدو السؤال عينه، غير ذي معنى، فكيف يكون للعلم علم، خاص به، حتى الحديث عن العلم، بلغة المفرد، لا يستقيم، فالعلم علوم متمايزة، بتمايز موضوعاتها، وما أكثرها، من موضوعات، وهي تتناسل، في كل يوم، لتولد موضوعات جديدة، وعلوم جديدة. لم يعد من الممكن، لكثرتها، الإحاطة بأسمائها، فكان لا بد من ولادة علم متخصص، في إحصاء، وتصنيف العلوم، وتقسيمها، إلى عائلات كبيرة، أم صغيرة، تشكل مستوعبات، لعدد كبير من العلوم المفردة، والجزئية، في إطار العائلة الكبرى. نتحدث في الوقت الراهن، عن عائلة العلوم الأساسية، وعائلة العلوم الاجتماعية، وعائلة العلوم الزراعية، وعائلة العلوم الطبية، وعائلة العلوم الهندسية، وهكذا دواليك. وعلى الرغم، من كل ما يميز عائلات العلوم، بعضها عن البعض الآخر، إلا أنها تنسج بينها، علاقات قرابة وتجاور، لا تستطيع أن تستغني عنها. فإذا كان، على سبيل المثال، علم الاقتصاد الزراعي، ينتمي إلى عائلة العلوم الاقتصادية الصغرى، إلا أنه أصيل النسب أيضا، إلى عائلة العلوم الاجتماعية الكبرى، وإلى عائلة العلوم الزراعية، وينسج علاقات قرابة، أو جوار، مع العلوم الرياضية، والإحصائية، وغيرها، من عائلات العلوم الأخرى. وبحكم تدخله في جميع مناحي حياتنا الراهنة، لا يوجد مجال علمي معين، إلا وله صلة به. ويمكن بالطريقة ذاتها، الحديث عن بقية العلوم، حتى المتخصص والضيق منها.
من الواضح إن الجواب عن السؤال: هل يوجد علم معين، في مجال معين؟ لا يشكل صعوبة، فهي علوم معاشة، ونلمس نتائجها، كل يوم، في حياتنا. لكن أن يكون لكل هذه العلوم، علم معين جامع، هنا تكمن المشكلة، وهنا يصير الشك بمصداقية السؤال، عن علم العلوم، في محله، خصوصا، لدى غير المختصين. لكن ما إن يتم التدقيق في السؤال، حتى تصغر المشكلة، ويزول الشك. ولمقاربة الجواب نستبق فنقول، إذا كان علم الاقتصاد، ينتج معرفة في مجاله، وعلم البيولوجيا ينتج معرفة، عن العضوية الحية، في مجاله أيضا، وهكذا بالنسبة لجميع العلوم الأخرى، المتخصصة في جوانب معينة، من وجودنا المادي، فإن علم العلم، ينتج معرفة في كيفية الحصول على المعرفة ذاتها، بغض النظر، عن مجالها، أو موضوعها، الدقيق، أو الكبير. فعلم العلم بهذا المعنى، هو علم المعرفة، وهو علم قديم ، يزداد شبابا، كلما طال عمره، فهو علم لا يشيخ.
كيف يمكن الحصول على المعرفة؟ ما هي آلية ذلك؟ وما علاقة اللغة بالمعرفة؟ كيف تبدأ العملية المعرفية؟ ما هي طرقها؟ وما هي أدواتها؟ ما دور الحواس في ذلك؟ وما هو دور المخ كجهاز معرفي؟ ما دور البيئة في تكوين الذات العارفة؟ أسئلة كثيرة، وغيرها كثير، هي بعض من أسئلة علم العلم.
لقد أكثرنا، من ترداد كلمة "العلم"، وكأن المفردة ،على درجة عالية، من الوضوح، والشفافية، والبداهة، بحيث تستغني عن التعريف. واقع الحال، يقول غير ذلك تماما، فمصطلح " علم" ليس معينا، ولهذا فإن طرح السؤال: ما هو العلم؟ له ما يبرره.
2- تعريف العلم
كلمة " العلم" في اللغة العربية، حمالة أوجه، ولها دلالات لغوية، واصطلاحية متعددة. لقد جاء في المصباح المنير : " العلم : اليقين"، يقال علم يعلم؛ إذا تيقن. وجاء أيضا بمعنى المعرفة، والمعرفة هنا تعني " إدراك الشيء بحقيقته". ويقال أيضا أن " العلم هو مبدأ المعرفة، وعكسه الجهل". ولا يكون "العلم، إلا بادراك الشيء، إدراكا جازماً" [1]. وحسب صالح الكليات" العلم هو معرفة الشيء، على ما هو به". بهذا المعنى الاصطلاحي للعلم، فإنه يشمل مجالات عديدة، ومتنوعة للمعرفة، في استعماله العام والتاريخي، على الرغم من اختلاف مناهجه، فنقول علم الفلك، وعلم الموسيقى، ويقال علوم الدين، وغيرها.
وقال ابن عبد البر، في جامع بيان العلم، وفضله " حد العلم عند العلماء المتكلمين، في هذا المعنى هو: ما استيقنته، وتبينته، وكل من استيقن شيئا، وتبينه، فقد علمه".
ويعرف العلم أيضاً بنقيضه، أي بالجهل فيقال " فلان على علم بالأمر، أي يعرفه". وتستخدم كلمة "المعرفة"، باعتبارها مرادفا للعلم، في سياقات مختلفة، فقد تستخدم في السياقات الكلية، والمركبة، كأن يقال مثلا " عرفت الطبيعة" أو عرفت الله" ولا يقال علمت الطبيعة، أو علمت الله. وقد تستخدم في السياقات الحسية، والجزئية، وهنا تكون في الغالب الأعم، مرادفة مباشرة للعلم، فيمكن أن نقول عرفت القضية، وعلمت بها[2]. ويمكن أن
1-محمد بن صالح العثمين (1925-2005)، كتاب العلم في الموسوعة الشاملة
2_ المحيط(1993) تعريف " العلم "، قاموس صخر.
يعرف العلم باعتباره نقيض الشك، وهنا يمكن أن يأخذ مراتب معينة، " وإن اللذين أوتوا الكتاب ليعلمون، أنه الحق من ربهم". ويقال إن " اليقين" بلوغ الإيمان في القلب، مرتبة العلم، والمعرفة التامة، وان لدى فلان علم اليقين، أي أن ما لديه من علم، لا يطاله الشك.
ويعرف العلم أيضا، بأنه الاعتقاد الجازم، المطابق للواقع، وحصول صورة الشيء في العقل [3].
ويعرف العلم، بالمعنى الشامل للكلمة، بأنه " كل نوع من المعارف، أو التطبيقات، أو هو مجموع مسائل، وأصول كلية، تدور حول موضوع، أو ظاهرة محددة، وتعالج بمنهج معين، وينتهي إلى النظريات، أو القوانين" [4]
وبصورة أكثر تحديدا، يعرف العلم بأنه " منظومة من المعارف المتناسقة، التي يعتمد في تحصيلها، على المنهج العلمي، دون سواه، أو مجموعة المفاهيم المترابطة، التي نبحث عنها، ونتوصل إليها، بواسطة هذه الطريقة"[5].
وبالمعنى الحديث لمصطلح "علم"، فإنه يطلق في الآن نفسه، على الطريقة العلمية في التفكير(مشاهدة، فرضية، تجربة، صياغة)، والمنظومة الفكرية،التي تنتج عنها، وتشمل مجموعة الفرضيات، والنظريات، والقوانين، والاكتشافات المتسقة، والمتناسقة، التي تصف الطبيعة، وتسعى لبلوغ حقيقة الأشياء[6]. العلم بهذا المعنى، يقابل في الانكليزية كلمة Science " "، المشتقة من الكلمة اللاتينية " Scientia "، وتعني المعرفة " Knowledge "، وتحمل أحيانا المعنى نفسه.
التعريف السابق، على أهميته، واتساع نطاق شموله، فإنه يقصي جميع
3-الجرجاني( 1339-1414م)، كتاب التعريفات، ص 155.
4- مجمع اللغة العربية(1980) المعجم الوجيز، مادة "علم" ص 432.
5- كارل بوبر(1959) ص 3 (مترجم)
6-كارل بوبر(1959) ص 79-82 (مترجم)
المواضيع العلمية، التي لا يمكن مشاهدتها، والفرضيات التي لا يمكن اختبارها تجريبياً، لإثباتها، أو لتفنيدها. ويرى البعض، إن علم الرياضيات، لا يشمله هذا التعريف أيضاً، لأنه علم يعالج مواضيع، لا تقبل المشاهدة، وهو يبني منظومته المعرفية، على جملة من البديهيات، والمسلمات، ويتعامل مع كائنات مجردة، لا تقبل التجريب، لإثباتها، أو دحضها[7]. مع ذلك، ثمة رأي آخر يقول؛ بالرياضيات التجريبية، التي تطبق المنهج التجريبي، خصوصا، بعد ظهور ما يسمى بالهندسة الكسيرية، ( خاصة مع أعمال إدوارد لورينتز في سبعينيات القرن الماضي)[8] .
وإذا كان التعريف السابق، كما تبين لنا، يقصي جملة من العلوم العقلية، التي لا تخضع للملاحظة والتجربة، فإن تعريفاً آخراً له، يجعله يشمل كل معرفة منظمة، عقلية منطقية كانت، أو حسية تجريبية. فالعلم بهذا المعنى اللغوي، إنما سميا علما، لأنه علامة يهتدي بها العالم، إلى ما قد جهله الناس، وهو كالعَلم المنصوب في الطريق[9].
مما سبق، يمكن القول؛ أن العلم في تعريفاته المختلفة، يجمع بين النظرية، والتطبيق، المنهج، والمضمون المعرفي، التأكيد على العلم الطبيعي، الذي يقبل الملاحظة، والتجريب، وهو أدنى مرتبة من المعرفة العامة، لتعلقه بمجال معين[10].ــــــــــــــــــــــــــــ
7- ثمة مقولة شهيرة لأينشتاين(1923) تقول " كلما كانت القوانين الرياضية تعبر عن الواقع كانت غير مؤكدة، وكلما كانت القوانين الرياضية مؤكدة كانت لا تعبر عن الواقع" مترجم عن Si delights on Experience من منشورات Co,P.Dutton ص 28
8-انظر موقع الرياضيات التجريبية(en)
9-الدكتور عمار الطالبي، " مفهوم العلم وحرية البحث العلمي في الإسلام، مادة(مفهوم العلم) تاريخ الوصول إلى المسار 8/2/2008.
10-المرجع السابق ص 1
وما دمنا بصدد الحديث، عن تعريف العلم، تجدر الإشارة، إلى أن العلماء العرب، قد عنوا عناية فائقة، بتحديد مفهوم العلم، والمعرفة، والعقل، والفكر والنظر، " وذهبوا، في هذا الشأن، مذاهب متباينة، تباين اتجاهاتهم الفكرية ومذاهبهم العقدية، والفقهية، من معتزلة، أم أشاعرة"[10]. فمنهم من عرفه بأنه؛ "الاعتقاد الجازم، المطابق للواقع، عن دليل"، أو هو "ما يوجب كون من قام به عالما " أو هو " ما ينكشف به المطلوب انكشافا تاماً " [11]. غير أن تعريف الإمام المازري(ت536هـ)، يفوق في دقته الكثير من تعاريف المعاصرين، لمفهوم العلم. يقول المازري:" العلم هو اعتقاد الشيء، على ما هو به، مع سكون النفس إليه، إذا وقع عن ضرورة، أو دليل". في هذا التعريف، جمع المازري بين أربعة عناصر، يتضمنها مفهوم العلم وهي : اعتقاد، ومطابقة، وسكون النفس، والدليل الضروري، أو النظري.
لقد ميز بعض الباحثين العرب، والمسلمين، بين العلم، والمعرفة، وقد خالفوا المدارس الغربية، في هذا الأمر. فحسب رأيهم؛ العلم لا يسبقه جهل، ولهذا فهو ليس نقيضه، بل المعرفة يسبقها جهل، وهو نقيضها. واستنادا إلى ذلك، فإن الله لا يوصف بأنه عارف، بل عالم، بحسب ما ذهبوا إليه.
لكن ثمة فئة أخرى منهم، ترى أن العلم، هو موضوع المعرفة، كما أن المعرفة هي موضوع العلم، وبهذا المعنى، فإنهما يشكلان معاً الإدراك الشامل للتصور، والتصديق[12].
نخلص مما سبق إلى القول؛ إن تحديد مفهوم العلم، رغم جميع التعاريف التي تم استعرضها سابقاً، والتي لم يتم استعراضها، وهي كثيرة، لا يزال مشكلة قائمة، في اللغة، كما في الاصطلاح. والمشكلة نابعة من صعوبة الاتفاق بين العلماء ،والمعاجم، على مدلول لغوي، أو اصطلاحي للكلمة،
11- علي جمعة" مفهوم العلم "، جامعة الأزهر، تاريخ الدخول إلى المسار28/11/2009، ص2
12- المرجع السابق، ص 3
حتى ذهب بعضهم، إلى القول بعدم جدوى تعريفه: " لأنه أظهر الأشياء، فلا معنى لحده، بما هو أخفى منه"[13]. وتأتي الصعوبة، في المقام الأول، من تعدد موضوعاته، وتباينها، والتي تبدو، أن لا جامع يجمعها، فالمرض، والموسيقى مثلا، هي ظواهر يمكن التعرف عليها بيسر، لكن من الصعوبة بمكان، تحديدها بدقة كافية، لأن العلم يتطلب وجود معايير، تحدد ما هو علمي، وما هو ليس علمي. فهل اللسانيات علم؟، وهل التحليل النفسي علم؟ على ما يبدو، سوف تظل هذه الإشكالية قائمة، في المستقبل، لأنه من العسير وضع حدود، بين العلم، والمناشط الثقافية الأخرى.
وهكذا؛ ثمة ثلاث وجهات نظر للعلم:
الأولى؛تنظر إليه،باعتباره المادة المعرفية ذاتها،وهذا هو التعريف التقليدي للعلم.
أما الثانية؛ فتنظر إليه، باعتباره الطريقة، التي يتم حصول المعرفة بها، ولهذا فهي تعرفه بدلالة طرقه، ووسائله، وأساليبه.
أما الثالثة، فهي تنظر إليه، باعتباره المادة المعرفية، وطرق الحصول عليها. بهذا المعنى، فإن العلم يتضمن أربعة مكونات، هي الآتية:
أ- العمليات؛ وهي تشمل الطرق، والأساليب، والوسائل، التي يتبعها العلماء، في التوصل إلى نتائج العلم.
ب- المبادئ؛ وهي مجموعة القواعد، والمعايير، والضوابط، التي تحكم النشاط العلمي.
ج- الأخلاقيات؛وهي تشمل مجموعة الخصائص،التي يجب أن يتصف بها العلماء.
د-النتائج؛ وتشمل الحقائق، والقوانين، والنظريات، التي يتم التوصل إليها، في نهاية العلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
13- الدكتور عمار الطالبي، "مفهوم العلم ..." مرجع سبق ذكره، ص 1
3- بنية العلم
يقوم بناء العلم، على مجموعة من المكونات، تشكل نوعاً من الدعائم، التي يشيد عليها، وهي متفاوتة كثيراً، بطبيعتها، ونطاق استخدامها. تشمل هذه المكونات، الحقيقة العلمية، والمفهوم العلمي، والمبدأ العلمي، والقانون العلمي، والنظرية العلمية، سوف يتم التوقف عند كل منها قليلاً.
3-1-الحقيقة العلمية
الحقيقة، في اللغة، هي التصديق، و في الاصطلاح، هي تعبير عن صفة، من صفات الأحكام. والحكم هو تقرير، لعلاقة موضوع بمحمول، ويوصف الحكم، بأنه حق، إذا تطابق مضمونه، مع الواقع. الحقيقة إذا؛ هي "تطابق ما في الأذهان، مع ما في الأعيان".[14]
الحقيقة، في الفلسفة، هي صفة للحكم، والحكم هو فعل عقلي، ولهذا لا معنى للحقيقة، إلا بالنسبة لعقل معين. ينتج عن ذلك، إن الحقيقة الفلسفية، هي كذلك، فقط لصاحبها، لأنها " متضمنة في الحكم، الذي يطلقه، وملازمة للقضية، التي يقررها".[15]
أما الحقيقة العلمية، فهي مختلفة، لأن حدودها واضحة، وتصوراتها ثابتة، ويمكن تقرير صدقها، استنادا إلى دلالاتها الثابتة.
من جهة أخرى، الأشياء من حولنا، هي موجودات مميزة دائماً، فهذه الشجرة الفلانية، أو الحيوان الفلاني، أو الطاولة، أو الصخرة، أو المطر، أو الحرارة، أو المرض، أو غيرها. وهذه الأشياء المميزة، تتكرر كثيرا، و تتفاعل باستمرار فيما بينها، وتتحرك، وتتغير، بصورة دائمة.
إن وجود هذه الأشياء المميزة، هو وجود موضوعي، بغض النظر عن معرفتنا به، وبغض النظر عن إرادتنا، وهي في وجودها هذا، تنطوي على
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14-بديع الكسم، الحقيقة الفلسفية،ص 1،تاريخ الدخول إلى المسار 21/5/2009
15- المرجع السابق ص2
حقيقة معينة، هي حقيقتها بذاتها. لكل موجود في الطبيعة، أو في المجتمع، أو في ذواتنا، حقيقته، التي هي ذاته، على ما هي عليها.
إن النشاط العلمي المعرفي للإنسان، يتوجه دائما، إلى حقيقة الأشياء بذاتها، ليزيل من نفسه، ما جهله عنها منها، وبقدر ما يكتشف، يكون لديه حقائقه الخاصة، التي يدعوها، بالحقائق العلمية.
فالحقيقة العلمية إذا؛ ليست سوى تلك الجوانب، من حقيقة الشيء بذاته، التي يكتشفها الإنسان، ويمتلكها معرفيا. ونظرا لأن الحقائق العلمية متغيرة، مع الزمن، بقدر ما يكتشف الإنسان، من أجزاء أخرى، من حقيقة الأشياء بذاتها، أو بقدر ما يغير من حقائقه العلمية السابقة، لذلك فهي حقيقة تاريخية.
إن الحقيقة التي يستهدفها الإنسان، في نشاطه العلمي، هي حقيقة الأشياء بذاتها، وتسمى أيضا بالحقيقة المطلقة، أما الحقيقة المتحصلة لديه من جراء نشاطه العلمي المعرفي، فهي الحقيقة العلمية النسبية التاريخية.
3-2 المفهوم العلمي.
المفهوم في اللغة هو " ما وقع عليه الفهم، والإدراك"، هذا يعني إن المفهوم يتوجه، إلى المعنى، من الكلام، الذي به، يتحقق الإدراك، والتعقل. وفي الاصطلاح، المفهوم هو " مجموعة من الأشياء، أو الحوادث، أو الرموز، التي تجتمع، على أساس خصائص مشتركة، ويمكن الإشارة إليها، باسم، أو رمز". أو هو " تصور عقلي عام مادي، أو مجرد، لموقف، أو حادثة، أو شيء ما". ويعرف المفهوم المادي، بأنه " تصور لأشياء يمكن إدراكها، عن طريق الحواس". ويعرف المفهوم المجرد، بأنه " فكرة، أو مجموعة أفكار، يكتسبها الفرد، على شكل رموز، أو تعميمات، لتجريدات معينة".
قد يحصل خلط، بين "المفهوم" والمعلومة. المفهوم هو معنى الأفكار، التي حملتها الألفاظ. أما المعلومة، فهي من أصل العلم، وتعني إدراك الشيء، على ما هو عليه، بغض النظر عن موضوع ذلك الشيء.
الكلام، في الأصل، هو ألفاظ تدل على معنى، وقد يكون المعنى واقعيا، أو تصوريا. عندما يلفظ الكلام، يقفز إلى الذهن مباشرة، المعنى الذي يدل عليه. فإذا كان المعنى، مما يمكن تحسسه، أو تعقله، وكأنه شيء محسوس، يكون اللفظ مفهوما. المفاهيم، بهذا المعنى، هي المعاني، أي الواقع الذهني، للواقع المحسوس، أو المسلم به. بكلام أخر، هي نوع، من الربط ،بين الواقع والمعلومات، أو بين المعلومات، والواقع.
تبنى المفاهيم، عادة، من تصورات ذهنية، لمعلومات تنقلها الحواس، أو من خلال التخيل، أو من خلال الذكريات[16]. تسبق المدركات الحسية، في العادة، وجود المفاهيم، إذ يتعرف الطفل، أثناء نموه، على المدركات الحسية أولاً، ويسميها لا حقا، في ذهنه، عن طريق مفردات اللغة، أو رموز معينة. فالكلمة اللغوية، أو الرمز، ليستا المفهوم، بل مضمون الكلمة، ودلالة الرمز. مثلا كلمة "شجرة" ليست مفهوما، بل اسما لمفهوم.
يمر المفهوم، في سياق صيرورته، في عدد من المراحل هي: المرحلة الحسية، والمرحلة الصورية، والمرحلة الرمزية.
في المرحلة الحسية، يكون الطفل مدركاته، من خلال التفاعل المباشر مع بيئته.
و في المرحلة الصورية، يبدأ الطفل بتصوير المعلومات، التي حصل عليها، في المرحلة الحسية، بصور من خياله.
أما في المرحلة الرمزية، يكون الطفل قد بلغ مرحلة من النمو، يستطيع عندها استخدام الرموز، والتجريدات الذهنية، كبديل للأفعال الحركية.
تتعرض المفاهيم، في أثناء صيرورتها، إلى تغيرات كثيرة، تختلف هذه التغيرات، وسرعتها، بحسب طبيعة المفهوم. في العادة، تتغير المفاهيم المتعلقة بالمادة بسرعة أكبر، من سرعة تغير المفاهيم، المتعلقة بالتصورات
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
16-تدريس المفاهيم، https://www.drmosad.com تاريخ الدخول 20/2/2008
المجردة، لتعلق الخبرات المباشرة بالأشياء المحسوسة.أما المفاهيم المجردة، فتتغير ببطء، لكونها متعلقة بالعمليات الذهنية، ورموزها[17] .
3-3-المبدأ العلمي.
المبدأ، في اللغة، هو "فعل الشيء ابتداء، ومبدأ الشيء أوله، ومنطلقة[18] وفي الاصطلاح، المبدأ هو عبارة عن" قاعدة أساسية، لها صفة العمومية، يصل إليها الإنسان، عن طريق الخبرة، والمعرفة، والمنطق، أو التجريب، والقياس".[19]
للوهلة الأولى، يبدو أن المبدأ العلمي، بسيط واضح بذاته، لكن واقع الحال، هو غير ذلك، فهو شديد التعقيد. لتبسيط ذلك، وتقريبه، يمكن القول، إن لكل فعل من الأفعال، سواء كانت فواعله طبيعية، أو إرادية، غاية، فإذا كانت هذه الغاية مدركة، يقال إنها صادرة عن إرادة، وإذا كانت غير مدركة فتكون طبيعية. مثلا النار تحرق، إذا غايتها هي الحرق، المعدة تهضم الطعام، إذا غايتها الهضم. النار، والمعدة، يصدر فعلهما عن غير إرادة، فهو إذا من الأفعال الطبيعية.إن جميع الموجودات الطبيعية، تصدر عنها أفعال طبيعية، ولها غايات طبيعية، مادام لا يسبق فعلها تصور للفعل. فغاية الأفعال الطبيعية، هو ما انتهت إليه حركتها، ومبدؤها في هذه الحالة، هو غايتها. فغاية المعدة، ومبدأها، هو الهضم، كما أن غاية العضلات، هي تحريك أعضاء الجسم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
17- تدريس المفاهيم، مرجع سبق ذكره.
18- لسان العرب لأبن منظور، مرجع سبق ذكره،مادة بدأ، المجلد الأول ص 171
19- تدريس المفاهيم، مرجع سبق ذكره. أنظر أيضا تعريف المبدأ، https://www.asyeh.com تاريخ الدخول 20/2/2008.
أما بالنسبة للأفعال، التي تصدر عن إرادة، وهذه تخص الإنسان، على وجه التحديد، فإنها تشمل دائما، ثلاثة مبادئ، يمكن عرضها من خلال المثال الآتي:
لنفترض أن شخصا أراد المشي، إلى مكان عمله، فعل المشي هنا، يقتضي أن تقوم العضلات، بفعل ما هو في مبدئها، أي تحريك الرجلين باتجاه الهدف. وعندما تتحرك الرجلين، خطوة فخطوة، باتجاه الهدف، فإنها تقوم بفعل، ما هو فيها مبدأ، فغاية الرجلين المشي. العضلات، والرجلين، كما المعدة، فهي من الفواعل الطبيعية. مبدأها ،هو ما انتهت إليه حركتها.
لكن قبل البدء، بتحقيق فعل المشي، يسبقه دافع له، يعبر عن ذاته، بالرغبة التي تتبعها مباشرة، إرادة المشي. فالإرادة هنا، هي المبدأ، الذي يسبب الحركة. تصدر أفعال الإنسان دائما، عن إرادة، والإرادة هنا، من الفواعل الإرادية.
المبدأ الثالث؛ وهو مبدأ التصور. ما إن تولد الرغبة في النفس، ويشتغل مبدأ الإرادة، حتى ينتج الفاعل الإرادي، في ذهنه، صورة للفعل، الذي سوف يقوم به، وتكون هذه الصورة، في العادة جزئية، وغير كاملة، يطلق عليها، عادة، بالمبدأ العلمي.
لتوضيح المبادئ الثلاث، تم الانطلاق من مبدأ الحركة، وانتهى إلى مبدأ التصور، إذ إن مبادئ الفواعل الطبيعية، تكون، في العادة، أقرب إلى الفهم. في الواقع، يتم الانتقال من الصورة، إلى الرغبة، ومنها إلى الإرادة، ومن ثم إلى تحريك العضلات. هذه هي تراتبية المبادئ، التي تحكم فعل المشي. بين الرغبة، والصورة، يصعب، في كثير من الأحيان، وجود فاصل زمني، فالرغبة، وإنتاج الصورة، يكاد يكون لهما زمن واحد. ينطبق المثال السابق، على جميع أفعال الإنسان، وخصوصا على نشاطه العلمي، فالعلم يصدر عن الفواعل الإرادية.
يجري التمييز، أيضاً، بين نوعين من المبادئ: النوع الأول؛ ويدعى بالمبدأ الفكري، ويدعى الثاني؛ بالمبدأ الخيالي. فعندما يتصور الإنسان شيئا، ويفكر بأن فيه فائدة فعلية(أو مضرة) له، يكون فكره، قد صدق تصوره. يدعى المبدأ،في هذه الحالة،باسم المبدأ الفكري،ويكون المبدأ العلمي تمثيلا له.
أما في الحالات، التي يتصور فيها الفاعل فعلاً معيناً، لكنه لا يفكر فيه، من قبيل عبث الأطفال، أو بعض تصرفات الإنسان، التي تبدو بلا غرض محدد، فهناك مبدأ علمي، لكنه ليس مبدأً فكريا، أي يوجد تصور، غير مقترن بالتصديق. يدعى المبدأ العلمي، في هذه الحالة، باسم المبدأ الخيالي.
على افتراض، أن جميع أركان، وشروط المبدأ الفكري، متحققة، فإن الغاية من الفعل، مع ذلك، قد لا تحصل، بسبب تدخل عوامل غير ملحوظة، أي بسبب تزاحم العلل، والمعلولات، على حد قول المناطقة. لنفترض مثلاً، إن تصور المشي قد حصل، فتولدت عنه الرغبة، التي هي حركة إرادة المشي، وبدأ الفاعل بالمشي، لكن فجأة حصل ما حال دون متابعة المشي. في هذه الحالة، غاية المشي موجودة، لكن حال دون تحققها مانع، وما إن يزول هذا المانع، حتى تتحقق الغاية.
في الحقيقة، لكل فعل، سواء صدر عن الفواعل الطبيعية، أو الإرادية، غاية، هي ما ينتهي إليه مبدأه، يصل إليه، إذا لم يحل مانع ما، دونه [20].
تعتبر المبادئ العلمية، بمثابة الوحدات البنائية الأولى، لكل علم، وهي تستخدم في تنظيم العمل العلمي، ومعايرته.
في سياق تطور البحث العلمي، واغتناء الإنسان بالمعرفة، تدقق المبادئ العلمية، فتقترب أكثر فأكثر، من الصورة الكاملة لها، دون أن تبلغها. وقد تتغير المبادئ، أو يتم اكتشاف مبادئ أخرى، نتيجة تزايد الخبرة العلمية، والعملية، لدى المختصين، في مجال علمي معين.
20- انظر تفاصيل ذلك في عبد الجبار الرفاعي" المبدأ العلمي"، https://www.balagh.com ،تاريخ الوصول إلى المسار29/11/2009.
3-4- القانون العلمي
يعود أصل كلمة " قانون " ،إلى اللغة اليونانية (kanun )، وتعني العصا المستقيمة، وهي تعبير دلالي، عن الصراط المستقيم، والطريق القويم. اللافت، أن اللفظ الدال على القانون، في اللغات الأوربية، يبتعد كثيرا عن أصله اليوناني، ففي الانكليزية تستخدم لفظة law، وفي الفرنسية تستخدم لفظة droit ، في حين تستخدم، في اللغة العربية، اللفظة ذاتها[21].
كلمة قانون، في اللغة العربية، بحسب لسان العرب تعني "طريقة كل شيء، ومقياسه"[22]، وفي قاموس الوجيز، القانون في الاصطلاح هو " أمر كلي، ينطبق على جميع جزئياته"، أي أن له معنا عاماً، يطلق على " كل قاعدة، أو قواعد مطردةً، يحمل اضطرادها معنى الاستمرار، والاستقرار، والنظام"[23]. أو هو تعبير عن الروابط، والعلاقات الجوهرية، المتكررة باستمرار، في الأشياء، والظواهر [24].
من حيث المبدأ، وبصورة عامة، فإن لفظة قانون، تعتبر حمالة أوجه، لذلك يختلف مفهوم القانون، بحسب طبيعة المجال العلمي، فهو في العلوم الطبيعية، غيره في العلوم الاجتماعية.
ففي مجال الطبيعة، تطلق لفظة قانون على " مجموعة القواعد التي تحكم ظواهر الطبيعة"، مثل قانون الجاذبية، أو قانون غليان الماء،وغيرها. تتميز هذه القواعد بطابعها التقريري، أي أنها تقرر واقعا معينا، في وجود أسبابه، وشروطه.
في مجال الاقتصاد، ثمة قوانين عديدة، تعبر عما هو جوهري، ومتكرر في الظواهر الاقتصادية، التي تحكمها. مثل قوانين العرض والطلب، قوانين تمركز رأس المال، قانون الربح،وغيرها.
21- انظر https://www. Documents and settings تاريخ الدخول 29/11/2009
22- لسان العرب لابن منظور، مادة قنن، ص332. أنظر أيضا قاموس الوجيز.
23-عبد الله هادي أنظر موقع " Abdullahhadi. Maktoobblog.com "
24- منذر خدام " في المنهج " دراسة نقدية في الفكر الماركسي، مخطوط غير منشور، مبحث لقوانين الجدلية،1997.
في مجال المجتمع يشير القانون، إلى "مجموعة الضوابط السلوكية في مجال معين"، أو إلى " مجموعة القواعد القانونية المكتوبة". في هذه الأخيرة يبدو القانون أقل صرامة، وحتمية، وأكثر نسبية، واحتمالية، مع ذلك، فإنها تتصف بالإلزام، الذي يوجب العقوبة، في حال عدم احترام القانون. أما في العلوم الطبيعية، والمادية، فإن القانون يكون صارماً، وحتمياً.
إن اكتشاف القوانين، التي تحكم الأشياء، والظواهر، بالإضافة إلى أهميته العلمية، فهو يساعد في التنبؤ، والتوقع المستقبلي، وفي إعادة إنتاج الشيء، أو الظاهرة، للاستفادة منها في المجتمع.
3-5 النظرية العلمية
النظرية في التداول العامي، تعني الرأي، أو الحكم، أو القول في موضوع معين، بما هو جالب للمنفعة. ومع أن العامة يضعون النظرية في مقابل الممارسة، أو العمل، إلا أنهم يعتبرونها أكثر نفعا، وفائدة، كلما اقتربت من الممارسة. وقد يعود أصل هذا التداول العامي للنظرية، إلى كون أصلها في اللغة العربية، مشتق من فعل النظر بالعين المجردة، في حين، يعود أصلها في اللغة الفرنسية، إلى النظر، والملاحظة، والتأمل. من وجهة نظر الفلسفة، النظرية مجردة عن المنفعة، منزهة عن الغاية.
النظرية في معجم لسان العرب، مشتقة من فعل "نظر"، الذي يعني، من جملة ما يعنيه، "التفكر في الأمر، والتدبر فيه"، أو " ترتيب أمور معلومة، على وجه يؤدي، إلى استعلام ما ليس بمعلوم"[25].
والنظرية في المعجم الفرنسي (روبير) لها عدة معان، فهي في معنى أول تعني " مجموعة من الأفكار، والمفاهيم المجردة، قليلاً، أم كثيراً والمطبقة على ميدان مخصوص"، وهي في معنى ثان " بناء عقلي منظم ذو طابع فرضي تركيبي"[26].
25- لسان العرب لأبن منظور، المجلد السادس، مادة نظر، ص211
26- المعجم الفرنسي( روبير)،انظر أيضا من الدلالة إلى الإشكالية، ص1
بناء على ما سبق، فإن النظرية، هي عبارة، عن تراكيب عقلية افتراضية، متميزة، بطابعها، عن الإدراك الحسي المباشر.أو هي " جهاز متماسك من المسلمات، والمفاهيم، والقوانين، والتوجيهات العامة، تستعمل لتحليل، أو تفسير، أو وصف جوانب معينة، من الواقع، أو ما قد يحدث من ظواهر، ووقائع"[27]. يثير مصطلح "نظرية" جملة من الأسئلة وهي:
-ما هي علاقة النظرية بالممارسة؟
-ما هي وظيفة النظرية، وكيف تؤديها؟
- من أين تستمد النظرية مبادئها: من العقل، أم من الواقع؟.
- هل تتطابق النظرية مع الواقع الذي تحاول تفسيره؟.
- هل النظرية ثابتة، أم متغيرة؟
جواباً على السؤال الأول، تبدو الفلسفة اليونانية القديمة منحازة إلى جانب الفكر التأملي المجرد، المتحرر من النفعية، ومن الممارسة العملية. تقول أطروحتها الكلاسيكية، بأن النظرية سابقة على الممارسة، ومنفصلة عنها. فعند أفلاطون النظرية ممتزجة بالنفس، قبل اتحادها بالجسد. وعند أرسطو فإن مبادئ التفكير المنطقي؛" مبدأ الهوية، ومبدأ عدم التناقض، ومبدأ الثالث المرفوع"، سابقة على التجربة.
وبالانتقال إلى العصر الحديث، فإن ديكارت مثلا، يرى أن العقل فطري في الإنسان، وسابق على التجربة. على العكس من ذلك، تعتبر التجريبية الكلاسيكية، التجربة سابقة على النظرية، وأن النظرية ليست سوى انعكاس سلبي، لما هو واقع بالفعل. العقل بالنسبة لهذه المدرسة الفلسفية عبارة عن " صفحة بيضاء".
ـــــــــــــــــــــــ
27- انظر" النظرية والممارسة" تاريخ الدخول إلى المسار 20/11/2009
خلاصة القول؛ إن النظرية لدى المدارس الفلسفية المذكورة، توجد منفصلة عن الممارسة، بغض النظر، عن أسبقية النظرية، أم الممارسة، الواحدة على الأخرى.
من جهته، ابن خلدون، فإنه يرفض الفصل بين النظرية، والممارسة، ويرى أن الأولى، مرتبطة بالثانية. الفكر عنده، هو الذي يدرك " ترتيب الحوادث، وهو الذي ينظمها، ويضبط أسبابابها، وعللها، وشروطها". الفكر يسبق العمل، ويشرف عليه، وينهيه.
وتربط المدرسة الماركسية، أيضاً، بين النظرية، والممارسة، " إن دور الفلسفة هو تغيير العالم، وليس الاكتفاء بتفسيره".
وفي الجواب عن السؤال الثاني، يمكن القول، بإن وظيفة النظرية تتخطى حدود كونها تفسيرا للوقائع، إلى العمل على خلقها، وفق نموذج النظرية. فإذا كان المنهج العلمي؛ هو مجموعة من المبادئ، والخطوات، التي تنظم عمل الباحث، وهو يحاول اكتشاف الظواهر، التي يشتغل عليها، ليصوغ ما يكتشفه، في قوانين تصدق، على الحالات المماثلة، تسمح له، في خطوة لاحقة، تطبيق ما اكتشفه.
بطبيعة الحال، لا توجد نظرية واحدة، بل نظريات عديدة، وذلك بحسب المنهج المتبع، وحسب المجال المعرفي، الذي يجري دراسته.
وفي الجواب عن السؤال الثالث، يتضح إن صدق النظرية ليس في ذاتها، بل في قدرتها على التحقق التجريبي في الواقع، وبذلك تكون التجربة هي المنطلق، وهي النهاية. غير أن مفهوم الواقع، يتغير باستمرار، خصوصا، مع ظهور علوم الفضاء، والفلك، وكذلك مع ظهور العلوم الدقيقة، حيث يصعب التجريب، أو يستحيل، ولهذا فإنه البحث، سوف يتعين على وقائع تجريبية، مختلفة كثيراً، أو قليلاً.
وفي الجواب عن السؤال الرابع والخامس، يمكن القول؛ إن النظرية تمثل تفسيراً تقريبياً للواقع، تتحدد درجة اقترابها منه، بحسب ظروف إنتاجها، وشروطه. ونظراً لأن الواقع يتغير باستمرار، فهو، في تغيره، يرغم النظرية على التطور، أو الانحجاز في التاريخ.
4- حدود العلم
يجري التمييز، عادة، بين المعرفة العلمية، والمعرفة التي يفترضها العلم، والمعرفة بالحقائق الخاصة. فما هو بحث في الماضي (التاريخ مثلا) يندرج في إطار المعرفة، التي يفترضها العلم، أما المعرفة بوجود الشمس، أو زنوبيا، أو الوقائع في الهوية الشخصية، فهي معرفة بحقائق معروفة(وقائع). أما المعرفة بالقوانين الطبيعية، فهي معرفة علمية.
يوجد للمعرفة، بصورة عامة، مصدران: المصدر الأول؛ وهو التجربة الشخصية، أما المصدر الثاني؛ فهو روايات الثقات، من الناس مباشرة، أو عن طريق المطبوعات.
بالنسبة للمعرفة المكتسبة من التجربة الشخصية، أي من خلال المشاركة المباشرة في إنتاجها، فإنها، في العادة، تكون أكثر صدقية لصاحبها، أما المعرفة المكتسبة عن طريق الغير، أو عن طريق المطبوعات، فإنها تحتمل الشك. و بغض النظر، عن مصدر المعرفة، فإنها تكون، دائما، ذات طبيعة نسبية واحتمالية، أي أن لها حدوداً، هي حدود شروطها، وظروفها.
من الناحية النظرية، ليس للعلم حدود،ما دام الإنسان موجوداً، ذاتاً تعرف. تبدو هذه الحقيقة، على درجة عالية من البداهة، يؤكدها تطور الإنسان ذاته، فما يعرفه في الوقت الراهن، أكبر بما لا يقاس، مع ما كان يعرفه قبل عقد من السنين، فكيف بقرن، أو قرون من السنين. لقد وصلت معرفة الإنسان إلى أعماق الذرة، والخلية، ووهي توسع توغلها في الفضاء الخارجي باستمرار. بل صار الإنسان بفضلها قادراً، على تخليق الحياة حسب الطلب، وحتى بعثها من الموت، بفضل علم الاستنساخ. وفي كل يوم تتوسع معرفة الإنسان بوجود العالم من حوله، وبوجوده الاجتماعي، وبوجوده الشخصي.
من جهة أخرى للعلم، بالمعنى النظري، والعملي، حدود لا يستطيع تخطيها، لا لعجز فيه، بل لأن الوجود ذاته، ليس له حدود، فهو لا نهائي في الزمان، والمكان، وهو لانهائي في حقيقته بذاته. في غياب حدود الوجود، وحدود موجوداته، وحقائقه بذاته، مهما امتد الزمن بالذات العارفة، ومهما امتلك من وسائل، وطرق معرفية، فكأنه لم يتحرك من مكانه، وكأنه لا يعرف، إلا شيئا يسيراً. هذا هو سر الوجود، وسر السعي الدائم للإنسان لإماطة اللثام عنه. لو استطاع الإنسان، على سبيل الافتراض، امتلاك المعرفة الكاملة بالوجود، وموجوداته، لفقد وجود الإنسان ذاته معناه، ولاستغنى عن نفسه.
5- تاريخ العلم
منذ أن امتلك الإنسان القدرة على التساؤل، والتفكير، وهو يحاول اكتشاف ما يحيط به، من مكونات الطبيعة، وظواهرها، وقد استخدم في ذلك طرقاً، ومناهج شتى، يصعب حصرها. مع ذلك يتفق علماء الإنسانيات(أنتربيولوجيا)، أو يكادون، على أن تطور الفكر الإنساني، قد مر بمراحل ثلاث، وهي الآتية:
أ- مرحلة الأسطورة. لقد امتدت هذه المرحلة مئات الآلاف من السنين، كان الإنسان في أثنائها بدائيا، لا يملك قدرات كبيرة على التفكير، وكانت لغته بسيطة، وبدائية، ولم تكن قدرته على التخيل واسعة. بعبارة أخرى؛ كان الإنسان طبيعيا، لم ينفصل بعد، عن عالمه الحيواني، الذي ينتمي إليه.
اللافت في هذه المرحلة، امتدادها الطويل في الزمن، وبنيتها المعقدة، إذ يصعب تصنيفها استنادا إلى مؤشر واحد،هو الأسطورة. وحتى هذه الأخيرة، فإنها ظهرت في مرحلة متأخرة نسبيا، كان خلالها مخيال الإنسان قد نضج بعض الشيء، وتوسع مجاله، وكانت اللغة قد تطورت كثيراً، إذ صارت تسمح للإنسان، بصوغ تفسيراته لظواهر وسطه، ولاكتشافاته المعرفية عنها.
ثمة من يقول، بمرحلة طوطمية، سبقت المرحلة الأسطورية، بزمن طويل. وبالفعل فقد كانت الشعوب البدائية، تفسر الكثير من الظواهر المحيطة بها، بشواخص طوطمية، تنسب إليها قدرات خارقة، وكانت تختار طواطمها، من البيئة ذاتها، التي تحيط بها، لتكون تفسيرا لهذه الظواهر. في تجربة أجريت حديثاً، على بعض قاطني غابات الأمازون المنعزلين، إذ تم تطير طائرة فوقهم لعدة مرات، وعندما تمت زيارة تجمعاتهم، وجد أنه قد تم تشخيصها من قبلهم، من أغصان الأشجار، وأخذوا يقدمون لها طقوس العبادة.
ما يهم في تلك المرحلة، هو أن الإنسان قد امتلك القدرة اللغوية على تفسير ما يحيط به، من موجودات الطبيعة، وظواهرها، في صورة أساطير.
تجدر الإشارة إلى إن الأسطورة، حسب ابن منظور، في لسان العرب، هي الأباطيل، أو الأحاديث التي لا نظام لها.
لفظة "أسطورة" في العربية، هي من أصل سرياني( أسطوريا istoreya)، وهي مأخوذ، أساساً، من اليونانية (هستريا).
أما من الناحية العلمية الاصطلاحية، فقد عرّفت الأسطورة، بأنها حكاية تقليدية، تروي أحيانا أحداثا خارقة للعادة، تتركز حول أبطال أسطوريين، أو آلهة.
إن علم الأساطير هو من العلوم الحديثة نسبيا، فقد بدأت دراسة الأساطير دراسة علمية ممنهجة، لأول مرة، في القرن التاسع عشر، من قبل المستشرق، والعالم اللغوي البريطاني، ماكس مولر الذي صنفها باعتبارها " تحريفات لغوية"[28].
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
28- د. عبد الهادي الفضلي، "تاريخ أصول البحث، تاريخ الوصول إلى المسار 12/2/2009
وربطها عالم بريطاني آخر، هو العالم الأنتربولوجي السير جيمس جورج، بفكرة الخصب في الطبيعة. واعتبرها آخرون، بأنها تفسير مجازي لظواهر الطبيعة، فغاب المجاز، مع الزمن، وبقيت الحرفية اللغوية فيها.
لكل شعب أساطيره الخاصة به، ولذلك من الخطأ العلمي، دراستها دون
تخصيص، وتمييز. مع ذلك فهي تشترك في المنهج، فجميع الأساطير، لدى مختلف الشعوب، كانت تنتقل من جيل إلى جيل، بواسطة النقل، ولذلك فإن المنهج النقلي، هو، من الناحية التاريخية،أقدم منهج عرفه الإنسان.
لقد تطورت الأساطير كثيراً، في مرحلة ظهور الأديان، سواء ما دعي منها بالسماوي، أو ما دعي بالوضعي، فلا يوجد دين بدون قصص أسطورية، تشكل تفسيرا دينيا أسطوريا، للموضوعات التي عالجتها[29]. ومع تطورها، فقد حافظت الأسطورة على نسيجها اللغوي، وعلى طبيعتها المعرفية، ورغم تقدم علم الآثار، فلم يجد لها ما يؤكد صحتها، في الواقع المادي، ولهذا ينظر العلم إليها كمجرد خرافات.
تتعدد مصادر المعرفة الدينية كثيرا، حسب طبيعة الدين، ففي الأديان السماوية، يعتبر الوحي الإلهي مصدر المعرفة الدينية، أما في الأديان البدائية، فإن مصدر المعرفة هو الوهم البشري. ويعتبر الدين الطبيعي(الربوبية deism) العقل الفردي هو مصدر المعرفة الدينية. يقوم الدين الطبيعي على تأليه الطبيعة، ويعد كلاً من مونتسكيو، وفولتير، وروسو، من أبرز الداعين إليها.
ب- مرحلة الفلسفة.
لقد اهتمت الفلسفة، بدراسة المبادئ الأولى للأشياء، والظواهر، وحقائقها، وعلاقاتها بعضها ببعض. في مرحلة من التاريخ، كانت الفلسفة ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
29- الموسوعة العربية الميسرة ط2،1972، ص 148.
تجمع جميع العلوم الأخرى، لكنها أخذت تنفصل عنها تباعا، مع مرور الزمن، بدءا بعلم الرياضيات.
بعد اكتمال انفصال جميع العلوم عن الفلسفة، تحولت هذه الأخيرة، إلى علم خاص، تشكل قضايا الوجود، والمعرفة، وقيم الحق، والخير، والجمال موضوعاتها. وحتى هذه القيم الأخيرة، بدأت تستقل بعلوم خاصة بها، مثل علم المنطق، الذي اختص بدراسة الحق، وعلم الأخلاق، الذي اختص بدراسة الخير، وعلم الجمال، أو الفن، الذي اختص بقضايا الجمال، وترك للفلسفة أن تختص بقضايا الوجود والمعرفة. وفي مرحلة متأخرة انفصل موضوع المعرفة عن الفلسفة، ليشكل علما خاصا به، يعرف بعلم المعرفة، أو علم نظريات المعرفة. في الوقت الراهن، تركز الفلسفة على قضايا الوجود، وخصوصا على تلك القضايا المرتبطة، بما بعد الطبيعة، أي ما يعرف بالميتافيزيقا.
خلال المرحلة الفلسفية، من تطور الفكر الانساني، كان المنهج المنطقي العقلي، هو منهج التفكير الرئيسي، معتمدا على قواعد المنطق، وقواعد الاستدلال، وقواعد تنظيم العلوم، وغيرها من القواعد، التي استقلت لا حقا لتشكل علم المناهج. وفي مرحلة متأخرة من تطور الفلسفة، اكتسب المنهج العقلي تطورا إضافيا، على يد الفلاسفة العقليين، من أمثال ديكارت، وسبينوزا، ولايبتز، ممهدين الطريق أمام ظهور الفلاسفة التجريبيين، الذي أكدوا من جهتهم، بأن أصل المعرفة يكمن في التجربة، وليس في العقل. ومن أبرز هؤلاء الفلاسفة التجريبيين يذكر عادة جون لوك، ودافيد هيوم.
ت- مرحلة العلم
العلم المقصود هنا " المعرفة النظامية المنسقة المبنية على الملاحظة والاختبار"، أي ما يعرف بالعلم التجريبي، وليس العلم بمعناه الواسع، والعام. لقد بدأت مرحلة العلم ، في القرن السادس عشر مع غاليلو، ومنذ ذلك التاريخ، اخذ البحث العلمي، يعتمد طرقاً خاصة به، تعرف بالطرق العلمية.
حسب الطريقة العلمية، يبدأ البحث بدراسة الوقائع المشاهدة، ومن ثم يتم تفسيرها بفرضية معينة، تجري ملاحقتها بمزيد من الدراسة، والبحث، والاستقصاء. وإذا أيدت الدراسات اللاحقة، والاختبارات، التي أجريت على الفرضية صحتها، تتحول عندئذ الفرضية إلى نظرية Theory. وعندما يقوم الدليل القطعي على صحة النظرية، من خلال مزيد من الدراسات، والبحوث، والاختبارات، وعندما يتعذر وضع نظرية جديدة، أو نظرية أخرى، لتفسير المعطيات ذاتها، تتحول النظرية إلى قانون Law .
وحتى في حالة النظرية، والقانون، فإن الحقيقة التي تم التوصل لها، لا تعدو كونها حقيقة تاريخية، مرتبطة بشروط الزمان، والمكان، والشروط البحثية المختلفة، وليس حقيقة سرمدية، أو حقيقة الشيء بذاته.
خلال هذه المرحلة من تطور المعرفة، كان المنهج التجريبي، هو المنهج العلمي الرئيسي المستخدم في أغلب العلوم، وخصوصا، في العلوم الطبيعية، والمادية.
ينبغي النظر إلى التصنيف السابق لتاريخ تطور المعرفة، كمخطط عام منفتح الحدود، والمعايير، أي أنه ينضوي على استثناءات كثيرة. ففي المراحل التي كانت فيه الأساطير، والأديان، والفن، هي وسائل، وأدوات، وطرق المعرفة السائدة، كان يمكن ملاحظة شواهد كثيرة، على نضج علمي غير مسبوق، بل عجز اللاحقون عن تفسيره، كما هو الحال في الحضارات الفرعونية، و الإغريقية، و الرومانية، و الصينية، و في حضارات الأنكانوغيرها من الحضارات. فالآثار التي وصلتنا، من تلك الحضارات، لا تسمح بتقبل فكرة بنائها بدون وجود علم، بل علم على مستوى عال من التطور، والتقدم. فالدقة الهندسية، والجمال العمراني، عداك عن التعامل مع كتل بنائية كبيرة، تتطلب جميعها، بالضرورة، وجود علوم متطورة، في الهندسة، والحساب، وصناعة وسائل الإنتاج وغيرها. كما أن التحنيط المصري، يتطلب تطور علوم الأمراض، وعلوم الكيمياء، وغيرها من العلوم ذات العلاقة بالتحنيط.
في المرحلة الفلسفية، من تطور الفكر الإنساني، تطورت أيضا علوم كثير أخرى، مثل العلوم المتخصصة في الرياضيات، وفي الصناعة، وخصوصا، الصناعة البحرية، والهندسة، والزراعة وغيرها كثير.
في مرحلة العلم، لم يقتصر التطور على العلوم الطبيعية، والمادية، بل تطورت أيضا العلوم الاجتماعية، والنفسية، واللغوية، والتشريعية، وعلوم الفن، وغيرها كثير.
وأكثر من ذلك، فإن هذه المراحل الثلاث من تطور الفكر الإنساني، لم تقطع فيما بينها، بل تداخلت بصورة لا فتة. ففي مرحلة العلم، وتحديداً، في الوقت الراهن، يلاحظ انتعاشاً لافتاً للأساطير، والأديان السماوية، والوضعية، كوسائل معرفية خلاصية، وإن بعض النظريات الوضعية، التي كانت تدعي العلمية، تحولت إلى حالة شبه دينية،كما هو حال الماركسية مثلاً.
6- تصنيف العلوم
تتعدد كثيرا معايير تصنيف العلوم بحيث يصعب كثيرا تصنيفها لكثرتها أيضا وتناسلها المستمر، ويذهب بعض العلماء إلى القول بلا جدوى من تصنيفها، ويطالبون بدراستها كعلوم مستقلة. مع ذلك نرى ضرورة تصنيف العلوم استنادا إلى معايير كلية تجمعها في عائلات متمايزة.
من حيث المبدأ تتوزع العلوم على المجالات الكلية التالية:
- مجال دراسة الإنسان الفرد بما هو عضوية اجتماعية وذات مفكرة.
- مجال دراسة الوجود الاجتماعي للإنسان
- مجال دراسة الوسط الطبيعي لوجود الإنسان
- مجال دراسة العلاقات الناشئة بين المجالات السابقة الذكر.
كل من المجالات السابقة تنقسم بدورها إلى مجالات أصغر فأصغر حتى ينتهي بالعلم المفرد والجزئي.
فعلى سبيل المثال في المجال الأول تندرج عائلات كثيرة من العلوم مثل العلوم الطبية والغذائية والنفسية والوظيفية وغيرها كثير.
العلوم الطبية بدورها تنقسم إلى علوم متخصصة في كل مجال من مجالات الأمراض التي تصيب أعضاء الجسم.
في المجال الثاني تندرج جميع العلوم الاجتماعية بما فيها العلوم الاقتصادية والسياسية والثقافية والتشريعية القانونية..الخ.
العلوم الاقتصادية بدورها تنقسم إلى علوم عامة وإلى علوم خاصة، و إلى علوم نظرية وعلوم تطبيقية، وهذه الأخيرة تتخصص في كل مجال من مجالات النشاطات الاقتصادية في الصناعة والزراعة والتجارة وغيرها.
في المجال الثالث تندرج جميع العلوم الطبيعية والبيئية والمناخية وغيرها. العلوم الطبيعة تنقسم إلى علوم الفيزياء وعلوم الكيمياء والعلوم الهندسية المختلفة وعلوم الحياة البرية وغيرها كثير.
ونظرا لأن المجالات السابقة الذكر ليست منفصلة بعضها عن البعض الأخر فقد ظهرت علوم تدرس علاقاتها المشتركة والمتبادلة وأخذت تنتظم في إطار عائلات علمية متميزة. مثلا علوم الكيمياء الحيوية، أو علوم الرياضيات التطبيقية،أو علوم السلوك الفردي الاجتماعي...الخ.
#منذر_خدام (هاشتاغ)



ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

|
حفظ
 |
بحث |
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
| إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
أسئلة الديمقراطية في الوطن العربي في عصر العولمة(الفصل الساد
...
-
أسئلة الديمقراطية في الوطن العربي في عصر العولمة(الفصل الخام
...
-
أسئلة الديمقراطية في الوطن العربي في عصر العولمة(الفصل الراب
...
-
أسئلة الديمقراطية في الوطن العربي في عصر العولمة(الفصل الثال
...
-
أسئلة الديمقراطية في الوطن العربي في عصر العولمة(الفصل الثان
...
-
رهانات الاسد والسقوط الكبير
-
أسئلة الديمقراطية في الوطن العربي في عصر العولمة(الفصل الأول
...
-
العرب والعولمة( الفصل السادس)
-
العرب والعولمة( الفصل الخامس)
-
العرب والعولمة( الفصل الرابع)
-
العرب والعولمة( الفصل الثالث)
-
العرب والعولمة(الفصل الثاني)
-
العرب والعولمة( الفصل الأول)
-
العرب والعولمة( مدخل)
-
العرب والعولمة(مقدمة)
-
في المنهج-دراسة نقدية في الفكر الماركسي( الفصل الحادي عشر)
-
في المنهج-دراسة نقدية في الفكر الماركسي( الفصل الهاشر)
-
في المنهج-دراسة نقدية في الفكر الماركسي( الفصل التاسع)
-
في المنهج-دراسة نقدية في الفكر الماركسي( الفصل الثامن)
-
في المنهج-دراسة نقدية في الفكر الماركسي( الفصل ااسابع)
المزيد.....
-
كشف ملابسها الداخليّة.. هايلي بيبر بفستان شفّاف في سيدني
-
كوريا الشمالية.. هل يمكن أن تصبح هذه المراهقة الزعيمة القادم
...
-
تصعيد جديد بين طوكيو وبكين.. احتجاز قارب صيد صيني قبالة ناغا
...
-
أخبار اليوم: حاملة الطائرات جيرالد آر. فورد الأمريكية في طري
...
-
مباشر: ترامب يهدد إيران بعواقب -مؤلمة جدا- في حال عدم التوصل
...
-
نصف الألمان يعتبرون أمريكا أقرب للخصم
-
توغل إسرائيلي ومداهمة منزل في ريف القنيطرة الجنوبي
-
عاجل | وزارة العدل العراقية: عدد معتقلي تنظيم الدولة الذين ن
...
-
بعد عامين.. أب فلسطيني يودّع زوجته وتوائمه الأربعة في كيس أب
...
-
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تقدّر -السلوك المعقول- لسول بشأن ا
...
المزيد.....
-
قواعد الأمة ووسائل الهمة
/ أحمد حيدر
-
علم العلم- الفصل الرابع نظرية المعرفة
/ منذر خدام
-
قصة الإنسان العراقي.. محاولة لفهم الشخصية العراقية في ضوء مف
...
/ محمد اسماعيل السراي
-
الثقافة العربية الصفراء
/ د. خالد زغريت
-
الأنساق الثقافية للأسطورة في القصة النسوية
/ د. خالد زغريت
-
الثقافة العربية الصفراء
/ د. خالد زغريت
-
الفاكهة الرجيمة في شعر أدونيس
/ د. خالد زغريت
-
المفاعلة الجزمية لتحرير العقل العربي المعاق / اسم المبادرتين
...
/ أمين أحمد ثابت
-
في مدى نظريات علم الجمال دراسات تطبيقية في الأدب العربي
/ د. خالد زغريت
-
الحفر على أمواج العاصي
/ د. خالد زغريت
المزيد.....
|
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

 |
بحث
|
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
|
إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة