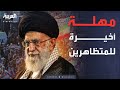زهير الخويلدي


الحوار المتمدن-العدد: 8344 - 2025 / 5 / 16 - 01:20
المحور:
الثورات والانتفاضات الجماهيرية
الترجمة
"هل تُفسّر مناهج ما بعد الاستعمار السياسة العالمية بشكل أفضل من نظريات العلاقات الدولية الأخرى؟
إن تقييم المناهج التي تُقدم تفسيرًا أفضل للسياسة العالمية مهمة تتجاوز مجرد مقارنة النظريات، إذ إنها تتطلب دراسةً مُعمّقة لمفهوم السياسة العالمية والافتراضات المعرفية والوجودية التي تُؤسسها. ولتحديد المناهج التي تُقدم تفسيرًا أفضل للسياسة العالمية، ستتناول هذه المقالة أولًا النظريات التقليدية للعلاقات الدولية، وكيف تُغفل مفاهيمها الجوهرية الكثير في تفسير الفروق الدقيقة وتنوع السياسة العالمية. ثم ستُقيّم كيفية فهم مناهج ما بعد الاستعمار للسياسة العالمية، وتعقيدات علاقتها بنظريات نقدية أخرى مثل ما بعد البنيوية والماركسية، والحاجة إلى نظرية معرفية وجودية استعمارية للسياسة تنبثق من الفكر غير الغربي، بالاعتماد على أعمال مُنظري أمريكا اللاتينية كمثال. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى استنتاج مفاده أن المناهج ما بعد الاستعمارية تقدم تفسيراً أكثر شمولاً ودقة للسياسة العالمية من معظم نظريات العلاقات الدولية، ولكن من غير المناسب وصفها بأنها "أفضل". بدايةً، من المهم فهم المقصود بمناهج ما بعد الاستعمار. وكما يوحي الجمع، لا توجد نظرية واحدة متماسكة لما بعد الاستعمار. بل إن ما بعد الاستعمار في العلاقات الدولية هو "تعدد في وجهات النظر والتقاليد والمناهج المتعلقة بمسائل الهوية والثقافة والسلطة"، والتي تشترك في اهتمام مشترك بخطابات وممارسات الاستعمار والإمبريالية، وكيف تستمر هذه الخطابات والممارسات في التجلي في السياسة العالمية وتتقاطع مع مسائل العرق والنوع والطبقة. ينعكس التنوع الهائل في التجارب الاستعمارية عبر مختلف مناطق العالم في مختلف أنواع ما بعد الاستعمار التي تنبثق عنها، إلا أن التركيز الرئيسي لجميعها يتمثل في إظهار كيف تظل العلاقات الدولية ذات مركزية أوروبية نظريًا وعمليًا، كونها "من إنتاج الغرب ولصالحه". ولمواجهة ذلك، تُقدم مناهج ما بعد الاستعمار نوعًا من العلاقات الدولية أكثر اهتمامًا بالاختلاف، و"يُقرّب أوروبا" ومطالباتها بالعالمية، وينقل التركيز الوجودي إلى قضايا مثل الثقافة والعرق والحياة اليومية، أو إلى مفاهيم جديدة تنبثق من الفكر غير الغربي.
مفاهيم جوهرية من منظور غير جوهري
تميل العلاقات الدولية، كمجال، إلى اعتبار نفسها قد بدأت بعد الحرب العالمية الأولى، كمحاولة لفهم المجال الدولي بشكل أفضل، ومنع تكرار مثل هذا الحدث، حيث رسخت الليبرالية، ثم الواقعية، مكانتهما كنظريتين مؤسستين للعلاقات الدولية. بشكل عام، تُعنى الواقعية بممارسة الدول ذات السيادة للسلطة في نظام فوضوي يميل نحو الصراع، بينما تهتم الليبرالية، على العكس من ذلك، بكيفية عمل الفاعلين العقلانيين معًا لتقليل هذا الخطر. على الرغم من أن هذا المفهوم للعلاقات الدولية يُنشئ نقطة بداية تُخفي استمرارية بين عالم ما قبل عام 1914 وما بعده، فإن صمود هذه النظريات وقربها من السلطة يعنيان أهمية إشراكها في النقد لتقييم ما تُعليه وما تُخفيه في تفسيراتها للسياسة العالمية. علاوةً على ذلك، من خلال تناول الأسس المعرفية والوجودية للواقعية والليبرالية، يُمكن توسيع نطاق الانتقادات لتشمل نظريات أخرى في العلاقات الدولية تتشارك معها، مثل بعض أشكال البنائية أو المدرسة الإنجليزية.
أولًا سيُحدد هذا القسم الأسس المعرفية الأوروبية المركزية للمفاهيم الأساسية، مثل الطبيعة الفوضوية للنظام الدولي، ثم سينظر في كيفية حجب التركيز الزمني للفكر الأوروبي للأبعاد المكانية لمسلمات العلاقات الدولية مثل الدولة. يمكن تحديد المركزية الأوروبية لمفاهيم العلاقات الدولية الرئيسية، مثل الطبيعة الفوضوية للنظام الدولي، من خلال تطبيق فكر إدوارد سعيد ما بعد الاستعماري. يُظهر عمله التأسيسي "الاستشراق" كيف أصبح الغرب معروفًا لنفسه من خلال خلق معرفة عن شرق "أدنى"، وتطوير تناقضات ثنائية كان الغرب فيها دائمًا متفوقًا. وقد أصبحت هذه العملية ممكنة من خلال علاقات القوة الموضعية؛ فقد تم استشراق الشرق لأنه "يمكن أن يكون". أصبح إدراك "التكوين المتبادل" للعالمين الأوروبي وغير الأوروبي الذي حدده سعيد ركيزة أساسية للعلاقات الدولية ما بعد الاستعمار والتفكير في السياسة العالمية، ويمكن استخدامه لتوضيح سبب إشكالية التفكير في النظام الدولي على أنه فوضوي. الفوضى الدولية مفهومٌ أساسي في الواقعية والليبرالية، وهو ما يفسر للواقعيين "التشابه اللافت" للسياسة العالمية على مر الزمن. يستند هذا المفهوم إلى التباين بين الأنظمة السياسية المحلية، حيث تكون الدولة هي الحكم النهائي في النزاعات وتحتكر القوة المشروعة. تتجذر هذه الأفكار في تقليد عريق من الفكر السياسي الأوروبي، بدءًا من منظري العقد الاجتماعي وصولًا إلى ماكس فيبر. ويُبرر عمل توماس هوبز، الذي كان مؤثرًا بشكل خاص في الواقعية، الحاجة إلى دولة قوية ذات سيادة من خلال مقارنته الشهيرة بين البديل في "حالة الطبيعة" كحياة "منعزلة، فقيرة، بغيضة، وحشية، وقصيرة" (ليفياثان، الجزء الأول، الفصل الثالث عشر، الفقرة 9). ومع ذلك، فقد شكك نقد ما بعد الاستعمار في هذا المفهوم من جانبين. أولًا، يتحدى فكرة أن النظام الدولي هو نظام فوضوي للدول ذات السيادة. يتضح جليًا أن النظام الدولي يندرج ضمن علاقات القوة الهرمية عند النظر في تقويض المعايير القانونية الدولية، مثل سيادة الدولة، أو تقويض مؤسسات مثل الاتحاد الأفريقي من قِبل دول قوية، كما حدث أثناء التدخل الغربي في ليبيا.
ثانيًا، وربما الأهم من ذلك، أن مفهوم "حالة الطبيعة" الذي يدعم الإطار الواقعي غارق في التجربة الاستعمارية. وقد تطور هذا المفهوم من خلال التقاء الأوروبيين بمجتمعات الأمريكتين أو أفريقيا، التي اعتُبرت وحشية وخارجة عن نطاق السياسة نظرًا لجهلها بها. لا يقتصر الأمر على حجب دور الشعوب الأصلية في تشكيل المعرفة الأوروبية، بل يُعمّق هذا المحو من خلال هذه النظريات التي تُقدّم "مجالاً وجودياً محدوداً للغاية" لفهم السياسي، وخاصةً للمجموعات التي لا تتناسب بشكل مريح مع نظام الدولة القومية. وهكذا، يُستخدَم غير الأوروبيين لخلق معرفة حول الذات الأوروبية، تُرفع إلى مستوى نظرية قابلة للتطبيق عالمياً، بينما تُستبعد أو تُنكر التجارب غير الأوروبية لهذه الأنظمة والهياكل في آنٍ واحد في صمت مُفروض. إن إدراك دور غير الأوروبيين في تشكيل الحداثة يُحدّد العلاقة بين الحداثة والاستعمار على أنها تكوينية وليست تتابعية. من المهم أيضًا فهم كيفية نشوء الظواهر الوجودية للعلاقات الدولية، وكيفية تقييمها وفقًا لمجموعة محددة من المعايير الأوروبية المركزية. الدولة مثالٌ واضح على ذلك. فهي تُجسّد في الفكر الواقعي كوحدة مركزية للسياسة العالمية، إلا أن تطبيقها في مفاهيم أكثر ليبرالية تتعلق بـ"التنمية" أو "التحديث" ربما يكون أكثر إثارة للاهتمام من منظور ما بعد الاستعمار، لأنه يُظهر خباثة الخطابات الأوروبية المركزية حتى في الممارسات التي قد تكون حسنة النية. يُظهر فحص مسار الفكر الليبرالي ميوله الأوروبية المركزية؛ يُحدد جروفوغي كيف أن مفهوم إيمانويل كانط عن "السلام الدائم"، مصدر الكثير من الفكر الليبرالي في العلاقات الدولية، يتجاهل عنف "الاتحاد السلمي"، في حين أن عنوان كتاب فوكوياما (1992) "نهاية التاريخ والإنسان الأخير" يُظهر بجلاء الرأي القائل بأن الرؤية الوحيدة المسموح بها للعالم هي الرؤية الغربية. يان (2005) تستهدف أيضًا كانط في تقييمها، لكنها تذهب إلى أبعد من ذلك بالإشارة إلى أن الفكر الليبرالي الحالي للعلاقات الدولية أكثر اعتمادًا على الليبرالية التجريبية، والعنصرية بشكل صريح، لجون ستيوارت ميل. يان تُعيد إحياء أطروحة "إمبريالية التجارة الحرة" التي طرحها غالاغر وروبنسون (1953) في وقتنا الحاضر، مُظهرةً كيف يُمكّن الاقتصاد والأيديولوجية الليبرالية الصراع والإمبريالية الجديدة من خلال منح حقوق السيادة وعدم التدخل فقط لمن تعتبرهم قد استوفوا معايير الديمقراطية. تُحكم الدول "شبه الفاشلة" أو "الفاشلة" بمدى التزامها بالزخارف السياسية الأوروبية المُصدَّرة إليها عبر عمليات الاستعمار وإنهاء الاستعمار العنيفة، متجاهلةً عملية التفاوض التي تُطبَّق من خلالها هذه المفاهيم وتُختبر عبر مختلف فضاءات عالم ما بعد الاستعمار. تُظهر مناهج ما بعد الاستعمار أنه يُمكن تحقيق فهم أكثر دقة للدولة من خلال مزج هذا التركيز الزمني للفكر الأوروبي بوعي مكاني أكبر بتنوع السياسة العالمية. كانت فكرة "التقدم" محوريةً لتبرير الإمبريالية، وجسَّدت مسارًا خطيًا وغائيًا للتاريخ على أسس أوروبية، مع ترك من لم يلتزم في "غرفة انتظار التاريخ". ومع ذلك، فإن إعادة صياغة مفهوم عدم المطابقة هذا يُشكِّل تحديًا للرواية الخطية. لنأخذ فكرة التهجين المؤثرة التي طورها هومي بابا ، "حيث يتحدى بناء كائن سياسي جديد، لا هذا ولا ذاك"، توقعات وفهم السياسي. يُظهر التعامل مع الدول بهذا الإطار كيف تُصاغ المؤسسات في عالم ما بعد الاستعمار وفقًا للاحتياجات المحلية بدلًا من صيغة محظورة تُحدد "التقدم". يتيح إدراك هذا فهمًا أكثر شمولية وحساسية للسياسة العالمية مما تسمح به تسميات مثل "الفاشلة" أو "شبه"، كما يُقدّر فاعلية الشعوب غير الأوروبية وكيف يطالبون بالحق في السياسة في سياق دولة ما بعد الاستعمار والمجال الدولي. تتحدى هذه المناهج ما بعد الاستعمارية الجدول الزمني المفترض "للتنمية" و"التحديث" من خلال إعلان نسختها الخاصة من الدولة، وهي ليست خاطئة، بل مختلفة ببساطة.
من ما بعد الاستعمارpostcolonial إلى انهاء الاستعمارdecolonial
يمكن لمناهج ما بعد الاستعمار أن تقدم تقييمًا مقنعًا لسبب انغماس نظريات العلاقات الدولية التقليدية في المركزية الأوروبية التي تعيق قدرتها على تفسير السياسة العالمية، إلا أنه من الضروري أيضًا تقييم ما تقترحه مناهج ما بعد الاستعمار كبديل. وفي هذا الصدد، من المهم ملاحظة التناقضات القائمة بين مختلف مناهج ما بعد الاستعمار، ولفت الانتباه إلى الجهود المبذولة للتغلب على هذه التناقضات من خلال إنشاء نظرية معرفية ووجودية ما بعد استعمارية انطلاقًا من منهج الفكر غير الغربي. من منظور وجودي، يسعى بعض كُتّاب ما بعد الاستعمار إلى تحويل تركيز السياسة العالمية إلى مواضيع مثل الثقافة، والعرق ، والحياة اليومية ، والتي طمس تأثيرها نظريات توجيهية حول ما يُشكل السياسي. على سبيل المثال، عندما تُناقش الثقافة في النظريات التقليدية، فإن ذلك يتم بطريقة أوروبية مركزية، مثل تصور المدرسة الإنجليزية للعالمية على أنها أفقية لا هرمية، أو من خلال مساواة الثقافات والحضارات بالدول القومية. علاوة على ذلك، لا يزال الميل إلى جوهرية الثقافات، كما حدده سعيد، واضحًا بشكل صارخ في أعمال مثل كتاب صموئيل هنتنغتون (1997) "صراع الحضارات وإعادة صياغة النظام العالمي". بل إن مناهج ما بعد الاستعمار تستخدم الثقافة للتأكيد على مفهوم الاختلاف في المجال الدولي في مواجهة النزعات الشمولية لمعظم نظريات العلاقات الدولية. على سبيل المثال، يُجادل إناية الله وبلاني بأنه بإدراكنا أن للآخرين "روايات بديلة لما نسميه "التحديث" أو "الحضارة"، ربما كنا سنتنبأ بالإذلال والغضب ورد الفعل العنيف تجاه ما يُنظر إليه على أنه مشاريع استعمارية" فيما يتعلق بالهجمات على مركز التجارة العالمي. ومع ذلك، فإن الطبيعة السائدة للمصطلحات ذات التوجه الأوروبي في اللغة المستخدمة لمناقشة السياسة تعني أنه قد يصعب اختراق الفئات الأنطولوجية التقليدية. على سبيل المثال، يسعى أنسيمس دي فريس وآخرون إلى الانتقال إلى مناقشة الصراعات من أجل التنقل بدلاً من اللجوء إلى مصطلحات مثل المواطنة أو الأمن في دراسات الهجرة النقدية. تُسلط هذه المسألة الضوء على حدود ما بعد البنيوية، التي تُدحض إمكانية وجود نظريات شاملة ومعرفة محايدة، وتركيزها على التفكيك . في حين أن هذا الموقف يُمكن أن يُكمّل مناهج ما بعد الاستعمار، يُشير ساجد الى أن ما بعد البنيوية، ومن المفارقات، تُغفل تاريخيتها وأهمية التجربة الجزائرية في الاستعمار وإنهاء الاستعمار في توفير الحوافز الفكرية لمُنظّريها. علاوة على ذلك، يبدو أن نقد كريشنا القائل بأن انشغال ما بعد الحداثة بالتمثيل يعني فقدان "الحس المادي للعنف" ينطبق بالقدر نفسه على نصية التفكيكية، التي قد تُسهم، بتقديمها نقدًا داخليًا للغرب، في استبعاد أو استيعاب الأصوات غير الغربية أو إضفاء طابع رومانسي على مقاومة راديكالية غير غربية، مما يُخنق مجددًا قدرة الشعوب غير الغربية على التأثير. كيف إذن يُمكن لمناهج ما بعد الاستعمار أن تتجاوز ما بعد البنيوية التي اتسمت بها شخصيات مثل سعيد وبهابي، إلى مفهوم للسياسة العالمية ليس حديثًا، بل ما بعد استعماري؟ قد يُقدم أنسيمس دي فريس وتازولي حلاً في تفسيرهما للتصدع، الذي يسعى إلى زعزعة الثنائيات من خلال تجاوز المفاهيم التي تقدمها الحداثة وتحدي الانشغال الحديث بالكمال أو التماسك. وقد أوضح فاسكيز هذا الأمر، الذي يُحدد كيف تُتيح التصدعات في نظام الحداثة والاستعمار تكوينات سياسية بديلة، مثل "الحكم الذاتي" و"المجتمعات المحلية" التي تمارسها جماعات مكسيكية مثل الزاباتيستا أو مجتمعات أواكساكا الأصلية. وتتجاوز هذه المفاهيم التفتيت، الذي لا يزال مدينًا لما بعد البنيوية، نحو تطوير وجود سياسي ما بعد استعماري حقيقي. بالعودة، ولو للحظة، إلى تعليقات كريشنا حول المادية، نركز على نهج آخر في السياسة العالمية كان مؤثرًا في مرحلة ما بعد الاستعمار: الماركسية. ورغم اهتمامه بالمادية، فإن قوة النهج الماركسي في التعامل مع التجربة الاستعمارية تكمن في قدرته على توضيح الواقع الوحشي للاستغلال والقمع الاستعماريين، كما وصفه فرانز فانون بوضوح في أعماله بأنه "جو من العنف، ذلك العنف الكامن تحت الجلد". ورغم استعانته بماركس بشكل كبير، إلا أن فانون يدرك أيضًا أن تحليله يتطلب توسيعًا ليتناسب مع المشكلة الاستعمارية. إلا أن نقد ما بعد الاستعمار للماركسية يتجاوز مجرد التوسيع الطفيف. فقد أشار لينين (1917)، في شرحه الأساسي للموقف الماركسي التقليدي، إلى الإمبريالية على أنها "أعلى مراحل الرأسمالية". ومع ذلك، فإن ما يعود إليه هذا هو نقد الحداثة ومفهومها الخطي والغائي للزمن؛ وهو نقدٌ تميل إليه الماركسية بشكل خاص، نظرًا لمفهومها التدريجي للطريق إلى الشيوعية. سعى عمل ماتان (2011) إلى التخفيف من هذا التأثير، من خلال إحياء مفهوم تروتسكي عن "التطور غير المتكافئ والمركب" كتحليل ماركسي للسياسة العالمية يُراعي الاختلاف. يسعى هذا العمل إلى "استعادة العالمي" لصالح مناهج ما بعد الاستعمار من خلال تضمين التباين فيه.
على الرغم من تقديمه حجة مقنعة لدمج عملي بين الماركسية وما بعد الاستعمار، إلا أن مفهوم "التطور غير المتكافئ والمركب" متجذر في الكتابات السياسية للحداثة الأوروبية، وبالتالي فهو غير قادر على تقديم رؤية حقيقية لما بعد الاستعمار للسياسة العالمية. على الرغم من عدم قدرة عمل ماتين على التخلص من جذوره الحديثة، فإنه يطرح تساؤلاً حول دور الكوني في مناهج ما بعد الاستعمار، وما إذا كان الكوني شرطاً أساسياً لتفسير مُرضٍ للسياسة العالمية. بالنظر إلى الإرث الإشكالي لكلٍّ من ما بعد البنيوية والماركسية، فإن مثل هذه الكونية تتطلب منطقاً ما بعد استعماري. هذه ليست انعزالية فكرية لمجرد الانعزالية، بل هي خطوة حاسمة في تجاوز الإرث الفكري للاستعمار. يُدرك منظرون مثل شيليام استحالة استخلاص مفهوم ما بعد استعماري حقيقي للسياسة من شريعة الفكر الغربي. وعلى حد تعبير ميغنولو، "إن حدود الفلسفة الغربية هي الحدود التي يبرز عندها الاختلاف الاستعماري"، وينفتح مجالٌ للتاريخ المحلي. بالاعتماد على أعمال المنظرين اللاتينيين كويجانو ودوسيل، يُفصّل ميغنولو نظرية معرفية ثانوية حول "التنوع كمشروع عالمي" تُعيد "العالمي" إلى ما لم يستطع مفهوم ماتان تحقيقه. فالأمر لا يعني أن الشعوب الأخرى تفتقر إلى مفهوم العالمي - لنأخذ، على سبيل المثال، الرؤية الكونية الأنديزية. بل يكمن الخطأ في افتراض أن نسخة واحدة أفضل أو قادرة على غلبة الأخرى. وكما ذكر كويجانو، ليس من الضروري "رفض فكرة الشمولية برمتها للتجرد من الأفكار والصور التي صُنعت بها في ظل الاستعمار الأوروبي/الحداثة". بدلاً من ذلك، يمكن استيعاب هذه الرؤى المختلفة وتقديرها لاختلافها في التحول من الكوني إلى التعددي في تفسيراتنا للسياسة العالمية، دون فقدان بُعد القوة الناشئ عن الاختلاف الاستعماري. وبالتالي، فإن التفسير اللااستعماري للسياسة العالمية أكثر شمولية، ويستوعب الاختلاف، ويهتم بعلاقات القوة المضمنة في العلاقات الدولية، سواءً في الممارسة أو النظرية. من المهم أيضًا ملاحظة أن ظهور مثل هذا الشكل من العلاقات الدولية لا يعني بالضرورة أنه يجب علينا التقليل من قيمة مناهج ما بعد الاستعمار. ما يهم هو أنه عند استخدام ما بعد البنيوية أو الماركسية، يظل المنظرون دائمًا منتبهين لكيفية تأثر هذه النظريات نفسها بالممارسات الاستعمارية أو إدامتها، والسعي إلى التغلب على هذه الاتجاهات وتجاوز حدود الإطار المرجعي الغربي. بالعودة، ولو للحظة، إلى تعليقات كريشنا حول المادية، نركز على نهج آخر في السياسة العالمية كان مؤثرًا في مرحلة ما بعد الاستعمار: الماركسية. ورغم اهتمامه بالمادية، فإن قوة النهج الماركسي في التعامل مع التجربة الاستعمارية تكمن في قدرته على توضيح الواقع الوحشي للاستغلال والقمع الاستعماريين، كما وصفه فرانز فانون بوضوح في أعماله بأنه "جو من العنف، ذلك العنف الكامن تحت الجلد". ورغم استعانته بماركس بشكل كبير، إلا أن فانون (1961) يدرك أيضًا أن تحليله يتطلب توسيعًا ليتناسب مع المشكلة الاستعمارية. إلا أن نقد ما بعد الاستعمار للماركسية يتجاوز مجرد التوسيع الطفيف. فقد أشار لينين (1917)، في شرحه الأساسي للموقف الماركسي التقليدي، إلى الإمبريالية على أنها "أعلى مراحل الرأسمالية". ومع ذلك، فإن ما يعود إليه هذا هو نقد الحداثة ومفهومها الخطي والغائي للزمن؛ وهو نقدٌ تميل إليه الماركسية بشكل خاص، نظرًا لمفهومها التدريجي للطريق إلى الشيوعية. سعى عمل ماتان (2011) إلى التخفيف من هذا التأثير، من خلال إحياء مفهوم تروتسكي عن "التطور غير المتكافئ والمركب" كتحليل ماركسي للسياسة العالمية يُراعي الاختلاف. يسعى هذا العمل إلى "استعادة العالمي" لصالح مناهج ما بعد الاستعمار من خلال تضمين التباين فيه. على الرغم من تقديمه حجة مقنعة لدمج عملي بين الماركسية وما بعد الاستعمار، إلا أن مفهوم "التطور غير المتكافئ والمركب" متجذر في الكتابات السياسية للحداثة الأوروبية، وبالتالي فهو غير قادر على تقديم رؤية حقيقية لما بعد الاستعمار للسياسة العالمية. على الرغم من عدم قدرة عمل ماتين على التخلص من جذوره الحديثة، فإنه يطرح تساؤلاً حول دور الكوني في مناهج ما بعد الاستعمار، وما إذا كان الكوني شرطاً أساسياً لتفسير مُرضٍ للسياسة العالمية. بالنظر إلى الإرث الإشكالي لكلٍّ من ما بعد البنيوية والماركسية، فإن مثل هذه الكونية تتطلب منطقاً ما بعد استعماري. هذه ليست انعزالية فكرية لمجرد الانعزالية، بل هي خطوة حاسمة في تجاوز الإرث الفكري للاستعمار. يُدرك منظرون مثل شيليام استحالة استخلاص مفهوم ما بعد استعماري حقيقي للسياسة من شريعة الفكر الغربي. وعلى حد تعبير ميغنولو، "إن حدود الفلسفة الغربية هي الحدود التي يبرز عندها الاختلاف الاستعماري، وينفتح مجالٌ للتاريخ المحلي. بالاعتماد على أعمال المنظرين اللاتينيين كويجانو ودوسيل، يُفصّل ميغنولو نظرية معرفية ثانوية حول "التنوع كمشروع عالمي" تُعيد "العالمي" إلى ما لم يستطع مفهوم ماتان تحقيقه. فالأمر لا يعني أن الشعوب الأخرى تفتقر إلى مفهوم العالمي - لنأخذ، على سبيل المثال، الرؤية الكونية الأنديزية . بل يكمن الخطأ في افتراض أن نسخة واحدة أفضل أو قادرة على غلبة الأخرى. وكما ذكر كويجانو، ليس من الضروري "رفض فكرة الشمولية برمتها للتجرد من الأفكار والصور التي صُنعت بها في ظل الاستعمار الأوروبي/الحداثة". بدلاً من ذلك، يمكن استيعاب هذه الرؤى المختلفة وتقديرها لاختلافها في التحول من الكوني إلى التعددي في تفسيراتنا للسياسة العالمية، دون فقدان بُعد القوة الناشئ عن الاختلاف الاستعماري. وبالتالي، فإن التفسير اللااستعماري للسياسة العالمية أكثر شمولية، ويستوعب الاختلاف، ويهتم بعلاقات القوة المضمنة في العلاقات الدولية، سواءً في الممارسة أو النظرية. من المهم أيضًا ملاحظة أن ظهور مثل هذا الشكل من العلاقات الدولية لا يعني بالضرورة أنه يجب علينا التقليل من قيمة مناهج ما بعد الاستعمار. ما يهم هو أنه عند استخدام ما بعد البنيوية أو الماركسية، يظل المنظرون دائمًا منتبهين لكيفية تأثر هذه النظريات نفسها بالممارسات الاستعمارية أو إدامتها، والسعي إلى التغلب على هذه الاتجاهات وتجاوز حدود الإطار المرجعي الغربي.
الخاتمة: ندرة "الأفضل"
يبدو من المناسب أن نختتم بالتعليق على سبب عبث محاولة تقديم مبررات لتفسير مناهج ما بعد الاستعمار "الأفضل" للسياسة العالمية مقارنةً بنظريات العلاقات الدولية الأخرى. أظهر التحليل أن نظريات العلاقات الدولية التقليدية، وحتى النظريات النقدية مثل ما بعد البنيوية والماركسية، تعمل ضمن حدود نظرية معرفية أوروبية المركز بطبيعتها، ومرتبطة برؤية للسياسة العالمية مفرطة في زمانيتها، مع مقولات وجودية تعكس هذه الرؤية. حتى عندما تُنتقد الرؤية الأوروبية للحداثة من الداخل، فإن هذا النقد يميل إلى الرجوع إلى هذه المقولات نفسها لتحقيق ذلك. بدلاً من ذلك، يمكن لنظرية معرفية ما بعد الاستعمار أن تخلق مساحة لعالمية تستوعب الاختلاف بدلاً من إقصائه، بينما يمكن للمفاهيم الوجودية المستمدة من هذه النظرية المعرفية والتجربة غير الغربية أن تُبلور رؤية للسياسة العالمية أكثر شمولية ودقة. ومع ذلك، يبدو أن القول بأن هذا التفسير "أفضل" ينفي الهدف الأساسي لمناهج ما بعد الاستعمار في العلاقات الدولية؛ وهو لفت الانتباه إلى التسلسلات الهرمية المتأصلة في المجال الدولي من خلال الممارسات والخطابات الاستعمارية والإمبريالية الماضية والحالية. إن وصف هذه المناهج بأنها "أفضل" لا يعدو أن يكون انخراطًا في نفس التوجه نحو التسلسل الهرمي والثنائيات والاختزالية التي تُنتقد في مناهج أخرى. ولهذا السبب، دافعت هذه المقالة بقوة عن أهمية مناهج ما بعد الاستعمار في تفسير السياسة العالمية، لكنها رفضت اختزال هذه السمات في تمييز أفضل أو أسوأ. يكفي القول إن مناهج ما بعد الاستعمار تشجع على فهم السياسة العالمية الذي يستحق هذا الاسم حقًا."
بقلم سوزانا فيتزجيرالد 26 يونيو 2019 جامعة: كينغز كوليدج لندن
References
Acharya, Amitav and Buzan, Barry (2007) ‘Why is there no non-Western international theory? An introduction’, International Relations of the Asia-Pacific 7(3), pp.287-312.
Ansems de Vries, Leonie et al. (2017) ‘Collective Discussion: Fracturing Politics (Or, How to Avoid the Tacit Reproduction of Modern/Colonial Ontologies in Critical Thought’, International Political Sociology 11, pp.90-108.
Barkawi, Tarak and Laffey, Mark (2006) ‘The postcolonial moment in security studies’, Review of International Studies 32, pp.329-352.
Beier, J. Marshall (2004) ‘Beyond Hegemonic State(Ment)s of Nature: Indigenous knowledge and non-possibilities in international relations’ in Power, Postcolonialism and International Relations: Reading race, gender and class, edited by Geeta Chowdry and Sheela Nair. London/New York: Routledge.
Bhabha, Homi (1994) The Location of Culture. London/New York: Routledge.
Chakrabarty, Dipesh (2000) Provincializing Europe: Postcolonial thought and historical difference. Princeton/Oxford: Princeton University Press.
Chowdry, Geeta and Nair, Sheela (2004) ‘Introduction: Power in a postcolonial world: race, gender and class in international relations’ in Power, Postcolonialism and International Relations: Reading race, gender and class, edited by Geeta Chowdry and Sheela Nair. London/New York: Routledge.
Darby, Phillip (2004) ‘Pursuing the Political: A Postcolonial Rethinking of Relations International’, Millenium: Journal of International Studies 33(1), pp.1-32.
Doty, Roxanne Lynn (1993) ‘The Bounds of ‘Race’ in International Relations’, Millennium: Journal of International Studies 22(3), pp. 443-61.
Edkins, Jenny (2007) ‘Poststructuralism’ in International Relations Theory for the Twenty-First Century: An Introduction, edited by Martin Griffiths. London: Routledge
Escobar, Arturo (2007) ‘Worlds and Knowledge Otherwise: The Latin American Modernity/Coloniality Research Program’, Cultural Studies, 21 (2-3), pp.179-210.
Fanon, Frantz (1961) The Wretched of the Earth. Re--print--, London: Penguin. 2001.
Fukuyama, Francis (1992) The End of History and the Last Man. Harmondsworth: Penguin.
Gallagher, John and Robinson, Ronald (1953) ‘The Imperialism of Free Trade’, The Economic History Review 6 (1), pp.1-15.
Grovogui, Siba N. (2013) ‘Postcolonialism’ in International Relations Theories: Discipline and Diversity, edited by Tim Dunne, Milja Kurki and Steve Smith. 7th Edition. Oxford: OUP.
Hobbes, Thomas (1588-1679) Leviathan. Re--print-- edited by J. C. A. Gaskin, Oxford: OUP. 1998.
Hobson, John (2012) The Eurocentric Conception of World Politics: Western International Theory, 1760-2010. Cambridge: CUP.
Huntington, Samuel (1997) The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order. New York: Simon and Schuster.
Inayatullah, Naeem and Blaney, David L. (2004) International Relations and the Problem of Difference. London: Routledge.
Jabri, Vivienne (2013) The Postcolonial Subject: Claiming Politics/Governing Others in Late Modernity. London/New York: Routledge.
Jahn, Beate (2005) ‘Kant, Mill, and Illiberal Legacies in International Affairs’, International Organization 59, pp.177-207.
Lenin, Vladimir (1917) Imperialism: the highest stage of capitalism – a popular outline. Re--print--, New York: International Publishers, 1939.
Krishna, Sankaran (1993) ‘The Importance of Being Ironic: A Postcolonial View on Critical International Relations Theory’, Alternatives 18, pp.385-417.
Kurki, Milja and Wight, Colin (2013) ‘International Relations and Social Science’ in International Relations Theories: Discipline and Diversity, edited by Tim Dunne, Milja Kurki and Steve Smith. 7th Edition. Oxford: OUP.
Matin, Kamran (2011), ‘Redeeming the universal: Postcolonialism and the inner life of Eurocentrism’, European Journal of International Relations, 19 (2), pp.353-377.
Mignolo, W-alter-D (2002) ‘The Geopolitics of Knowledge and the Colonial Difference’, South Atlantic Quarterly 101 (1), pp.57-96.
Pagden, Anthony (2003) ‘Human Rights, Natural Rights, and Europe’s Imperial Legacy’, Political Theory 31(2), pp.171-199.
Rojas, Cristina (2016) ‘Contesting the Colonial Logics of the International: Toward a Relational Politics for the Pluriverse’, International Political Sociology (2016) 10, pp.369-382.
Said, Edward (1978) Orientalism. Re--print--, London: Penguin. 2003.
Sajed, Alina (2012) ‘The post always rings twice? The Algerian War, poststructuralism and the postcolonial in IR theory’, Review of International Studies 38, pp.141-163.
Seth, Sanjay (2011), ‘Postcolonial Theory and the Critique of International Relations’, Millenium: Journal of International Studies 40 (1), pp.167-183.
Shilliam, Robbie (2011) ‘The perilous but unavoidable terrain of the non-West’ in International Relations and Non-Western Thought: Imperialism, Colonialism and Investigations of Global Modernity, edited by Robbie Shilliam. London: Routledge.
Sylvester, Christine (2017) ‘Post-colonialism’ in The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations edited by John Baylis, Steve Smith, and Patricia Owens. 7th Edition. Oxford: OUP.
Tickner, Arlene B. and Blaney, David L. (2012) ‘Introduction: thinking difference’ in Thinking International Relations Differently edited by Arlene B. Tickner and David L. Blaney. Abingdon/New York: Routledge.
Tucker, Karen (2018), ‘Unraveling Coloniality in International Relations: Knowledge, Relationality, and Strategies for Engagement’, International Political Sociology 12, pp.215-232.
Waltz, Kenneth (1979) Theory of international politics. Reading: Addison-Wesley.
Walker, R. B. J. (1993) Inside/Outside: International Relations as Political Theory. Cambridge: CUP.
كاتب فلسفي
#زهير_الخويلدي (هاشتاغ)



ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

 |
بحث
|
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
|
إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة