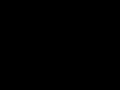|
|
المقاومة الفلسطينية: محاولة تقييم انتقادي
سلامة كيلة



الحوار المتمدن-العدد: 1734 - 2006 / 11 / 14 - 12:17
المحور:
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
لاشك أن الرهبة والتهيّب يقفزان بقوة حين محاولة تقييم تجربة المقاومة الفلسطينية، نقدها ومحاولة توضيح إشكالاتها. والسبب، كما يبدو لي، نابع من التجربة ذاتها: الظروف التي وُجدت فيها، التصورات التي طرحتها، الدور الذي لعبته، والتصورات التي تبلورت حولها. فقد جاءت المقاومة الفلسطينية بعد تفاقم أزمة الحركة القومية العربية، وبعد بدء انكسار الأحلام التي انتشرت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أحلام الجماهير العربية في التحرر والوحدة القومية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي. كما لعبت هزيمة حزيران دوراً في زيادة الاهتمام بها، خصوصاً أنها تطرح صيغة عمل جديد، وتقلب بعض المفاهيم التي أوحت هزيمة حزيران بسقوطها(1). في المقابل، تصدّرت المأساة التي تعرضت لها الجماهير الفلسطينية عام 1948، والتي غطتها أحلام الخمسينات وبداية الستينات، تصدّرت الاهتمام من جديد. فقد تفاقمت المشكلة الفلسطينية، وطُرحت بإلحاح مسألة الحلول الممكنة للاجئين الموزّعين في عدد من الأقطار العربية. في هذه الأجواء، أجواء العجز والهزيمة والعطف والبطولة، تبلور التصوّر الشعبي العربي للمقاومة الفلسطينية، لتصبح قيمة مطلقة، ومقدسة، ويمكن القول أنها غدت إلهاً يعبد. هنا تكون محاولة التقييم و النقد صعبة، لأنها من جهة تبدو غير مقبولة، ومن جهة أخرى واقعة تحت عبء رؤى مقابلة فاحصة ومدققة، مما يفرض رقياً في التناول النقدي، ووضوحاً في التقييم يدفعان للإطاحة الأشمل وللدراسة الأدق..
في الجانب الآخر، تبدو إشكالية أخرى معاكسة، حيث أن في التجربة الفلسطينية من «الركاكة» والتخلف على الصعيد النظري، وفي مجال العمل الحزبي والعسكري والسلوك، ما يجعل التقييم والنقد لا يبدوان منطقيين، بل قد يوحيان ببعض التسفيه لتجربة حظيت باهتمام كبير، ومثلّت مرحلة مهمة في تاريخ النضال العربي. كيف ذلك؟ يبدو أن عمق الأزمة التي تفاقمت في الوطن العربي منذ أواسط الستينات، جعلت «العقل» العربي يرى الأمور مقلوبة، فيعكس مطامح ذاتية على حركات تمثّل شيئاً آخر. و بدل أن تفرض بوادر الانكسار العودة إلى الواقع و محاولة فهمه، فرضت التوغّل بعيداً في «الحلم»، حلم القوة و الانتصار و التحرّر، وبالتالي فرضت، أيضاً، الهروب بعيداً عن الواقع، عن الظرف الواقعي. إن التناول التقييمي النقدي هنا يغدو شائكاً إلى أبعد الحدود، لأنه لا يمكن اللجوء إلى التبسيط في ذلك، في نفس الوقت الذي لا تعطي التجربة ذاتها من الحيوية ما يجعل التناول التقييمي النقدي ذا غنىً. و في هذا المجال يمكن ملاحظة عدد من القضايا التي أسهمت في ذلك، منها أن هناك إتجاهات لم تكن تطرح بوضوح ما يعبّر عن أهدافها، بل كانت تستخدم الحديث الإنشائي والشعارات الرنّانة، مما كان يعني غياب التصور النظري الذي يعبّر عن طبيعة المقاومة، أو تنظيم الأفكار و المفاهيم من قبل أطراف ليست هي الفاعلة في بنية المقاومة، وهي بدورها كانت تعكس رؤيتها وطموحاتها و أحلامها، ولم تكن تعبّر عن الاتجاه الأساسي فيها. إضافة إلى أن التجربة كتجربة لم تدرس بعد.
من هنا تأتي الرهبة و يقوى التهيّب. و لكن أيضاً هل من الممكن تقييم التجربة الحيّة بمجموعة تصورات تبدو ميتة؟ في كل الأحوال من الضروري تقييم التجربة، ولاشك أن الظروف العامة التي باتت تعيشها المقاومة الفلسطينية، تجعل مسألة التقييم راهنة وذات أهمية. وهنا نستعيد قول لينين: «إن الملايين التي استيقظت فجأة من سباتها الطويل، و واجهت حالاً أهم القضايا، لم تستطع البقاء طويلاً في مستوى هذه القضايا. إنها لم تستطع الاستغناء عن وقفة، عن عودة إلى المسائل الأولية، عن استعداد جديد يتيح «هضم» الدروس الغنية بالعبر، غنى لا سابق له، ويتيح لجماهير أوسع إلى ما لا حد له، إمكانية التقدم من جديد بخطى تكون هذه المرة أشدّ ثباتاً، و أوفر وعياً و أقوى اطمئناناً، وأكثر استقامة، إلى حد كبير»(2).
لقد غدا التقييم النقدي حاجة راهنة، وهذا ما يفرض أن نبحث في تجربة المقاومة الفلسطينية، وأن ندرس إشكالاتها.
لكن قبل ذلك لاُبدّ من الإشارة إلى أن إشكالية المقاومة الفلسطينية العامة هي إشكالية الحركة الوطنية العربية. وهنا نحن لا نعني التشابه فقط، بل نشير إلى أبعد من ذلك، إن الأزمة هي أزمة الحركة الوطنية العربية أساساً، و إن كانت هناك بعض الخصوصيات للتجربة الفلسطينية. وسوف يوضح البحث اللاحق هذه المسألة، سواء بـ«واحديّة» الأزمة، أو بخصوصيات التجربة الفلسطينية. إننا أمام مظاهرة مشتركة، كما نحن أمام أسباب واحدة، خصوصاً حينما يتعلق الأمر بالتصوّر النظري الذي عَبّر عن التجربة، وبالتالي بالأسس التي قام عليها، والفئات التي عَبّر عنها، وهنا نحن لا نريد تعميم الجزئي على الكلي، بل أن منطلقنا هو النظر للجزئي من خلال الكلي.
مناقشة التجربة الفلسطينية
مناقشة التجربة الفلسطينية تفترض التنويه إلى مسألتين، فأولاً نحن نناقش المقاومة الفلسطينية، الحركة السياسية الفلسطينية، ونعني هنا أننا نحاول التمييز بين المنظمات الفلسطينية والجماهير الفلسطينية، من أجل أن نتجاوز إشكالية كانت سائدة داخل المقاومة، تقارن المقاومة بكومونة باريس وتطبق الدعوة الماركسية لاندماج المثقفين بحركة الجماهير العفوية على التجربة الفلسطينية(3)، دون رؤية الفروق الجوهرية بين حركة جماهيرية عفوية، غير منظمة، وبين حركة سياسية منظمة لها تصوراتها وبرامجها وقياداتها وتعبيراتها الطبقية. فقد بدأ النضال الفلسطيني الراهن بمجموعة من القوى، أهمها حركة فتح، حاولت أن تلعب دوراً عسكرياً « جديداً» ضد الكيان الصهيوني، كان يبدو صغيراً قبل هزيمة عام 1967، لكن الهزيمة دفعت الجماهير الفلسطينية للحاق بهذا الخيار، ولقد انتظمت ضمن الأطر القائمة، وناضلت على ضوء المفاهيم التي حرصت تلك الحركة على نشرها. وإذا كان عدد من المثقفين قد إنضمّ إلى التجربة، فقد ظل دورهم ثانوياً، ولم يكن ممكناً لهم إسقاط البنية الأيديولوجية التي سودّتها حركة فتح، ولا أن يغيّروا في البرنامج السياسي المطروح، لا بل أنهم لعبوا دور أدلجة هذا البرنامج، و تفسيره بما يتفق مع تصوراتهم، دون الانتباه إلى مصلحة القوى الطبقية القائدة وتصوراتها. إن تمييزنا بين المقاومة (المنظمات الفلسطينية) و الجماهير، يهدف إلى إعمال التقييم النقدي في الحركة السياسية ذاتها، مع الانتباه للتضحيات الكبيرة التي قدّمتها ولازالت الجماهير الفلسطينية، وكذلك للدور الذي لعبته. إن المقاومة الفلسطينية هي المعنية بالنقد لأنها هي التي صاغت طبيعة النضال الفلسطيني طيلة السنوات منذ عام 1965.
وثانياً: هل نستطيع تلخيص أزمة المقاومة في بنيتها النظرية؟ إننا ننطلق هنا من أن الرؤية النظرية هي انعكاس للبنية الطبقية، هي «وعي» كل طبقة لدورها، وبالتالي فحين نشير للتصوّر النظري نعرف أنه انعكاس لبنية طبقية، لدور طبقات. ولهذا كان علينا أن ندرس هذا «الوعي». لكن المشكلة التي تواجهنا هي أن طبقات مختلفة شاركت في تكوين المقاومة، وأن «اتجاهات أيديولوجية مختلفة» انتشرت فيها، وبالتالي فإن السؤال هنا هو: عن وعي أي الطبقات عَبّر «المشروع السياسي الفلسطيني»؟ وعن أي إتجاه أيديولوجي؟ هنا نلاحظ اختلاطاً نظرياً كبيراً، وتشوّشاً واضحاً، حيث أن هناك تقاطعات هامة في التصور السياسي بين مختلف المنظمات، رغم أن هناك اختلاف معيّن في الانتماءات الطبقية. ولتوضيح ذلك سوف نقسم الموضوع إلى جانبين، الأوّل يتعلق بإشكالية المشروع السياسي، والثاني يخصّ الطبيعة الطبقية لقيادة المقاومة، فإذا كان الجانب الأوّل يشير إلى التقاطعات الهامة، فإن الجانب الثاني يشير إلى احتمالات (إمكانيات) الاختلاف.
الجانب الأوّل: إشكالية المشروع السياسي
لاشك أننا نحاول تلخيص الإشكالية العامة ولا ندخل في نقد اتجاه محدّد، بل ننقد التصوّر الذي تبلور في سياق التجربة، وبالتالي فإن هذا النقد سوف يطال كل الاتجاهات بشكل أو بآخر، وأن الجانب الثاني من هذا البحث سوف يناقش الاتجاهين الأساسيين. إننا، ونحن نناقش إشكالية المقاومة الفلسطينية، أمام تصورين، وهذا ما سوف يشار إليه حين مناقشة المشروع السياسي، ولكن سوف يلمس بوضوح حين مناقشة الطبيعة الطبقية لقيادة المقاومة.
يمكن تحديد الخطوط العامة للمشروع السياسي الفلسطيني، بثلاث قضايا أساسية، أولها يتعلق برؤية وضع فلسطين، و بالتالي القضية الفلسطينية، و وضع الكيان الصهيوني. وثانيها يتعلق بطبيعة المرحلة التي يمرّ النضال الفلسطيني فيها، و القيادة الطبقية المهيأة للقيام بالدور الريادي. و ثالثها حرب الشعب و الكفاح المسلح. وهذا ما سوف نلخص الحديث حوله.
قصور الرؤية الاستراتيجية:
ما هو وضع القضية الفلسطينية؟ ما هو وضعها العياني؟ لاشك أن منظمات المقاومة الفلسطينية أجابت على هذا السؤال، ونحن لن نؤرخ لمواقفها، لكن الذي يهمنا هو تقييم هذه المواقف. لذا يمكن الإشارة لمسألتين، الأولى تتعلق بوضع فلسطين في الإطار العربي. والثانية بوضع الكيان الصهيوني في الإطار الإمبريالي. لقد أحدثت «الايديولوجيا الفلسطينية» فصلاً مفتعلاً بين القضية الفلسطينية والقضية العربية من جهة، وبين الكيان الصهيوني والاستراتيجية الإمبريالية من جهة أخرى. وإذا كان هذا الفصل خاطىء من أساسه، فقد أوجد خطأً مضاعفاً في التجربة الفلسطينية، لأنه قاد إلى تصورات خاطئة فيما يتعلق بطبيعة النضال، حيث ابتسر إلى ابعد حدٍّ ممكن، فتبلورت صيغة «النضال الوطني التحرري ضد إستعمار إستيطاني». هل هو نضال وطني تحرري فقط؟ وهل الصراع مع الصهيونية هو صراع ضد استعمار استيطاني؟
رغم أن أفكار المنظمات الفلسطينية المختلفة تؤكد الربط بين فلسطين والأمة العربية، حيث أن فلسطين هي «جزء من الوطن العربي، والشعب الفلسطيني جزء من الأمة العربية»(4)، ورغم الحديث الطويل عن علاقة النضال الفلسطيني بالنضال العربي، إلا أن كل ذلك لا يعبّر سوى عن «رؤية فكرية»، عن حديث «نظري»، عن شعار «عمومي»، بمعنى أنه «موقف نظري» مفصول عن الممارسة العملية و مخالف لها. طبعاً هذا يدخلنا في إشكالية أعم، هي إشكالية النضال العربي منذ نصف قرن تقريباً، ونقصد إشكالية العلاقة بين «النضال القطري» والنضال القومي. كما يدخلنا في مناقشة قانون نظري يتعلق بالعلاقة بين العام و الخاص في النضال. لقد أدت اتفاقيات سايكس ـ بيكو، ليس إلى تجزئة الوطن العربي (المشرق العربي) فقط، بل وإلى تجزئة النضال العربي ، فتصاعد «النضال القطري» الذي أدى إلى حصول الاستقلال السياسي «للدول العربية»، لكنه لم يحقق أكثر من ذلك، بل أن الاستقلال السياسي ذاته غدا عرضة للتصفية أمام جبروت العلاقات التي أوجدها النظام الإمبريالي بقيادة الولايات المتحدة، ونقصد نظام التبعية. مما أظهر أن تغيراً سطحياً قد حصل. لكن مشكلة النضال الفلسطيني أعقد من ذلك، بسبب من طبيعة المشكلة ذاتها، وبالضبط لأنها مشكلة عربية، من غير الممكن فصلها لا نظرياً ولا عملياً عن مجمل القضية العربية. و إذا كانت طبيعة الوجود الصهيوني تفرض ذلك، وهذا ما سوف نشير إليه لاحقاً، فإن وضع فلسطين وموقعها يجعلها كذلك. وبالتالي فإذا كان النظام الإمبريالي العالمي قد إنتقل إلى مرحلة جديدة، مختلفة في شكل سيطرتها على العالم، فهل يمكن للنضال الفلسطيني أن يحقِّق حتى هذا التغير السطحي؟ و خصوصاً أنه موجَّه ضد «هراوة» الإمبريالية؟ بمعنى، هل يمكن للإمبريالية أن تتخلى عن «هراوتها»؟ هنا تبرز قضية أخرى، و هي أن «النضال القطري» العربي إنطلق من العمل وسط جماهير موجودة على «أرضها»، أما النضال الفلسطيني فيفتقد هذه المزية، بل أن معظم الجماهير الفلسطينية تسعى من أجل العودة إلى فلسطين، وبالتالي فالنضال الفلسطيني إنطلق من الأرض العربية. ولقد كان الفصل بين هذا النضال والنضال العربي (و خصوصاً في بعض الدول المحيطة بفلسطين ـ الأردن، سوريا، لبنان، مصر) صعباً ومدمراً. و نقول مدمراً لأنه عانى من ازدواجية معقّدة حيث كان يحكمه التصور العام لأيديولوجيا المقاومة الفلسطينية، و نقصد مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية(5)، في نفس الوقت الذي كان من الصعب فصله عملياً، في الممارسة العملية، مما أوجد ارتباكاً داخلياً، أسهم في مفاقمة المشاكل التي عانتها المقاومة في هذه الدول، وقاد إلى النتيجة الحتمية، أي طردها منها.
لقد فصلت القضية الفلسطينية عن القضية القومية العربية، و فصل الفلسطينيون عن العرب، و تأسست الرؤى النظرية على هذا الأساس. فطُرحت أولوية تحرير فلسطين كهدف، و جرى الدفع باتجاه أن يمرّ النضال العربي من خرم الإبرة هذا، لكن مع إبقاء الدور الفلسطيني طليعياً، و مساندة العرب له فقط (6). كما غدت فلسطين طريق الوحدة العربية. باختصار دفعت «الايديولوجيا الفلسطينية» باتجاه استقلال «القضية الفلسطينية» و استقلال «النضال الفلسطيني»، لكن مع دور عربي يتمثل بالصفيق لهذا البطل.
طبعاً هذا يعود إلى مسألة «النزوع المحلي» في الوعي العربي، الذي كان أساس النضال القطري (و أقل من القطري) العربي، و كان أساس النضال القطري الفلسطيني. هذا النزوع الذي يغلِّب روابط القربى على الرابطة الوطنية. وسبب الظاهرتين واحد، و هو سيادة الوعي ما قبل رأسمالي، (أو ما قبل شمولي)، الوعي القبلي، الطائفي، المحلي، على الوعي الوطني، وعي ارتباط الفرد بوطن و بأمة، و ليس وعي ارتباط شيء بقبيلة أو بطائفة أو بمنطقة، لذلك طالبت المنظمات الفلسطينية بأن تصبح القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في النضال العربي، دون أن تطرح على نفسها ما هي مهماتها تجاه قضايا الجماهير العربية. هنا ندخل في قانون الخاص و العام، حيث أن الذي جري هو تعميم الخاص، إحلال الخاص محلّ العام. لقد تأسست بنية أيديولوجية مختلّة، تقوم على أساس فصل قضية فلسطين عن القضية العربية، في نفس الوقت التي تُدفع لأن تصبح قضية العرب المركزية، في المقابل يلعب الفلسطينيون دوراً طليعياً(7)، و لا يطلب من العرب سوى المساندة و الدعم. في هذا الإطار تطوّر النضال القطري، و خفت «الدعم» العربي. و كان منطقياً أن يحدث ذلك، لأن الجماهير العربية المعنية بقضية فلسطين، تعيش ظروفاً تفرض عليها ليس طرح قضية فلسطين فقط، بل قضايا أخرى مختلفة، منها على الأقل الموقف من الأنظمة الحاكمة، ومن الاستغلال الذي تعيشه. و بالتالي كان صعباً عليها التزام النضال فقط لتحرير فلسطين (إلا مجموعات من المناضلين الذين كانوا يغادرون مواقعهم الطبقية للالتحاق بالمقاومة الفلسطينية). ثم أن منظمات المقاومة كانت عاجزة عن حشد جماهير واسعة، و ملزمة نفسها أن لا تفعل ذلك (شعار عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، الذي كان يعني في التطبيق الابتعاد عن التعامل مع الجماهير العربية، خشية مفاقمة إشكالات مع الأنظمة).
هذا يطرح التساؤل التالي و هو: هل يمكن فصل نضالات جماهير الأمة الواحدة؟ هنا ندخل في مناقشة إشكالية النضال القطري العربي كله. و بالتالي هل تفرض الانقسامات ـ التي بفعل داخلي، والتي بفعل خارجي ـ «انقسام» نضالات الجماهير؟ أم تفرض النضال لإزالتها؟ و هذا يفرض الإجابة على سؤال فلسفي أكثر عمومية، و هو: هل كل ما هو واقعي مقبول؟ طبعاً الإجابة بنعم تقودنا إلى هيغل(8)، أما الماركسية فقد رفضت هذه الصيغة، و أكّدت على الصيرورة، لهذا دعت لاندماج البشر في الأمم، دعت لتجاوز التجزئة الإقطاعية، و كذلك دعت الطبقة العاملة لتجاوز التجزئة التي تعتريها نتيجة «إنقسامها» للعمل في مصانع مختلفة، لرأسماليين مختلفين، لهذا اعتبرت الوحدة القومية ضرورة(9)، ووحدة العمال في طبقة ضرورة أيضاً(10)، ولم تعتبر «الوعي» المحلي، و الإقطاعي و لا الوعي الجزئي لدى العمال مقبولاً، رغم أنه كان واقعاً. لقد طالبت بتجاوز هذا الوعي، و بالتالي تجاوز أشكال النضال التي تتأسس على ضوئه. لماذا كل ذلك؟
لثلاث أسباب جوهرية، هي التالي:
أ ـ لاشك أن الحاضر هو استمرار للماضي، و إذا كان التطوّر يفرض القطيعة مع المفاهيم الأيديولوجية المؤسَّسة في الماضي، فان كل تطوّر يتضمّن كل القضايا التقدمية فيما سبقه، و إلا كانت القطيعة انقطاعاً، فلا يعود هناك تاريخ. و لعل «الطابع القومي» المعين في مجموعة من البشر ذات خصائص مشتركة، هو ما يمكن الانطلاق منه في مرحلة محدّدة. و لذلك حين يتحقق الانقسام بفعل عوامل داخلية أو خارجية، لا يكون للتاريخ معنى إذا جرى الانطلاق من نتائج (متحققات) الانقسام، لأنه بذلك يؤسّس لتاريخ جديد، يُحدث الانقطاع مع التاريخ الأصلي. و لهذا السبب بالضبط يقال عادة أن للأمة حركتها التاريخية الصاعدة.
ب ـ إن إتجاه حركة المجتمع نحو تشكيل أمة، يقوم على أساس إنهاء التفكك في التشكيلات الاجتماعية، و إلغاء أنماط الإنتاج الطبيعي، من أجل تأسيس نمط إنتاج سلعي، و بالتالي تفرض هذه العملية إسقاط «الوعي» غير الشمولي، المحلي، القبلي، الطائفي، و تأسيس وعي يعبّر عن ارتباط مجموعة من البشر بالوطن. وفي هذا الإطار يعبّر الوعي ما قبل وطني (أو قومي) عن حالة «سلفية». بمعنى أنه «وعي متخلف»، غير قادر على دفع حركة الأمة إلى الأمام.
جـ) حين الحديث عن الطبقات، نتحدث عنها في إطار أمة، فلا طبقات خارج الأمة، و لهذا تحدّث ماركس عن توحيد العمال في طبقة، و كان يقصد تجاوز التجزئة التي توجدها الصناعة في المرحلة الأولى، لهذا يؤكد على «تحويل النضالات المحلية المتعدِّدة ذات الصبغة المتماثلة في كل مكان، إلى نضال طبقي واحد يشكل القطر [وهنا يقصد الأمة ـ س] بأسره "(11 ).
هنا نعود لمسألة الخاص و العام، حيث انتشرت «نظرية الخصوصيات»(12)، و أصبحت سلاحاً أيديولوجياً يدعم «النضال القطري». لكن ليس العام هو مجموع الخاص، فهذه نظرة غير جدلية، غير علمية، بل أن العام يحوي الخاص دائماً. و لهذا فإن خصوصية القضية من عموميتها.
أما في المقاومة الفلسطينية فقد عنت الخصوصية التفرُّد، و التمايز، و الاختلاف، إلى حدّ الانفصال. و إذا كان الحديث السابق لا يصل إلى هذه النتيجة، فقد كانت هي النتيجة المنطقية له. حيث «راج في السنوات الأخيرة التنظير للإقليمية الفلسطينية، تحت مسميات عدة أهمها ـ الخصوصية ـ و ـ الكيانية ـ و ـ التفرد ـ وـ الظروف الاستثنائية ـ» وينطلق هذا التنظير من حقيقة وجود كيان فلسطيني، و إن كان غائباً عن وعي الجماهير الفلسطينية(13). وبتأكيد هذه «الحقيقة»!! يجري البدء بتمزيق التاريخ الموحّد إلى فسيفساء تاريخية(14) و مادام هناك كيان، فهناك «وعي كياني»، أي وعي الفلسطيني بارتباطه بهذا الكيان. هنا لا يعود الحديث عن خصوصيات في إطار عام، بل يجري الحديث عن «عام» جديد، مستقل، له جذوره في التاريخ. و إذا كان اختفى في مراحل معينة ، إلا أنه عاد و تبلور من جديد بعد انطلاقة المقاومة، و بعد «التطور» الذي تحقق في برنامج منظمة التحرير بعد عام 1973. وبذلك يمكن القول أن النضال القطري، أسّس الصيغة الأيديولوجية المطابقة له، أي الكيانية، فغدت هناك فلسطين، وفلسطين فقط.
في المقابل، عانى المشروع السياسي الفلسطيني من غياب الرؤية الواضحة لطبيعة المشروع الصهيوني. لقد إبتُسِر المشروع الصهيوني إلى أبعد حَدٍّ أيضاً، فاعتُبر مشروعاً استيطانياً، بمعنى أنه مشروع توطين اليهود في فلسطين. و هو كذلك بمعنى من المعاني، لكن مع ملاحظة أن غرض التوطين ليس حلّ مشكلة اليهود المشرّدين في بقاع العالم المختلفة، فهذا ما لم تطرحه لا الحركة الصهيونية ولا الدول الاستعمارية التي دعمتها. إن للتوطين غرض آخر غير الغرض «الإنساني»، إنهم جنود في حرب الإمبريالية للسيطرة على الوطن العربي، و لم يكن ممكناً تحقق المشروع الصهيوني بقيام الكيان الصهيوني لولا ذلك. و لن نطيل في ذلك لأننا نعتقد أنها واضحة، حيث «أن الدولة اليهودية» كانت «ضرورة عالمية» كما كان يعتقد هرتزل(15)، منطلقاً من رؤية مصالح الرأسمالية الأوروبية التي كانت تهدف السيطرة على آسيا وأفريقيا، وبضمنها السيطرة على العرب. و كانت تفكّر بكل التصوّرات التي تجعل السيطرة ممكنة، و في نفس الوقت تجعل استمرارها ممكناً أيضاً. لهذا ناقشت مسألة عودة اليهود إلى فلسطين قبل نشوء الحركة الصهيونية(16)، و جاء طرحها ضمن مسوغات مختلفة، فمنهم مَن ركزّ على ضرورة فصل الشرق العربي عن المغرب العربي(17). و منهم من انطلق من ضمان الطريق التجاري إلى الهند، الذي كان شريان التطوّر الاقتصادي في ذلك العصر(18)، و منهم من انطلق من السيطرة الاقتصادية على الوطن العربي، من خلال دور اليهود(19). ولهذا أصبح المشروع الصهيوني مشروعاً رأسمالياً أوروبياً منذ عام 1917 (أي منذ إصدار وعد بلفور).
والآن لازال هذا المشروع مشروعاً إمبريالياً. إن الكيان الصهيوني ليس دولة تابعة فقط ، إنه أكثر من ذلك لأن الدولة التابعة لديها دخلها القومي الذي تعمل الإمبريالية على نهبه، و لما تقدِّم لها المساعدات فلا تشكل نسبة كبيرة إلى الدخل القومي هذا. أما الكيان الصهيوني فإن نسبة 40% ـ 50% من دخله المحلي تتولد نتيجة المساعدات الخارجية(20). إذن هو جزء عضوي من الإمبريالية، يلعب دور الأداة العسكرية، و الحاجز «الأمني» في الوطن العربي، في هذا الوضع يكون الطابع الاستيطاني للكيان ثانوياً، لأنه يأتي لخدمة مصالح الاحتكارات الإمبريالية العالمية ( و نؤكد هنا أن ذلك لا يعني أن هذا الكيان بمفاهيمه الأيديولوجية و مطامحه الخاصة، لا يمتلك نزوعاً خاصاً، لكن يُعمل على التوافق بين هذا النزوع و المصلحة الإمبريالية، لأنه لا يكون إلا في إطار المصلحة الإمبريالية هذه). من هنا تكون المعركة ليس مع المستوطنين الصهاينة بصفتهم مستوطنين فقط، بل بصفتهم جنود الرأسمال الإمبريالي. وبالتالي تكون المعركة هي معركة مع الإمبريالية العالمية، و أدواتها.
إن محاولة الانطلاق من الطابع الاستيطاني للكيان الصهيوني فقط، إضافة إلى أنها تتجاوز الدور الإمبريالي الذي يقوم به، تقود إلى ربط المشروع الصهيوني بفلسطين فقط، انطلاقاً من (الرؤية التوراتية) ذاتها، التي تربط اليهود بفلسطين، متجاوزة المسألة الأهم، و هي أن فلسطيني لم تكن بالنسبة للمشروع الإمبريالي الصهيوني، سوى «موطىء قدم» من أجل تنفيذ سياسات إمبريالية في الوطن العربي. و هذا المنطق يعيد تأسيس «الكيانية الفلسطينية»، لكنه يفتح آفاقاً رحبة للسياسة القائمة على أساس التفاوض مع الكيان الصهيوني، لأنه يسقط قانون الصراع مع الإمبريالية، و يعتبر أن الاستيطان هو المشكلة. و في هذا الوضع يمكن اللجوء إلى الولايات المتحدة من أجل إيجاد حلٍّ وسط يرضي أطراف فلسطينية و أطراف صهيونية، من أجل إقامة «الدولة الديمقراطية العلمانية» في فلسطين، المتحالفة مع الولايات المتحدة، و القادرة على تحقيق مطامحها، أكثر مما تستطيع «دولة» غريبة معزولة محاصرة(21) هي الكيان الصهيوني.
و بذلك فُصلت فلسطين عن الوطن العربي، وفُصل الكيان الصهيوني عن الإمبريالية العالمية. و لقد كان هذا الفصل يتجاهل الحقائق التالية:
أـ إن الكيان الصهيوني جزء من القوى الإمبريالية، و هو أداة من أدواتها. و هذا الفهم يقتضي فهم الاستراتيجية الإمبريالية في الوطن العربي، التي تقوم على أساس دعم و توطيد الأنظمة الرجعية، إضافة إلى تقويتها الكيان الصهيوني.
ب ـ إن المخططات الإمبريالية الصهيونية تتجاوز حدود فلسطين و القضية الفلسطينية، لتشمل الوطن العربي كله، ووفق صيغ مختلفة، منها الاحتلال والتوسع، و منها تسعير الحروب الطائفية، و منها أساساً السيطرة الاقتصادية، والتوسع الاقتصادي.
جـ) إن مهمات الكيان الصهيوني في الاستراتيجية الإمبريالية الأميركية لا تشمل المحافظة على هذا الكيان ضمن حدود فلسطين فقط، بل و العمل من أجل مواجهة أية مبادرة تؤشر إلى إمكانية بروز عوامل جديدة تؤثر في وضع السيطرة الإمبريالية في الوطن العربي.
إذن لقد قُزّمت القضية إلى «كيانية فلسطينية» بينما يلعب الكيان الصهيوني دوراً «عربياً»، أي يلعب دوراً يرتبط بالحفاظ على أركان الاستراتيجية الإمبريالية، القائمة على أساس تكريس نظام التبعية الإمبريالي، و تدعم التخلف الاقتصادي الاجتماعي، و الأيديولوجي، و الحفاظ على التجزئة العربية، مع الدفع باتجاه إلغاء الطابع القومي للوطن العربي. وفي هذا الإطار كانت تبدو القوى الفلسطينية صغيرة إلى حدٍّ كبير، و لا تشكِّل سوى قوة إزعاج فقط، مما جعل شعار التحرير «حلماً» أقرب إلى الوهم، و فتح الآفاق للتصورات التي انطلقت من هذا الميزان المختل، من أجل أن تتنازل عن شعار التحرير و«تناضل» من أجل تحقيق «تسوية عادلة» تقوم على أساس التفاوض من أجل «حق تقرير المصير، و الدولة المستقلة»، التي تعني الضفة الغربية وقطاع غزة، دون باقي الأرض الفلسطينية.
التحرر الوطني أم لا؟
إذا كان قصور الرؤية الاستراتيجية، قد أسهم في اختلال رؤية وضع القضية الفلسطينية، فقد أدى أيضاً إلى نشوء اختلال آخر، تمثل في وسم مرحلة النضال الفلسطيني بمرحلة التحرر الوطني، حيث أن فلسطين محتلة من قبل قوة خارجية، سمتها أنها قوّة احتلال واستيطان، و في هذا الإطار يكون هدف النضال هو التحرر الوطني.
هل يمكن إطلاق تعبير مرحلة التحرر الوطني بكل المعاني و التصورات النظرية التي حواها، على النضال الفلسطيني؟
قبل ذلك ماذا تعني مرحلة التحرر الوطني؟ لقد عنت ثلاث قضايا متشابكة، القضية الأولى هي الانطلاق من ضرورة مواجهة العدو الخارجي المحتل. والقضية الثانية هي قضية مشاركة كل طبقات الشعب في النضال. والقضية الثالثة هي قيادة البرجوازية للنضال. و لقد سادت هذه النظرة منذ بداية هذا القرن تقريباً. و انطلقت من معالجة مشكلة الاستعمار المباشر(22)، الأمر الذي يفرض «توحيد صفوف الشعب» من أجل تحرير الأرض المحتلة، و بالتالي تصبح هذه القضية هي محور النشاط الثوري، التي تصيغ مختلف المواقف السياسية، و التي تجعل الصراع الطبقي في المرتبة الثانوية، بل و تجعل إمكانيات طرح تصورات تتعلق بذلك، أو بطبيعة الخط الاقتصادي الاجتماعي المستقبلي، أمراً طفولياً مغامراً. و«إن البورجوازية الوطنية في كثير من البلدان ترى في الاستعمار و الاحتلال الأجنبي عدواً لها و تعتبر زواله أمراً من مصلحتها لأنها ستكون البديل الطبيعي للإستعمار بعد زواله " ( 23 ). و إذا كانت الفئات البرجوازية أو البرجوازية الصغيرة تطرح هذه الصيغة من أجل أن تبرر دورها القيادي في الثورة، فإن نظرة «اليسار» تتفق مع هذه الصيغة، لكن بالاستناد إلى مبررات ماركسية، سواء في صيغة إعلان طموح السعي من أجل القيادة وتجاوز دور البرجوازية الصغيرة أو في صيغة تبرير لقيادة البرجوازية الصغيرة للعملية الثورية.
هنا نكون أمام خلاف نظري، أي يتعلق برؤية طبيعة العصر الراهن، و بالتالي بطبيعة الثورات فيه، انطلاقاً من رؤية لطبيعة الإمبريالية العالمية في صيغتها الراهنة. لكننا نكون أيضاً أمام خلاف يخصّ القضية الفلسطينية تحديداً. أو فلنقل أننا إزاء خلاف أيديولوجي وخلاف سياسي. فكما أشرنا سابقاً فقد تحدّدت سمات مرحلة التحرر الوطني انطلاقاً من ظروف الاحتلال الاستعماري التي كانت سائدة بداية القرن، على أساس حاجة الشعوب المستعمَرة للتحرر و الاستقلال. لهذا وسمت الماركسية نضالات هذه الشعوب بسمة حركة الشعوب المستعمرة الوطنية التحررية. كما كانت أقسام من برجوازية هذه الشعوب معنية بالتحرر و الاستقلال، لأنها كانت معنية بأن تؤسس لنفسها دوراً اقتصادياً. و لهذا توجّه دعم القوى الماركسية (أو بعضها على الأقل) لهذه البرجوازية، و اعتبرتها قائدة النضال التحرري. لكن ظروفاً جديدة تبلورت بعد الحرب العالمية الثانية، على وجه التحديد، أحدثت تغيرات هامة في الوضع العالمي، و في البلدان المستعمرة تحديداً. فلقد انهار الاستعمار القديم، القائم على أساس الاحتلال العسكري، و بالتالي استنفدت حركات التحرر أغراضها (وإن كانت بعض المناطق، قد ظلت مستعمرة). لكن الأهم في هذا المجال، هو التغيّر الذي تحقّق داخل إطار النظام الإمبريالي، و أدى إلى تغيّر طبيعة السيطرة الإمبريالية التي قامت على أساس الربط الاقتصادي، أي ربط الأمم المتخلفة بالمركز الإمبريالي من خلال العلاقات الاقتصادية، و هو ما أسّس ما غدا يعرف بنظام التبعية. أهمية تحديد هذه المسألة نابعة من انعكاساتها على الأمم المتخلفة، حيث حظيت بالاستقلال السياسي، لكن على أساس تبعية اقتصادها للمركز الإمبريالي، مما حوّل الأنظمة السياسية «المستقلة» فيها إلى واجهات تخدم الاحتكارات العالمية. و نجحت هذه الصيغة من خلال تأسيس بنية اقتصادية اجتماعية مناسبة، تقوم على أساس ارتباط مصالح الطبقة المستغِلة ـ الحاكمة بالاحتكارات الإمبريالية، وبالتالي سعيها من أجل تطويع البنية الداخلية لمصلحتها، ولمصلحة تلك الاحتكارات، حتى الجيوش المحلية غدت تلعب دوراً في الدفاع عن مصلحة تلك الاحتكارات.
في هذا الوضع تجاوز النضال طابعه التحرري، حيث لم تَعُدْ مهمة النضال الثوري تصفية الاحتلال العسكري فقط، بل اتجه وجهة أخرى هي تصفية بنية طبقية سائدة، تعمل لأن يبقى الوطن موثق الرباط بالاحتكارات الإمبريالية، وبذلك غدا الاقتصاد هو ميدان المعركة، إنه جوهر الحرب.
إننا سوف نحارب أشباحاً إذا تجاهلنا هذه الحرب (المرفق بها أدوات خارجية محددة، كالكيان الصهيوني، والقواعد العسكرية الأمير كية..)، و بالتالي لم تعد الثورة هي ثورة التحرر الوطني ذات الطابع السياسي القائم على أساس الحرب ضد الاستعمار، بل غدت ثورة ديمقراطية تقوم على أساس تحقيق التطور الاقتصادي المستقل، أي التطور القائم على أساس «فك الارتباط بالسوق الرأسمالية العالمية "(24)، ولكن مع تصفية أدوات الإمبريالية المحلية، تصفية الجيوب الموجودة من أجل مواجهة خيار التطور الاقتصادي المستقل (من خلال مواجهة تطوير الاقتصاد من جهة، لكن أيضاً من خلال تكريس بنى سياسية متخلفة، تقف عائقاً أمام التطور المستقل ـ التجزئة، الإيديولوجية الرجعية، ...ـ). وفي هذا الإطار تتغير طبيعة الحرب، و يتبدل اصطفاف القوى الطبقية، و تصبح القيادة الطبقية مسألة حاسمة، رغم أن التجربة أوضحت أن حركات التحرر الوطني المنتصرة كانت بقيادة أحزاب شيوعية، أما التجارب الأخرى فقد حقّقت استقلالاً سياسياً سرعان مع تحوّل واجهة لتبعية الاقتصاد للاحتكارات الإمبريالية.
و الآن سوف نتجاوز العام ونتحدث في الخاص، إذن لنبحث وضع القضية الفلسطينية. كما أوضحنا سابقاً إبتسرت «الإيديولوجية الفلسطينية» القضية إلى اعتبار «إن الغزو الصهيوني يمثل في حقيقته احتلالاً في أقسى صورة، فقد استبدل شعبنا بشرذمة من شذّاذ الآفاق جاءوا من مختلف المجتمعات الإنسانية تجمعهم المصلحة في الاستيطان، و تقودهم حركة استعمارية عنصرية هي الحركة الصهيونية و تدعمهم الإمكانيات المالية و السياسية و الدعاوية لأكبر دول الاستعمار،أمريكا وبريطانيا، و تشترك في تثبيت وجودهم حفنة من المتآمرين الخونة من الحكام العرب إبان مرحلة النكبة»(25). لقد طغى الشكل الاستيطاني للاستعمار الصهيوني على جوهر الدور الذي يؤديه، و تقلصت القوى التي يواجهها إلى الفلسطينيين. و بذا غدت مرحلة التحرر الوطني هي السمة المميزة للنضال الفلسطيني. و لاشك أن قصور الرؤية الاستراتيجية يظهر واضحاً هنا، لان هذه النتيجة قامت على أساس من فصل الكيان الصهيوني عن الإمبريالية العالمية من جهة، وفصل الجماهير الفلسطينية عن الأمة العربية من جهة أخرى. لهذا جرى الحديث ـ كما يوضّح النصّ السابق ـ عن الدعم المالي و السياسي و الدعاوي من قبل الإمبريالية للكيان الصهيوني،كما جرى الحديث عن الغزو الصهيوني ضد «شعبنا الفلسطيني». لقد أدى هذا الابتسار إلى قولبة التصوّر النظري بما يناسب التصوّر القديم لحركات التحرر الوطني، الذي هزم في تجارب عديدة، أو نجح في تحقيق هدف محدود، ونقصد الاستقلال السياسي، لعل المثال العربي الأبرز في هذا المجال كان تجربة الجزائر، لكن ظروف الجزائر مختلفة عن ظروف فلسطين، رغم أن انتصار الثورة الجزائرية جاء في مرحلة أفول الاستعمار القديم، هذا الأفول الذي يسمح بتحقيق انتصارات سياسية، لكنها لم تصمد أمام زحف «الاستعمار الجديد»، القائم على أساس التبعية الاقتصادية.
إن خصوصية النضال الفلسطيني تكمن في أنه متشابك بكل بنية الوضع العربي، أنه قضيّة عربية، وهذا ما أوضحناه سابقاً. وما يهنا هنا هو التالي:
أـ تشابك العلاقة بين الكيان الصهيوني والإمبريالية العالمية. مما جعل الاحتلال الاستيطاني مرتبط بالاستعمار الجديد، إنه أداة من أدواته، و بالتالي تكون السمة الخاصة بالكيان الصهيوني هي المظهر الثانوي، بينما تطغى السمة العامة، سمة «نظام التبعية». و رغم أن للكيان الصهيوني إيديولوجيته المعبرة عن بنية (دون أن ننسى أن الايديولوجيا الصهيونية أسهمت في تأسيس هذا الكيان)، و بالتالي له تصوّراته وأهدافه التي قد «تتناقض» أحياناً مع الاستراتيجية الإمبريالية العامة، سيبدو هذا «التناقض» جزئياً و ثانوياً أمام عمق الارتباط القائم بينهما. و لهذا يبقى الكيان الصهيوني أداة من الأدوات الإمبريالية، و ربما الأداة الأكثر وثوقاً و قوة، ينفذ سياساتها أولاً. وهو لا يستطيع تجاوز ذلك لعجزه عن الاستقلال عن الإمبريالية، حيث أن طبيعته تفرض وجود قوى تموّله، لان رأس المال المتوفر لديه ينفق في الحرب، و بناء القاعدة الاستيطانية، مما يجعل «الناتج المحلي الإجمالي» و مساعدات الحركة الصهيونية عاجزان عن تحقيق «الاكتفاء الذاتي»، و هذه الواقعة تبرز الاستراتيجية الإمبريالية كاستراتيجية أساسية و الاستراتيجية الصهيونية كاستراتيجية ثانوية. و بالتالي يكون الصراع مع الكيان الصهيوني، هو مظهر من مظاهر الصراع مع الإمبريالية العالمية، و على رأسها الإمبريالية الأميركية. هنا نعود للصيغة العامة للنضال في العصر الراهن.
ب) من الجانب الآخر، إن احتلال فلسطين مظهر من مظاهر إشكالية الأمة العربية. لقد كان الوطن العربي محتلاً في مرحلة الاستعمار القديم (الإنجليزي ـ الفرنسي ـ الإيطالي)، ولقد عمل هذا الاحتلال على تجزئته، و إلى تكييف البنية الاقتصادية الاجتماعية وفق متطلبات الرأسمالية الأوروبية. لكنه تحرّر، لكن أعيد إنتاج بعض أشكال الاستعمار في عدد من المناطق منها عربستان، الاسكندرون، ثم فلسطين سنة 1948. والآن أعيد ربطه بالنظام الإمبريالي العالمي في صيغته الجديدة، ونقصد «نظام التبعية». إن تقدُّم الجماهير العربية مرتبط بثلاث قضايا، أولها إنهاء احتلال الأراضي العربية، التي لازالت محتلة، وثانيها تحقيق الوحدة القومية، وثالثها فك الارتباط الاقتصادي بالنظام الرأسمالي العالمي. وبالتالي فنحن هنا أمام تحقيق الثورة القومية الديمقراطية، ولسنا أمام ثورة تحرر وطني.
و لا شك أن الفرق كبير بين الصيغتين، لأن التأكيد على «الطابع التحرري» يستتبع جملة من التصوّرات الخاطئة. إن الفئات البرجوازية أو البرجوازية الصغيرة لا تفهم في المرحلة سوى أنها مرحلة تحرر وطني، لأنها تنطلق من مسألة «التنازع» على الأرض، دون أن تربط بين ذلك و بين السيطرة الإمبريالية العامة. إنها تبحث عن دور في ظل هذه السيطرة و ليس خارجها، و لهذا تشدّد على الاختلاف التكتيكي، لأنها تسعى من أجل تحقيق «الاستقلال» السياسي فقط، دون المساس بمسألة التبعية الاقتصادية. و هذه المعادلة تجعل إمكانيات المساومة محققة، لأن هذه الفئات تسعى للتفاهم مع الإمبريالية من أجل تحقيق أهدافها مادامت قرّرت البقاء ضمن إطار نظام التبعية، و لهذا تقبل بالعديد من السياسات التي تقرِّرها الإمبريالية. أما الفئات التي تسعى لأن تلعب دوراً «يسارياً» فقد حصرت نفسها في نفس الفهم، فقد سادت لديها التصوّرات التي كانت تتجاوز طبيعة العصر، و تتجاوز جوهر التصور اللينيني.
ندخل هنا في إشكالية أخرى، هي النتيجة الطبيعية لهذا التصور.
القيادة لمن؟
لا ننطلق هنا من تصوّر طفولي، بل ننطلق من طبيعة الظرف العالمي، وبالتالي من إمكانيات الطبقات المختلفة في تحقيق الانتصار. و إذا كانت الفئات البرجوازية أو البرجوازية الصغيرة تنطلق من بديهية قيادتها للنضال الفلسطيني، وتعتبر أن هذا هو الوضع الطبيعي، و بالتالي أسبغت لونها على هذا النضال. فإن القوى «اليسارية» طمحت، و برّرت، لكنها ظلت بعيدة عن أن تلعب دوراً قيادياً. لقد حلمت أن تكون القيادة، منذ أن أعلنت بعد حرب 1967 سقوط البرجوازية الصغيرة(26)، لكنها برّرت أسباب قيادة البرجوازية الصغيرة، و اعتبرت أن القيادة هي «معركة» السنوات التالية، مع مراعاة عدم طغيان التناقض الثانوي، و اعتبرت أن مهمتها الملحة هي بناء «حزب الطبقة العاملة»(27). لكن أوضحت الممارسة أن كل هذا لا يعدو أن يعبّر عن «رؤية نظرية»، أو «حلم» بعيد المنال، لأن الممارسة أوضحت مدى التمسك بقيادة ما غدا يسمى «اليمين الفلسطيني».
لاشك أن القيادة، قيادة النضال، ليست مطمحاً ذاتياً محضاً، بل أنها ترتبط بموازين القوى الواقعية. من هذا المنطلق يمكن إبداء ملاحظتين و هما: أولاً: أن انتصار الثورات ارتبط منذ تحوّل الرأسمالية إلى إمبريالية، بدور القوى الجذرية الممثلة للعمال والفلاحين الفقراء. و إذا كان لينين أوّل مَنْ شدد على ذلك فيما يتعلق بالثورة الروسية، حيث أكّد أن البرجوازية عاجزة عن تحقيق الثورة الديمقراطية برجوازية الطابع، و أن العمال هم المعنيون بتحقيقها(28)، فقد أكّدت التجربة العملية ذلك، ليس في البلدان الرأسمالية التابعة، بل وفي البلدان المستعمرة وشبه المستعمرة. و لهذا هُزمت التجارب التي قادتها البرجوازية أو البرجوازية الصغيرة، سواء هزيمة مباشرة أو من خلال الحصول على استقلال شكلي، أو بتحقيق انتصار محدود سرعان ما تلاشى. و بالتالي فإن قيادة البرجوازية الصغيرة للنضال سوف يقود إلى هزيمة، و لعل هذه النتيجة غدت بديهية في الوضع الفلسطيني. ثانياً: قد يبدو ما نقول الآن نزوعاً «ذاتياً»، لكن أوضحت التجربة أن مسألة القيادة غير مرتبطة بـ«وعي» الجماهير المحافظ، ـ و هذه أحد التبريرات التي تساق لتبرير عجز «اليسار» عن القيادة ـ بل بالدور العملي (الثوري) للقوى السياسية، النابع من وضوح برنامجها، و من ملامسته مصلحة الجماهير. و تجاوز ذلك هو الذي يجعل «اليسار» قيادة.
في كل الأحوال سوف يبقى النضال يدور في حلقة مفرغة مادامت القوى الجذرية غير قادة على لعب دور قيادي، و هذه كانت إشكالية من إشكاليات النضال الفلسطيني، و هي إشكالية النضال العربي كله.
العمل الثوري ـ حرب الشعب والكفاح المسلح:
مادامت الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى(29)، فإن إشكالية الرؤية الاستراتيجية وما تفرّع عنها من إشكالات أخرى، انعكست على أساليب النضال ـ و أساسها الكفاح المسلح، و حرب الشعب كطريق وحيد لتحرير فلسطين. لقد أعلنت المقاومة الفلسطينية سقوط الحرب النظامية التي تخوضها الأنظمة العربية، و أكدت أن «العمل الفدائي»، أو «الكفاح المسلح»، أو «حرب الشعب» هو البديل. و لقد أعطت هزيمة حزيران مصداقية معينة لهذا البديل، حيث هزمت الجيوش النظامية، بينما تقدّمت قوى «فدائية» للقتال في صيغة جديدة. لكن اختلفت الأمور بعد التجربة الطويلة من ممارسة «حرب الشعب»، وخصوصاً أن هذه الممارسة أظهرت إشكاليات جعلت إعادة النظر بالصيغة الجديدة هذه أمراً لا مفرّ منه، فقد جاءت معارك أيلول سنة 1970 في الأردن، لتؤكد أن شعار «حرب الشعب الفلسطينية» القائم على أساس مبدأ «كل البنادق نحو العدو الصهيوني»، هو شعار مهزوز، و لتلقي بعض الضوء على تناسق الأدوار بين الكيان الصهيوني والرجعية العربية، و لتشير أيضاً إلى أهمية «القاعدة الآمنة» من أجل حرب شعب حقيقية. ثم جاءت حرب تشرين لتظهر اختلال الصيغة الجديدة من أساسها، لأن «الحرب النظامية» عادت لتؤكد أهليتها من جديد، و لتوضّح الحجم الحقيقي لحرب الشعب الفلسطينية. كما جاءت «الحرب الأهلية» في لبنان لتعيد طرح الإشكالية التي طرحتها معارك أيلول 1970 في الأردن. لقد كانت هذه تجارب عملية أوضحت الاختلالات النظرية في نظرية «حرب الشعب الفلسطينية»، النابعة من «التصوّر النظري» الذي حاولنا التطرق إليه سابقاً.
هنا نجد الأثر المباشر لهذا التصور، حيث أن قصور الرؤية الاستراتيجية الذي فرض تقزيم القضية إلى قضية الفلسطينيين، و ضد الاستعمار الاستيطاني الصهيوني (المدعوم من قبل الولايات المتحدة، وهنا كلمة مدعوم تعني ثانوية الطرف الإمبريالي)، و بالتالي فرض الحديث عن مرحلة التحرر الوطني، فرض الانطلاق من الطريقة التقليدية لـ«حرب الشعب»، الطريقة أقل من الفيتنامية، أي الطريقة الجزائرية بالتحديد. و رغم أن هزيمة الكيان الصهيوني لا تتحقّق إلا بالحرب، فإن طبيعة هذه الحرب هي مجال نقدنا. لقد جاء تقزيم القضية بهذا الشكل ليجعل «حرب الشعب الفلسطينية" في مأزق، لأن حرب الشعب تحتاج إلى الشعب، و كانت الجماهير الفلسطينية تعيش أحدى حالتين، جزء يقع تحت الاحتلال و الآخر في الشتات. و كانت إشكالية العمل المسلح في الأرض المحتلة صعبة، لأن «الأقلية العربية» الواقعة تحت الاحتلال تواجه، ليس جيش احتلال فقط، بل قوّة استيطان مسلح تفوقها عدداً، إضافة إلى التفوق النوعي(30)، و بالتالي فإن كل ما يمكن أن تلعبه هو دور الإرباك لبنية العدو، و لم يكن ممكناً أن تتطوّر إلى أكثر من ذلك. و هذه الواقعة هي التي جعلت الجماهير الفلسطينية في المناطق المحتلة ترى في الدور الخارجي (الفلسطيني ـ العربي) المنقذ، و المحرر. و هذه إشكالية حقيقية لا تعطي للجماهير في المناطق المحتلة دوراً أكبر من ذلك، إنه دور «العمل خلف خطوط العدو». أما جماهير الشتات فقد تداخلت بالجماهير العربية، وأصبحت محكومة من الأنظمة التي تحكم البلدان التي تعيش فيها رغم تميُّزها، و بالتالي فإن دورها سوف يقوم في هذا الإطار، مما يجعلها تصطدم بسياسات هذه الأنظمة، و برؤيتها للصراع العربي الصهيوني. و لعل هذه هي خبرة معارك أيلول 1970 في الأردن، و«الحرب الأهلية» في لبنان. و إذا كانت المقاومة الفلسطينية قد أولت اهتمامها للشتات الفلسطيني (مع ملاحظة الاهتمام الجزئي لدى بعض المنظمات للداخل، ومع الإشارة إلى أن تجربة العمل المسلح في الداخل أوضحت المدى الممكن لها)، فقد انطلقت من رؤية عاجزة تقوم على أساس حيادية الواقع العربي، حيادية الأنظمة التي يجب أن تسمح للفلسطينيين بممارسة العمل المسلح، قافزة عن مصالح هذه الأنظمة، و سياساتها، و مخططاتها، و كون العمل المسلح ينطلق من أرضها (وهنا نشير إلى دول الطوق)، و حيادية الجماهير، فقد أقيمت القواعد العسكرية في «الغابات البشرية» العربية، لكن مع تجاهل كامل لمشاكلها، و لطبيعة دورها، حتى في الحرب ضد الكيان الصهيوني.
لقد تأسست «أيديولوجيا الكفاح المسلح» دون أن يكون لها أي أساس مادي، لقد أصبحت أسطورة بكل معنى الكلمة (السلبي) تكسّرت أمام إشكاليات الواقع. هنا يمكن أن نبدي ملاحظتين، الأولى: أن فصل الحرب ضد الكيان الصهيوني، عن الحرب ضد الإمبريالية وضد الأنظمة المستغلة ـ الحاكمة في الوطن العربي، ضخّم من «أيديولوجيا الكفاح المسلح» إلى الحد الذي دفع إلى تعميم الجزئي على الشمولي، تعميم شكل مواجهة الكيان الصهيوني على شكل مواجهة مظاهر التواجد الإمبريالي في الوطن العربي، و شكل مواجهة الفئات المستغِلة ـ الحاكمة، مع تجاهل كامل لمسألة أن الحرب ضد الكيان الصهيوني هي جزء من نضال أوسع هو نضال الجماهير العربية من أجل تحرُّرها، هذا النضال الذي يتخذ أساليب مختلفة، منها الحرب ضد الكيان الصهيوني. و رؤية هذه المسألة يجعل لطبيعة الحرب هذه معنى محدداً، فإذا كانت لا تلغي «العمل المسلح»، الذي سمَّي «حرب العصابات»، فإنها لا تلغي الحرب النظامية، رغم أنها تعطي معنى محدداً أيضاً للحرب النظامية. بمعنى أن تخوض القوى المعنية بالحرب ضد الكيان الصهيوني هذه الحرب، أي أنها حرب تخوضها قوى طبقية معينة، هي الجماهير الشعبية. هنا توضع «الحرب الشعبية» في إطارها الصحيح، فلا هي بديل النضال الجماهيري، و لا هي على النقيض من الحرب النظامية ذات الطابع الطبقي المحدد. و لعل ذلك هو حده الذي يمكن أن يعطي الإجابة على سؤالين مهمين، لم يكن ممكناً لحرب الشعب الفلسطينية الإجابة عليهما، وهما: كيف يمكن مواجهة الرد الصهيوني على الحرب العربية (حرب العصابات، أو حرب الشعب، أو الحرب النظامية) لأنه لا يجوز النظر للاستراتيجية الصهيونية نظرة ساكنة، لأن القيادة الصهيونية تستطيع تقرير الحرب أيضاً (و لقد قرّرتها في معظم الحالات) وفق مصالحها. ثم كيف يمكن أن تكون الأرض التي يتأسس عليها «العمل المسلح» أرضاً آمنة تسود فيها سلطة القوى المعينة بالحرب مع الكيان الصهيوني؟ الملاحظة الثانية: إن طرح «التحليل القديم» للتحرر الوطني، فرض سيادة الشكل القديم لحرب الشعب، الحرب التي تقوم على أساس «الصيغة العسكرتارية»، أي صيغة العمل العسكري الخالي من التنظيم والوعي، ووفق الطرق التقليدية (31).
الجانب الثاني: حول الطبيعة الطبقية لقيادة المقاومة
إن النظرة العامة التي حكمت قوى اليسار للطبيعة الطبقية لقيادة المقاومة نظرة كلاسيكية، حيث تتحوّل البرجوازية الصغيرة في ظروف ملائمة إلى برجوازية كبيرة (طفيلية أو كومبرادورية). وهذه نظرة لا تنطبق على الوضع الفلسطيني، وإن كانت فئات من القيادات العليا، ومن الكادر في المستويات الوسطى، قد تحوّل فعلاً بهذه الطريقة، بسبب تأسيس «أجهزة دولة» تسمح بالنهب، وباستغلال الموقع لتنمية المصالح الخاصة.
أما قيادة حركة فتح فلا يجوز النظر إليها بهذه الطريقة، رغم أن هناك من العوامل ما يساعد على تبني هذه النظرة، فهي فعلاً من أصول برجوازية صغيرة، ولقد طرحت مشروعاً وطنياً. رغم ذلك من الضروري أن ندقق في وضعها وبرنامجها. فهي فئات من البرجوازية الصغيرة لديها مطامح، درست لكي تُثري، ثم انتقلت إلى دول النفط مصدر الإثراء الجديد، فحصلت على مواقع تجعلها بمصاف الفئات الوسطى (مدراء الوزراء، والأمراء، وموظفين كبار في شركات النفط)، لكن الأهم من ذلك أنها كانت جزءً من حركة الأخوان المسلمين ، وبالتالي كانت تتبنى أيديولوجيتها ومفاهيمها السياسية. وهي من هذا المنطلق جاءت متصالحة مع الأنظمة الرجعية، داعمة القوى الدينية في مواجهة المد القومي، وهذا السبب هو الذي سمح لها لأن تتبوأ مراكز هامة في هذه الدول. وهي من خلال وجودها في الخليج تعرّفت على هموم البرجوازية الفلسطينية هناك (الكومبرادورية والطفيلية)، هموم الخوف والضعف بسبب غياب سلطة سياسية تدعمها (وملحقات ذلك، جواز السفر...). ولقد تبلور مشروعها إستناداً إلى كل ذلك، فهو من نقطة واحدة «الدولة»، هذه الدولة التي توفّر لها سنداً يحمي مصالحها ويقوّي مواقعها، ويحفظ وجودها.
لقد طرحت هذه القيادة برنامجاً يعبر عن مصلحة البرجوازية الفلسطينية في الخليج، على الضد من برنامج البرجوازية الفلسطينية في الأردن، التي اندمجت في بنية النظام الأردني وأصبحت جزءاً منه، ولهذا أيّدت المقاومة بعدما أصبحت قوة فقط، معتبرة نفسها جزء منها، أو متحالفة معها. وهنا لا نُنكر أن البرجوازية الصغيرة الفلسطينية تأثرت بدور البرجوازية الصغيرة العربية التي وصلت أقسام منها إلى السلطة، لكن الفرق في المشروع السياسي الذي يؤطِّر هذا التوجه، حيث كانت هذه القيادة أقرب إلى توجّه البرجوازية الفلسطينية منها إلى نشاط البرجوازية الصغيرة العفوي والذي يطرح قضية تحرير فلسطين كقضية جدّية لأن مصلحته الأساسية تقوم على العودة إليها.
ولكي تتوضّح الصورة أكثر، من الضروري فهم المشروع الذي يؤطّر هذا الهدف، حيث أن فصل الهدف عن المشروع سوف يقود إلى نتائج مضلله. إن تشرُّب هذه الفئات بأيديولوجيا الأخوان المسلمين من جهة، وتحالفها مع البرجوازية الفلسطينية من جهة أخرى، أوجد «ثوابت» أساسية لديها، فأولاً هي متحالفة مع الأنظمة والقوى الرجعية ( التقليدية ) لأن حركة الأخوان المسلمين تعبّر عن هذه القوى، ولأن البرجوازية الفلسطينية في الخليج متحالفة معها، وهي بذلك قد تبنّت الرؤية الرجعية للكيان الصهيوني والولايات المتحدة والوضع العربي، فقبلت التجزئة مادامت أساس وجود الأنظمة الرجعية، وأيضاً أساس مطالبها بدولة، وحين قبلت التجزئة قبلت المشروع الإمبريالي كله، بما فيه القبول بالوجود الصهيوني. وهذا يفسِّر كل سياساتها التي مورست خلال عشرين عاماً، سواء بتوطيد العلاقة مع الأنظمة الرجعية العربية، أو رفض طرح القضية الاجتماعية، أو التأكيد على الخصوصية الفلسطينية، وتوجيه أنظار الفلسطينيين بعيداً عن دور الأنظمة وسياساتها، أو قبول سياسة التسوية أو السعي للتفاهم مع الولايات المتحدة.
لكن أين موقع الدولة من كل ذلك؟
لقد طرحت قبل عام 1967 هدف إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهاجمت المنادين بتحرير فلسطين (وكان وقتها عبد الناصر) و طالبتهم بالسماح للفلسطينيين إقامة دولة على الأرض التي " يحتلونها "، ثم حددت ذلك بوضوح حيث طالبت بإقامة الدولة في الضفة وغزة (ورد ذلك في مجلة فلسطيننا، وفي كراس هيكل البناء الثوري، كما وضحها صلاح خلف في ـ فلسطين بلا هوية ـ ). أما بعد عام 1967 فقد غاب هذا الشعار، بل بالعكس هاجمت هذه القيادة الفئات التي طرحت شعار بناء الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية و غزّة، وهي فئات عميلة تعيش في الضفة الغربية، بينما طغى شعار تحرير فلسطين وقتها. وهو الشعار الذي إستُخدم لتوحيد فئات واسعة من الجماهير الفلسطينية حولها لكي تصبح هي " الممثل الشرعي والوحيد». فهل ألغى ذلك مشروع الدولة في الضفة وغزّة؟ لقد أظهرت الأيام أنها اتجهت صوب الأردن، حيث اقتنعت أن الأردن يمكن أن يكون دولة فلسطينية، لأن الدولة في الضفة وغزة سوف تكون ضعيفة ومحاصرة (وهو ما حاول تأكيده «خبراء» في الإحصاء السكاني مثل عصام سخنيني) ولقد طرحت هذه القيادة موضوع الدولة في الأردن على الولايات المتحدة ، وهو ما أوضحه هنري كيسنجر في مذكراته.
إن هذا المشروع ليس مشروع البرجوازية الصغيرة، و لا كان مشروعاً طارئاً ظهر عند انتكاس الثورة، إنه مشروع البرجوازية الفلسطينية الكمبرادورية والطفيلية. أما «مشروع» تحرير فلسطين فكان الغطاء، أي أن هذه القيادة عملت بمنطق الظاهر والباطن (المضمر)، ولقد كان المشروع الظاهر مشروع الجماهير الفلسطينية والعربية، أما المشروع المضمر (الباطن) فهو مشروع هذه القيادة ومن تمثله.
وهذه قضية هامة وليست قضية تكتيكية، لأن فهم جذر المشروع الفلسطيني يقود إلى فكفكة كل رموزه.
#سلامة_كيلة (هاشتاغ)



ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

|
حفظ
 |
بحث |
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
| إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
أزمة العقل الأحادي في تناول العلاقة بين الوطنية والديمقراطية
-
الحزب الشيوعي العراقي ومسألة الأولويات
-
من اجل تحالف القوى الماركسية في الوطن العربي
-
حزب الشعب الفلسطيني وتعزيز الهوية اليسارية
-
المساءلة حول المقاومة:بصدد حجج الليبراليين العرب الساذجة
-
ترقيع السلطة الفلسطينية
-
وحدة اليسار: حول اعادة صياغة اليسار الماركسي
-
من أجل المواجهة مع المشروع الامبريالي الصهيوني
-
الحرب على لبنان: الدور الصهيوني في الاستراتيجية الأميركية
-
وضع فلسطين بعد الحرب على لبنان
-
الصراع الطائفي يُفشل القتال مع الاحتلال الأميركي
-
إنتصار حماس ومآل الوضع الفلسطيني
-
توضيح -إعلان دمشق-
-
مأزق حزب الله
-
-فرق الموت- في العراق
-
الوطن والوطنية: بصدد المفاهيم
-
ملاحظات أخيرة على إعلان دمشق
-
أزمة - القطاع العام - في سوريا
-
ثورة أكتوبر، محاولة للتفكير
-
دعوة لتجاوز - إعلان دمشق -
المزيد.....
-
10 مارس المقبل، انتخابات مندوبي السلامة بالمناجم: من اجل دور
...
-
ليون: إصابة ناشط يميني متطرف بجروح خطيرة خلال زيارة للنائبة
...
-
من تجربة شغيلة سيكوم-سيكوميك نتعلم جميعا
-
انكسار أحلام الاستيطان في غزة: إحباط يضرب اليمين المتطرف وات
...
-
عاجل | الفرنسية: حريق بمصفاة نفط في العاصمة الكوبية هافانا
-
بيان تلقى المكتب الجهوي للنهج الديمقراطي العمالي بجهة أوروب
...
-
Can Europe Reassert Itself After Ukraine?
-
Working Time in Germany’s Service Sector – a Union View
-
First Gaza, Then the World: The Global Danger of Israeli Exc
...
-
How to Defeat MAGA Tyranny, Chapters 5 & 6: Timelines and Or
...
المزيد.....
-
النظرية الماركسية في الدولة
/ مراسلات أممية
-
البرنامج السياسي - 2026
/ الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي
-
هل الصين دولة امبريالية؟
/ علي هانسن
-
كراسات شيوعية (الصراع الطبقي والدورة الاقتصادية) [Manual no:
...
/ عبدالرؤوف بطيخ
-
موضوعات اللجنة المركزية المقدمة الى الموتمر 22 للحزب الشيوعي
...
/ الحزب الشيوعي اليوناني
-
الرأسمالية والاستبداد في فنزويلا مادورو
/ غابرييل هيتلاند
-
فنزويلا، استراتيجية الأمن القومي الأميركية، وأزمة الدولة الم
...
/ مايكل جون-هوبكنز
-
نظريّة و ممارسة التخطيط الماوي : دفاعا عن إشتراكيّة فعّالة و
...
/ شادي الشماوي
-
روزا لوكسمبورغ: حول الحرية والديمقراطية الطبقية
/ إلين آغرسكوف
-
بين قيم اليسار ومنهجية الرأسمالية، مقترحات لتجديد وتوحيد الي
...
/ رزكار عقراوي
المزيد.....
|
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

 |
بحث
|
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
|
إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة