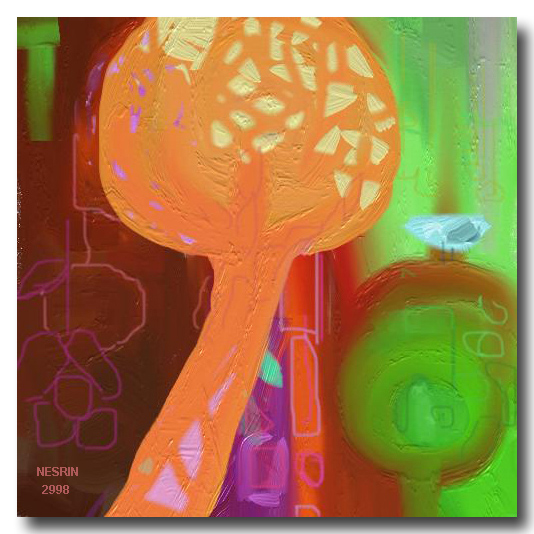ابراهيم طلبه سلكها


الحوار المتمدن-العدد: 8398 - 2025 / 7 / 9 - 18:06
المحور:
الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
أولا: التحليل فى الفلسفة
كلمة " تحليل " analysis هى كلمه يونانية, تعنى فك كل ماهو مركب إلى أجزائه، وتقابلها كلمة "تركيب" synthesis التى تعنى بناء "الكل" من الأجزاء(1)والتحليل قد يكون عقلياً أو تجريبياً، أو منطقياً أو استقصائياً، أو نفسياً، أو ترانسندنتالياً .. إلخ.
وإذا كان عالم الكيمياء مثلاً يقوم بتحليل مركباته المادية وردها إلى أبسط عناصرها, فإن الفيلسوف التحليلي يقوم أيضَا بهذه العملية التحليلية لكنه يقوم بها في مجال اللغة. والفيلسوف التحليلي لا ينظر إلي اللغة على أنها وسيلة, بل أيضاً على أنها هدف من أهداف البحث الفلسفى. فهو لايدرس اللغة من أجل وضع فروض علمية بشأنها, بل لاعتقاده بأن مثل هذه الدراسة لها قيمتها بالنسبة للفلسفة ذاتها. ومع أن الفلاسفه التحليليين يتفقون على أهمية البدء بدراسة اللغة, فإنهم يختلفون حول نوع اللغة التى يدرسونها, وينتمون في ذلك - بوجه عام- إلى فريقين: الأول : يرى أن التحليل الفلسفي للغة يجب أن يتجه إلى تأليف لغة إصطناعية جديدة بإعتبار أن قواعد مثل هذه اللغة أوضح وأدق من القواعد التى تحكم استعمال اللغة العادية, كما هو الحال في مجال العلم. فالفلسفة يجب أن تطور مفرداتها وتصطنع سلسلة من المفاهيم لحل مشكلاتها الأساسيه. أما الفريق الثانى : فيرى أن مثل هذه اللغات الإصطناعية لا تساعد كثيراً على حل المشكلات الفلسفية إذ أن هذه المشكلات يمكن حلها على أفضل وجه عن طريق التحليل الدقيق للغة العادية التى نستخدمها جميعاً في التواصل مع الأخرين(2)
والحق أن تصور الفلسفة على أنها، بوجه عام، عبارة عن "تحليل" Analysis يشكل أساساً رؤية معاصرة، مع أن جذور هذه الرؤية قديمة قدم الفلسفة ذاتها. ذلك أن جوهر أعمال جميع الفلاسفة، تقريباً، هو التحليل نفسه. فالتحليل منذ زينون الإيلى (430- 490 ق. م) مروراً بفلاسفة ميغارا philosophers of Megara وصولا إلى الرواقيين كان مألوفاً ومميزاً بخاصته المنطقية، وكان يهدف إلى توضيح المواقف المتقابلة ومفارقتها وأنماط التفكير غير المقبولة، فالفيلسوفان الإيليان "زينون" و"بارمنيدس" وأنصارهما اعتقدوا أن هذا التحليل السلبى يؤدى أحياناً إلى معرفة موثوق بها. ومن الملاحظ أن شهرة زينون تتعلق أساساً بتميزه فى إجراءات هذا التحليل فهو أول من أوضح – فى دراسته لفلسفة بارمنيدس الواحدية من خلال هجومه على التعدديين – أن المذهب التعددى أو مذهب الكثرة يؤدى إلى مفارقات أو تناقضات ذاتية(3).
وكان "التحليل" عند سقراط يهدف إلى توضيح المعانى الأخلاقية فى ضوء منهجه الديالكتيكى... فقد حاول سقراط فى جميع تساؤلاته أن يرد جميع الفضائلvirtues إلى فضيلة واحدة وصفها بفضيلة الحكمة wisdom أو المعرفة، معرفة الخير والشر. فبعد أن حصل فى محاوره "مينون" meno مجموعة الفضائل المقبولة بصفة عامة استطرد قائلاً: و"الآن خذ تلك الفضائل التى لا تبدو لنا معرفة وانظر فيما إذا لم تكن فى بعض الأحيان ضارة مثلما تكون نافعة. مثلاً افترض أن الشجاعة Courage ليست حكمة ولكنها نوع من التهور. أليس صحيحاً أن الإنسان يصيبه الضرر عندما يكون واثقاً من نفسه بلا مبرر والعكس صحيح؟ فعندما يمارس الإنسان كل هذه الصفات ثم ينظمها فى إطار مترابط منطقى تصير نافعة ومفيدة على عكس إذا ما خلت من الوعى والمنطق. باختصار، عندما تكون الحكمة هى المرشد فإن أفعال الروح تؤدى إلى السعادة، وعندما ترشدها الحماقة تؤدى العكس. وعلى هذا فإن كانت الفضيلة خصلة من خصال الروح، أو هى بطبيعتها نافعة ومفيدة فلابد وأن تكون حكمة. فالصفات الروحية جميعها فى ذاتها وبذاتها ليست نافعة أو ضارة، ولكن عندما يحكمها الغباء والحماقة تصير ضارة". وبهذا المعيار الذى دافع عنه سقراط يقف العقل كى يميز المنفعة الحقيقية والدائمة من المنفعة الزائفة التى تؤدى إلى لذة أو صواب مصطنع(4).
وهكذا كان سقراط مهتماً بالمعانى الأخلاقية، كما كان أفلاطون فيلسوفاً تحليلاً فى كثير مما تعرض له.. فإذا كانت قواعد التحليل ذاتها يجب أن تكون ميتافيزيقية فى طبيعتها، بمعنى أنه لابد أن تتضمن مناقشة العروض الفلسفية بواسطة إجراءات العقل العامة بدلاً من الاعتماد على مضامين خاصة فإن هذه الخاصية للتحليل نجدها بوضوح فى محاورات أفلاطون التى عبر فيها عن جميع مهاراته التحليلية لا سيما عرضه لنظرية المثل(5).
ونجد فى المرحلة الحديثة أن معظم الفلاسفة التجريبيين- على حد تعبير إير- كانوا تحليليين إذ أن معظم ما كتبه هؤلاء الفلاسفة يندرج تحت نظرية المعرفة، والمفروض فيها أن تحلل ضروب الإدراك المختلفة بما فى ذلك المعرفة ذاتها والخيال والاعتقاد والتمييز بين مختلف الألوان... فالفيلسوف لوك كان تحليليا لأنه كما يتضح من كتابه "مقال فى الفهم الإنسانى" لا يثبت صحة قضايا تجريبية بعينها أو ينفيها بل نجده يركز فقط على تحليلها. وكذلك "باركلى" لم ينكر- فى الواقع- الأشياء المادية كما هو شائع عنه. وإن ما أنكره فعلاً هو تحليل "لوك" لمثل هذه الأشياء. فقد جعل "لوك" أفكار الإحساس Ideas of sensation التى نتلقاها بحواسنا من شىء ما مرتبطة بعنصر معين، أى أن للشىء جوهراً مركزياً تلتف حوله صفاته. غير أن باركلى لم يوافق على هذا التحليل، وجعل صفات الشىء لاتلتف حول عنصر أو جوهر بل يرتبط بعضها ببعض فحسب. بحيث لايكون الشىء عنده إلا مجموعة إحساساتنا به، متصلاً بعضها ببعض فحسب على صورة ما. وكان الخطأ الذى وقع فيه "باركلى" حين تصدى لنقد "لوك" هو أنه استثنى النفس إذ جعلها عنصراً قائماً بذاته. ولهذا نهض "هيوم" ليدفع نقد "باركلى" إلى نتائجه المنطقية حتى النهاية، وإذن فالنفس أيضاً إن هى إلا حالات مجزأة متتابعة متصل بعضها ببعض على صورة ما دون أن يكون هناك عنصر جوهرى مركزى تتعلق به تلك الحالات. حتى فكرة السببية التى كثيراً ما يقال عن "هيوم" أنه أنكرها لم تكن فقط موضع إنكار لأنه فيلسوف يحلل العبارات والمدركات لا يثبت شيئاً، أو ينكر شيئاً، إنه اقتصر فى فكرة السببية على تحديدها وتعريفها... إلخ(6).
كما أن "هوبز" و"بنتام" و"جون ستيوارت مل" فلاسفة تحليل فإذا تأملنا أعمال "هوبز" و"بنتام" نجد أنهما قد انشغلا بتقديم تعريفات للقضايا، وأن أعظم بعد من أبعاد فلسفة "مل" هو تطويره للتحليل عند "هيوم". وبذلك يرى اير أن مهمة التفلسف أساساً مهمة تحليلية وأن هذه المهمة نجدها متحققة بوضوح فى الفلسفة التجريبية الإنجليزية. ولكن ليس معنى ذلك أن ممارسة التحليل الفلسفى تقتصر على أعضاء هذه المدرسة الفلسفية وإنما ترتبط بهم تاريخياً بشكل قوى(7).
وهكذا يؤكد إير أنه لا جديد فى القول بأن توضيح الأفكار من أهداف الفلاسفة لأنه قول يمتد على الأقل إلى سقراط الذى كان مشغولاً أساساً بأسئلة معينة مثل ما العدل، وما المعرفة؟. ونجد ذلك عند "هيوم" فى تقسيمه كل أنواع الدراسة المشروعة إلى علم مجرد موضوعه الكم والعدد، وأبحاث فى أمور الواقع والوجود تعتمد أساساً على الخبرة، وهجومه على الميتافيزيقا المدرسية والذى نتج عنه حصر الفلاسفة فى التحليل. وقد أعلن فتجنشتين فى العشرينيات من هذا القرن أن الفلسفة ليست مجموعة نظريات لكنها نشاط يهدف إلى توضيح الأفكار ولقد تبنى الوضعيون المناطقة موقف فتجنشتين والفروض التى اعتمد عليها "هيوم" فى صورة ما سماه الوضعيون "مبدأ التحقق" الذى صاغه مورتس شليك بقوله "إن معنى قضية ما يقوم فى منهج تحقيقها"(8).
ولكن مع أن التحليل كان شائعاً فى الفلسفة منذ قديم، فإن أنصار الفلسفة التحليلية المعاصرة يتفردون بما يميزهم عن أسلافهم. وإنهم يتميزون بحذفهم للميتافيزيقا من قائمة الكلام المقبول، فهم يحذفون الميتافيزيقا حذفاً تاماً على أساس تحليلاتهم المنطقية للعبارات اللغوية، ثم يتميزون كذلك بتفرقتهم بين قضايا المنطق والرياضة من جهة وقضايا العلوم الطبيعية من جهة أخرى، على حين كان المحللون السابقون يفسرون هذه بما يفسرون تلك كما فعل هيوم نفسه أو يفسرون تلك بما يفسرون هذه كما فعل "مل" حين رد القضايا الرياضية إلى أصول حسية، وفى كلتا الحالتين يكون إشكال، ففى الحالة الأولى ينتهى الأمر بالتشكك فى العلوم الطبيعية ما دامت لا توصل إلى يقين فى الرياضة، وفى الحالة الثانية ينتهى الأمر بجعل قضايا الرياضة احتمالية لا يقينية(9).
ثانيا : التحول اللغوى
تمتاز الفلسفة التحليلية بجملة من الخصائص تميزها عن المدارس الفلسفية الأخرى فى الفلسفة المعاصرة ومنها :
1- فكرة مركزية اللغة بالنسبة للفلسفة ، إذ يعتقد الفلاسفة التحليليون أن قضايا الفلسفة يمكن فهمها جيداً عن طريق العناية باللغة . وهذا الاتجاه نحو الاهتمام باللغة أصبح يسمى فى العرف الفلسفى " التحول اللغوى "وهو أصدق ما توصف به الفلسفة التحليلية وتعرف فى كلمتين .
2- الاعتماد على المنهج التحليلى سواء اتخذ هذا المنهج صورة التحليل المنطقى أو التحليل اللغوى .
3- احترام نتائج العلم والحقائق التى يسلم بها الحس المشترك ، وأخذها بعين الاعتبار عند معالجة المشكلات الفلسفية (10)
ولقد نسب الفيلسوف مايكل داميت Michael Dummett الصيغة الكلاسيكية " التحول اللغوى "إلى فريجه ، مؤسس المنطق الرياضى الحديث ، حيث قال : "إن موضوع بحث الفلسفة لم يحدد بصفة نهائية إلا مع فريجه ، بحيث تبين (1) أن هدف الفلسفة قائم فى تحليل بنية الفكر ، (2) وأن دراسة الفكر ينبغى أن تتميز عن دراسة عمليات التفكير النفسية،(3) وأن المنهج الكفؤ لتحليل الفكر يستند إلى تحليل اللغة"(11).
وهذا ما أكده أنتونى كينى Anthony Kenny فى كتابه "فريجه "بقوله : " .. إذا كانت الفلسفة التحليلية قد ولدت عندما حدث التحول اللغوى ، فإن ولادتها لابد من أن تؤرخ بنشر كتاب فريجه "أسس الحساب "عام 1984 عندما قرر أن الطريق إلى بحث طبيعة العدد هو تحليل الجمل التى تظهر فيها الأعداد " (12).
كما أكد داميت فى موضع آخر دور فتجنشتين المهم فى هذا الشأن فقال : ".. إذا جعلنا من التحول اللغوى نقطة إنطلاق الفلسفة التحليلية ، فإننا ، على الرغم من تقديرنا لأعمال فريجه ، ومور ورسل التى هيأت الأجواء ، لن نستطيع أن نشك فى أن الخطوة الرئيسية نحو هذا التحول خطاها فتجنشتين فى كتابه "رسالة فلسفية منطقية " (13). فقد رأى أن العمل الفلسفى هو فى جوهره توضيحات ، حيث قال : "إن موضوع الفلسفة هو التوضيح المنطقى للأفكار ، فالفلسفة ليست نظرية بل هى فاعلية . ولذلك يتكون العمل الفلسفى أساساً من توضيحات لا تكون نتيجة الفلسفة عدداً من القضايا الفلسفية إنما هى توضيح للقضايا . فالفلسفة يجب أن تعمل على توضيح الأفكار وتحديدها بكل دقة وإلا ظلت تلك الأفكار معتمة مبهمة إذا جاز لنا هذا الوصف " (14).
ولقد رأى فتجنشتين أن العمل الفلسفى هو فى جوهره توضيحات وقال: أن موضوع الفلسفة هو التوضيح المنطقى للأفكار، فالفلسفة ليست نظرية بل هى فاعلية. ولذلك يتكون العمل الفلسفى أساساً من توضيحات لاتكون نتيجة الفلسفة عدداً من القضايا الفلسفية إنما هى توضيح للقضايا. فالفلسفة يجب أن تعمل على توضيح الأفكار وتحديدها بكل دقة وإلا ظلت تلك الأفكار معتمة مبهمة إذا جاز لنا هذا الوصف(15).
وقد يكون الفيلسوف إير هو أول من لفت الانتباه إلى "التحول اللغوى "، فهو يقول: " إن الفيلسوف من حيث إنه محلل ليس معنياً بالخصائص الفيزيائية التى تتميز بها الأشياء . هدف الفيلسوف هو أن ينظر فى الكيفية التى نتحدث بها عن الأشياء " . أو بعبارة أخرى : "إن قضايا الفلسفة ليست قضايا واقعية ، بل هى فى طبيعتها قضايا لغوية . فهى لا تصف سلوك الأشياء المادية ، ولا حتى الأشياء العقلية ، بل تقتصر على التعبير عن التعريفات أو النتائج الصورية التى تترتب على التعريفات . وكنتيجة لذلك تكون الفلسفة علامة بارزة من علامات البحث المنطقى الخالص " (16).
يؤكد إير ضرورة أن ينحصر دور الفلسفة فى التحليل فيقول: "إذا أراد الفيلسوف أن يثبت صدق ما يزعمه من أنه شريك فى زيارة المعرفة الإنسانية فلا يجوز له أن يحاول وصف الحقائق عن طريق التأمل الخالص، أو أن يبحث عن المبادئ الأولى، أو أن يصدر أحكاماً قبلية عن صحة ما نعتقد فى صدقه على أساس التجربة، بل ينبغى له أن يحصر مجهوده فى التوضيح والتحليل"(17).
إن الفلسفة المعاصرة – بوجه عام- تتخذ من "التحليل" منهجاً وموقفاً ثابتاً فى دراستها للعديد من المشكلات وهى تركز أساساً على "تحليل" الألفاظ والقضايا التى يستخدمها العلماء فى أبحاثهم العلمية واللغة العادية التى يتعامل بها الناس فى حياتهم اليومية. ولذا فإنها تتخذ موقفاً عدائياً من الفلسفة المثالية وتتعصب ضد الميتافيزيقا وتنحاز مع العلم. وهذا ما عبر عنه مور فى مقالته "تفنيد المثالية" the refutation of idealism الذى استهدف فيها دحض مبدأ "الوجود إدراك" باعتباره ضرورياً لكل مثالية، وأيضاً فى مقالته "دفاع عن الحس المشترك". كما دافع راسل وفتجنشتين وفلاسفة الوضعية المنطقية عن هذا المعنى فى مواقفهم التحليلية المختلفة.
أكد مور ضرورة "تحليل" "لغة" "الحس المشترك" لتوضيحها وإبراز عناصرها، وكذلك تحديد معانى المفاهيم الأخلاقية. بل ورأى أن عدم الاهتمام الجاد بالتحليل هو السبب المباشر فى وجود مشكلات فلسفية.. وفى ذلك نجده يقول: "يبدو لى فى علم الأخلاق كما فى كل الدراسات الفلسفية الأخرى أن الصعوبات والخلافات التى يكتظ بها تاريخها إنما ترجع أساساً إلى سبب بسيط جداً هو: أننا نحاول الإجابة عن أسئلة لم نتبين على وجه الدقة معناها أوبدون أن نتبين أى سؤال هو الذى نريد الإجابة عنه. وأنا لا أعرف المدى الذى قد يصل إليه الفلاسفة باستبعادهم مصدر هذا الخطأ Error إذا ما حاولوا أن يكشفوا عن السؤال الذى يسألونه قبل أن يشرعوا فى الإجابة عنه، إذ أن القيام بالتحليل والتمييز عمل بالغ الصعوبة غير أننى أميل إلى الظن أن المحاولة الجادة القائمة على العزم والتصميم تكفى لتحقيق أو ضمان النجاح، وأن كثيراً من أصعب المشكلات وأشدها إثارة للخلافات Disagreements فى الفلسفة سوف تزول لو أننا قمنا فعلاً بمثل هذه المحاولات الجادة، ولكن يبدو أن الفلاسفة بصفة عامة لايقومون فى أغلب الأحوال بمثل هذه المحاولة الجادة، بل هم يحاولون دائماً أن يبرهنوا على أن الإجابة "بنعم أو لا" هى الإجابة الصحيحة عنها، وذلك لأنهم لا يضعون أمام أذهانهم سؤالاً واحداً بعينه بل عدة أسئلة تكون الإجابة عن بعضها بالنفى وعن بعضها بالإيجاب"(18)
ويعترف مور بأن "التحليل" هو من أهم وظائف الفلسفة وأنه يجب أن ينصب على المفاهيم. ولذلك نجده فى رده على الآراء التى عبر عنها لانج فوردLangfrd فى مقالته "فكرة التحليل فى فلسفة مور" يعلن عن خطأ لانج فورد فى افتراضه أن "التحليل الفلسفى" يرتكز مباشرة على التعبيرات اللفظية Verbal Expressions. وبين فى استخدامه لكلمة "التحليل" أنه لا يركز على تحليل التعبيرات اللفظية بل تحليل المفاهيم Concepts أو القضايا propositions. ولعل سبب رفض مور الاهتمام بتحليل التعبيرات اللفظية هو افتراضه أن مثل هذا التحليل سوف يكون نمطياً خالصاً. وعندما يتناول مور تحليل المفاهيم أو القضايا نجد تحليله لا يزيد عن كونه منصباً على ما تعنيه التعبيرات اللفظية.. ولهذا نجده يضع خمسة شروط لتحليل (المفهوم) يجب توافرها ليكون مقبولاً: الأول، لا أحد يمكنه أن يعرف أن موضوع التحليل Analysandum ينطبق على شىء بدون أن يعرف أن عناصر التحليل Analysans تنطبق عليه. الثانى، لا أحد يستطيع أن يثبت أن موضوع التحليل ينطب قعلى شىء بدون أن يثبت أن عناصر التحليل يتم تطبيقها عليه. الثالث، أى تعبير يعبر عن موضوع التلحيل يجب أن يكون مترادفاً مع التعبير الذى يعبر عن عناصر التحليل. الرابع، التعبير المستخدم لعناصر التحليل يجب أن يذكر بوضوح المفاهيم التى لم تذكر بوضوح بواسطة التعبير المستخدم لموضوع التحليل. أخيراً، التعبير المستخدم لعناصر التحليل يجب أن يذكر الطريقة التى ترتبط بها المفاهيم التى يذكرها موضوع التحليل(19). كما يؤكد مور أن الاهتمام الحاد بالحس المشترك واللغة العادية هو مفتاح حل المشكلات الفلسفية وتوضيحها(20).
وطبق رسل كذلك "منهج التحليل" على كثير من المشكلات الفلسفية. وقد استخدمه فى تحليل الموضوعات المادية إلى المعطيات الحسية أو "الأحداث" حيث كان يهدف رد الموضوعات المستدل عليها إلى عناصرها البسيطة التى نكون على ثقة منها بحيث نستغنى عن افتراض تلك الكائنات، ونكتفى بتقرير هذه العناصر، ما دامت تحقق جميع الأغراض التى تحققها تلك الكائنات المفترضة. كما طبقه أيضاً فى تحليل العقل حيث رده إلى مجموعة المظاهر، وهى الأحداث الذهنية بحيث لم تعد هناك ضرورة لافتراضه ككائن(21).
ولهذا يرى اير أن فلسفة التحليل المعاصرة تعد ثور فى تاريخ الفكر الفلسفى(22).
و" التحول اللغوى " Linguistic Turn هو التحول نحو اللغة واتخاذها موضوعاً للفلسفة ؛ وهذا التحول لم يأخذ صيغة واحدة ، كما يصوره أنصار الفلسفة التحليلية ، وإنما يأخذ فى الحقيقة صوراً متعددة . وأصبحت عبارة " التحول اللغوى " أكثر انتشاراً عندما استعملها رورتى عنواناً للكتاب الجماعى الذى أشرف عليه وكتب له مقدمة نشرت عام 1967 . وهذا الكتاب عبارة عن مجموعة من المقالات أغلبها لفلاسفة مناطقة وتحليليين ، ومنها : "مستقبل الفلسفة " لـ (مورتس شليك)، " التجريبية ، السيمانطيقا ، والأنطولوجيا " لـ)رودلف كارناب)، " الوضعية المنطقية ، اللغة ، وإعادة بناء الميتافيزيقا " لـ ( كوستاف برجمان ) ، "التعبيرات النسقية الخاطئة " لـ ( جيلبرت رايل ) و " معضلة فلسفية " لـ ( جون وزدم ) و " التقدم السيمانطيقى " لـ ( ويلارد كواين) و " الاكتشافات الفلسفية " لـ ( ر.م. هير) و " أرامسون ودارنوك " لـ ( جون أوستن ) ، " مدخل إلى اللغة : الكلمات والمفاهيم " لـ ( ستيوارت هامبشير ) ، " تاريخ التحليل الفلسفى " لـ (أرامسون ) و " التحليل ، العلم ، والميتافيزيقا " لـ (بيتر ستروسون) .. الخ .
يقول رورتى فى مقدمة كتابه " التحول اللغوى " : " إن الهدف الذى يصبو إليه هذا الكتاب يتصل بتقديم معطيات تمكن من التفكير فى الثورة الفلسفية التى حدثت فى السنوات القليلة الماضية ، أى فى الفلسفة اللغوية. وأعنى " بالفلسفة اللغوية " هنا " تلك الرؤية التى تقضى بأن المشكلات الفلسفية يمكن حلها سواء بإصلاح اللغة ، أو بالمزيد من الفهم الذى يمكن أن نصل إليه حول اللغة التى نحن بصدد استعمالها " (23) . وهو يعرف "التحول اللغوى " بأنه ذلك " التحول الذى اتخذه الفلاسفة فى اللحظة التى هجروا فيها الخبرة بوصفها موضوعاً فلسفياً وتبنوا موضوع اللغة وبدأوا فى السير خلف خطى فريجه بدلاً من لوك " (24).
وأكد رورتى هذا المعنى فى موضع آخر فقال : " لقد اتخذت صورة الفلسفة القديمة والوسيطة " الأشياء " Things منطلقاً لها ، واتخذت الفلسفة فى القرون من السابع عشر إلى التاسع عشر " الأفكار " Ideas منطلقاً لها ، ويتم توضيح الساحة الفلسفية المعاصرة بواسطة " الكلمات " Words (25). وأضاف رورتى أن النظام المعرفى المسمى حالياً " فلسفة اللغة " له مصدران أساسيان :
المصدر الأول : جملة المشكلات التى عالجها فريجه وناقشها ، على سبيل المثال ، فتجنشتين فى "الرسالة" ، وكارناب فى "المعنى والضرورة " . وهى مشكلات بخصوص معرفة كيفية تنظيم أفكارنا عن المعنى والإشارة بطريقة تمكننا من الإفادة من المنطق الكمى ، والحفاظ على حدوسنا عن منطق الجهة ، وبصفة عامة ، تقديم صورة واضحة ومرضية حدسياً تتشكل من مفاهيم " الحقيقة " ، و"المعنى" ، و" الضرورة " و" الإسم " . ويسمى رورتى هذه الفئة من المشكلات " موضوع فلسفة اللغة الخالصة " ، وهى نظام ليس له شكل معرفى ولا حتى أى علاقة مع معظم الاهتمامات التقليدية للفلسفة الحديثة .
المصدر الثانى : هو المصدر المعرفى ، ويتمثل فى محاولة استعادة صورة الفلسفة الكانطية كإطار تاريخى دائم للبحث فى شكل "نظرية المعرفة " . فقد بدأ " التحول اللغوى " كمحاولة لتقديم نزعة تجريبية غير نفسية عن طريق إعادة صياغة الأسئلة الفلسفية بخصوص المنطق . ولقد جرى الاعتقاد بأنه من الممكن الأن ، تقديم المذاهب التجريبية والفينومينولوجية ليس بوصفها تعميمات تجريبية – نفسية ولكن كنتائج " للتحليل المنطقى للغة " . وبوجه عام ، إن الفعاليات الفلسفية حول طبيعة المعرفة الإنسانية ومجالها ( على سبيل المثال ما قدمه كانط من مزاعم معرفية حول " الإله " و " الحرية " و " الأخلاق") يجب أن تقدم من جديد فى شكل ملاحظات أو تعليقات حول اللغة (26).
ويرى رورتى أن " الفلسفة التحليلية " بوصفها صورة من التجريبية قد انطلقت فى عصرنا من أعمال رسل وكارناب – الخ- وأن الفيلسوف إير هو الذى استوعب هذه الأعمال وقام بنشرها وتفسيرها خاصة فى كتابه " اللغة والصدق والمنطق " (1936) . حيث قدم من خلاله جملة من الأفكار التى تشكل ما يسمى فى عصرنا " الوضعية المنطقية " أو " التجريبية المنطقية " وهى الأفكار نفسها التى أعادت الابستمولوجيا التأسيسية للتجريبية البريطانية إلى مجراها اللغوى بدلاً من النفسى . وهذه الأفكار تختلف بشكل كبير عن الأفكار التى تشكل الأساس لما يسمى ، أحياناً ، " فلسفة تحليلية ما بعد الوضعية " – وهى فرع من الفلسفة يقال عنه أنه " أبعد من " أو " تجاوز " للتجريبية والعقلانية (27).
ويقول رورتى : " إن التحول الذى حدث داخل الفلسفة التحليلية منذ بداياتها فى حدود 1950 م ، إلى غاية اكتمالها فى سنة 1970م ، من الصعب رصده بيسر وتحديده بدقة ، فهو يرجع إلى تفاعل معقد لقوى كثيرة صاحبت الفلسفة التحليلية . لكن مع هذه الصعوبة هناك ثلاثة أعمال رئيسية ساهمت فى مسار الفلسفة التحليلية وهى : "معتقدان للتجريبية " لـ ( ويلارد فان أورمان كواين) و " بحوث فلسفية " لـ ( لودفيج فتجنشتين ) و" التجريبية وفلسفة العقل" لـ ( وليفرد سيلرز) (28)
ومقال سيلرز ، من بين تلك الأعمال الثلاثة ، والذى يتصف بالتعقد والثراء ، هو أقلها شهرة ومناقشة . فقد أكد مؤرخوا الفلسفة الأنجلوأمريكية أهمية مقال كواين فى إثارة الشكوك حول فكرة " الصدق التحليلى " وكذلك حول فكرة رسل وكارناب القائلة " بأن الموضوع الرئيسى للفلسفة يجب أن يكون " التحليل المنطقى للغة ". كما عملوا على إبراز قيمة مقال فتجنشتين ودوره فى هدم كثيراً من مشكلات الفلسفة التقليدية . ومع هذا ، فإنهم لم يسلطوا الضوء بشكل كاف لتقدير دور سيلرز فى هذا المجال. وسيلرز (1912 -1982) بأعماله العديدة ورؤيته الموسوعية والعميقة بتاريخ الفلسفة قد تميز عن كثير من فلاسفة التحليل وعلى رأسهم كواين وفتجنشتين؛ فهو يقول : " إن الفلسفة من دون تاريخ الفلسفة، إن لم تكن عمياء ، فإنها على الأقل تكون خرصاء "(29).
والحقيقة أن محاولة رورتى للجمع بين " التجريبية " و "العقلانية" تعتمد أساساً على أفكار سيلرز وخاصة فى كتابه "التجريبية وفلسفة العقل " . وهو الكتاب الذى أشاد به رورتى واعتبره من أكثر الأعمال جاذبية فى عصرنا ، ولا يمكن التعرف على مشروع سيلرز الفلسفى من دونه . والفكرة الرئيسية فى هذا الكتاب هى قول كانط : " الحدوس من دون مفاهيم تكون عمياء " . فوجود انطباع حسى ، هو فى حد ذاته ليس مثالاً للمعرفة ولا للخبرة الواعية . سيلرز ، مثل فتجنشتين المتأخر ، وعكس كانط ، رأى أن وجود "مفهوم " يعنى " التمكن من استعمال كلمة " . ولذلك فهو يقول : " إن كل وعى بالأنواع ، وبالتماثلات ، وبالوقائع .. الخ ، أى باختصار ، كل وعى بالكيانات المجردة – بل حتى كل وعى بالجزئيات هو " عمل لغوى" . ومذهبه الذى سماه " النزعة الاسمية السيكولوجية" Psychological Nominalism يوضح – كما يرى رورتى – أن لوك ، وباركلى ، وهيوم كانوا مخطئين فى اعتقادهم أننا " ندرك أنواع محددة .. وذلك ببساطة بفضل وجود أحاسيس وصور(30).
و" النزعة الأسمية السيكولوجية " عند سيلرز مبنية على أسلوب فتجنشتين فى كتابه "بحوث فلسفية " ، والذى أكد ارتباط المعرفة بالممارسة الاجتماعية .. وتؤدى إلى تضييق الخلاف ، بل والجمع بين توجهات " العقلانيين " و " التجريبيين " (31).وذلك من خلال توسط اللغة ومعالجة المشكلات الفلسفية بالرجوع إليها .. يقول سيلرز : " إن التحكم فى اللغة هو الشرط الضرورى لكل خبرة واعية " (32).
ويقسم رورتى فلاسفة العقل واللغة إلى قسمين : فلاسفة ذريين Atomists وفلاسفة كليين Holists ؛ وهؤلاء جميعاً يرون أن أهم ما يميز الإنسان عن غيره من المخلوقات هو العقل واللغة . وقد زادت حدة الخلاف بين الفريقين منذ نشر كتاب " مفهوم العقل " لـ " رايل " ، و " بحوث فلسفية " لـ " فتجنشتين " ، و " التجريبية ومفهوم العقل " و " معتقدان للتجريبية " لـ " كواين " . فقد شك فتجنشتين فى منطلق النظرية النسقية للمعنى ، وسخر كواين من القول " بوجود كيانات تسمى (معانى) مرتبطة بالتعبيرات اللغوية" ، وشك رايل فى تصورات علم النفس التجريبى ، وسار سيلرز على نهج فتجنشتين بقوله إن ما يميز البشر هو قدرتهم على التخاطب مع بعضهم البعض ، وليس امتلاكهم حالات عقلية داخلية متماثلة بشكل ما مع حالات بيئتهم (33).
وبعد أن تربى رورتى فى أحضان الفلسفة التحليلية ، وتمرس على آلياتها سرعان ما تمرد عليها وانتقدها بعدما اكتشف إخفاقاتها المتنوعة .
ثالثا : التحليل وسياق الحال
العبارة الإنجليزية context of situation تترجم عادة في فكرنا العربي إلى "سياق الحال" و"مقتضى الحال" و"المجاريات" وكلها بمعنى واحد. و"سياق الحال" هو نقطة ارتكاز نظرية فيرث اللغوية. ولذلك يقول جيفري إلليس Jeffry Ellis: (إن "سياق الحال" يعد من أهم إسهامات فيرث في مجال دراسة "النظرية اللغوية")(34).
وبدأ فيرث عرضه لتصوره عن "سياق الحال" بالإشارة إلى أن الإنثروبولوجي الشهير مالينوفسكي Malinowski هو أول من استخدم عبارة "سياق الحال" بشكل كبير في الفكر الإنجليزي. و"سياق الحال" عنده هو قمة العمليات الاجتماعية التي يمكن أن تكون مستقلة، والحدث الكلامي هو مركزها.. فهو سلسلة من الأحداث في قلب الواقع الاجتماعي(35). وفى حديث مالينوفسكى عن سياق الحال أوجد مايسمى " بالتجامل" وذهب الى " أن كثيرا ما نتكلم به لايقصد به أساسا التفاهم ، أو تقديم المعلومات ، أو اصدار الأوامر ، أو التعبير عن الآمال والرغبات واثارة العواطف ، وانما يستعمل لخلق شور بالتفاهم الاجتماعى والمعاملة . وكثير من العبارات المعدة أصلا –مثل- How do you do – المحددة اجتماعيا قد تخدم هذا الغرض أى : التجامل. (36)
ووصل مالينوفسكي إلى أن اللغة ليست كما يرى التعريف التقليدي وسيلة من وسائل توصيل الأفكار والانفعالات أو التعبير عنها، أو نقلها.. فمثل هذا لا يعدو أن يكون وظيفة واحدة من وظائف اللغة، ورأى أن اللغة كما يمارسها المتكلمون في أي جماعة من الجماعات إنما هي نوع من السلوك، ضرب من العمل، إنها تؤدى وظائف كثيرة غير التوصيل(37).
وقدم مالينوفسكي الخطوط العامة لفكرة "سياق الحال" التي نالت إعجاب فيرث، حتى إنه كتب مقالاً يتحدث فيه عن التحليل الإثنجرافي في اللغة مع الإشارة إلى آراء مالينوفسكي. وأشار فيرث إلى أن أهم إضافة قدمها مالينوفسكي تذكر فيما يلي:
1- تقديمه نظرية عامة، وبخاصة استعماله تصورات "سياق الحال" وأنماط الوظائف الكلامية.
2- تقريره أن معنى "اللفظة" يتحدد بالإشارة على السياق الثقافي.
3- بحثه قضية المعنى والترجمة.
4- بحثه صلة اللغة بالثقافة، وصلة علم اللغة بالأنثروبولوجيا(38).
لقد اعتقد مالينوفسكي أن رؤية اللغة كوسيلة لنقل الأفكار من رأس المتكلم إلى رأس السامع ليست سوى خرافة مضللة. فالتكلم، لاسيما في الثقافات البدائية ليس "قولاً" بل "عملاً". فاللغة "باستعمالاتها البدائية حلقة اتصال في نشاط بشري جماعي.. إنها نمط من العمل وليست أداة للتأمل". ويورد مالينوفسكي في معرض شرحه لرأيه بعثة صيد في تروبرياند فيقول: "يتم توجيه مجموعة من قوارب الصيد وتنظيم حركتها باستمرار عن طريق الكلام. فالصرخة التي تعلن وجود كمية من الأسماك تعنى إعادة تنظيم جميع حركات القوارب من جديد. "ومن جهة أخرى" فإن الطريقة التي استعملت فيها اللغة الآن في كتابة هذه الكلمات هي من الاستعمالات الفرعية والبعيدة للغة". فالكلمات هي أدوات، و"معنى" الأداة يكمن في استعمالها(39).
وطور مالينوفسكي مواجهته لمهمة ترجمة الكلمات والجمل المحلية في النصوص الاثنوجرافية من جزر تروبرياند Trobriand إلى إنجليزية مفهومة- طور نظريته لسياق الحال التي وفقًا لها ترجع معاني المنطوقات meanings of autterances (الي تؤخذ كمادة أولية) وكلماتها وعباراتها المكونة لها، إلى وظائفها المختلفة في سياقات الحال الخاصة التي تستعمل فيها(40). وبهذا كان مالينوفسكي باحثًا شديد القرب من الأشخاص والناس، فقدم نظرية لعالم الأجناس البشرية عن اللغة، أعطى فيها تقريرًا رائعًا لشخصيات تروبرياند وقام بعمل دراسة شاملة حولها(41).
كما اهتم عالم اللغة فندريس " بسياق المقال " فقال : " اننا حينما نقول بأن لاحدى الكلمات أكثر من معنى واحد فى وقت واحد ، نكون ضحايا الانخداع الى حد ما، اذ لايطفو فى الشعور من المعانى المختلفة التى تدل عليها احدى الكلمات الا المعنى الذى يعنيه سياق النص .أما المعانى الأخرى جميعها فتنمحى وتتبدد، ولا توجد اطلاقا "(42) وقال: " ان الكلمة لاتتحدد فقط بالتعريف التجريدى الذى تحددها به القواميس ، اذ يتأرجح حول المعنى المنطقى استعمالها – وهى التى تكون قيمتها التعبيرية ." (43) بمعنى أن معنى الكلمة يختلف باختلاف استعمالها.
أشار فندريس الى أهمية السياق فى التحليل اللغوى للنصوص فجاءت على النحو التالى :
1-السياق : هو الذى يعين قيمة الكلمة.
2-السياق : هو الذى يفرض قيمة واحدة بعينها على الكلمة ، على الرغم من المعانى المتنوعة التى فى وسها أن تدل عليها.
3-السياق : هو الذى يخلص الكلمة من الدلالات الماضية التى تدعها الذاكرة تتراكم عليها ، وهو الذى يخلق لها قيمة حضورية.
4-السياق : هو الذى يحدد معنى الكلمة المناسب ويعمد الى ابعاد كل ما خلاه من معانى ذهنية مرتبطة بهذه الكلمة دون السياق . (44)
وهذه الطريقة سحبها فيرث على اللغة بمعالجتها للوصف اللغويlinguistic de-script-ion كله باعتباره تحديدًا للمعنى، وبذلك يمد تطبيق معادلة "المعنى هو الوظيفة في السياق"meaning is -function- in context" ليغطي التحليل النحوي والفونولوجي. وعلى سبيل المثال، فإن تحديد الاستعمالات النحوية لصيغة الحال case form في لغة كاللاتينية هو تحديد لوظيفتها في السياقات القواعدية المختلفة، كما أن تحديد التباينات الفونولوجية والإمكانيات السياقية لصامت مثل (b) أو (n) في الإنجليزية هو تحديد لوظيفته في السياقات الفونولوجية المختلفة وفي سياق النظام الفونولوجي للغة(45).
والمعنى بمعناه المعتاد للعلاقة بين اللغة وعالم التجربة قد تم تناوله بأسلوب الوظائف الدلالية semantic -function-s للكلمات والعبارات والجمل، في سياقات الحال المختلفة ذات الطبيعة الأكثر تجريدًا من التفصيل الفعلي المرصود لمالينوفسكي والتي تقدم إطارًا للفصائل أو الفئات يضم المقصود reference والماصدق denotation اللذين يمكن عن طريقهما، أن تربط المنطوقات وأجزاؤها بالصور المتصلة بها وبالواقع في العالم الخارجي. وقد أكد فيرث على التوازي بين السياقات الداخلية والصورية للقواعد والفونولوجيا وبين السياقات الخارجية للحال، وبهذا يسوغ التوسيع المختلف والمتناقض ظاهريًا في استعمال مصطلح المعنى. ويمكن أن يقال: إن فيرث قد بخس أهمية الفروق بين التحليل الصوري formal analysis والتحليل الدلالي، لكن الانتقال في الدلالة بعيدًا عن تجسيد المعاني كما "يمثل" أو يشار إليه بشكل بسيط (ما دام لا يوجد بسهولة مشار إليه معين بكثير من الكلمات) إلى تفسير المعنى بوصفه وظيفة (كيفية استعمال الكلمات وتركيباتها) هذا الانتقال كان انتقالاً عظيم قيمة(46).
ولذلك كان من الملائم أن يكون أحد أعمال فيرث عن مالينوفسكي،حيث إنه يدين لمالينوفسكي حول "سياق الحال". فالتحليل الإثنوجرافي واللغة مع الإشارة لآراء مالينوفسكي "لا يناقش فقط الإسهام الذي قام به مالينوفسكي في مجال علم اللغة، لكنه يشير بوضوح أيضًا إلى أنه إذا كان فيرث استمد نظريته عن "سياق الحال" من مالينوفسكي إلا أنه قد طورها بناءً على آرائه وأنتج ما يعد نظرية مختلفة تمامًا(47).
فلقد رأى فيرث أن هناك استخدامات معينة من قبل الناس لهاتين الكلمتين؛ "السياق" و"الحال". فهما تلائمان العديد من الناس في الحالات المختلفة. فمثلاً، حالة العديد من الإنجليز في مواقف اللطف والشراب والزجاجات المليئة بالخمر تنسجم معهم فلديهم اعتبارات نفسية، ولحظات عملية في أثناء الحوار، لديهم أعين، وأيدي، ومعرفة وعوامل عديدة تشارك في اهتماماتهم في لحظة حياتية معينة. وكل ذلك يعني مايقومون به من أعمال أثناء استخدامهم للكلمات في سياق الحال بأفضل شكر مؤثر وفعال. ويمكننا معرفة ذلك بشكل أفضل من خلال مشاهدة مايحدث قبل التحدث بالكلمات وأثناءه وبعده، بملاحظة الدور الذي تلعبه تلك الكلمات فيما يحدث. الناس، الأثاث، الخمور، الزجاجات، المقاعد، سلوك المرافقين، والكلمات المستخدمة، كلها عناصر مكونة لما يمكن أن يسمى "سياق الحال". والمعنى يكون في أفضل حالاته بهذه الطريقة باعتباره مجموعة من العلاقات المتعددة الأنواع بين العناصر الكونة لسياق الحال(48).
والحال هو "عملية ممثلة تحدد على أنها نشاط معقد ذا علاقات داخلية بين عناصره المختلفة". وتلك العناصر ليست واضحة فحسب من خلال علاقتها بعضها البعض، بل هي تجذب بعضه بعضًا بنشاط لعمل علاقة، أو تمسك ببعضها البعض بالتبادل كما يقول وايتهد Whitehead. حتى من خلال نظام اللغة ذاته فإن ما يمكن أن يقال بواسطة أحد الأشخاص في محادثة مرتبط بما قاله الشخص الآخر فيما قبل وما سيقوله فيما بعد. إنه مرتبط حتى بشكل سلبي بأي شيء لم يقال ولكن يمكن أن يقال. ويجب أخذ هذا "الارتباط الداخلي" على أنه مبدأ رئيسي حتى في علم الأصوات وعلم القواعد الصوري فالعمليات الممثلة للأحوال التي يسود فيها السلوك اللغوي تكون ديناميكية وابتكارية. ولذلك فإن الكلمة خلق أو إبداع(49)."والمعنى" يعد خاصية للناس والأحداث الملائمة في الحال وإذا كان بعض الأحداث عبارة عن ضوضاء صادرة من المتحدثين، فمن المهم إدراك أن "المعنى" هو مجرد خاصية للناس من حيث أوضاعهم، مقاعدهم، سلوكهم الخاص وما يقومون به من أحداث(50).
ويؤكد فيرث في موقفه من "سياق الحال" نظرته الاجتماعية للغة فيقول: (لو اعتبرنا "اللغة أداة تعبيرية أو تواصلية" فإننا نفترض أنها أداة للحالات العقلية الداخلية. وحيث إننا نعلم القليل جدًا عن هذه الحالات العقلية الداخلية، حتى بواسطة الفحوص أو الدراسات الأكثر دقة، فإن مشكلة اللغة تصبح أكثر غموضًا كلما حاولنا تفسيرها بواسطة إرجاعها للأحداث العقلية الداخلية عير الملحوظة. وباعتبار الكلمات على أنها أفعال، وأحداث، وعادات، فإننا نقصر دراستنا على ما هو موضوعي أو مفيد أو ملحوظ في الحياة الجماعية لزملائنا)(51).
والكلام هو نوع من سلوك الجماعة المكونة من شخصين أو أكثر بواسطة استخدام ألفاظ مشتركة في سياق حال مشترك وفي سياقات تجريبية لأفرادها. فهو نموذج محدد ويصعب فصله ووصفه، وهو غاية للفرد. فالإنسان الطبيعي لا يستطيع الهرب من عبودية الأصوات. فعاداته الكلامية الجسمية أسست روابط مع رفاقه، ووجد أنه من المستحيل رسم حد حول فرديته. والإنسان المتحدث هو إنسان متعاون، ومترابط في وقته الحاضر مع إنسان كل العصور. والفرض الرئيسي لسويت وهو "أن اللغة موجودة في الفرد فقط" صحيح فقط من ناحية الأساس المادي لعاداتنا الصوتية في نظم الجهاز العصبي المركزي. والكلام كضوضاء عبارة عن عمل اجتماعي فقط. والميدان الصحيح لعلم اللغة هو دراسة ما يقول الناس وما يسمعونه وسط المحيط والتجارب التي يعملون فيها الأشياء، وواحد من أول الذين أدركوا هذه المشكلة من وجهة النظر الاجتماعية في القرن الحالي هو الأستاذ بالي Bally السويسري من (جنيف) الذي كتب سنة 1913: "إن مشكلة علم اللغة في المستقبل ستكون الدراسة التجريبية لوظيفة الكلام الاجتماعية"(52).
ولذلك تستخدم النظرية السياقية للمعنى التجريدات التي تمكننا من القبض على اللغة أو معالجتها في مواقف الحياة الشخصية والاجتماعية المترابطة في مجرى الأحداث.. "فالمعنى هو سمة التعاون المشترك بين الناس، والأشياء، والأحداث في الحال"(53).
والكلام العملي يعد نوعًا من السلوك الجسدي للتأقلم مع البيئات المحيطة، وفعل لفظي في معالجة المواقف. وهذا الجانب العمل للغة عام في كل أنواع العلم التعاوني وأنشطة الجماعة بكل أنواعها. وفي ذلك تكون الأوامر والتوجهات، والعلامات الإرشادية ذات نوع واحد، سواء كان مكتوبة أو منطوق. فجميع الأعمال والمشاريع العامة التي تحتاج لإرشاد اللغة قبل، وأثناء وبعد الإنجاز تعطى معنى عملي practical meaning للكلمات التي تخدمها. وتسمى تلك اللغة بـ"لغة الإرشاد العام" أو "لغة التخطيط" وهي تحتاج لرجال أقوياء عمليين للحفاظ على وظائفها: "فهناك ثلاث مراح في كل عمل عظيم: الكلام، والتخطيط، والتنفيذ. ولنعلم أن مرحلة الكلام يجب أن تنتهي لنواصل العمل". ولابد من التشجيع على المشاركة الفعالة، والإيمان بأهمية كلامنا اليومي تمامًا مثل أهمية حياتنا اليومية"(54).
ويؤكد فيرث أهمية اللغة في صياغة المواقف الاجتماعية وبناء الواقع الاجتماعي؛ فالكلام شبكة اتصال ونظام عصبي للمجتمع بشكل أكبر من كونه مجرد أداة للانبعاث الغنائي للروح الفردية. فهو شبكة روابط والتزامات. واللغة المشتركة تعد نوعًا من "لوحة مفاتيح الحياة الاجتماعية" التي تعطي الأوامر لشبكة الطاقة المحفزة للمجتمع. فالكلام هو المحرك والموجه لشبكة العلاقات الاجتماعية(55).
ولذلك فإن فيرث يعد "المقام" أو "الحال" خطوة من الخطوات التي يتخذها اللغوي في سبيل دراسة المعنى. وكان يرى أن دراسة الكلام ينبغي أن تتم على مراحل، هذه المراحل أو الخطوات التي ينبغي اتباعها عند تحليل الكلام هي فروع علم اللغة، والنتائج التي تصل إليها هذه الفروع هي مجموع خواص الكلام المدروس، ومن ثم فالمعن اللغوي عنده هو مجموع هذه الخواص. وينبغي أن نتذكر أن هذه الفروع يتصل بعضها ببعض اتصالاً وثيقًا ولا يجوز الفصل بينها إلا بقدر وفي ظروف مخصوصة(56).
وهنا يقترح فيرث الاستخدام systematic use لتعبيرات مثل: اللغة، لغة ما، اللغات المختلفة، الحدث الكلامي، عنصر الكلام، حدث الكلام، والأحداث الكلامية، الكلام، وذلك كما يلي:
1- اللغة تعد نزعة طبيعية لاستخدام موهبتنا المادية لعمل أصوات، وإشارات، وعلامات، ورمز لها معنى.
2- هذه النزعة تحافظ على النشاط النسقي الذي نصفه أو نوضحه في علوم القواعد، والقواميس، والصور الأخرى للعلم اللغوي. فهناك مجال كبير للبحث في الدراسة العامة للغة.
3- حينما ندرس أي لغة معطاة، فإننا ننوي الإشارة لنظام أو أنظمة لغة معينة، تم الحفاظ عليها بواسطة أشخاص يقومون بنقل وتحويل النظام أو الأنظمة.
4- إن الدراسة المقارنة لأنظمة اللغة تعد مجالاً واسعًا تم تطويره بشكل كبير بالفعل في اللغات الهندو-أوربية- لكنها تعد البداية فقط في علم اللغة الوصفي. ففي هذا المجال، الذي يتضمن الدراسة المباشرة للأشخاص الين يقومون بالعمل، يكمن التطوير المستقبلي الواعد للعلوم اللغوية.
5- إن حدوث الكلام أو المنطوق ربما يكون شفهيًا أو مكتوبًا ويتم في سياق الحال. ولهذا فإن "الحدث الكلامي" في "سياق الحال" تجريد فني من المنطوقات والأحداث. "فالحدث الكلامي" يمكن تقسيمه إلى أجزاء أصغر من عناصر الكلام".
6- وتلك "الأحداث" هي تعبيرات عن نظام اللغة الذي تنتج منه، ويشار إليها به.
7- الكلام يتكون من أعداد كبيرة من تلك الأحداث في سياقاتها، الناتجة من مجموعة من الأصوات الإنسانية في العمل وكميات كبيرة من الورق الملطخ بالحبر(57).
وبصفة عامة فإن "سياق الحال" هو جملة العناصر المكونة للموقف الكلامي (أو للحال الكلامية)، ومن هذه العناصر المكونة للحال الكلامية:
1- شخصية المتكلم والسامع، وتكوينهما "الثقافي" وشخصيات من يشهد الكلام غير المتكلم والسامع – إن وجدوا- وبيان ما لذلك من علاقة بالسلوك اللغوي، ودورهم أيقتصر على "الشهود" أم يشاركون من آن إلى آخر بالكلام، والنصوص الكلامية التي تصدر عنهم.
2- العوامل والظواهر الاجتماعية ذات العلاقة باللغة وبالسلوك اللغوي لمن يشارك في الموقف الكلامي كحالة الجو إن كان لها دخل، وكالوضع السياسي، وكمكان الكلام- إلخ.
3- أثر النص الكلامي في المشتركين كالإقناع، أو الألم أو الإغراء أو الضحك إلخ(58).
ولهذا يرى فيرث أن الوصول إلى معنى أي نص لغوي يستلزم:
1- أن يحلل النص اللغوي على المستويات اللغوية المختلفة (الصوتية والفونولوجية، والمورفولوجية، أو النظمية، والمعجمية).
2- أن يبين "سياق الحال" شخصية المتكلم وشخصية السامع، وجميع الظروف المحيطة بالكلام- إلخ.
3- أن يبين نوع الوظيفة الكلامية: تمن، إغراء- إلخ.
4- وأخيرًا يذكر الأثر الذي يتركه الكلام (ضحك، تصديق، سخرية.. إلخ)(59).
وبهذا يتفق فيرث في ربطه المعنى بالوظيفة في السياق، إلى حد كبير مع فتجشتين في تعريفه المعنى في حدود الاستعمال اللغوي في السياق ومع فلاسفة أكسفورد، ويعبر فتجنشتين عن ذلك بقوله: "لاتسأل عن المعنى، واسأل عن الاستعمال"(60). وتأكيده أن معنى الكلمة هو استعمالها في ألعاب اللغة المنوعة التي تلعب الكلمة دورًا فيها، وذلك بقوله: "فيما يتعلق بطائفة كبيرة من الحالات- وليست جميعها – التي تستعمل فيها كلمة "معنى" يمكن أن يتم تحديده هكذا: معنى الكلمة هو استعمالها في اللغة ويوضح معنى الاسم أحيانًا عن طريق الإشارة إلى حامله"(61).
رابعا: التحليل ونظرية المنطوقات:
يبدأ أوستن كتابة "كيف نصنع الأشياء بالكلمات"How to do things with words بالتمييز بين المنطوقات التقريرية constative utterances والمنطوقات الأدائيةperformative utterancesعلى أساس أن الأولى قد تكون صادقة أو كاذبة بينما الثانية لايمكن أن تكون صادقة أو كاذبة(62).
ويرجع هذا التمييز الى ايمان أوستن بوجود منطوقات لا تقوم بوصف العالم الخارجى ولا صلة لها مطلقا بالصدق والكذب. ولذلك نجده يقول: "لقد اصبح مدركا مؤخرا أن كثيرا من المنطوقات التى أخذت على أنها عبارات هى فى الواقع ليست وصفية, ولا هى عرضة لأن تكون صادقة أو كاذبة. لكن متى تكون العبارة لا عبارة؟ عندما تكون صيغة فى حساب التفاضل والتكامل, وعندما تكون منطوقا أدئيا, وعندما تكون حجة قيمة, وعندما تكون تعريفا definition, وعندما تكون جزءا من عمل قصصى, وهناك إجابات كثيرة مقترحة كهذه. وببساطة ليس عمل هذه المنطوقات هو " التطابق مع الوقائع". (63)
ولهذا يشير أوستن الى وجود منطوقات تشبه المنطوقات التقريرية ولا تقرر شيئاً فى العالم الخارجى, ومع ذلك لا يمكن وصفها بأنها زائفة. ومن هذه المنطوقات ما يستخدم فى مراسم الزواج مثل " إننى أتخذ من هذه المرأه زوجة شرعية لى", ومنها ما يستخدم فى الوصية مثل "اننى أورث ممتلكاتى لأخى", ومنها ما يستخدم فى المراهنة مثل " اننى أراهنك على مبلغ كذا وكذا من المال أنه سوف يحدث غدا كذا ", ومنها مايستخدم فى التسمية مثل "إطلاق اسم على مكان معين".. الخ. ومع أن هذه المنطوقات ليست صادقة وليست كاذبة, فانها ذوات معنى. ويقترح أوستن تسمية أى منطوق من هذه المنطوقات باسم "المنطوق الأدائى"(64).
ويضع أوستن عدة قواعد يؤدى عدم الالتزام بها الى الوقوع فى المخالفات وبالتالى وجود منطوقات غير ملائمة كما يلى:
1- لابد من وجود أجراء عرفى conventional procedure ذات أثر معين ويمكن قبوله, وأن يتضمن كلمات محددة يتم التلفظ بها من قبل أشخاص معينون فى ظروف معينة .
2- لابد أن يتلائم الأشخاص مع الظروف لكى ينفذ الأجراء المحدد.
3- لابد أن يقوم كل المشاركين فى الأجراء بتنفيذه بشكل صحيح وبصورة كاملة.
4- لابد أن يكون لدى المشاركين أفكار أو مشاعر أو نوايا محددة واهتمام بتوجية ذواتهم. (65)
ولكن هل المنطوقات التي هي عبارات تنطبق فكرة المخالفة عليها؟, يرى أوستن في إجابته عن هذا السؤال أن "المخالفة" هي أهم ما يميز المنطوق الأدائي على أنه مغاير للعبارة. وأن المنطوقات الأدائية من حيث هي أفعال متميزة عن غيرها. فالأفعال بصفة عامة قد تتم عن طريق الإكراه, أو الضغط, أو الصدفة. وفى هذه الحالات لا ينبغي القول أن الفعل قد أنجز, بل هو فعل عاجز نظرا للإكراه, وترتبط مثل هذه الأفعال ب "الظروف المخففة" أو ب"الغاء مسئولية الفاعل"...الخ(66).
ومن أمثلة المخالفات للقاعدة الأولى والتى تجعل المنطوق الأدائى غير مقبول: قول الزوج المسيحى لزوجته "أننى أطلقك" فرغم هذا القول لا يقع الطلاق لأن هذا الأمر لا يتعلق بأى اجراء مطلقاً حيث إنه مع الزواج لايوجد انفصال. ومن المخالفات للقاعدة الثانية "إذا كنا فى صحراء جرداء وتقول لى اذهب وأفعل كذا" وأقول "أنا لا أتلقى أوامرى منك" أو "لست أنت الذى يصدر لى الأوامر", وهذا مخالف ولاشك للحالة التى تكون فيها رباناً على سفينة لأنك فى هذه الحالة تكون لك سلطة حقيقية. ومن المخالفات التى تقع للقاعدة الثالثة "استخدام, الصيغ اللغوية بطريقة غير صحيحة كأن نستخدم صيغ غامضة واشارات ملتبسة". أماالمخالفات الخاصة بالقاعدة الرابعة فترتبط بالمشاعر والأفكار والنوايا. ذلك أن مشاعر الأفراد المشاركين فى الأجراء ليست واحدة, فالمنطوق "أنا أهنئك" قد يقال وأنا غير شاعر بالرضا أو وأنا أشعر بالغضب, كما أن الأفكار لدى الأشخاص المشاركين فى الاجراء قد لا تكون واحدة, وكذلك قد تغيب النية لدى المشاركين فتقع المخالفة. (67).
وهكذا يناقش أوستن فى عرضه لقواعد المنطوقات أفكاراً عديدة من أهمها فكرة "القبول" و"الملامة" و"الأهلية" و"الظروف" و"المشاعر" و"النوايا" وهلم جرا.. ولذلك فإن من الأسئلة الهامة فى مجال دراسة أفعال الكلام السؤال عما اذا كان الفرد قام بأداء الفعل بطريقة صحيحة أم خاطئة, وما إذا كان يمتدح أو يلام بسبب طريقة الأداء.. وهناك سؤال آخر "هل يستطيع أن يؤدى مرة ثانية؟", "هل يمكن فعل شئ آخر غير الذى قام به؟" بلا شك كلنا نجيب بالإثبات فى معظم الأحوال. فربما يظل اللص فى أحد المنازل يشاهد التلفزيون بدلاً من السرقة, وأنا يمكن أن أقوم بأعمال الحديقة بدلاً من لعب الجولف, ولا يهم فعلاً ما الذى أقوم به .. وهكذا. والذى يشكل المشكلة هنا هو أنه على الرغم من الميل الطبيعى لافتراض أن الناس قادرون على فعل أشياء غير التى يفعلونها, فان معظم الفلاسفة يقولون أن هناك بعض الأسس التى عليها يمكننا أن نقول أن لا شئ يمكن أن يحدث سوى ذلك الذى يحدث الآن ولذلك من بين الأشياء التى لايمكن للبشر أن يقوموا بها أثناء أداء أشياء أخرى ولا يستطيعون فى أى الحالات على الإطلاق أن يقوموا بها. ولتوضيح ذلك يبدأ أوستن حديثة بذكر بعض ملاحظات مور فى الفصل السادس من كتابة "مبادئ علم الأخلاق".(68).
يبدأ مور بالملاحظة التالية: هب أننى اقضى فترة الصباح فى العمل على مكتبى. اذن يبدو أن هذين الشيئين يمكن قولهما عنى: أننى فى هذا الصباح أستطيع أن أمشى ميلاً واحداً فى عشرين دقيقة (رغم أننى لم أفعل, وبالعكس, أننى لا أستطيع أن أجرى ميلين فى خمس دقائق). ونلاحظ أن هذه من الملاحظات الخاصة بالقدرات الجسمية – مشى ميل فى عشرين دقيقة هى شئ فى حالة الصباح يمكننى أن أفعله ولكن لا أنا ولا أحد غيرة يمكنه أن يغطى ميلين فى خمس دقائق. ولو كان الأمر كذلك, فهناك على الأقل حاسة – أيا كانت- يكون بها صحيحاً عن أحد الأفراد أنه يمكنه أن يفعل شيئا لم يقم بفعله فى الواقع. (69).
ولكن المعترض أو ما نسميه بـ"الحتمي" لا يرضى بهذا دعنا نتفق على أن شيئاً لم أفعله حقاً هذا الصباح كان يوجد ضمن قدراتي الجسمية فى ذلك الوقت وبهذا كان شيئاً يمكننى القيام به, وربما لا تزال نفس الحالة التى لا يمكننى فعلها والقيام بها. لأنه يمكن أن نفهم – فى وجود كل الظروف كما كانت فى الصباح – عدد الأنشطة التى تمت ويمكن أن تحدد بطريقة عادية بمعرفة الظروف الموجودة وقوانين الطبيعة, فلا يمكن أن يحدث شئ سوى ما قد حدث فعلاً. وبهذا لا يمكن ادراك حركة المشى فأنا لا أستطيع القيام بها فى وجود تلك الظروف, رغم أن هذا شئ عادى وهو ضمن قدراتى الجسمية. (70).
ويعتقد مور أن هناك سبباً للقول فى هذه الحالة بأن كلمة "يمكن" تعنى "يمكننى لو أن لدى الاختيار" أو – كما يقترح- "كان على لو أننى أخترت". ولكن لو كان هذا حقاً فان الحتمي ربما يوافق تماماً على أننى استطيع فعل ذلك رغم أننى لم أفعله. لأنه لابد أن يعترف بأن شيئاً يمكن أن يكون قد حدث لم يحدث فعلاً لو أن الظروف مختلفة عما هى عليه, وأنه لو كان لدى الاختيار فربما كان على أن أسير الميل فى عشرين دقية هذا الصباح. وهذا يعنى أن "يمكننى" و "احتمال" على الأقل فى هذه الحالات هى "شرطية" وترتبط بالفعل بما يقوله الحتمي فى وجود الظروف الفعلية فى أى مجال آخر مختلف بأن شيئاً يمكن أن يحدث فى حين أنه لم يحدث بالفعل.(71).
بعد أن عرض أوستن هذا الموقف تجادل أو أجرى حواراً مع مور حول المثال الأول كما يلي:
أولا: يتساءل أوستن: ماذا عن "يمكنني" و"يجب أن أكون قد"؟. لقد أقترح مور أنه ربما "يمكنني" تعنى "يمكنني لو أنا اخترت"، ولكنه يستمر ليقول أنه كان من الأفضل أن نقول "كان يجب على لو أنا اخترت". ولكن في الواقع هذا يبدو كقول شيء مختلف تماماً: "فالذي يستطيع الفرد أن يفعله يختلف عما يمكن أن يفعله: ربما يستطيع أن يطلق عليك الرصاص ولكن هذا ليس ضرورياً من أجل أن يقوم بذلك". ويقول أوستن: لو أنا اخترت حالة مور نفسه "كان يمكنني أن أمشى ميلاً في عشرين دقيقة لو أنا اخترت "نجد أنها ليست مرادفه ("كان على أن أمشى ميلا في عشرين دقيقة لو أنا اخترت " ربما يكون صواباً عندي ولكنهما لا يقولان الشيء نفسه. فالطريقة المثلى في قراءة الأولى ربما تكون إدعاء أو على الأقل تأكيداً لقدرتي الجسمية, أما الثانية فإنما هى شيء عن قوة شخصيتي: لو أنا أخترت أن أمشى ميلاً فى عشرين دقيقة هذا الصباح, إذن فعلى أن أمشى. ولهذا فان اقتراح مور من وجهة نظر أوستن غير مبرر بالتأكيد.
ثانياً: من المزايا الهامة لاقتراح مور أن جملة "كان يمكنني" وجملة "يمكنني":" أو "يحتمل" كلاهما شرطيتان. ويبدو أن هذا هو الذى يعنيه , وهو هدفه اللغوى وهو المطلوب فى جداله مع الحتمى. فالذى حدث فعلاً هو الذى يمكن أن يحدث" ولكنه مستعد جداً ليعترف بأن –شيئاً آخر يمكن أن يكون قد حدث لو أن الظروف اختلفت عما كانت عليه. وافترض مور أن جملة "أنا أستطيع لو أنا اخترت" هى جملة شرطية" ولكن هل هي شرطية فعلاً؟ ربما نقول نعم لو أن هذا يعنى أنها تحتوى على جملة مساعدة تبدأ بـ"اذا" . ولكن من وجهة نظر أخرى كما يود أستن أن يقول فهى تختلف كثيرا عن الشرطيات العادية. فعن طريق القواعد العادية، لو أن لدينا الصيغة "لوكانت أ- إذن تكون ب" فإن الأولى تمكننا من استنتاج أنه "لو لم تكن أ" إذا لم تكن ب-" والثانيه بالطبع لا تمكننا من استنتاج (ب) عن طريق ذاتها. ومن خلال "لو كان يمشى فسوف يتاخر" يمكننا استنتاج "لو لم يتاخر فهو لم يكن يمشى" ولكن، بالطبع، "هو لن يكون متاخراً". ولنأخذ مثالاً عن "يستطيع" من خلال "هو يستطيع أن يفعل ذلك الشىء لو كان مستعداً له" يمكننا استنتاج "لا يمكنه فعله لو لم يكن مستعداً له" ولكن ليس "هو يستطيع فعله .. ولكن "أستطيع لو أنا اخترت" تتفق مع هذه القاعدة العادية. فنحن لايمكن أن نقوم بالاستنتاج الدقيق "لو لم أستطع ، لن أختار أن .. "ولكن يبدو أننا يمكن أن نستنتج "أنا استطيع سواء اخترت أم لا" وكذلك ببساطة "أستطيع" بدون أى شروط. (فقدرتى على فعل شىء غير مشروطه بأى شىء آخر) فهذه الاحتمالات غير موجوده وليست عامة كما يقول أوستن. فعبارة "يوجد بعض البسكويت على المنضدة اذا كنت تريده" تعنى "أن هناك بعض البسكويت" ولا تعنى "لايوجد بسكويت إذن فانت لا تريده". وعبارة "ولقد دفعت لك أمس لو كنت تتذكر تعنى "أننى دفعت لك أمس لو أنت تذكرت أم لا ولا تعنى "أننى لم أدفع لك لو لم تتذكر أننى دفعت" رغم ان هذا قد يكون صحيحاً(72).
وهكذا فإن عبارة "أنا استطيع لو أنا اخترت" و" كان يمكننى لو أنا استطعت الاختيار" ليست شرطيات طبيعية، بل ليست شرطيات على الإطلاق كما هو واضح عند مور. فماذا عن "يجب على لو أنا اخترت؟" وهذا مختلف تماماً. فنحن لانستطيع أن نستنتج من "يجب على لو أنا اخترت" انه يجب على لو أنا اخترت أم لا.وكذلك هذه الجملة" يجب على لو أنا اخترت" تبدو شرطية بصورة طبيعية. ولكن ماذا عن "لو لم تكن أ ولا ب؟ هل نستطيع استنتاج "لو لم أستطع أن أختار ذلك" وهذا غريباً حقاً ويرفضه أوستن. إذ يرى أن "يجب على لو أنا اخترت" تعنى "يجب على ليست حقاً بل تأكيداً أن شيئاً ما سوف يتحقق ولكنه إعلان للنية والقصد وهو القيام به لو كنت أستطيع الاختيار.ولكن هذا غير واضح فعبارة "لم يجب على" ماذا يمكن أن تعنى؟ إذا كانت تعنى نفى كلمة "يجب على "فهى لن تكون افتراضاً لشىء ما سوف يحدث فى المستقبل، ولكن إذا لم تكن كذلك، ماذا يمكنها أن تكون أيضاً. أعتقد أنه إذا ما حاولنا فحصها من أجل الاستنتاج نجد أنفسنا أمام تغيير فى الكلمات: "جدك سوف يغضب منك لو أنت تزوجت هذا الرجل"، "سأتزوجه لو أنا اخترت"، "أنت بالتأكيد لن تفعلى هذا لو أنت علمت شعور جدك"، "لو أنا لم أفعل فهذا فقط سيكون بسبب أننى لا أستطيع الاختيار". فى هذا الجزء من المحادثة نلاحظ أن جملة "أنا سوف" متبوعة بـ"لو أنا لم" وهذا كاف جداً ولكن ربما لم يكن النفى الجازم لجملة "أنا سوف" فى الجملة السابقة (73).
ويرى أوستن أن جملة "يمكننى أن" لها صورتين متماثلتين ولكنهما مختلفتان فى القواعد النحوية. فإحداهما شرطية: "يمكننى أن أفعل هذا الشىء لو كنت مستعدا له" تقول بالفعل أنه كان بإمكانى أن أفعله لو توافرت الظروف وخاصة كونى مستعداً. والأخرى غير شرطية " كان يمكننى أن أفعله – ليس يمكننى أن أفعله لو...، ولكن أننى كنت قادراً أن "... وبالنسبة لجملة "أنا أستطيع لو أنا اخترت" فيقول أوستن أن هناك ثمانية اختلافات وتفسيرات بسيطة ويلاحظ أن الشىء المشترك فيها جميعاً هو التأكيد الإيجابى الكامل على أن "أنا أستطيع" ترتبط بوجود السؤال عما إذا كنت أنا اخترت والذى يتعلق بما نحن فيه بمجموعة من الطرق (74).
كما يذكر أوستن بعض الملاحظات على كتاب "الأخلاق"(1954) لـ"نويل – سميث، P. H. Nowell- Smith الذى قدم فى البداية اقتراحه بأننا عندما نقول إن "فلان قد استطاع أن يفعل كذا وكذا" فذلك يتضمن أنه لم يقم بالفعل نفسه. فهذا الاقتراح لا يؤكد الفعل نفسه، أو أن الفعل قد تم بالفعل مباشرة، وهذا يبدو معقولاً. فإذا قلنا إنه "ارتكب جريمة" أو "قد يرتكب الجريمة" فهل هذا يعنى أنه ارتكبها بالفعل أم لا؟. ويرى أوستن أن الفعل "يستطيع" يؤكد لنا القدرة على إنجاز الفعل فى الواقع. ولكن ماذا إذا استخدمته لتقول أنه استطاع أن يفعل شيئاً وأنا متأكد أنه لم يفعله أبداً؟ فهذه الجملة ليست مباشرة مما يعنى أن هناك بعض الحالات التى تناسب الإدعاء الذى قام به "نويل – سميث". فما يكون الشخص قد فعله لا يعنى بالضرورة أنه قد فعله فعلاً. فحقيقة الفعل المباشر هذه قد تكون خاصة ببعض الحالات من دون الأخرى. ولذا فنحن لا نندهش بالحقيقة العامة عندما تقول "قد فعل" عندما تعنى "ربما فعل" بما فيها من قدرات معينة. ولذلك فإن عبارة "هو قد فعلها" ليست قاطعة لسببين هما: أولاً أننى لم أره يفعلها وثانياً ليس هناك ما يثبت أنها وقعت بالفعل أى أنها أمر قاطع. وهذا يتضمن أن جملة "قد فعلها" نفسها ليست جملة قاطعة وباتة(75).
إذن ماذا عن تحليل كل من "يستطيع" و"قد فعل"؟ يقول نويل- سميث أن هناك ارتباطاً للعوامل بطريقة "شاذة منطقياً". فعندما نقول أن الشخص "يستطيع" أن يعمل كذا وكذا نعنى أن لديه الفرصة ولديه الدافع لفعل ذلك ولكنه لم يفعله بعد. لكن هل يعد ذلك منطقياً؟ يقول أوستن إن هذا لا يبدد النتيجة التى وصل إليها نويل سميث. وهذا أيضاً يثير الدهشة لأنه فى الواقع وضع لنا مثالاً معاكساً لذلك يفسر هذا الغموض. فالارتباط بين القضايا يكون "شاذاً منطقياً" معناه ببساطة أنها لا يمكن أن تكون كلها صحيحة معاً. لتوضيح ذلك يمكننا أن نسوق القضايا التالية:
1- يمكننى أن أفعل كذا.
2- عندى فرصة أن أفعل كذا.
3- عندى دافع أن أفعل كذا.
4- أفشل فى عمل كذا.
ويرى أوستن فى تعليقه على ذلك أنه لا يوجد ما يسميه نويل بـ"الشاذ" "منطقياً" فعندما أحاول وأفشل فى محاولتى لا يجب أن أستنتج أننى لم أفعل ذلك. وحقيقة ما قاله نويل عن وجود ارتباط بين هذه القضايا أو اعتقاده بأن هذه العلاقة شاذة منطقياً ينطوى على خطأوهو: إذا افترضنا صحة ما يستطيع الفرد عمله فهذا يتضمن صحة محاولاته للعمل نفسه بعد ذلك. وقد يكون شاذاً فعلاً أن اللاعب وأنا قد نحاول بجهد ثم نفشل ولكنه ليس شاذاً منطقياً أو حتى مستحيل منطقياً logically impossible(76).
وإذا اعتقدنا أن نويل – سميث على حق فيما قاله عن الارتباط "الشاذ منطقياً" فلن نجد علاقة بين "يستطيع" و"قد يستطيع أن يفعل". "فهو يستطيع" تعنى أنه إذا واتته الفرصة والدافع فقد يفعل وسوف يفعل. ولكن أوستن ينكر ذلك لسببين:
الأول: أن الارتباط بين القضايا الأربع السابقة غير محتمل ومن هنا يمكننا الظن بأن واحدة منها تعنى صحة اثنتين وتؤدى إلى عدم صحة الرابعة. فعندما أقول"هو يريد أن..." تعنى أنه يستطيع ولكن ليس لديه الفرص لذلك. وعندما أقول "هو لا يفعل..." تعنى أنه يستطيع ولديه الفرصة ولكنه لا يفعل. وكلها كما يقول أوستن مجرد "اقتراحات خيالية" Fantasti suggestions مثال: إذا لم أقضى أجازتى الصيفية فى أيسلندا فيكون صحيحاً أننى يمكننى ذلك ولكن لا أريده.
الثانى: أن أوستن يوضح ما قاله نويل سميث فى تحليله لكلمة "يستطيع" بما قد يقوم به الفاعل أو ما لا يفعله وذلك بالرجوع إلى الدوافع أو كما قال بالرجوع إلى ما يريده. فلا يمكننى إذن أن أقول ما يفعله الفرد أو ما سوف يقوم بفعله بدون الرجوع إلى الدوافع لمثل هذا الفعل. قد يكون هذا صحيحاً إذا تحدثنا عما يستطيع الفرد عمله ونجد أن ذكر الدوافع هنا ليس لها ارتباط بالموضوع. وتبدو النظرية مرفوضة بناء على هذين السببين(77).
وهنا يبدو من المهم جداً الرجوع إلى ما قاله أوستن بشأن "المقدرة" و"الفرصة" و"المهارة" و"الاستطاعة" حتى ندرك أهمية مدى اختلاف القضايا رغم اشتراكها فى نفس الموضوع. تعبر "الاستطاعة" عن "القدرة الجسمية" أو "القدرة العقلية" أو "القدرة المهارية" أو ما يسميه بـ"القدرة الشرعية أو الحق الشرعى legal power and right.. إلخ. فإذا وضعنا نصب أعيننا حالة مثل "القدرة الجسمية" كـ"تحريك اليد": فنحن نعتقد خطأ أن "هو يستطيع" لا يمكن أن تعنى "أنه فعل ذلك حقاً وأنها قد تكون ضربة حظ فقط... ويمكننا إذن أن نقول كما اعتقد أوستن أن المقدرة هى عائق أو احتمال ورائى لا يتضمن دائماً النجاح". وإذا عدنا مرة أخرى إلى سؤالنا عما هو مطلوب لكى نحدد ما يمكن للفرد أن يفعله وما قد يفعله حقاً نجد مرة أخرى أن القضايا مختلفة فيما بينها. إذا أردت معرفة هل قرأت القصة مثلاً يجب على أولاً أن أعرف هل يمكنك القراءة بالإنجليزية أم لا؟ وهل يمكنك القراءة أم لا؟ كل هذه المقدمات لا تؤكد قدرتك على الفعل عند المحاولة(78).
ولهذا يرى أوستن أن المرء يمكنه أن يستخدم عدة وسائل لغوية لتوضيح فعله الذى ينجزه مثل: الصيغة mood، والنغمة toon، والظروف, والعبارات الظرفية وأدوات الربط ولواحق المنطوق وظروف التلفظ به وهذا كما يلى:
أولاً: الصيغة:
الصيغة الطلبية مثلاً التى تجعل المنطوق "أمراً" أو "نصيحة" أو "رخصة" أو "تصريح.. إلخ لها استعمالات عدة فالمرء يمكنه أن يستعم عبارة "اغلق الباب" كما يلى: "اغلق الباب إذا طاب لك" تشبه المنطوق الأدائى "أنا أجيز لك أن تغلق الباب", "حسن" جداً إذن أغلق الباب "تشبه المنطوق الأدائى "أنى أوافقك على إغلاق الباب". هذا فضلاً عن إمكانية استعمال الأفعال المساعدة من أجل الغرض نفسه، فالصيغة "يجوز لك أن تغلقه" تقوم على الفعل المساعد "يجوز" وتشبه المنطوق الأدائى "أنا أعطيك إذناً لأن تغلقه" أو المنطوق الأدائى" أنا أوفقك على أن تغلقه". والصيغة "يجب أن تغلقه" تشبه المنطوق الأدائى "أنا أمرك بأن تغلقه"، والصيغة "ينبغى أن تغلقه" تشبه المنطوق الأدائى "أنا أنصحك بأن تغلقه".
ثانياً: النغمة:
يمكن استعمال نغمة الصوت أو النغمة الختامية أو التضخيم لتوضيح قوة المنطوق، ومن أمثلة لك: المنطوق "إنه يشرع فى الهجوم" هو تحذير و"أيشرع" فى الهجوم؟ "استفهام و"يشرع فى الهجوم" الترخى.
ثالثاً: الظروف والعبارات:
يعول المرء فى اللغة المكتوبة – وإلى حد ما فى اللغة المنطوقة – على الظروف والعبارات الظرفية، والتالى يستطيع أن يحدد قوة المنطوق "أنا سوف أقابلك غداً" عن طريق إضافة الظرف "على الأرجح" مثل "أنا سوف أقابلك غداً على الأرجح"، أو بمعنى معارض عن طريق إضافة الظرف "حتماً" إلى المنطوق نفسه: "أنا سوف أقابلك غداً حتماً".
رابعاً: أدوات الربط:
قد تستخدم أداة الربط مع قوة المنطوق، فمثلاً، نستخدم الأداة "ومع ذلك"، "أنا أصر على" "ولذلك" مع قوة المنطو.
خامساً: لواحق المنطوق:
قد نتبع نطق كلمات بالإيماءة أو الغمز أو هز "الكتفين أو العبوس أو نرفقه بالأفعال الشعائرية غير اللفظية كالتصنيف مثلاً، وقد تكفى هذه اللواحق أحياناً بدون النطق بالكلمات.
سادساً: ظروف التلفظ بالمنطوق:
بدون معرفة الظروف التى يتم فيها التلفظ بالمنطوق نقع حتماً فى الخلط فى عملية فهمنا للمنطوقات موضوع الدراسة(79).
وهكذا يمكن القول أن أوستن قد كرس اهتماماً كبيراً لما أسماه "المنطوقات الأدائية" وتنوعها وخصائصها. وكانت آراؤه حول هذه المنطوقات مثمرة، فقد قدمت نموذجاً لذلك النوع من البحث الخاص بحقائق الكلام واللغة والتى بدت وكأنها قد تم البحث فيه منذ القدم وتم تطويرها بصورة شديدة. ولا شك أن العديد من المشكلات التقليدية فى الفلسفة تم توضيحها من خلال هذا النوع من البحث(80).
خامسا: التحليل و نظرية أفعال الكلام
يجمع كثير من الباحثين على أن عدم اطمئنان أوستن إلى تفسيراته وتحليلاته المختلفة للمنطوقات والحالات الخلافية لها، وكذا وسائل توضيحها هو الذى دفعه أساساً إلى تقديم نظريته حول أفعال الكلام. ومنهم على سبيل المثال، "أرامسون" J. O. Urmson، و"ألبرت بروجمان" Albert Borgmann و"وارنوك"G. J. Warnock .
يرى أرامسون أن أوستن قد أسس أولاً فى كتابه "كيف نصنع الأشياء بالكلمات؟" مذهبه حول "المنطوقات الأدائية" غير أنه عندما تبين له أنه غير مرضى تماماً عمل على استبدال التمييز بين "المنطوقات الأدائية" و"المنطوقات التعبيرية" بالتمييز بين ثلاثة أنواع من الأفعال هى: الفعل التعبيرى locutionary act، والفعل الغرضى illocutionary act والفعل التأثيرى Perlocutionary act، وتلك الأفعال الثلاثة هى مكونات تجريدية من الفعل الكلامى التام compelte speech - act. وكان لهذا المذهب تأثيره القوى على الأعمال التى دارت فيما بعد حول فلسفة اللغة(81).
ويرى ألبرت بروجمان أن الاكتشاف الشهير لأوستن ربما هو تمييزه بين "الجملة التقريرية" و"الجمل الأدائية" فقد أوضح أن "الجمل الأدائية" محكومة بقواعد محددة ومعقدة وأننا نستطيع قياسها بمعيار النجاح والفشل. وبهذا التمييز قدم رؤية واضحة حول نمطين من الكلام، ولكنه واجه كذلك مشكلات عديدة... وقد هاجم أوستن هذه المشكلات بتمييزه بين ثلاثة نماذج ممكنة من الفعل هى: الفعل التعبيرى والفعل الغرضى والفعل التأثيرى(82).
ويرى وارنوك أن أوستن عندما وجد أنه لا يمكننا دائماً التمييز بين "المنطوقات الأدائية و"المنطوقات التقريرية" آثر أن يبحث فى الأسس العميقة للعديد من الطرق التى يكون فيها قول شىء ما "هو" is فعلاً لشىء ما، أو "فى" in قول شىء ما نؤدى شيئاً ما، أو "بواسطة" by قول شىء ما نؤدى شيئاً ما وذلك بعد اكتشاف البعد الأدائى perfornative dimension للمنطوق –بوجه عام – وهذا على النحو التالى:
أولاً: قد نتقيد بالكلام الحرفى، أو نتفق على أن قول شىء هو دائماً فعل نطق أصوات معينة يطلق عليه أوستن اسم "الفعل الصوتى" a phonetic act .
ثانياً: الفعل الصوتى للمتكلم هو، بطبيعة الحال، دائماً فعل نطق ألفاظ أو تعبير عن أصوات أو كلمات من أنماط معينة تنتمى إلى مفردات لغوية vocabulary معينة، وفى نظام محدد طبقاً لنحو معين، وبتنغيم intonation معين.. إلخ. ويطلق أوستن على هذا الفعل اسم "الفعل الصرفى التركيبى"aphaitc act ،والمنطوق الذى يكون فعلاً للنطق هو "الوحدة الصرفية التركيبية" pheme. إن ما يريد أن يؤكده أوستن هنا هو أن المتكلم فى الكلام (أو فى أداء الفعل الصوتى) ينتج، بصورة نموذجية، جمل اللغة وكلماتها فى نوع معين من التركيب النحوى.. إلخ.
ثالثاً: المتكلم فى الطريقة العادية لا يعبر بدقة عن جملة اللغة. إنه يعبر عنها فى "القول" أو لكى "يقول" شىء ما أو آخر. وهذا الأداء التعبيرى يسميه أوستن "الفعل الدلالى" rhetic act. ولكى نحصل من "الفعل الصرفى التركيبى" على "الفعل الدلالى" نحتاج إلى شيئين يسميهما أوستن: "المغزى" أو "الفحوى" sense و"الإشارة" reference وهما يساويان عنده "المعنى" meaning(83). وهذه الأفعال الثلاثة وهى "الفعل الصوتى والفعل الصرفى التركيبى والفعل الدلالى" تشكل معاً الفعل التعببيرى عند أوستن(84).
وبهذا يوضح أوستن أن أداء الفعل الصرفى التركيبى يتطلب بالضرورة أن نؤدى الفعل الصوتى، بمعنى أن أداء أولهما أداء للآخر، ولكن العكس ليس صحيحاً. كما أن تعريف الفعل الصرفى التركيبى يجمع بين أمرين معاً: المفردات اللغوية والنحو(85). ولذلك نجد أوستن فى تمييزه بين الفعل التعبيرى والفعل الغرضى يقول: "من البديهى، بالطبع، أن أداء الفعل الغرضى هو بالضرورة أداءاً للفعل التعبيرى، فعلى سبيل المثال (فعل التهنئة) هو بالضرورة قول ألفاظ معينة(86).
وهكذا فقد شعر أوستن بضرورة البحث عن بديل للتمييز ما بين المنطوقات الأدائية والمنطوقات التقريرية، فوضع نظرية القوى الغرضية the theory of illocutionary forces. ورأى أن المرء عندما يقول شيئاً ما فإنه يؤدى عدداً من الأفعال التى يمكن التمييز بينها مثل "الفعل الصوتى" وهو أداء نطق أصوات معينة، و"الفعل الصرفى التركيبى" وهو نطق كلمات محددة وفقاً لنحو محدد. وأراد أوستن أن يميز بين ثلاثة أنواع أخرى من الأفعال نؤديها عندما نقول شيئاً ما وهى أولاً: "الفعل التعبيرى" وهو أداء منطوق بـ"مغزى محدد تقريباً و"إشارة" محددة مثل قولنا "الباب مفتوح"، ثانياً: "الفعل الغرضى" وهو الفعل الذى نؤديه فى أدائنا للفعل التعبيرى، ثالثاً: "الفعل التاثيرى" وهو الفعل الذى تنجح فى أدائه عن طريق وسائل فعلنا الغرضى(87).
كما أوضح أوستن أوجه الخلاف بين هذه الأفعال الثلاثة وطرق أدائها بالأمثلة التالية:
أ- التعبير locution:
1- قال لو "صوب هنا". He said to me "shoot her"
2- قال لى "إنك لا تستطيع أداءه". He said me "you can t do that".
ب- الغرض: illocution:
1- "أمرنى أن أصوب هنا" He ordered me to shoot her
2- "اعترض على أدائى له: He proctested aginst my doing it.
جـ- التأثير perlocution
1- "حثنى أن أصوب هنا": He persuaded me shoot her
2- "لقد صدنى، لقد ردنى، لقد منعنى، لقد أوقفنى".
He stopped me(88).
وفى تصنيفه المبدئى للقوى الغرضية قدم أوستن تفسيراً يتضمن "الأفعال التقريرية" constiative acts. ورأى أننا فى أدائنا للفعل التعبيرى يمكننا أن: نؤكد، ننكر، نصف، نقرر، نوافق، نثبت، نريد.. إلخ، كما يمكننا أن نؤدى الفعل بـ"القوة الإلزامية أو قوة الإلزام" Ccommissive force وذلك عندما: نعد، نراهن، ننذر، نتبنى أو نقبل، أو بـ"القوة الإحكامية أو قوة الإحكام": verdictive force وذلك عندما: نبرئ، نضمن، نلزم أو نرفض أو بـ"القوة السلوكية أو قوة السلوك" behabitive force وذلك عندما: نعتذر، نشكر أو نلعن(89).
وربما يحدث المتكلم فى قوله لشىء ما تأثيرات معينة على مشاعر المستمع وأفكاره وسلوكه كنتيجة لما يقول، على سبيل المثال، ربما يقنع شخصاً معيناً أن شيئاً ما حقيقة واقعية، أو يحث شخصاً معيناً لأداء شىء ما، وهكذا يفعل المرء شيئاً ما عن طريق القول، فقد يعبر به رؤية شخص معين حول موضوع ما، أو يخدعه، أو يرعبه، أو يدهشن.. إلخ. ويسمى أوستن هذا النوع من الأداء بـ"الأفعال التأثيرية"(90) كما يقول: "أن الأفعال الغرضية هى أفعال عرفية conventional acts: بينما الأفعال التأثرية ليست عرفية.. وتجب ملاحظة أن الفعل الغرضى هو فعل عرفى أى فعل مفعول وفقاً لعرف. وأننا نؤدى أيضاً الأفعال الغرضية مثل الأعلام، والأمر، والتحذير، والتعهد.. إلخ، أعنى المنطوقات التى لها قوة عرفية معينة(91).
وركز أوستن كذلك فى تمييزه بين الفعل التعبيرى والفعل الغرضى والفعل التأثيرى على ببيان مدى تعارض الفعل الغرضى مع النوعين الآخرين. فالفعل الغرضى رغم وجود نزعة ثابتة فى الفلسفة لاستبعاده لصالح أى فعل من الفعلين الآخرين إلا أنه يظل متميزاً عنهما. وإذا كان "استعمال اللغة"، ربما يولد مشكلات تحول دون التمييز بين الفعل التعبيرى والفعل الغرضى فكذلك الحال بالنسبة للكلام عن استعمال اللغة. ذلك أن الكلام عن استعمال اللغة للإثبات أو التخويف يبدو تماماً مثل الكلام عن استعمال اللغة للإقناع والإفزاع. ومع هذا فإن الأول ربما يكون عرفياً أى يمكن توضيحه بواسطة "الصيغة الأدائية" وأما الآخر فلا يمكن أن يكون كذلك(92).
وموجز القول: أن أفعال الكلام speech acts تتشكل عندما نتحدث بالكلمات أو نتلفظ بها. ولقد اعتقد أوستن أن أفعال الكلام تنقسم ببساطة إلى:
1- الفعل التعبيرى (قول كلمات) وهو يتضمن فعل صوتى (نطق أصوات) وفعل صرفى تركيبى (استعمال النحو)، وفعل دلالى (استعمال كلمات بمعنى).
2- الفعل الغرضى (أداء فعل فى كلمات منطوقة، على سبيل المثال، للوعد أو الإعلان).
3- الفعل التأثيرى ويكون عندما نحدث تأثيرات معينة فى الآخرين عن طريق كلماتنا.
واعتقد أوستن أن دراسة "أفعال الكلام" قد توضح المشكلات الخاصة بالمعنى والإشارة.. إلخ(93)
الهوامش
1-H. N. S: "analysis" in "The concise Encyclopedia of Western philosophy and philosophers" ed J. O. Urmsonl, p-2.
2-Ammerman, Robert. R. (editor)Classics of analytic philosophy,TaTa Mc Graw- Hill publishing company LTD. Bombay, New Delhi, 1956 pp. 1-3.
راجع أيضاً د. محمد مهران: دراسات فى فلسفة اللغة، ص ص15-16.
3- Sheldon peterfreund (and others): Contemporary philosophy and Its origins, D van Nostrand company, inc, London 1968 p- 234.
4-Guthrie. W. K. C.: Th Greek philosophers from Thales to Aristotle, Methuen, London, 1987,m pp-104-105.
5- Sheldon p. peterfreund (and others): op- cit, pp- 237- 238.
6-Ayer, A. J. language, truth and logic pp- 70- 72.
7- Ibid, p- 74.
8- Ayer, A., J: The Central Questions of philosophy, pp- 23- 25.
قارن الترجمة العربية ص ص37- 39.
9- د/ زكى نجيب محمود: مرجع سابق ص ص146- 147.
10- د. صلاح إسماعيل : نظرية جون سيرل فى القصدية ، دراسة فى فلسفة العقل ، حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية – الحولية السابعة والعشرون ، مجلس النشر العلمى، جامعة الكويت ، 2007 ، ص34 .
11- Timothy Williamson : Op – cit , pp- 11-12.
12- Anthony Kenny : Frege : An Introduction to the Founder of Modern Analytical philosophy , oxford , Blackwell, 2000, p-211
13-Michael Dummett : Origins of Analytical philosophy , Cambridge, Mass : Harvard university press, 1996 , p- 25 .
14- لودفيج فتجنشتين : رسالة فلسفية منطقية ، ترجمة د. عزمى إسلام ، مراجعة د/ زكى نجيب محمود ، مكتبة الأنجلو المصرية ، 1968 ، ص ص 36 ، 37 .
15- د/ محمد مهران رشوان: دراسات فى فلسفة اللغة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع 1998 ص37.
16-Alfred Jules Ayer : Language, Truth and logic, Penguin Books, 1936,p- 76.
17- د/ زكى نجيب محمود: موقف من الميتافيزيقا، دار الشروق ط3 1937 ص21.
18-Moore, E. G: principia Ethica, Cambridge university press 1962, p- vii
19-Ayer, A. J: Russell and Moore, the Analytical Heritage Macmillan, London, 1971 pp- 221- 222.
20-Sheldon p. peterfreund (and others): op. ci p- 252.
21- د/ محمد مهران رشوان: دراسات فى فلسفة اللغة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع 1998 ص37.
22- Ayer, A, J (ed), The Revolution in philosophy, paperback, London, p-1.
23- Richard Rorty : The Linguistic Turn , Essay in philosophical Method , The University of Chicago press, 1992, p- 3 .
24-Richard Rorty : The Linguistic Turn , Essay in philosophical Method , The University of Chicago press, 1992, p- 3 .
25-محمد جديدى : مرجع سابق ، ص 256 .
26- Richard Rorty : Philosophy and the Mirror of Nature , p-263.
(194) Ibid , pp- 257-258 .
قارن د.محمد جديدى : مرجع سابق ص 259
27- Richard Rorty : " Introduction " In " Empiricism and the philosophy of Mind " edited by willforid Sellars, Cambridge, Mass, Harvard University press, 1997, p-1 .
28- Ibid , pp- 1-2 .
29- Ibid, pp- 2-3 .
30- Ibid, pp- 3-4 .
31-Ibid, pp- 4-5 .
32- Ibid, p- 9 .
33- Richard Rorty : Contingency, Irony and solidarity, Cambridge university press, 1995, pp—176 – 180 .
34-Jeffry Ellis,"on contextual meaning" in "in ,memory of J. R. frith" edby C. E. Bazell and others, Longmans, 1966, P. 79.
35-Frith, J. R. "Personality and language in society" in "Readings for Applied linguistics" ed by: P. B. Allen and. s. p IT corder, Oxford University press, London 1975, P 16.
36-جون لايتر : مقدمة فى علم اللغة النظرى ، ترجمة مجيد عبدالحليم الماشطة وآخرون ، العراق أ جامة البصرة ، كلية الآداب ، ص 32
37-د. محمود السعران: علم اللغة، مقدمة للقارئ العربي، دار الفكر العربي ص310.
38-د. محمود سليمان ياقوت: فقه اللغة وعلم اللغة, نصوص ودراسات، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية 1991، ص236.
39-جعفري سامون: مدارس اللسانيات، التسابق والتطور، ترجمة د. محمد زياد كبه، مطابع جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1994م، ص238.
40-Robins, R. H: A short History of linguistics, P- 213.
41-Firth, J. R, Papers in linguistics 1934- 151, P- 143.
42- فندريس، ج:اللغة ، ترجمة عبدالحميد الدواخلى ومحمد القصاص، القاهرة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، 1950م، ص 228
43-المرجع نفسه ، ص 252
44-د.محمد اسماعيل بصل وأخرون : "ملامح نظرية السياق فى الدرس اللغوى الحديث" مقال فى " مجلة دراسات فى اللغة العربية وآدابها" فصلية محكمة ، الدد الثامن عشر ، 2014م ، ص 4
45-Robins, R. H: A short History of linguistics, P- 213
46-Ibid, P- 214.
47-Firth, J. R: selected pupers of J. R. Frith, 1952- 59, introduction, P-4.
48-Firth, J. E, The Tongues of men and speech, P-110.
49-Ibid, PP- 110- 111.
50-loc-cit.
51-Ibid, P- 173.
52-loc-cit.
53-Firth, J. R: selected pupers of J. R. Frith, 1952- 59, introduction, P-14.
54-Firth, J. E, The Tongues of men and speech, PP-112- 113.
55-Ibid, PP- 113- 114.
56-د. محمد حسن عبد العزيز: مرجع سابق ص ص137- 138.
57-Firth, J. R, Papers in linguistics 1934- 1951, PP- 143-144.
58-د. محمود السعران: مرجع سابق، ص ص331- 312.
59-الموضع نفسه.
60-Wittgenstein, L: Philosophical Investigutions, Translated by g. E. Anscombe, Basil Blackwell, Oxford, 1963. P-89.
61-د. صلاح إسماعيل عبد الحق: التحليل اللغوي عند مدرسة إكسفورد، دار التنوير للطباعة والنشر، لبنان، ط 1993، ص290.
62- Ausin, J. L, philosophical papers, p- 131.
قارن أيضاً د/ صلاح إسماعيل عبد الحق: التحليل اللغوى عند مدرسة أكسفورد ص140.
63- Austin, J. L., How To Do Things with words, edited by Mrnson, Oxford University press, New York, 1970, pp- 5-6.
64- Ibid, pp- 14- 16.
65- Ibid, pp- 16-18.
66- Ibid, pp- 37- 40.
وكذلك د/ صلاح إسماعيل : مرجع سابق ص ص148- 149
67- Warnock, G. J: J. L., Austin, p- 80.
68- Ibid, pp- 80- 81.
69- Loc-cit.
70- Loc-cit.
71- Ibid, pp- 81-83.
72- Loc-cit.
73- Ibid, pp- 83- 85.
74- Ibid. p- 90.
75- Ibid, pp-90- 91.
76- Ibid, p. 93.
77- Ibid, pp- 93.
78- Ibid,pp – 94-94
79- Austin, J. L: How To Do Things with words pp- 73- 76
راجع أيضاً: د. صلاح إسماعيل عبد الحق،: مرجع سابق، ص ص163- 167.
80- Warnock, G. L: English philosophy since 1900, p- 154.
81- Urmson, J. O: op- cit, p. 38.
82-Borgmann, A: The philosophy of language, Historical foundations and contemporary Issues, Martinus Nijhof, The language 1974, p-116.
83-Warnock, G. J: J. L., Austin, pp- 119- 121.
راجع أيضاً: د. صلاح إسماعيل عبد الحق، : المرجع السابق ص184.
84- Ibid, p- 122.
85- Austin, J. L: How To Do Things with words, p- 95.
86- Edwards (paul): op- cit, p- 313.
87- Warnock, G. J: J. L., Austin, P- 122.
88- Borgman, A, op. cit, pp- 116-117.
89- Edwards (Pual), op.cit. p- 313.
90- Warnoc, G. J: J. L. Austin, p.- 122.
91- Ibid, p- 127.
راجع كذلك د/ صلاح إسماعيل: مرجع سابق ص198.
92- Austin, J. L: How To Do Things with wards, p- 103.
93- Flew, Antony, A Dictionary of philosophy, Macmillan Reference Books, 1984, p- 333.
#ابراهيم_طلبه_سلكها (هاشتاغ)



ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

 |
بحث
|
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
|
إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة