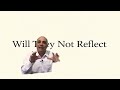|
|
الهوية المغلقة تتلاعب بالذاكرة
عبدالجبار الرفاعي


الحوار المتمدن-العدد: 8336 - 2025 / 5 / 8 - 10:01
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
عبد الجبار الرفاعي
التقيتُ ببعضِ الأصدقاءِ ممن هاجروا إلى بعضِ الدولِ الغربية، إثرَ اختناقِهم بالانغلاقِ والتشدُّدِ في مجتمعاتِهم، وأقاموا هناك سنواتٍ طويلةً، اكتسبوا فيها جنسيةَ تلك الدول. كان لديهم شغفٌ شديدٌ للعيشِ في دولةٍ غربيةٍ، يترقَّبون أن توفِّرَ لهم ضمانًا للعيشِ والصحةِ، ويَحميَهم فيها القانونُ، الذي يساوي بينهم وبين المواطنين غيرِهم، ويوفِّرَ لهم حريةً فكريةً وسياسيةً وحريةَ تعبيرٍ، ويحرِّرَهم من الإكراهِ على الولاءِ والطاعةِ العمياء. رأيتُ هؤلاء بعد سنواتٍ طويلةٍ من الإقامةِ في تلك البلدان، ينظرون لكلِّ شيءٍ في آفاقِ الحنينِ لهويتهم الموروثة، إلى درجةٍ بدأوا فيها يبجِّلون ما كانوا يعلنون كراهيتَهم له ونفورَهم منه، وصاروا مفتونين بما كان يثير اشمئزازَهم في بلادِهم، حتى أمسَوا أكثرَ تعصُّبًا وانغلاقًا وتشدُّدًا مما هربوا منه. أتحدَّث عن أصدقاء شخصيِّين التقيتُهُم في سفراتي إلى الغربِ، ولا أتحدَّثُ عن كلِّ المُغتَربينَ، ولم أشأْ ذِكرَ الأسماءِ. أذكُرُ هنا أشخاصًا أعرِفُهُم شخصيًّا، فأُشيرُ إليهم بوَصفِهم مِصداقًا للمفهومِ الذي أتحدَّثُ عنه. اتَّخَذتُ من هؤلاءِ الأصدقاءِ نَموذجًا لتلاعُبِ الهُويَّةِ المُغلَقةِ بالذاكرةِ. ولم أُصدِرُ حُكمًا عامًّا على كلِّ المُغتَربينَ.
تساءلتُ عن هذا الانقلابِ كيف حدث بهذه الكيفيةِ المثيرة، على الرغم من معرفتهم بأن لا شيءَ تغيَّر نحو الأفضل مما هربوا منه. أدركتُ أن الإنسانَ عندما يغترب عن وطنه، ويعيش في فضاءِ هويةٍ مختلفةٍ عن هويته، تحذفُ ذاكرته ما كابده في مجتمعه من بؤسٍ وشقاءٍ، ولا تحتفظ إلا بصورٍ فاتنةٍ من طفولته وصباه وذكرياتٍ مريحةٍ من حياته الماضية، يعيد متخيِّلُه إنتاجَها بأبهى أشكالها، ويَبتكِرُ لها صورةً خلّابَةً. ما يستدعي حضورَ الهوية هو شعورُها بالاغتراب، وممانعتُها الاندماجَ بهويةِ المجتمع الذي يعيش فيه المهاجر، إثرَ ما يستفزه ويضاعف آلامَه من تمييزٍ مضمرٍ ضد المهاجرين، وما يشعره بالعزلة والعجزِ عن بناءِ روابطَ اجتماعيةٍ تعيد ما ألفه من روابطَ في مجتمعه ووطنه الأصلي. يستحثُّ ذلك هويتَه الدينيةَ والطائفيةَ والعرقيةَ والثقافيةَ على أن تعلن عن حضورِها بثقةٍ وفاعليةٍ، وتتصلَّبَ وتنغلقَ، ويستبدَّ به الشوقُ والحنينُ للصورةِ الآسرةِ المتخيَّلة للوطن والمجتمع الذي وُلِد وترعرع فيه، كما يستبدُّ به تضخُّمُ الشعور بتهديدِ هويته الدينيةِ والطائفيةِ والعرقيةِ والثقافيةِ وتذويبِها، فتصبح وظيفةُ المغتربِ حمايةَ هويته والاحتماءَ بها، ورفضَ أيةِ محاولةٍ لنقدها أو مسائلتها أو الإعلان عن ثغراتِها وأخطائها وإخفاقاتها وتعصُّباتها وانغلاقها، أو تذكيره بما كان ينهجُها فيه وكان سببًا لهجرته.
وفي ضوء ما يشرحه بيير بورديو في «الهابيتوس» (habitus)، يمكن أن نفسِّر هذا الاغترابَ الذي يعيشه بعضُ المغتربين عن أوطانهم، وكيف يمارس الحنينُ نسيانَ ذاكرةِ ألمِ الماضي، وبناءَ ذاكرةٍ بديلةٍ مبهجةٍ، وتكوينَ معرفةٍ فاتنةٍ متخيَّلةٍ بماضي المغترب وهويته. يرى بورديو أن الإنسانَ ينشأ في إطارِ هابيتوس يتشكَّل من معتقداتٍ وتقاليدَ وعاداتٍ ومفاهيمَ ورموزٍ، فيكون إطارًا عميقًا للهوية والسلوك والذوق، يترسَّخ في البنية اللاواعيةِ العميقة لشخصيته منذ الطفولة. وحين يغترب الإنسانُ ويعيش في فضاءِ هويةٍ مغايرةٍ لهويته، يحدث تنافرٌ بنيويٌّ بين: الجسدِ واللاوعي اللذين يواصلان الاستمرارَ في نمطِ هابيتوس هويةِ وثقافةِ مجتمعه، وهويةِ وثقافةِ مغتربِه، مما يخلق صراعًا حادًّا بين ما هو متجذِّرٌ في شخصيته، ورأسِ المالِ الثقافيِّ المفروض عليه في غربته، فيتسبب في اغترابٍ مريرٍ يشتدُّ ويتفاقم بمرور الأيام، وبموازاته حنينٌ حادٌّ لهوية الأمس. ويعمل العنفُ الرمزيُّ بخفاءٍ على إكراه الإنسانِ في مغتربِه على نسيانِ ماضيه ومحوِ ذاكرته والاندماجِ ببيئتِه اليوم. وهذا ما يُحفِّز المغتربَ على محوِ ما يثير النفورَ والخجلَ والألمَ والرفضَ من ذاكرةِ الأمس، واستبداله بصورٍ تجعل الذاكرةَ مصدرَ إغواءٍ فاتنةٍ، وهويةَ أمسَ مثارَ إعجابٍ واشتياقٍ.
بول ريكور تَحَدَّثَ في كتابه: "الذاكرة، التاريخ، النسيان"، عن نوعين مختلفين من الذاكرة، النوع الأول: ذاكرةٌ حقيقيةٌ تعمل على استحضار الماضي كما كان بأمانةٍ وصدقٍ قدر ما يتمكن الإنسان، وذلك يرتبط بمفهوم الشهادة عند ريكور، بما يعنيه من وفاءٍ للتجربة الإنسانية والحقيقة التاريخية. وهذه الذاكرة تحرص على الحديث عن الوقائع التاريخية كما وقعت، والتحدث عن الشخصيات كما كانت، بعيدًا عن الإضافات والتحريفات، والتأويلات المتعسفة، وإن كانت عمليةُ الاستذكار ذاتَها تعني إعادةَ بناءٍ، وهذه الإعادة لا تخلو من تأويلٍ، غير أنه ضربٌ من التأويل الذي لا يزيف. والنوع الثاني من الذاكرة: ذاكرةٌ موجَّهة، يجري ابتكارُها وتوجيهُها وفقًا لمطامحَ أيديولوجيةٍ، كما تفعل الهوياتُ المغلقةُ، عندما تعمل على صياغة الماضي لتوظيفه في مطامحَ تنشدها الهويةُ في الحاضر. الهويةُ المغلقةُ لا ترى التنوعَ والتعقيدَ في الهويات، وتكون منحازةً وأسيرةً لصورة تحلم بها وتشدد على خلقها، فتعمد لانتقاء ما يجعل هذه الصورة أجملَ، وإن كان لا تعرفه الهويةُ في ماضيها، وتحرص على تكريس "نحن" مقابل "هم" على الدوام.
الهوياتُ سردياتٌ تصوغ بها المجتمعاتُ صورتَها عن نفسها، فترسمها بالكلمات، في ضوء ما تحلم به ويحلُو لها وتتمناه. وتستبعد ما يخصُّ الآخرَ المختلفَ، بل وتعمل على تهميش روايةِ المختلفِ في داخل الهوية وتتجاهلها، ولا تمتنع عن تسويغ العنف الرمزي والجسدي ضدَّه في بعض الحالات. وحذفُ ذاكرة التنوع والتعايش في إطار الاختلاف داخل المجتمع في الماضي، واستحضارُ صورةٍ واحدةٍ للهوية لا غير. وبذلك تختزل الهويةُ المغلقةُ الماضي في ذاكرةٍ أيديولوجيةٍ، تنتقيها مما تتمناه وترغب فيه، وتستبعد ما لا ترغب فيه. في ضوء ذلك تكون الذاكرةُ الحقيقيةُ مزيجًا من الحقيقة والتأويل، وهو تأويلٌ بمعنى إعادة بناءٍ، لكن الذاكرةَ الأيديولوجية الموجَّهة لا تحرص على اكتشاف الحقيقة، قدر حرصها على توجيه الذاكرة لبناء روايةِ هويةِ جماعةٍ عن ماضيها، بحيث يجري توظيف الروايةِ بالكيفية التي تفرضها الأيديولوجيا.
الإنسانُ المغتربُ يتصرَّفُ بذاكرةِ الألمِ فيعيدُ تشكيلَها، بعد حذفٍ وإضافاتٍ يُمارسُها متخيِّلُه، في ضوءِ رغباتِه وأمانيه، بكيفيةٍ يحدثُ فيها تلاعُبٌ في الذاكرةِ بالخلاصِ من صُوَرِ آلامِ الأمس، وابتكارِ ذاكرةٍ تختزنُ صورًا جميلةً للماضي، إذ يجري إعادةُ خلقِ الذاكرةِ، فبدلًا من كونِها منبعًا للألمِ والإحباطِ تصيرُ منبعًا للثقةِ والأملِ. ويتَصاعدُ الحنينُ حدَّ الشغفِ بالماضي، بنحوٍ يُضيِّعُ الوعيَ النقديَّ، ويُعطِّلُ التساؤلَ، ويُعيدُ خلقَ الذاكرةِ ويستبدلُها بما يتمنَّى أن تكونَ عليه. عندما تنغلقُ الهويةُ تنظرُ لذاتها بوصفِها نهائيةً كاملةً مكتفيةً بنفسِها، وتُعيدُ صياغةَ ماضيها وحاضرِها، بحيثُ ترى ذاتَها على الدوام؛ إما متفوِّقةً على غيرِها أو مظلومةً مضطهَدةً، وكأنْ لا شيء آخرَ في تاريخِها سوى كونِها بطلةً، أو ضحيةً لأعداءَ متربصينَ بها، وتَخترعُ حكاياتٍ متنوِّعةً لكيفيةِ تآمرِ أولئك الأعداءِ عليها. يحرصُ على صناعةِ هذه الحكاياتِ وترويجِها الزعماءُ المستبدُّون وأجهزتُهم الدعائيةُ الفعّالةُ، بغيةَ تبريرِ استبدادِهم وتكريسِه، وخَلعِ المشروعيةِ على قمعِهم. وتَحتجبُ خلفَ ذلك مختلِفُ العواملِ الداخليةِ للإخفاقِ والفشلِ، فلا يُفكَّرُ في أثرِ الاستبدادِ السياسيِّ والدينيِّ، ولا في مصادرةِ حرياتِ وحقوقِ المواطنينَ، ولا في تفشِّي القيمِ والتقاليدِ المتحجِّرةِ، ولا في شيوعِ الأميةِ والتجهيلِ والتخلُّفِ.
ويجري تلاعُبُ الهويةِ المغلقةِ بالذاكرةِ بكيفيةٍ تُعلي من قيمةِ كلِّ شيءٍ ينتمي إليها، وتنتقصُ من قيمةِ كلِّ شيءٍ ينتمي لغيرها، فتعمدُ إلى حذفِ المظالمِ والهزائمِ من تاريخِها، وتضخيمِ الانتصاراتِ والإنجازاتِ وتصويرها بشكلٍ مُبهِر، وإعادةِ إخراجِها بشكلٍ يجعلُها تتنكَّرُ للواقعةِ المدونةِ في المراجعِ التاريخيةِ المتاخمةِ لعصرِها، وكثيرًا ما تنتقلُ الواقعةُ من كونِها حادثةً وقعت في زمانٍ ومكانٍ معينٍ وتلتحقُ بالأساطيرِ، يراها أتباعُ الهويةِ المغلقةِ بوصفِها مفارقةً لعصرِها ومتعاليةً على التاريخِ، وذلك ما يتجلَّى في الوقائعِ التاريخيةِ التي تَقترنُ بطولتَها بشخصياتٍ دينيةٍ في مختلفِ الأديانِ.كلُّ هويةٍ يَخترعُ متخيِّلُها أساطيرَها الخاصةَ، ويتمادى متخيِّلُها في افتعالِ ما يريدُ أن يراه من صورٍ مبهجةٍ لهويتِه المترسِّبةِ في أعماقِه. كل هوية يخترع متخيلها أساطيرها الخاصة، ويتمادى متخيلها في افتعال ما يريد أن يراه من صور مبهجة لهويته المترسبة في أعماقه.
تعملُ الهويةُ المغلقةُ على إعادةِ خلقِ ذاكرةٍ موازيةٍ لها، تَنتقي فيها من كلِّ شيءٍ، في تاريخِها وتراثِها، ما هو الأجملُ والأكملُ، ولا تكتفي بذلك، بل تَسلُبُ ما يمكنُها من الأجملِ والأكملِ في تاريخِ وتراثِ ما حولَها، فتستولي على ما هو مضيءٌ فيه. يَجري كلُّ ذلك في ضوءِ اصطفاءِ الهويةِ لذاتِها، لذلك تَعمَدُ إلى حذفِ كلِّ خساراتِ الماضي وإخفاقاتِه من ذاكرةِ الجماعةِ، ولا تتوقَّفُ عند ذلك، بل تسعى لتشويهِ ماضي جماعاتٍ مجاورةٍ لها، والتكتُّمِ على مكاسبِها ومنجزاتِها عبرَ التاريخِ.
#عبدالجبار_الرفاعي (هاشتاغ)



ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
الكاتب-ة لايسمح
بالتعليق على هذا
الموضوع
|
نسخة قابلة للطباعة
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

|
حفظ
 |
بحث |
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
| إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الهوية في حالة صيرورة وتشكّل
-
تمركزُ الهوية الاعتقادية في الدرس الفلسفي كفٌّ عن التفلسف
-
فاعلية الحُبّ تتجلى في الصفح
-
حُبّ الله يجعل الدين دواء وشفاء
-
الحُبّ يهزم قلقَ الموت
-
يتسع القلب للرحمة كلما اتسع بالمحبّة
-
السلفية حالة متفشية في كلِّ الأديان والمذاهب
-
إيمان الحُبّ يُطهِّر الأرضَ من الكراهية
-
الحُبّ ضرب من انكشاف الوجود
-
مَن يُلهِم المحبّة لغيره يعيش بسلام
-
يترجم القلبُ كلمات الحُبّ بمعنى واحد
-
يبقى الكاتب كاتبًا ما دام يفكر ويقرأ
-
قراءة تبعث المسرات وأخرى تثير الاكتئاب
-
الكتب التي توقظ الوعي نادرة
-
في الفلسفة كلُّ شيء يخضع لمُساءَلة العقل ونقده
-
الجيل الجديد أثمن رأسمال بشري
-
نفيُ الفلسفة ضربٌ من التفلسف
-
مكافأة الحب الحب ذاته
-
العقل يخضع لمساءلة العقل
-
شخصيات طفيلية بثياب قديس
المزيد.....
-
الشيخ نعيم قاسم: الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعبت دورًا أس
...
-
بنغلاديش.. طارق رحمن يتعهد بالإصلاح والجماعة الإسلامية تَعد
...
-
بوتين يوجه رسالة تهنئة إلى الرئيس الإيراني بمناسبة الذكرى ال
...
-
محامي إبستين يهدد بمقاضاة باسم يوسف.. فما السبب؟
-
رئيس حزب الجماعة الإسلامية يقر بهزيمته في انتخابات بنغلاديش
...
-
إفتاء مصر تدخل على خط جدل -نجاة أبوي النبي محمد-.. وهذا رأي
...
-
في الجمعة الأخيرة قبل رمضان.. تشديدات أمنية واقتحامات واسعة
...
-
جدل كسوة الكعبة: ملفات تكشف إرسال آثار من أقدس المقدسات الإس
...
-
رسالة قائد الثورة الإسلامية إلى مؤتمر -شهداء الأسر الغرباء-
...
-
بسبب تضامنها مع فلسطين.. إقالة عضوة في لجنة الحرية الدينية ب
...
المزيد.....
-
رسالة السلوان لمواطن سعودي مجهول (من وحي رسالة الغفران لأبي
...
/ سامي الذيب
-
الفقه الوعظى : الكتاب كاملا
/ أحمد صبحى منصور
-
نشوء الظاهرة الإسلاموية
/ فارس إيغو
-
كتاب تقويم نقدي للفكر الجمهوري في السودان
/ تاج السر عثمان
-
القرآن عمل جماعي مِن كلام العرب ... وجذوره في تراث الشرق الق
...
/ مُؤْمِن عقلاني حر مستقل
-
علي قتل فاطمة الزهراء , جريمة في يترب
/ حسين العراقي
-
المثقف العربي بين النظام و بنية النظام
/ أحمد التاوتي
-
السلطة والاستغلال السياسى للدين
/ سعيد العليمى
-
نشأة الديانات الابراهيمية -قراءة عقلانية
/ د. لبيب سلطان
-
شهداء الحرف والكلمة في الإسلام
/ المستنير الحازمي
المزيد.....
|
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

 |
بحث
|
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
|
إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة