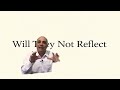أحمد الجوهري
مهندس مدني *مهندس تصميم انشائي* ماركسي-تشومسكي|اشتراكي تحرري
(Ahmed El Gohary)



الحوار المتمدن-العدد: 8311 - 2025 / 4 / 13 - 20:47
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
عنوان المشهد: "بيت الأب الغائب"
المكان:
فناء شرقي قديم، يتوسطه شجرة زيتون وارفة الظلال وكراسي حجرية مرتبة على شكل دائرة. وعلى حجرٍ مركزي منقوش عبارة: "من هنا بدأ كل شيء".
الشخصيات:
عامر (الأخ الأول): يرتدي ثيابًا بسيطة ويحمل لفافة قديمة ومجموعة مفاتيح.
نائل (الأخ الثاني): يرتدي وشاحًا أحمر ويحمل كتابًا بفن تصميمه الراقي.
سالم (الأخ الثالث): يرتدي الثوب الأبيض ويحمل كتيبًا صغيرًا منقوشًا بنقوش ذهبية.
الحوار:
عامر (بنبرة يقينية):
"أنا أول من سار على درب أبيه. فقد سلمني مفاتيح البيت بنفسه، وهمس لي قائلاً: هذه أمانة تحفظها لك ولذريتك. "
نائل (بابتسامة خافتة):
"لكنَّك نسيت أن أبيه كان يخاطبنا بلغة لا يفهمها الجميع. فقد رأيت ما وراء الكلمات... كان يحب السرد أكثر من القواعد. حتى بعدما رحل، ترك لي تذكارًا لا يستطيع أحد التدخل فيه: رقعة مُضيئة بنوره."
سالم (بصوتٍ هادئ عميق):
"وإياكما أن تنسيا أنّه عاد بي في النهاية ووصلني نسخة من كلماته، نقية غير مُلوّنة؛ فقال لي: احفظ هذا وأنقله. وقد أنجزت ذلك."
عامر (باندفاع):
"أنجزت؟! هو من ترك لي مفاتيح البيت! فكيف تُسَلِّم مفاتيح بيت لمن لم يُحضر بعد؟"
نائل (بهدوء بدأ يرتجف):
"وإن كان لديك مفاتيح، لكنك تجهل الباب الذي تنتمي إليه... فماذا لديك؟ ذكرى أم معنى؟"
سالم (بصرامة):
"أنا أمتلك خريطةً كاملةً؛ لا رموزًا، لا أحاجي، ولا تفسيرات متناقضة."
(يسود الصمت لبرهة، ثم يضحك عامر بخفة قائلاً:)
"أنتم لطفاء، مادام لم يُتَهم أحدٌ بأن مفاتيحي مُزيفة."
نائل (رافعًا حاجبه):
"وما دام لم يُتَهم أحدٌ بأن الرقعة خرافية."
سالم (بنظرة ثاقبة):
"وما دام لم يُتَهم أحدٌ بأن الخريطة مرسومة بيد بشرٍ، لا بيده."
(يعمُّ السكون من جديد، ثم يسمع صوت خافت يأتي من داخل الشجرة قائلاً:)
"هل رأيتموه؟ هل سمعتم صوته؟ هل تأكدتم أنه هو؟"
(يرد الثلاثة معًا بنبرات مختلفة:)
عامر: "بإحساس."
نائل: "بحكاية."
سالم: "بعلامة."
(ينتهي الحوار بصمتٍ يُعبّر عن انفصال طرقهم، فيخرج كلٌ منهم من الفناء عبر مخرجٍ مختلف، بينما تبقى الشجرة شاهدةً على ذلك بتلك النقشات: "كان هنا... وربما لا.")
المقدمة
تُعدُّ الظاهرة الدينية من أقدم تجليات الفكر الإنساني، إذ سعت البشرية منذ القدم إلى شرح الطبيعة ومصيرها عبر الأساطير والقصص التي حملتها الأجيال. ومن بين هذه الظواهر تبرز مفاهيم النبوة والإله الإبراهيمي التي تشكل جوهر الديانات السماوية الثلاث. ومع ازدياد التساؤلات حول مصداقية هذه القصص، برزت دراسات تشير إلى أن الشخصيات النبوية التي تُنسب إليها هذه القصص قد لا تكون موجودة تاريخيًا، وأن الروايات المقدسة قد استمدت الكثير من رموزها وسردها من أساطير حضارات قديمة مثل سومر وبابل ومصر. تهدف هذه الورقة إلى تقديم نقد موضوعي يتناول النبوة والإله الإبراهيمي عبر منظور عقلاني ومنطقي، مع تسليط الضوء على الأدلة المادية والتاريخية، وكذلك الاستشهاد بالأبحاث التي يقترحها الباحثان فراس سواح وخزعل الماجدي.
الإطار النظري والمراجع
يشكل النقد العلمي للدين مجالًا يتقاطع فيه التاريخ والفلسفة والأنثروبولوجيا وعلم الآثار. ومن أبرز الأفكار التي تطرحها الدراسات الحديثة أن النصوص المقدسة ليست سوى تراكمٍ ثقافيٍّ تعبيريّ يهدف إلى تأليف صورة رمزية للمصدر الإلهي والنبوة، بدلاً من كونها وثائق تاريخية دقيقة. وفي هذا السياق، تناول باحثون مثل فراس سواح (سواه، 2008) وخزعل الماجدي (الماجدي، 2010) مسألة أصول القصص الدينية للإبراهيمية، حيث أشار كلاهما إلى أوجه الشبه البليغة بين سرديات هذه الكتب والأساطير الموجودة في حضارات سومر وبابل ومصر القديمة. وقد تبين أن الكثير من الرموز والقصص قد تم إعادة صياغتها لتناسب السياق الاجتماعي والسياسي لكل فترة زمنية.
نقد مفهوم النبوة من منظور تاريخي
يرتكز مفهوم النبوة تقليديًا على الاعتقاد بأن الأنبياء هم وسيلة لتلقي الوحي الإلهي؛ إذ ينقلون الرسالة التي لا تعبر عن إرادة الإنسان أو تأويلاته الذاتية. ومع ذلك، يشير النقد الحديث إلى أن عدم وجود أدلة أثرية ونصية تؤكد الوجود التاريخي لهذه الشخصيات يضع تساؤلات جدية حول مصداقيتها. فمن جهة، يعتمد الباحثون في هذا المجال على منهجيات النقد النصي وتحليل المخطوطات القديمة؛ ومن جهة أخرى، تُظهر الدراسات العلمية أن الأدلة المادية التي يُستند إليها إثبات وجود الأنبياء غالبًا ما تكون عرضة للتأويل والاعتماد على مصادر ثانوية ومناقضة. إن غياب الأدلة التاريخية القاطعة يثير تساؤلات حول صحة الروايات التي ترتكز على الإيمان الذاتي والتجربة الرمزية بدلاً من الوقائع التاريخية المثبتة.
استقراء القصص الدينية وأصولها في الحضارات القديمة
يشير البحث المقارن في التراث الديني إلى أن الكثير من القصص الدينية التي تتواجد في الكتب الإبراهيمية قد استُخدمت فيها عناصر سردية ورمزية من أساطير حضارات ما قبلية. ففي حضارة سومر القديمة، على سبيل المثال، توجد قصص عن آلهة خلق العالم والإنسان بأسلوب سردي قد يشبه إلى حد بعيد الروايات التكوينية الموجودة في سفر التكوين. كما أن حضارات بابل ومصر قد ازدهرت أساطيرها التي تُعنى بموت وبعث الآلهة، وإعادة إحياء القوى الكونية، وهو ما يظهر جليًا في بعض معجزات الأنبياء وقصصهم في النصوص المقدسة.
وقد أوضح الباحث فراس سواح في دراسته أن العديد من الرموز والقصص الموجودة في كتب إبراهيمية لها أصول مشتركة مع الأساطير السومرية، حيث تُظهر تعايشًا بين العناصر الدينية والرمزية التي تعكس احتياجات مجتمعية معينة في مراحل تطور الحضارة. وأكد أن استخدام القصص كوسيلة لتفسير الظواهر الطبيعية والأحداث الكونية لم يكن حكرًا على الديانات الإبراهيمية، بل إنه امتداد تقليدي لأسلوب سردي موجود منذ القدم.
من جهته، تناول الباحث خزعل الماجدي مسألة تشابه القصص الدينية مع الأساطير المصرية القديمة، حيث وجد أن العديد من رموز التنجيم والبعث والموت والقيامة تم استعارتها وإعادة تشكيلها لتخدم أهدافًا دينية واجتماعية مختلفة. إن هذه الاستعارات المشتركة بين الحضارات تشير إلى أن النصوص المقدسة قد شُكّلت في سياق تبادل ثقافي واسع ولا يمكن اعتبارها وثائق تاريخية بحتة.
مناقشة وتحليل الأدلة المادية والنقد العقلاني
من منظور التحليل العقلي والمنطقي، نجد أن الاعتماد الكلي على النصوص الرمزية دون دعمها بالأدلة المادية يُضعف من قابليتها على أن تُعامل كأدلة تاريخية مباشرة. إذ يتطلب التحليل العلمي أن تكون هناك معطيات أثرية ونصوصية يمكن التحقق منها عبر منهجيات البحث العلمي. إلا أن ما يُعرض من أدلة حول الشخصيات النبوية غالبًا ما يكون مبعثرًا وغير موثق بشكل كافٍ، مما يفضي إلى اعتبارها نتاجاً من الخيال الجمعي والاحتياجات النفسية والاجتماعية لفترات معينة من التاريخ.
وفي ضوء هذا التحليل، يبرز تناقضٌ رئيسيٌ يكمن في أن القصص الدينية تقوم على فرضية التداخل بين الأبعاد الروحية والرمزية وبين التجربة الواقعية المادية. ومن هنا، يقدم النقد العقلاني تفسيرًا يقول بأن الإنسان اللاإيماني يميل إلى استبدال التجربة المادية بعملية تأويلية، بحيث يتحول الدين إلى لغة رمزية تعبّر عن معانٍ اجتماعية وإنسانية عميقة، لا يمكن اختبارها أو قياسها بالأدوات العلمية التقليدية.
تداعيات عدم الوجود التاريخي للأنبياء
إن الدراسات الحديثة التي ناقشت عدم الوجود التاريخي للأنبياء تتجلى في محاولات نقدية متعددة تناولت النصوص المقدسة بأساليب تحليلية حديثة. وأشارت بعض الأعمال الأكاديمية إلى أن عدم وجود أدلة أثرية تدعم الوجود الفعلي لهذه الشخصيات يُضعف من مصداقية الروايات التي تُعتبر مصدر الإيمان لدى أتباع الديانات السماوية. ويُظهر هذا الوضع أن ما يُعرض من قصص الأنبياء هو في كثير من الأحيان سرد رمزي تُبنى عليه محاولات لتفسير الظواهر الطبيعية والوجود الكوني من خلال إطار قصصي متداخل مع الأساطير القديمة.
وعلى الرغم من أن بعض الباحثين يدافعون عن فكرة أن النصوص المقدسة تحمل معانٍ عميقة لا يمكن الاستغناء عنها لفهم البُعد الروحي لدى الإنسان، إلا أن الأدلة التاريخية والأثرية التي تُثبت الوجود التاريخي للأنبياء لم تكن مرضية بالشكل الكافي. ويترك هذا الفارق مجالًا كبيرًا للتأويل، مما يجعل النقاش حول مدى دقة الروايات الدينية أمرًا لا يزال محل خلاف ونقاش في الأوساط الأكاديمية.
الخاتمة
خلصت هذه الورقة إلى أن تحليل الظاهرة الدينية ومفهوم النبوة والإله الإبراهيمي من منظور تاريخي وعقلي يكشف تناقضات وإشكاليات أساسية تتعلق بمصداقية النصوص المقدسة. إذ تشير الأدلة المادية والتاريخية إلى أن الكثير من القصص التي تتردد في كتب إبراهيمية ليست سوى نسخ معدلة من أساطير حضارات قديمة مثل سومر وبابل ومصر، كما يُظهر بحث فراس سواح وخزعل الماجدي. ويؤكد هذا النقد أن الاعتماد على النصوص الرمزية وحدها لا يمكن اعتباره دليلًا تاريخيًا قاطعًا، بل يُظهر أن الدين يتشكل من تفاعل معقد بين الثقافة والاحتياجات النفسية والاجتماعية للإنسان.
إن هذا النقد لا يهدف إلى الإساءة إلى قناعات المؤمنين، بل هو دعوة للتفكير النقدي والبحث العلمي الذي يستند إلى الأدلة الموضوعية والمنهجيات التجريبية. إذ يجب على الباحثين والمفكرين أن يسعوا جاهدين لإعادة قراءة التراث الديني في ضوء المعطيات الحديثة، وأن يتبنى منهجيات تحليلية شاملة تدمج بين الحس الإنساني والعقلانية العلمية. وبذلك يكون من الممكن تقريب الصورة إلى فهم أعمق ليس فقط للمعتقدات الدينية، بل للأسس الثقافية التي قامت عليها الحضارات الإنسانية.
وفي الختام، يبقى السؤال حول صحة وجود الأنبياء ورواياتهم الموضوعية قضية مفتوحة تتطلب مزيدًا من البحث والدراسة. إن التقدم في مجالات علم الآثار والتاريخ قد يوفر في المستقبل معطيات إضافية تساعد على بناء صورة أكثر وضوحًا عن تلك الحقبات التاريخية، لكن ما يظهر حتى الآن هو أن الكثير من القصص الدينية تظل روايات رمزية تعبر عن تجارب إنسانية عميقة ولا يمكن نسبها بشكل مباشر إلى وقائع تاريخية مثبتة. ومن هذا المنطلق، فإن إعادة تقييم التراث الديني بأسلوب علمي منهجي هو السبيل الأمثل للارتقاء بالمستوى الفكري والثقافي للمجتمعات المعاصرة.
#أحمد_الجوهري (هاشتاغ)


 Ahmed_El_Gohary#
Ahmed_El_Gohary#



ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

 |
بحث
|
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
|
إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة