أسئلة الديمقراطية في الوطن العربي في عصر العولمة(الفصل السادس)
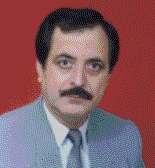
منذر خدام
الحوار المتمدن
-
العدد: 8331 - 2025 / 5 / 3 - 11:28
المحور:
قضايا ثقافية
الفصل السادس
الديمقراطية: ضرورتها وممكناتها في الدول العربية.
1-الديمقراطية والأسئلة الصعبة (بديهية القبول والتقبل).
يكاد يقارب البديهة تقبل الديمقراطية والدعوة إليها في جميع دول العالم، ولا يشذ عن ذلك الدول العربية، خصوصا، بعد زوال الاتحاد السوفيتي ومنظومته الاشتراكية. وبالفعل فقد تسارعت حركة الانتقال إلى النظام الديمقراطي على الصعيد العالمي، في أوربا الشرقية، وفي أفريقيا، وأسيا، وأمريكا اللاتينية. ونظرا للصخب الذي رافق، ولا يزال يرافق عمليات التحول هذه، التي لا تخلو من الاستعراض سواء في الإعلام، أو في الخطاب السياسي، أو في التطبيق، أخذت تتداخل في الوعي العام، وفي الوعي السياسي، وحتى في الفكر النظري، الأسئلة المتعلقة بالديمقراطية، وعمليات الانتقال والتحول إلى الأنظمة الديمقراطية، نجم عن ذلك نوع من التبسيط، والاستسهال، والتسرع في الإجابة عنها.
مثلا كيف يمكن الانتقال إلى النظام الديمقراطي في ظروف التبعية، أو في البلدان التي لم يبلغ تطور الرأسمالية فيها المستوى الضروري الذي يسمح بتوطين الديمقراطية؟ يلح هذا السؤال كون الديمقراطية تعبير عن نمط الحياة السياسية للرأسمالية الصناعية.
ثم كيف يمكن لقوى اجتماعية تنتمي في مجملها سواء من ناحية التكوين، أم من ناحية الوضعية، إلى مجتمعات ما قبل الرأسمالية، أي إلى المجتمعات العضوية، القبلية، أو العشائرية أو الطائفية، أن تحتضن الديمقراطية؟
بعبارة أخرى ما هي الكتلة التاريخية التي يمكن أن تنجز عمليات الانتقال والتحول الديمقراطي في ظروف التخلف؟ وهل صار الخيار الديمقراطي خيارا لا رجعة عنه فعلا في وطننا العربي؟
من الواضح أننا إزاء عملية معقدة جدا يتداخل فيها النظري والعملي، المحلي والعالمي، العقلاني والعاطفي، ما هو رأسمالي وغير رأسمالي لتجعل أسئلتها مركبة ومتداخلة وأجوبتها معقدة لا تقبل القطع بها، بل فقط النسبية والاحتمالية.
فالقول مثلا أن الديمقراطية لا يمكن بناؤها في ظل التبعية يفنده الواقع من ناحيتين على الأقل: من ناحية أن العولمة التي تزيد من الاشتراط المتبادل بين جميع دول العالم وبين الوحدات البنيوية المكونة للنظام الرأسمالي هي عملية موضوعية من يحاول وضع نفسه خارجها، على افتراض أن هذا ممكن، يحكم على نفسه بالموت الحضاري. ومن جهة ثانية إن ما يجري واقعيا في جميع دول العالم من تحول باتجاه الديمقراطية يجري في إطار عمليات الاندماج المتسارعة الجارية عالميا، وليس من خارجها أو على الضد منها. السؤال الحق في هذا المجال ليس هو كيف نخرج من إطار العولمة، وما تفرضه من علاقات تبعية، بل أن نجعل التبعية متبادلة، والاشتراط المتبادل يتحرك في اتجاه واحد، وليس في اتجاهين مختلفين.
كذلك القول بأن الديمقراطية هي وليدة النظام الرأسمالي الصناعي، وبالتالي لا يمكن أن تطبق إلا في المجتمعات التي أنجزت ثورتها الصناعية، كما هو الحال في الدول الأوربية ومثيلاتها من الدول المتقدمة، تكذبه واقعة أن الهند التي تعيش نظاما ديمقراطيا مستقرا، بل أكبر نظام ديمقراطي في العالم، لم تكن قد أنجزت ثورتها الصناعية ولم تنته منها بعد. كما أن هناك دول عديدة أنجزت ثورتها الصناعية منذ زمن، لكنها لم تتحول إلى الديمقراطية إلا في الفترة الأخيرة، مثل كوريا الجنوبية والعديد من دول جنوب شرق أسيا، وأمريكا اللاتينية.
كما أن القول بأن الديمقراطية بحاجة إلى بنية اجتماعية انصهاريه تختفي منها البنيات الأهلية القائمة على العلاقات الشخصانية، أو بالحد الأدنى اضمحلال دورها الاجتماعي لصالح مؤسسات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية والنقابات، تخالفه الوقائع في العديد من الديمقراطيات الأوربية، وفي الهند التي تمثل بحق أنموذجا محرجا للتنظيرات الغربية المتعلقة بالديمقراطية. فليس كل ما هو أهلي يتناقض مع الديمقراطية. ربما هناك نوع من التنظيمات الأهلية التي لا تتوافق مع الديمقراطية، وتحول دونها، أو تعيقها، وهي تلك التي تدخل مع غيرها في علاقات تحديد على قاعدة النفي. بمعنى أن وجودها يتحدد من خلال نفيها لغيرها، أو تميزها عنها على قاعدة الهيمنة. أما التنظيمات الأهلية التي تقوم بينها علاقات ندية يتحدد من خلالها وجود أي منها بوجود الآخر فهي تدعم الديمقراطية ولا تنفيها أو تعيقها.
ثم هل يمكن اعتبار الديمقراطية سلعة قابلة للاستيراد والتصدير، كما في العديد من التنظيرات العالمثالثية؟ ألا يجب النظر إليها كصيرورة؟ بكلام آخر هل المطلوب ديمقراطية ناجزة وكاملة، أم هوامش للحرية والديمقراطية، يمكن البناء عليها وتطويرها مع تعمق التحولات المدنية المصاحبة؟ ثم ما هي الضمانات أن لا تظل الهوامش الديمقراطية، التي يمكن أن تسمح بها الأنظمة الحاكمة، مجرد هوامش شكلية تعيد إنتاجها باستمرار.
الأسئلة السابقة المشحونة بالشك، وغيرها كثير، لا يجوز النظر إليها على أنها أسئلة تعجيزية تدفع باتجاه اليأس، أو أنها من نوع الأسئلة التي لا تخاطب واقعا معينا، ومتميزا. بل على العكس تماما، يكفي أن ننظر في واقعنا العربي لنشاهد نموذجا مشخصا تسائله ولديه الأجوبة عنها. ما نود التأكيد عليه قبل البحث في ممكنات الديمقراطية في الدول العربية هو أن أية إجابة عن الأسئلة السابقة، وغيرها مما له علاقة بالديمقراطية، لا بد أن تنبع من الواقع المشخص، وليس من خلال النظرة التأملية المجردة، التي اختبرناها في الخطاب القومي، وفي الخطاب الماركسي، ونختبرها الآن أيضا في الخطاب الديني المستنفر، وجرّت علينا ولا تزال مزيدا من الفشل والإحباط.
2- الديمقراطية وطبيعة المرحلة الراهنة في الدول العربية.
إن سؤال طبيعة المرحلة الراهنة في الدول العربية يتضمن إحالة الديمقراطية إلى شروطها الواقعية، كما تتحدد في المرحلة التاريخية على أعتاب القرن الواحد والعشرين، لتبحث عن ممكناتها فيها، وعن الكتلة التاريخية التي يمكن أن تتولى إنجاز هذه المهمة التاريخية.
في ظروف العالم الثالث، وفي ظروف البلدان العربية، لا يزال سؤال طبيعة المرحلة هو نفسه تقريبا كما طرحته أوربا منذ قرون، وأجابت عنه منذ قرون أيضا. وهو السؤال عينه الذي طرح في الوطن العربي منذ نحو قرن من الزمان، لكنه لم يجب عنه بعد.
تتحدد طبيعة المرحلة في الدول العربية بأنها مرحلة وطنية ديمقراطية، يتحدد جوهرها في إزاحة كاملة للبنى الفكرية والاجتماعية والاقتصادية الإقطاعية أو الكولونيالية من المجتمع، لصالح نشر وتعميم البنى الرأسمالية محلها، كقواعد أساسية لاشتغال النظام. الطابع العام لهذه المرحلة هو الصراع بين الميول والاتجاهات الوطنية والقومية من جهة، والنزعات اللاإنتمائية أو الكولونيالية من جهة أخرى. الأولى تؤسس للاستقلال الوطني بالمعنى التاريخي، أما الثانية فإنها تؤسس للاغتراب عن الوطن وتاريخه وقضاياه، وتعزز التبعية وحيدة الاتجاه، وبالتالي تبقيه في دائرة التخلف.
في ضوء ما تقدم يمكن رؤية ثلاث محاور رئيسية تخترق كامل الزمن البنيوي للمرحلة الوطنية الديمقراطية هي التالية:
أ-محور التنمية الاقتصادية: يتطلب إنجاز المهام المتعلقة بهذا المحور تطوير قوى الإنتاج الاجتماعي، وبناء الهياكل الاقتصادية المناسبة، مع مراعاة العلاقات الفنية والتوازنية في داخل الفروع الاقتصادية، أو فيما بينها، وإقامة توازن دقيق ومحسوب بين دائرة الإنتاج ودائرة الاستهلاك، بين رصيد التراكم ورصيد الاستهلاك، وربط الاستهلاك بالقوة الإنتاجية المحلية بالدرجة الأولى، والاستفادة القصوى من مصادر التراكم المحلية والإقليمية والدولية، وتعميم العقلانية الاقتصادية بما يحقق النماء الاقتصادي. إن تحقيق المهام السابقة الذكر سوف يخلق اقتصادا ديناميا مندمجا بالاقتصاد العالمي، ومتفاعلا معه، على قاعدة التكيف المتبادل يستفيد من الاتجاهات الاندماجية العالمية ويفيدها أيضا.
ب-محور التنمية الاجتماعية والسياسية والثقافية. على هذا المحور تتوزع مهام عديدة متشعبة لكنها مترابطة نذكر منها ثلاث عناوين رئيسة هي:
1-العدالة الاجتماعية 2- الديمقراطية 3- الثورة الثقافية.
لقد ادت العدالة الاجتماعية على امتداد التاريخ المعروف دورا رئيسا في الصراعات الاجتماعية الطبقية، وسوف تظل تؤدي هذا الدور في المستقبل. إنها أحد المحركات الرئيسة للتقدم الاجتماعي، مع أن شكل الصراع الذي يسببه فقدانها، والدور الذي بؤديه في التقدم الاجتماعي يختلفان من عصر إلى آخر، ومن مرحلة إلى أخرى من مراحل التطور العام، أو الخاص بهذا البلد أو ذاك. ما يهمنا التذكير به في هذا الموضع هو أن العدالة الاجتماعية التي تحرك نضال فئات وطبقات اجتماعية عديدة وواسعة في الوطن العربي في المرحلة الوطنية الديمقراطية لا تتطلب بالضرورة إلغاء الاستغلال الناجم عن النشاطات الاقتصادية الطبيعية المطابقة للرواج النظامي لرأس المال، بل إلغاء الأشكال الاستغلالية الطفيلية وتلك التي تتحقق بالوسائل السياسية. إن المطالبة بإلغاء الاستغلال في الرأسمالية مسالة غير منطقية وغير واقعية.
من جانب آخر فإن العدالة الاجتماعية الممكنة في المرحلة الوطنية الديمقراطية مدعوة إلى توزيع القيمة المنتجة الجديدة (الدخل الوطني) بصورة عادلة حسب مساهمة عوامل الإنتاج فبها. هذا يعني إقامة توازن دقيق بين الطبقات والفئات الاجتماعية، الأمر الذي يمكن تحقيقه عن طريق سيادة القانون وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة أو المؤسسات الاقتصادية وتعميم الضمان الاجتماعي واحترام حقوق المواطنين في العمل والحياة وتفعيل منظماتهم المدنية. باختصار لا بد من إقامة توازن دقيق بين مجال العدالة الاجتماعية ومجال التقدم الاجتماعي مع تامين أرجحية نسبية للتقدم الاجتماعي على أن يتحقق هذا التوازن بالوسائل الاقتصادية من ضرائب وأجور وريوع وأسعار وأرباح وغيرها وهذه الوظائف يمكن أن يقوم بها النقد بامتياز.
العنوان الثاني يتعلق بالديمقراطية وإشاعتها في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية. في هذا الصدد يمكن القول دون مبالغة أن إنجاز مهام المرحلة الوطنية الديمقراطية بشكل سليم يتوقف إلى حد بعيد على تعميم الديمقراطية في جميع مجالات الحياة الاجتماعية، وفي المقدمة منها في المجال السياسي. الديمقراطية كما نفهمها تمثل الأوالية العامة لحل التناقضات في المجتمع وخلق التوليفات المناسبة بينها وإيجاد أفضل تقاطع ممكن واقعيا بين القوى الاجتماعية الفاعلة في التقدم الاجتماعي. إنها المناخ الذي تتنفس فيه مبادرات وإبداعات الشعب وبدونها يكاد يختنق.
العنوان الثالث يتعلق بالثورة الثقافية. الثقافة للتقدم الاجتماعي كالماء للسمك. ليس من ظاهرة اجتماعية إلا ولها إطارها وفضاؤها الثقافي ولها مقدماتها الثقافية أيضا. من غير الممكن تجاوز أي شيء في الواقع الاجتماعي، إلا إذا تحقق حد معين من تجاوزه على صعيد الفاعل الاجتماعي، أي حصول تغير مناسب في وعيه يجعله يعرض الموضوع الذي يود تجاوزه كأطروحة أيديولوجية (مشروع)، ومن ثم يعمل على تحقيقه." لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ". ونظرا لأن التغير والتغيير عملية مستمرة في الزمن فإن الثورة الثقافية مستمرة أيضا تغير وعي الناس فتغير واقعهم الاجتماعي في عملية تفاعلية دائرية مستمرة.
ت- المحور الثالث هو المحور الوطني والقومي. على هذا المحور تتوزع مهام تحرير الأرض وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق الدولة القومية.
إن المسالة القومية، وفي القلب منها تحقيق الوحدة العربية، عليها أن تتقدم في جدول الأعمال للحركة الاجتماعية والسياسية العربية، ليس لأنها حق من حقوق الأمة في قيام دولتها بل لأنها المجال الحيوي للتنمية الوطنية والقومية، المستقبل هو للتكتلات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة. من خلال ذلك وحده يمكن الحديث عن الاستقلال الوطني والقومي بالمعنى التاريخي، الاستقلال الذي يعيدنا للمساهمة من جديد في الحضارة العالمية كفاعلين لا منفعلين، نتبادل التأثير والتأثر مع غيرنا من الشعوب.
لا شك أن العقبات التي تحول دون تحقيق الوحدة العربية كبيرة وعديدة. فليست خافية على أحد الميول والنزعات المعادية، والمعاكسة لها، سواء في داخل كل بلد عربي أم فيما بين الدول العربية. مع ذلك لا بديل عن الوحدة للحفاظ على مستقبل الأمة وان العمليات الجارية موضوعيا على الصعيد العالمي والعربي سوف تدفع العمل العربي الاجتماعي والسياسي في هذا الاتجاه.
إذا كانت الوحدة العربية ضرورة موضوعية في منطق التاريخ خلال المرحلة الوطنية الديمقراطية يقدمها كمهمة في جدول أعماله، إلا أنه على ما يبدو لا يطرحها بشكل محدد ولا يشير إلى مداخل أو أولويات معينة كأفضليات للإنجاز، ولا يحدد طريقا معينة لإنجاز كل ذلك. هذا لا يدعو للاستغراب فعملية التوحيد القومي عملية معقدة جدا تتدخل فيها مصالح عديدة منها ما هو محلي، ومنها ما هو عالمي، منها ما هو معادي لها بشكل سافر، ومنها ما هو معادي لها بشكل مستتر، وحتى في أوساط مؤيديها ثمة اختلاف وتباين حولها.
وعلى خلاف الخطاب الوحدوي السابق، الذي ما كان ليرضى بأقل من تهديم أسس الدولة القطرية ليبني على أنقاضها الدولة القومية، نرى أن الوحدة المنشودة عليها أن تحافظ على الدولة القطرية إلى أجل غير معروف، وليس من الضروري التكهن به. وان الطريق إلى الوحدة يمكن أن يبدأ بمشروع اقتصادي مشترك بين دولتين أو أكثر، أو بتكتل اقتصادي على شكل سوق حرة أو سوق مشتركة، وصولا إلى تحقيق نوع أو شكل من أشكال التوحيد القومي السياسي. ومما لا شك فيه أن تحقيق الوحدة القومية العربية سوف يستغرق زمنا طويلا قد تسارع إليه بعض الأقطار العربية، وقد تتباطأ أقطار أخرى، لكن في النهاية لا بديل عن الوحدة القومية إلا الموت الحضاري، فقاع التاريخ مليء بأنقاض الأمم والشعوب.
بقي أمر واحد في هذا المجال لا بد من التأكيد عليه باعتباره المسرع الأقوى لعمليات التوحيد القومي والكفيل وحده بالمحافظة عليها ألا وهو الديمقراطية. من المعلوم أن الخطاب الوحدوي السابق تعددت اشتراطاته، مرة يشترط لتحقيق الوحدة تحرير فلسطين ومرة أخرى يشترط لذلك بناء الاشتراكية. فلم تتحقق الوحدة ولا تحققت اشتراطاتها لسبب بسيط هو أن الخطاب الوحدوي كان فوقيا لم يشرك القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة الحقيقية في الوحدة في عملية صنعها والحفاظ عليها.
وعندما نشترط لقيام الوحدة تعميم الديمقراطية (مع أنها يمكن أن تتحقق بدونها) فلأنها تمثل المناخ الأفضل الذي تعبر فيه ومن خلاله مختلف القوى الاجتماعية والسياسية عن مصالحها الحقيقية وتدافع عنها ومنها مصلحتها في الوحدة. الديمقراطية تجعل الوحدة قريبة من وعي الشعب قائمة على دعائم قوية من المصالح الطبقية والوطنية والقومية.
أما فيما يتعلق بالكتلة التاريخية التي سوف تنجز مهام المرحلة الوطنية الديمقراطية وفي المقدمة منها مهمة الديمقراطية، نقول بإيجاز إنها تشمل جميع طبقات وفئات المجتمع باستثناء الشرائح البيروقراطية والطفيلية والكمبرادورية من البرجوازية. هذا لا يعني أن وعي ضرورة إنجاز الديمقراطية أو العمل الفعلي في سبيلها هو واحد عند مختلف الفئات الاجتماعية، بل على العكس هناك اختلاف بين وواضح في دور كل منها في العملية التاريخية الجارية في سبيل الديمقراطية. اللافت في الموضوع أن البرجوازية التي يعتبر المشروع الديمقراطي هو مشروعها التاريخي هي من أقل الفئات الاجتماعية احتضانا للديمقراطية كمشروع، بل هي التي تقف، في الغالب الأعم، خلف الأنظمة الدكتاتورية الحاكمة في الدول العربية، تدعمها وتحافظ على استمراريتها. بينما الفئات الأكثر نشاطا في مجال الدعوة للمشروع الديمقراطي والعاملة في سبيله هي الفئات المثقفة والطلاب والشرائح المدينية من البرجوازية الصغيرة.
3- الديمقراطية في تشريعات الدول العربية
التأسيس القانوني للديمقراطية في الدول العربية ليس وليدة اليوم بل له تاريخ يعود به إلى نحو قرن من الزمن. ففي مصر صدر القانون الأساسي للدولة لأول مرة في عام 1883، وفي عام1913 صدر أول دستور فيها يقوم على أساس نظام المجلسين وقد حكمت حكومة الوفد بموجبه. وفي عام 1923 صدر دستور جديد وسَّع كثيرا من صلاحيات الجمعية التشريعية، لكنه لم يلبث أن عُدل في عام 1930 (1)
وفي سورية صدر أول دستور في عهد الحكم الفيصلي في عام 1920 وكان يتضمن 148 مادة تحدد بناء الدولة الملكية وصلاحيات مستويات الحكم المختلفة فيها بالإضافة إلى حقوق المواطنين والجماعات وعلاقاتهم فيما بينهم، أو في علاقاتهم بالدولة، على أساس مبدئي الحرية والمساواة في إطار القانون. وقد فصل الدستور بالحقوق والحريات الممنوحة للمواطنين بحيث شملت حرية المعتقد وحرية الاجتماع وإنشاء الجمعيات والمنظمات الاجتماعية والسياسية المختلفة. كما نص الدستور على حرية المعتقد وحرية الصحافة والحق بالتعليم وغيرها. لكن مع دخول الفرنسيين إلى سورية واحتلال دمشق في العام نفسه بعد معركة ميسلون في 25 تموز1920 ألغت السلطات الاستعمارية دستور عام 1920، لتعود فتسمح بصدور دستور جديد في عام 1926 صادقت عليه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الدجاني، أحمد صدقي،" تطور مفاهيم الديمقراطية في الفكر العربي الحديث " في أزمة الديمقراطية في الوطن العربي(بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية،1987) ص133.
1928 الجمعية التأسيسية المنتخبة. وفي عام حاولت الجمعية التأسيسية تطوير هذا الدستور فأصدرت دستورا بديلا عنه عارضته السلطات الاستعمارية ولم تعترف به. وفي عام 1943 أعيد إصدار دستور جديد أقره المجلس النيابي المنتخب وكان مؤلفا من115 مادة خلت جميعها من أي حقوق، أو مزايا انتدابية، وشكل في حينه تأسيساً دستوريا لمرحلة الاستقلال. ومنذ عام1949 وحتى عام 1958 بدلت سورية دستورها ثلاث مرات. ففي عهد حسني الزعيم تم إلغاء دستور عام 1943، وفي عهد الحناوي وضع دستور1950، الذي ألغاه بدوره الشيشكلي، واستبدله بدستور جمهوري رئاسي عام 1953، وبسقوط الشيشكلي تم العودة إلى دستور عام 1950، الذي بقي معمولا به حتى قيام الوحدة مع مصر في عام 1958.
وكان لبنان أقرب الدول العربية إلى سورية وأكثرهم تأثرا بما كان يجري فيها لذلك شكل الدستور السوري في عام 1926 أساس الدستور اللبناني الذي صدر بعده.
وفي الأردن صدر أول قانون أساسي لدولة شرق الأردن في طور التشكيل عام 1928، وبعد قيام مملكة شرقي الأردن صدر دستور جديد لها في عام 1946 (2)
وفي العراق وضع دستور في عام 1943 من قبل جمعية تأسيسية وظل معمولا به حتى عام 1958حيث ألغاه عبد الكريم قاسم.
هذه إرهاصات مبكرة للخيار الديمقراطي في الدول العربية، سرعان ما تحولت بعد الحرب العالمية الثانية وخصوصا في العقدين الأخيرين من القرن العشرين إلى ظاهرة عامة في جميع الدول العربية تقريبا. فلا يخلو بلد عربي في الوقت الراهن من وجود قانون أساسي للدولة (دستور) تحدد فيه هياكل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الدجاني، أحمد صدقي " تطور مفاهيم الديمقراطية في الفكر العربي الحديث"، مرجع سبق ذكره، ص134.
الدولة والسلطة وصلاحياتها، وحقوق المواطنين. وبدأت بعض الدول العربية تأخذ بالنظام التمثيلي، وتجري انتخابات دورية للهيئات التشريعية، وتسمح بوجود الأحزاب السياسية والنقابات والتنظيمات الأهلية والمدنية الضرورية للحياة الديمقراطية. ونتيجة للتطور المتفاوت بين الدول العربية، واختلاف الظروف الموضوعية والذاتية يلاحظ تقدم الخيار الديمقراطي في بعض الدول العربية أكثر من غيرها. ففي مصر ولبنان والكويت على سبيل المثال يتقدم الخيار الديمقراطي بصورة أكثر رسوخا. في مصر يتقدم الخيار الديمقراطي بسبب حجم السكان الكبير، وإنجاز مصر لثورتها الصناعية وتحقيق الانصهار الاجتماعي على أسس مدنية.
أما لبنان، فهو البلد العربي الوحيد، الذي استمرت فيه الحياة الديمقراطية دون انقطاع منذ استقلاله، بسبب تركيبته الطائفية والحكم القائم على التوازن بين الطوائف.
وللسودان، أيضا، تاريخ في مجال الديمقراطية والارتداد عليها، فهي لم تغب خلال وجوده المستقل عن الصراعات الاجتماعية والسياسية الجارية فيه.
وفي الكويت، للديمقراطية حضور في الوعي العام، وفي الممارسة، وتحوز القبول من مختلف قطاعات المجتمع.
وفي الأردن بدأت الديمقراطية تتقدم بخطى واثقة وكذلك الحال في المغرب العربي وفي الجزائر وفي تونس. وأخيرا أخذت الديمقراطية تشق طريقها في اليمن وموريتانيا وجيبوتي وفي البحرين. وحتى في سلطنة عمان والإمارات وقطر بدأت تتشكل فيها مجالس استشارية وأجرت جميعها نوع من انتخاب المجالس البلدية. وفي السعودية البلد العربي الأكثر محافظة في المجال السياسي أنشئ مجلس استشاري، وثمة دعوات متزايدة إلى مزيد من الانفتاح.
وفي الأنظمة "القومية" التي يوجد فيها دساتير وهياكل تمثيلية شكلية كما في سورية والعراق وليبيا تطرح الآن وبقوة قضايا التجديد والتغيير.
اللافت في هذا الخصوص ما يجري في سورية في عهد بشار الأسد من دعوات إلى الإصلاح والتطوير والتجديد واحياء مؤسسات المجتمع المدني وإلغاء حالة الأحكام العرفية، وهي دعوات تصدر عن السلطة الحاكمة كما تصدر عن القوى الاجتماعية والسياسية سواء أكانت في موقع الموالاة أم في موقع المعارضة.
لا شك بأن ثمة فارقاً كبيراً بين ما يعلن ويوثق من حقوق ديمقراطية في الدساتير والقوانين وما يطبق منها فعلا، مما يجعل من هذه المكتسبات الديمقراطية المنصوص عنها، مجرد مكتسبات شكلية بلا مضمون حقيقي. هذه المفارقة بين الدعوة إلى الخيار الديمقراطي من قبل جميع القوى الاجتماعية، كل على طريقته، وبين ما يمارس في الحياة الواقعية، لا يغير من حقيقة أن هناك ظاهرة آخذة في التوسع والتعمق هي ظاهرة التحول من الأنظمة الاستبدادية المغلقة، ملكية كانت أم جمهورية، باتجاه أنظمة أكثر مرونة وأكثر انفتاحا وأكثر تقبلا لشكل أو لآخر من أشكال الديمقراطية الواقعية تراعى فيه أكثر فأكثر حقوق الإنسان، ويسود فيه حكم القانون والمؤسسات، وربما يتحقق فيها قريبا تبادل للسلطة بصورة سلمية عبر صناديق الاقتراع.
4-وعي الديمقراطية مقدمة لإمكان تحققها.
لقد دخلت الديمقراطية في بنية الوعي العام، في جميع الدول العربية تقريباً، منذ بداية ما اصطلح عليه بعصر النهضة العربية تحت مسميات مختلفة، واكتسبت زخما بعد الحرب العالمية الثانية لتصبح مألوفة تحوز على التقبل والمطالبة لدى مختلف الفئات الاجتماعية كل من موقعه الطبقي وفي إطار منظومته الأيديولوجية وعلى طريقته.
وكما بحثنا في الثقافة العربية الإسلامية وكيف أنها حاولت استيعاب الديمقراطية وبيئتها المفهومية من خلال المنظومة الفكرية التراثية الإسلامية، وما خلصنا إليه من أن هذه البنية الفكرية تظل محكومة بثنائية الإيمان والكفر، لكنها مع ذلك ليست مغلقة تماما، بل تحاول أن تنفتح على المنظومات الفكرية الأخرى، وعلى ما يحصل حولها من تغيرات وتطورات، وان قابليتها للانفتاح والتكيف تظل ،مع ذلك، مرهونة بعمق التحولات المجتمعية وبضغط القوى الديمقراطية الأخرى في المجتمع، وبمدى اتساع هوامش الحرية التي تتيحها الأنظمة العربية. نعود الآن لاستقصاء وعي الديمقراطية عند التيارات الفكرية الأخرى وخصوصا عند التيار الماركسي والتيار القومي وكيف تنزاح العوائق هنا أيضا لتفسح المجال أمام تقدم الخيار الديمقراطي.
4-1-وعي الديمقراطية لدى الحركة الشيوعية والماركسية العربية.
لقد ادى الفكر الماركسي والحركات الاجتماعية والسياسية التي عملت تحت رايته دورا مهما في الحركة النهضوية والتنويرية العربية خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية. بل كان له التأثير الأبرز على الحركات الثورية العربية ذات الاتجاه القومي، فانعكس ذلك في طراز الدولة التي بنتها بعد استلامها للسلطة، وفي التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي أنجزتها.
في هذا المبحث سوف نناقش مفهوم " دكتاتورية البروليتاريا " باعتباره ركنا أساسيا في النظرية الماركسية، يحدد رؤيتها للسلطة والدولة، وشكل أساسا للأنظمة الشمولية التي بنتها الأحزاب الشيوعية، فيما كان يعرف بالمعسكر الاشتراكي. ومع أن هذه الرؤية يمكن اعتبارها محجوزة ومتجاوزة بالمعنى التاريخي، وان العديد من الحركات والأحزاب الشيوعية والماركسية قد تخلت عنها رسميا، فإنه لا يمكن بناء رؤية ماركسية جديدة للديمقراطية بدون نقد هذا المفهوم الأساس في النظرية الماركسية.
يشير ماركس في إحدى رسائله إلى أن مساهمته الرئيسية في مجال الصراع الطبقي تتلخص في برهانه على تاريخيته، وان النضال الطبقي سوف يفضي موضوعيا إلى دكتاتورية البروليتاريا، وان هذه الدكتاتورية نفسها لا تعني غير الانتقال إلى القضاء على كل الطبقات والوصول إلى المجتمع الخالي من
الطبقات (3)
لقد استند ماركس في برهانه على دكتاتورية البروليتاريا على تحليله لكيفية اشتغال القوانين الاقتصادية الرأسمالية التي تفضي موضوعيا إلى تشكيل طبقتين متضادتين مبدئيا: الطبقة البرجوازية وطبقة العمال الأجراء. وان سيرورة الطبقة الأولى سوف تفضي موضوعيا إلى تلاشيها التدريجي في حين أن سيرورة الطبقة الثانية تقود موضوعيا إلى توسعها المستمر وعند نقطة معينة من المسار العام للتاريخ سوف تتحول إلى الطبقة الأمة.
إن تحليل ماركس واستنتاجاته من الناحية النظرية تبدو متماسكة منطقيا فالطريقة التي تشتغل بها القوانين العامة للحراك الاجتماعي ومنها القوانين الاقتصادية تؤدي فعلا إلى إزاحة مستمرة للعمل الحي من دائرة الإنتاج، بل ومن الدوائر الأخرى لاستهلاك قوة العمل وذلك نتيجة الثورة العلمية والتكنولوجية المعاصرة. وعلى المدى البعيد يمكن توقع وضعية اجتماعية جديدة نوعيا يصبح الانقسام الرئيس فيها هو بين وقت العمل ووقت الراحة وليس بين من يملك وسائل الإنتاج ومن لا يملك.
لكن ما لم يقله ماركس (وما كان باستطاعته أن يقوله آنئذ) هو كيف سوف تتحقق هذه الصيرورة الموضوعية على الصعيد السياسي والأيديولوجي؟ وفي أية وضعية بنيوية سوف تكون هذه الطبقة الأمة؟ ونظرا لأن ماركس كان رجل علم فإنه لم يعط أجوبة على أسئلة لم تطرحها الحياة بعد، بل لم يقطع بأجوبة عن أسئلة هي بطبيعتها احتمالية. فعندما سئل عن بناء الدولة في ظل الاشتراكية أجاب بأن العلم هو الكفيل بالإجابة عن هكذا سؤال في المستقبل فقد تأخذ الكثير من مكونات الدولة التي بنتها البرجوازية. لكن الذي حصل لا حقا في عهد لينين صاحب نظرية "الاحتراف الثوري"، أو في عهد ستالين باني الدولة المركزية الشمولية هو، ليس فقط تجاوزاً لأفكار ماركس، بل اعتبار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3-رسالة ماركس إلى يوسف فيديماير 5/3/1852.
النموذج السوفييتي، هو النموذج الاشتراكي السليم الذي يجب الاقتداء به. وكالعادة فإن الماركسيين العرب الذي وعوا الماركسية بصورة تأملية، وبحكم استسهال تبني النماذج الجاهزة، فقد تم استحضار طراز الدولة السوفييتي كما هو، وروجوا له في منطقتنا العربية، وعندما تبنت الحركات القومية الثورية هذا النموذج كان من أول ضحاياه الشيوعيين أنفسهم.
يقوم النموذج السوفييتي للحكم على أساس فصل الديمقراطية بالمعنى الاجتماعي والاقتصادي عن الديمقراطية بالمعنى السياسي، الأمر الذي قضى على الاثنين معا، وكرس الحزب الشيوعي القوة السياسية الوحيدة في البلدان الاشتراكية السابقة. في ظل هذه الوضعية جرى بناء اكثر الدكتاتوريات شمولية في التاريخ المعاصر، الدولة تقف في مواجهة جميع فئات الشعب بما فيهم العمال أنفسهم، وحتى الحزب الشيوعي نفسه تحول إلى مجرد جهاز من أجهزتها.
لقد سببت الدكتاتورية الشمولية في البلدان الاشتراكية السابقة أضرارا كبيرة بقضية تطور هذه البلدان من خلال كبت التناقضات الاجتماعية ومنعها من التعبير عن نفسها بصورة سليمة.
ولم يكن الحال أفضل من ذلك في البلدان المتخلفة التي استلهمت النموذج الاشتراكي السابق، فلم يتم إنجاز مهام المرحلة الوطنية الديمقراطية، فتعمق اغتراب المواطن عن وسائل إنتاجه، بل عن وطنه أيضا.
ماذا كانت نتيجة التصورات الأيديولوجية السابقة في الحقل السياسي؟ إن الإلغاء التعسفي للأحزاب السياسية، التي هي شكل ضروري للوجود المجتمعي في ظل الرأسمالية، يمارس المجتمع من خلالها حياته السياسية، ألحق ضرراً كبيراً بقضية التقدم الاجتماعي، وأربك الحياة السياسية ومهد الطريق أمام قيام الدكتاتوريات الشمولية.
إن وجود الآخر المختلف عنك سياسيا يشكل حدا معياريا لمصداقيتك السياسية، وهو ضروري للبناء الاجتماعي السليم، ولحراكه التطوري الداخلي، ويحصن المجتمع ضد الأخطار في اللحظات الانعطافية الحادة. من هذا المنطلق لا يجوز القبول بالدكتاتورية مهما تم تزيينها أيديولوجيا، بل بالديمقراطية الشاملة. لذلك فإن القضية التي يجب طرحها في الوقت الراهن هي الجمع بين الاشتراكية والديمقراطية، فشعار" المزيد من الاشتراكية يعني المزيد من الديمقراطية " له ما يبرره في البلدان المتقدمة، لكنه شعار خاطئ في الدول المتخلفة. هنا يصح رفع شعار آخر هو " مزيدٌ من الديمقراطية يعني مزيداً من التقدم الاجتماعي والعدالة الاجتماعية ".
وهكذا، ونتيجة للتحولات الكبيرة التي جرت على الصعيد العالمي، وفشل النموذج السوفييتي، فقد أزيحت عقبة كبيرة من أمام وعي ضرورة الديمقراطية لدى قطاع هام جدا من شعبنا العربي، وخصوصا لدى الفئات الأكثر فاعلية منه، أعني لدى المثقفين والطلبة والأحزاب الشيوعية والماركسية والقومية. لم يعد النموذج السوفييتي ملهما لها، كما أن العديد منها وصل إلى استنتاج هام مفاده أن الاشتراكية ليست قضية راهنة في ظروف التخلف، بل تطوير قوى الإنتاج وإنجاز الإنماء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الشامل في إطار من العدالة الاجتماعية الممكنة هي القضية الملحة. مهمة بهذا الحجم تحتاج إلى جهود جميع فئات المجتمع وطبقاته وأفراده خصوصا في ظروف العولمة.
وانزاحت عقبة كبيرة أخرى أيضاً من أمام تقدم الخيار الديمقراطي، نتيجة لسقوط المنظومة السوفييتية، فانفك الحصار عنه في البلدان المتخلفة، التي شكلت في حينه ميدانا رئيسيا للصراع بين الكتلة السوفييتية والمعسكر الرأسمالي الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. فمن جهة لم يعد الاتحاد السوفييتي قائما، وبالتالي فإن احتمال سعيه لإنشاء أنظمة شمولية حليفة له لم يعد قائما أيضا.
ومن جهة ثانية لم تعد المصالح الغربية والأمريكية عموما في خطر جدي يهددها مما كان يدفعها إلى دعم وتشجيع الأنظمة الدكتاتورية.
هذا في الإطار العام أما ما يتعلق بالمنطقة العربية وكما ذكرنا سابقا لا تزال الدوائر الغربية والأمريكية منها على وجه الخصوص متحفظة تجاه دعم الخيار الديمقراطي بشكل جدي، لما تتوقعه من احتمال تهديد مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، لذلك نراها تميل إلى دعم الأنظمة القائمة مع تشجيعها للقيام ببعض الرتوش الديمقراطية، هنا وهناك، بالقدر الذي يفرغ الاحتقانات القائمة ويصرفها باتجاهات غير ضارة بمصالحها السياسية أو الاقتصادية. لذلك نعود فنؤكد مرة ثانية على أن الخيار الديمقراطي في الوطن العربي هو خيار وطني لا يستطيع أن يعول كثيرا على العوامل الخارجية، إلا من ناحية واحدة، وهي المتمثلة موضوعيا في التحولات الديمقراطية المتسارعة على الصعيد العالمي مما يفسح المجال أمام فئات اجتماعية أوسع لتتقبل الخيار الديمقراطي عن طريق استلهام ما يجري في مناطق أخرى في العالم.
4-2- وعي الديمقراطية لدى الحركات القومية والليبرالية.
لقد شكلت المطالبة بالدستور إلى جانب المطالبة بالاستقلال شعارات الحركة الوطنية العربية خلال النصف الأول من القرن العشرين. ففي العراق وحسب استفتاء أجرته السلطات البريطانية في عام 1918 حول مطالب الشعب العراقي جاء الجواب في العديد من المدن العراقية بالمطالبة بالاستقلال وبحكم وطني مقيد بمجلس نيابي منتخب. وكان موضوع الحكم الوطني الديمقراطي في العراق مطلبا رئيسيا في برامج الأحزاب العراقية التي عملت على استقلال العراق (4)
وفي مصر جرى تحالف بين القوى الوطنية والديمقراطية في عام 1919 على أساس أن الديمقراطية هي وسيلة تحقيق الاستقلال، كما أن الاستقلال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4 -البصير، محمد مهدي، " تاريخ القضية العراقية " (بغداد، الناشر المؤلف،) ص 192.انظر أيضا جميل، حسين، "حقوق الإنسان في الوطن العربي: المعوقات والممارسة " في أزمة الديمقراطية في الوطن العربي" ندوة، (بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،1987) ص 520.
يحافظ على الديمقراطية (5). وفي المغرب تم ربط الكفاح من اجل الاستقلال الوطني بالكفاح في سبيل الديمقراطية (6) وتتكرر المشاهد نفسها في سورية وفي لبنان وفي غيرها من الدول العربية الأخرى. مع ذلك لم يستطع هذا الشعار أن يشغل حيزا مناسبا في الوعي العام وفي الوعي السياسي منه على وجه الخصوص بصورة مستقرة، نظرا لطبيعة القوى الاجتماعية التي كانت ترفعه، وضغط المجتمع الريفي على المجتمع المديني الذي هو نفسه لم يكن قد أعيد بناؤه وهيكلته على أسس وطنية انصهاريه بسبب التخلف الاقتصادي والاجتماعي.
وإذا جاز لنا الحديث عن وجود تيار ليبرالي في الحركة السياسية والفكرية في ذلك الوقت، فهو على وجه القطع لم يكن أصيلا ولا متمكنا من فكره الليبرالي الذي استلهمه بطريقة تأملية من خلال انفعاله بالفكر الليبرالي الأوربي، ولم يكن واثقا من إمكانية تطبيقه في ظروف اجتماعية واقتصادية مختلفة لا تزال في المرحلة ما قبل الصناعية، ولم يتم إنجاز الدولة القومية بل ولم تكن الدولة القطرية قد استقرت بعد. ونتيجة لدور الدول الاستعمارية الأوربية في تفتيت الوطن العربي وزرع الكيان الصهيوني في القلب منه، فقد كان الخطاب الليبرالي محرجا ومحاصرا، وقد استغل دعاة الفكر القومي هذه الحالة للربط بينه وبين الاستعمار مما جعل المطالبة بالديمقراطية الليبرالية نوعا من الدعوة إلى عودة الاستعمار من جديد، وبهذا الشكل تم الإجهاز عليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5-البشري، طارق "ثلاث ملاحظات عن الديمقراطية "(القاهرة، الفكر المعاصر العدد 2) ص 69
6-غلاب، عبد الكريم" التجربة الديمقراطية في المغرب "الملحق الثقافي لمجلة العلم (21/11/1980)
لقد كانت أولويات الحركات القومية تتمثل في تحقيق الوحدة العربية وتحرير فلسطين وإنجاز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقصر وقت ممكن، ولم تكن من بينها مسألة الديمقراطية السياسية وتوسيع مشاركة الناس في الحياة السياسية تحظى بأي اهتمام. ومن اللافت أن الحركات القومية الأكثر شعبية في الوطن العربي، أي حزب البعث العربي الاشتراكي والحركة الناصرية كانت الأشد عداء للفكر الليبرالي وللديمقراطية السياسية، وتعزز لديها ذلك خصوصا بعد أن استلمت زمام الحكم في اكثر من بلد عربي، وذلك من جهة بسبب تبنيها للنموذج السوفييتي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء الدولة، ومن جهة ثانية بسبب الدور الحاسم للعسكر فيها. لذلك لا يستدعي الاستغراب أن يستطيع رجل مثل السادات ومن قلب الحركة الناصرية أن ينقض عليها بسهولة ويسر، وأن ينتهك أقدس المقدسات لدى الحركات القومية عموما، ولدى الحركة الناصرية خصوصا، أعني زيارة القدس المحتلة وإبرام اتفاق سلام مع الكيان الصهيوني بعد الانتصار الذي حققته الجيوش العربية في حرب تشرين في عام 1973، متخليا له عن جميع المكتسبات السياسية والعسكرية التي تحققت بنتيجة تلك الحرب.
ومع أن طروحات التغيير بدأت تصدر عن فئات اجتماعية وسياسية مختلفة بعد هزيمة النظام السياسي العربي في حزيران عام 1967 وأخذت تركز على ضرورة الديمقراطية، إلا أن الأنظمة القومية على وجه الخصوص لم تستطع أن تتوصل إلى الاستنتاجات المناسبة، فزادت من مركزية الحكم ووسعت من دور الدولة وأجهزتها الأمنية تحت ذريعة تحرير الأرض وإزالة أثار العدوان الإسرائيلي. لكن وبنتيجة التحولات التي جرت إلى الصعيد العالمي في العقدين الأخيرين من القرن العشرين وبعد انخراط جميع الدول العربية في عملية التسوية مع الكيان الصهيوني، ارتفعت الأصوات المطالبة بالتغيير حتى من داخل الأنظمة العربية ذاتها. وأخذت المطالب الجماهيرية تركز على ضرورة احترام حقوق الإنسان وتوسيع مشاركة المواطنين في الحياة السياسية وتوسيع الهوامش الديمقراطية. واصبح من المألوف أن تبادر الأنظمة العربية من تلقاء ذاتها أو تحت ضغط الحركة الجماهيرية إلى إجراء تحولات ديمقراطية، وتحول ذلك في العقد الأخير من القرن العشرين إلى ظاهرة عامة على امتداد الوطن العربي. لقد أصبحت المطالب الديمقراطية تتقدم الخطاب السياسي للحركات الاجتماعية والسياسية العربية بغض النظر عن الراية الأيديولوجية التي تتحرك تحتها قومية كانت أم ماركسية أم دينية أم ليبرالية بحيث يصدق القول أننا إزاء عملية تحول جميع الحركات السياسية والفكرية والاجتماعية العربية إلى الليبرالية وان البعض منها قد قطع شوطا بعيدا على هذا الطريق.
سوف نحاول في المبحث التالي رصد وتفحص حضور الهم الديمقراطي في الفكر العربي المعاصر من خلال أراء نخبة من المفكرين العرب من مختلف الاتجاهات السياسية والأيديولوجية، الذي بدوره يعبر أصدق تعبير عن عمق التحولات الليبرالية الجارية بشكل يؤسس لتبيئتها وتوطيدها بصورة لا رجعة عنها.
5- الديمقراطية في الفكر العربي المعاصر
إن البحث في الديمقراطية حسب السيد على الدين هلال هو بحث في طبيعة الدولة، في العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وجوهرها يقوم على المساواة وتوسيع دائرة الحقوق وإشراك الناس في الحياة السياسية (7). لقد قامت الديمقراطية الليبرالية حسب رأيه على عدة أسس منها: التعددية السياسية، وتداول السلطة سلميا، واحترام مبدأ الأغلبية، وقيام دولة المؤسسات والقانون، واقرار الحقوق الفردية للمواطنين (8).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7-هلال، علي الدين "مناهج الديمقراطية في الفكر السياسي الحديث " في ((أزمة الديمقراطية في الوطن العربي ))، ندوة،(بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية ،1987) ص36-38.
8--المرجع السابق، ص 40.
من جهته السيد هشام جعيط يعتبر أن الديمقراطية قديمة في التاريخ وكانت تأخذ صيغة الخطاب الشعبوي للتقرب من الطبقات الشعبية، لذلك لا يجوز حسب رأيه أن تعرف الديمقراطية بدلالة البرجوازية، وليس من المشروع تاريخيا ولا فلسفيا أن تربط الديمقراطية بصفة عضوية جوهرية بها لأنها تتجاوز أفقها التاريخي، وتتأسس على مبادئ أخلاقية وعقلية كالحرية والمساواة وحقوق الإنسان والإرادة العامة. الديمقراطية بهذا الشكل تخترق المجتمعات والقرون فتتجه إلى كل البشر شانها في ذلك شأن كبرى الديانات والأيديولوجيات (9).
وعلى العكس من السيد هشام جعيط الذي ينظر إلى الديمقراطية كقيمة مجردة متعالية عابرة للتاريخ فإن السيد حمد الفرحان والسيدة سعاد الصباح لا يعتقدان بإمكانية قيام ديمقراطية في ظروف التبعية (10)
أما السيد الطاهر لبيب فإنه يؤكد على الطابع النخبوي للديمقراطية، على الرغم من أن الشعب يشكل مادتها المرجعية، ويرى أن خطاب الديمقراطية بحد ذاته هو خطاب نخبوي لأنه خطاب المعرفة التي لا تكون إلا للنخبة ومن هذه الناحية فهو خطاب سلطة (11).
من جهته السيد برهان غليون يرفض إعطاء الديمقراطية تعريفات جوهرية شمولية لأن ذلك لن يقربها من وعي الناس، بل يزيد الأمر صعوبة ويجعل الرهان كبيرا. لذلك يطالب السيد غليون بضرورة النظر إلى الديمقراطية في إطار أقل طموحا وأكثر واقعية وأقرب إلى ما يفهم منها أغلب الناس اليوم. وهو يعتقد أن الديمقراطية ليست الحرية ولا المساواة وإنما ما يحقق الحرية والمساواة، أنها تتعلق أساسا بمسألة السلطة (12).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9-جعيط، هشام، في تعقيبه على علي الدين هلال، المرجع السابق ص 52.و 55
10-الفرحان، حمد، الصباح، سعاد، المرجع السابق، ص 60-61.
11- لبيب، الطاهر، المرجع السابق ً63.
12-غليون، برهان، في "ندوة أزمة الديمقراطية في الوطن العربي " المرجع السابق ص 67.
السيد بسام الطيبي يعتبر الديمقراطية نسقاً خاصاً لتنظيم العلاقات الإنسانية له هياكله السياسية والاقتصادية والاجتماعية تفترض لوجودها بنيات معينة ودرجة محددة من التطور الاجتماعي لذلك فإن غياب الديمقراطية في الوطن العربي يجد تفسيره في سببين:
أ-غياب الأسس الاقتصادية والاجتماعية التي تسمح بقيام مؤسسات سياسية تمكن من ممارسة المفاهيم الديمقراطية.
ب-تفسير وتزييف مفاهيم الحرية التي ظهرت مع الإسلام (الشورى، العدالة، الاختيار) بشكل يتعارض مع هذه المفاهيم (13)
ويؤكد السيد حسن حنفي على أن أزمة الحرية والديمقراطية في وجداننا المعاصر ليست بنت اليوم، بل امتداد لوضع حضاري واستمرار له منذ ما يقارب الألف عام (14)، ولا يمكن الخروج من هذه الوضعية –الأزمة، حسب علي الدين هلال، إلا إذا حدث انقلاب ثقافي في حياتنا العقلية نتخلص بمقتضاه من التصور السلطوي للعالم وان نأخذ الليبرالية في الفكر والحياة (15).
إن غياب الديمقراطية كمؤسسة في التاريخ العربي له تفسيره التاريخي الذي يرتبط بطبيعة الدولة، فالدولة حسب السيد بسام الطيبي لم تكن مؤسسة سياسية تقوم على السلطة المجردة وإنما كانت سلطة عسكرية تبتلع المجتمع. لذلك لا يمكن أن يكون هناك ديمقراطية حين تكون الدولة كل شيء والمجتمع لا شيء (16).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13-الطيبي، بسام " البناء الاقتصادي والاجتماعي للديمقراطية "، في (0أزمة الديمقراطية في الوطن العربي))، ندوة، مرجع سبق ذكره، ص 74.
14-حنفي، حسن "الجذور التاريخية لأزمة الحرية والديمقراطية في وجداننا المعاصر "، في علي الدين هلال وآخرون ((الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي)) سلسلة كتب المستقبل العربي ،4، (بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية ،1983) ص 224.
15-هلال، علي الدين" مقدمة: الديمقراطية وهموم الإنسان العربي المعاصر" المرجع السابق ص17.
16- الطيبي، بسام " البناء الاقتصادي والاجتماعي للديمقراطية "، مرجع سبق ذكره ص 80.
ويبدو أن السؤال الحقيقي الذي يجب أن نتأمله حسب السيد كمال أبو ديب هو: هل الديمقراطية اختيار واع نمارسه، اختيار واع نقوم به، ونقول أن علينا أن نحققه لأننا نريد حياة أفضل؟ أم أن الديمقراطية إفراز تاريخي، حتمية تاريخية تتحقق في شروط معينة نتيجة لنمط البنى السائد في المجتمع ولحركيتها؟ أي البنى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها (17)
وحسب السيد عبد الباقي الهرماسي فإن تقديس الماضي والأصالة من أكبر العقبات أمام تأطير الحرية والقومية ضمن مؤسسات. وإن ربط فكرة الرضى بفكرة تساوي حق كل فرد في المشاركة في إرساء وممارسة السلطة هو الذي سمح بالخصوص باتخاذ النظرية الديمقراطية الحديثة شكلا واضحا وشموليا (18)
ويؤكد السيد عادل حسين على الطابع النخبوي للديمقراطية، الديمقراطية من وجهة نظره هي أسلوب ملائم تدير به النخبة السياسية الذكية مجمل النشاط الاجتماعي للأمة وخاصة نشاطها السياسي، في إطار مؤسسات تضمن استمرار وانتظام الممارسة وتنشيط الحوار والاتصال بين الحاكمين والمحكومين. وبهذا المعنى فإن الديمقراطية كانت موجودة دائما في إحدى صورها قديما وحديثا (19). غير أن بسام الطيبي يعتقد أن الديمقراطية ليست فكرة فحسب بل نسقا اجتماعيا وهي لم توجد قبل العصر الحديث، لا في تاريخنا، ولا في التاريخ الأوربي (20) وحسب سمير أمين فإن المفهوم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
17-أبو ديب، كمال، في تعقيبه على بسام الطيبي، أزمة الديمقراطية في الوطن العربي "ندوة، مرجع سبق ذكره، ص109.
18-الهرماسي، محمد عبد الباقي "القومية والديمقراطية في الوطن العربي " في "أزمة الديمقراطية في الوطن العربي " ،ندوة، مرجع سبق ذكره ،ص 169-170.
19- حسين، عادل، "المحددات التاريخية والاجتماعية للديمقراطية " في "أزمة الديمقراطية في الوطن العربي "،ندوة ، مرجع سبق ذكره، ص206-207.
20- الطيبي، بسام، في " أزمة الديمقراطية في الوطن العربي "، مرجع سبق ذكره، ص336.
البرجوازي للديمقراطية يكاد يكون مرادفا لمفهوم الحرية الفردية في إطار المجتمع الرأسمالي والمساواة القانونية للجميع وعدم تدخل السلطة الحاكمة في ميادين الرأي والحياة الشخصية. ولممارسة هذه الديمقراطية كان لا بد من الانتخابات (21).
ويرى السيد يسين أننا في الوطن العربي نحلم دائما بنموذج ديمقراطي شامل يتكون من ثلاث عناصر أساسية:
- تحقيق الحريات الأساسية للإنسان (مستقاة من النموذج الليبرالي)
- تحقيق العدالة الاجتماعية (مستقاة من النموذج الاشتراكي)
- تحقيق الأصالة الحضارية (مستقاة من النموذج الإسلامي) (22)
هذه عينة قليلة لكنها معبرة عن أراء وتصورات نخبة من المفكرين العرب من اتجاهات أيديولوجية مختلفة تبين كيف أن الهم الديمقراطية أخذ يوحدهم رغم اختلاف زوايا النظر إليه. يبقى أن نجيب بدورنا حول السؤال نفسه ما هي الديمقراطية التي نريد؟
6-الديمقراطية الممكنة والمناسبة في الدول العربية
بداية لا بد من القول أن مفهوم " الديمقراطية " مثله مثل أي مفهوم أخر وثيق الصلة بموضوعه، وعندما يتغير الموضوع تتغير الدلالة الاصطلاحية للمفهوم. وبالنسبة للديمقراطية تحديدا كان ثمة فارق كبير دائما بين الصورة -الحلم لها كمفهوم وبين شكل وجودها الواقعي ولا يزال هذا الفارق موجودا حتى الآن في عصر الرأسمالية العالمية. ربما كان هذا من طبيعة المغامرة الذهنية للإنسان التي تجعله ينسج أحلامه بصورة أكثر كمالا لكن ما إن تستفيق هذه الأحلام في واقع معين حتى تكتشف أن أجزاء منها قد فُقدت. لذلك لا بد من
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
21-أمين، سمير "ملاحظات منهجية حول أزمة الديمقراطية في الوطن العربي "،في( أزمة الديمقراطية في الوطن العربي ) ،مرجع سبق ذكره،ص 307.
22-يسين، السيد ، في "أزمة الديمقراطية في الوطن العربي " ،مرجع سبق ذكره ،ص 339.
التمييز في موضوع الديمقراطية بين مبادئ الديمقراطية، وبين الشكل الذي تظهر به هذه المبادئ في واقع محدد.
على مستوى المبادئ فإننا نرى أن الديمقراطية تتحدد إيجابيا على شكل إعلان مبادئ، يتضمن جميع الحقوق الطبيعية للإنسان من حقوق مدنية وسياسية، واقتصادية واجتماعية، وثقافية، وغيرها من حقوق اشتملت عليها شرعة حقوق الإنسان العالمية التي صادقت عليها أغلب الدول العربية، وقد وجدنا أن الحقوق المدنية والسياسية منها على وجه الخصوص قابلة للتطبيق، ويكاد لا يخلو منها في الوقت الراهن أي دستور من الدساتير العربية عداك عن تبنيها من مختلف القوى الاجتماعية والسياسية المعارضة.
لكن إذا نظرنا إلى هذه المبادئ في إطار الشروط التاريخية القائمة في الوطن العربي فإن الديمقراطية تكاد تتحدد بها سلبا. بمعنى أن الشروط التاريخية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا تزال غير ناضجة لاحتواء الديمقراطية بصورة إيجابية. فالفارق لا يزال كبيرا بين الحديث عن الديمقراطية، أو تبنيها اللفظي، أو الورقي، وبين ما هو قائم منها فعلا. والقياس هنا ليس ما هو موجود في أوربا، بل ما هو معلن ومتبنى في البرامج والمشاريع السياسية، سواء للأنظمة الحاكمة، أم للقوى السياسية المعارضة.
فعلى الرغم من أن أغلب الدول العربية قد قطعت أشواطا على طريق إنجاز التحول الصناعي والتحديث كبيرة جدا بالقياس إلى مثيلتها في بدء الانطلاقة الأوربية، وعلى الرغم أيضا من انتشار التعليم، وانخراط المرأة في العمل العام، وتشكل الهياكل الطبقية، والأحزاب السياسية، والمنظمات النقابية وغيرها، مما يشكل مقدمات أساسية للمشاركة السياسية للمواطنين، إلا أن الديمقراطية لا تزال تتعثر. وإذ تتقدم في هذا القطر العربي أو ذاك، فإنها تتقدم بخطى بطيئة وغير ثابتة، فالارتداد عنها ما زال قائما. إن البحث المعمق عن أسباب ذلك قادنا إلى التشديد على المسائل الثلاث الآتية:
المسالة الأولى ذات طابع تاريخي، بمعنى أن النظر في تاريخنا القديم والحديث يبين لنا أنه تاريخ الدولة المركزية الشمولية، فليس في تاريخنا تقاليد ديمقراطية يعتد بها.
المسألة الثانية تتعلق بطبيعة البنية المجتمعية ذاتها. فالنظر إلى الديمقراطية من زاوية أشكال الوجود الاجتماعي القائمة يبين أنها لاتزال تتحدد بها سلبا. فالمصالح الاجتماعية والطبقية والفئوية وحتى الفردية منها تشترطها المحددات الطائفية أو المذهبية أو القبلية أو العشائرية أو الجهوية أو الإثنية، أي كل ما ينتمي إلى العلاقات الشخصانية ويعززها. بكلام آخر إن نمو العلاقات الرأسمالية في البلدان العربية لم يصهر البنية المجتمعية على قاعدة وطنية بسبب الطابع الخاص للرأسمالية الطرفية وشروط تصير الطبقات الاجتماعية والأحزاب السياسية والنخب الاجتماعية والحضور الكثيف للتراث في الوعي الاجتماعي العام. لذلك كله لا تزال مجتمعاتنا تفتقر إلى الندية في العلاقات القائمة بين مختلف أشكال الوجود الاجتماعي، ولا تشترط بعضها بعضا بصورة إيجابية، بل سلبيا، أي أن كل منها يحاول نفي الآخر لكي يؤكد وجوده، ويدافع عن مصالحه. إن منطق المساومات التاريخية والحلول الوسط لا يزال غريبا عن مجتمعاتنا إلى حد بعيد.
المسألة الثالثة وتتعلق بالطابع العسكري للعديد من الأنظمة الحاكمة. من حيث المبدأ يبرز الدور السياسي للعسكر في ظروف التخلف وهو ليس سلبيا على طول الخط، غير أنه في منطقتنا العربية يكاد يكون حاسما في جميع المجالات وخصوصا في المجال السياسي، ويغلب عليه الطابع السلبي بصورة عامة.
لقد تهيأت فرصة تاريخية وربما نادرة لكي تؤدي القوى العسكرية، وغير العسكرية دورا إيجابيا في نهضة العرب وتقدمهم، تمثلت في التحدي الصهيوني المباشر لها في عقر دارها وأمام أنظارها. لكن بدلا من العمل على امتلاك عناصر القوة بالمعنى العام والشامل؛ أي الحضاري وبالأخص منها إعادة النظر في البناء الاجتماعي، والحياة السياسية، وطراز الدولة القائمة، بما يخلق الأطر المناسبة للتقدم الصناعي والتنمية الشاملة، فإنها عملت على تدعيم أركان الأنظمة الحاكمة، و تعظيم الدور الأمني للسلطة، مما خلق في المحصلة مناخاً ملائما لانتشار الفساد وتعميمه، وغياب المحاسبة، وتراجع الاهتمام بالقضايا الوطنية والقومية. وأبلغ مثال على ذلك المواقف المتفرجة للحكومات العربية، على شعبنا العربي الفلسطيني وهو يذبح بساطور الجلاد، دون تقديم الدعم المطلوب له، وهو في متناول اليد.
ومما يزيد المسألة تعقيدا وإشكالية هو أن المصالح الإمبريالية في منطقتنا لا تتعارض مع البنى الاجتماعية القائمة ولا مع طراز الحياة السياسية السائدة، وليس لها حساسية خاصة تجاه العسكر.
إن تجاوز هذا الواقع الموضوعي المعقد، لا يكون إلا من خلال الديمقراطية، وهذا بدوره يتطلب وعيا استثنائيا من قبل النخب السياسية الوطنية والحركات الجماهيرية، وتفعيل التحولات الجارية في المنطقة العربية على طريق الديمقراطية، بحيث تصبح عضوية لا رجعة عنها. لكن ذلك سوف يطرح بإلحاح تساؤلات عدة حول نوع الديمقراطية المطلوبة والطريق إلى تحقيقها وبأية وسائل.
بداية لا بد من التشديد على أن الرهان على تأمين الشروط الموضوعية للديمقراطية، من حيث إنجاز الانقلاب الصناعي بالمعنى التاريخي، وتحقيق التنمية الشاملة هو رهان بلا جدوى في ظروف العولمة، لأن المدخل إلى ذلك قد اختلف باختلاف الشروط، والظروف التاريخية.
في البلدان الأوربية تكفلت حركة رأس المال بصهر البنية الاجتماعية وإعادة تشكيلها على أسس وطنية جديدة، أي أن المصالح الاقتصادية، وما نسجته من علاقات وروابط في المجتمع لعبت الدور الحاسم في إزاحة البنى الاجتماعية الاقتصادية الإقطاعية، وكل ما ينتمي إلى ما قبل الرأسمالية، من حقل الممارسات السياسية، أو أضعفت دورها في الحياة السياسية العامة.
لكن في ظروف التخلف عموما وفي ظروف البلدان العربية خصوصا فإن الرهان الأكبر هو على دور العامل السياسي في إنجاز مهام المرحلة الوطنية الديمقراطية، وخلق الظروف التي تجعل الديمقراطية تتحدد إيجابيا. بكلام آخر إن الديمقراطية هي المدخل الوحيد السليم لإعادة بناء المجتمع على أساس من المصالح الموضوعية، التي تتلاءم مع منطق التاريخ في هذه المرحلة، بدلا من العلاقات والروابط الشخصانية. وكلما تعززت الديمقراطية في المجتمع كلما خلقت إمكانيات أكبر لاستنهاض مختلف القوى الاجتماعية لتلعب دورها في التنمية الشاملة وإنجاز مهام التحرير وتحقيق الوحدة القومية.
لكن مَنْ سوف يُقنع مَنْ بضرورة هذا المدخل الديمقراطي لإنجاز هذه المهام الوطنية والقومية الكبيرة؟ وعلى افتراض أن هنالك قوى اجتماعية وسياسية ترفع راية التغيير الديمقراطي، وهي قوى موجودة فعلا، سواء في موقع السلطة والحكم، أو في موقع المعارضة، فإن من أولى واجباتها أن تحاول إقناع القوى الاجتماعية والسياسية الأخرى، وخصوصا تلك التي في موقع الحكم أن مصالحها لن تتهدد في ظروف الديمقراطية.
وثانيا؛ عليها أن تتبع نهجا تكتيكيا حوارياً، ومتدرجا، في خطابها السياسي الموجه إلى الأنظمة الحاكمة، يركز أكثر ما يركز، على ضرورة احترام حقوق الإنسان، والحريات العامة، وعلى توسيع الهوامش الديمقراطية التي منحتها الأنظمة ذاتها، وأن تتخلى عن الخطاب التخويني التكفيري، الذي لا طائل منه، ولسان حالها يردد " لعلى قريشاً تدرك أن مصالحها هي في الإسلام ". وفي هذا المجال يمكن الاستفادة من المناخ الدولي ومن تجارب الشعوب الأخرى التي سبقتنا إلى الديمقراطية، مع أنها قد تكون أكثر تخلفا منا، وبصورة خاصة تجارب الدول الإسلامية في جنوب شرق أسيا.
وثالثا؛ أن تركز على تعميم وتطوير الحياة الديمقراطية في داخل الأحزاب السياسية والنقابات، وفي غيرها من المنظمات المدنية، أو الأهلية القائمة. فلا يمكن مطالبة المختلف معك بالديمقراطية، إذا كنت أنت نفسك لا تحترمها، ولا تطبقها في حياتك الحزبية، أو المدنية.
ورابعا؛ التشديد على ضرورة وأهمية الحفاظ على السلم الأهلي، وعلى الاستقرار، وعلى قوة الدولة ومنعتها، في إطار القانون والمؤسسات، وعلى ضرورة احترام القوانين والعمل على تطويرها بالطرق المشروعة، ورفض أي خيار غير سلمي، والتركيز على لغة الحوار انطلاقا من أن لا أحد يملك الحقيقة كاملة، والتعامل بندية، ورفض مقولة العدو في إطار المجتمع، واستبدالها بمقولة الخصم السياسي، أو صاحب الرأي المختلف.
وخامسا؛ يجب عدم الخوف والتوجس من احتمال انتعاش وبروز بعض القوى غير الديمقراطية، أو تلك التي تريد المحافظة على الأطر الأهلية للحياة الاجتماعية، فهذا الاحتمال قد يكون لا مفر منه، لكنه مع ذلك سوف يكون من طبيعة انتقالية، سرعان ما يضعف ويتلاشى مع تعمق الحياة المدنية، وزوال الخوف، واستقرار دولة المؤسسات والقانون.
بعد هذه الوصفة الوعظية ألا يجب علينا تحديد النموذج الديمقراطي الذي نريده؟ ألم نقل أن الديمقراطية هي دائما واقعية؟ أي ليس هناك ديمقراطية حقيقية بالمعنى المعياري؟ بكلام آخر هل علينا أن نهدم ما بدأته الأنظمة من انفتاح، وتوسيع لهوامش الحرية والمشاركة، أم البناء عليها؟ قد يكون الجواب عن هذه الأسئلة بديهيا، مع انه ليس كذلك تماما. بالنسبة إلينا الخيار الديمقراطي الذي ننشده في صورته الناضجة هو الخيار الذي يسمح لجميع التناقضات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أن تعبر عن نفسها في مختلف مستويات السلطة. يقوم اختيارنا الديمقراطي هذا على اقتناعنا بأن إشكالية الديمقراطية في الدول العربية تكمن في ضرورة الوحدة العضوية الوظيفية بين الديمقراطية في المجال الاقتصادي والاجتماعي، والديمقراطية في الحقل السياسي. فالعلاقة بين الديمقراطية بما هي نظام في الحكم أو نمط حياة -لا فرق - وبين أسسها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية هي علاقة دائرية يؤدي فيها السياسي دورا محفزا ومحرضا في ظروفنا العربية بشرط وعي ضرورتها.
على هذا الطريق فإن إلغاء الأحكام العرفية، ورفع حالة الطوارئ خطوة، وخلق هوامش للحرية المدنية والسياسية إجراء هام، ونموذج ديمقراطي على الطريقة المصرية أو الأردنية نقلة نوعية، لكن في النهاية لا بديل عن دولة المؤسسات والقانون، واحترام حقوق الإنسان كاملة، وخصوصا حقوقه المدنية والسياسية، وصولا إلى تبادل السلطة سلميا عبر صناديق الاقتراع، من خلال إجراء انتخابات دورية نزيهة وشفافة، مما يخلق وضعا ديناميا يسمح باستقصاء المثل والمبادئ الديمقراطية في الواقع العربي، في ضوء قيمنا وأهدافنا الوطنية والقومية.
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد
 |
نسخ
- Copy
|
نسخ
- Copy
 |
حفظ
|
حفظ
 |
بحث
|
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
|
اضافة موضوع جديد
|
اضافة خبر
|
إضافة إلى المفضلة
|
اضافة موضوع جديد
|
اضافة خبر
|
 |
الحوار المتمدن
|
الحوار المتمدن
 |
قواعد النشر
|
قواعد النشر
 |
ابرز كتاب / كاتبات الحوار المتمدن
|
ابرز كتاب / كاتبات الحوار المتمدن
 |
قواعد نظام التعليقات والتصويت في الحوار المتمدن |
|
قواعد نظام التعليقات والتصويت في الحوار المتمدن |