أزمة العمل النقابي الراهن: من الترويض إلى التآكل
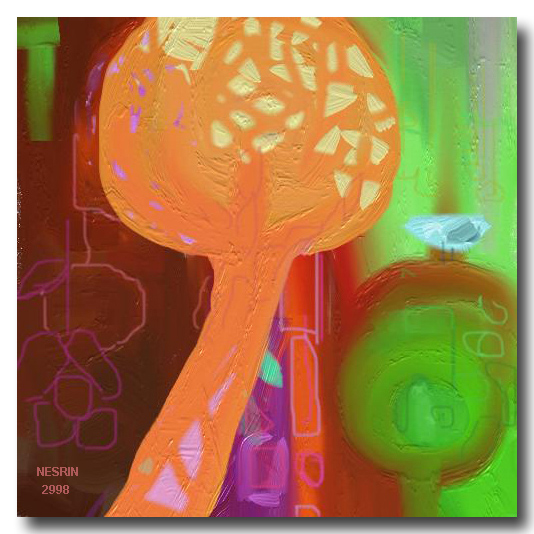
عبد الغاني العونية
2025 / 10 / 8 - 16:08
لم يعد من الممكن اليوم الحديث عن العمل النقابي كفاعل حي في المشهد الاجتماعي دون الاصطدام بواقع الأزمة المركبة التي تحاصره. فالمفارقة أن اتساع الاستغلال، تصاعد البطالة، تدمير الخدمات العمومية، وتعميم الهشاشة، لم يواكبه اتساع في الفعل النقابي، بل على العكس: النقابات تتقلص، الإضرابات تتناقص، ووعي الشغيلة يتجه نحو القطيعة مع النقابة التقليدية.
السؤال إذًا ليس في مظاهر الأزمة، بل في بنيتها. ما الذي يجعل النقابة، وهي المفروض أن تكون رديفًا للاحتجاج والرفض، تتحول إلى أداة ترويض؟ وما السبيل لتجاوز هذا الوضع الكارثي؟
أولًا: أزمة تمثيلية لا أزمة تواصل
غالب الخطابات الرسمية، وحتى بعض الخطابات الإصلاحية، تُرجع الأزمة إلى فجوة تواصلية بين القيادات النقابية والقاعدة العمالية، وتطرح وصفات تقنية من قبيل "تجديد الخطاب"، "تشبيب الأجهزة"، أو "تعزيز الحضور الرقمي". لكن جوهر الأزمة أعمق من ذلك بكثير.
إننا نعيش أزمة تمثيلية سياسية: النقابات لم تعد تعبّر عن مصالح الطبقة العاملة، بل عن مصالح أجهزة بيروقراطية متفرغة، فقدت كل صلة بالصراع الملموس، وأضحت تقايض الملفات الاجتماعية في غرف مغلقة مقابل الامتيازات أو وهم "الاستقرار".
ثانيًا: النقابة كأداة ضبط اجتماعي
تحوّلت النقابة، في وضعها الحالي، إلى جهاز شبه رسمي ضمن منظومة الدولة، يُعاد إنتاجه في الانتخابات المهنية، ويُمنح "الشرعية" في الحوار الاجتماعي. هذه النقابة لا تناضل، بل تُفاوض. لا تعبّئ، بل تُهدّئ. لا تفتح أفقًا، بل تغلقه.
لقد أصبح دورها تأمين الانتقال السلس للسياسات النيوليبرالية، عبر تفكيك المقاومة العمالية، وتفريغ السخط في قنوات مضبوطة. إنها بيروقراطية مروّضة تقوم بدور وظيفي: امتصاص الغضب، عزل النضالات، ومنع التسييس.
ثالثًا: من البيروقراطية إلى الذيلية
البيروقراطية ليست مجرّد قيادات فاسدة أو منتهية الصلاحية، بل هي بنية سياسية تنظيمية تنتج الذيلية والتبعية. والنتيجة أن النقابات صارت عاجزة عن:
دعم الحركات الاجتماعية الجديدة (حراكات الريف، جرادة، الأساتذة المفروض عليهم التعاقد...).
بناء التحالفات الجذرية مع مكونات المجتمع المقاوِم.
إعادة توحيد الطبقة العاملة المُشتتة في قطاعات مجزأة، وهشة، وخارجة عن التأطير الكلاسيكي.
هذا العجز البنيوي يعكس قصر أفقها السياسي: لا أفق للنقابة خارج "الشراكة"، ولا فعل خارج "الحوار"، ولا خطاب خارج "المصلحة الوطنية".
رابعًا: انسحاب الطبقة العاملة من النقابة
النتيجة الطبيعية لهذا الانحراف هو انسحاب القاعدة العمالية من العمل النقابي، ليس لأن العمال لم يعودوا مهتمين بالنضال، بل لأن النقابة لم تعد أداة نضال.
إننا نشهد تقهقرًا جماهيريًا، لكن في ظل تصاعد الاحتجاجات العفوية، التنسيقيات، الإضرابات غير المؤطرة. بمعنى أن هناك طاقة نضالية موجودة، لكنها تجد نفسها خارج النقابة. وهذا هو أخطر وجوه الأزمة: القطيعة التاريخية بين الشغيلة وتنظيمها المفترض.
خامسًا: مهام التيار النقابي الملتزم بخيار المواجهة الاجتماعية
في مواجهة هذا الوضع، لا يكفي الاكتفاء بالنقد، بل يجب طرح مشروع بديل يعيد للنقابة وظيفتها الأصلية: تنظيم الغضب الجماعي، إسناد المعركة الاجتماعية بشروطها الطبقية الحقيقية، وبناء أدوات المقاومة الجماعية في وجه الاستغلال والقمع.
المهام المطروحة اليوم أمام المناضلين داخل الحقل النقابي هي:
1. فضح الطابع الوظيفي للنقابة الرسمية، وتعريتها أمام القواعد.
2. بناء أشكال تنظيم قاعدي حقيقية في مواقع العمل، تنبع من دينامية نضالية مباشرة لا من البنى المتكلسة.
3. توحيد النضالات القطاعية ضمن أفق اجتماعي عام.
4. فتح قنوات الالتقاء مع الحركات الاجتماعية والتنسيقيات.
5. ربط النضال المطلبي بمشروع التحرر الجماعي من الهيمنة الرأسمالية.
خاتمة: إما نقابة منغرسة في الواقع النضالي أو لا جدوى من النقابة
أزمة العمل النقابي الراهن ليست مؤقتة، ولا تقنية، بل هي أزمة دور وموقع ضمن معادلة الصراع الطبقي. لا يمكن تجاوزها إلا عبر انخراط المناضلين الحقيقيين في بناء شكل نقابي جديد: مستقل عن الدولة، متجذر في القواعد، منخرط في مسار التغيير الاجتماعي الجذري.
فالاختيار اليوم ليس بين ترميم الموروث النقابي أو التنازل عنه، بل بين ابتكار أدوات جديدة للمقاومة الجماعية أو ترك الساحة لمزيد من التفكيك والتدجين.
يتبع