من يملك الأرض؟
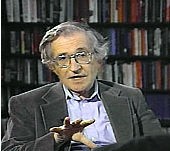
نعوم تشومسكي
2013 / 7 / 25 - 09:33
في ظلّ المآسي المؤلمة على بُعد أميال قليلة منّا، وكوارث أسوأ حتّى لم ينتهِ أثرها بعد، قد يكون من الخطأ، وربما من القسوة، تحويل الانتباه إلى توقعات أخرى، ترسم على الرغم من إبهامها وغموضها طريقاً نحو عالم أفضل، في مستقبل ليس بالبعيد. لقد زرتُ لبنان مرات عدّة وشهدتُ على لحظات أمل كبير ويأس، طُبعت بالعزم الملحوظ على تخطّيها والمضي قدماً في أوساط الشعب اللبناني.
وكانت أوّل مرة زرتُ فيها لبنان منذ 60 سنة. وكنتُ أتسلّق برفقة زوجتي الجبال في شمال الجليل ذات مساء، حين مرّت سيارة جيب بجانبنا وطلب منا سائقها العودة، لأننا كنّا في البلد الخطأ. فقد عبرنا، عن غير قصد، الحدود التي لم تكن محدّدة آنذاك، وأفترض أنّها باتت اليوم مدججة بالسلاح. ولعلّه حدث عابر، لكنّه دفعني إلى استخلاص عبرة، وهي أنّ شرعية الحدود وشرعية الدول تكون في أفضل الأحوال ظرفية ومؤقتة.
لقد فُرضت جميع الحدود تقريباً بالعنف وتم الإبقاء عليها بالعنف أيضاً، وهي اعتباطية إلى حد كبير، بل عارية من أي منطق، ما يفسّر السبب الذي يجعلها سهلة العبور على نحو غير مقصود.
عند النظر إلى الصراعات المريعة في أرجاء العالم، يتّضح أنّ معظمها من بقايا الجرائم الإمبريالية وحصيلة الحدود التي رسمتها القوى العظمى لمصالحها الخاصة. فمثلا لم ترضَ قبائل البشتون الاعتراف بشرعية خط دوراند الذي رسمته بريطانيا بهدف فصل باكستان عن أفغانستان. كما كان هذا الخط مرفوضاً من كلّ حكومة أفغانية تشكّلت. ومن مصلحة القوى الإمبريالية الحالية اعتبار البشتون العابرين لخط دوراند «إرهابيين»، حتى تشنّ طائرات أميركية من دون طيار، وقوات العمليات الخاصة، هجمات قاتلة على منازلهم.
وقليلة هي دول العالم التي تُحرَس حدودها باستخدام التكنولوجيا المتطوّرة وتخضع لمنطق متّقد كما يحصل بالنسبة الحدود التي تفصل المكسيك عن الولايات المتحدّة، واللتين تجمع بينهما علاقات دبلوماسية ودية.
لقد تمّ إرساء هذه الحدود جرّاء هجوم شنّته الولايات المتحدّة خلال القرن التاسع عشر، إلا أنّها بقيت مفتوحة لغاية عام 1994، حين أطلق كلينتون عملية «حارس البوابة» لعسكرة الحدود.
وقبل ذلك، كان الناس يعبرون هذه الحدود للقاء الأقرباء والأصدقاء. ومن المرجّح أن تكون عملية «حارس البوابة» ناتجة عن حدث آخر حصل في تلك السنة، وهو فرض «اتفاقية التجارة الحرة في أميركا الشمالية» (نافتا)، مع العلم بأنها تسمية خاطئة بسبب عبارة «تجارة حرّة».
ولاشك أن إدارة أوباما أدركت أن المزارعين المكسيكيين، مهما كانوا فاعلين، عاجزون عن منافسة المشاريع الزراعية الأميركية المدعومة بشدة، وأن الشركات المكسيكية لا تستطيع منافسة الشركات الأميركية متعددة الجنسيات، التي تحصل بموجب قوانين اتفاقية «نافتا» على ميزات خاصة، مثل «المعاملة الوطنية» في المكسيك. ومن شأن إجراءات مماثلة أن تؤدي إلى تدفق المهاجرين عبر الحدود.
تتلاشى بعض الحدود بموازاة الكره والنزاعات القاسية التي تمثلها وتلهمها. أما الحالة الأكثر مأساوية فتتمثّل بأوروبا. فعلى مدى عقود، كانت أوروبا المنطقة الأكثر وحشيةً في العالم، وقد مزقتها حروب مدمرة وبشعة. وطوّرت أوروبا تكنولوجيا الحرب وثقافتها التين سمحتا لها بغزو العالم، ثم توقّف الدمار المتبادل مع انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وينسب باحثون هذه النتيجة إلى فرضية السلام الديمقراطي، ومفادها أن الدولة الديمقراطية تتردد في شن حرب ضد دولة ديمقراطية أخرى. غير أن الأوروبيين أدركوا أنهم طوروا قدرات على بث الدمار إلى حد قد يجعل المرة القادمة التي يلعبون فيها لعبتهم المفضلة المرة الأخيرة.
واللافت أنّ التكامل المتزايد الذي تطوّر منذ ذلك الحين لم يخلُ من المشاكل الجدية، إلا أنه شمل تحسناً واسع النطاق مقارنة بما كانت عليه الأمور سابقاً.
ويصعب لنتيجة مماثلة أن تشكل سابقة بالنسبة للشرق الأوسط، الذي بقي بلا حدود حتى وقت قريب من الآن، مع الإشارة إلى أن الحدود تتلاشى، وإن حصل ذلك بطرق مريعة.
وفي سوريا، يؤدي اندفاع البلاد بلا هوادة على طريق الانتحار إلى تمزيق البلد وتشتيتها. وتوقع مراسل الشرق الأوسط المخضرم باتريك كوكبيرن، أن يؤدي اشتعال الوضع إلى انهيار نظام سايكس-بيكو.
لقد أعادت الحرب الأهلية السورية إشعال النزاع السني الشيعي، الذي يعد من أخطر تداعيات الغزو الأميركي البريطاني للعراق قبل عشر سنوات. وتتجه المناطق الكردية في العراق وسوريا نحو الاستقلال الذاتي وإنشاء الروابط، حيث يشير عدد كبير من المحللين إلى احتمال نشوء دولة كردية قبل قيام دولة فلسطينية.
وفي حال حصلت فلسطين على الاستقلال، من المرجح أن تتلاشى حدودها مع إسرائيل، بفضل التبادلات التجارية والثقافية الطبيعية بين الجانبين، كما حصل في الماضي خلال فترات الهدوء النسبي.
وقد يكون هذا التطور خطوة باتجاه حصول تكامل إقليمي أكبر، وربما باتجاه الاضمحلال البطيء للحدود الاصطناعية التي تقسم الجليل بين إسرائيل ولبنان، حتى يستطيع محبو رياضة السير في الطبيعة وغيرهم أن يعبروا بحرية المنطقة التي عبرتُها برفقة زوجتي منذ 60 سنة.
ويبدو لي أن هذا التطور يوفر فسحة الأمل الواقعية الوحيدة للتوصل إلى حل لمحنة اللاجئين الفلسطينيين، وهي ليست سوى واحدة من كوارث اللاجئين التي تعانيها المنطقة منذ غزو العراق وتدهور سوريا نحو الجحيم.
ولا شك أن تلاشي الحدود، والتحديات المفروضة على شرعية الدول، تثير أسئلة جدية حول هوية من يملك الأرض. من يملك الغلاف الجوي للكرة الأرضية، الذي تلوثه الغازات التي تحبس الحرارة، والتي سجلت مستويات قياسية؟
ولاستعارة الجملة التي استخدمها السكان الأصليون في معظم أنحاء العالم، من سيدافع عن الأرض؟ من سيصون حقوق الطبيعة؟ من سيؤدي دور المضيف ويصون أملاكنا المشتركة؟
من الواضح بالنسبة لأي شخص عاقل ومثقف أن الأرض بحاجة ملحة إلى الحماية من الكارثة البيئية الوشيكة. ولاشك أن ردود الفعل المختلفة على الأزمة هي من أهم خصائص التاريخ الحالي.
وفي مقدّمة المدافعين عن الطبيعة، من يُسَمون بالشعوب «البدائية»؛ أي مجموعات الشعوب الأصلية والقبائل، أمثال «الأمم الأولى» في كندا والسكان الأصليين في أستراليا، وهم بقايا الشعوب التي صمدت في وجه المجازر الإمبريالية. وفي طليعة المعتدين على الطبيعة من يعتبرون أنفسهم الأكثر تقدماً وتحضراً.
يتبلور النضال من أجل الدفاع عن الميراث المشترك بأشكال عديدة. وعلى نطاق ضيق، يحصل حالياً في ميدان تقسيم في تركيا، حيث يسعى رجال ونساء شجعان لحماية إحدى آخر بقايا الميراث المشترك في إسطنبول من المشاريع التجارية، والتدهور البيئي، والحكم الاستبدادي الذي يدمر هذه الثروة القديمة.
ويعد المدافعون عن البيئة في ميدان تقسيم في مقدمة المناضلين العالميين في سبيل حماية الميراث العالمي المشترك من معاول الدمار. ويجب أن نشارك جميعاً في هذا النضال بتفان وعزم، للحفاظ على الأمل بعيش حياة كريمة، في عالم مجرد من الحدود. هذا هو ميراثنا المشترك، فإما أن نحميه أو ندمره.