في ظلّ الرأسمالية... هل تصمد الحضارة؟
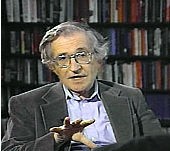
نعوم تشومسكي
2013 / 3 / 12 - 08:16
ثمّة «رأسمالية»، وثمة «الرأسمالية القائمة فعلاً»، يُستعمل مصطلح «الرأسمالية» بشكل شائع للإشارة إلى النظام الاقتصادي الأميركي، مع تدخّل لافت من قبل الدولة يتراوح بين دعم الابتكار الإبداعي وتغطية الحكومة المطلقة للبنوك، مهما كانت مخاطرها كبيرة.
النظام محتكَر للغاية، ويحدّ من اعتماده على السوق بنحو متزايد: أورد الكاتب «روبرت ماكشيسني» في كتابه الجديد «ديدجتل ديسكونكت» أنّه في السنوات العشرين الماضية، ارتفعت حصة أكبر مئتي شركة من الأرباح بشكل ملحوظ.
اليوم، يُستخدم مصطلح «الرأسمالية» للإشارة إلى الأنظمة التي يغيب فيها الرأسماليون، أو الشركات التي تتّبع خططاً توسعية والمملوكة للعمّال.
وقد يستعمل البعض مصطلح «الرأسمالية» للإشارة إلى الديمقراطية الصناعية التي دافع عنها «جون ديوي»، الفيلسوف الأميركي الرائد في علم الاجتماع ، في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.
ودعا «ديوي» العمّال ليكونوا «أسياد مصيرهم الصناعي»، كما دعا لأن تخضع المؤسّسات كافة لرقابة عامة، بما في ذلك وسائل الإنتاج، والتبادل، والشهرة، والنقل، والتواصل. فبحسب «ديوي»، من دون هذه الشروط، ستبقى السياسة «عبئاً على المجتمع بسبب الشركات الكبيرة».
وفي السنوات الأخيرة، بقيت الديمقراطية المبتورة التي أدانها «ديوي» في حالة يرثى لها. فاليوم، ترتكز رقابة الحكومة بشكل ضيق على رأس سلّم الدخل، فيما حُرمت الأكثرية الكبرى «أدناه» عمليّاً حقها. النظام السياسي الاقتصادي الراهن هو شكل من أشكال «البلوتوقراطية» التي تختلف كليّاً عن الديمقراطية، إذا قصدنا بهذا المفهوم الترتيبات السياسية، حيث تتأثر السياسة إلى حدّ بعيد بالإرادة العامة.
جرت مناقشات جادة على مرّ السنين حول ما إذا كانت الرأسمالية تتوافق مع الديمقراطية. ولكن إذا أبقينا على ديمقراطية الرأسمالية القائمة فعلاً، سيكون الجواب حتماً: هما تتعارضان بشكلٍ جذري. يبدو لي أنّه من غير المرجّح أن تستمرّ الحضارة في ظلّ الديمقراطية الرأسمالية القائمة فعلاً والديمقراطية المخفّفة بشدّة التي تأتي معها. ولكن أيمكن لديمقراطية فاعلة أن تُحدث فرقاً؟
فلنركز انتباهنا في الوقت الراهن على المشكلة الحالية الدقيقة التي تواجهها الحضارة، ألا وهي الكارثة البيئيّة. وفي هذا الصدد، تختلف السياسات والمواقف العامّة بشكل حاد، كما هو الحال غالباً في ظلّ الديمقراطية الرأسمالية القائمة فعلاً. وتبحث مقالات عدّة في العدد الحالي من مجلة «ديدالوس»، التي تصدرها أكاديمية الفنون والعلوم الأميركية، في طبيعة الفجوة.
وأظهرت الباحثة «كيلي جالاجر سيمز» أنّ «مائة وتسع دول انتهجت بعض أنواع السياسات بشأن الطاقة المتجدّدة، فيما وضعت مائة وثماني عشرة دولة أهدافاً حول الطاقة المتجدّدة. في المقابل، لم تتّخذ الولايات المتحدة أي سياسات متماسكة وثابتة على المستوى الوطني لتعزيز استخدام الطاقة المتجدّدة».
ليس الرأي العام الذي يُبعد السياسة الأميركية عن الاتجاه الدولي، بل على العكس تماماً، فالرأي العام أقرب من المعيار العالمي أكثر ممّا تعكسه سياسات الحكومة الأميركية، وهو أكثر دعماً للإجراءات اللازمة لمواجهة الكارثة البيئيّة المحتملة والمتوقعة بإجماع علمي شامل – وهي كارثة بيئيّة وشيكة ستؤثر دون شك على حياة أحفادنا.
وجاء في تقرير «جون كروسنك» و«بوماكينيس» في مجلّة «ديدالوس»، «أنّ الأكثريات الساحقة دعمت خطوات الحكومة الفيدرالية بغية الحدّ من كمية انبعاث غازات الدفيئة الناتجة عن إنتاج الكهرباء في المنشآت. ففي عام 2006، دعم 86 في المئة من المُستطلعين الطلب من المنشآت أو تشجيعها عبر إعفاءات ضريبية، على تقليص كمية غازات الدفيئة التي تبعثها فضلاً عن ذلك، دعم 87 في المئة في ذلك العام الإعفاءات الضريبية للمنشآت التي تنتج المزيد من الكهرباء بواسطة المياه أو الرياح أو أشعة الشمس، واستمرّت هذه الأكثريات بين عامَي 2006 و2010 وتقلّصت إلى حدٍّ ما بعد ذلك. ويُعتبر واقع تأثيرّ العلم على الشعب أمراً مقلقاً للغاية، لأولئك الذين يهيمنون على الاقتصاد وعلى سياسة البلد.
أما خير مثال على قلقهم الحالي، فهو «وثيقة تحسين المعرفة البيئية»، التي اقترحها مجلس التبادل التشريعي الأميركي على المجالس التشريعية للدولة، وهو لوبي تموّله الشركات، يصمّم التشريعات لتلبية حاجات قطاع الشركات والثروة القصوى.
تنصّ وثيقة مجلس التبادل التشريعي الأميركي على «تعليم متوازن» لعلم المناخ في الصفوف الابتدائية والثانوية. «التعليم المتوازن» هو عبارة عن رمز يشير إلى تعليم استنكار التغير المناخي وإلى «توازن» علم تعميم المناخ. وهو مماثل «للتعليم المتوازن»، الذي ينادي به المدافعون عن علم المخلوقات لتمكين تعليم «علم الخلق» في المدارس الرسمية. 76 في المئة وقد أُدخلت تشريعات في ولايات عدّة استناداً إلى نماذج مجلس التبادل التشريعي الأميركي.
ومن المؤكّد أنّ كل ذلك يندرج في بيان رسمي حول تعليم التفكير النقدي- ولا شكّ أنها فكرة سديدة، ولكن من السهل التفكير في أمثلة أفضل بكثير من قضية تهدّد بقاءنا تمّ اختيارها نظراً لأهميّتها في ما يتعلّق بأرباح الشركات.
أما تقارير وسائل الإعلام، فتطرح على نحوٍ مشترك جدلاً بين طرفَين بشأن تغير المناخ. طرفٌ يتألّف من الأكثرية الساحقة من العلماء وأكبر الأكاديميات الوطنية للعلوم في العالم، والمجلّات العلمية المهنية، واللجنة الحكومية البينية المعنية بتغير المناخ.
وتوافق كل هذه الأطراف على أنّ الاحترار العالمي جار، وأنّ العنصر الإنساني يلعب دوراً كبيراً فيه، وأنّ الوضع خطير وربما وخيم، وأنّه في وقتٍ قريب جداً، ربما خلال عقود، قد يصل العالم إلى نقطة تحوّل حيث تتفاقم المشكلة بحدّة لدرجة أنّه سيتعذّر العودة عنها، مخلّفةً آثاراً اقتصادية واجتماعية خطيرة. إشارة إلى أنّه من النادر أن نجد مثل هذا الإجماع على القضايا العلمية المعقّدة.
أمّا الطرف الآخر، فيتألّف من مشكّكين، ومن ضمنهم بعض العلماء المحترمين الحذرين، إذ يبقى بنظرهم الكثير مجهولاً – ما يعني أنّ الأمور قد لا تكون سيّئة كما كان يُعتقد، أو أنّها قد تكون أسوأ.
لم تُذكر مجموعة أكبر بكثير من المشكّكين في النقاش: يرى علماء المناخ المرموقون أنّ تقارير اللجنة الدولية لتغير المناخ المنتظمة محافظة أكثر من اللازم. ولسوء الحظ، لقد أُثبت مراراً وتكراراً أنّ هؤلاء العلماء على حق.
بدا لحملة نشر الأكاذيب تأثير على الرأي العام الأميركي، وهو أكثر تشكيكاً من المعيار العالمي، إلّا أنّ التأثير ليس كافياً لإرضاء الأسياد. من المفترض أن يكون هذا هو السبب الذي يدفع قطاع الشركات في العالم إلى شنّ هجوم على النظام التعليمي في محاولة لتغيير نزعة الرأي العام الخطيرة إلى الانتباه إلى استنتاجات الأبحاث العلمية.
في ظلّ نظام الديمقراطية الرأسمالية القائمة فعلاً، من المهمّ جدّاً أن نتحوّل إلى الأمّة الغبية، التي لا يضلّلها العلم والعقلانية لصالح المكاسب القصيرة الأمد لأسياد الاقتصاد والنظام السياسي، ولا مشكلة في العواقب. تتجذّر هذه الالتزامات في مذاهب السوق الأصولية المبشّر بها في إطار الديمقراطية الرأسمالية القائمة فعلاً، على الرغم من أنّه يُنظر إليها بطريقة انتقائية للغاية، وذلك بغية الحفاظ على دولة قوية تخدم الثروة والسلطة.
غير أنّ الكارثة البيئية أشدّ خطورة: فالتأثيرات الخارجية التي يتمّ تجاهلها هي مصير الأجناس، ولا يمكن اللجوء إلى أي مكان لطلب النجدة.
في المستقبل، سيعيد المؤرّخون (إن بقي مؤرّخون) النظر إلى المشهد الغريب الذي ً تجسّد في أوائل القرن الواحد والعشرين. ولأوّل مرّة في تاريخ البشرية، سيواجه البشر احتمال وقوع مصيبة خطيرة كنتيجة لأفعالهم - أفعالٌ تقضي على آمالنا في العيش اللائق.
وسوف يلاحظ هؤلاء المؤرّخون أنّ أغنى وأقوى دولة في التاريخ التي تتمتّع بمزايا لا تُضاهى، هي التي تقود الجهود التي ترمي إلى زيادة حدة الكارثة المحتملة. أمّا المجتمعات المسمّاة «بالبدائيّة» على غرار الأمم الأولى، والقبائل، والبدائيين، والأصليين، فتقود الجهود للحفاظ على الظروف الملائمة ليتمتع أحفادنا بحياة لائقة.
إنّ البلدان التي تسكنها غالبية من الشعوب الأصلية تقف في طليعة البلدان التي تسعى للحفاظ على الأرض. في حين أنّ الدول التي تسببّت في انقراض السكان الأصليين أو تهميشهم تتسابق إلى الدمار. لذلك تسعى الإكوادور، بعدد سكّانها الأصليين الهائل، للحصول على مساعدات من الدول الغنية لتتمكّن من الحفاظ على احتياطاتها الكبيرة من النفط في الأرض، حيث ينبغي أن تكون.
وفي غضون ذلك، تسعى الولايات المتحدة وكندا لحرق الوقود الأحفوري، بما في ذلك رمال القطران الكندية الشديدة الخطورة، والقيام بذلك بأسرع وقت ممكن وعلى أكمل وجه، في حين أنّهما تحيّيان عجائب قرن (من دون معنىً إلى حدٍّ كبير) من الاستقلالية في مجال الطاقة، من دون إلقاء نظرة جانبية إلى ما قد يبدو عليه العالم بعد هذا الالتزام المفرط بتدمير الذات.
تعمّم هذه الملاحظة ما يلي: تكافح المجتمعات الأصلية في جميع أنحاء العالم من أجل حماية ما تسمّيه أحياناً «بحقوق الطبيعة» بينما تسخر المجتمعات المتحضّرة والمتطوّرة من هذه الحماقة. هذا هو بالضبط عكس كلّ ما يمكن أن تتوقّعه العقلانية - إلّا إذا كان شكل المنطق المنحرف هو الذي يمرّ عبر مصفاة الديمقراطية الرأسمالية القائمة فعلاً.